أبو عبيدة التّيمي
منهجه ومذهبه في «مجاز القرآن»
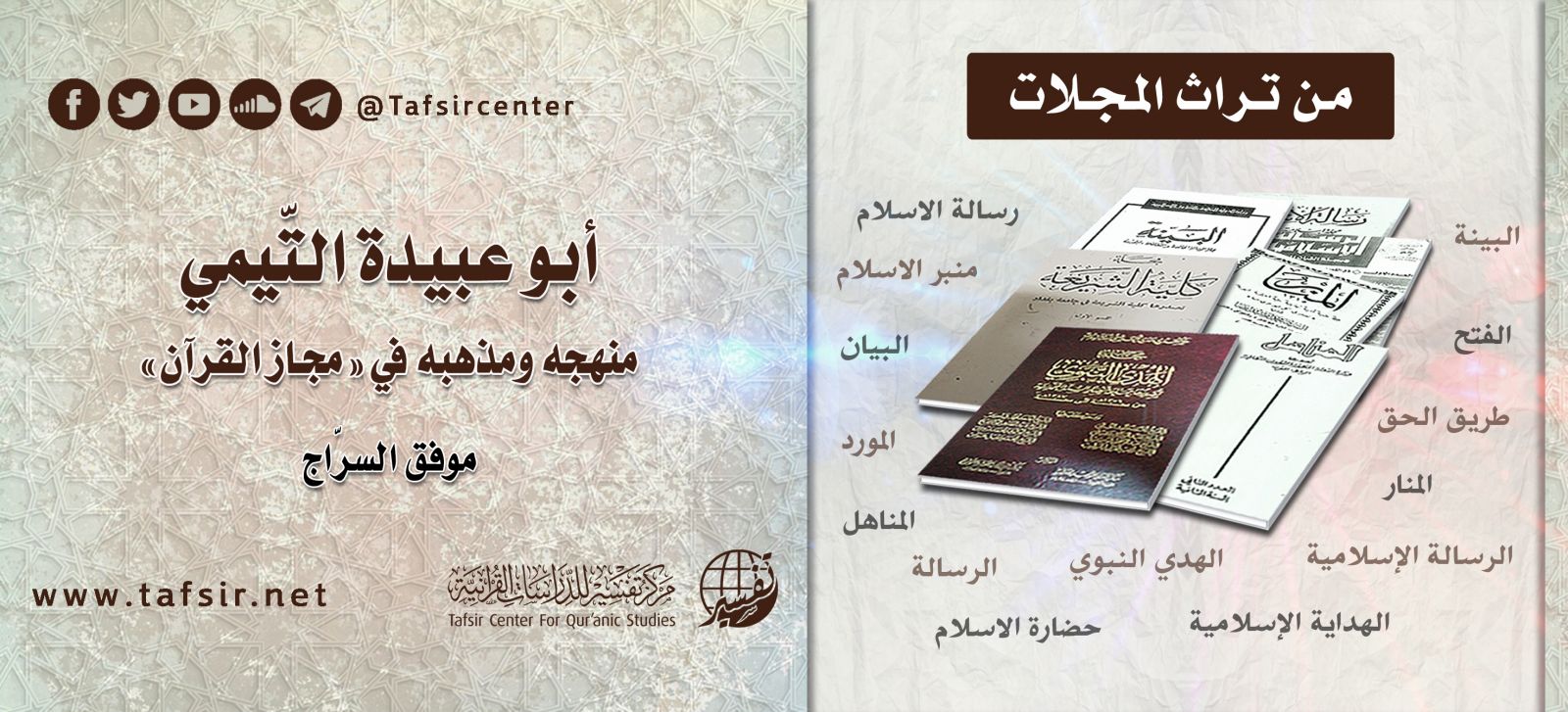
أبو عبيدة التّيمي؛ منهجه ومذهبه في «مَجاز القرآن»[1]
تمهيد:
أحبُّ أن أشير في البداية إلى أنَّ أهمَّ نقطة يمكن أن يتعرّض لها الباحثون في التراث العربي هي المنهج الذي كان يتبعه أصحاب تلك الأعمال التراثية الضخمة في مؤلَّفاتهم، هذا المنهج الذي يتخطّى حدود الزمان والمكان، ويكشف عن التوجّه العقلي الذي يصدر عنه الكاتب في كتاباته، وبالتالي يدلّ على مكانة العمل التراثي وصاحبه، والأثر الذي خلّفه في عصره وما بعد عصره، ويجلو مذاهب المؤلِّفين من آثارهم. وذاك ما أبتغيه من هذه الدراسة فأعرض لكتاب «مجاز القرآن»، لأبي عبيدة مَعمر بن المثنّى التيمي (110- 210هـ)، فأبيّن من خلال هذا الكتاب منهج مؤلِّفه ومذهبه؛ لأنه أول كتاب وصَلنا في عنوانه وموضوعه، وعندما ظهر في زمانه أحدث ضجة كبيرة في الأوساط العلمية المختلفة، ولكن أرى من الضرورة قبل ذلك أن أعرِّج على ما أُلِّف في القرآن كي نعرف إلى أيّ لون من التفاسير القرآنية ينتمي كتاب المجاز هذا.
ما أُلِّف في القرآن:
قد يكون من نافلة القول أنْ نُذَكِّر بأنّ لونًا من ألوان التراث العربي لم يحظَ بالعناية والدراسة والشرح والتمحيص مثل ما حظي به القرآن الكريم خاصّة، والعلوم الشرعية عامّة، منذ نزل القرآن على محمد -صلى الله عليه وسلم- ليكون مفسّره الأول إلى الصحابة والتابعين والعلماء والدارِسين في أصقاع متنوّعة من عالم واسع عريض امتدّ من الصين والهند في أقصى المشرق، إلى مراكش والأندلس في أقصى المغرب، وحتى عصرنا هذا الذي ظهرتْ فيه -ولا تزال- دراسات وشروح وتفاسير مختلفة.
والناظر إلى المكتبة القرآنية يدرك مدى غناها بكتب التفسير، كما يلحظ ألوانًا شتّى للتفاسير، بسبب العصبيات المذهبية والسياسية والفكرية التي ينتمي إليها المفسِّرون، فكان ما يسمى بـ(التفسير بالمأثور) أو (التفسير النقلي)، الذي اعتمد فيه أصحابه على ما وَرد في القرآن وما جاء في الحديث الشريف وأُثر عن الصحابة والتابعين من تفسيرٍ للآيات.
ثم (التفسير بالرأي) أو (التفسير العقلي)، الذي اتخذ من الرأي أو العقل والاجتهاد طريقًا له في الكشف عن غامض التنزيل. و(تفاسير الفِرق الإسلامية المختلفة) ترجع في الحقيقة إلى التفسير بالرأي؛ لأنّ أصحابها لم يؤلِّفوها إلا لتأييد أهوائهم؛ ومن ذلك تفاسير المعتزلة والمتصوّفة. ويغلِب على تفاسير المعتزلة الطابع العقلي والمذهب الكلامي، ولا ترد النصوص فيها إلا على أنها شيء ثانوي نادرًا ما يلجؤون إليه لشرح معاني الآيات[2]، ويغلِب على تفاسير المتصوّفة الشطحات التي تبعدهم عن النَّسَق القرآني، وتجعل كلامهم غامضًا إلا على المشتغل بالشؤون الروحية[3].
ويقرب من تفاسير المتصوّفة ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو الذي تؤوّل به الآيات على غير ظاهرها مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي[4].
إلا أنّ مِن كتب التفسير ما أظهر عناية خاصّة في جانب من جوانب القرآن؛ كالتوجيه الإعرابي أو البلاغي أو النظرِ في معاني مفردات القرآن، أو مجازِه، أو في أقسامه، أو نَظْمِه. ونذكُر من ذلك على سبيل المثال كتابَ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت: 210هـ)، وكُتُبَ «معاني القرآن»: للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة[5] (ت: 215هـ)، ويحيى بن زياد الفرّاء[6] (ت: 207هـ)، والزجّاج[7] (ت: 310هـ)، وأبي جعفر النحاس[8] (ت: 337هـ)، وكتابَ «أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص (ت: 370هـ)، و«إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه (ت: 370هـ)، و«إعجاز القرآن» للقاضي الباقلاني (ت: 403هـ)، و«دلائل الإعجاز» للإمام عبد القاهر الجرجاني (ت: 471هـ)، وكتاب «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني (ت: 502هـ)... إلخ.
ولعلّ من دواعي كثرة الدراسات والتفاسير القرآنية أنّ هذا الكتابَ قد بهر أرباب الفصاحة والبيان، وجعلهم عاجزين عن مجاراته، بَلْه الإتيان بآية من آياته، مما دفع علماء العربية إلى البحث عن أسباب إعجازه من جهة، واستنباط قواعد العربية النحوية واللغوية من خلال القراءات التي لم تعدُ وجوهًا فصيحة صحيحة لكلام العرب ولهجاتهم من جهة أخرى، فظهرتْ عن ذلك التفاسير اللغوية التي يلجأ فيها المفسِّر إلى اللغة، يستعين بها في تطبيق المنهاج الذي ارتضاه لنفسه والمذهب الذي يميل إليه. بيدَ أنّ الاعتماد على اللغة يختلف مقداره من مفسِّر إلى آخر؛ فمنهم مَن جعل كلَّ اعتماده أو جُلَّه على اللغة، فقدّموا إلينا كُتُبَ (معاني القرآن)، التي تنحو في التفسير منحى لغويًّا ونحويًّا وبلاغيًّا. وكتابُ (مجاز القرآن) واحد منها، وإن اختلف عنها في التسمية؛ لأنه ينحو في التفسير منحى لغويًّا.
ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أنّ الحركة اللغوية عامة، والنحوية خاصّة، بدأتْ أول ما بدأت، بدافعٍ من الحرص على حِفْظِ ألسُنِ العرب من اللّحن وتعليمِ الأعاجم -الذين دخلوا الإسلام أفواجًا- حُسْنَ قراءة القرآن، «وكان القائمون على ذلك من قرّاء القرآن الذين ورثوا ألوانًا من وجوه القراءات، هي سابقة -ولا شك- على الاشتغال باللغة والنحو، فمن الطبيعي -والحالة هذه- أن يورثوها بدورهم تلاميذَهم، وأن يحاول هؤلاء التلاميذ مع الزمن تأويلها وتعليلها حين بدأت تتكوّن مقومات البحث المنهجي العلمي»[9].
وكي لا نشعّب القول ونظلّ في التعميم، نلقِي المرساة في أواخر القرن الثاني الهجري فنرى أنّ «أوّل ما يطالعنا من دراسات القرآن الدراساتُ اللغوية والنحوية لأسلوب القرآن، أمّا اللغوية فيضطلع بها أبو عبيدة معمر بن المثنّى في كتابه (مجاز القرآن)، وأمّا النحوية فيضطلع بها أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء في كتابه (معاني القرآن)»[10]، وسوف نقف على الكتاب الأول ونفصّل فيه القول لأنّ عليه مدار حديثنا.
في مجاز القرآن:
كنتُ قد ذكرتُ أن هذا الكتاب ينضوي تحت ما أُلّف من كتب في (معاني القرآن)، وإن اختلف عنها في التسمية؛ لأنه ينطلق -كما انطلقت هذه الكتب- في غاية واحدة هي الرجوع إلى أساليب العربية المستعملة، ومعرفة الطرق التي تسلكها في التعبير، ومِن ثَمّ فَهْمُ آية التنزيل التي نزلتْ على طريقة العرب.
وإذا كان كتاب الفرّاء (معاني القرآن)، يمثّل المذهب الكوفي النحوي واللغوي، فإنّ (مجاز القرآن)، لا يكاد يمثّل مذهبًا سوى الرأي المتحرّر من القيود التي كانت المدرستان البصرية والكوفية تضعانها لفهم النصوص[11]، على أنّ صاحبه يُعَدّ من علماء البصرة.
ومع أنّ الكتاب قد وُجدت فيه بعض آثار البحث البلاغي إلا أنّ الطابع اللغوي يكاد يطغى عليه حتى يوشك أن يكون كتاب لغة قبل أن يكون كتاب تفسير. و«يُعَدّ (معاني القرآن) للفرّاء دراسة مكملة -من الناحية اللغوية- لكتاب (مجاز القرآن)؛ لأنه يبحث في التراكيب والإعراب، و(المجاز) يبحث في الغريب والمجاز، وكلتا الدراستين متعلقتان بالأسلوب، واختلفت دراسة الفرّاء هنا عن دراسة أبي عبيدة، وكان لهذا الخلاف أسبابه»[12].
ولكن ما الدافع الذي جعل أبا عبيدة يؤلِّف كتاب المجاز؟ ويطلِق عليه هذا الاسم؟ وفي أيّ وقت كان ذلك؟
لقد ذكرَتْ كتبُ التراجم سبب التأليف وزمنه من غير تحديدٍ دقيق للسّنَة التي تم فيها ذلك. سوى ياقوت الحموي الذي حدّد زمن تأليفه بسنة 188هـ، قال: «...قال أبو عبيدة: أرسَل إليَّ الفضلُ بن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه سنة 188هـ، فقدمتُ إلى بغداد واستأذنتُ عليه فأذن لي، ودخلتُ وهو في مجلس له طويل عريض في بساط واحد قد ملأه، وفي صدره فرش عالية لا يُرتقى إليها إلا على كرسي وهو جالس عليها. ثم دخل رجل في زي الكُتَّاب له هيئة فأجلسه إلى جانبي، وقال له: أتعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا أبو عبيدة علّامة أهل البصرة، أقدمناه لنستفيد من علمه، فدعا له الرجل وقرظه لفعله هذا. قال لي: إني كنت إليك مشتاقًا وقد سُئلت عن مسألة أفتأذن لي أن أُعرّفك إياها؟ قلت: هات. قال: قال الله تعالى: ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾، وإنما يقع الوعد والإيعاد بما قد عُرف مثلُه، وهذا لم يُعرف، فقلت: إنما كلّم الله العرب على قدر كلامهم، أمَا سمعتَ قولَ امرئ القيس:
أيقتلني والمشرفيُّ مضاجعي ** ومسنونة زرق كأنياب أغوال
وهم لم يروا الغول قط، ولكنه لما كان أمرُ الغول يهولهم أُوعدوا به، فاستحسن الفضلُ ذلك، واستحسنه السّائل، واعتقدتُ من ذلك اليوم أن أضع كتابًا في القرآن لمثل هذا وأشباهه، ولِما يُحتاج إليه من علم. فلما رجعت إلى البصرة عملتُ كتابي الذي سميته (المجاز)، وسألتُ عن الرجل فقيل لي: هو من كُتّاب الوزير وجلسائه يقال له: إبراهيم بن إسماعيل بن داود الكاتب»[13].
وهذا الذي حكاه أبو عبيدة يلفتنا إلى أمور نرى من الفائدة ذكرها، وهي الآتية:
1. أنّ أبا عبيدة أَلّف كتاب المجاز سنة 188هـ، وهذا يعني أنه سابق لكتاب الأخفش الأوسط الذي اعترف بأنه أفاد منه في كتابه (معاني القرآن)، كما سيرِد في حينه، كما أنه أسبق من كتاب الفرّاء الذي أُلّف ما بين (202- 204هـ).
2. إنّ الدافع لتأليفه هو سؤال إبراهيم بن إسماعيل بن داود أحد كُتّاب الوزير الفضل بن الربيع، ولم يكن هذا الكاتب ممن عُرِفوا بالفصاحة والحذق وسَعَة الاطلاع على العربية ومذاهبها من أفواه أصحابها الذين ارتحل إليهم علماء العربية، فدرسوا اللغة عليهم في مواطنها، وإنما كان -فيما يبدو- ممن تَعَلَّم العربية تعلُّمًا مدرسيًّا كما كانت تُعلَّم في المدن، فعَرف القواعد الدقيقة التي تنسرب اللغة فيها، من غير أن يدرك الأوجه المختلفة التي تُستعمل فيها مفردات العربية التي تتمرّد على كلّ القواعد الصارمة التي يجب أن تخضع لأحوال استعمال المفردات، لا أن تخضع هذه المفردات لتلك القواعد[14] التي كانت تدرس في مجالس النحاة واللغويين. «وغنيّ عن البيان أنّ أيّ قاعدة نحوية أو لغوية تضيق دائمًا عن إمكانات الواقع الحي للغة وثرائه، ويظلّ مَن يتعلم اللغة ولفترة طويلة جدًّا في حدود القواعد والحدود، دون أن يتجاوز ذلك إلى رحابة الأساليب الفنية للغة»[15].
«فالفكرة التي تراود أبا عبيدة وهو يؤلِّف كتابه كانت فكرة مدرسية، يحاول أن يضع أمام طبقة المستعربين صورًا من التعبير في القرآن وما يقابله من التعبير في الأدب العربي شعرًا ونثرًا، ويبيّن ما فيها من التجاوز أو الانتقال من المعنى القريب أو التركيب المعهود للألفاظ والعبارات إلى معانٍ وتراكيب أخرى اقتضاها الكلام. فكلمة (مجاز) عنده إذًا ليست مجرّد مقابل لكلمة (تفسير) أو كلمة (معنى) بصفة مطلقة. وإنّ هذا لا ينفي إطلاقها أحيانًا في ذلك المعنى»[16].
فهو قد سماه بـ(المجاز) انطلاقًا من هذا المعنى؛ لأنّ «جاز الموضعَ جوزًا ومجازًا: سار فيه وخلَّفه،... والمجاز: الطريق إذا قُطع من أحد جانبيه إلى الآخر. وخلاف الحقيقة»[17].
والمجازة: الطريقة. والمادة ومشتقاتها تعني (الانتقال) بوجهٍ عامّ، ومنه التجوّز في الشيء: الترخّص فيه[18].
وقد وضّح لنا مراده هذا منذ الصفحة الأولى وما تلاها، عندما شرح معنى كلمة (قرآن) ولماذا سمي القرآن بهذا الاسم، فقال: «القرآن: اسم كتاب الله خاصّة، ولا يسمّى به شيء من سائر الكتب غيره، وإنما سُمّي قرآنًا لأنه يجمع السور فيضمها، وتفسير ذلك في آية من القرآن، قال الله -جلَّ ثناؤه-: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ [القيامة: 17]. مجازُه: تأليف بعضه إلى بعض، ثم قال: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾[القيامة: 18]. مجازُه: فإذا ألقينا منه شيئًا فضممناه إليك فخُذ به واعمَل به وضمه إليك، وقال عمرو بن كلثوم في هذا المعنى:
ذراعي حرة أدماء بكر ** هجان اللون لم تقرأ جنينا
أي لم تضمَّ في رحمها ولدًا قط... وفي آية أخرى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾[النحل: 98]، مجازُه: إذا تلوتَ بعضه في إثر بعض، حتى يجتمع وينضم بعضه إلى بعض، ومعناه يصير إلى معنى التأليف والجمع»[19]. ثم يأتي على معنى الفرقان ومجاز السورة فالآية[20]. مما يتصل بمعارف عامّة في القرآن، ثم يصرّح بالدافع الذي جعله يؤلِّف كتابه فيبيّن أنه لم يضعه للعرب الفصحاء وإنما لعامة الناس -بما فيهم الأعاجم- الذين شعر أبو عبيدة بحاجتهم إلى فهم القرآن وإدراك معانيه، والإلمام بأساليبه الجارية على خصائص الكلام العربي؛ من زيادة وإضمار وحذف واختصار وتقديم وتأخير، وما جاءت مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناه مخاطبة الشاهد، وما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم تُركت وحُوّلت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب، قال: «فلم يحتج السَّلَف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن، فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه وعمّا فيه مما في كلام العرب مثلُه من الوجوه والتلخيص...»[21]، ثم يَضْرِب أمثلة مختلفة من القرآن على أنواع المجاز التي ذكرنا[22]، ثم يشرع بتفسير آيات من كلّ سورة بحسَب ورودها في القرآن حتى يأتي على جميع السور[23].
ولعلّ هذا ما حَدَا أحدَ الباحثين على أن يَعُدّ أبا عبيدة في كتابه المجاز نحويًّا رائدًا تجاوَز وقوف النّحاة على حركات الإعراب وانشغالهم بها زمنًا طويلًا ليتناول بحسّه طُرُقَ التعبير، ويكشف من سرّ العربية ونَظْم تأليفها ما يتجاوز آخر الكلمة وحكم إعرابه. بَيْد أنه لم يُكْثِر ما أكثر سيبويه وجماعته، ولم يتعمّق ما تعمّقوا، ولا أحاط إحاطتهم. ولكنه دلّ على سبيل تبصرة انصرف الناس عنها غافلين[24].
3. وأمّا الأمر الثالث الذي يلفتنا إليه جواب أبي عبيدة فهو أنه يردُّ المثالَ القرآني الذي سُئل عنه إلى طريقة العرب التي نزل القرآن عليها، فيجعل من ذلك منهجًا له في الكتاب، ودليل ذلك أنه يقول: «نزل القرآن بلسان عربي مبين، فمَن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن ﴿طه﴾ بالنبطية فقد أكبر، وإن لم يعلم ما هو، فهو افتتاح كلام وهو اسم للسورة وشعار لها. وقد يوافق اللفظُ اللفظَ ويقاربه ومعناهما واحد وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها؛ فمن ذلك الإستبرق بالعربية، وهو الغليظ من الديباج، والفِرِند، وهو بالفارسية إستبره، وكَوز وهو بالعربية جوز، وأشباه هذا كثير»[25].
وفي ذلك طرف من القضية اللغوية المهمّة التي أثارها القرآن على أقلام علماء العربية الذين انقسموا في ألفاظه بين فريقٍ رافضٍ لفكرة وجود أية ألفاظ غير عربية في القرآن معتمدًا على تفسيرٍ لظاهر الآيات التي تعرضت للّسان الذي جاء به التنزيل، من مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فصلت: 44][26]. وفريقٍ آخر رأى أنّ العرب خالطوا سائر الألسنة فعلقت من لغاتهم ألفاظ غيّرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح، وعلى هذا الحدّ نزل بها القرآن[27]. وبين الرأيين رأيٌ ثالث اتخذ منحى توفيقيًّا فقال بوجود كلمات يسيرة غير عربية دون أنْ تُخْرِج القرآن عن عربيته[28].
وعلى هذا يكون أبو عبيدة من أصحاب الرأي الأول، وعليه بنى منهجه في الكتاب كلّه، بمعنى أنه يحاول شرح لفظ أو تركيب، ثم يستشهد على صحته بآية أو حديث في المعنى نفسه أو كلام العرب الفصيح؛ كالخُطَب والأمثال والأقوال المأثورة، وفي أغلب الأحيان بأبيات من الشِّعر القديم وخاصّة الرّجز منها، ويحرص دائمًا على أن يؤكّد صلة أسلوب القرآن بأساليب العرب، فيذكر في ختام كلامه أنّ «العرب تفعل هذا».
وبعدُ، فـ(مجاز القرآن) كتاب تمتزج فيه اللغة والبلاغة والنحو، وكذلك كان الأمر في تراثنا القديم، حيث كانت الدراسة البلاغية متداخلة مع الدراسة اللغوية في كتب النحاة الأوائل أمثال سيبويه حتى عدّه بعضُ الباحثين واضع علمي المعاني والبيان[29]. ورأى أنّ أبا عبيدة في كتابه (مجاز القرآن) لم يفعل أكثر من أنه سلك مسلك سابقِيه من اللغويين مِن ربط النحو بالأساليب والتراكيب، على عكس ما فعل المتأخِّرون حيث قصروه على أنه علم يعرف به أحوال أواخر الكَلِم إعرابًا وبناء[30]. وقد بينَّا ذلك حين تحدثنا عن المقصود بكلمة (مجاز).
على أنّ ذلك لا يمنع أن نرى في أبي عبيدة -نظريًّا- رجلَ لغةٍ أولًا، وبلاغةٍ ثانيًا، ونحوٍ ثالثًا. كفنّان يلمُّ بألوان الفنّ، ولكنه يبرع في رسم الوجوه وكشف ملامحها بأفضل من محاولته مع المناظر الطبيعية، ويتقن رسم الطبيعة بما لا يتوافر له مع اللوحات التجريدية.
أولًا: أبو عبيدة اللغوي:
لا يخفى على كلّ ذي نظر متأمِّل في كتاب (المجاز) أنّ صاحبَه لغويّ في المقام الأول، عليم بلغات العرب وغريبها، يوجّه اهتمامه الأول عند التفسير إلى شرح ما يراه يستحقّ الشرح من مفردات القرآن، مستعينًا ببعض الآيات المماثلة أو فصيح الكلام، من غير أن يغفل الاستشهاد بالشِّعْر القديم، وخاصّة الرجز الممتلئ بأوابد اللغة وشواردها[31]. وقد يحدّد نوع الكلمة ووزنها[32]، وكثيرًا ما يبدو ذا حسّ لغوي مرهف، ومثال ذلك إدراكه فَرْقَ المعنى بين كسر العين وفتحها في كلمة (عوج) في الآية: ﴿تَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ [آل عمران: 99]؛ إِذْ يقول: مكسورة الأول؛ لأنه في الدِّين، وكذلك في الكلام والعمل، فإذا كان في شيء قائم نحو الحائط والجذع، فهو عَوج مفتوح الأول[33]، ويستطرد في شرح مفردة لا علاقة لها بالآية، كأنْ يشرح اسم صاحب الشاهد الشِّعري[34]، أو مفردة من الشاهد[35]، أو من كلامه، ويأتي لها بالشاهد مما يدلّ على تبحره باللغة، فمن ذلك مثلًا شرحه الآية: ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: 30]، قتلهم الله، وقلّما يوجد فاعل إلا أن يكون العمل من اثنين، وقد جاء هذا ونظيره ونِظْره: عافاك الله، والمعنى: أعفاك الله، وهو من الله وحده، والنِّظْر والنَّظِير سواء مثل نِدّ ونَدِيد، قال:
ألَا هَل أتَى نِظْرِي مُلَيْكَة أنّني»[36].
وقد أشاد الطبري بهذا التفسير[37]، كما أقرّ في مواضع كثيرة من تفسيره ببصر أبي عبيدة بكلام العرب ونقل عنه[38]، وبعد ذلك يحقّ له أن يسنّ القواعد اللغوية[39]، وأن يكون له تفرّده فيخالف غيره من العلماء في بعض أمور اللّغة كالفرّاء والكسائي[40]. ويكون له مذهب في التفسير[41].
وربما مَرّ بتعليل حركة كلمة، فقال: «زعم النحويون»[42]، وكأنه يقرّ أنه لغويّ أولًا؛ واهتمامه بالنحو محدود لأنه يذكر رأيهم فلا يعلّق عليه. ومما يؤكّد ما نذهب إليه قول صاحب اللسان: «وقال الأزهري: أبو عبيدة صاحب بالغريب وأيام العرب، وهو بليد النظر في باب النحو ومقاييسه»[43].
ثانيًا: أبو عبيدة البلاغي:
لقد سبق وعرفنا أنّ تأليف كتاب المجاز كان بسبب مسألة بلاغية في القرآن، تتعلّق بالتشبيه ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾[الصافات: 65]، فلا غرابة أن نجد أنّ أبا عبيدة يهتم بإيضاح المسائل البيانية الموجودة في القرآن، ويجد لها ما يماثلها في كلام العرب وأساليبهم في التعبير، وقد صارتْ هذه المسائل فيما بعد مسائل في البيان العربي[44]، حتى وصل الأمر بالأستاذ إبراهيم مصطفى إلى أن وجده أسبق من الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت: 471هـ) في وضع أُسس علم المعاني الذي فصَله النحاة فيما بعد عن معاني النحو فأزهقوا روح الفكرة[45]، كما عدّه آخَر أوّل مَن كتب في علم البيان[46].
ولا بدّ من التدليل على هذا الكلام فنحدد ما جاء في الكتاب من أمور بلاغية؛ لأنّ كلّ كلام يفتقر إلى الدليل القاطع يبقى في حيز الافتراض، فإليك البيان:
أ. المجاز العقلي؛ حيث قال في قوله تعالى: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾[يونس: 67]، «له مجازان؛ أحدهما: إنّ العرب وضعوا أشياء من كلامهم في موضع الفاعل، والمعنى أنه مفعول؛ لأنه ظرف يفعل فيه غيره، لأنه لا يبصر ولكنه يبصر فيه الذي ينظر، وفي القرآن: ﴿فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾[الحاقة: 21]. وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها، قال جرير:
لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ** ونمت وما ليل المطي بنائم
والليل لا يَنام وإنما يُنام فيه، وقال رؤبة:
(فنام ليلي وتجلّى همّي)»[47].
ب. الكناية والتشبيه المصرّح بهما من غير تفصيل؛ في مثل قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾[البقرة: 223][48]، كناية وتشبيه، قال: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223]. وفي بعض الأماكن يريد الكناية من غير أن يصرح باسمها[49]. أمّا مجاز التمثيل فيعني عنده التشبيه أو تشبيه التمثيل، كما في تفسير قوله تعالى: ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾[التوبة: 109][50].
ج. الاستعارة: وإليها يشير إشارة تفهم من خلالها[51]، وقد يخلط بينها وبين التشبيه[52].
د. الالتفات: تنبّه أبو عبيدة إلى هذا الأسلوب، وإن لم يسمعه، كأن يقول: «ومن مجاز ما جاءت به مخاطبة الشاهد، ثم تركت، وحوّلت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب، قول الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾[يونس: 22] أي: بكم»[53].
هـ. الحذف والاختصار عند أمن اللبس للإيجاز. والإيجاز صفة محمودة من صفات الكلام عند العرب، والقرآن خير ممثل لهذه الصفة في أسلوبه، وقد أشار أبو عبيدة إلى كثير من مواضع الحذف في آياته، فلنسمعه يقول في هذه الآية: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾[آل عمران: 106]، العرب تختصر لعِلْم المخاطب بما أُريدَ به، فكأنّه خرج مخرج قولك: فأمّا الذين كفروا فيقول لهم: أكفرتم، فحذف واختصر الكلام، وقال الأسدي:
كذبتم وبيت الله لا تنكحونها ** بني شاب قرناها تصر وتحلب
أراد: بني التي شاب قرناها، وقال النابغة الذبياني:
كأنك من جمال بني أقيش ** يقعقع خلف رجليه بشنِّ
(بني أقيش): حيّ من الجنّ، أراد: كأنك جمل يقعقع خلف رجليه بشن، فألقى الجمل، ففهم عنه ما أراد[54].
و. الإطناب: مثلما أحبّ العرب الإيجاز، فحذفوا عند أمن اللّبس، لم يستنكروا الإطناب حين تدعو الحاجة إليه، كتوكيد بعض الكلام. وقد أشار أبو عبيدة إلى مكان الإطناب من غير تسمية، فقال: «ومن مجاز المكرّر للتوكيد، قوله تعالى: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: 4]، أعاد الرؤية. وقال: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾[القيامة: 34]، أعاد اللفظ»[55].
ز. إدراك الفارق بين الخبر والإنشاء، قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233]. يقول: «رفعٌ؛ خبر. ومن قال: ﴿لَا تُضَارَّ﴾ بالنصب، فإنما أراد (لَا تُضَارِرْ)، نَهْيٌ»[56]، ومعلوم أنّ النهي غرض من أغراض الإنشاء.
ح. خروج الإنشاء عن حقيقة معناه ليعبر عن معنى آخر يفهم من السياق؛ كخروج الاستفهام إلى تقرير أمرٍ ما، وهو ما يسمى بالاستفهام التقريري[57]، أو خروجه إلى معنى التحذير[58]، أو الإنكار[59]. وكذا الحال في الأمر الذي يخرج معناه إلى الوعيد[60].
ط. التقديم والتأخير: يحدث في الجملة أن تتقدّم كلمة على أخرى لغرض بلاغي، مما يكسب الكلام جمالًا وتأثيرًا، ويجعل للتقديم والتأخير مكانة سامية في علم المعاني، وقد أشار أبو عبيدة إلى أماكنه في القرآن وتنبّه إليها، ولكنه لم يكن يذكر السبب البلاغي الذي حصل من أجله التقديم والتأخير[61].
ي. الكلام بالواحد على لفظ الجمع بغرض التفخيم: وكثيرًا ما ردّد أبو عبيدة أنّ العرب تتكلّم بهذا أو تفعله[62].
ولكن يجدر بنا بعد هذا البيان أن نُشير إلى أنّ فهم أبي عبيدة للصورة البيانية بوجه عام لا يتعدى الفهم اللغوي، فهو يتعرّض لكلّ الفنون البيانية المتعلّقة بالأسلوب، ويعدّها من المجاز اللغوي، وكثيرٌ من الاستعارات والتشبيهات في القرآن تدخل نطاق الحرج؛ لأنها تتعلق بالذات أو بالعقيدة، أو بصورة البعث، وموقف أبي عبيدة من هذه جميعًا موقف اللغويين، يأخذ بظاهر القول إلى أمدٍ محدود، غايته المعنى المجازي القريب، وهو المذهب الذي عُرفوا به[63]، ولكن استعماله للكناية في الدلالة على فنّ من فنون الأسلوب قريب من استعمال البلاغيين للدلالة على الاصطلاح البلاغي المعروف، (الكناية)[64].
ثالثًا: أبو عبيدة النحوي:
بانَ لنا أنّ أبا عبيدة يوجّه جُلّ اهتمامه إلى اللّغة ثم البلاغة ليكون الجانب النحوي عنده أضعفَ الجوانب، واحتفاؤه به قليلًا. ولا بأس علينا أن نتلمّس شخصيته النحوية من خلال هذا القليل فنجده:
أ. لا يحتفي بإيراد وجوه القراءات احتفاءَ غيره بها، وإن أورد منها شيئًا فأحيانًا يكتفي بوجه واحد[65]، وحينًا بوجهين[66]، ونادرًا بثلاثة أوجه[67].
ب. إذا مَرّ ببعض وجوه الإعراب مسَّهَا مسًّا خفيفًا من غير أن يقف عليها أو يتأمّلها بعمقِ نَظَرِ النُّحاة[68]، ويكاد النّصب على المصدرية يشكّل قاعدة لديه؛ فكثيرًا ما ذكر المصدر سببًا للنّصْب[69].
ج. يقول بالإعمال[70]، ويذكر العامل المحذوف أحيانًا ليعلّل حركة كلمة[71]، ولكن دون أن يبالغَ في ذلك أو يتزيدَ أو يتمحلَ فِعلَ متأخِّري النحاة.
د. له شخصية مستقلّة ورأي حُرّ، فلا يتقيّد -وهو البصري- بمذهب أهل البصرة، فيستعمل أحيانًا مصطلحًا كوفيًّا كالكناية التي يعبر بها الكوفيون عن الضمير[72]، وقد يعمّم عليه قاعدة نحوية[73].
لماذا تألّب على أبي عبيدة مُعَاصِروه؟
ما إنْ ألّفَ أبو عبيدة كتاب (المجاز)، وذاع أمرُه حتى أحدث ضجّة كبيرة في البيئات العلمية في البصرة والكوفة على السواء.
في البصرة كان الأصمعي يحمل لواء الحملة ويتهّمه بأنه فَسّر القرآن برأيه، فلما بلغ ذلك أبا عبيدة سأل عن مجلس الأصمعي في أيّ يوم هو؟ فذهب إليه وسأله: أبا سعيد، ما تقول في الخبز؟ قال: هو الذي تخبزه وتأكله، فقال له أبو عبيدة: فسّرت كتاب الله برأيك؟! قال: قال تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا﴾[يوسف: 36]. قال: الأصمعي: هذا شيء بانَ لي فقُلْتُه ولم أفسّره برأيي، فقال له أبو عبيدة: وهذا الذي تعيبه علينا كلّه شيء بانَ لنا فقلناه ولم نفسّره برأينا[74].
وانتقل هذا الحرج إلى أبي حاتم السجستاني الذي قال -وقد سُئل عن كتاب المجاز-: «إنه لكتابٌ ما يحلّ لأحد أن يكتبه، وما كان شيء أشدّ عليّ من أن أقرأه قبل اليوم، ولقد كان أنْ أُضْرَب بالسياط أهونَ عليّ من أن أقرأه»، ثم نازعَتْه إليه نفسُه فقرأه، والتقى بحمد بن المعذل فصار كلّ منهما يقول للآخر: «وَقِّفْنِي على خطأ أبي عبيدة في القرآن»[75].
وكذلك ذهب أبو عمرو الجرمي بشيء منه إلى أبي عبيدة، وكأنه ينكره، وقال له: عمّن أخذتَ هذا يا أبا عبيدة فإن هذا تفسيرٌ خلاف تفسير الفقهاء؟ فقال له، وقد ضاق به: «هذا تفسير الأعراب البوّالين على أعقابهم، فإن شئتَ فخذه وإن شئت فدعه»[76].
أمّا في الكوفة فقد كان موقف علمائها أشدَّ حِدّة مما ذكرنا، فهم أنكروا عليه ما ورد في تفسيره، وشنّعوا عليه حتى قال الفرّاء: «لو حُمِلَ إليَّ أبو عبيدة لضربته عشرين في كتابه المجاز»[77]، وكثيرًا ما قال في كتابه (معاني القرآن): «وقد قال بعضُ مَن لا يُعرف العربية»[78]، قاصدًا أبا عبيدة.
وهنا يحق لنا أن نتساءل:
ما الأسباب التي جعلتْ علماء البصرة والكوفة يقفون من تفسير أبي عبيدة موقف المنكِر المستهجِن؟
لقد عزا بعضُ الباحثين الاختلاف حول كتاب المجاز في البصرة إلى الخصومة بين النزعة العقلية والنزعة النقلية[79]؛ إِذْ كان مسلكُ أبي عبيدة في عدم التزامه بآثار السَّلَف في التفسير، واعتمادُه على النزعة العقلية والتفكير الحرّ والنظر الدقيق المستقلّ =خروجًا على ما كان عليه علماء اللغة والتفسير الذين كانوا يتحرّجون أشد الحرج ويلتزمون بآثار السَّلَف[80]، على حين كان موقف علماء الكوفة من كتاب المجاز من أوّل الدلائل على العصبية القائمة بين البلدين[81].
بيدَ أنني، وإن كنتُ لا أنفي أن تكون الأسباب المذكورة وراء الحملة التي شُنّت على أبي عبيدة، إلا أنّني أرى لهذه الخصومة سببًا أهم من كلّ ذلك، ولا أقدّم عليه سواه، وهو سبب شخصي يتعلّق بأصل أبي عبيدة وموقفه وأخلاقه، ذلك أنه ينحدر من أصل يهودي، وقد عُرِفَ بشُعوبيته وطعنه على العرب، كما اتُّهم في أخلاقه، ومن ذلك قول بروكلمان: «وُلِدَ أبو عبيدة لأبوين رقيقين من يهود فارس من باجروان، وكان مولى لتيم قريش، وأخذ في شبيبته عن أبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب، ولا عيب عليه نسبه من العجم. لحقَ بفرقة الصفرية من الخوارج، وحاول أن ينتقم لنفسه بتصنيف كتبٍ في مثالب العرب على مذهب الشُّعوبية، وهجاه أبو نواس بتهمة اللّواط، ولما كتب كتاب المثالب -الذي نقل عنه ياقوت- كَرِهَهُ الناسُ فلم يحضر جنازته أحد من البصريين»[82].
ولعلّ هذا دليل على ما كان في شخصية أبي عبيدة من أسبابٍ جعلتْ حتى جماعته البصريين يقفون منه هذا الموقف وينفرون منه ويحجمون عن المشاركة في تشييعه حين انتقل إلى جوار ربه.
ولو كان الخلاف المعروف بين البصرة والكوفة السبب الأول والوحيد في موقف بعض علماء الكوفة من أبي عبيدة لوجب أن نجد لهذه الخصومة نظائر مع علماءَ بصريين آخرين كتبوا في تفسير القرآن على هذا المنحى، كالأخفش الأوسط أبي الحسن سعيد بن مسعدة المتوفى سنة 215هـ، الذي كتب كتاب (معاني القرآن)[83] في الفترة نفسها، والذي يُعَدّ من كبار علماءِ البصرة؛ إِذْ أخذ النحو واللغة عن سيبويه[84]، غير أنّنا نرى أبا زكريا الفرّاء إمامَ مدرسة الكوفة بعد الكسائي يُجِلّه ويعترف بسموّ مكانته العلمية في أمور اللغة بين علماءِ عصره، فقد روى ياقوت على لسان ثعلب: «أنّ الفرّاء دخل على سعيد بن سالم، فقال: قد جاءكم سيد أهل اللغة وسيد أهل العربية، فقال الفرّاء: أمّا ما دام الأخفش يعيش، فَلا»[85].
على أنّ ما ذكرناه في شخصية أبي عبيدة لا يَغُضّ من مكانته العلمية ومنزلته الثقافية بحال من الأحوال، فقد قال فيه الجاحظ: «لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة»[86]. وفي عهده وُضعت أُسس العلوم الإسلامية على ما اختلفت نواحيها من تفسير وفقه وأخبار، وكان أبو عبيدة يشارك في أنواع هذه الثقافة مشاركة جيدة. ونستطيع أن نتبيّن في كتبه جوانب من هذه الثقافة، فهي لغوية بما فيها من تفسير وحديث وغريب، وهي تاريخية تتناول مواضيع في تاريخ العرب وعاداتهم في جاهليتهم أحيانًا وفي إسلامهم أحيانًا أخرى، وقد تتجاوز ثقافته هذه الأمة العربية إلى عادات وأخبار لغير العرب[87].
ولعلّ فيما روي من اعتراف أبي الحسن الأخفش الأوسط برفعة مكانة أبي عبيدة في العلم بغريب اللغة حتى قدّمَه على نفسه معلنًا تأثُّرَه بكتاب المجاز وإفادته منه في كتابه (معاني القرآن) =دليلًا آخر يضاف في هذا المجال، فقد «قال أبو حاتم: كان الأخفش قد أخذ كتاب أبي عبيدة في القرآن فأسقط منه شيئًا وزاد شيئًا، وأبدل منه شيئًا، قال أبو حاتم: فقلت له: أي شيء هذا الذي تصنع؟ مَن أعرفُ بالغريب؛ أنت أو أبو عبيدة؟ فقال: أبو عبيدة، فقلت: هذا الذي تصنع له ليس بشيء، فقال: الكتاب لمن أصلحه، وليس لمن أفسده»[88].
كما أن فيما ورد في صلب الدراسة دلائل أُخر تثبت شأن أبي عبيدة وعلوّ قدره العلمي، ولا مندوحة لنا من الإقرار بأنه من العسف أن نغضَّ من المكانة العلمية لإنسانٍ ما، فنغمطه حقّه لأنه لا يوافقنا في أخلاقه ومعتقداته ومواقفه؛ فهذه الأمور شيء والعلم والحقيقة شيء آخر.
[1] نُشرت هذه المقالة في مجلة (التراث العربي)، العدد 18، 1 يناير 1985م. (موقع تفسير).
[2] مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح، ط6، 1969م، دار العلم للملايين- بيروت، ص294.
[3] مباحث في علوم القرآن، ص295.
[4] مباحث في علوم القرآن، ص296.
[5] معاني القرآن للأخفش الأوسط، مطبوع في الكويت في جزأين، عام 1979، بتحقيق: د. فائز فارس.
[6] معاني القرآن للفراء، مطبوع في ثلاثة أجزاء، بتحقيق: محمد علي النجار، وأحمد يوسف نجاتي.
[7] معاني القرآن للزجّاج، مخطوط، دار الكتب المصرية، رقم (111)، م. تفسير.
[8] معاني القرآن للنحاس، مخطوط، دار الكتب المصرية، رقم (385)، تفسير. وفي دار الكتب الظاهرية مخطوط «معاني القرآن»، رقم (181)، للزجاج والنحاس، في أوله خمس ورقات ربما كانت للنحاس من أصل (246) ورقة. (فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية قسم علوم القرآن، د. عزة حسن).
[9] أثر القراءات القرآنية في تطوّر الدرس النحوي، د. عفيف دمشقية، معهد الإنماء العربي 1978، ص45.
[10] أثر القرآن في تطور النقد العربي، د. محمد زغلول سلام، الطبعة الثالثة 1952، دار المعارف، ص36.
[11] مقدمة المجاز، للدكتور/ محمد فؤاد سزكين، ط2، مؤسسة الرسالة 1981، ص19.
[12] أثر القرآن في تطور النقد العربي، ص48.
[13] معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ط. دار المأمون، 1355هـ= 1936م، (7/ 166). وانظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، الطبعة الأولى 1931، (13/ 254). وطبقات النحويين واللغويين، للزبيدي، الطبعة الأولى 1954، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة الخانجي، ص97. والبغية، ص395، وبروكلمان (2/ 143)، وضحى الإسلام، أحمد أمين، ط10، دار الكتاب العربي- بيروت، (2/ 304- 305). وانظر في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن داود الكاتب: إنباه الرواة، عليّ بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار الكتب 1973، (3/ 278).
[14] انظر: الاتجاه العقلي في التفسير، د. نصر حامد أبو زيد، الطبعة الأولى 1982، دار التنوير للطباعة والنشر- بيروت، ص100- 101.
[15] الاتجاه العقلي في التفسير، ص101.
[16] أثر القرآن في تطور النقد العربي، ص43- 44. وانظر: دائرة المعارف الإسلامية. مادة: تفسير.
[17] القاموس المحيط: جاز.
[18] أثر القرآن في تطور النقد العربي، ص43.
[19] المجاز، (1/ 1- 2- 3).
[20] المجاز، (1/ 3- 4- 5).
[21] المجاز، (1/ 8).
[22] المجاز، (1/ 8- 16).
[23] كلام الأستاذ المرحوم إبراهيم مصطفى، غير دقيق، حيث ذكر أنّ أبا عبيدة، «أخذ في تفسير القرآن الكريم كلّه»؛ لأنه أغفل كثيرًا من الآيات. (انظر: إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، القاهرة 1959، ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر، ص12).
[24] إحياء النحو، ص11- 16.
[25] المجاز، (1/ 17- 18).
[26] انظر: الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، الطبعة الثانية، 1925م، المطبعة الأزهرية بمصر، (1/ 135). والمزهر، جلال الدين السيوطي، المطبعة الأميرية، 1282هـ، (1/ 129- 130).
[27] الإتقان في علوم القرآن، (1/ 136).
[28] الإتقان في علوم القرآن، (1/ 136).
[29] تاريخ علوم البلاغة العربية، أحمد مصطفى المراغي، الطبعة الأولى، 1950، مصطفى البابي الحلبي، ص43. وانظر: البلاغة العربية تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، الطبعة الثانية، 1965، دار المعارف، ص29، والاتجاه العقلي في التفسير، ص100.
[30] تاريخ علوم البلاغة العربية، ص49، والاتجاه العقلي في التفسير، ص100.
[31] انظر مثلًا: المجاز، (1/ 43، 44، 68، 82، 83، 105، 164، 165، 234).
[32] انظر مثلًا: المجاز، (1/ 88، 93، 117، 140).
[33] المجاز (1/ 98).
[34] انظر مثلًا: المجاز، (1/ 149).
[35] المجاز (2/ 56، 72، 263).
[36] المجاز (1/ 256- 257). وانظره، (1/ 301). لقد أصاب الاستطراد منهج أبي عبيدة بالقصور، وكذا التكرار في الشرح. انظر: المجاز، (1/ 149، 154، 155، 157).
[37] تفسير الطبري (جامع البيان)، الطبعة الثانية، 1954، مصطفى البابي الحلبي، (10/ 110).
[38] تفسير الطبري، (12/ 54).
جدير بالنظر أنّ الطبري ينقل عن أبي عبيدة، ولكنه كذلك ينتقد أقواله أحيانًا ويردّ عليها بعنف. ويراجَع للمزيد في ذلك الدراسات التي عُقدت حول موقف الطبري من أبي عبيدة ومن بعض اللغويين ممن كتبوا في معاني القرآن. (موقع تفسير).
[39] المجاز (1/ 351).
[40] المجاز، (2/ 99).
[41] المجاز (2/ 188).
[42] المجاز (2/ 150، 152، 155).
[43] اللسان: عشا.
[44] انظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن، د. عبد الفتاح لاشين، ط1، 1976، دار المعارف، ص14.
[45] إحياء النحو، ص16 وما بعدها.
[46] علوم البلاغة العربية، أحمد مصطفى المراغي، الطبعة الثالثة، المطبعة العربية، ص7، 215.
[47] المجاز (1/ 279)، (2/ 96).
[48] المجاز (1/ 73). وانظره، (1/ 155)، (2/ 127).
[49] المجاز (1/ 75، 170، 171، 263، 290).
[50] المجاز، (1/ 269). وأثر القرآن في تطور النقد العربي، ص46- 47.
[51] المجاز، (1/ 410)، (2/ 82، 196).
[52] المجاز، (2/ 68).
[53] المجاز، (1/ 11). وانظره، (1/ 23، 253).
[54] المجاز، (1/ 100- 101). وانظره، (1/ 126، 257، 297، 342).
[55] المجاز، (1/ 12).
[56] المجاز، (1/ 75).
[57] المجاز (1/ 35، 287)، (2/ 118، 133).
[58] المجاز (1/ 288).
[59] المجاز (1/ 130).
[60] المجاز (2/ 197، 270).
[61] المجاز (1/ 173، 185، 364).
[62] المجاز (1/ 38، 108، 131).
[63] أثر القرآن في تطور النقد العربي، ص47.
[64] أثر القرآن في تطور النقد العربي، ص47- 48.
[65] المجاز (1/ 91).
[66] المجاز، (1/ 355).
[67] المجاز (1/ 303).
[68] المجاز (1/ 211).
[69] انظر مثلًا: المجاز، (2/ 214، 223).
[70] انظر: (1/ 35، 107)، (2/ 160).
[71] المجاز (1/ 57)، (2/ 143).
[72] المجاز (1/ 174). وانظر: (2/ 109).
[73] المجاز (1/ 24).
[74] معجم الأدباء (19/ 159). رواية اللغة، د. عبد الحميد الشلقاني، ط 1971، دار المعارف، ص141.
[75] طبقات النحويين واللغويين. رواية اللغة، ص141.
[76] طبقات النحويين واللغويين. تاريخ بغداد، (13/ 255).
[77] معجم الأدباء (19/ 159).
[78] انظر مثلًا: معاني القرآن للفرّاء، ط2، 1980، عالم الكتب- بيروت، (1/ 8)، ومجاز القرآن، (1/ 25).
[79] رواية اللغة، ص142.
[80] انظر: رواية اللغة، ص141.
[81] رواية اللغة، ص142.
[82] تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، ترجمة: د. عبد الحليم نجار، الطبعة الثانية، 1959، دار المعارف، (2/ 143). وانظر مقدمة مجاز القرآن لمحققه الدكتور: محمد فؤاد سزكين، ص14- 15.
[83] انظر في سبب تأليفه وزمنه: بغية الوعاة، جلال الدين السيوطي، الطبعة الأولى، 1326هـ، دار السعادة، ص258.
[84] البلغة في تاريخ أئمة اللغة، الفيروزآبادي، تحقيق: محمد المصري، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ص87.
[85] معجم الأدباء (11/ 227).
[86] البيان والتبيين (1/ 331)، نقلًا عن مقدمة المجاز (1/ 12).
[87] مقدمة المجاز (1/ 13- 14).
[88] طبقات النحويين واللغويين، ص74- 75.


