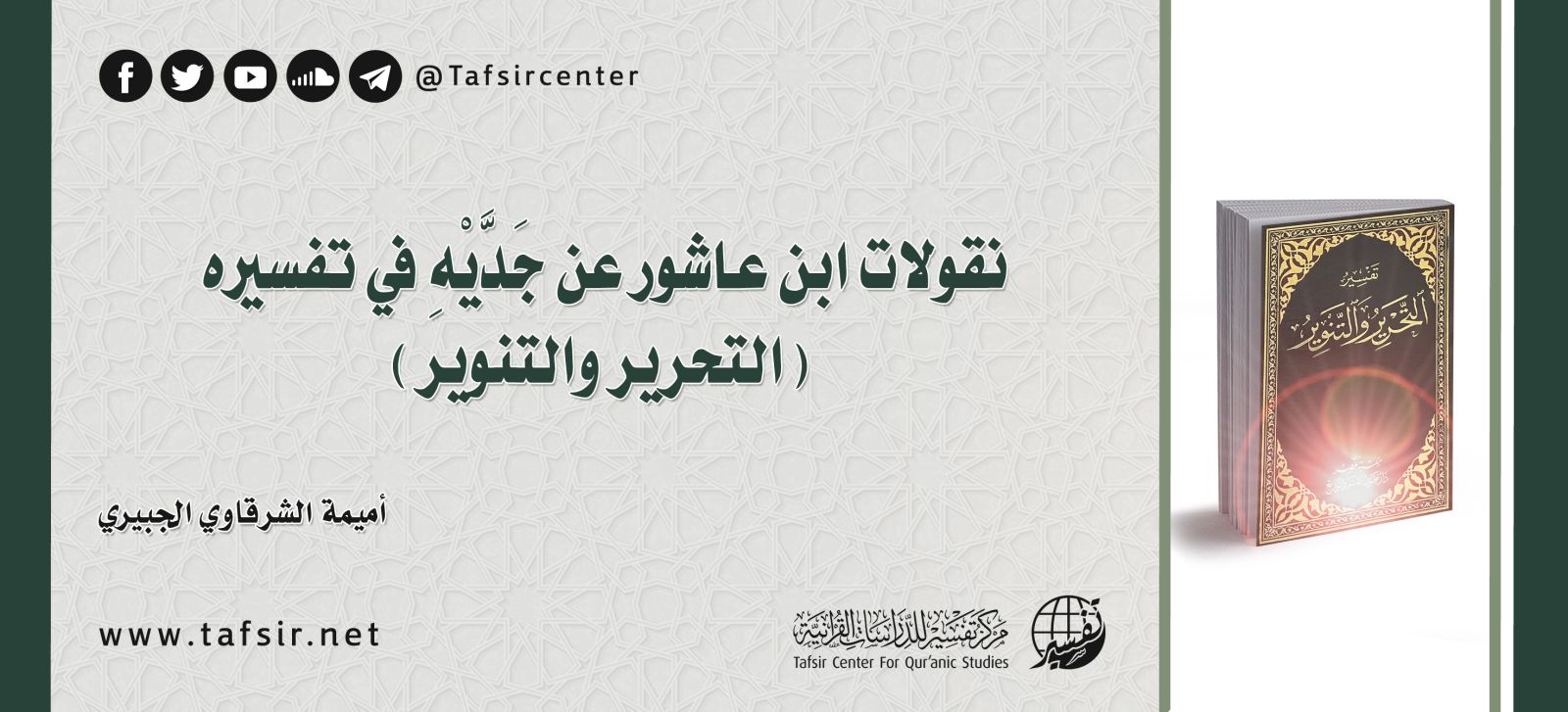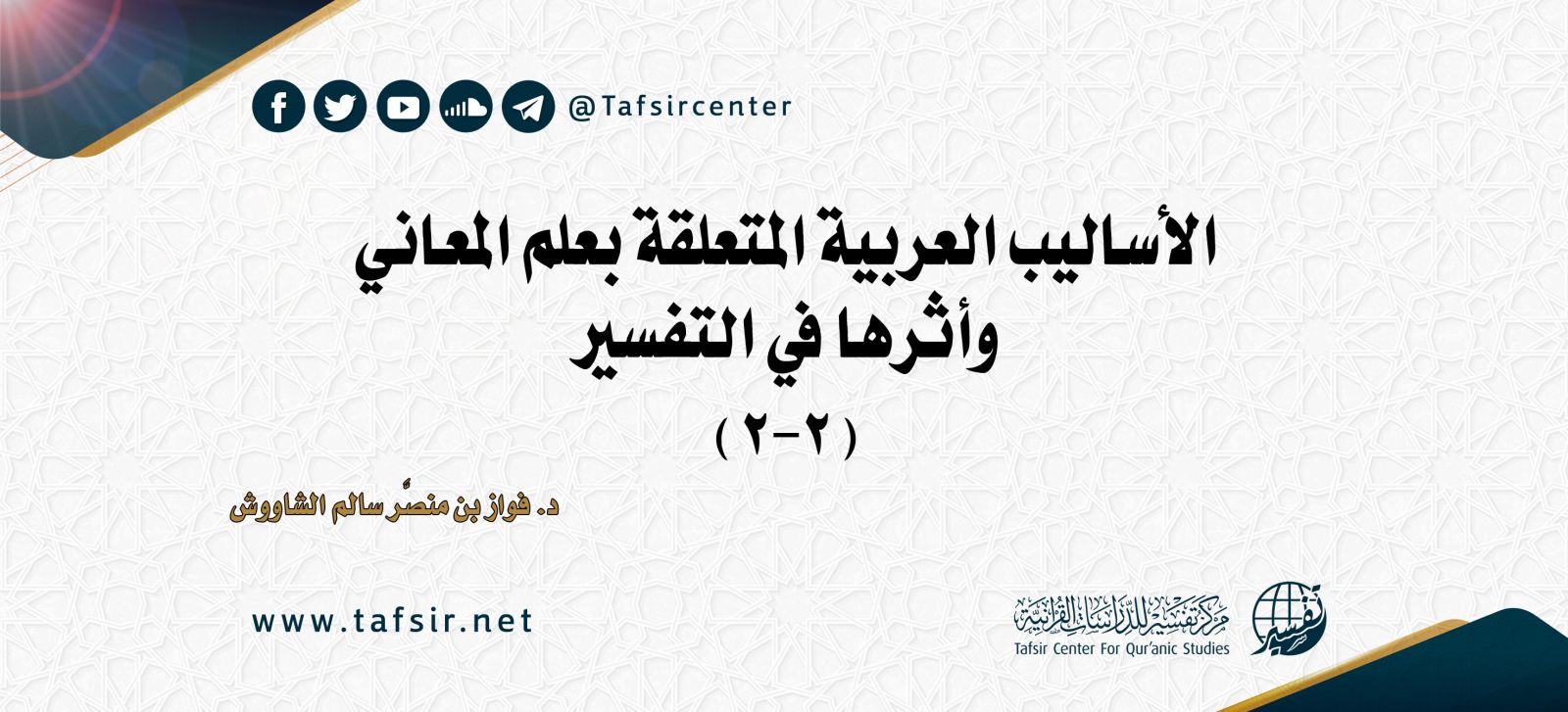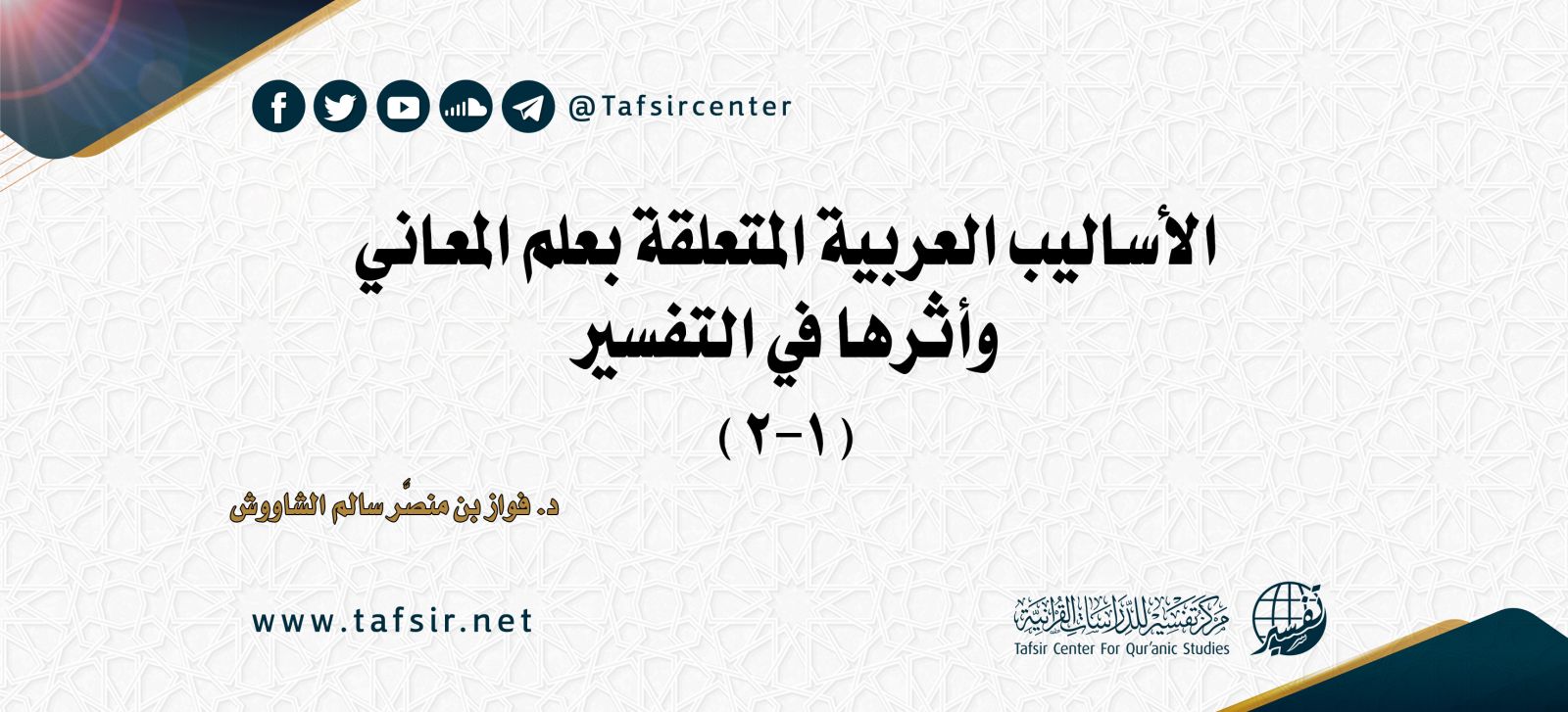ملامح التفسير اللغوي عند ابن جُزَيّ الكلبي
ملامح التفسير اللغوي عند ابن جُزَيّ الكلبي
الكاتب: رمضان فوزي بديني

ملامح التفسير اللغوي عند ابن جُزَيّ الكلبي[1]
عاشت الحضارة الإسلامية فترةً ذهبيةً من تاريخها في بلاد الأندلس؛ حيث روعة الموقع الجغرافي، وسِحر الطبيعة الخلّابة، وجمال القصور الشاهقة؛ فتفاعل كلُّ هذا مع عقول منفتحة على كلّ العلوم ونفوس متشبّعة بحقائق دينها وقيم إسلامها، فأنتجتْ لنا تراثًا علميًّا وحضارة بلغتْ من التقدّم شأوًا قلَّ نظيره في زمانه، حتى أضحتْ قِبْلَة للعلماء والأدباء والمفكِّرين والفلاسفة، وأصبحتْ مقصدًا لبعض أبناء أوروبا المسيحية لينهلوا من علومها ثم يعودوا لبلادهم لنقل قَبَس من هذه الحضارة المضيئة لعلهم يمحون به بعض الظلام الذي خيّم عليهم.
يقول الدكتور عبد الرحمن الحجي -رحمه الله تعالى-: «إنّ مثل هذا الجوّ العلمي الذي عاشه بلد الأندلس متمتعًا بالخير والمعرفة الحقّة يُنتج شمولًا في طلب العلم وكثرةً من العلماء ووفرةً من المكتبات واهتمامًا باقتناء الكتب وشغفًا للاعتناء بالعلم وسعيًا في طلبه».
ثم ذكر -رحمه الله- ثلاث ظواهر للحضارة العلمية في الأندلس، وهي:
- كثرة عدد الكتب والمؤلِّفين في كلّ ميدان خلال العصور.
- الإكثار من الإنتاج لكلّ مؤلِّف وفي عدّة ميادين، مع الاحتفاظ بالأصالة والعمق، فهيّأ ثراءً في الإنتاج العلمي المتنوّع الحقول وسيلًا من الكتب متدفقًا.
- كثرة عدد الأجزاء للكتاب الواحد، مع إنتاج الكتب ذوات الأجزاء الكثيرة لمؤلّف واحد[2].
وكان نتاج هذه البيئة الكثير من العلماء الذين ذاع صيتهم على مدى الأزمان والأماكن، ومنهم الإمام ابن جزي الكلبي، موضوع حديثنا في هذه الحلقة، الذي جمع بين العلم والجهاد حيث مات شهيدًا قبل الخمسين من عمره. وفي العلم جَمَع بين موضوعات شتى وصنوف متنوّعة، تفاعلتْ كلّها وخرج رحيقها في تفسيره الماتع: (التسهيل لعلوم التنزيل) الذي هو موضوع حديثنا في هذا المقام.
لمحة تعريفية:
هو الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جُزَيّ الكلبي، أبو القاسم.
وُلِدَ في ربيع الثاني عام 693هـ بغرناطة حاضرة الأندلس.
وقد شاء الله تعالى له أن تكون فترته من أزهى عصور مملكة غرناطة؛ إحياءً للجهاد وبعثًا للعلم ورعايةً لأهله، بالإضافة إلى أنّ أباه كان من أهل العلم والفضل، وهو ما كان له تأثيره في تأسيسه خاصّة في حياته الأولى.
نقل ابن حجر أنه «كان على طَريقَة مُثلى من العكوف على العِلْم والاشتغال بِالنّظَرِ وَالتَّقْيِيد، مشاركًا فِي فنون من عَرَبِيَّةٍ وَفِقْهٍ وأصول وأدب وَحَدِيث، تقدَّم خَطِيبًا بِبَلَدِهِ على حَدَاثَة سِنّة فاتفقوا على فَضله.
وَكَانَ قد قَرَأَ على أبي جَعْفَر بن الزبير وَأبي الحسن بن سمعون، وَقَرَأَ على أبي عبد الله بن العِمَاد، ولازَم الحافِظ ابن رشيد، وروى أَيْضًا عَن أبي عبد الله بن أبي عامر بن ربيع وَأبي المجد بن أبي عَليّ بن أبي الأَحْوَص»[3].
أمّا مذهبه الفقهي فكان من أعلام المذهب المالكي، وهو المذهب الذي انتشر في بلاد الأندلس، وله فيه تصانيف مثل كتابه: (القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية). وقد ذكره ابن فرحون ضمن فقهاء المالكية في كتابه: (الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب)، ويقصد به علماء المالكية.
وفاته:
تُوفي -رحمه الله تعالى- شهيدًا، وعمره 48 عامًا، في موقعة طريف[4] 17 جمادى الأولى سنة 741هـ؛ حيث فُقِد وهو يحرّض المؤمنين ويشحذ هِممهم على القتال بعد أن أَبْلَى بلاءً حسنًا[5].
من كتبه:
رغم قِصَر عُمْر ابن جزي، ورغم انشغاله بالجهاد والقتال مع العلم؛ فإنّه ترك تراثًا متنوّعًا في مختلف مجالات العلوم الشرعية؛ فمن مؤلّفاته:
- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية.
- تقريب الوصول إلى علم الأصول.
- الفوائد العامة في لحن العامة.
- التسهيل لعلوم التنزيل.
- الأنوار السنيّة في الألفاظ السنيّة.
- وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم.
- البارع في قراءة نافع.
- فهرست كبير اشتمل على ذِكْر كثيرين من علماء المشرق والمغرب.
التسهيل لعلوم التنزيل:
يُعَدُّ كتاب (التسهيل لعلوم التنزيل) -كما يوحِي عنوانه- موسوعةً مُسْعِفَة في القرآن وعلومه؛ فهو ليس مجرّد تفسير عاديّ؛ حيث ضمّنه مؤلِّفه مقدِّمَتَيْن منهجيّتَيْن رائعتَيْن، وهي طريقة قد يكون تفرَّد بها؛ حيث جمع بين علوم القرآن وتفسيره في مصنّف واحد.
المقدّمة الأولى لم تتجاوز خمس عشرة صفحة؛ لكنها حوَت اثني عشر بابًا في علوم القرآن؛ ففيها -كما وصفها هو- (أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة)؛ حيث عرض فيها لأسباب النزول، والمكي والمدني، والمعاني والعلوم التي تضمّنها القرآن، وفنون العلم التي تتعلّق بالقرآن، وأسباب اختلاف المفسِّرين...إلخ.
أمّا المقدّمة الثانية فهي بعنوان: (في تفسير معاني اللغات). وسنشير إليها لاحقًا في هذا الموضوع.
يقول ابن جزي عن موضوع كتابه: «ضمّنته من كلّ علم من علوم القرآن اللباب المرغوب فيه، دون القشر المرغوب عنه، من غير إفراط ولا تفريط».
ملامح التفسير اللغوي:
عُرِفَ عن المدرسة الأندلسية دورها البارز في تيسير اللغة وتذليل صعوبتها؛ ومن مظاهر ذلك مثلًا أنهم تشدّدوا في إلغاء العِلل الثواني والثوالث التي أثقلت النحو؛ حيث رأوا أنها لا تزيده إلّا تعقيدًا وصعوبة.
والناظر في كتاب ابن جزي يلاحظ هذا المسلك واضحًا جليًّا؛ حيث اعتمد على اللغة اعتمادًا كبيرًا في التفسير لكن بالقَدْر الذي يساعد في توصيل المعنى دون لبس أو تعقيد.
ويمكن تقسيم مظاهر اهتمام ابن جزي باللغة إلى قسمين؛ قسم نظري يحوي ما ذكره في مقدّماته عن اللغة وأهميتها كأداة من الأدوات التي لا يَسَع المفسِّر تجاهلها، والقسم الآخر وهو القسم التطبيقي الذي انعكس في أثناء تفسيره للآيات.
الجانب التنظيري:
يمكن تلخيص الموقف النظري لابن جزي من اللغة من خلال مقدّماته فيما يأتي:
أولًا: تأكيده على أهمية اللغة للمفسِّر وما ينبغي عليه معرفته منها:
وفي هذا يقول: «وأمّا اللغة فلا بد للمفسِّر من حِفْظِ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن وهي من فنون التفسير، وقد صنّف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة»[6]. ثم يؤكّد على أهمية علم النحو بصورة خاصّة قائلًا: «وأمّا النحو فلا بد للمفسِّر من معرفته؛ فإنّ القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة اللسان»[7].
ثانيًا: حديثه عن النحو بقسمَيْه وتوضيح منهجه فيه في التفسير:
اهتم ابن جزي في مقدّمته بالنحو وتقسيمه حيث يقول: «والنحو ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: عوامل الإعراب، وهي أحكام الكلام المركب.
والآخر: التصريف، وهي أحكام الكلمات من قِبَل تركيبها»[8].
ويوضح المنهج النحوي الذي سلكه هو في تفسيره: «وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يُحتاج إليه من المشكل والمختلف، أو ما يفيد فهم المعنى، أو ما يختلف المعنى باختلافه، ولم نتعرّض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلّا المبتدئ؛ فإنّ ذلك يطول بغير فائدة كبيرة»[9].
ثالثًا: تأكيده على أهمية علم البيان للمفسِّر:
بعد حديثه عن علم النحو أشار ابن جزي إلى فرع لغوي آخر لا يكتمل فهم النصّ القرآني ولا يظهر إعجازه اللغوي بدونه وهو علم البيان؛ حيث يقول: «وأمّا علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن؛ وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة، ونكات مستحسنة رائقة، وجعلنا في المقدّمات بابًا في أدوات البيان ليفهم به ما يرِد منها مفرّقًا في مواضعه من القرآن»[10].
رابعًا: إشارته للغة باعتبارها أحد أهم أسباب الخلاف بين المفسِّرين:
أفرد ابن جزي في مقدّمته بابًا خاصًّا بأسباب الخلاف بين المفسِّرين ووجوه الترجيح بين الآراء، ذكر فيه اثني عشر سببًا للخلاف، والمتفحّص لهذه الأسباب الاثني عشر، يجد منها تسعة أبواب على صِلَة وثيقة باللغة وفروعها؛ حيث يقول في أسباب الخلاف: «الثاني: اختلاف وجوه الإعراب وإن اتّفقت القراءات. الثالث: اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. الخامس: احتمال العموم والخصوص. السادس: احتمال الإطلاق أو التقييد. السابع: احتمال الحقيقة أو المجاز. الثامن: احتمال الإضمار أو الاستقلال. التاسع: احتمال الكلمة زائدة. العاشر: احتمال حَمْل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير»[11].
خامسًا: اعتباره اللغة من أهم وجوه الترجيح:
بعد أن ذكر ابن جزي أسباب الخلاف بين المفسِّرين ذكر أيضًا اثني عشر وجهًا للترجيح بين الآراء، جعل منها ثمانية وجوه متعلّقة أيضًا باللغة وفنونها، وهي: «الخامس: أن يدلّ على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدلّ عليه ما قبله أو ما بعده. السابع: أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن؛ فإنّ ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز؛ فإنّ الحقيقة أَوْلَى أن يُحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجّح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالًا من الحقيقة ويُسمى مجازًا راجحًا والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيّهما يقدّم: فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع: تقديم العمومي على الخصوصي؛ فإنّ العمومي أَوْلَى لأنه الأصل إلّا أن يدلّ دليل على التخصيص. العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد، إلّا أن يدلّ دليل على التقييد. الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلّا أن يدلّ دليل على الإضمار. الثاني عشر: حَمْل الكلام على ترتيبه إلّا أن يدلّ دليل على التقديم والتأخير»[12].
سادسًا: ربطه بين علم النحو والوقف والابتداء في القرآن:
رَبَطَ ابن جزي بين أنواع الوقف والإعراب؛ حيث يقول: «الباب التاسع في الوقف، وهو أربعة أنوع: وقف تامّ، وحَسَن، وكافٍ، وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى، فإن كان الكلام مفتقرًا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرًا إليه كذلك لم يجز إليه الفصل بين كلّ معمول وعامله، وبين كلّ ذي خبر وخبره...»، وهكذا يستطرد في ذِكْر أبواب من النحو وتأثيرها على الوقف حتى يقول: «هذا الذي ذكرْنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف: استقرّ عليه العمل، وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات، فيقفون عندها لأنها في القرآن كالفِقَر في النثر والقوافي في الشعر...»[13].
سابعًا: إفراده بابًا خاصًّا عن الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان:
ذكر فيه شروط الفصاحة، ثم عرّف البلاغة، ثم أفرد حديثًا عن البيان ومزَج بينه وبين البديع؛ حيث عرّف أدوات البيان بأنها «صناعة البديع، وهو تزيين الكلام كما يزين العَلَم الثوب»، وذَكَر من هذه الأدوات اثنتي عشرة أداة، وقف عليها -كما ذكر- في كتاب الله تعالى؛ حيث أفرد كلًّا منها بالتعريف[14].
ثامنًا: إفراده مقدّمة خاصّة عن «تفسير معاني اللغات»:
مما تفرَّد به ابن جزي أنه أفرد مقدّمة في تفسيره تُعَدُّ بمثابة معجم قرآني، تحت عنوان: (في تفسير معاني اللغات)؛ حيث جمع فيها الكلمات التي يكثر دَوْرها في القرآن، أو تقع في موضعَيْن فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، ورتّبها ترتيبًا ألفابائيًّا، وقد ذكر المعاني العامة لكلّ كلمة من هذه الكلمات.
وبيَّن سبب جمعها في هذه المقدّمة في ثلاث فوائد:
أُولاها: تفسيرها للحفظ؛ فإنها وقعتْ في القرآن متفرّقة، فجمْعُها أسهل لحفظها.
ثانيتها: ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير؛ لما أنّ تآليف القرآن جُمعت فيها الأصول المطّردة والكثيرة الدّور.
أمّا الفائدة الثالثة فهي: «الاقتصار، فسنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن؛ خوف التطويل بتكرارها».
الجانب التطبيقي:
بعد هذه الرحلة التي وقفنا فيها على النّهج اللغوي لابن جزي من خلال ما اختطّه هو بيده في مقدِّمَتَيْه البديعَتَيْن، نقف وقفات سريعة -حسب ما يسمح به المقام- مع الجانب التطبيقي من خلال استعراض لبعض توظيفاته اللغوية في تفسيره للآيات، ويمكن تلخيص ملامح هذا التوظيف فيما يأتي:
أولًا: الرّبط بين الإعراب والمعنى:
وهذا واضح جليّ في تفسير ابن جزي، ومثال على ذلك عند تفسيره قول الله تعالى: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ}[البقرة: 96]، قال: «{وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا} فيه وجهان:
أحدهما: أن يكون عطفًا على ما قبله فيوصَل به، والمعنى أنّ اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا، فحمل على المعنى، كأنه قال: أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، وخصّ الذين أشركوا بالذِّكر بعد دخولهم في عموم الناس؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبّهم للحياة الدنيا.
والآخر أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقَف على ما قبله، والمعنى: من الذين أشركوا قوم {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ}، فحُذف الموصوف...»[15].
ثانيًا: الإشارة إلى بعض الوجوه الإعرابية المتوهّمة الضعيفة والتنبيه عليها:
ويتّضح هذا عند إعرابه سورة الفاتحة، حيث يقول: «إعراب {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ} بدل؛ ويبعد النعت لأنّ إضافته غير مخصوصة وهو قد جرى عن معرفة»[16].
ثالثًا: ذكر الأوجه اللغوية الواردة في الآية الواحدة والترجيح بينها بدليل قرآني آخر:
ويتّضح هذا عند تفسيره قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ}[البقرة: 23]؛ حيث يقول: «{فَأْتُوا بِسُورَةٍ} أمر يُراد به التعجيز، {مِنْ مِثْلِهِ} الضمير عائد على {مَا نَزَّلْنَا} وهو القرآن، و{مِنْ} لبيان الجنس.
وقيل: يعود على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ فـ{مِنْ} على هذا لابتداء الغاية: (من بشرٍ مثله). والأول أرجح لتعيينه في يونس وهود، وبمعنى مثله في فصاحته وفيما تضمنه من العلوم والحِكَم العجيبة والبراهين الواضحة»[17].
رابعًا: اعتماده السياق لتفسير استخدام أداة أو توجيه لغوي معين:
وهذا واضح جليّ في قوله: «{وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ}[البقرة: 95]، إن قيل: لِمَ قال في هذه السورة: {وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ}، وفي سورة الجمعة: {وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ}[الجمعة: 7]، فنفى هنا بِـ(لَنْ)، وفي الجمعة بِـ(لَا)؟
فقال أستاذنا الشيخ أبو جعفر ابن الزبير: الجواب أنه لما كان الشرط في المغفرة مستقبلًا وهو قوله {إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً}[البقرة: 94]، جاء جوابه بـ(لَنْ) التي تخصّ الاستقبال، ولما كان الشرط في الجمعة حالًا، وهو قوله: {إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ}[الجمعة: 6]، جاء جوابه بـ(لا): التي تدخل على الحال، أو تدخل على المستقبل»[18].
خامسًا: توجيهه للقراءات مع مَيْله لموقف البصريين في تضعيف بعضها:
حرص ابنُ جزي على توجيه القراءات القرآنية توجيهًا لغويًّا، لكن لُوحظ تبنِّيه لموقف البصريين في تضعيف بعض القراءات لمخالفتها منهجهم التقعيدي. ويتّضح هذا جليًّا في قراءتَيْن تُعَدّان من أبرز أسباب الخلاف بين البصريين والكوفيين، وهما:
الأولى: في قوله تعالى في أوّل النساء: {وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ}[النساء: 1]؛ حيث يقول: «{والْأَرْحَامَ} بالنصب؛ عطفًا على اسم الله، أي: اتقوا الأرحامَ فلا تقطعوها، أو على موضع الجار والمجرور، وهو به؛ لأنّ موضعه نصب.
وقرئ بالخفض عطفًا على الضمير في به، وهو ضعيف عند البصريين؛ لأنّ الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلّا بإعادة الخافض»[19].
فهو هنا ذَكَر تضعيف البصريين دون رَدٍّ منه.
الثانية: في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ}[الأنعام: 137]؛ حيث يقول: «وقرأ الجمهور بفتح الزاي من {زَيَّنَ} على البناء للفاعل، ونصب {قَتْلَ} على أنه مفعول، وخفض {أَوْلَادِهِمْ} بالإضافة، ورفع {شُرَكَاؤُهُمْ} على أنه فاعل بـ{زَيَّنَ}. والشركاء على هذه القراءة هم الذين زيَّنوا القتل.
وقرأ ابنُ عباس بضمّ الزّاي على البناء للمفعول، ورفع {قَتْلُ} على أنه مفعول لم يُسَمَّ فاعله، ونصب {أَوْلَادَهُمْ} على أنه مفعول بـ{قَتْلُ}، وخفض {شُرَكَائِهِمْ} على الإضافة إلى {قَتْلُ} إضافة المصدر إلى فاعله، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله: {أَوْلَادَهُمْ}».
ثم يعقِّب قائلًا: «وذلك ضعيف في العربية، وقد سُمِع في الشِّعر»[20].
فهو هنا تبنَّى رأي البصريين صراحةً حتى دون نسبته إليهم.
سادسًا: استنباط الأحكام الفقهية بناءً على الدليل اللغوي:
يُعَدُّ ابنُ جزي من فقهاء المذهب المالكي -كما ذكرنا-؛ ولذا فإنّ استنباط الحُكم الفقهي من آيات الأحكام حاضر لديه بوضوح. ومن الأدلّة التي اعتمدها لاستنباط بعض الأحكام الفقهية الدليل اللغوي وما تقضيه قواعد اللغة العربية من توجيهات.
ومثال على هذا ترجيحه إباحة التيمّم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء (منتصرًا لمذهبه المالكي)، بناء على معنى (أو) في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً...}[النساء: 43]؛ حيث يقول: «{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ} في (أو) هنا تأويلان:
أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها.
والآخر: أنها بمعنى الواو.
فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} راجعًا إلى المريض والمسافر، وإلى مَنْ جاء من الغائط، وإلى مَنْ لامَس، سواء كانا مريضَيْن أو مسافرَيْن، أم حسبما ذكرنا قبل هذا، فيقتضي لك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، وهو مذهب مالك والشافعي فيكون في الآية حُجّة لهما.
وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} راجعًا إلى المريض والمسافر، فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلّا في المرض والسفر مع عدم الماء، وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر.
والراجح أن تكون (أو) على بابها لوجهَيْن؛ أحدهما: أنّ جَعْلها بمعنى الواو إخراجٌ لها عن أصلها وذلك ضعيف، والآخر: إن كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها، وإذا كانت بمعنى الواو لم تُعْطِ هذه الفائدة».
هذه بعض الفوائد التي سمح المقام والمقال بذِكْرِها عن هذه الموسوعة القرآنية المفيدة، التي يجد فيها أيُّ مُسلم بُغيته عن كتاب الله تعالى، بله المتخصّصين والباحثين.
طوّفنا في هذه المقالة حول كتاب (التسهيل في علوم التنزيل) لابن جزي الكلبي، وحاولْنا بيان جوانب من ملامح التفسير اللغوي عنده، وكشفْنَا عن الاهتمام الكبير لابن جزي باللغة وعُمق اعتماده عليها في التفسير، وكيف انعكستْ هذه الأهمية في كتابته لمقدّمات تفسيره، وكيف برزتْ كذلك في تطبيقاته التفسيرية، ونسألُ اللهَ تعالى أنْ يرحم هذا العالم الجليل وأنْ يجزيه خير الجزاء.
[1] نُشرت المقالة سابقًا في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، العدد (673)، رمضان 1442هـ، أبريل 2021م.
[2] دراسة الظاهرة العلمية في المجتمع الأندلسي، ص44.
[3] الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني (5/ 88).
[4] التقى فيها الجيش الإسلامي بقيادة السلطان أبي الحسن ملك المغرب ومعه السلطان يوسف بن الأحمر وأهل غرناطة بالجيش الصليبي بقيادة ألفونسو الحادي عشر، وانتهت بهزيمة وكارثة مدوية للمسلمين، وكانت أُولى الضربات الموجعة والمؤذِنة بسقوط الأندلس. (موقع قصة الإسلام).
[5] موقع قصة الإسلام.
[6] التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 18).
[7] التسهيل لعلوم التنزيل.
[8] التسهيل لعلوم التنزيل.
[9] التسهيل لعلوم التنزيل.
[10] التسهيل لعلوم التنزيل.
[11] التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 18، 19).
[12] التسهيل (1/ 19).
[13] التسهيل (1/ 23، 24).
[14] التسهيل (1/ 24، 25).
[15] التسهيل (1/ 91).
[16] التسهيل (1/ 66).
[17] التسهيل (1/ 76).
[18] التسهيل (1/ 91).
[19] التسهيل (1/ 176).
[20] التسهيل (1/ 277).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

رمضان فوزي بديني
حاصل على الدكتوراه من كلية دار العلوم - جامعة القاهرة، وله عدد من المشاركات العلمية والإعلامية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))