القرآن الكريم؛ وأثره في اللغة والعلم والاجتماع والأخلاق (3-3)

القرآن الكريم؛ وأثره في اللغة والعلم والاجتماع والأخلاق (3-3)[1]
أثر القرآن الكريم في الأحوال الخُلُقية:
لـمّا كان الـمَنْزِل هو المربَى الأول الذي يتعلّم فيه الإنسان الآداب الخُلقية ويألفها أوجب القرآن الكريم طاعة الوالدين: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}[الإسراء: 23، 24].
ولم يرخِّص في عصيانهما إلا إذا أرادا أن يحملاه على الإشراك بالله: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[لقمان: 15].
هذا الاحترام العظيم للوالدين هو الأساس الذي بُنِيَت عليه فضيلة الطاعة لأولياء الأمور: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: 59]، وليس المراد بأولي الأمر الحكام فقط بل يشمل كلّ مَن أُعطِي سلطانًا ونفوذًا، يشير إلى ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «كلُّكم راعٍ، وكلّ راعٍ مسؤول عن رعيته».
ومن هذا يتبيَّن أنّ دين الإسلام يطالب الناس جميعهم بالطاعة لمَن فوقهم؛ ليجتثَّ بذلك أصول الفوضى والمخالفة ويثبِّت دعائم الطاعة.
بَنَى القرآنُ الكريمُ الأخلاقَ على فضيلة واحدة هي التقوى، وقد دَلّ تصفُّح الآيات الكريمة التي وردَت فيها هذه الكلمة وما اتصل بها من المشتقات على أنّ المراد منها أن يتقي الإنسان كلّ ما كان فيه ضرر لنفسه أو إضرار لغيره؛ لتكون حدود المساواة قائمةً في المجتمع الإنساني لا تحصل فيها ثُلمة ولا يطرأ عليها وَهنٌ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[الحجرات: 13]، وقد جاء في الحديث: «لا فضل لأحدٍ على أحد إلَّا بالتقوى».
والآية صريحة في أنّ الغاية الاجتماعية للناس شعوبًا وقبائل هي التعارف، وتلك كلمة لا تشذّ عنها فضيلة من فضائل الاجتماع قاطبةً، ولا يمكن أن تدخل في مدلولها رذيلة اجتماعية. وفي هذه الآية الكريمة أقام القرآن الأساس الخُلقي العظيم فجعل أكرم الناس المتساوِين في الحالَين الفردية والاجتماعية هو أتقاهم، أي: أعظمهم خُلُقًا. لا أوفرهم مالًا ولا أكثرهم رجالًا ولا أثقبهم فكرًا ولا أعظمهم عِلْمًا، ولا شيئًا من ذلك مما لا يصحّ أن يكون سببًا للتفضيل إلَّا في إدبار الدول واضطراب الاجتماع وفساد العمران.
فالحقيقة أنّ التقوى هي الخُلق الكامل، ومن أجْلِ ذلك كان العدل في رأي القرآن أقرب شيء إلى التقوى؛ إِذْ يقول الله جلّ شأنه: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}[المائدة: 8].
وقد ردَّ القرآن مظاهر التقوى إلى ثلاثة أشياء: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان بالله. وهذه الأشياء الثلاثة هي المبدأ والنهاية لكلّ قوانين الأدب والاجتماع، قال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}[آل عمران: 110].
والمعروف: كلّ ما يعرفه العقل الصحيح حقًّا، ولا يتأتَّى الأمر بالمعروف إلا إذا توافر استقلال الإدارة وقوّتها.
والمنكر: هو كلّ ما ينكره العقل الصحيح، ولا يمكن النهي عن المنكر إلا باستقلال الرأي وحريته.
والإيمان بالله: هو الاعتقاد بوجوده ووحدانيته، ولا يتم ذلك إلا إذا استقلَّت النفس من أَسْر العادات والأوهام بالنظر والفكر في مصنوعات الله، وهذا هو الإيمان الذي يبعث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بثقة إلهية لا يعترضها شيء من عوارض الاجتماع التي تعتري الناس من ضعف الطباع الإنسانية؛ كالجُبن والنفاق وإيثار العاجلة وما إليها.
فإن هذه الصفات لا تتحقق مع صحة الإيمان، بل هي أنواع من العبادة للقويّ والمستبِدّ، وللشهوات والنزعات وما شابهها، وذلك لا يتفق والإيمان الصحيح بالله.
ما تدبَّر أحد القرآن إلا وجده يمنح كلّ إنسان إرادة اجتماعية أساسها الحرية: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}[الكهف: 29]، {فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ}[يونس: 108]؛ ولذلك لـمّا اتخذه الجيل الأول في صدر الإسلام مثالًا لهم واتخذوا آدابه الُخلقية شعارًا لهم حقّق لهم هذه الإِرادة الاجتماعية. ولو أنّ العلوم كلّها والفلسفة وأهلها كانت لأولئك العرب مكان القرآن ما أغنَت عنه شيئًا؛ لأن الفضيلة العقلية التي أساسها العلم لا توصل حتمًا إلى الإِرادة العملية.
أما الفضيلة الخُلُقية التي جاء بها القرآن فإنها تسوق إلى الإِرادة العملية؛ لأن هذه الإرادة مظهرها ولا سبيل لظهورها غير العمل، ومتى صحَّت إرادة الفرد واستقامَت له وجهته في الجماعة فقد صار بنفسه جزءًا من عمل الأُمّة، والأُمّة التي تتألَّف من مِثْلِ هذا الفرد تشغل مكانةً ساميةً في تاريخ الاجتماع.
والمتأمِّل في القرآن الكريم يرى أنّ جميع آدابه وعظاته ترمي إلى بثِّ الروح الاجتماعية في نفوس أهله، فكانت هذه الروح هي السبب الأول في انتشاره حتى بين أعدائه الذين أرادوا استئصاله كالتتار والمغول وغيرهم ممن اشتدوا عليه ليخذلوه، فكانوا بعد ذلك من أشدّ أهله في نُصرته والغضب له. ليس للقرآن طرائق للدعوة إليه إلا الأُسوة: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: 21]، فالأسوة أو القدوة مظهر آدابه؛ ولذلك كان كلّما وُجِدَت طائفة من أهله وُجدت الدعوة إليه وإن لم ينتحلوها ويعملوا لها، وما استَحَثَّ أحدًا بالعطايا؛ لأنه الدّين الطبعيّ للإنسان تأخذ فيه النفس عن النفس بلا وساطة ولا حيلة في الوساطة. وما أفصح ما وَرَدَ في صفة القرآن من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فيه نبَأُ ما قبلكم وخبرُ ما بعدكم وحُكْم ما بينكم، وهو الفَصْل ليس بالهزل».
أثره في الحياة العلمية:
مَن يدرس تاريخ العلم الحديث لا يسعه إلّا أنْ يستنبط أنَّ القرآن الكريم كان أصل النهضة الإسلامية، وأن النهضة الإسلامية هي التي لها الفضل في حفظ علوم الأولين وتهذيبها وتصفيتها وهي التي أوسعت المجال للعقل يبحث ويناظر ويستدلّ، وبذلك كانت هذه النهضة أساس التاريخ العلمي في أوربا.
انفرد القرآن بأنه هو الذي حرّر العقول البشرية من أصفاد الجمود والرِّقّ، وحفّز النفوس البشرية وساقها إلى قراءة صحف الكائنات وتدبُّر ما فيها من الصُّنْع البديع.
القرآن هو الذي ساق النفوس إلى تقصِّي غوامض الكائنات والتنقيب عن دفائنها، وبيَّن لهم أنهم لم يُؤْتَوا من العلم إلّا قليلًا: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}[الإسراء: 85]، ثم دلَّهم على مواطن التفكير والبحث، وبيَّن للناس بضرب الأمثال فِيمَ يفكرون، فقال جلّ شأنه: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ}[الذاريات: 49]، {سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ}[يس: 36]، {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}[الأنبياء: 30]، {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ}[الطلاق: 12]، {كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ}[الأنبياء: 33]، {وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ}[المؤمنون: 17]، {تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا}[الفرقان: 61]، {فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ}[القمر: 11]، {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ}[الفرقان: 25]، {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا}[النبأ: 6، 7]، {وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ}[ق: 7].
القرآن هو الذي أعدّ العقول لفهم الفلسفة الإغريقية ودراسة العلوم الكونية، فتصافَى العلم والقرآن بضعة قرون لم يقع بينهما نفور ولا مشادّة، فقد كرَّم العلمَ ونوَّه بالعقل وذمَّ الذين يعطلون عقولهم ويتبعون أهواءهم، إِذْ يقول في شأنهم: {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}[الأعراف: 179]، {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ}[الأنفال: 22]، {وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ}[يونس: 43].
{ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}[الإسراء: 36]، {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ}[هود: 28]، {نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآَنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ}[ق: 45]، {إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ}[الشورى: 48]، {قَدْ بَيَّنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}[البقرة: 118]، {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}[البقرة: 256]، {إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ}[الغاشية: 21، 22].
القرآن هو الباب الذي خرج منه العقل الإنساني الكامل بعد أن كان طفلًا؛ فقد هداه إلى النظر والاعتبار والاستنباط، إِذْ يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}[آل عمران: 190، 191]، {وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}[الجاثية: 4، 5]، {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ}[الأعراف: 185]، {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ}[الأنعام: 38].
كانت هذه الآيات وأشباهها سببًا في إطلاق الحرية العلمية للعقول البشرية، فلما اقتبَسَت منها أوربا نهَضَت وأصبحَت تسوس العالم وترشده إلى ما فيه صلاحه.
القرآن هو الذي أوجد العَدد الجَمّ من أعاظم المؤلِّفين في العلوم الشرعية والرياضية والطبعية والفلكية وغيرها؛ ذلك بأنّ العلماء لـمّا نظروا فيه تشعَّبَت طرق تفكيرهم: فمنهم قومٌ عُنوا بضبط لهجاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وهؤلاء هم علماء القراءة، وقومٌ عُنوا بالمعرب والمبني وما إلى ذلك وهؤلاء هم علماء النحو، وقوم شغفوا بما فيه من الأدلة العقلية وهؤلاء هم علماء الكلام، وتأمَّلَت طائفة منهم معاني خطابه فرَأَت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص ومنها ما هو مُطلَق ومنها ما هو مُقيَّد ومنها ما هو مُجْمَل إلى غير ذلك وهؤلاء هم علماء الأصول، وتلمَّسَت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية وهؤلاء هم أهل التاريخ والقصص، وتنبَّه آخرون لِما فيه من الحِكَم والأمثال والمواعظ وهؤلاء هم الخطباء والوُعّاظ، وأخذ قوم علم الفرائض وحسابه من آيات المواريث، ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالّة على الحِكَم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهؤلاء هم علماء الميقات.
من هذا يتبيَّن أنّ القرآن الذي نزَل في البادية على أُمِّيّ وقومٍ أُمِّيين لم يكن لهم إلّا ألْسِنتهم وقلوبهم، وكانت فنون القول التي يذهبون فيها مذاهبهم لا تتجاوز ضروبًا من الصفات وأنواعًا من الحِكَم، مكَّن العلماء من أن يُخرِجوا من كلّ معنًى عِلمًا برأسه، وعلى ممرِّ السنين أَخرَجوا من كلّ علمٍ فرعًا حتى وصلَت العلوم إلى ما وصلَت إليه في الحضارة الإسلامية التي أنجبَت الحضارة الحديثة.
كفاك بالعلم في الأُمِّيّ معجزةً .. في الجاهلية، والتأديب في اليُتْمِ
لا يزال الباحثون في القرآن الكريم يستخرجون منه ما يُشير إلى مستحدثات الاختراع وما يحقّق بعض غوامض العلوم، فمِن ذلك قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا}[الأنبياء: 30]، مما يؤيّد ما حقّقه العلماء من أن الأرض انفتقَت من النظام الشمسي، وقوله تعالى: {وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ}[النحل: 15]، مما يدلّ -كما أثبته العلماء- على أنه لولا الجبال لمادَت الأرض ببحارها واضطربَت بأمواجها ولَما طاب للإنسان بها مستقَر.
وقوله تعالى: {وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا}[نوح: 16]، {وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا}[النبأ: 13]، ممّا يؤيّد ما حققه العلم من أنّ الشمس جسم مشتعل تبثُّ النور والنار من ذاتها وترسلها إلى سيّاراتها المرتبطة بها.
وقوله تعالى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ}[الرحمن: 33]، مما يشير إلى حدوث الطيران وأنه سيكون منه نصيب للإنسان.
وقصارَى القول أنَّ العقل هو القائم على فهم القرآن واستنباط ما فيه من الأسرار على اختلاف الأحقاب والدهور؛ لأن الذي جاء بهذا القرآن كان آخر الأنبياء من الناس، ولا حاجة بالكمال الإنساني لغير العقول ينبّه إليه بعضها بعضًا.
ولذلك يقول الله تعالى: {سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}[فصلت: 53]، فلو محّصت جميع العلوم الإنسانية ما خرجت في معانيها عن قوله تعالى: {فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ}. وكلما تقدّم النظر وتوافرَت طرائق البحث ظهرَت حقائق الكائنات ناصعة، وتجلَّت الإِشارات التي انبثَّت في ثنيّات القرآن: {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}[يوسف: 21].
[1] نُشرت هذه المقالات بمجلة الإصلاح الصادرة بمكة المكرمة، الأعداد: الخامس (ص:18-24)، والسادس (ص:22)، والسابع والثامن (ص:23-27)، الصادرة في: غرة جمادى الأولى و15 جمادى الأولى و15 جمادى الآخرة عام 1347هـ، الموافق 14 أكتوبر و30 أكتوبر و28 نوفمبر عام 1928م، على الترتيب.
وقد صُدِّرت المقالة الأولى ببيان أن أصل المقالات محاضرة ألقاها الكاتب في (مؤتمر المستشرقين الذي عُقد بكلية أكسفورد من بلاد الإنكليز).
وقد أعدنا تقسيم المقالات؛ حيث كان التقسيم غير متناسق مراعاةً لمساحات النشر في المجلة فيما يظهر.
رابط المقالة الأولى: tafsir.net/article/5210
ورابط المقالة الثانية: tafsir.net/article/5211 (موقع تفسير).


 ثقافة الحوار في القرآن
ثقافة الحوار في القرآن القرآن الكريم وقضية البعث
القرآن الكريم وقضية البعث مقدمة تفسير القرآن الكريم
مقدمة تفسير القرآن الكريم القرآن الكريم؛ وأثره في اللغة والعلم والاجتماع والأخلاق (2-3)
القرآن الكريم؛ وأثره في اللغة والعلم والاجتماع والأخلاق (2-3) المنهج القرآني في الاستدلال على وجود الله تعالى
المنهج القرآني في الاستدلال على وجود الله تعالى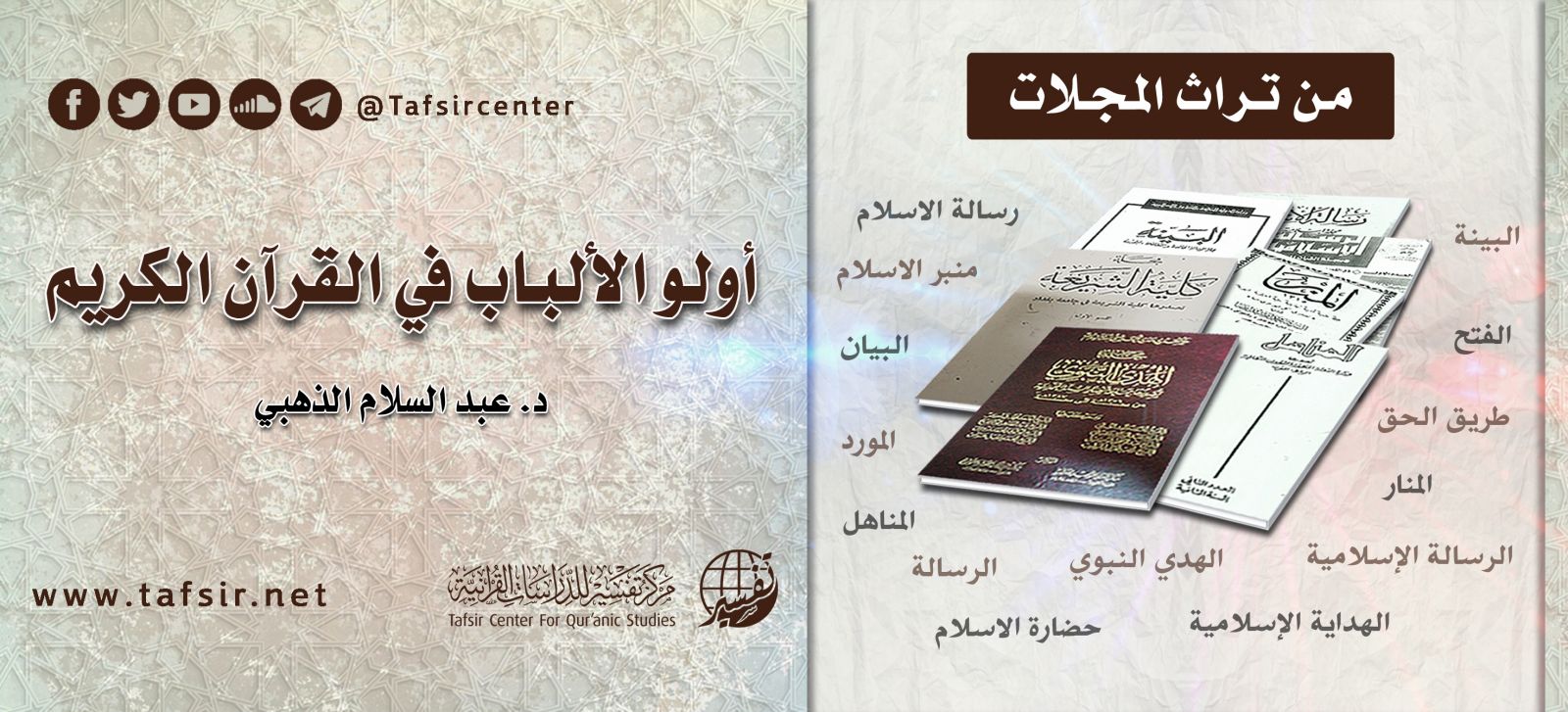 أولو الألباب في القرآن الكريم
أولو الألباب في القرآن الكريم