المنشورات الحديثة في المجلات العلمية الغربية المتخصّصة في الدراسات القرآنية
ملخصات مترجمة
الجزء الثالث والأربعون
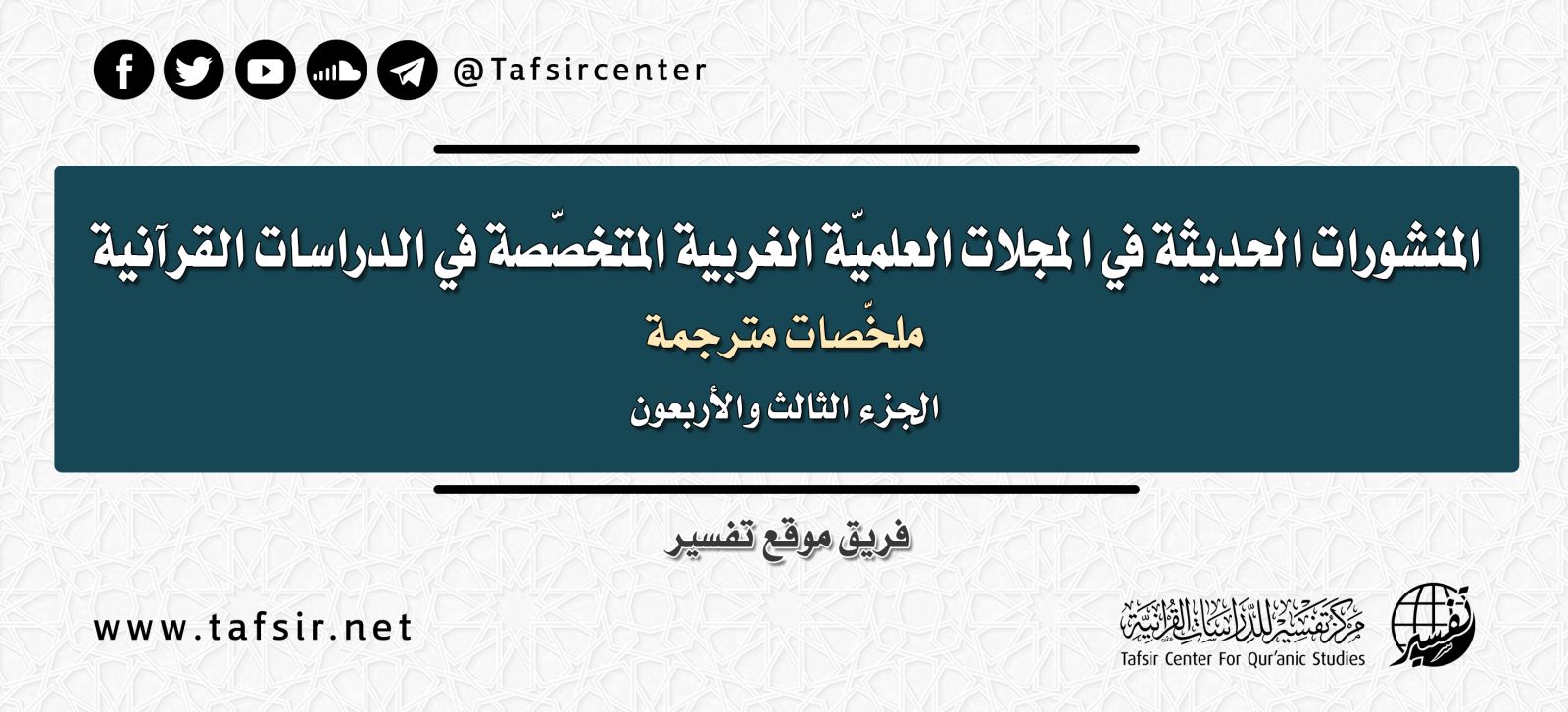
هذه المقالة هي الجزء (43) من ترجمة ملخَّصات أبرز الدراسات الغربية المنشورة حديثًا[1]، والمنشورة في بعض المجلات الغربية، والتي نحاول من خلالها الإسهام في ملاحقة النتاج الغربي حول القرآن الكريم ومتابعة جديدِه بقدرٍ ما، وتقديم صورة تعريفية أشمل عن هذا النتاج تتيح قدرًا من التبصير العامّ بكلِّ ما يحمله هذا النتاج مِن تنوُّع في مساحات الدرس.
1- Textual Authority and Modern Urdū Exegetical Interpretations, A Case Study of Q.4:34
Naveed Anjum
American Journal of Islam and Society, Vol. 42 No. 1-2 (2025)
السلطة النصّية والتفسير الأوردي الحديث للقرآن
دراسة حالة للآية 34 من سورة النساء[2]
نافيد أنجوم
نتيجةً للحداثة وظهور دراسات النوع الاجتماعي، أُعيد النظر في النصوص الإسلامية التي تتناول المرأة ومكانتها في الرؤية الشاملة الأوسع للإسلام، وأُعيد تفسيرها. وُضِعَت مناهج التفسير التقليدية موضع تساؤل، وجرتْ محاولات لإعادة تفسير القرآن. كما تأثّر التفسير الحديث في شبه القارة الهندية بالحداثة، مما أدّى بدوره إلى ظهور اتجاهات تفسيرية متنوّعة ومتنافسة. وفي هذا السياق، تتناول هذه المقالة الآية 34 من سورة النساء كدراسة حالة؛ نظرًا لكونها من أكثر هذه النصوص إثارة للجدل. وتُقيِّم المقالة نقديًّا بعضًا من أهمّ الاتجاهات التفسيرية الأوردية وأكثرها تأثيرًا في أدب شبه القارة الهندية الحديثة، وتُحلّل مناهجها واستنتاجاتها المتعلّقة بالآية 34 من سورة النساء. ويُتيح لنا هذا التحليل فهمًا أعمق لديناميكيات سلطة النصّ، وتلقّي النصّ، ودور المفسِّرين في عملية صياغة المعنى. تتناول هذه المقالة اتجاهات تفسيرية مهمّة وغير مستكشفة في شبه القارة الهندية الحديثة، وتحاول سدّ الفجوة في سياق التناول الحديث للآية 34 من سورة النساء.
2-The Tefsir of the Tatars – the Critical Edition of the First Translation of the Qurʾān into Polish (16th Century). Results of the Tefsir Project
Joanna Kulwicka-Kamińska and Czesław Łapicz |
Arabica, Volume 72 (2025): Issue 3 (Jul 2025)
تفسير التتر، نسخة نقدية من أول ترجمة للقرآن إلى البولندية
يوهانا كولفيكا كامينسكا وشيلاف لابسيك
تشير هذه المقالة إلى ترجمة القرآن المحفوظة بالكامل إلى لغة أوروبية ثالثة ولغة سلافية أُولى. وقد أنجزها تتر دوقية ليتوانيا الكبرى السابقة، الذين كانوا يعتنقون الإسلام السنّي في بيئة مسيحية. تقدِّم هذه الورقة البحثية دراسة لغوية وتاريخية وطبعة نقدية لِما يُسمّى بتفسير تتر دوقية ليتوانيا الكبرى في النصف الثاني من القرن السادس عشر (أول ترجمة للقرآن الكريم إلى البولندية). تُمكّن الأفكار الواردة في الورقة مجال الدراسات الإسلامية من تجاوز تركيزه المعتاد على العرب المسلمين والشرق الأوسط، والكشف عن تنوّع المجتمعات الإسلامية، وخاصّة تلك الموجودة في أوروبا الشرقية، والتي نادرًا ما تُتناول في الأدبيات العلمية. تُظْهِر الورقة البحثية الروابط التي كانت تربط الثقافة الأدبية التترية بالمسيحية، وبشكلٍ أكثر تحديدًا بتقاليد دراسة الكتاب المقدّس، وهو الموضوع الذي اكتسب اهتمامًا متجددًا في سياق إعادة تعريف تاريخ علاقة أوروبا المسيحية بالإسلام.
3- Enabling Obedience: Exploring Qur’anic Norms in the Context of Obligations and Belief
M. A. S. Abdel Haleem
Journal of Qur'anic Studies, Volume 27, Issue 1, 2025
تمكين الطاعة: استكشاف المعايير القرآنية في سياق الفروض والعقيدة
محمد عبد الحليم
خلال الدراسات الأكاديمية للقرآن الكريم، وفي ضوء الكتابات الأخيرة تحديدًا لكاتب هذه الدراسة، يقترح الكاتب أنّ القرآن لا يكتفي بتوقّع الامتثال والطاعة من المؤمنين، بل يسعى إلى تشجيعهما. ومن بين الأدوات العديدة التي يستخدمها القرآن، يسلِّط هذا المقال الضوء على سمة محددة، وهي (التمكين) القرآني. ويمكن فهم ذلك بسهولة في سياق وظيفة القرآن الأساسية كـ(هدى) بدلًا من (كتاب شريعة). ستوضّح المقالة مجموعة مختارة من الآيات كيف تُسهّل لغة القرآن التمكينية الطاعة في مجالات متنوّعة ومتميزة؛ كالالتزامات المالية الدينية، والشعائر الدينية، والأخلاق الجنسية. تتناول المقالة مجموعةً من الأمثلة التوضيحية على ذلك، إذ تشير إلى مجموعةٍ محوريةٍ من الآيات القرآنية التي تُمجّد صفات الله، وتُوضّح -بطريقةٍ ما- علاقة الإنسان بالله وكتابه، مُذكِّرةً بذلك جمهورها بعَهْده معه. إنَّ وضع التذكير بهذه الطريقة يُعزّز علاقة المرء بالله، ويُذكّره بشكر الله وطاعته الواجبة. وبالتالي، فإنّ هذه (المقاطعات)، أو ما يُمكن تسميته (التعليقات)، ضروريةٌ لـ(التمكين) الـمُبيّن هنا.
4- al-Ṣafadī’s Interpretation of the Disconnected Letters (al-Ḥurūf al-Muqaṭṭaʿa) in His Kashf al-Asrār wa Hatk al-Astārr
Salam Ahmad Freijat and Mohammad F. Hawamdeh
Islamic Studies Journal, Volume 2 (2025): Issue 1 (May 2025)
الحروف المقطعة عند الصفدي في تفسيره (كشف الأسرار وهتك الأستار)
سلام أحمد فرجاتي، ومحمد الحوامدة
يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية الحروف المقطّعة عند جمال الدين الصفدي (ت: 696هـ/ 1297م) في تفسيره، ووجوه الإعجاز فيها، وبيان أدلّته فيما ذهب إليه. وقد اتُّبع في هذا البحث لتحقيق أهدافه المنهج الاستقرائي من خلال تتبّع رأي الصفدي في الحروف المُقَطّعة، والمنهج التحليلي بمناقشة آراء الصفدي وأدلّته فيها. وقد أظهرت الدراسة عدّة نتائج، منها: ذهاب الصفدي إلى أنّ الحروف المقطّعة جاءت لفوائد وحِكَم يجب أن تُعلم، وأنه ردّ على مَن قال إنها سِرّ محجوب استأثر اللّٰهُ به في علمه، ونفى أن تكون لها معانٍ مقصودة في ذاتها، بل المعنى في تركيبها القرآني المعجز. وقد فرّق الصفدي بين القول بماهية هذه الحروف المقطعة في بداية السور، والحكمة والغاية منها، وهو أمر اختلط على بعض الباحثين الذين تناولوا هذه الحروف بالبحث والدراسة. وقد سار الصفدي في تفسيره للحروف المقطعة وفق منهج محدّد وطريقة مطّردة في جميع السور التسع والعشرين المبدوءة بها. ويمكن أن تُعَدّ الدراسة الحالية هي الأُولى التي تتناول الحروف المقطّعة عند الصفدي.
[1] يمكن مطالعة الجزء السابق على هذا الرابط: tafsir.net/paper/89.
[2] تعريب عناوين المقالات والبحوث هو تعريب تقريبي من عمل القِسْم. (قِسم الترجمات)


