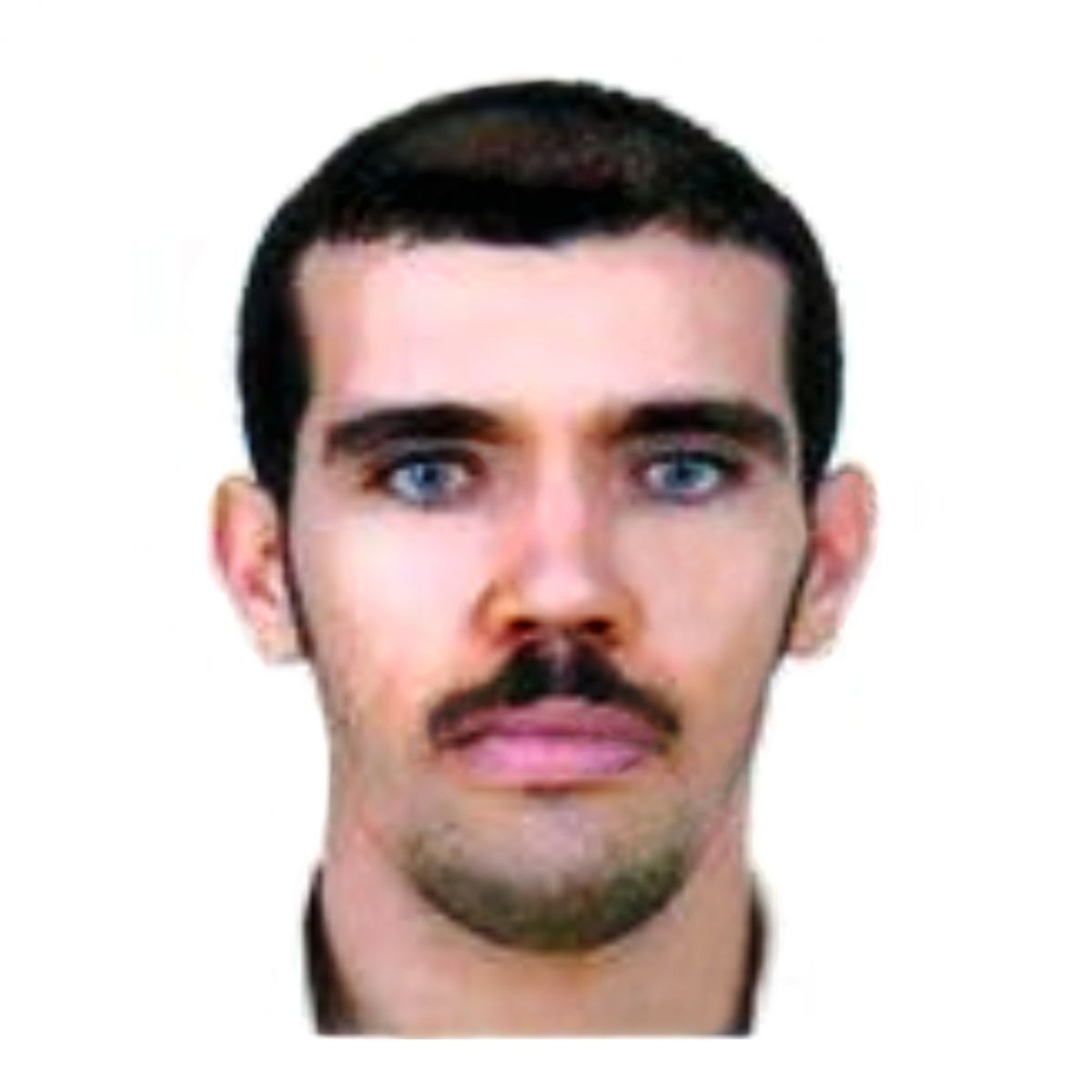الترتيب البنائي لوحدة القرآن، وموجب إعادة القراءة من منظور محمد أبو القاسم حاج حمد
مقاربة منهجيّة
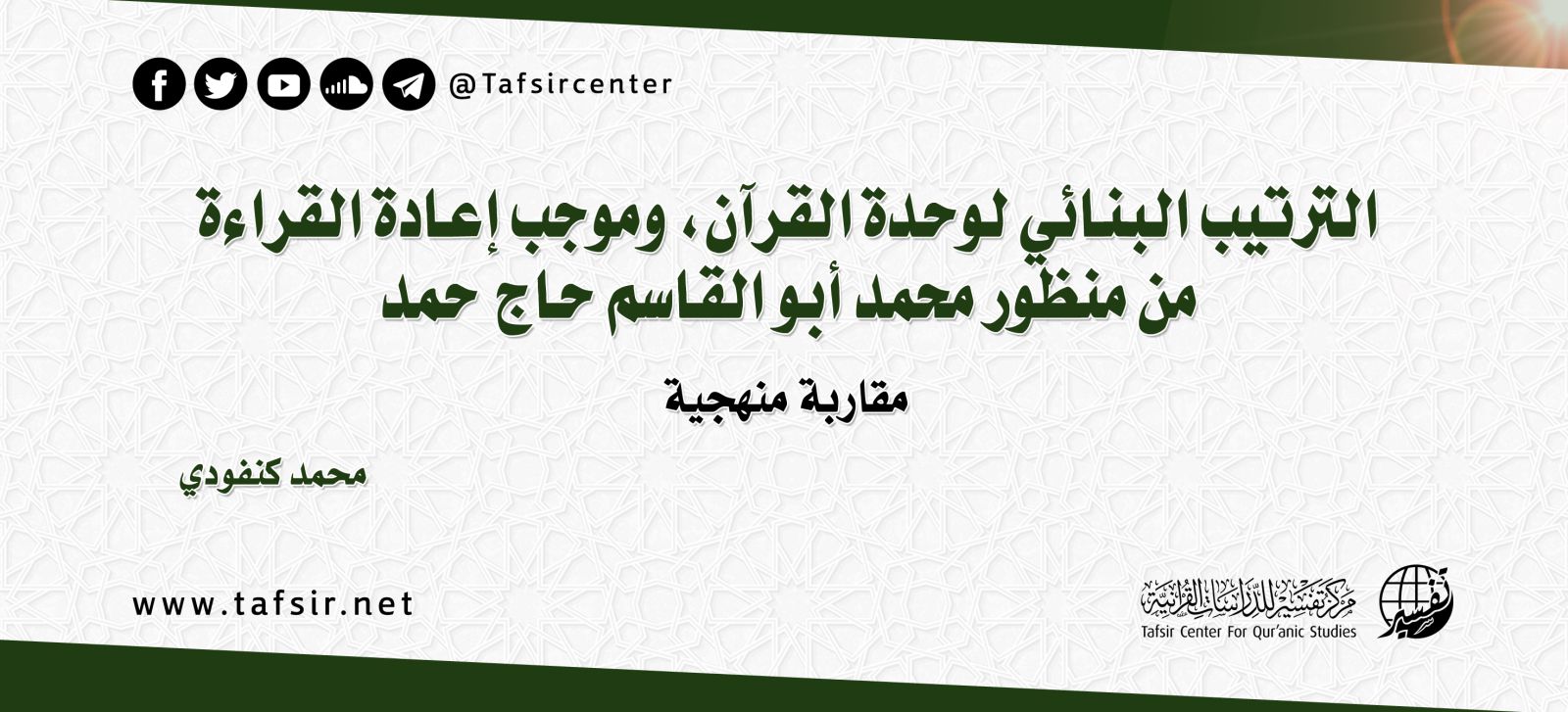
تَعَلّق النظر وما زال متعلّقًا بما يحقّق له المشروعية المنهجية، التي تنبثق عنها المشروعية المعرفية كونها تابعةً لها، ليس في تاريخ الفكر الإسلامي فحسب، وإنما في عموم تاريخ الفكر الإنساني؛ بحيث تتعذّر إمكانية الفصل بين النظر ومنهجه من جهة، والمنهج وإنتاجه من جهة أخرى. ويزداد الاهتمام أكثر بالبحث في مشروعية منهج النظر بالحقل المعرفي الذي يكون أحد مواضيعه مناط النظر. وكلّما كان الحقل أو النصّ ذا خصوصية فارقة، كلّما كثر الاهتمام بالمنهج بصورة أعمق وأوسع ومن جهات شتى.
وكون النظر الذي نحن بصدد الحديث عنه يتعلّق بالنصّ القرآني الذي له خصوصية فارقة جليلة لا مراء فيها، ليس باعتبار أنه نصّ ديني خاتم عالمي راهني مفارق ونحو ذلك فحسب، وإنما لكونه يضع التكليف إنْ إجمالًا أو تفصيلًا، فكان بهذه الخصوصية حريًّا أن يكثر ويتنوّع ويتعدّد ويتوالى البحث في منهج النظر فيه إِنْ فهمًا أو تفسيرًا أو قراءةً أو تأويلًا من مختلف مناحي النظر الممكنة، ليس في منظور التفسير التراثي فحسب، وإنما في منظور تجديد التفسير وإعادة القراءة أيضًا.
وبالنظر إلى أنّ اعتبار تأسيس منهج النظر في النصّ القرآني لا ينفكّ عن خواصّ الاجتهاد الإنساني مثله مثل غيره، كان بذلك محتملًا للإصابة والخطأ؛ اعتمادًا على موافقة منهج النظر أو مخالفته لأصل خصوصية القرآن، فضلًا عن أنّ إمكانية إعادة التأسيس واردة. وعلى الرغم من كونها واردة فهي لا تنشأ -بالضرورة- عن قطيعة مطلقة مع الاجتهادات السابقة التي كان مدارها تأسيس منهج النظر في تاريخ التفسير الأصلي والتبعي، وإنما تخضعها للتمحيص والمراجعة لتبيّن ما ثبتت فائدته وموافقته وتمييزه عن ما ثبتت مخالفته وفَقَدَ اعتباره؛ قصد استثمار الأول في إعادة التأسيس، والاعتبار من الثاني تجنبًا لأعطابه.
في هذا السياق الكلّي ترِد هذه المقالة التي خصصتها للنظر في اجتهاد محمد أبو القاسم في سياق اهتمامه بإعادة قراءة القرآن في الزمن التأويلي المعاصر، والتي قضَت بإعادة تأسيس منهج القراءة اعتمادًا على ترتيب وحدة القرآن في المصحف، بالنظر إلى الصِّلَة الوثيقة بين وحدة القرآن ومنهجها من جهة، وكذا بينه وبين إعادة القراءة من غير انفكاك من جهة أخرى، خصوصًا على مستوى الاعتبار وعدمه.
ومن هذه الزاوية التي ننطلق منها في دراسة اجتهاد محمد أبو القاسم تظهر أهمية البحث في موضوع المقالة، ليس باعتبار الاحتكام لراهنية النصّ القرآني الدائمة؛ استجابة لخاتميته وعالميته، وما يقتضيان من التعالي المفارق والتجرّد عن المحايثة التاريخية القاضية بتوالي النظر فيه، وليس بالنظر إلى أنّ مدار النظر في القرآن لا ينفكّ بأيّ وجه عن المنهج، وليس بالنظر إلى أنّ معيار قبول التفسيرات أو ردّها راجع إلى اعتبار صحة المنهج أو اعتلاله فحسب، وإنما بالنظر إلى أنّ جملة من الإشكالات المنهجية والمعرفية الناشئة في ظلال الاشتغال بالقرآن في تاريخ التفسير قديمًا وحديثًا يمكن حسم القول فيها احتكامًا لمعيارية منهج القراءة المؤسّس عن أصل خصوصية القرآن؛ سواء الخصوصية التي ركّز عليها محمد أبو القاسم أو غيره من الأعلام، والمتمثّلة في كلية وحدة القرآن البنائية الترتيبية التوقيفية في المصحف، أو غيرها من عموم مصاديق أصل خصوصية القرآن، وإن كانت محدّدات هذه المصاديق على مستوى تأسيس المنهج لا تَرِد منفصلة، بل متّصلة اتصال آيات القرآن بعضها ببعض.
وفق هذا التأطير الكلّي، فإنّ ما نتغيّا تحقيقه من الأهداف، أو على الأقل تسهيم القول في بعضها، تبيان أنّ اعتبار القراءة من اعتبار منهجها، وأنّ اعتبار المنهج من نوع المرجعية التي يستند إليها ويستمدّ منها مقوّمات تأسيس المنهج، خصوصًا وأن أصل خصوصية القرآن عمومًا، وما تعلّق بخصيصة التوقيف الترتيبي البنائي في المصحف على وجه التحديد، ليست مجرّد فضيلة من فضائل القرآن، وإنما هي -بالقصد الأصلي- حضن مرجعي معياري مؤسّس للمنهج، إن لم يكن على مستوى تفصيل الجزئيات، فعلى الأقل على مستوى تحديد الكليات المحكّمة الناظمة، كونها تنزل منزلة النموذج الإرشادي الموجّه للنظر.
كما أنّ المقالة تسعى للتدليل على فاعلية هذا المنحَى في تأسيس منهج القراءة، خصوصًا على مستوى الركون إلى تلك الخصيصة من خصائص القرآن المنهجية المرجعية المعيارية المحكّمة، التي من شأنها أن تجعل تأسيس منهج القراءة منصبًّا على القرآن كما هو ثابت في المصحف على سبيل القطع، الأمر الذي يترتب عنه التقليل والتخفيف من الاعتماد على جملة من المداخل المنهجية الخارجية المحمّلة، التي نشأت خارج المقتضيات المنهجية والمعرفية لخصوصية القرآن؛ سواء كانت سابقة عن زمن النزول، أو نشأت تزامنًا معه، أو ظهرت متأخرة عنه، ويُستثنى من ذلك على سبيل القطع البيان النبوي الصحيح.
ولضبط النظر في بعض ذلك، فإنّ الإشكال الذي نؤطّر به المقالة يمكن صوغه بصورة مجملة وفق ما يأتي: ما البواعث القاضية بتجديد النظر في منهج إعادة قراءة النصّ القرآني؛ ركونًا لإعادة تأسيس المنهج من منظور محمد أبو القاسم، وما جملة المقومات المنهجية التي ينبني عليها منظور إعادة تأسيس منهج القراءة، وإلى أيّ حدّ كان هذا المنظور محتكمًا لأصل خصوصية القرآن كما هي ثابتة في المصحف، وهل يمكن أن يعدّ هذا المنظور مرجعًا حاضنًا لإعادة تأسيس منهج قراءة النصّ القرآني في الزمن التأويلي المعاصر، وكون هذا المنظور مسبوقًا بمقاربات عديدة كان مدارها تأسيس منهج القراءة عمومًا، ومن نفس زاوية نظر محمد أبو القاسم خصوصًا، وإن لم تكن متكاملة الجوانب، فهي على الأقلّ عُدّت مقترحات في الموضوع، فما صلة هذا المنظور ببعضها إِنْ على سبيل النقد القاضي بالتجاوز، أو على سبيل التكميل والتطوير، وهل لذلك المنظور آثار عملية تطبيقية صريحة في إعادة قراءة آيات القرآن وما يتصل بها من قضايا ومسائل؟
ولتبيان بعض ذلك حسب إمكان المقالة، فإنّ المنهج الذي نتقيّد به يجمع بين جوانب عدّة من المقاربة المنهجية، فهو ينطلق من مسلك التحليل والتركيب الذي يبتغي تحقيق النسق في تقديم المنظور، ونردفه بالمقارنة المنهجية بين اشتغال محمد أبو القاسم وغيره من الأعلام الذين كان مدار اهتمامهم نفسه مدار اهتمامه بوجهٍ ما؛ سواء كان من المتقدّمين أو المتأخّرين، قصد الكشف عن المقومات المشتركة التي يتأسّس عليها منهج إعادة القراءة، وكذا إمعان النظر من أجلِ الإشارة إلى بعض جوانب القصور والنقص المنهجي التي تخلّلت منظور إعادة القراءة وفق هذا المنحى من جهة، وكذا كشف وتحديد بعض الجوانب الأخرى التي تحتاج إلى إكمال وتطوير. ولتناول ذلك نحتكم فيه لأصل خصوصية القرآن عمومًا، وما تعلّق بالأصل الكلّي الذي يكون محلّ النظر خصوصًا؛ وهو أصل بنائيّة القرآن التوقيفية الترتيبية في المصحف.
هذه الزاوية التي نركّز النظر عليها في هذه المقالة من أجلِ دراسة منظور محمد أبو القاسم وإن تناولها غيره من الأعلام بصورة من الصور كما يأتي التمثيل في المحور الأول، وأنجز بعض الباحثين بعض الدراسات حول عموم مشروع اجتهاد محمد أبو القاسم، خصوصًا كتاب: (الإبستمولوجيا الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي: قراءة في مشروع محمد أبو القاسم حاج حمد)، للحاج أوحمنه دوّاق[1]، إلا أنّ إفراد تلك الزاوية بالدرس لم تلقَ العناية الكافية. والأمر لا يتعلّق بإعادة قراءة آيات القرآن وفق خصيصة بنائية القرآن التوقيفية الترتيبية في المصحف فحسب، وإنما في صِلَة ذلك بتأسيس منهج القراءة، على اعتبار أنّ مجمل خصائص القرآن في علاقتها بالمنهج تعدّ مشروعات متكاملة لتأسيس منهج القرآن من جهة، ومعايرة الإنتاج المنهجي والمعرفي في تاريخ التفسير قبولًا وردًّا من جهة ثانية.
من باب التنبيه، نُورد في ثنايا هذه المقالة مجموعة من المفاهيم قد تكون متداولة أو غير متداولة، إلا أنّ تحقيق المبتغى باستعمالها يقتضي تعريفها، ونُورد ذلك البيان إمّا في ثنايا محاور المشاركة، أو أن نستعملها بأسلوب يكشف عن معناها، خصوصًا وأنّنا نسوق أغلبها بصيغة التقابل، ومن تلك المفاهيم: مفهوم زمن النزول في مقابل زمن أو أزمنة التأويل، أصل الإمكان في مقابل أصل الوجوب، أصل الإكمال في مقابل أصل القطيعة المطلقة، التفسير الأصلي في مقابل التفسير التبعي، أصل خصوصية القرآن وما ينبثق عنها من خصائص كلية مرجعية معيارية، كأصل بنائية القرآن التوقيفية، ترتيب النزول في مقابل ترتيب المصحف.
بناء على ما تقدّم، ولدراسة اجتهاد محمد أبو القاسم بما يستجيب لمقتضيات المقاربة المنهجية[2]، نسوقه وفق ثلاثة محاور؛ وهي كما يأتي:
المحور الأول: نظرة موجزة عن منهج النظر في القرآن احتكامًا لأصل وحدة بنائيته التوقيفية:
بعض مناحي النظر في القرآن السائدة في الزمن التأويلي المعاصر، تعدّ امتدادات ظاهرة أو مضمرة لِما ساد في تاريخ التفسير؛ بحيث توجد لتلك المناحي جذور في إنتاجات المتقدّمين؛ سواء كان النظر في القرآن أصليًّا عمَّ كلَّ آيات القرآن، أو تبعيًّا اقتصر على بعض آياته بحسب خصوصية الحقل المعرفي. وهذا ما ينطبق بصورة صريحة على تأسيس محمد أبو القاسم لمنهج إعادة القراءة على بنائية القرآن التوقيفية في المصحف.
ذلك أنّ القرآن منذ انتهاء زمن نزوله بوفاة الرسول -عليه السلام- تولاه النظار بالتفسير في مختلف أزمنة التأويل في تاريخ الفكر الإسلامي؛ ابتداء بالمراحل الجنينية، مرورًا بالحقب التأسيسية، وبمراحل التنقيح والتحقيق، وانتهاء بأزمنة التجديد وإعادة التأسيس في الزمن التأويلي الحديث والمعاصر؛ بحيث إنّ سُنَّة التفسير عند المتقدّمين جرت وفق ترتيب المصحف، وإن كان النظر في ترتيب النزول معتمدًا بوجهٍ ما من باب الاستعانة على تبيّن معاني بعض الآيات التي يُشْكِل معناها على بعض المفسّرين، إلا أنّ إقامة كلية التفاسير تقيد فيها أعلامها بترتيب المصحف، ليس من باب الاختيار المنهجي فحسب، وإنما التسليم بكونه وحيانيًّا مثل نزوله وتدوينه، فكان بذلك مدار وضع التكليف الشرعي، لكونه تم تحت عناية وإشراف الرسول عليه الصلاة والسلام.
والاهتمام بالقرآن -احتكامًا لبنائية الترتيب التوقيفي في المصحف- لم يقتصر على مسلك التعامل المباشر مع آيات القرآن، وإنما تأسّس ذلك على مسلك التنظير لمنهج التفسير؛ بحيث إنّ مجموعة من المصنّفات العامة والخاصّة تولّت بسط النظر في مقومات منهج بنائية القرآن، من خلال تناول الصِّلات بين السور أو بين الآيات في المصحف، إِذْ قد نشأت عن ذلك جملة مباحث ذات أبعاد منهجية صريحة، كمبحث المناسبة والتناسب، وتحديد طبيعة الصِّلَة بين اللفظ والمعنى. ومن جملة المصنفات العامة، نذكر مختلف مصنفات علوم القرآن؛ كالإتقان للسيوطي، والبرهان للزركشي، فضلًا عن تفسير الرازي الذي أَوْلى مبحث المناسبة اهتمامًا خاصًّا وغيره.
علاوة على المصنفات العامة التي تشمل عليها العديد من العلوم الإسلامية الأصيلة ذات الصِّلَة المباشرة أو غير المباشرة بالقرآن كونها متداخلة متكاملة منهجيًّا ومعرفيًّا، وجدت مصنفات خاصّة اقتصرت على تناول مبحث التناسب خصوصًا دون غيره، ونذكر منها: نظم الدرر في تناسُب الآيات والسور للبقاعي، تناسُق الدرر في تناسُب السور للسيوطي، البرهان في ترتيب سور القرآن لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي.
وفي الزمن التأويلي الحديث والمعاصر وجد بعض الأعلام الذين قصروا النظر بوجه أو بآخر على تناول بنائية القرآن التوقيفية الترتيبية في المصحف؛ سواء على مستوى تأسيس المنهج، أو على مستوى التفسير والبيان، أو المزاوجة بين ذلك، ومن مؤلَّفات هؤلاء النظّار نذكر: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم لمحمد عبد الله دراز، التصوير الفنّي في القرآن، ومشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب، فضلًا عن تفسيره، التفسير البياني للقرآن لعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، وبعض كتابات فاضل صالح السامرائي، ككتاب: أسئلة بيانية في القرآن الكريم، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، على طريق التفسير البياني، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني.
كون السياق ليس مقتصرًا على حشد المؤلَّفات وحشر المصنّفات التي لها صِلَة بما نحن بصدد الحديث عنه، وإن كان هذا مهمًّا في سياق البحث عن رَصْد التطوّر المنهجي كمًّا وكيفًا في الموضوع، وإنما يتعلّق بسَوْق بعض ما يدلّ على اهتمام المتقدّمين والمتأخّرين ببنائية القرآن التوقيفية، ليس باعتبارها من فضائل القرآن قصرًا، وإنما لكونها تؤسّس لمنهج القراءة. ولتبيان هذا الأمر نسوق بعض النصوص للدلالة عليه، ومنها:
1. يقول ابن العربي في سياق بيان إمكانية أن تكون عبارة: (الشيخ والشيخة إذا زنيَا فارجموهما ألبتة)، من القرآن: «وهمٌ: قال بعض الناس: (الحَبْس) منسوخ بآية الرجم، ثم نُسخت آية الرجم لفظًا وبقي حكمها علمًا، رُوي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لكتبتُ على حاشية المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، فإنّا قرأناها على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. تنبيه: قد بينّا أن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد في ذاته ولا يثبت به غيره، فلا وجه للتعلق به؛ إذ طريق القرآن النقل المتواتر، به صحّت المعجزة وقامت لله الحُجة»[3].
2.يقول الشاطبي في سياق بيان منهج النظر في القرآن: «المدني من السور ينبغي أن يكون منزَّلًا في الفهم على المكّي. وكذلك المكّي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل، وإلا لم يصحّ. والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في الغالب مبنيّ على المكّي، كما أنّ المتأخّر من كلّ واحد منهما مبنيّ على متقدّمِه، دلّ على ذلك الاستقراء؛ وذلك إنما يكون ببيان مجمل، أو تخصيص عموم، أو تقييد مطلق، أو تفصيل ما لم يفصل، أو تكميل ما لم يظهر تكميله»[4].
3. يقول السيوطي في سياق بيان الاختلاف بين مصحف أُبيّ وابن مسعود -رضي الله عنهما-: «إنّ القرآن وقع فيه النسخ كثيرًا للرسم، حتى لسور كاملة، وآيات كثيرة، فلا بدع أن يكون الترتيب العثماني هو الذي استقرّ في العرضة الأخيرة، كالقراءات في المصحف، ولم يبلغ ذلك أُبيًّا وابن مسعود، كما لم يبلغهما نَسخ ما وضعاه في مصاحفهما من القراءات التي تخالف المصحف العثماني؛ ولذلك كتب أُبَيٌّ في المصحف سورة الحفَد، والخُلْع، وهما منسوختان. فالحاصل أنِّي أقول: ترتيب كلّ المصاحف بتوقيف، واستقرّ التوقيف في العرضة الأخيرة على القراءات العثمانية، ورتّب أولئك على ما كان عندهم، ولم يبلغهم ما استقرّ، كما كتبوا القراءات المنسوخة المثبتة في مصاحفهم بتوقيف، واستقرّ التوقيف في العرضة الأخيرة على القراءات المنسوخات، ولم يبلغهم النَّسْخ»[5].
إذا كان الأمر كما سلف القول، فهل منهج التفسير في تاريخه كما اشتغل عليه النظّار تقيّد في التأسيس بوحدة بنائية القرآن التوفيقية مع تعضيدها بجملة محدّدات منهجية صريحة منبثقة عن أصل خصوصية القرآن انبثاق أحكام الفروع عن أحكام الأصول في النظر الأصولي والفقهي، كخصيصة الإحكام والحفظ من التحريف والتصديق والهيمنة والتعالي عن الحيثيات التاريخية ونحو ذلك، أم أنّ ذلك إن لم يغيّب كليًّا على مستوى الاحتكام إليه في تأسيس المنهج، فهو على الأقلّ كانت معياريته المنهجية محدودة؟
مجموعة من الأعلام -كمحمد أبو القاسم وغيره كما تأتي الإشارة إلى بعض ذلك في المحور الثاني- ترجّح لديهم أنّ الاحتكام إلى ذلك لم يكن بصورة مؤسّسة محكّمة، بدليل أنها تقتضي حصر النظر في كلية وحدة القرآن ليكون الجانب المنهجي والجانب المعرفي منبثقين عن ذلك؛ إِذْ قد ساد النظر في سياقات تأسيس منهج التفسير الاحتكام إلى ما هو خارج عن كلية وحدة القرآن، خصوصًا على مستوى الاعتماد على مجموعة من المداخل المنهجية التي وإن استند في تأسيسها إلى القرآن إلا أنّ استواءها تحقّق خارج تلك الوحدة، بل إنّ جملة من الإشكالات المنهجية التي انبثقت عن النظر في عدّة من مداخل التفسير المعتمدة في التفسير التراثي أسقطت على القرآن، فحكم بها من باب إحكام حكم الفرع بحكم الأصل كما يأتي التمثيل في المحور الثالث، مما عدّ صورة من صور تغييب الاحتكام لبنائية القرآن التوقيفية، بل تغييب بعض المقتضيات المنهجية للأصل المرجعي؛ وهو أصل خصوصية القرآن.
وقد عدّ ذلك باعثًا موضوعيًّا من أجل إعادة تأسيس منهج القراءة احتكامًا لما غيّب في منظور التفسير التراثي. وقبل بيان منظور محمد أبو القاسم، نمهّد لذلك ببعض نصوص الأعلام الذين اعتبروا أنّ عدم الاحتكام لما غيّب في التفسير التراثي مما له صلة بأصل خصوصية القرآن، إن لم يوجب إعادة التأسيس الجذري، فهو على الأقل يقضي بضرورة ربط تأسيس منهج القراءة بذلك، ومن تلك النصوص نسوق النصّين الآتيين:
1. يقول سيّد قطب في سياق بيان (منبع السحر في القرآن): «لا بدّ إذن أنّ السحر الذي عنَاه كان كامنًا في مظهر آخر غير التشريع والغيبيات والعلوم الكونية. لا بدّ أنه كامنٌ في صميم النسق القرآني ذاته»، المتمثل في «التصوير الفني»[6]. بعض النصوص التفسيرية وإن اجتهد أربابها في العثور على ما يدلّ على التناسق في القرآن، من خلال رصد بعض صور الترابط المعنوي، مع التمحّل الشديد في ذلك، لم يهتدوا للوصول إلى (القاعدة الشاملة)، بالنظر إلى أن (العقلية الجزئية) كانت مهيمنة وموجهة[7].
2. يقول محمد عبد الله دراز في سياق الاستدلال على أنّ القرآن ليس فيه «كلمة مُقحمة ولا حرف زائد زيادة معنوية: دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها (مقحمة) وفي بعض حروفه إنها (زائدة) زيادة معنوية. ودع عنك قول الذي يستخف كلمة (التأكيد) فيرمي بها في كلّ موطن يظنّ فيه الزيادة، لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح لتأكيده أو لا تكون، ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به... فإنّ الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل -مستورًا أو مكشوفًا- بدقّة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن»[8].
وعليه؛ فليس السياق متعلقًا بنقد وتصويب منظور التفسير التراثي في كُلّيته أو في بعض جزئياته المنهجية، وإنما التدليل على أنّ بعض مناحي النظر المنهجي التي قام عليها اعتبرت منتقدة من باب كونها لا تتجانس مع أصل خصوصية القرآن عمومًا، أو بعض مصاديق ذلك الأصل، خصوصًا ما تعلّق بما اعتمده محمد أبو القاسم في إعادة تأسيس منهج القراءة، والذي جعل مداره الاحتكام لبنائية القرآن التوقيفية الترتيبية في المصحف؛ سواء كان إثبات التنافي وعدم التجانس ظاهرًا أو محتملًا بحسب ما يستند إليه الناظر في اجتهادات منظور التفسير التراثي من شواهد دالة على ذلك التغييب وعدم الاحتكام.
وإذا ثبت أنّ بعض مناحي النظر في التفسير التراثي لم تحتكم في تأسيس منهج التفسير إلى ذلك الأصل الكلّي بصورة مرجعية معيارية، المتمثل في أصل خصوصية القرآن، أو ما يمكن أن ينبثق عنه، خصوصًا الاحتكام لبنائية القرآن التوقيفية في المصحف، فكيف تتحقق إعادة تأسيس منهج القراءة احتكامًا لذلك من منظور محمد أبو القاسم، فضلًا عن غيره من الأعلام الذين تقاطعوا معه في ذلك بصورة أصلية أو تبعية، تفصيلية أو مجملة؟
المحور الثاني: المقومات المنهجية المرجعية لوحدة بنائية القرآن التوقيفية:
محمد أبو القاسم مثله مثل بعض أعلام إعادة قراءة القرآن في الزمن التأويلي المعاصر الذين انطلقوا في تحقيق ذلك من مسلَّمة كلية؛ وهي أنّ إعادة كشف وتحديد بعض دلالات آيات القرآن لا يتمّ بدون تأسيس منهجي أصيل، بعلّة تبعية محصول القراءة للمنهج المؤسّس، وإلا أفضى النظر بأسره -إذا كان من غير تأسيس منهجي جديد- إلى إعادة المعاد وتكرار المكرور، ما عدا ما تعلّق بالجمع والشرح تارة، والتنسيق والتدقيق والتحقيق تارة ثانية، والترجيح وفق معايير محدّدة تارة ثالثة، وإبداء جملة مَلاحِظ منهجية ومعرفية معززة أو مصححة في علاقة المتقدم بالمتأخّر زمانيًّا تارة رابعة، باعتبار ذلك كلّه محكومًا بمنهج مرجعي واحد، وهذا إن كان من دواعي التأليف بلا ريب، إلا أنه يبقى منصهرًا في الأفق الكلي لمنهج القراءة السابق، الذي يؤول -بعد تثبيت محصوله- إلى مرجع أصلي معياري حاكم للقراءة والتفسير.
اعتبار أنّ منظور التفسير التراثي اكتنفته بعض الاعتلالات المنهجية، خصوصًا في علاقتها بأصل خصوصية القرآن وما يمكن أن ينبثق عنه، والتنصيص على أن الصِّلَة وثيقة بين المنهج ومحصوله، فإنّ محمد أبو القاسم سوّغ الركون إلى إعادة التأسيس احتكامًا لذلك الأصل الكلّي، الذي يتمثل في الاحتكام لكلية وحدة القرآن البنائية الترتيبية التوقيفية في المصحف. مع العلم أنه وإن ابتغى بذلك ضبط منهج القراءة بمرجعية القرآن المعيارية، فإنه -من باب المقارنة- ليس هو الوحيد من أعلام إعادة القراءة الذين ركنوا إلى ذلك؛ إذ يندرج فيه -وبنفس منحى محمد أبو القاسم بوجهٍ ما- مجموعة من الأعلام، ومنهم: طه جابر العلواني، وفضل الرحمن مالك، وعدنان الرفاعي، وأبو يعرب المرزوقي، وأحمد عبادي، وغيرهم. وبالنظر إلى أنّ المشاركة متعلقة باجتهاد محمد أبو القاسم، وأنّ إمكانها لا يسمح بتناول مقاربات غيره على جهة التفصيل، إلا أن المقتضى المنهجي في تعلقه بالمقارنة يوجب الإشارة إلى غيره ولو من باب الإجمال؛ لتبيان المنحى الكلّي في إعادة تأسيس منهج القراءة بالاحتكام لِما احتكم إليه.
مدار النظر في مقاربة فضل الرحمن مالك أنه جعل مرجعية القرآن -بوصفه وحدة كلية- أساس بناء نظرية تفسير القرآن. ولتحقيق ذلك، يتعيّن أن يكون تأسس المنهج على (أساس القرآن)، الأمر الذي لا يوجب السعي لإعادة التركيب والتجديد من داخل منظور التفسير التراثي، وإنما الاجتهاد من أجل إعادة التأسيس من جديد على ذلك الأساس[9]. وفي سياق رصد البواعث الموضوعية لإعادة تأسيس منهج التفسير على أساس وحدة القرآن يقول فضل الرحمن: «نتج عن الافتقار إلى منهجٍ صالحٍ لفهم القرآن نفسه»؛ بحيث -على سبيل التحقيق- «كان ثمة إخفاق عامّ في فهم وحدة القرآن، تضافر مع إلحاحٍ عملي على التركيز على ألفاظ شتى للآيات، وقد أخذت معزولة بعضها عن بعض، وكان من نتيجة هذه المحاولة الذرّية أن الشرائع غالبًا ما كانت تستنبط من نصوص آيات لم تكن في حدّ ذاتها آيات تشريعية»[10].
إذا كان النظرُ في القرآن بوصفه وحدة غائبًا مغيّـبًا في منظور التفسير التراثي كليًّا أو جزئيًّا، فقد كانت -في مقابل ذلك- محاولات عدّة لفهمه على ذلك الأساس الأصلي المغيّب؛ وهو ما قام به بعض الفلاسفة والمتصوّفة، إلا أنّ الاختلال المنهجي الذي سيّجَ تلك المحاولات من منظور فضل الرحمن، هو «أنّ هذه الوحدة إنما فرضت على القرآن (وعلى الإسلام عمومًا) من خارجه، بدلًا أن تترتب على دراسة القرآن نفسه»؛ بحيث كانت غريبة عنه وليست متوافقة معه، باعتبار الهيكل الأساسي للأفكار «لم يكن مستخلصًا من داخل القرآن نفسه»، الأمر الذي قوّى نزعة «التعاطي البرّاني مع القرآن»، أو «التفسيرات ذات البُعد الذاتي»[11]. والتسليم بكون محاولات «دراسة القرآن كوحدة في ذاتها» لم تكن بالمنهج والعدد الكافي في تاريخ الفكر الإسلامي، تعيّن قصر النظر على ما غيّب من أجل إعادة التأسيس؛ بحيث يتعين النظر في «مضامين التعاليم القرآنية» بوصفها وحدة كلية بـ«شكل يجعل من كلِّ معنى معيَّنٍ مفهومٍ، ومن كلّ قانونٍ مذكورٍ، ومن كلّ غايةٍ مصوغةٍ =أمرًا متماسكًا مع البقية»[12].
منظور فضل الرحمن -في كليته- بقدر كونه يستند في إعادة تأسيس منهج قراءة القراءة على نقد منظور التفسير التراثي بعلّة أنه لم يتعامل مع القرآن على أساس كونه وحدة، بقدر ما أنه يبتغي أن يكون منهج إعادة القراءة نسقيًّا من داخل القرآن وعلى أساسه. وتأسيس منهج القراءة على ذلك الأساس، خصوصًا وأن القرآن وحدة عضوية متداخلة متكاملة، هو نفسه سياق منظور أبي يعرب المرزوقي الساعي لاكتشاف نسقية القرآن المرجعية؛ بحيث تُحْكَم فيها الجزئيات بالكليات والفروع بالأصول بصورة متكاملة لا تضارب بينها ولا تعارض؛ وهو الذي جعله ينصّ في سياق بيان إحدى المسلَّمات المنهجية على «أنّ القرآن الكريم وحدة لا تتجزّأ، ويمكن أن نثبت أن هذه الوحدة توجد في كلّ آية من آياته؛ فتكون كلّ آية متضمّنة لكلّ القرآن، الذي تدلّ عليه بموضعها»[13]. وبهذا المنهج، يصير القرآن مكتفيًا بذاته على مستوى بيان دلالاته، وذلك لـ«تضمّنه شروط فهمه: فعلاقة الجزء بالكلّ وعلاقة الجزئي بالكلي؛ لأنه بعضٌ من كلٍّ وعيّنةٌ من كليّ تجعلانه منظومة من المعطيات القابلة للتحليل العقلي الموصل إلى علمٍ اجتهادي نظيرٍ لعلم الكون، بل وأفضل منه وأكثر يقينية»[14].
إذا كان القصد من إعادة قراءة القرآن من داخل القرآن وعلى أساسه تحقيق نسقية منهج النظر كما هو ظاهر في منظور فضل الرحمن، وكذا أبو يعرب المرزوقي، باعتبار أن علمية المنهج متوقفة على ذلك توقف الجزاء على تحقق الشرط، فإنّ منظور طه جابر العلواني بقدر كونه يتقاطع مع ذلك، فهو يتطابق مع منظور محمد أبو القاسم؛ بحيث إنّ العلواني جعل مادة تأسيس منهج القرآن (مدخل الوحدة البنائية للقرآن)، وهو يدلّ على أنّ القرآن وإن كان -في الأصل- مجموعة آيات وسور وموضوعات متعدّدة إلا أنها متداخلة محتفّة في كليتها بوحدة بنائية ناظمة، جعلت منه كالكلمة الواحدة تمامًا في وحدتها وتجانسها وتناسقها. لذا، فإنّ تحقيق النظر في هذه الوحدة يتوقف على كشف الروابط والعلاقات بين الآيات والسور في المصحف بصورة كلية لغويًّا ودلاليًّا[15]. وبهذا، يتقرر أنّ القرآن «كتاب واحد في بنائه ووحدته العضوية، وكلّ مفردة من مفرداته محفوظة بهذه الوحدة البنائية»[16].
وبهذا المدخل التأسيسي للمنهج، نتفادى أضربًا عديدة من القراءات غير المنهجية؛ كالقراءة الانتقائية، القائمة على تكريس مفهوم الثنائيات المتقابلة المترافعة، وكذا القراءة التجزيئية، والقراءة المؤدلجة، والقراءة العقلية السكونية، وغير ذلك[17]. وفي سياق تجاوز آثار الضرب الأول من القراءة احتكامًا لوحدة بنائية القرآن كونه المعتمَد في تجاوز بعض المزالق المنهجية؛ كادّعاء تحقق التعارض بين آيات القرآن، يقول العلواني: «من الـمُحال أن يقع في القرآن تضارب أو اختلاف أو نسخ أو تعارض، وأنّ كلماته، بل حروفه، لا يمكن أن تكون ميدانًا للتأويلات الشاذة المتضاربة، إذا تُلي حقّ تلاوته، فمفرداته منضبطة في دلالاتها انضباط النجوم في مواقعها من السماء»[18].
لا شكّ أن هذه المنظورات الثلاثة التي سقناها من باب الإجمال والتمثيل وغيرها مما لا يسمح المقام بتناوله، فهي بقدر كونها رامت تأسيس منهج قراءة القرآن تحريرًا له من بعض الأعطاب المنهجية في تاريخ التفسير، بقدر كونها متقاطعة على مستوى جعل أصل تأسيس منهج القراءة كلية وحدة القرآن. ولا مرية أنّ هذا المنحى -في كليته- معتبر بصرف النظر عن صلته بمنظور التفسير التراثي؛ إِذْ يجعل مدار ومادة تأسيس المنهج ذلك الأصل الكلي، الذي له جدواه وآثاره بلا منازعة كما يأتي البيان في لاحق هذه المشاركة. والسؤال الواجب الوضع في هذا السياق: هل اشتغال محمد أبو القاسم بوحدة القرآن البنائية الترتيبية التوقيفية في المصحف ينتظم في هذا الإطار الكلي، أو أنه وإن انتظم فيه يتفرد عنه؛ سواء تعلق التفرد بإحكام تأسيس منهج القراءة اعتمادًا على وحدة القرآن البنائية، أو بجعلها معيارية في التعامل مع بعض الأنظار التي رامت التأسيس المنهجي، أو تعلّق التفرد بجملة من آثارها في التعامل مع بعض القضايا والمسائل المنهجية المتّصلة بالقرآن، فضلًا عن إعادة تفسير بعض آيات القرآن؟
عموم ما يتحدّد به منظور اجتهاد محمد أبو القاسم من حيث المنطلق الكلي، أنه جعل مدار إعادة تأسيس منهج القراءة يقوم على ذلك الأصل، ليس باعتباره من ضوابط القراءة، وإنما باعتباره مرجعًا معياريًّا محكّمًا مؤسسًا؛ كونه المرجع الكلي المحقّق لعلمية ونسقية منهج القراءة من جهة، والذي يؤول إلى تخليص القرآن من مناحي الإسقاط وتحريره من جملة التاريخيات التي أثقلته ووجهته دلاليًّا نحو مسارات بعيدة عن خصوصيته؛ سواء الثابتة في المصحف أو دلالاته التابعة لذلك من جهة أخرى.
كون المنهجية الحاضنة أساس تحقيق المقاربة المرجعية، فإنّ محمد أبو القاسم ينزل مفهوم المنهجية المنبثقة عن ذلك الأصل منزلة القانون المرجعي الكلي الحاضن لجزئيات وفروع شتى، باعتبار أن أثر المنهجية يتجلى في أنها (تقنّن الفكر)؛ ليتجرّد عن التأملات العابرة والأنظار التجزيئية الذرّية غير ذات جذب تنظيري حاضن. وتماثل عملية (تقنين الأفكار بالمنهج)، (حالة توليد القوانين من الطبيعة). وكون المنهج ينتج احتكامًا لقانون حاضن منظّم، تكون مختلف إنتاجاته الفكرية والمعرفية من جنسه. فمَن فقَدَ قانون المنهج في النظر آلَ الأمر به إلى إنتاج معرفي غير تأسيسي، إذًا لا تأسيس علمي بدون قانون منهج حاضن؛ لذا، تكون خلاصة المنهج أنه قانون نظري محكوم بإطار مرجعي. في سياق بيان معيار النظر في وضع منهج القراءة يقول أبو القاسم: «المنهجية ناظم مقنّن لإنتاج الأفكار ذات النسق الواحد، فكلّ فِكْر تتعدّد مقولاته وتتضارب، إنما هو فكر غير منهجي، ولو التزم في إنتاجه الذهني بإطار مرجعي أرقى منه»[19].
المنهجية بهذا التحديد تمكّن الناظر في آيات القرآن من التغلّب على العديد من الإشكالات المتناثرة المتقابلة ترافعًا، التي أنهكت النظر في مجموع التراث التفسيري كما تأتي الإشارة إلى بعض ذلك في المحور الثالث، باعتبار أنها نشأت عن غياب «البناء المفاهيمي ضِمن أطر منهجية» كلية نسقية، القائم على ردّ الكثرة إلى الوحدة المرجعية، من باب ردّ الفروع للأصول، والمتشابهات للمحكمات، وهيمنَت عليها -تبعًا لذلك- آفة الأحادية الذرّية التجزيئية في التفكير والنظر، الذي عسر عليها التغلب على ما يظهر من التعارض بين آيات القرآن، فلجأت إلى التوفيق تارة، والترجيح تارة ثانية، والتأويل تارة أخرى، ونحو ذلك، خصوصًا في ساحة شدة صراع التأويلات المتكاثرة[20].
تأسيس منهج القراءة وفق هذا المنحى، بقدر كونه يحتكم لأصل خصوصية القرآن، ككونه محْكَمًا لا اختلاف فيه ولا تعارُض بين آياته دلاليًّا، وكونه محكومًا بهيمنة الأصول على الفروع وردّها إليها، ونحو ذلك، بقدر كونه يجعل القراءة خاضعة للنّسق من داخل وحدة القرآن، وليست تابعة لِما أُحيط بها من خارج. وهذا النظر في التأسيس المنهجي معتدّ به بلا ريب، ليس لكونه مقنّنًا للمنهج فحسب، وإنما لكونه يستجيب لأصل خصوصية القرآن المنهجية.
في نفس هذا السياق الذي يشكّل الإطار المنهجي الذي يركن إليه محمد أبو القاسم، كان لعدة أعلام في مجموع التراث الإسلامي اجتهادات وشذرات في هذا المضمار، نسوق من ذلك نصًّا للشاطبي الذي يقول في سياقبيان منهج التعامل مع آيات القرآن في علاقة بعضها ببعض على جهة التفسير، والقائم على الجمع بين الآيات ذات التعلق الواحد: «فالبيان مقترن بالمبيَّن، فإذا أخذ المبيَّن من غير بيان، صار متشابهًا، وليس بمتشابه في نفسه شرعًا، بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم فضلُّوا عن الصراط المستقيم»[21].
لذا، فإنّ النظر في آيات القرآن وفق منظور المنهجية المرجعية الحاضنة، يعدّ-كما يرى محمد أبو القاسم- نمطًا من أنماط القراءات الجديدة الممكنة في الزمن التأويلي المعاصر، إلا أنه يفضلها جميعًا، ومرجع الأفضلية لا يتعلّق بكونه جديدًا أو قديمًا، حداثيًّا أو تراثيًّا، وإنما يرتدّ إلى الاحتكام لأصل خصوصية القرآن التركيبية كما هي في المصحف، وليس من باب الإخضاع القسري تأويلًا، والتحكم الجدلي تسويغًا، باعتبارها تقوم في حقيقتها على «منطق علمي تحليلي يستند إلى وحدة الكتاب العضوية ولا تتوقف في حدود الاستقراء»[22]. وبهذا فإنّ القراءة المنهجية المعرفية المعاصرة للقرآن بوصفها «إطارًا مرجعيًّا للأفكار موحدة، لا تستخلص علميًّا إلا من إطار موحّد عضويًّا»[23]؛ وهو كامن -أساسًا- في ترتيب المصحف.
كون المنهج بهذه الخصوصية المرجعية، فإن ذلك يرتدّ -تأسيسًا- إلى (بنائية القرآن الحرفية)؛ إِذْ بفضل وحدته العضوية التي تأسست على (الترتيب النبوي) لآيات القرآن في المصحف، فهو (يفتح الطريق أمام القراءة المنهجية المعرفية)، القائمة على ثنائية منهجية مفصلية؛ وهي «النصّ واحد، وقراءاته تختلف»[24]. فكان القرآن بالترتيب التوقيفي (يحمل ضمن وحدته الكتابية العضوية منهجية كاملة)، إلا أنّ هذه المنهجية في تاريخ التفسير لم تتحقق ماهيتها علميًّا تنظيرًا وتطبيقًا، بعلّة أنّ المفسِّرين تعاملوا مع آيات القرآن وأحكامها ومقاصدها بصورة مجزّأة لا بصورة موحّدة[25].
وفق ذلك، فإنّ قراءة وتفسير القرآن بهذه المنهجية المرجعية، تعتبر بديلًا منهجيًّا كونيًّا لكونية القرآن، إِذْ توجد (مسائل عديدة لا تحلّ إلا في إطار المنهجية المعرفية القرآنية)، غير أنّ أهل العقل الإسلامي لا يزالون يركنون إلى منهج التفسير التراثي بعلاته، ولم يَنْتَـبْهُم قلق «فكري ناتج عن الافتقار للمنهجية أو المعرفية، أو الافتقار لاستخدامها في مرجعياته الفكرية»، ما عدا طائفة من المثقفين المتفاعلين مع السقف المعرفي المعاصر، خصوصًا في سياقه الغربي الحداثي[26].
كوننا في الطور العقلي الثالث[27]؛ وهو طور المنهجية والمعرفية بأفق عالمي وباتجاه كوني، فلا يتحقّق تأسيس ما يستجيب لهذا الأفق والاتجاه إلا في رحاب المنهجية المعرفية القرآنية. لذا، فإن علاقتنا بالقرآن بوصفه كتابًا مطلقًا، تكون وفق منظور منهجي معرفي ناظم، قصد استخراج نظامه المنهجي وإطاره المعرفي الكوني؛ بحيث يتم التخلص من أكبر آفة حكمت العقل التفسيري التراثي؛ وهي التعارض بين آياته وموضوعاته، فكان بذلك تاريخيًّا متجاوزًا؛ إذ النظر في القرآن لا يعتبر إلا إذا قام على رؤية منهجية ومعرفية؛ فالرؤية أو الوعي المنهجي الحاكم للنظر في القرآن، يمكّن من اكتشاف منهجه بصورة مبيّنة، كما أنّ الرؤية أو الوعي المعرفي، يترتب عنه اكتشاف نسقه ونظامه المعرفي بصورة محدّدة[28].
إذا كان هذا المسلك الذي ينتهجه أبو القاسم معتبرًا من أكثر من وجه، خصوصًا بالنظر إلى كونه يحصر النظر في بنائية آيات القرآن في المصحف دون أيّ مؤثر منهجي ومعرفي خارجي، فإنّ القصد من ورائه تجاوز بعض اعتلالات منظور من منظورات التفسير؛ وهو التفسير التجزيئي، استنادًا إلى ما أُحيطت به آيات القرآن من منقولات ومأثورات ومفاهيم ومقولات، الأمر الذي جعل دلالات الآيات تابعة لما هو خارجي عن بنائية القرآن في المصحف، مما آلَ إلى كثرة الاختلافات بين المفسِّرين، التي تصل حدّ اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع.
ووفقًا لذلك، يعدّ كشف واكتشاف منهج بناء آيات القرآن تركيبيًّا ودلاليًّا اعتمادًا على النسق الترتيبي في المصحف، من أهم ما يتعيَّن أن يُناط به النظر المؤسّس، احتكامًا لأصل خصوصية القرآن، الأمر الذي يفضي للتخلّص من جملة آفات منهجية ومعرفية، التي تفتقت بسبب التقيد بقراءة وتفسير آيات القرآن من خارج، توسلًا بجملة معينات خارجية محمّلة باعتبارها نشأت وتكوّنت خارج وحدة القرآن، فهي لا تكون إلا محمّلة، مما يترتب عنه توجيه دلالات آيات القرآن نحو مسارات دلالية ومدارات معرفية قد تكون غير مقصودة بالقصد الأصلي، وإنما أُلصقت بها عن طريق التأويل البعيد الغريب تحكّمًا لتقوية المقرّرات المذهبية تارة، أو لإفحام الخصوم والمخالفين تارة أخرى.
لذا، يبقى المدار الأصلي لإعادة تأسيس منهج القراءة متوقّف على الأصل المرجعي في الباب؛ وهو الاحتكام لأصل خصوصية القرآن، باعتباره تنبثق عنه جملة أصول منهجية، تنزل منزلة المعايير المحكمة المؤسّسة، خصوصًا جملة الخصائص التي تنتظم منظور محمد أبو القاسم؛ وهي على وجه التحديد: خصيصة الترتيب التوقيفي، خصيصة الكفاية الذاتية على مستوى البيان والتبيان المبين داخليًّا، خصيصة الإحكام والدقّة في التعبير والاستعمال. وأخذ جملة هذه الخصائص وغيرها، بقدر كونها التي تشكِّل المنهجية المرجعية، بقدر كونها الحضن الأصلي لدلالات آيات القرآن، التي لا تكون بطبيعتها إلا نسقية كلية متعاضدة، لا تجزيئية ذرّية متنافرة.
إنّ التشديد على ضرورة اعتماد هذه الأصول المنهجية المرجعية في إعادة تأسيس منهج القراءة لا يرتدّ إلى كونها مدار حضن منظور محمد أبو القاسم أو غيره، وإنما يرجع الأمر إلى أنه متجانس مع سؤال المشروعية المنهجية، بقطع النظر عن تطبيقاته؛ سواء في اجتهاد محمد أبو القاسم أو غيره قديمًا وحديثًا، باعتبار أن التطبيق قد تكتنفه بعض الاختلالات جزئيًّا، تقلّ تارة وتكثر تارة أخرى، في سياق واحد أو في مجموعة سياقات نظرية أو تطبيقية، خصوصًا لِما يكون المنظور ينحى منحى إعادة التأسيس. والمقاربة المنهجية للمنظور التأسيسي وإن زاوجَت بين الجانب التنظيري والتطبيقي، إلا أنّ مناط الأمر كليات منظور التأسيس، فإن صحّت وسلمَت من الاعتلالات القادحة سلبًا، أو الاعتراضات الكاشفة عن القصور، فما بعدها يكون أثره المنهجي أقلّ، عكس لِما يتصل الأمر بكليات منظور التأسيس. وهذا الأمر عام في دراسة أعلام التأسيس المنهجي في تاريخ الفكر الإسلامي.
ولبلورة هذا المنحى في تأسيس منهج القراءة يركن محمد أبو القاسم لمسلك (الجمع بين القراءتين)، الذي يتبعه غير واحد من الأعلام بصرف النظر عن منحى التعامل في تأسيس منهج القراءة[29]، إلا أنّ أبا القاسم يستعمله في سياق كونه كاشفًا عن منهجية القرآن البنائية باعتبارها تماثل البنائية الكونية؛ بحيث إذا سقط نجم في البناء الكوني، انعكس ذلك اختلالًا على بنائه في كليته، وكذلك إذا سقط حرف في النصّ القرآني ونحوه، اختلّ -أيضًا- البناء في كليته؛ ذلك أن القرآن احتكامًا لأصل خصوصيته، ليس مجرّد آيات ومقاطع مفصول بعضها عن بعض، وإنما هو وحدة عضوية متعاضدة، لا تقبل بطبيعتها التجزئة ولا الفصل بينها، ولا التغييب والإهمال على أيّ أساس، إلا وترَك ذلك آثارًا ظاهرة منهجيًّا ومعرفيًّا[30].
المسوّغ للاستناد على ذلك المسلك الذي يتقيّد به غيره، خصوصًا على مستوى اعتبار دقّة القول كدقّة الخلق[31]، هو بنائية القرآن باعتباره كتابًا مطلقًا محيطًا شاملًا معادلًا موضوعيًّا ومعرفيًّا بمحتوى معانيه ودلالاته للوجود الكوني وحركته ومطلق الإنسان فيه وما يحتويه من متغيرات مكانية وزمانية[32]. لذا، فـ(الجمع بين القراءتين)؛ قراءة القرآن وقراءة الكون، يرجع إلى أن القرآن يعطي ما هو موجود في الكون، والكون يعطي ما هو موجود في القرآن؛ فإذا كان الكون سبعًا من المثاني؛ سبع سماوات وسبع أراضين، فكذلك القرآن. فيكون المرجع الكلّي للانطلاق من منظور (الجمع بين القراءتين)، طلب وإدراك (خصائص القرآن المنهجية والمعرفية)، كما هي ماثلة في بنائية آيات القرآن في المصحف[33].
إذا كانت تلك هي الجدوى المنهجية لمسلك (الجمع بين القراءتين)، خصوصًا وأنه يقوم على التفاعل الجدليّ الحيوي الديناميكي، فإن الإشكال -كما يرى محمد أبو القاسم- أنه قد أسيء وفُهم خطئًا، و(أُخذ في كثير من الأحيان على نحو مخلّ للغاية)؛ وذلك باعتباره يدل على النظر في القرآن والنظر في الواقع، لـ(نكتشف وجود رابط بين القرآن والواقع، لنقول في الختام: إنّ القرآن كوْنٌ مسطور، والواقع كوْنٌ منثور). لذا، فإن من لم «يكتشف في القرآن منهجيته المعرفية، ولم يكتشف في الواقع منهجيته المعرفية، لا يستطيع الجمع بين القراءتين»[34].
مرجع الفهم الخاطئ المضلّل هو الأخذ بالثنائية بين القرآن والكون تقابلًا؛ إذ اعتبر أعلام هذا المسلك من أهل القول بالإعجاز العلمي في القرآن قديمًا حديثًا، أنه يدل على تحديد علامات كونية نستدل بها على كون القرآن وحيًا منزلًا من عند الله[35]. إلا أنّ مسلك (الجمع بين القراءتين) هو في حقيقته نظر جامع بين القراءة الغيبية الوحيانية، أو القراءة بالله بوصفه مصدر الوحي، والقراءة الموضوعية العلمية بوصفه سبحانه خالقًا. و(الجمع بين القراءتين) وفق هذا المنحى القائم على الدمج والاقتران بين القراءتين، بوصفهما قراءة واحدة تدلّ على أنّ مضمون المنهج القرآني الكلي الكوني، لا يرجع إلى الانقسام التام بين الغيب والطبيعة، وإنما هو مسلك في القراءة قائم على القراءة الجدلية وليس القراءة الثنائية، وقراءة في إطلاق وليس في آحادية جبرية كانت أو عبثية، فهي قراءة كونية قرآنية واحدة، مركزها الله[36].
يقول أبو محمد القاسم في سياق بيان ماهية مسلك (الجمع بين القراءتين): «إنّ الجمع بين القراءتين كبحث في العلاقة بين عالمي الغيب والشهادة، والقرآن والكون، هو جمع بين قراءتين بمنطق جدلي وليس ثنائيًّا، وقراءة في إطلاق وليس في متقابلات محدودة». إنّ الجمع بين القراءتين، كونه قائمًا على قراءة جدلية في إطلاق، يؤول إلى أنّ من لم «يكتشف هذه الإطلاقية، ومن لم يتبيَّن مفهوم التفاعل الجدلي، لا يستطيع أن يجمع بين القراءتين»[37].
(الجمع بين القراءتين) باعتباره مسلكًا جديدًا في القراءة، فهو غير مرتهن لِما هو خارج عن كلية القرآن البنائية، ولا علاقة له بما يسمّى (الإعجاز العلمي) في القرآن، الذي حصر فيه خطئًا، باعتبار القرآن منهجية معرفية ورؤية كونية و(ليس مختبر علوم تطبيقية). لذا، (لا يستند إلى علوم تجريبية أو فلسفات وضعية، ليخضع للتعديل)، تبعًا لِما يطرأ من تغييرات ومستجدّات، وإنما هو منظور منهجي يستند إلى رؤية قرآنية كلية[38].
بناءُ مسلك (الجمع بين القراءتين) القائم على الاستيعاب التجاوزي التفاعلي للتدليل على إطلاقية القرآن، فإنه يؤول -على المستوى المنهجي- إلى ترسيخ أسلوب منهجي في النظر قائم على التحليل والتركيب والاكتشاف في إطار الوحدة القرآنية البنائية، وذلك بـ(طرح الجزء في إطار الكلّ)، ولا يتم اللجوء لا إلى التفسير ولا التأويل الإسقاطي؛ سواء كان التأويل تجزيئيًّا تقليديًّا أو كان اتجاه التأويل العصراني- العصرنة، وكذا الابتعاد عن الاتجاهات التأويلية والفلسفية التي تعتمد على «سحب الجزئي على الكلّي»[39]. ومستند ذلك، أنّ مهمة التحليل والتركيب والاكتشاف، ليست هي تأويل القرآن أو عصرنته ضِمن متغيّرات العصر، وإنما تكمن -أساسًا- في اكتشاف منهجيته الكاملة الكامنة في ترتيب الرسول -عليه السلام- لآيات القرآن، بمسوّغ أنّ القرآن بخصوصيته فهو متعالٍ عن أيّ استفاذ في أيّ تجربة تفسيرية تاريخية مهما قيل فيها، كونه يحيط به التعالي المطلق في «كلّ المراحل التطورية التاريخية، ولكنه يمدّ إلى كلّ مرحلة صورتها فيه، وضمن منهجه الكلي»[40].
لذلك، فالفرق شاسع بين المعالجة التفسيرية السائدة والمعالجة التحليلية في المنهج البديل؛ فالأُولى تنظر للقرآن وفق (وعي عقلي مركَّب من الكثرة المتمظهرة دون ناظم يجمعها)؛ إِذْ يكون مدار النظر فيها التعامل مع كثرة الأفكار المجزّأة في السور والآيات، أمّا الثانية فهي (قائمة على وعي علمي ومعرفي معاصر)، احتكامًا في فهمِ القرآن لوحدته المنهجية الحاضنة. وفق هذا، فالمعالجة التحليلية، تضعنا «في مرحلة متقدّمة جدًّا لفهم القرآن»[41].
بناء على ما تقدّم، فكون (الإسلام بحاجة إلى قراءة جديدة تستمدّ من مرجعية القرآن الكونية) -كما يقول أبو القاسم- أمرٌ لا مناص منه، ليس بدعوى الاختلالات التي اكتنفت مناهج التفسير والتأويل في تاريخ التعامل مع آيات القرآن؛ كالمنهج اللاهوتي والوضعي القائمين على الثنائية التقابلية والاستيلاب، ولا بدعوى كون القرآن بمرجعيته المنهجية والمعرفية المستمدّة من وحدة القرآن الكتابية العضوية لم يكن محتكمًا إليه في تأسيس المقاربات فحسب، وإنما بالنظر -أيضًا- إلى أنّ التوظيف المعرفي للمناهج العلمية المعاصرة، كان يتمّ وفق منطق الإقبال والأخذ الكلّي، دون الارتقاء إلى مقام النقد قصد تأسيس ما يستوعبها ويتجاوزها نحو تأسيس بديل كوني، يعتمد مرجعية القرآن الكونية[42].
كون المرجع في النقد والتجاوز والاستيعاب وإعادة تأسيس البديل مرجعية القرآن المتمثلة في وحدته المنهجية والمعرفية الكونية، فاستمرارية القرآن ليست كامنة في آياته فحسب، وإنما متحقّقة ضِمن منهجيته. لذا، يكون المطلوب -منهجيًّا- «اكتشاف المنهج القرآني عبر التفاعل العميق معه، كما نكتشف المنهج الكوني في الحركة الطبيعية»[43]. وهذه الاستمرارية لا تحقّقها المنهجية السائدة في منظورات التفسير، وإنما تتحقّق بواسطة منظور التحليل والاكتشاف الذي يبتغي (الوصول إلى المنهجية القرآنية) الكلية الكونية الحاضنة[44].
بهذا المنظور المنهجي الجديد القائم على التحليل والاكتشاف، في مقابل التفسير والتأويل في التعامل مع القرآن، (نكون أمام اكتشاف جديد لنصّ قديم لم يكشف من قبلُ عن منهجيته) الكلية الكونية، فكلّ ما نجتهد في سبيله هو إعادة فهم القرآن ضِمن منهجيته التركيبية كما هي. يقول في سياق بيان ذلك: «أسلوبنا في اكتشاف تركيبة القرآن المنهجية لا يرجع إلى مناهج علمية أو أدبية جزئية في التحليل، كالتي يعتمدها الباحثون في معالجتهم لظواهر معيّنة، وإنما يعتمد أسلوبنا على جملة الوعي الإنساني، باعتباره قدرة كونية كامنة في الإنسان بحكم منشئه الكوني؛ وهي القدرة الوحيدة التي تقابل صفة القرآن الكونية الشاملة»[45].
كون اجتهاد محمد أبو القاسم يبتغي تجاوز بعض المنظورات السائدة في قراءة آيات القرآن قديمًا وحديثًا، فذلك مردّه إلى معيارية أصل خصوصية القرآن عمومًا، والمتمثلة في بنائية القرآن التوقيفية الترتيبية في المصحف خصوصًا، والتي قضَتْ أن تكون مشروعية منهج القراءة لا تتحقّق بدون تحقّق الانسجام معها بوجه ظاهر. ولا مرية أنّ المحددَيْن اللذَيْن وضعهما محمد أبو القاسم في تحقّق الانسجام؛ وهما: الاعتماد على التحليل والاكتشاف، والركون إلى التجاوز نحو البديل القرآني المنهجي الكوني المتعالي، لهُما من الفاعلية المنهجية الشيء الكثير، خصوصًا على مستوى التقليل من المعينات الخارجية المحملة؛ سواء تلك التي استند إليها بعض إنتاج التفسير التراثي، أو التي يعتمدها بعض أنصار الإعجاز العلمي من أجلِ تبيّن المضامين العلمية في آيات القرآن المتعلقة بالخَلْق، أو التي يعتمدها بعض أعلام إعادة القراءة، خصوصًا ما تعلق بجملة المناهج المتعلقة بعلوم الإنسان والمجتمع، ونحو ذلك.
والتحرّر من آثار المعينات الخارجية المحملة الموجّهة -الذي يُستثنى منها على سبيل القطع البيان النبوي الصحيح- لا يقدح فيها أنها نشأَت خارج وحدة القرآن، وتحكّمَت في تكوّنها وتشكّلها سياقات معرفية محددة قديمًا وحديثًا فحسب، وإنما لِما لها من القدرة على التوجيه الذي يؤول إلى إقحام آيات القرآن في مدارات دلالية ليس مقصودة لا بالقصد الأصلي ولا بالقصد التبعي، فتتقوّى -تبعًا لذلك- منازع التأويل البعيد الغريب، التي تجد فيها نزعاتُ التفسير المذهبي ضالّتَها المنشودة، كونها تفتح بعض آيات القرآن على احتمالات دلالية متعدّدة. وبيان بعض ما يتعلّق بهذا الأمر نتناوله في المحور الثالث على سبيل الختم؛ لذا يبقى مدار الأمر كلّه، اعتبار منهج القراءة لا ينفكّ عن مرجعيته الحاضنة الموجهة.
المحور الثالث: من الآثار المنهجية لبنائية القرآن التوقيفية:
إذا كان اعتبار النظر باعتبار منهجه، فكذلك الاعتداد بالجانب المعرفي متوقّف على اعتبار الجانب المنهجي، كونه تابعًا له تبعية الفرع لأصله، وكون محمد أبو القاسم أقام تأسيس منهج قراءة القرآن على وحدة كليته البنائية التوقيفية الترتيبية في المصحف، فإنّ ذلك وإن كان معتبرًا لا اعتراض عليه، على الأقلّ بعلّة الاحتكام لأصل خصوصية القرآن، فإنّ تمحيص النظر فيه يتحقّق من جملة وجوه، من أبرزها بيان آثاره التي تظهر على المستوى التطبيقي. وقد أعاد النظر في ضوء ذلك الأصل المرجعي في مجموعة ممّا يعدّ مسلَّمات منهجية في منظور التفسير التراثي، إِنْ على سبيل التحقيق والتدقيق، أو على سبيل الرفض وإعادة التأسيس. ولكون إمكان المقالة محدودًا، فإننا نورد مثلًا واحدًا للتدليل على ذلك.
يتعلق هذا المثال بالناسخ والمنسوخ في القرآن؛ بحيث إنّ منظور التفسير التراثي تأسّس عليه باعتباره علمًا من علوم القرآن، لا تتحقّق أهلية المفسّر بدونه. مع العلم أنّ الاختلاف فيه في تاريخ التفسير متحقّق؛ سواء على مستوى تحديد دلالته تبعًا لتعاقُب أزمن التأويل، أو على مستوى الإثبات والنفي، أو على مستوى تحديد الآيات الناسخة من المنسوخة قلةً وكثرةً، أو على مستوى تحقيق النظر في إطلاق القول بالنسخ، وغير ذلك. إلا أنّ ما يلاحظ -في مقابل ذلك- أنّ بعض أعلام إعادة القراءة في الزمن التأويلي المعاصر نَفَوا وجوده في القرآن بصرف النظر عن موجبات ذلك. والأمر لا يقتصر عليهم، بل يشمل -أيضًا- بل أعلام التجديد، كمحمد الغزالي[46]؛ واجتهاد محمد أبو القاسم -في كليته- لا يخرج عن مذهب النفي.
وتقرير النفي قد أقامه أبو القاسم على أصل وحدة القرآن البنائية التوقيفية في المصحف، باعتبار ذلك الأصل المرجعي معياري محكّم، والذي قضى نفي القول بناء على ذلك الأصل، منطلق إقامة القول بالنَّسْخ؛ وهو تحقّق التعارض غير المرفوع بين بعض آيات القرآن ودلالاتها. وقد كان قصد اللجوء إلى إقرار القول بالنسخ إثبات الانسجام الداخلي والاتساق المنهجي بين آيات القرآن في المصحف؛ إِذ القول بالنسخ يجعل آيات القرآن منسجمة متّسقة، وكأنّ القرآن قبل الإقرار بذلك، كان «يفْتقِرُ للاتّسَاق المنهجي»[47]، ولم يتحقّق الانسجام والاتساق بين آياته إلا بالقول بالنَّسْخ. لذا، يكون الاتفاق على القول بالنسخ عند الجمهور، ما هو في حقيقته الباطنة سوى «قول ملطّف بتناقض القرآن»[48].
في هذا السياق يقول محمد أبو القاسم على سبيل القطع: «فليس هناك آية تسقط»، فإذا «سقطت آية أو أسقطت، يسقط الحق كله. وإذا نسخت آيةٌ آيةً أخرى، نسخ الحقّ كله. فليس في القرآن آية ساقطة أو مرفوعة عن التلاوة، وليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ». ومن «ابتدع علم الناسخ والمنسوخ، فقد كان يحاول أن يحلّ مشكلته هو مع القرآن، حين لم يتفهّم منهجية القرآن الرابطة للآيات التي بدت له متضاربة أو متشابهة، أو حتى متناقضة مع بعضها أحيانًا، فأوجد علم الناسخ والمنسوخ الذي لا يعني سوى إقرار حالة التناقض في تركيب القرآن ومضمونه، فظنّ بمجرّد القول أنّ في القرآن ناسخًا ومنسوخًا أن قد حلّ الإشكال، وما أدرك أنّه بذلك قد طعن في الحقّ الذي أنزل القرآن»[49].
وكون منطلق القول بالنسخ غير ثابت في القرآن، فقد ترتّب عنه إعادة النظر في مفهوم النّسخ في القرآن، قصد تحقيق النظر في دلالته بما ينسج مع انسجام واتساق آيات القرآن ودلالاتها؛ وهو ما جعل أبا القاسم يعتبر أنّ إثبات القول بالنسخ ليس داخليًّا بين آيات القرآن، وإنما هو خارجي في صلة القرآن بما سبقه من الكتب المنزلة. يقول في هذا الشأن: «بالرغم من أن بعض المفسرين قد تأوّلوا وجهًا آخر لمعنى (النسخ) باعتباره نسخًا في آيات القرآن الكريم، وليس نسخًا للحالة الإسرائيلية التاريخية ونمطها الديني الحسي، حين ربطنا الآيات ربطًا كليًّا وعضويًّا دون تجزئة السياق». وفق هذا يكون النسخ في حقيقته «تجاوزًا لحالة دينية تاريخية قائمة على المدرك الحسي إلى علاقة قائمة على المدرك الغيبي وقوى الوعي الثلاثي سمعًا وبصرًا وفؤادًا»[50].
والتنصيص على كون النسخ غير متحقّق الوقوع في القرآن بناء على المنطلق الكلي الذي أُقيم عليه، فضلًا عن الاحتكام لأصل خصوصية القرآن، خصوصًا ما تعلّق بالخاتمية والعالمية، فقد ترتّب عنه رفض القول بمجموعة من المرويات التي تُساق في الحديث عن بعض أقسام النسخ؛ سواء تعلّقت بمرويات القول بسقوط بعض آيات القرآن أو رفعها أو تقرير ما نُسخ رواية وبقي حكمًا وغير ذلك، باعتبار أنّ هذا كلية يتنافى مع أصل الحفظ اللإلهيّ للقرآن من جهة، وعدم تجانسه مع بنائية القرآن التوقيفية الثابتة في المصحف الذي بين أيدينا من جهة ثانية[51].
بناء على عموم القول في موضوع النسخ، وبالنظر إلى التطوّر الحاصل في تاريخه، يوجب تحقيق النظر فيه بالاحتكام للأصل خصوصية القرآن عمومًا، والترتيب التوقيفي في المصحف خصوصًا، وليس بالضرورة أن يكون مآل التحقيق وفق مذهب النفي أو الإثبات، وإنما إمعان النظر في مجمل ما أُحيط به هذا الموضوع في تاريخ التفسير وعلوم القرآن احتكامًا لذلك الأصل باعتباره مرجعًا محكّمًا معياريًّا.
والاحتكام لذلك الأصل خصوصًا في تناول الناسخ والمنسوخ في القرآن وإن كان معتمدًا في منظور التفسير التراثي، إلا أنه لم يكن على منوال واحد، بحيث وجد من أعلام منهج التفسير من تقيد بالتحقيق احتكامًا لذلك الأصل، وأخصّ بالذِّكْر ابن العربي[52]. لذا يمكن أن يعدّ أرباب مسلك التحقيق في التفسير التراثي الأصلي والتبعي من أهم المداخل المنهجية لتحرير القول في الناسخ والمنسوخ في القرآن احتكامًا لذلك الأصل، ليس من باب التقيّد ببعض مقتضيات الأصل الذي يركن إليه محمد أبو القاسم والتي لا نزاع فيها، وإنما من باب مراعاة عموم مقتضيات سؤال المشروعية المنهجية في تأسيس منهج القراءة.
وعليه؛ فإن الأمثلة التي يسوقها محمد أبو القاسم وغيره من أعلام إعادة تأسيس منهج القراءة الدالّة على تغييب أصل بنائية القرآن التوقيفية الترتيبية في المصحف كثيرة ومتنوعة، فإنّ الذي ينبغي التأكيد عليه، أنّ الاحتكام في تأسيس منهج القراءة لذلك الأصل الأصيل من شأنه أن يتقرّر في ضوئه أمورٌ عديدة، نورد منها أمرين؛ أولهما: التقليل من الاعتماد على ما هو خارج عن تلك الوحدة. ثانيهما: جعل دلالات مفردات وتراكيب آيات القرآن تتحدّد بناء على تلك الوحدة وليس خارجها بأيّ صورة من الصور. وبهذا يتجاوز مسلك التفسير التجزيئي الذي لا ينفصل عن الاستناد إلى ما هو خارج عن وحدة القرآن، الذي يؤول بأعلامه الأمر إلى الإكثار من المعينات الخارجية المحمّلة والتي لا تنفكّ عن توجيه دلالات آيات القرآن خارج مقتضيات الدلالية لوحدة القرآن الداخلية.
بناء على ما تقدّم، يتبيّن بجلاء أنّ اجتهاد محمد أبو القاسم ليس مجرّد تأسيس نظري منصبّ على إعادة تأسيس منهج قراءة القرآن بناء على أصل خصوصية القرآن عمومًا، وعلى كلية وحدة القرآن البنائية الترتيبية التوقيفية في المصحف، وإنما هو مشفوع بتبيان آثار التأسيس المنهجي؛ بحيث يكون مادة تأسيس منهج إعادة القراءة، معيار رفض ما يتنافى معها، وقبول ما يتجانس معها بوجهٍ ما، وهذا المسلك في النظر إن كان معتدًّا به، ليس بالنظر لكون التأسيس المنهجي المنتقد محكومًا بخواصّ الاجتهاد الإنساني فحسب، وإنما بالنظر إلى ضرورة الاحتكام لأصل خصوصية القرآن في التأسيس المنهجي والمعرفي. ويبقى الاختلاف لا يتعلّق بمنطلق المسلك في كليته وإنما في حدوده؛ ذلك أن منظور التفسير التراثي وإن كان محكومًا بمنهج كلي، إلا أنه على مستوى الجزئيات والفروع محكومٌ بالاختلاف، خصوصًا ما تعلق بالتحقيق والتدقيق في جملة من متعلقات المنهج، وليس الأمر وقفًا على مدخل الناسخ والمنسوخ، أو المعهود اللغوي العربي، أو مرويات أسباب النزول، ومنقولات أهل الكتاب، وإنما يشمل الأمر عدة مداخل منهجية أخرى.
خاتمة:
بعد ختم إمكان القول في المقالة، نسوق بعض النتائج التي أسفر عنها البحث في سياق إعادة تأسيس منهج القراءة من منظور اجتهاد محمد أبو القاسم احتكامًا لأصل خصوصية القرآن عمومًا، ولوحدة القرآن البنائية التوقيفية في المصحف خصوصًا، ومن أهمها ما يأتي:
1. تأسيس منهج القراءة على بنائية الترتيب التوقيفي لآيات القرآن في المصحف ليس وقفًا على اجتهاد محمد أبو القاسم أو غيره من الأعلام المعاصرين، وإنما يضرب بجذوره في تاريخ التفسير منذ الأزمنة الجنينية والتأسيسية، بصرف النظر عن مدى اعتماده كليًّا أو جزئيًّا، أو مدى اعتماد ما يتنافى معه في بعض اجتهادات التفسير.
2. إذا كان ذلك الأصل المنهجي معتمَدًا في تاريخ التفسير بوجهٍ ما، فالأمر يوجب الاستناد إلى إكماله وتطويره، خصوصًا من خلال جملة من المباحث في تاريخ التفسير التي تعدّ مدار النظر في تأسيس منهج القراءة وفق مقتضيات ذلك الأصل، خصوصًا مبحث المناسبة والنَّظْم، إلا أنّ أبا القاسم مثله مثل غيره من أعلام إعادة القراءة وفق مسلك التأسيس الجذري القائم على القطيعة لم يهتدوا بذلك؛ وهو ما نراه يعكس خللًا منهجيًّا صريحًا، خصوصًا أنّ مدار النظر واحد؛ وهو القرآن الحكيم.
3. الأصل الذي أقام عليه أبو القاسم إعادة تأسيس منهج القراءة، يتحدّد وفق عدة مقتضيات، أهمها: أنّ كلية وحدة القرآن البنائية كونها بيان لذاتها بذاتها، وأنّ هذا البيان رهين بنائيّـتها في المصحف استقلالًا دون تبعية، فالأمر يوجب الركون إلى التحديد والاكتشاف وليس التأويل بمختلف أضربه، تحررًا من آثار التأويل، خصوصًا التأويل البعيد أو المفرط القائم على الصرف تسويغًا لمقررات سابقة منهجية كانت أو معرفية.
4. ما يميز اجتهاد محمد أبو القاسم مع العلم أن الأمر ليس مقتصرًا عليها حصرًا، أنْ جعلَ ذلك الأصل؛ سواء في جوانب التأسيس النظري أو التطبيقي، معيارًا محكّمًا؛ بحيث ما تجانس معه قُبِل، وما تنافى معه بوجه صريح رُفِض. وهذا المنحى في النظر إن كان معتدًّا به لا منازعة، إلا أنه في حاجة إلى تحقيق وتدقيق لضبط مداره ومساراته، خصوصًا في صِلة هذا المنحى بمنظور التفسير التراثي، بالنظر إلى كونه متعددًا ومتنوّعًا ومتكوثرًا.
5. وفي آخر القول ندعو أعلام التحقيق إلى تطوير البحث في أمرين أساسيين؛ أولهما: تأسيس النظر في أن يكون أصلُ خصوصية القرآن بمختلف كلياته المنهجية وليس حصرًا على كلية بنائية وحدة القرآن التوقيفية الترتيبية في المصحف =المادةَ الأساسية لتأسيس منهج القراءة. ثانيهما: جعلُ الكليات المنهجية لأصل خصوصية القرآن معيارًا للتعامل مع مختلف الاجتهادات في تاريخ التفسير قديمًا وحديثًا، منهجيًّا ومعرفيًّا؛ بحيث ما تجانس مع ذلك قُبِل، وما تنافى معها رُفِض. ولا يتحقّق الأمران معًا إلا بأن يكون البحث مؤسّسًا وعلميًّا؛ احتكامًا لتكوثر تلك الاجتهادات من جهة، والحدّ من آثار المسبقات من جهة أخرى، كما هو ظاهر في اجتهاد مركز تفسير.
[1]كتاب من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وصدرت طبعته الأولى عام 1436هـ= 2025م.
[2] محمد أبو القاسم حاج حمد (1942- 2004)، مفكر وفيلسوف وسياسي سوداني، غلب على اهتمامه في الجزء الأول من حياته النضال السياسي، خصوصًا ما تعلّق بعموم القضايا الإفريقية والسودانية والإريتيرية، وفي الجزء الثاني منها اهتمّ بالقضايا المنهجية والمعرفية في عموم الحقول الفلسفية والاجتماعية والتاريخية والإستراتيجية. عمل مستشارًا علميًّا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، مؤسّس لمركز الإنماء الثقافي في أبو ظبي، وأسّس في قبرص دار الدينونة لإعداد موسوعة القرآن المنهجية والمعرفية. عموم مؤلَّفات محمد أبو القاسم يمكن تصنيفها ضمن مجموعتين؛ الأولى تتعلق بالجانب السياسي والإستراتيجي في القطر السوداني والإريتيري وعموم القارة الإفريقية، ومنها: أزمة القَرْن الإفريقي وموقعه في إستراتيجية العدوّ الصهيوني، السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقبل، جذور المأزق الأصولي. والثانية تتصل بالإسلام عمومًا والقرآن خصوصًا، وأهمّ كتبه في هذا المجال ما يأتي: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة العالمية الإسلامية الثانية، منهجية القرآن المعرفية، القرآن والمتغيرات الاجتماعية والتاريخية، إبستمولوجية المعرفة الكونية إسلامية المعرفة والمنهج، الحاكمية، تشريعات العائلة في الإسلام، حرية الإنسان في الإسلام. وقد أُنجزت حول اجتهاد محمد أبو القاسم عدة دراسات ومقالات؛ فمن الدراسات نذكر: الإبستمولوجيا الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي: قراءة في مشروع محمد أبو القاسم حاج حمد للحاج أوحمنه دوّاق. ومن جملة المقالات المتعلقة بأوجه من اجتهاده، نذكر ما يأتي: المنهجية المعرفية للقرآن الكريم وبعض تطبيقاتها قراءة في مشروع المفكر محمد أبو القاسم حاج حمد للشايب خليل وحسن برامة، مجلة المعيار، المجلد: 26، العدد: 64، 2022، اللاهوت المادي والبديل الإبستمولوجي عند محمد أبو القاسم حاج حمد، لمحمد قندوز وبوجلال نادية، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، المجلد: 8، العدد: 2، 2023، فضلًا عن ما نشره مركز تفسير.
[3] الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، أبو بكر بن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط:4، 2010، ص90.
[4] الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط:8، 2011، (3/ 304).
[5] تناسق الدرر في تناسب السور، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط:1، 1986، ص60- 61.
[6] التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة- مصر، ط:18، 2006، ص19.
[7] التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، ص 29- 34.
[8] النبأ العظيم؛ نظرات جديدة في القرآن الكريم، محمد عبد الله دراز، دار القلم، الكويت، ط:10، 2008، ص164- 165. انظر أيضًا: تنصيص الطاهر بن عاشور في سياق بيان خواصّ الدلالة في القرآن. المقدمات العشر لتفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، لخضر سالم اليافعي، دار المعراج، دمشق- سورية، ط:1، 2022، ص355- 357.
[9] الإسلام، فضل الرحمن مالك، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت. لبنان، ط:1، 2017، ص390- 392.
[10] الإسلام وضرورة التحديث نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية، محمد فضل الرحمن، دار الساقي، بيروت- لبنان، ط:2، 2015، ص11.
[11] الإسلام وضرورة التحديث نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية، محمد فضل الرحمن، ص12- 16.
[12] الإسلام وضرورة التحديث نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية، محمد فضل الرحمن، ص16.
[13] الجلي في التفسير إستراتيجية القرآن التوحيدية ومنطق السياسة المحمدية، أبو يعرب المرزوقي، الدار المتوسطية للنشر، تونس، ط:1، 2010، (2/ 141- 142).
[14] الجلي في التفسير إستراتيجية القرآن التوحيدية ومنطق السياسة المحمدية، أبو يعرب المرزوقي، (1/ 221).
[15] أفلا يتدبرون القرآن معالم منهجية في التدبر والتدبير، طه جابر العلواني، دار السلام، القاهرة- مصر، ط:1، 2010، ص130- 132.
[16] معالم في المنهج القرآني، طه جابر العلواني، دار السلام، القاهرة- مصر، ط:1، 2010، ص88- 89.
[17] معالم في المنهج القرآني، طه جابر العلواني، ص76- 77، 84- 85. انظر أيضًا: أفلا يتدبرون القرآن معالم منهجية في التدبر والتدبير، طه جابر العلواني، ص92.
[18] معالم في المنهج القرآني، طه جابر العلواني، ص85- 86.
[19] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، دار الهادي، بيروت- لبنان، ط:2، 2008، ص34- 35.
[20] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص70، 235.
[21] الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي، (3/ 67).
[22] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص111- 112.
[23] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص93.
[24] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص94- 96.
[25] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص35.
[26] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص38- 47.
[27] يقسم أبو القاسم منظور اشتغال العقل إلى ثلاثة أطوار، وقد أدرج التفسير التراثي أو الإحيائي أو اللاهوتي في الطور العقلي الثاني، القائم على الثنائيات المتقابلية. انظر: منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص267.
[28] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، دار الهادي، بيروت. لبنان، ط:1، 2004، ص10- 11.
[29] انظر: معالم في المنهج القرآني، طه جابر العلواني، ص84، 89. الوحي والإنسان نحو استئناف التعامل المنهاجي مع الوحي، أحمد العبادي، دار النيل، القاهرة- مصر، ط:1، 2013، ص69- 80.
[30] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص94- 96، 141.
[31] انظر: دراسات إسلامية معاصرة، ج5. تجفيف منابع الإرهاب، محمد شحرور، ص27- 28.
[32] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص93، 177. انظر أيضًا: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص10- 11، 33. الحاكمية، محمد أبو القاسم حاج حمد، دار الساقي، بيروت- لبنان، ط:1، 2010، ص73، 85، 93.
[33] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص178، 250- 251. انظر أيضًا: جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص33.
[34] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص11- 12، 107.
[35] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص260
[36] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص261، 531، 644، 654. انظر أيضًا: الحاكمية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص87- 88.
[37] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص260.
[38] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص110.
[39] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص45، 252، 653.
[40] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص399.
[41] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص655- 656.
[42] الحاكمية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص141.
[43] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص653.
[44] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص638- 639.
[45] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص636.
[46] انظر: نظرات في القرآن، محمد الغزالي، ص194، 211. الحق المطلق، عدنان الرفاعي، ص405- 486.
[47] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص35.
[48] دينامية النص، محمد مفتاح، ص200.
[49] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص95.
[50] جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص268.
[51] منهجية القرآن المعرفية أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية، محمد أبو القاسم حاج حمد، ص102- 105.
[52] انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، أبو بكر بن العربي، ص100- 101.