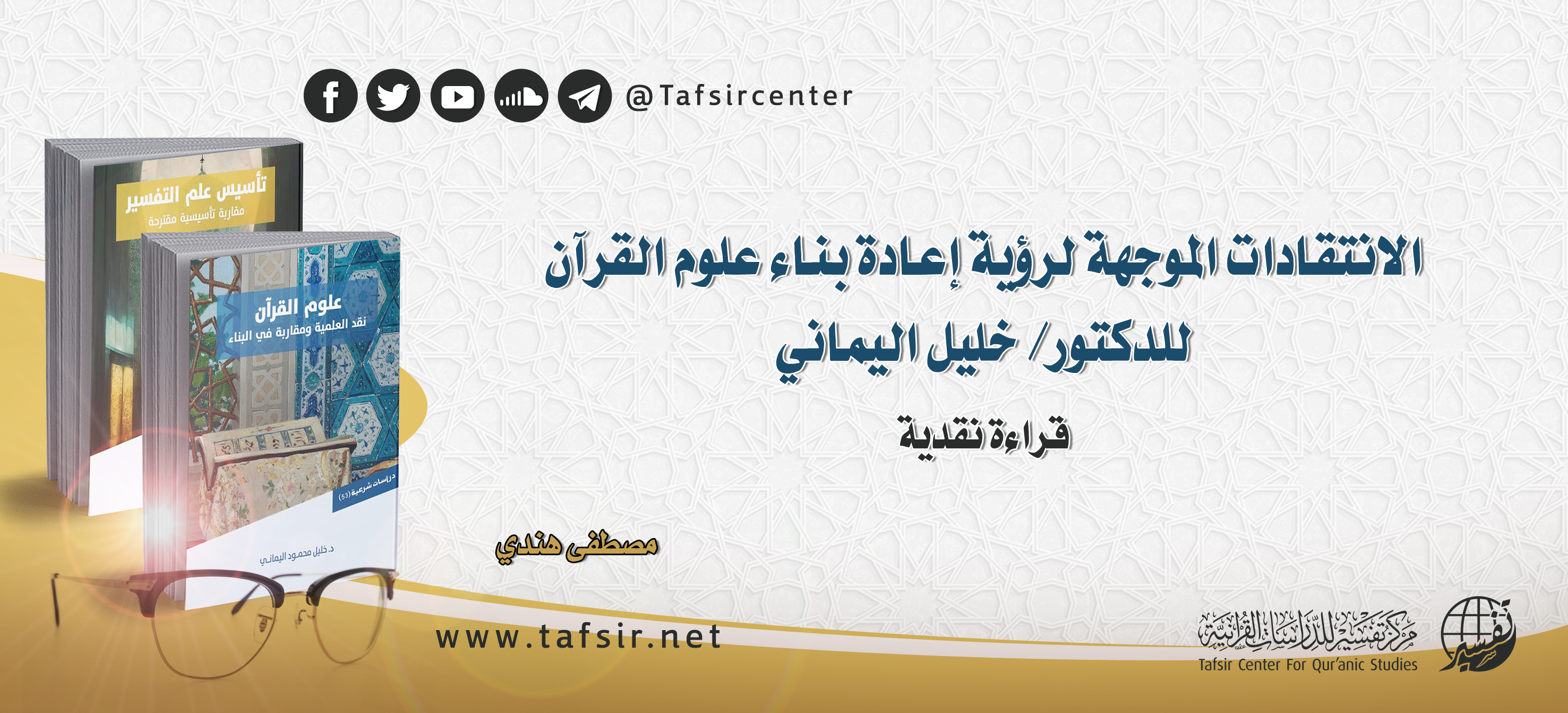قراءة في كتاب (البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، وأثرها في الدراسات البلاغية) تأليف: أ.د/ محمد محمد أبو موسى
(البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، وأثرها في الدراسات البلاغية)
تأليف: أ.د/ محمد محمد أبو موسى
الكاتب: محمد مصطفى قناوي

تمهيد:
أنزل اللهُ القرآنَ على قومٍ ذوي بيان، «رأَى ألسنتَهم تقود أرواحَهم، فقادَهم من ألسنتِهم»[1]، ثم دَرَسَ هذا الحسُّ البيانيُّ الذي كانت تُفزِعُه الإشارة وتثيره اللمحة دروسَ الأطلال، فقيّد اللهُ ببركة هذا القرآن وبحفظه له رجالًا يجمعون علوم هذا الكتاب، ويحفظون كلّ ما يمدُّ إليه بسبب، فكان جمعهم لهذه العلوم وبحثهم وصبرهم على استخراج مكنونها =وقوفًا صادقًا على أطلال هذا الحسّ البياني الأوّل، وقوفًا لا بكاء فيه وإنما إحياء -بقدر ما يفتح الله به عليهم- يحفظون به بيان القرآن. فكان من آثار ذلك علم البلاغة الذي نشأ في كنف قضية إعجاز القرآن، فكانت المحاولة الجادّة في تبيان أصوله، وتعليل أحكامه على يد الإمام عبد القاهر الجرجاني وليدة صراع حول ماهية الإعجاز وسرّه، إلا أن الدرس الذي وضع عبد القاهر معالمه، والأصول التي ألمح إليها لم تسرْ سيرتها المأمولة، فجاء على البلاغة ما أوجب أن يعاد النظر فيه مرة أخرى، وذلك بمتابعة السير العلمي ومعرفة ما ينقص فيزاد، وما خرج عن مهيعه فيردّ، وذلك شأن كلّ علمٍ فيه جهد إنساني، لا جرَم قد اعترضه بعض النقص وليس ذلك بقادحٍ فيه، وإنما يقدح في العقول التي تتغنى بالنقص ولا تستفرغ الوسع في إكماله.
ولا يكون إعادة النظر على الطريقة التي يسميها الشيخ أبو موسى «طريقة الروّاد»، وهي التبرؤ من علومنا وأصولنا في النظر وتأسيس المعرفة حتى ننال شهرة الروّاد!
وكانت إحدى إشكاليات الدرس البلاغي هي إغفال الميدان الحقيقي لها، وهو ميدان التطبيق والتذوّق، فإنها ولعت في طورها الأخير الذي استقرّت عليه بتقرير القواعد مجرّدة عن مثالٍ فيه ديباجة ورونق، فسرِّحْ بصرك في كتب الفنّ التي على هذه الصورة -مبسوطة كانت أو مختصرة- تجد المثال واحدًا بفصّه ونصّه، بل يُساق بخلافاته دون أدنى محاولة لاختيار شاهدٍ آخر يسلم من المؤاخذة، ناهيك عما أُرهقت به من تقريراتٍ جافة، إن أنت فتّشت عنها في النصوص الأدبية ما ظفرت إلا بحسرة. فكانت العناية -مثلًا- بالحدود المنطقية ومناقشة إشكالات الحمل، ومحاولة الجمع بين مذهب الحكماء ومذهب المتكلمين، وغير ذلك من التقريرات =شاغلةً عن أمورٍ هي أجدر بالبحث والتنقيب ومحاولة الفهم.
وقد يخيّل إليك أن علماء البلاغة آنذاك كانوا في غفلة عن هذا الأمر، وهذا خطأ؛ فإنك لن تعدم منهم ما يشير إلى أن تلك التقسيمات غير حاصرة، وأن تلك التفريعات غير مجدية، وأن هذه التعريفات أشبه بعلوم الحكمة منها بعلوم البلاغة[2]. ومن خير ذلك ما قاله الإمام السعد التفتازاني -رحمه الله- بعد أن شرح بعض تقسيمات وجه الشبه: «واعلم أنّ أمثال هذه التقسيمات -التي لا تتفرع على أقسامها أحكام متفاوتة- قليلة الجدوى. وكأنّ هذا ابتهاج من السكاكي باطّلاعه على اصطلاحات المتكلمين، فلله در الإمام عبد القاهر وإحاطته بأسرار كلام العرب، وخواص تراكيب البلغاء؛ فإنه لم يزد في هذا المقام على التكثير من أمثلة أنواع التشبيهات، وتحقيق اللطائف المودعة فيها»[3].
وكقوله أيضًا -رحمه الله- في ديباجة شرحه المختصر: «...وأنّ هذا الفنّ قد نضب اليوم ماؤه فصار جدالًا بلا أثر، وذهب رواؤه فعاد خلافًا بلا ثمر، حتى طارت بقية آثار السّلف أدراجَ الرياح، وسالت بأعناق مطايا تلك الأحاديثِ البِطاحُ»[4].
ويقول العصام الإسفراييني في شرحه على تلخيص المفتاح عن باب الإنشاء وما حواه: «وها هنا بحثٌ شريفٌ خفيٌّ عن البصائر؛ لأنه لطيف، وهو أنه ليس شيءٌ مما ذكر ويُذكر من مباحث الاستفهام ممّا يتعلق بفنّ المعاني، فإن حقائقه وظائف لغوية، ومجازاته من مباحث البيان وفروع قواعد المجاز، نعم إنه يتفرّع على حقائقه مزايا تتوقف معرفتها على معرفة الحقائق، لكن لم يذكر شيئًا منها [أي صاحب التلخيص]»[5].
ثم كانت محاولات التجديد بعد ذلك منطلقاتها متعدّدة، ومشاربها متحدة تارة ومتنافرة، وكان من ضمن هذه المحاولات كتابنا الذي بين أيدينا، فقد رأى الدكتور/ محمد محمد أبو موسى[6] -حفظه الله- هذه الإشكالية، فأحبّ أن يحيي هذه البلاغة ويعيد إليها رواءها بالورود على منابعها الأصيلة، ولا شك أن تفسير الزمخشري خير تلك المنابع؛ لما فيه من التطبيق البلاغي على أعلى نصٍّ أدبي، لا جرَم أن استفرغ الزمخشري وسعه في تبيان ذلك، فكانت دراسةُ الشيخ (البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية)[7] كاشفةً عن القدرات الهائلة التي يكتنفها، وعن المضامين الكثيرة التي كانت غائبة بسبب الانشغال بما هو دونها، ومعيدةً للبحث البلاغي جدته بعد طول الجفاء، وشحذًا لذهن المتعلم لكيفية ممارسة التطبيق وكيف تستخدم هذه الأصول، وخادمة للغرض الأول لهذه البلاغة وهي إدراك تلك البلاغة العالية الواقعة في الكتاب العزيز، فإعادة رواء هذا الدرس البلاغي من تفسيرٍ كالكشاف هو في الحقيقة تلمّس لآثار الحسّ البياني الأول؛ ولذلك كان الكتاب ذا قيمة عاليةٍ، ومرتبة سامية.
محتويات الكتاب:
أقام المؤلِّف كتابه على تمهيدٍ وبابين كبيرين.
فأمّا التمهيد فقال عنه المؤلِّف: «دراسة موجزة عن صاحب الكشاف، أذكرُ فيها طرفًا من أخباره، وأشيرُ إلى ألوان ثقافته الغالبة التي تطبع ذوقه وتغلب على حسّه [...] وحاولتُ أن تكون هذه الدراسة موجزة»[8].
وأمّا الباب الأول وهو: «البحث البلاغي في الكشاف»، فقد كسره على سبعة فصولٍ:
الفصل الأول في «البحث البلاغي قبل الكشاف»، حدّد فيه تحديدًا سريعًا وواعيًا المدى الذي وصل إليه الدرس البلاغي في كلّ فنّ من فنون البلاغة المطروقة من قبل الكشاف.
والفصل الثاني في «النَّظْم في الكشّاف»، عقده لتتبع معنى النَّظْم عند الزمخشري، ومعنى علم المعاني ومعنى علم البيان وعلاقة ذلك بالإعراب ومفهومه.
والفصل الثالث في «النظر في المفردات»، عقدَه لبحث كلام الزمخشري في المفردة من حيث الهيئة والملاءمة للسياق والإفراد والجمع، وما يعتريها من تعريفٍ بأقسامه وتنكير.
والفصل الرابع في «البحث في نَظْم الجملة»، عقده لدراسة «ما ذكره الزمخشري في نَظْم الجملة مما يتصل ببلاغتها وحسنها، سواءٌ أكان هذا معالجةً لإعراب، أو تفسيرًا لتركيب، أو بحثًا في أسرار النَّظْم»؛ فتحدث عن الاستفهام وصور النفي وصور التوكيد ودواعيه والقصر والحذف والذِّكْر وغير ذلك.
والفصل الخامس في «البحث في الجمل»، حاول فيه تلمّس أوجه البلاغة والبيان بالنظر إلى تعاقب الجُمَل وأحوالها، مثل ملاءمة المعاني أو المناسبات، مثل الفصل والوصل، ومثل الإيجاز والإطناب، ومثل التكرار.
الفصل السادس في «البحث في صور البيان»، جعله لدراسة التشبيه والمجاز والكناية والتعريض في تفسير الزمخشري.
الفصل السابع في «ألوان البديع»، جعله لدراسة الفنون البديعية التي تناولها الزمخشري ومدى أثرها في بلاغة القرآن المعجزة.
وأمّا الباب الثاني: «أثر الكشاف في الدراسات البلاغية»، فقد كسره على فصول ثلاثة: الفصل الأول كان عن أثره في مدرسة مفتاح العلوم للسكاكي، فتناول ذلك من خلال كتابي الإيضاح والمطول، للقزويني والسعد. والفصل الثاني في أثره في كتاب المثل السائر لابن الأثير الجزري. والفصل الثالث في أثره في كتاب الطراز ليحيى بن حمزة العلوي.
ليكون بذلك قد استوعب أثر هذا الجهد البلاغي في المدارس المختلفة مِن بعده.
هدف الكتاب:
كان هدف الكتاب واضحًا عند المؤلِّف في صفحاته الأولى، فقد نصّ عليه في المقدمة، فقال:
«ولمّا كان درس البلاغة العربية لم يستقم على منهجٍ صحيحٍ وطريقةٍ أقرب إلى الكمال إلا في دراسة الشيخين [يقصد الجرجاني والزمخشري]، وكانت بلاغة الزمخشري كأنها تائهة في تفسيره لا تظهر ملامحها محددة واضحة في كلّ مسألة من المسائل البلاغية =عمدتُ في هذا البحث إلى بيانها وتوضيحها، حتى يرى الدارسون كلَّ ما قاله الزمخشري في كلّ مسألة من المسائل البلاغية، وفي ضوء هذا يتحدّد ما أضافه من أصولٍ في هذه الدراسة، وما أفاده من غيره ثم ما أفاد غيره منه»[9].
وقال في موضعٍ آخر استطرادًا ما يكشف عن هدفه ذلك ويعضد أنه كان واضحًا لديه على طول الكتاب:
«وإنما كلُّ همّي أن أصوّر من خلال هذا كلّه حسّه الدقيق بمفردات النصوص، وعنايته بدراسة هذا النوع المهم الذي أهمله البلاغيون بعده، وأن أضع صورةً دقيقةً لبلاغته كما يصوّرها تفسيره، وأن أبين إلى أيّ مدى أحاطت دراسته البلاغية بكل أجزاء الكلام متتبعةً له؛ من مفرده إلى جملته إلى جمله»[10].
وقال في موضعٍ آخر:
«وليس همّي في هذه الدراسة أن أستخلص القواعد والأحكام؛ فإن هذا إفسادٌ لهذا البحث وقتلٌ لروحه، وإنما همّي أن أعرض روح البحث البلاغي، أعني روحه الأدبية التي تُعنى بالتعليق على كلّ صورة، وتحليلِ كلّ مثال في ضوء سياقه تحليلًا لا يُغنِي عنه غيره، ولا يُختَصر في قاعدة؛ لذلك سوف أذكرُ كثيرًا من النصوص والشواهد حتى أستطيع أن أضع الأعين على بلاغته»[11].
إشكالية الكتاب:
انطلق المؤلّف من فكرةٍ رئيسة وهي أنّ البلاغة المتأخّرة -وهي من بعد مفتاح العلوم- صورة قاصرة من بلاغتنا العربية، وفيها إهدار كبير لكثير من الإمكانات الكامنة في هذه اللغة النبيلة لتحليل النصوص، وذلك بسبب التقسيمات الحاصرة -وليست من الحصر في شيء- وبسبب الخروج عن الذوق البلاغي إلى التقرير المنطقي، فكانت الإجابة التي كان يحاولها المؤلّف، هي: كيف نتخذ خطوة في حلّ هذه الإشكالية؟
ونحن في هذه النقاط نحاول أن نبين كيف كان الشيخ يفكّر لحلّ هذه الإشكالية، وماذا فعل:
أولًا: نظر المؤلّف فوَجَد أنّ منهج عبد القاهر هو أمثل المناهج في التذوّق البلاغي، وطريقته من خير الطرق، ووجَد أن خير مَن حاوَل ممارسة منهجه بصورة عملية على القرآن -وهو ذروة سنام البيان- هو الإمام الزمخشري في تفسيره، ففي اختيار الشيخ لتفسير الزمخشري لحلّ هذه الإشكالية جزء كبير من الفقه للإشكالية التي حاول أن يحلّها، فلما كان ضعف التطبيق وسذاجة الشاهد إحدى الإشكالات التي كانت على هذه الصورة من البلاغة، انطلق الشيخ إلى ميدان التطبيق نفسه، يستخلص منه كيف تكون معايشة النصوص، وكيف تفهم على وجهها من البيان العالي، وكيف تستخدم قواعد اللغة في استخراج مكنونات النصّ، فإنّ الانغماس في التنظير وحده حجابٌ عن التذوّق، فكان اختيار الكشّاف نفسه إحدى الطرق إلى حل الإشكال.
ثانيًا: لم يدخل المؤلّف على تفسير الزمخشري بتصورٍ مُسبَّق أو قسمة قبلية، وهذا الأمر كشف له عن مكنونات هذا التفسير، وقد يظنّ أن هذا الأمر بدهي، إلا أنه ليس كذلك، بل إنّ كثيرًا من أرباب حواشي الكشاف لم يراعوا تلك النقطة، فإنهم تعاملوا مع مصطلحات الكشاف بما استقرّت عليه البلاغة بعد السكاكي، وذلك خطأ منهجي كبير، إلا أن المؤلِّف تفاداه واستخرج ما أراده الزمخشري نفسه من خلال تتبع ذلك في تفسيره، بل وأحيانًا في مؤلّفاته كلّها كما صنع عند تحرير مفهومي علم البيان والمعاني[12]، وهذا وعيٌ من المؤلّف بالإشكاليات الحقيقة التي تعانيها البلاغة، فلم يدخل بالقسمة الثلاثية التي استقرّت عليها البلاغة، بل استخلص قسمة عقلية من معايشته للتفسير، فكان من ثمرة ذلك على سبيل المثال:
1- الفصل الثالث من الباب الأول، وهو الفصل الذي عقده للنظر في المفردات، فإنه فصلٌ جليل القدر كشفَ فيه عن منهج عميق في استخراج البلاغة من اللفظة نفسها، فهو بذلك يخطو خطوة للأمام في معالجة إشكالية البلاغة المتأخرة التي حاول أن يعالجها، فإن النظر في المفردات مما أهملته القسمة المشهورة في البلاغة المتأخرة، حتى أن الكلمة لا توصف بالبلاغة ولا بمطابقة مقتضى الحال، فكان الأمر عكس ذلك، فإنك تجد الزمخشري يقول في تفسير قوله تعالى: {وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ}: «ألا ترى أنه لو وضع مكان (بنبأ) (بخبر) لكان المعنى صحيحًا؛ وهو كما جاء أصحّ لما في النّبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال»[13]، فهذا كما ترى ينقضُ ما ذكروه، ويؤصّل للاهتمام بالمفردة، وهذا ما فعله الشيخ لمّا دخل على التفسير يستنطق منه حلّ الإشكال.
2- الفصل الذي عقده للبديع، فإن الفكرة السائدة في بلاغة المتأخِّرين أنه ذيل لعلمي المعاني والبيان، وأنه تكميلي، والحقيقة أن كلام الزمخشري لا يفيد ذلك، وهذا الأمر أثّر على باحثين معاصرين كتبوا قبل الشيخ عن بلاغة الزمخشري، وقالوا إنّ البديع لا يدخل في الإعجاز حسَب تصور الزمخشري، وهذا ما نقضه الشيخ عليهم، وأنّ الأمر عند الزمخشري على عكس ذلك، فكان دخولُه على التفسير متحررًا من أسر التقسيمات القبلية مُعِينًا على حلّ إشكالية البلاغة، ومضيفًا لها قيمة كانت مهدرة في فهم علم البديع[14].
ثالثًا: وهو متصل بما سبق، أنّ الشيخ لم يتكلّف استخراج الحدود والتعريفات والأصول من تفسير الكشاف، ولم يتمحّل لنصّ الكشاف ليحمّله ما لا يحتمل كي يتماشى مع قواعد المنطق التي غلبت على البلاغة وعلى نظر علماء البلاغة؛ وذلك لِما علمه من أن هذا الأمر إحدى إشكاليات الدرس البلاغي، فلا بد في محاولة حلّها أن يجافي ذلك، ولأنّ البلاغة نفسها تتأبى على هذا التحديد؛ وذلك لِما في هذه التعليلات من أمورٍ منطقيةٍ لا يراعيها البليغ ولا تخطر بباله، فكان غرض الشيخ أن يسوق كلّ نظيرٍ مع نظيره، سواءٌ كان كلام الزمخشري فيه تصريحًا أو تلميحًا؛ لكن لا يضع القواعد العامة الصارمة، فهذا -كما قال هو من قبل- «إفسادٌ لهذا البحث وقتلٌ لروحه»، فلم تجده مثلًا عرّف البلاغة، ولم تجده يحاكم الزمخشري إلى ضرورة اتساق المصطلحات وذكر القيود في كلّ مكان، بل يرى أن في الأمر سعة، وهذا أعطى له الحرية لفهم طريقة التذوق، وكيفية النظر للنصوص نظرة بلاغية بحسٍّ أقرب ما يكون من حسّ العربي الأصيل، ونبيّن ذلك بمثالين:
الأول: لمّا ناقش الشيخ نظرة الزمخشري في «الاستفهام»[15]، قال إنّ جهد الزمخشري -ومن قبله عبد القاهر- كان منصبًّا في أن أداة الاستفهام تدخل على المستفهم عنه، ولم يهتم الزمخشري بأنّ التقديم فيه للتخصيص أو للتقوية؛ لأن هذا أمر غير محلّ البحث الذي يدور حوله النقاش، يقول الشيخ: «في تحليل هذه الصورة نهتم ببيان معنى الاستفهام أو التقرير وتوجهه إلى الفاعل أو المفعول؛ لأن ذلك هو الأهم في الجملة وقد يكون مناط الفائدة فيها»[16]، ولكن شرّاح الكشاف تمحلوا ذلك بقواعد المنطق، بل واضطروا من أجل ذلك أن يدفعوا إيرادات عجيبة ترد بمقتضى المنطق، فعلّق الشيخ عليها قائلًا: «وهذا التحقيق صورة من البحث البلاغي الذي استغرقه النظر العقلي وهو كلام لا نستطيع إنكاره؛ لأنه يقوم على النظر والمنطق، وما يقوم على هذين يصعب إبطاله، ولكننا مطمئنون إلى أن لدراسة اللغة وفهم الأساليب منطقًا آخر، وهذا المنطق كما أتصوّره هو منطق الإحساس والفطرة، هو ما يتبادر إلى الذهن [...] أمّا أن يكون الكلام رُوعي فيه «القيد» أولًا ثم نفي، فيكون النفي منصبًّا على القيد، أو أنه نفي ثم قيد فيكون لتقييد النفي لا لنفي القيد فهذه أمورٌ لا يراعيها الناس في إنشائهم، ولا تخطر بخيال متكلّم [...]، وكلّ هذه ملاحظات قد يستجيب لها المنطق ولكنها تكلّف في دراسة الأساليب»[17].
والمثال الثاني: أنه لمّا تعرّض لمسألة كيف تفيد أدوات الاستفهام معاني الإنكار والتعجيب ونحو ذلك، هل هي من طريق المجاز أم الحقيقة، قال: «ولا تجد جوابًا قاطعًا في كلام الزمخشري على هذا السؤال»[18]، وذكر إرهاقات الشراح من بعده لهذا الأمر وأنها كانت «رياضة ذهنية»، كما يقول، ولكنه يرى أن هذه الطريقة لا تفيد البلاغة في شيء، وأنّ صنيع الزمخشري هو الصواب، فقال: «والزمخشري أكثر تحررًا في بحثه من المتأخِّرين؛ لا يقف عند الكلمة في كلّ موضع ليقول إنها هنا حقيقة أو مجاز، ويكفيه أن يحيط بالغرض والمقصود من الكلام في بعض المقامات غير ملتفتٍ إلى وجه الاستعمال»[19].
فطريقة الشيخ في التحرّر من هذا الأسر كانت مجدية ومعيدة للبلاغة روحها، وهي أنجع في تحقيق غرض البيان.
ولا يفهم من ذلك أن الشيخ لم يُعْنَ بتحرير المصطلحات، فليس ذلك ما أردت، وإنما هناك مرحلة من التدقيق تُخرج الأمر عن فسحة البيان، وتجعل النظر فيها باهتًا إذا ما حرّر بالقيد العلمي، فهذا ما كان الزمخشري يراعيه، وكان الشيخ أبو موسى يصنعه عند استخراج البلاغة من تفسيره.
فمما سبق يتضح أن الشيخ قد وُفِّقَ في حلّ جملةٍ من إشكاليات البلاغة من خلال النظر في عقلية الزمخشري، ومن خلال ملاحظة تعامل الزمخشري مع الأساليب وتحليلها، فاستخرج منه بلاغة حيّة، وعرض ما أهدرته بلاغة المتأخرين.
مميزات الكتاب:
1. الاستيعاب الواعي لتاريخ أفكار البلاغة، وأعني بذلك أن الشيخ كان ملمًّا بالمباحث البلاغية المتناثرة في بطون الكتب قبل عبد القاهر وبعده، وهي قبل عبد القاهر أكثر صعوبة، يقول الشيخ في هذا الأمر: «...على أننا قلّما نجد كتابًا اهتم بتاريخ فنون البلاغة كأن يتناول نشأة كلّ فنٍّ، ويتتبع مراحل نموه وازدهاره تتبعًا واعيًا دقيقًا، وهذا عملٌ جليلٌ قد يساعدنا على تَبَيّن كثير من قضايا هذا العلم وتخليصه من كثيرٍ من الشوائب»[20]. على أنّي لم أقصد بهذا النقل أنّ الشيخ كانت دراسته تأريخًا، ولكن أعني أنه أهتم بهذا الأمر جدًّا، وهذا الإلمام الجيد والتتبع الواعي أعانه على:
- تحرير المصطلحات جيدًا، فهو يدرس كلّ مصطلح في ضوء معطياته، ولا يجور عليه بما هو منه بريء، فلمّا تحدّث في الفصل الأول عن البلاغة قبل الكشاف، وتناول مفهوم النَّظْم، خرج بأن أنظار العلماء لهذا المفهوم متعدّدة، وإن اتحدت التسمية، فالنَّظْم عند الباقلاني مباينٌ للنَّظْم عند عبد القاهر، ولولا الدراسة الواعية لتاريخ الأفكار في البلاغة لكانت النظرة العجلى تقضي باتحادهما، وذلك ما أخفق فيه الكثير، وهو الآن -يا للعجب- في ازدياد.
- معرفة النسبة الحقيقية للأقوال وإن تنازعها أهل العلم بعد ذلك، فإنّ الشيخ لما كانت دراسته للكشاف دراسة متقنة وواعية؛ أدرك أن جلّ أفكار ابن الأثير والعلوي في كتابيهما: المثل السائر، والطراز =ما هي إلا ترديد لآراء الزمخشري، بنصّه أو بتغيير فيه، وهذا ما أخفق في إدراكه جلّة أفاضل المتخصّصين في علم البلاغة، مثل: د. شوقي ضيف، د. بدوي طبانة، ود. محمد زغلول سلام، فأصدروا أحكامًا على الزمخشري وعلى ابن الأثير غير صحيحة، ولا يخفى أن تمحيص تاريخ الأفكار هو صلب العلم، وأنّ الخطأ فيها يستدعي خطئًا يسري في كلّ ما بُني عليها، وقد خفي مثل ذلك أيضًا على ابن أبي الحديد في كتابه الفلك الدائر الذي ناقش فيه بعض آراء ابن الأثير في كتابه المثل السائر، فكان بعض ما انتقده عليه وظنّ أنه من كيس ابن الأثير ما هو إلا قول الزمخشري، وهذا يفتح بابًا للنظر في هذا الكتاب: أعني الفلك الدائر، فإنه سيكون -على الحقيقة- نقاشًا لآراء الزمخشري لا ابن الأثير. وهذا كلّه من ثمرة القراءة الواعية المحرّرة لتاريخ الأفكار والآراء والمصطلحات.
2. حسن تتبّع كلام الزمخشري لاستخراج الفكرة العامة، فإنّ الشيخ كان يجوس في التفسير جيئة وذهابًا يستخرج منه الصورة الكاملة للمسألة، وهذا أمر يقتضي خبيرًا بالكتاب، عالمًا به، والتهاون فيه مزلّة وقع فيها أكابر، ومن أثر ذلك تجد الشيخ يقول: «والزمخشري يتساهل في المصطلحات العلمية التي حدّد مدلولها، ومرجع هذا إلى ميله للمعنى اللغوي الذي يعدل به كثيرًا عن الاصطلاح المحدد»[21]. فلهذا تجد الخطيب القزويني لما قصر نظره في موطنٍ واحد للزمخشري في المجاز العقلي، كان مذهب الخطيب فيه مخالف لغيره، يقول الشيخ: «وأمّا قول الزمخشري في تعريفه [المجاز العقلي]: هو أن يسند الفعل إلى شيءٍ يتلبس بالذي هو في الحقيقة له، والذي تأثّر به الخطيب، فليس تعريفًا جامعًا لكلّ صور المجاز العقلي كما يتصوره الزمخشري نفسه لِمَا قدمناه، ولا اعتراض عليه في هذا، فإنه يذكر من أصول البلاغة في كلّ موقفٍ ما يقتضيه هذا الموقف [...] ولذلك يقع الباحث في الخطأ إذا توهّم أن كلامه في موطنٍ واحد يوضح رأيه في مسألة بلاغية مهما أسهب في هذا الموطن»[22].
3. كثرة المناقشات والاستدراكات والردود، وهذه حياة العلم، فإنّ الشيخ لما كان قد حدّد الإشكالية واضحةً، واستوعب البلاغة في صورتها التي استقرّت عليها من شروحٍ للتلخيص وحواشٍ عليه وتقريرات، وكذلك استوعب ما كتبه معاصروه =كانت نقاشاته لهم كثيرة وثرية، منها ما هو في أصول الفنّ، ومنها ما هو في فروعه، فقد بلغت استدراكاته ومناقشاته أكثر من أربعين استدراكًا كلّها صالح للمدارسة والنظر[23]. وهذا لا شك مفصحٌ عن فهمٍ -عزّ نظيره- للإشكالية الحقيقية للعلم.
ملاحظات على الكتاب:
تردّدتُ كثيرًا قبل أن أخطّ شيئًا في هذا المبحث، حتى كدت أن أضرب صفحًا عن المقالة هيبةً من الشيخ -حفظه الله-، إلا أنّي أسجل ما لحظته متعلّمًا، وهما ملاحظتان علميتان، وواحدة فنية:
1. ذكر الشيخ في أحد دروسه أن رسالته في أول الأمر كانت باسم: «البحث البلاغي في تفسير الكشاف وأثره في الدراسات البلاغية»[24]، ثم لأمرٍ ما ذكره هو في الدرس غيّر العنوان إلى: «البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية»، وذكر أنّ الأستاذ محمود شاكر -رحمه الله- كان لا يوافقه على مصطلح «البلاغة القرآنية» فعُني الشيخ في مقدّمة الطبعة الثانية بإيجاد أصلٍ لهذه التسمية. إلا أني أحسب أن العنوان الأوّل أدلّ على مضمون الرسالة، وعلى ما جاء فيها؛ وذلك لأنّ الشيخ ذكر في مقدمة الطبعة الثانية مصطلح «البلاغة القرآنية»، وذكر أنها: «البلاغة الخاصّة بالقرآن والتي توجد فيه ولا يوجد منها شيء في كلام البشر البتة»[25]، ثم ذكر طريقة استخراج العلماء لها، وهي: «تحليل الكلام الصادر عن الإنسان واستخراج الأصل العام الذي هو وصف لازمٌ له لا ينفك عنه أبدًا حتى كأنه جزء من ماهية الكلام... وهو باختصار شديد كينونة النفس الإنسانية في كلّ ما يصدر عنها من بيانٍ؛ سواءٌ أكان شِعْرًا أو نثرًا أو كلامًا [...] ولما استحكم عندهم [أي العلماء] هذا الأصل واستيقنوه عادوا إلى القرآن ينظرون فيه فلم يجدوا فيه أثرًا لهذا الأصل الذي هو كالجزء من ماهية بلاغة الإنسان، وجدوا كلامًا يخلو خلوًّا قاطعًا من هذا النَّفَس الإنساني»[26].
وهذا الذي ذكره الشيخ بعيدٌ عن مضمون الكتاب؛ لأنّ البلاغة التي استخرجها الشيخ من تفسير الكشاف ليست بلاغة مختصّة بالقرآن ولا فيها ما يوضح ما الخصائص التي فاق بها بيان القرآن بيان البشر، بل هي استخراجٌ لأصول البلاغة -عمومًا- والزمخشري نفسه يستدل عليها بالشِّعر وكلام العرب.
فإن قيل: ولكنها -أعني البلاغة- في القرآن أعلى درجة منها في الشِّعْر.
قلنا: عاد البحث فيها جذعًا؛ إِذْ لم يظهر ما الخصوصية التي فاق بها القرآنُ الشِّعْرَ في هذا المبحث على وجه المثال. فكانت التسمية الأولى وهي «البحث البلاغي» أجود وأدلّ من «البلاغة القرآنية».
2. أنّ الشيخ لم يطّرد في تفصيل ما أضافه الزمخشري للبحث البلاغي، فإنه كان في مواضع قليلة يشير إلى ما زاده الزمخشري على عبد القاهر، وفي موضعٍ قال أنه خالفه[27]؛ ونقول ذلك لأنّ ما استخرجه الشيخ من مباحث البلاغة لم يكن الزمخشري أبا عذرته كلّه، بل كان منه ما هو معلوم من قبل. إلا أنّ معرفة ما أضافه الزمخشري يعرف بالمدارسة والنظر، وصنيع الشيخ في استخراج البلاغة مُعِين على ذلك.
3. أمّا الملاحظة الفنية فهي أنّ الكتاب حشوه أخطاء مطبعية، وتنسيقه يوشك أن يوهم القارئ بخلاف المراد، ونصُّ الشيخ لا يتبين من نصِّ الزمخشري حتى أنهما ليتداخلان أحيانًا، ومثل هذا الكتاب النفيس جديرٌ أن يُعتنى به، وأن يُطبع طباعة تليق به. وكذلك هو مفتقرٌ لكشافات تبرز دُرره التي حواها، فهذه الاستدراكات والمناقشات، وهذه الخلاصات في فهم منهج الزمخشري، وهذه البحوث المقترحة والأفكار المتناثرة =جديرةٌ أن تبرز في كشافاتٍ خاصّة تعِين الباحثين وتفيد الراغبين.
الخاتمة:
أحبّ أن أختم مقالي هذا بكلامٍ للشيخ الدكتور/ أبو موسى جدير أن يكون نصب عيني كلّ باحث جاد، يقول أطال اللهُ بقاءه:
«...لأنّ همّي وسدمي كان -ولا يزال- هو البحث عن شيءٍ في طيّ كلام علمائنا لم يتكلّموا به صراحةً، وإنما هو مضمرٌ في كلامهم سواءٌ أرادوه أو لم يريدوه؛ لأنّي على يقينٍ من أنّ أهل العلم الصادقين منحهم اللهُ -سبحانه وتعالى- لقانةً هي من وراء عِلْمهم الذي استخرجوه، وهي إرهاصٌ بعلم آخر لم يستخرجوه، وما تلبث هذه اللقانة أو هذا الإرهاص أن يثير في عقلِ مَنْ كان على طريقهم في الصدق والإخلاص، ثم تخرج هذه اللقانة أو هذه المعلومة اللدنية المطوية في علمهم ثم تصير فكرةً جديدة، ثم يكون وراءها فكرة مطوية، وهكذا نجد كلام الراسخين في العلوم كنوزًا ومناجم يفتح بعضها الباب لبعض، وهذا هو سبيل نموّ المعرفة وازدهارها وزهوها أيضًا حين يتولّد بعضها من بعض، ويفتح أوّلها الباب لثانيها، ومن ورائها عقول لا تني، وعزائم لا تني، وهذا شيءٌ، وترديد الببغاوات شيء آخر، وهذا هو الذي أفهمه من كلام المزني لما قال إنه قرأ رسالة الشافعي خمسمائة مرّة، وكان في كلّ مرة يفهم شيئًا لم يفهمه في المرة قبلها، ولا أتصوّر أن الذي كان يفهمه المزني في كلّ مرة هو ما ذكره الشافعي، وإنما المُضمر في طيّ ما قاله الشافعي، أو هو تحت الذي قاله الشافعي، وأن كلام الشافعي الملهم كان وراءه منادح بعيدة، وكلّما قطع (الجرميُّ) طريقًا وجد هناك الوديعة التي لا تردّ يد العالم صفرًا منها؛ لأنه بهذا التكرار يمدّ يده إلى الله، والله -سبحانه وتعالى- لا يردّ يدًا مدّها أحدٌ إليه حتى يضع فيها خيرًا»[28].
هذا الذي ذكره الشيخ هو ما فعله في رسالته، وهو ما فعله في جميع كتبه، يبصر الإشكال، ويدخل على كلام العلماء مستهديًا بطرائقهم، مستبصرًا بإلماحتهم، فأسهم في حلِّ بعض الإشكال، وجديرٌ بالباحث الجاد أن يسير سيرته وينتهج نهجه في تتبّع إشكالات العلم الحقيقية، وإنّ في كتب الشيخ لخيرًا عظيمًا، وعلمًا غزيرًا قد شُغِلَ عنه الناس بما هو دونه، ولو التُفِتَ إلى ما سطره يراع الشيخ -أطال الله في الخيرات عمره- لكان فتحًا عظيمًا على العلم. وإني رجوتُ بتلك المقالة أن أعرض مثالًا حيًّا بيننا يحاول أن يصلح ويجدد على جادة أهل العلم، وعسى أن أكون في ذلك قد وُفّقت، ولكُتُبِ الشيخ قد حَفَزت.
[1] إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، أبو السامي مصطفى صادق الرافعي، الطبعة التي بأمر الملك فؤاد، ص101.
[2] انظر على سبيل المثال: المطول (3/ 27) طبعة دار الرشد، مواهب الفتاح (3/ 343) مطبوع ضمن شروح تلخيص المفتاح.
[3] المطول، السعد التفتازاني، طبعة دار الرشد، (3/ 52).
[4] المختصر شرح تلخيص المفتاح، السعد التفتازاني، طبعة دار التقوى، ص87.
[5] الأطول، العصام الإسفراييني، طبعة دار الكتب العلمية، (1/ 584).
[6] هو محمد محمد حسنين أبو موسى، وُلد في قرية الزوامل- دسوق- كفر الشيخ- مصر: 30/ 6/ 1937م.
حصل على الإجازة العالية من كلية اللغة العربية بالقاهرة- جامعة الأزهر بتقدير عام جيد جدًّا عام 1963م. وحصل على التخصّص (الماجستير) في البلاغة والنقد من كلية اللغة العربية 1967م. ثم حصل على العالمية (الدكتوراه) في البلاغة والنقد من كلية اللغة العربية بالقاهرة عام 1971م عن رسالته: (البحث البلاغي في تفسير الكشاف وأثره في الدراسات البلاغية) بإشراف المرحوم أ.د/ كامل الخولي، ونُشرت الرسالة بعدُ تحت عنوان: (البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية). عُيّن معيدًا بكلية اللغة العربية بالقاهرة- قسم البلاغة والنقد عام 1964م، ثم مدرسًا مساعدًا 1967م. ثم عُين مدرسًا 1971م. ثم عُين أستاذًا مساعدًا 1977م. ثم عُين أستاذًا 1981م. ثم رئيسًا لقسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة أعوامًا كثيرة. وأُعير إلى جامعات عربية في بلاد متعددة. عُين أستاذًا غير متفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وما زال بهذه الوظيفة إلى الآن - أمدَّ الله في عمره، ونفع به طلاب العلم وأهله. بلغت مؤلّفاته ستة وعشرين كتابًا، ومنها غير كتابنا هذا: قراءة في الأدب القديم، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم.
[7] أصل هذا الكتاب أطروحة دكتوراه، صدر عن مكتبة وهبة، طبعته الثالثة عام 1438هـ= 2017م في مجلدٍ كبير عدد صفحاته 750 صفحة.
[8] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص60.
[9] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص58.
[10] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص276.
[11] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص338.
[12] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص261.
[13] الكشاف، الزمخشري، طبعة دار المعرفة، ص780.
[14] انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص573.
[15] انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص360.
[16] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص366.
[17] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص367.
[18] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص374.
[19] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص376.
[20] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص139.
[21] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص522.
[22] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص546.
[23] انظر على سبيل المثال نقده لعلماء البلاغة المتأخرين، ص66، 197، 232، 367، 423. وانظر نقده للمعاصرين، ص144، 207، 230، 515، 574. وانظر مناقشته هو للزمخشري نفسه، ص285، 345، 359، وانظر في انتصافه للزمخشري، ص290، 347، 353، 411، 499.
[24] الدرس الخامس من شرح أسرار البلاغة، الدقيقة 3:50 www.youtube.com/watch?v=N2mgsf3shQU
[25] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص50.
[26] البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص50- 51.
[27] انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، أبو موسى، ص308، 358، 480، 549، 565، 566.
[28] الشعر الجاهلي: دراسة في منازع الشعراء، محمد محمد أبو موسى، طبعة مكتبة وهبة، ص (ي).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد مصطفى قناوي
حاصل على ليسانس كلية الآداب قسم اللغة العربية - جامعة الإسكندرية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))