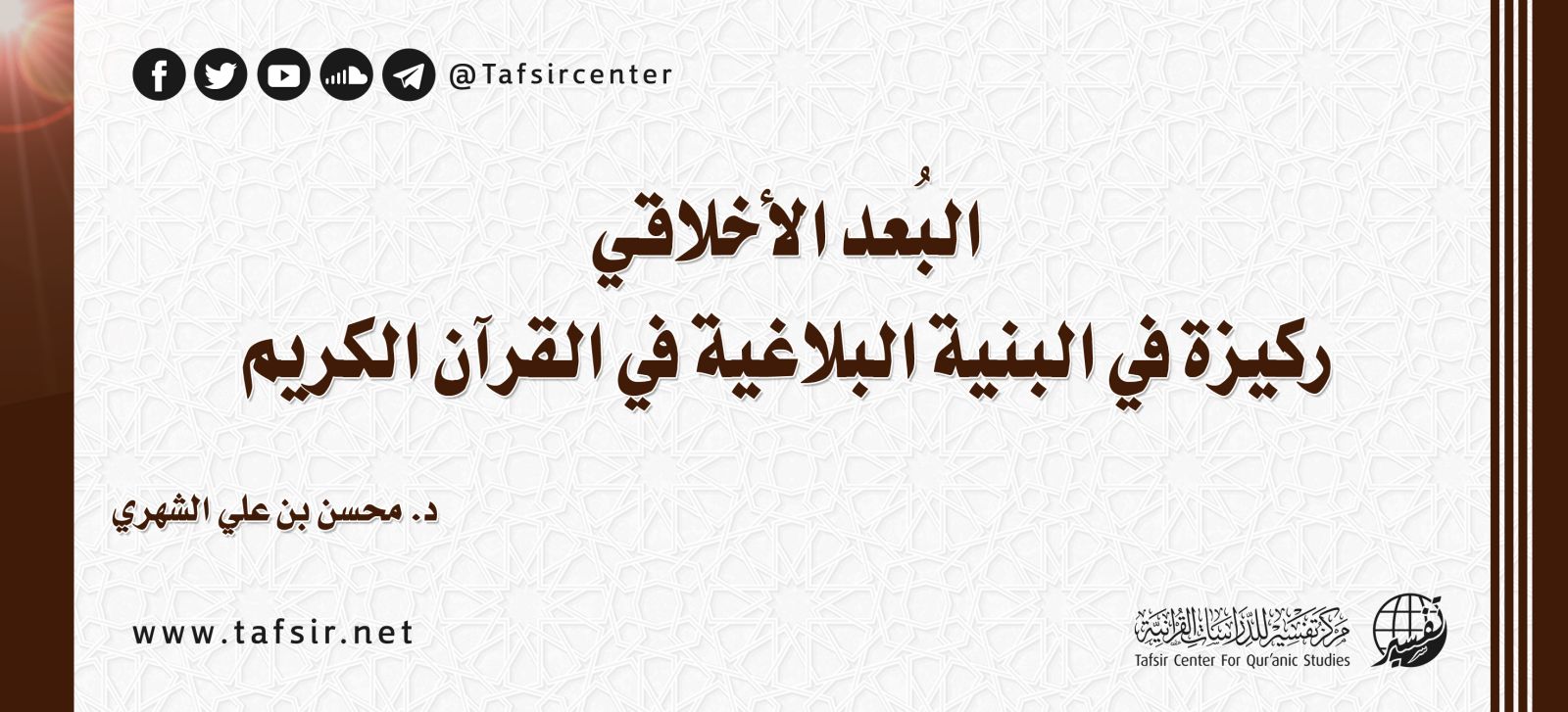مفهوم النصّ؛ ونقد المقاربة التاريخية للقرآن الكريم
ونقد المقاربة التاريخية للقرآن الكريم
الكاتب: كريم التايدي

تمهيد:
يُعَدّ مفهومُ النصّ من المفاهيم الإشكالية في العلوم الإسلامية لكونه غير مستقرّ على تحديد واحد. وما زاده إشكالًا هو تقاطعه مع المقاربات النصِّية المعاصرة، تلك التي تقارب النصوص الأدبية من منطلقات ومرجعيات متعدّدة، وهو ما أوقع في الاشتباه بين المرجعيات والأُطُر النظرية المتباعدة.
لقد ارتبط مفهوم النصّ في المقاربات المنهجية التي تناولت النصوص الأدبية بنصوص دنيوية لها طابع إنساني وتاريخي، تنجلي عبرها تجارب بشرية تاريخية، وتنعكس في مرآتها، وقد أدّى الإسقاط الفجّ لنتائج هذه المقاربات إلى القول بتاريخية الوحي، ونزع صفة القداسة عنه، وتوظيف مناهج ومقاربات النصوص الأدبية لتفسير القرآن ودراسته.
إنّ المنطلق الذي ينطلق منه دارس النصّ الأدبي مبنيّ على مسلّمة أن المتكلِّم يخفِي الحقيقة لينطق بلباسها متبنيًا أساليب التورية والمجاز والاستعارات، فالمتكلِّم على هذا الأساس مراوِغ ومخادِع، ليظلّ إبداعه منفتحًا على ما لا حدّ له من التأويلات، بينما حال الخطاب القرآني المطلق يقع على النقيض من ذلك؛ إِذْ يندرج ضمن النصوص المقصدية التي تتوخّى تبليغ المراد وإفهام السامع ودفعه إلى العمل.
يجد هذا الوجه من النظر أصوله الأولى عند الفلاسفة الذين ادّعوا أنّ ما في القرآن من توصيف وقصص وأخبار إنما هي مجرّد خيالات لا حقائق، وقد جيء بها لتناسب العوامّ من أجل مصلحتهم، ثم قارنوا في ذلك بين النبيّ والفيلسوف، وأدى ببعضهم إلى تفضيل الفيلسوف على النبيّ. هذه النتيجة تجد ما يشبهها في بعض المقاربات الحداثية التي تنفي النبوّة الاصطفائية وتتبنّى القول بنبوّة الإنسان أيًّا كان.
في هذا الإطار نسعى إلى مقاربة هذا الموضوع، في ضوء الإشكال الآتي: كيف حدّدت المقاربة التاريخية مفهوم النصّ؟ وما المرجعيات التي استندتْ إليها هذه المقاربة؟ وما مدى وجاهة ودقة هذا التحديد؟
أولًا: مفهوم النصّ:
إنّ أيّ محاولة لتحديد النصّ منفصلًا عن الخلفيات المعرفية التي تسند هذا التحديد تعدّ محاولة محكومة بالفشل ومنتهية إلى سراب لا تتبيّن فيه معالم النصّ، الأمر الذي يؤدي إلى الكثير من الخلط والمزج بين رؤى وتوجّهات نظرية لا يجمع بينها جامع؛ لذلك نسعى في هذه الورقة إلى مقاربة مفهوم النصّ باستحضار التعدّد الواقع فيما يسند هذا التحديد من رؤى واتجاهات نظرية.
بدءًا ينبغي أن يُنْظَر إلى النصّ من جهتين:
أ) علاقته بالنصوص الخارجية.
ب) تفاعله مع نفسه[1].
ذلك أنّ النص علاقة[2]، وكونه علاقة يقتضي وجود عناصر متشابكة على نحوٍ من الاتساق والانسجام بما يضمن الوحدة في إطارٍ من التعدّد، إلا أنّ تصوّر النصّ على أنه علاقة بما تقتضيه من ترابط بين العناصر المشكّلة للمجموع إنما هو تحديد وارد على العربية وليس منها؛ ذلك أنّ النصّ -عربيًّا- يحيل إلى البيان والظهور والرفع، ومنه انتقل إلى الاستخدام الشرعي في ميدان أصول الفقه.
ويمكن القول أنّ الاهتمام بالنظريات النصِّية يعود إلى الحقبة المعاصرة للوضعية المنطقية في ضوء مبدأ (العلمية) سعيًا إلى جعل النظرية النصِّية نظرية تستجيب للاختبار العلمي الدقيق، وقد ارتبط من جهة ثانية بالبنيوية التي سعت إلى تحقيق هذه العلمية عبر فصل النصّ عن المؤثرات الخارجية، واعتمادها مبدأ المحايثة تحقيقًا للموضوعية العلمية أيضًا.
وقد عَنّ لنا -في سياق تحديد مفهوم النصّ- أن ننظر إليه وهو يشتغل وسط البيئة التي نشأ بها؛ إِذْ لا يمكن فصل التحديد عن هذه البيئة، وإلا كانت النتيجة هي الوقوع في الالتباس الذي لا يرتفع إلا بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، من هنا آثرنا أن نحدّد المفهوم بحسَب مجالين تداوليّين مختلفين: مجال التداول التراثي العربي، ومجال التداول الغربي.
١-١- في التراث العربي:
تعود معاني أصول (نصّ) في العربية إلى الرفع والظهور والحركة، ووصول الشيء إلى غايته، يدلّ على ذلك صاحب لسان العرب حين يقول: «النصّ رَفْعُك الشيء، نصّ الحديثَ ينصُّه نصًّا رَفَعَهُ، وكلّ ما أُظْهِر فقد نُصَّ... والمنصة ما تظهر عليه العروس لتُرَى، وقد نصّها وانتصّت هي، والماشطة تنصُّ العروس فتُقعِدُها على المنصّة... والنصّ والنصيص السير الشديد والحثّ... وأصل النصّ أقصى الشيء وغايته... وفي حديث هرقل: ينصّهم، أي يَستخرج رأيهم ويُظهره، ومنه قول الفقهاء: نصّ القرآن ونصّ السُّنّة، أي: ما دلّ ظاهر لفظها عليه من الأحكام»[3]، وحين نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي ظلّ أصحاب الحقول المعرفية التي تناولته محافظين على أصل الدلالة اللغوي؛ وعلى هذا، كثيرًا ما تكون الدلالات اللغوية للمصطلحات كاشفة عن كثير من الجوانب التي لو أُهملت فإنها تُوقِع في الإيهام والالتباس.
إنّأهم الحقول المعرفية التي تناولت مفهوم النصّ تراثيًّا تؤول إلى علمي الفقه وأصوله، ولقد كان لهذين العِلْمين ارتباط وثيق باللغة وعلومها، إلا أنّ القضايا التي تناولها الأصوليون تجاوزت ما تحقّق عند أهل اللغة؛ منها توظيفهم لنسق اصطلاحي ينسجم ونحو النصّ لا الجملة[4]، بالرغم من أن التركيز الأساس كان منصبًّا على ما يفيد الحكم. ومن هنا وجب أن توقف على التحديد الأصولي والفقهي للنصّ.
نقَل الأصوليون معنى النصّ من الدلالة اللغوية فخصّوه باستعمال اصطلاحي وضعوه مقابلًا لاصطلاحات أخرى يمكن أن يتبيّن بها كالظاهر والمؤول...، وإن كانوا لم يتّفقوا في الحقيقة على تحديد واحد وواضح للنصّ، إلا أنهم تناولوا الحديث عنه في سياق باب المنطوق والمفهوم. فقد نقل صاحب المعتمد عن الشافعي أنه حدّ النصّ «بأنه خطاب يعلم ما أريد به من الحكم، سواءٌ كان مستقلًّا بنفسه، أو علم المراد به بغيره»[5]، ويقول القرافي: «والنصّ فيه ثلاثة اصطلاحات؛ قيل: ما دلّ على معنى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا؛ كأسماء الأعداد. وقيل: ما دلّ على معنى قطعًا وإن احتمل غيره؛ كصيغ المجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع قطعًا وتحتمل الاستغراق. وقيل: ما دلّ على معنى كيف ما كان، وهو غالب استعمال الفقهاء»[6]. فتبين أن مدار النصّ عند الأصوليين يقوم أساسًا على معيار وجود الاحتمال وعدمه. فمن الواضح أنّ استعمال الأصوليين مبنيّ على الدلالة اللغوية الأصلية التي تشير إلى الوضوح والظهور والبيان، وليس للأمر علاقة بالتماسك أو الانسجام.
لكن الأمر لم يقف عند هذا الحدّ، فإذا ما اعتبرنا مسألة التآلف الوثيق بين الفقه وأصوله، تبيّن لنا أنّ النصّ يمكن أن يطلق في الآن ذاته على: الدليل بصفة عامة، كما يطلق على كلام الوحي، بمعنى أنه وقع الاتساع في استعمال المصطلح ليشمل الكلام أيضًا، إلا أنه خاصّ بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام.
ويشتمل النصّ على ثلاثة شروط -بحسَب صاحب المعتمد- وهي:
١. أن يكون كلامًا؛ لأن أدلة العقول والأفعال لا تُسمى نصوصًا.
٢. ألا يتناول إلا ما هو نصّ فيه، أي ما يظهر منه.
٣. أن تكون إفادته لما يفيده ظاهرًا غير مجمل[7].
فيتبيّن من هذا إذن أنّ النصّ «كلام تظهر إفادته لمعناه، لا يتناول أكثر مما قيل إنه نصّ فيه»[8]، فإذا تطرّق إليه الاحتمال أو الإجمال لم يعد نصًّا، مع بقاء كونه كلامًا. ومن هنا فإنّ مفهوم النصّ أصوليًّا مرتبط أساسًا بمراتب الدلالة؛ إِذْ يقوم التصوّر أساسًا على إطلاق لفظ النصّ على أعلى درجات الدلالة انطباقًا بحيث يصبح الاحتمال لاغيًا.
وغالب استعمال الفقهاء لِلَفظ النصّ يحيل إلى اللفظ الدال على معنى، سواءٌ كان كتابًا أو سنّة أو قياسًا أو غيره، وهو توظيف أوسع مما رأيناه سلفًا. فالنصّ ضمن ترتيبهم للدلالة الواضحة من حيث إنّ اللفظ «إذا ظهر منه المراد يسمى ظاهرًا بالنسبة إليه، ثم إنْ زاد الوضوح بأنْ سيق الكلام له يسمى نصًّا، ثم إن زاد حتى سدّ باب التأويل والتخصيص يسمى مفسرًا، ثم إن زاد حتى سدّ باب احتمال النسخ أيضًا سمي محكمًا». وقد ورد ذلك في سياق الحديث عن أقسام الدليل من جهة مراتب الظهور والخفاء.
يمكن أن نخلص في نهاية هذه التعريفات إلى أنّ مفهومَ النصّ كما يُتداول حاليًا في الخطاب النقدي باختلاف مجالاته وحقوله =مختلفٌ عن إطلاقاته في المجالات العلمية التراثية، لكن التجليات النصِّية المختلفة تبدو في عدة اصطلاحات لعلّ أقربها إلى النصّ مفهوم الكلام، والمناسبة كما هي عليه عند علماء القرآن والتفسير.
١-٢- في التراث الغربي:
يرتبط لفظ texte الذي ترجم إلى (نصّ) في أصل اشتقاقه بالنسيجِ بما يحيل إليه من الترابط والتواشج بين مختلف العناصر التي تحقّق الانسجام والاتساق والوحدة، ومن هنا لم يخلُ تحديد المفهوم من صعوبات جمة منها ما يعود إلى إشكال التحديد في حدّ ذاته، ومنها ما يرتبط بالتقاطع الذي للمفهوم مع بعض المفاهيم الأخرى، وهو ما يستعصي معه أمر التحديد.
بدءًا ينبغي أن أشير إلى أنه من الممكن أن نتحدّث في إطار التحديد الغربي لمفهوم النص عن استعمالين له:
أ) النصّ الكوني: حيث ينظر إلى كلّ عناصر الحياة على أنها نصوص قابلة للتأويل، وقد تأسّس هذا الوعي في ظل التأويليات الحديثة بدءًا مع المفكر والمترجم الألماني شلايماخر، «وأخصّ ما يميز النظر التأويلي هو عنايته بمختلف الظواهر الإنسانية الخطابية منها وغير الخطابية، جاعلًا منها جميعًا نصوصًا تقبل القراءة والتحليل والاستنطاق»[9].
ب) النص الأدبي: وهو أخصّ من الأول، وحيث إنّ ما يهمنا في هذا السياق -درءًا للاستطراد والتشتيت- هو النصّ الأدبي، فإنّ ما سينصبّ عليه اهتمامنا بالأساس هو رسم الحدود والمعالم التي تحدّد هذا المفهوم بالذات، لكون المفهوم بالغ التشعّب والاتساع؛ لذا سنسعى إلى مقاربته من زوايا ثلاث:
١. النص والبنية:
أقصد بهذه الرؤية تلك المنظورات التي تناولت مفهوم النصّ بالنظر إلى العناصر البنيوية المشكّلة له، وإن كان النصّ لا ينفكّ لحظة عن جملة العوامل الخارجية المؤثِّرة فيه، إلا أنّ ما يميز هذا الوجه من النظر إنما يتأسّس على مفاهيم داخلية تحكم النصّ الأدبي، من قبِيل الاتساق والانسجام والبنية ومبدأ المحايثة وغيرها.
يعرف النصّ في هذا السياق في علاقته باللغة أساسًا لِمَا للمقاربات اللغوية واللسانية من تأثير واضح فيه، فالنصّ بنية مغلقة ينظر إليه في ضوء مبدأ «المحايثة»، ومن هنا كانت المباحث التي ترتبط به لا تتجاوز مبادئ الاتساق والانسجام، وَفق رؤية لسانية بنيوية، تنظر إلى النصّ من جهة عناصره المكوِّنة له، والعلاقات الرابطة بينها، دون أدنى التفات إلى المؤثرات الخارجية مهما كان لها من دور.
على هذا ينظر إلى النصّ على أنه متوالية من الجُمَل تربط بينها علاقات، لكنه في الآن ذاته يمثّل وحدة دلالية، ومن هنا فإنّ النصّ ينظر إليه في علاقته بالجُمَل، تماثلًا أو تقابلًا، فبحسَب الموقف الذي يماثل بينهما يرى بأن مهمّة الناقد الأدبي لا تكاد تختلف عن مهمّة اللساني في شيء، فينتج عن هذا التصوّر أن يصبح الجزء (الجملة) معيارًا للكلّ (النصّ) بما يقتضيه لك من تضمن الجزء للكلّ الذي يؤدي إلى الاستحالة، غير أن هناك مواقف أخرى تذهب إلى إثبات خصوصية كلّ من الجملة والنصّ، وإقامة علاقة تعارض بينهما، ويمكن الحديث هنا عن النحو النصِّي بما يقتضيه مِن تجاوزٍ للجوانب الصوتية والتركيبية إلى العلاقات المنطقية والتداولية التي يلعب السياق دورًا رئيسًا فيها[10].
وأهم ما يمكن رصده في هذا السياق هو أن هذا الموقف من النصّ يقوم على أساس رفض مقولة المؤلِّف أو صاحب النصّ، إنّ النصّ يُعزل عن كاتبه ومبدعه، ومن هنا يمكن للمتلقي أن يدرسه منفصلًا عن كلّ العوامل والمؤثرات الخارجية التي عملت فيه على أهميتها، ولا يتحقّق مبدأ العلمية ما لم يجرّد موضوع الدراسة عن هذه المؤثرات.
٢. النصّ والقصد:
أشرنا في السابق -وإنْ بصفة عامة- إلى التصوّر الناظر إلى النصّ من حيث كونه بنية مغلقة، تتأسّس على مبدأ المحايثة، ولا تتجاوز النصّ إلى المؤثرات الخارجية، إلا أنّ هناك مواقف أخرى ذات مرجعيات معرفية ونقدية مختلفة، سعت إلى مقاربة النصّ من حيث علاقته بالقصد، يصبح النصّ وَفق هذا التصوّر فاعلية وحوارًا بين أقطاب تتجاذبه، وأهم الأقطاب التي يمكن الإشارة إليها ثلاثة: المؤلِّف، والنصّ ذاته، والمتلقي. والعلاقة الرابطة بين هذه الأقطاب علاقة تفاعلية تذاوتية، وليست علاقة ذات بموضوع بما تقتضيه هذه العلاقة من التجريد الموضوعي الذي يستحيل تحقّقه في ظلّ العلوم الإنسانية.
وأُريد أن أشير بدءًا إلى ملحظ مهم، هو أنّ «كلامًا لا يصير نصًّا إلا داخل ثقافة معينة. فعملية تحديد النصّ ينبغي أن تحترم وجهة نظر المنتمين إلى ثقافة خاصّة؛ لأن الكلام الذي تَعتبره ثقافةٌ ما نصًّا، قد لا يُعتبر نصًّا من طرف ثقافة أخرى»[11]، فالاعتراف إذن مكوِّن أساس في اعتبار النصّ نصًّا، ومن هنا كانت النصوص نادرة، فينبغي استحضار العوامل الخارجية المؤثرة في النصّ لا على مستوى التشكيل فقط، بل على مستوى التأثير الناتج عنه، والحوارية التي تقيمها جماعة ما مع النصّ.
فكلّ مقاربة للنصّ على أنه متوالية خطّية من الألفاظ، أو على أنه جملة من المعطيات والإرشادات يوقعنا في تصوّر تقني للنصّ يربأ به عن كينونته ووظيفته، وإن كانت هذه المستويات تتقاطع على أكثر من موضعٍ والنصّ، إلا أن النصّ تظلّ له هويته المتفرّدة والخاصة، كما أن أية مقاربة تُفقِد النصّ هويته الخاصّة وتعيده إلى مجرّد عوامل اجتماعية وتاريخية توقعه في الالتباس وتوقع قارئه في قدر أكبر من تشتيت الانتباه والالتباس.
١-٣- تركيب:
هذا، يمكن أن ننتهي إلى بعض الخلاصات، وأهمها أنّ مفهوم النصّ اليوم ينبغي أن يُنظر إليه في ظلّ هذا التراكم الذي عرفته العلوم الإنسانية عمومًا، دون إقصاء أو إسقاط، وإني مدين في هذا التركيب لأستاذنا محمد الحيرش الذي وضع إطارًا نظريًّا لتصنيف النصّ القرآني، وهو تصنيف مبتكَر لم يُسبَق إليه -في حدود اطلاعي- نظرًا إلى أنه استفاد كثيرًا مما تتيحه الدراسات التأويلية والتداولية المعاصرة، ليقيم علاقة حوارية علمية بالمنجز التراثي في مجال علوم القرآن دون الحطّ من قدره، أو السعي إلى امتلاكه، وقد اتخذ لهذه النمذجة أبعادًا ثلاثة:
1. البُعد التكويني.
2. البعد النصِّي.
3. البعد التأويلي.
وإن كان الباحث قد أكّد أكثر من مرة على أن هذه الأبعاد مترابطة فيما بينها لا ينفكّ بعضها عن بعضها الآخر، إلا أنّ ما يهمّنا في هذا السياق هو البُعد النصِّي، وهو بحسَب الباحث «يشمل مجموع المباحث التي تطرّق فيها علماء القرآن إلى الجهات التي يكوِّن بها النصّ تحققًا ذاتيًّا له وسائله وآلياته الخاصّة في الإبانة عن معانيه والإفصاح عنها»[12]. والغاية التي سعى علماء القرآن إلى بيانها هي «تجلية البنيان الداخلي للنصّ القرآني واستقصاء الخصائص والآليات التي يتميز بها»[13].
ويؤسّس الباحث نمذجته للنصّ القرآني في مستوى هذا البُعد النصِّي على معايير ثلاثة:
أ) بُعد الهوية والمغايرة: والملاحظ أنّ الباحث وفيّ لمبدأ المحاورة الذي أسّس له في بداية كتابه؛ إِذْ يعمل على استخلاص المفاهيم المؤسّسة لنمذجته من الأُسس المعرفية التي بنى عليها علماء القرآن خلاصاتهم، فينتهي إلى أن أساس التحديد الهويّ للنصّ القرآني نظر إليه من زاويتين: زاوية هوية النصّ وتفرّده الذاتي، وزاوية اختلافه ومغايرته للنصوص الأخرى، ويمكن تناول هذا المعيار في إطار ما عُرف لدى علماء القرآن وعلماء الكلام والبلاغة بمبحث الإعجاز[14].
ب) بُعد الوضوح والإبهام: يؤكّد البحث في هذا المعيار على مبدأين: أولهما أنّ «النصّ القرآني لا يتحقّق دلاليًّا على نحو واحد»[15]، وهذا التعدّد بحسَب الباحث لا يرجع إلى مواقف المفسِّرين أو مذاهبهم بل هو «بالأساس واقع نصِّي قائم ومتعيّن»[16]، «وعلى هذا ينبغي أن يُنظر إلى التعدّد من الجهة التي يكون بها لصيقًا بكينونة النصّ وناظمًا لها، وليس من الجهة التي يكون بها إفرازًا لاختلاف المذاهب وتباينها»[17]. بهذا نتبيّن أنّ الدوافع كانت دوافع علمية بالأساس، بغضّ النظر عن كونها تخدم مذهبًا معينًا أم لا.
ت) بُعد التشذّر والتآلف: ويستحضر الباحث في هذا السياق مبحث التناسب، وهو مبحث قلّ اعتناء المفسِّرين به، وإن كانت مواقفهم مختلفة حوله إلا أن الاهتمام به لم يكن ترفًا علميًّا، بل نتج عن حاجة تتعلّق «بالكيفية التي ينتظم بها النصّ القرآني في المصحف»[18]، غير أن التناسب -بحسَب الباحث- يمكن النظر إليه من زاويتين: واحدة مرتبطة بـ«المزج اللفظي بين الآيات»، ويُنظر فيها إلى مختلف الوسائل اللفظية التي يتحقق بها التناسب، أمّا الثانية في الزاوية المعنوية «وينظر فيها إلى الوسائل المعنوية التي يحصل بها التناسب على أنها قرائن مستترة في النصّ وثاوية خلف تحقّقه الظاهر»[19].
ونعتقد أن كلّ تحديد للنصّ بالمفهوم الذي يطلق به في التداول المعاصر ينبغي أن يستحضر هذه الجوانب بما تتيحه من سعة في الأفق، ورحابة في ميدان الحوار العلمي، ذلك أنه تحفظ للنصّ بما هو نصّ خصوصيتَه وبناءَه، وتماسكه وانسجامه، دون إغفال العوامل السياقية والمقامية في تلقّيه أو تداوله، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وظيفة هذه العوامل السياقية إنما تكمن في إتاحة إمكانات الفهم والتأويل، لا أنها عوامل منتجة، بعيدًا عن منطق التملك والإسقاط، أو منهج الإغلاق الذي يتعارض مع كلّ أدبيات الموروث التفسيري على اختلاف توجهات أصحابه المعرفية والمذهبية معًا.
ثانيًا: نقد المقاربة التاريخية للوحي:
يمكن أن ندرج ضمن هذه المقاربة جميع المحاولات التي سعت إلى إعادة قراءة التراث بناءً على الربط بينه وبين الحوادث والتغيرات السياسية، مع تجاهل أو استبعاد مصدرية الوحي الإلهي. ولأن الموضوع مرتبط أساسًا بمقاربة مفهومية، وتدور على مفهوم محدّد سنقتصر في هذه المقالة على تصورَيْن: أولهما تضمنته دراسة لنصر حامد أبو زيد عن (مفهوم النصّ)، وهي دراسة تندرج في إطار علوم القرآن، سعى من خلالها إلى إبراز مفهوم النصّ من حيث ماهيته وخصائصه وتفاعله بالواقع، سعيًا منه إلى الاستدلال على وجاهة المقاربة الأدبية والنقدية لهذا النصّ، مقاربة تماثل بينه وبين النصوص البشرية. وثانيهما صادر عن محمد أركون المفكر الجزائري/ الفرنسي، علمًا أن بين التصورَيْن ما لا يُحْصى من أوجه التشابه والاقتراب، وهو ما يوحي بوجود وحدة المصدر والغاية في كليهما.
تقوم هذه المقاربة على أساسين:
أولهما: الارتباط بالواقع التاريخي وعدم تجاوزه، مما يجعل الواقع نموذجًا مفسرًا أو إطارًا به يتحقّق الفهم والإدراك العقلاني.
ثانيهما: بما أن الواقع متغيّر، فكذلك مسألة الفهم والإدراك.
في هذا الإطار سعت هذه المقاربة إلى تحديد (مفهوم النصّ) في إطار دنيوي بغية ربطه بالعوامل المتغيرة، بالرغم من عدم خوضها في مسألة أصل هذا النصّ، إلا أنها انشغلت بمسألة تلقّيه، ومدى فاعليته التاريخية، والحوار الناتج عن ذلك، باعتبار النزول أو الوحي حدثًا ينبغي تحليله بما يتلاءم والمعطيات التاريخية.
١.٢. مرجعيات المقاربة التاريخية:
ينطلق نصر حامد أبو زيد من الحاجة الملحّة -حسَب رأيه- علميًّا إلى تحديد مفهوم النصّ، فـ«لم يحظَ مفهوم النصّ بدراسة تحاول استكشاف هذا المفهوم في تراثنا إن كان له وجود، أو تحاول صياغته وبلورته إن لم يكن له وجود، إن البحث عن مفهوم ليس مجرّد رحلة فكرية في التراث، ولكنه فوق ذلك بحث عن البُعد المفقود في هذا التراث، وهو البعد الذي يمكن أن يساعدنا على الاقتراب من صياغة الوعي العلمي بهذا التراث»[20]. فما المقصود بالوعي العلمي أو المقاربة العلمية؟ إنّ قصد الكاتب من المقاربة العلمية يتّضح حين مقاربة العلمية بما يضادها -في نظره- وهو المقاربة الإيديولوجية أو العقدية، وهو توجّه سائد في ثقافتنا -بحسَبه- ينبغي أن يوضع له حَدّ.
ودون أن يبين الكاتب هل المفهوم موجود في تراثنا أم لا، فإنه يصادر على المطلوب بأن يصرّح بنتيجة مفادها أن القرآن الكريم يمثل ما صدق النصّ، ومن هنا ينبغي أن يعاد النظر إليه على وَفق هذا الوعي العلمي الجديد، فـ«البحث عن مفهوم النصّ ليس في حقيقته إلا بحثًا عن ماهية القرآن وطبيعته بوصفه نصًّا لغويًّا»[21]، وما دام القرآن نصًّا لغويًّا فلا يصح أن يقارب بمنهج بعيد عن المنهج اللغوي البنيوي على اختلاف مستويات النصّ اللغوي صوتيًّا وصرفيًّا ودلاليًّا، «وهذا الدرس الأدبي للقرآن في ذلك المستوى الفني، دون نظر إلى اعتبار ديني، هو ما نعتدّه وتعتدّه معنا الأمم العربية أصلًا العربية اختلاطًا، مقصدًا أول، وغرضًا أبعد يجب أن يسبق كلّ غرض ويتقدّم كلّ مقصد»[22].
ولأنّ تحديد المفهوم ليس مقصودًا لذاته، بل القصد هو إعادة النظر إلى تصوّرات الناس عن القرآن الكريم بعدّهِ وحيًا من الله تعالى، والسعي إلى تغيير هذا التصوّر نحو الموضوعية التي تفصل النصّ عن جانب القداسة، فإنّ نصرًا حدّد هدفين رئيسين لدراسته: «أمّا أولهما فهو إعادة ربط الدراسات القرآنية بمجال الدراسات الأدبية والنقدية، بعد أن انفصلت عنهما في الوعي الحديث والمعاصر نتيجةً لعوامل كثيرة أدّت إلى الفصل بين محتوى التراث وبين مناهج الدرس العلمي... الهدف الثاني يتمثّل في محاولة تحديد مفهوم موضوعي للإسلام، مفهوم يتجاوز الطروح الإيديولوجية من القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة في الواقع العربي الإسلامي»[23].
ويصرّ نصر في بداية الكتاب بصورة مبالغ فيها على أن «النصّ في حقيقته وجوهره منتج ثقافي، والمقصود بذلك أنه تشكّل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عامًا، وإذا كانت هذه الحقيقة تبدو بديهية ومتفقًا عليها، فإن الإيمان بوجودٍ ميتافيزيقي سابق للنصّ يعود لكي يطمس هذه الحقيقة البديهية ويعكّر مِن ثَمّ إمكانيةَ الفهم العلمي لظاهرة النصّ»[24]. ومن هنا فإنّ محور الدراسة كلّها في جميع الأبواب يدور حول جدلية الواقع والنصّ، والتأثير المتبادل بينهما، بل إلى درجة الزعم بأن الواقع قد عمل على تشكيل النصّ، والنتيجة التي يستلزمها هذا الفرض هو أن النصّ ليس هوية ثابتة بل مرتبط أساسًا بالتلقي ويتشكّل به، الأمر الذي يمكن أن يجعله مفتوحًا على أفق لا متناهٍ من التأويل.
ومن أهم المحاولات التي سعتْ إلى إعادة تعريف القرآن الكريم بعدّهِ نصًّا لغويًّا، محاولة المفكر الجزائي/ الفرنسي محمد أركون، فقد أكّد في كتابه (القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني) أنّ الوحي بمفهومه العام يتجاوز القرآن الكريم؛ لذا ينبغي وضعه في سياقه التاريخي بما يقتضيه ذلك من تفاعل متبادل لا يتجاوز الوقائع والأحداث، سعيًا منه إلى تجاوز «القراءة اللاهوتية الأرثوذكسية» التي نسبها إلى المفسِّرين والمتكلِّمين والفقهاء، بغية الوقوف على «قراءة تاريخية للوحي» تتجاوز منطق الإيديولوجيا والدوغمائية.
وأيًّا كان مفعول هذه الاصطلاحات وتأثيرها على نفس المتلقّي، فإنّ المؤدَّى في النهاية هو الوصول إلى ربط الصِّلة بين الواقع والنصّ، وقطع صِلته بالمصدر الإلهي المفارق، وإن كان قد ميّز بين المقاربتين معترفًا بمشروعية المقاربة اللاهوتية، إلا أنه دافع عن المقاربة اللسانية واللغوية بعدِّها مقاربةً تقدّمية ولها الأسبقية، يقول: «إنّ التحليل اللغوي والسيميائي سابق منهجيًّا وإبستمولوجيًّا على التحليل والتأويل اللاهوتيين»[25].
إلا أنّ أركون يفضل اصطلاح الخطاب على النصّ[26]، باعتبار أنّ القرآن خطاب لا نصّ، وكونه خطابًا يقتضي التشتيت والتشظّي، يقول: «الفكرة الأساسية تكمن في التلاوة المطابقة للخطاب المسموع، لا المقروء. ولهذا السبب بالذات أفضّل التحدّث شخصيًّا عن الخطاب القرآني وليس النصّ القرآني، عندما أصف المرحلة الأوّلية للتلفظ أو التنصيص من قبل النبي»[27].
وينصّ على المرجعيات التي استند إليها بصريح العبارة قائلًا: «إنّ النظر للكتابات المقدّسة من هذه الزاوية التاريخية والاجتماعية والأنثروبولوجية يعني بالطبع زعزعة كلّ التركيبات التقديسية والمتعالية للعقل اللاهوتي التقليدي»[28]، وفي هذا التصريح بالمرجعيات تصريح في الآن ذاته بالأهداف التي كان يسعى لبلوغها، وهي نزع القداسة عن النصّ القرآني.
إنّ هذا الوجه من النظر تبدو آثار الاستشراق واضحة عليه، فمقاربة الـ«نحن» بما أسّس من المعارف والعلوم نظريًّا وتطبيقيًّا عند «الغير» بصورة توحي بنوع من التملّك لا الكينونة هي مقاربة تستمد أُسسها النظرية من المناهج الاستشراقية، وهو ما يبرّر له أركون حين يقول: «لم يَعُد ممكنًا اليوم أن نتكلّم عن الاستشراق والمستشرقين كما كنّا نفعل حتى سبعينيات من القرن العشرين، وذلك من أجل رفضهم وإدانتهم والإعراض عن إنتاجهم العلمي، بل يجب علينا أن نقوم بترجمة أهم الأعمال المخصّصة للدراسات الإسلامية والتي ينتجها هؤلاء المستشرقون الأكاديميون بالذات»[29].
٢.٢. آليات المقاربة التاريخية:
إنّ أهم ما نادت به هذه المقاربة الحداثية ضرورة توظيف المنهج اللغوي والنقدي لتحليل النصّ القرآني بديلًا عن التفسير الموروث، فهو «المنهج الوحيد الممكن من حيث تلاؤمه مع موضوع الدرس ومادته»[30]، ذلك أنّ «النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغوية، بمعنى أنها تنتمي إلى بنية ثقافية محدّدة تم إنتاجها طبقًا لقوانين تلك الثقافة التي نعدّ اللغة نظامها الآلي المركزي»[31]. وهذه الدعوى مبنية على مسلّمة مطوية تقوم على نوع من المماثلة بين النصّ القرآني والنصوص البشرية، بما تنطوي عليه النصوص الإبداعية البشرية من الغموض والخداع وغياب المعنى أو تعدّده اللانهائي من جهة، ولكونها نصوصًا تنتج ضمن سياق من التفاعل بين وعي المبدع وتفاعلات الجماعة التي ينتمي إليها، ومعنى ذلك أن الإبداع لا يعدو أن يكون انعكاسًا لِما في الواقع والحياة.
ومن أهمّ آليات هذه المقاربة، آلية المقارنة، وهي آلية وظّفت من أجل بيان المماثلة لا المخالفة والتفرد[32]، «والحقيقة أنّ العرب المعاصرين لتشكيل النصّ لم يكونوا قادرين على استيعاب (التغاير) و(المخالفة) بين النصّ والنصوص التي لديهم؛ ولذلك كانوا حريصين أشدّ الحرص على جذب النصّ الجديد إلى أفق النصوص المعتادة، فقالوا عن النبي شاعرًا، وقالوا عنه كاهنًا. ولا شك أن هذه الأوصاف قامت عندهم على أساس من إدراك المماثلة بين نصّ القرآن ونصوص الشعراء والكهان»[33]. و«تحوّل الشِّعْر إلى أن يكون إطارًا مرجعيًّا لتفسير القرآن»، ولا يعدو الأمر أن يكون تغيّرًا ثقافيًّا هو تغيّر في «اتجاه الثقافة من الشِّعْر إلى القرآن»[34].
أمّا أركون فيرى أنه «يوجد في التراث الإسلامي شيء يدعى (قصص الأنبياء)، وهي تحتوي على العديد من القصص. ونخصّ بالذِّكْر منها تلك التي جمعها يهوديان اعتنقا الإسلام، وهما: كعب الأحبار، ووهب بن منبه. وهذه القصص العديدة تشكّل الخلفية الأسطورية التي تفسّر لنا سبب نزول كلّ آية من آيات القرآن (والآية هنا تعني القطعة الشفهية أو ما يدعوه علماء الألسنيات بالوحدة النصّية). إنّ هذه القصص تبيّن لنا العلاقة القوية بين تفاسير القرآن، وبين المخيال الديني الذي ساد طيلة القرون الهجرية الثلاثة الأولى»[35].
وتعدّ (الأنسنة) أهم آلية لهذه المقاربة، وتستهدف أساسًا «رفع عائق القدسية، ويتمثّل هذا العائق في اعتقاد أنّ القرآن كلام مقدّس»[36]،فتسعى إلى تثبيت تصوّر ناقل للنصّ من الوضع الإلهي إلى وضع بشري لا يكاد يختلف عن بقية النصوص البشرية الأخرى، وإن كان روّاد هذه المقاربة يصرّحون بالفصل بين القراءة والأصل، وأن القراءة الموضوعية لا تستدعي فصل الموضوع عن مصدريته، إلا أن واقع الحال يشهد بعكس ذلك.
إنّ هذا النمط من المقاربات في مستواه السطحي يبعد مسألة الميتافيزيقا أو الحديث عن مصدرية النصّ، مقتصرًا -فيما يبدو- على دراسة جدلية الواقع والنصّ، إلا أنّ الإشكال يكمن في نوعية الربط بين الواقع والنصّ؛ إذ الواقع لا يتّخذ سبيلًا لمعرفة النصّ وتفسيره، بل يتجاوز ذلك إلى دراسة عوامل التأثير والتأثر، بناءً على مسلّمة الاقتران بين الوجود المادي وغير المادي، وأن الثاني ناتج عن الأول غير مفارق له، وذلك يفضي بالضرورة إلى القول بإبداعية الوحي وإن اختلف الأمر في الدرجة.
٣.٢. في نقد المقاربة التاريخية:
1- تقوم هذه المقاربة على مغالطة واضحة مفادها أن المنجز التفسيري التراثي يقوم على أساس إيماني محض دون الوقوف على بناء النصّ القرآني لغويًّا وبلاغيًّا وجماليًّا، وهذه دعوى لا دليل عليها، بل هناك ما يُبطِلُها إذا ما أقمنا علاقة حوارية مع هذا التراث، فالمنجز التفسيري أساسًا يقوم على شرط العلم بالعربية ومعهود العرب وعاداتهم في الكلام، ولا يقتصر الأمر هنا على العلم بالعربية من حيث بنياتها صوتًا وصرفًا وتركيبًا ودلالة، بل يتجاوز ذلك إلى ما له علاقة بالمقام والأحوال، وأنّ لهذه الأحوال والمقامات دورًا أساسيًّا في فهم النصّ، إلا أن هذا الوعي لم يصل بهم إلى قطع النصّ عن مصدره الإلهي، وجعل الأمر كما لو أنه مجرّد ميثولوجيا غير مقبولة منطقًا وعقلًا.
إنّ الطبيعة اللغوية للنصّ القرآني بعدّهِ خطابًا طبيعيًّا يستجيب لعادة أهل العربية في الاستعمال =خاصية تؤكّد جانبًا مهمًّا من أبعاده الرسالية، وهو بُعد الشمولية؛ إِذْ لو لم يكن كذلك لَما تحقق فهمه أو التفاهم معه.
2- إن الغاية من القراءة الحداثية/ التاريخية للنصّ القرآني، وسعيها إلى تحديد مفهوم النص وَفقًا للبُعد الزمني، إنما تكمن في حصر النصّ وَفق هذا البُعد من جهة، ثم جعله بموجب ذلك واحدًا من النصوص التراثية الأدبية التي لا تتجاوز وظيفتها تحقيق حالة من الاستمتاع القائمة على الغريب والعجيب، دون أن يتجاوز ذلك إلى السلوك الإنساني وما يرتبط به من أحكام وضوابط، ولتبلغ المقاربة غايتها لزمها أن تقرأ النصّ القرآني قراءة مغايرة، قراءة تضعه وضعًا إشكاليًّا منفتحًا «على احتمالات متعدّدة، ويقبل تأويلات غير متناهية، ولا ميزة لتأويل على غيره»[37].
لا يتعلّق الأمر بالانفتاح في التأويل، أو اعتبار الشروط الظرفية زمانًا ومكانًا وأحوالًا، بل الإشكال يرتبط بما أسماه الدكتور/ محمد الحيرش بالفوضى التأويلية التي يمكن أن تُوقعنا فيها مثل هذه المقاربات، ذلك أن أيّ مقاربة تستبعد سياقات تكوين النصوص وفرادتها، إنما تعمل على أن تسلّط سيوفها على رقاب تلك النصوص من أجل امتلاكها على غير بيّنة من علمٍ أو معرفة، وينبغي التأكيد على أن الأمر لا يتعلّق هنا بالتاريخية بما هي مطابقة بين النصّ والواقع، فـ«رجوع المفسّرين إلى الوقائع الزمنية للنصّ ليس رجوعًا بغرض إقامة مطابقة تاريخية بين النصّ وتلك الوقائع، إنهم لا يتوخّون بذلك إيجاد شروط محدّدة تتيح لهم ضبط تاريخية النصّ، وإنما يتوخون البحث عن الشروط الموضوعية التي تتيح لهم إمكان الفهم والتفسير، وعلى هذا الأساس اتّخذ كلُّ ما يرتبط بالسياق التاريخي للنصّ عند المفسِّرين وعلماء القرآن أهميةً تفسيرية لا تاريخية... فتاريخية تلك الوقائع ليست هي المقصودة بالنسبة إلى المفسّر»[38].
3- يتبيّن إذن، أنّ الربط بين السياق التاريخي لنزول الوحي وتفسير النصّ، أمرٌ مشروع ويسهم بدور كبير في فهم النصّ فهمًا قويمًا، وهذا ما أشار إليه الشاطبي في نصٍّ دالٍّ حيث يقول: «معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن»، ويستدلّ على ذلك بدليلين، أولهما: أن «علم المعاني والبيان الذي يُعرف به إعجاز نَظْم القرآن، فضلًا عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب أو المخاطَب أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسَب حالين، وبحسَب مخاطبين، وبحسَب غير ذلك» وثانيهما: أن «الجهل بأسباب التنزيل مُوقِع في السبة والإشكالات، ومُورِد للنصوص الظاهرة مَورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع»[39]. فتبدو الغاية واضحة من استحضار هذه الجوانب المحيطة بالنصّ، وهي السعي إلى فهمه حقّ الفهم، من أجل تنزيله وَفق مراد الشارع ومقصوده.
خاتمة:
يمكن أن نخلص مما درسناه سالفًا إلى عدّة خلاصات:
أولًا: أن هذه القراءات الحداثية تتسم بخاصية جوهرية هي أنها تخرج عن الصفة الاعتقادية لتتصف بضدّها، وهي الصفة الانتقادية، «فالقراءات الحداثية لا تريد أن تحصِّل اعتقادًا من الآيات القرآنية، وإنما تريد أن تمارِسَ نقدها على هذه الآيات»[40]، ومن الواضح البيِّن هذا الإعلاء من شأن الذات التي تعلي من منسوب الثقة إلى درجة عالية، إنما تقوم أساسًا على نوع من الاعتقاد الواثق في الذات العاقلة وجعل تلك الثقة صمام الأمان.
ثانيًا: إذا كان الأمر مرتبطًا أساسًا بالإنسان، فلتكن العلاقة إذن علاقة تفاعلية حوارية مع النصّ القرآني بما أثبته القرآن ذاته، فقد أشارتْ آيات كثيرة إلى عربية القرآن الكريم بما يجعل من محاورته أمرًا مشروعًا، وهو الأمر الذي نتجت عنه الكثير من الآراء والمذاهب دون المساس بقدسية النصّ ومصدره الإلهي، إلا أن المقاربات الحداثية في مجملها تعمل على تنحية الإله وإحلال الإنسان محلّه من أجل اكتشاف الدلالة أو المعنى، والتأثّر بفلسفة الأنوار هنا واضح؛ إذ الأساس الذي يقوم عليه مفهوم التنوير هو الاعتماد على التفسير الفرداني للنصوص وتوظيفها وَفقًا لذلك.
فالوحي ليس معطى أنتجته ثقافة اللغة العربية وواقعها الاجتماعي في لحظة تنزّل الوحي، وإنما فعل شرعي في التاريخ اتخذ مسلك اللغة العربية للتغيير الشمولي والدائم للواقع الإنساني في أيّ زمن تاريخي؛ ولذلك لا يمكن إطلاقًا نزع التعالي والقداسة عنه بناء على كونه لغة بشرية تحمل حروفًا وكلمات ومدلولات بشرية. فنقطة التقاطع بين النصّ الشرعي والتاريخ الإنساني هي اللغة[41].
ثالثًا: كلّ نظرية تأويلية ينبغي أن يكون لها ما يسندها من النصّ، وإن كان الغالب أن «تُصاغ نظريات التأويل في غيبة النصوص أو على الهامش منها؛ وهو ما يجعلها نظريات مغرقة في التجريد، ومفتقرة أطرها ومقترحاتها التأويلية إلى أسانيد نصية»[42]. فبالرغم من فاعلية القارئ في العملية التأويلية، إلا أنها تظلّ محدودة بحدود موضوعية ترتبط بمجموعة من المحددات المنهجية والمعرفية، مثل سياق النصّ واتساقه وانسجامه، وكلّ هذه العوامل تسهم بدورها في تحقيق الفهم.
رابعًا: مبدأ العلمية الذي اتُّخِذ ذريعة لمقاربة النصوص وتأويلها اتضح أنه مبدأٌ واهٍ وواهِمٌ يؤدي إلى اختزال النصوص وردّها إلى جانب واحد هو الجانب اللغوي اللساني وَفق ما تقتضيه البنية من الانغلاق والاكتفاء بالعناصر الداخلية وعلاقاتها، أو ترك النصوص ومقتضياتها إلى دراسة ما يحيط بها، بينما حقيقة النصوص تتجاوز ذلك، بحيث تعدّ كل هذه العوامل بمثابة وسائل لتحقيق حوارية متسمة بالغنى مع النصوص.
خامسًا: إنّ «الوعي بقصدية النصّ لا يتعارض مع تعدّد جهات الاحتمال فيه، ولا مع ما يصطنعه لها المفسّرون من ممكنات تأويلية، فهو وعي بما يجعل هذه الممكنات اقترابًا من عوالم النصّ في تفاوت تحقّقاتها الدلالية، وذلك من دون أيّ إغفال أو إعدام لِما يتخذ منها وجودًا قصديًّا وإراديًّا، أي: وجودًا لم يكن له أن يتحقّق كذلك إلا لكون النصّ يجعل منه معيارًا ترتد إليه تلك الممكنات، وتستمدّ منه معقوليتها وصلاحيتها التأويلية»[43].
وفي الأخير «نؤكد أنّ الوعي بالاختلاف في النصّ القرآني هو وعي يجد خلفيته عند المفسِّرين في وحدة النصّ، وتحديدًا في الافتراض القاضي بأن (القرآن كالآية الواحدة)»[44]، من هنا كانت مقاربة القرآن الكريم مقاربة تخوض غمار الحوار مع المنجز التفسيري، بعيدًا عن أيّ إسقاط منهجي أو مذهبي، بغية التوصل إلى الآليات العلمية الموظفة في هذا المنجز يمكن أن تفضي بنا إلى نتائج أغنى، وأفق أرحب للنقاش العلمي، وذلك ما تدلّ عليه المدارس التفسيرية المتنوعة، من هنا كانت المقاربة التراثية أكثر غنى وأوسع أفقًا، سواءٌ ما ارتبط منها بالموروث التفسيري باختلاف توجهاته، أو ما اتصل ببعض العلوم الإسلامية ذات الصلة، مثل أصول الفقه؛ إذ الدارس لهذه العلوم يمكنه أن يستنتج بسهولة مدى التعدد الذي تتيحه في حفظٍ لمقتضيات النسق ومبادئه، وبناءٍ علمي متناسق ومتكامل، وتظلّ المقاربة التاريخية مقاربة قاصرة علميًّا، سواءٌ في بُعدها الآلي، أي: توظيفها للمنهج البنيوي والمقاربة اللغوية للنصّ، أو في بُعدها الغائي وهو نزع القداسة عن النصّ، لاختزالها تراثًا بأكمله إلى أبعاد غير علمية أو معرفية، مع أن هذا التراث يأبَى في روحه وجوهره أن يُختزَل في صورة نمطية موحَّدة.
[1] ينظر: النصّ من القراءة إلى التنظير، محمد مفتاح، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1999. ص9.
[2] النص من القراءة إلى التنظير، محمد مفتاح، ص9.
[3] لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: عبد الله عليّ الكبير، محمد أحمد حسَب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، د.ت، (6/ 4441- 4442).
[4] يكفي القارئ أن يعود إلى مصدر من المصادر الأصولية، ويتتبع القضايا اللغوية التي يشتغل بها الأصولي لتتبين له زاوية التمايز بين الرؤية التي تحكم كُلًّا من عمل الأصولي واللغوي.
[5] كتاب المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسن محمد بن عليّ البصري، تهذيب وتحقيق: محمد حميد الله، بتعاون محمد بكر، وحسن حنفي، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، 1964، (1/ 319).
[6] شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، شهاب الدين القرافي، دار الفكر، 2004، ص36.
[7] كتاب المعتمد، أبو الحسن البصري، مصدر سابق، (1/ 319).
[8] كتاب المعتمد، أبو الحسن البصري، مصدر سابق، (1/ 319).
[9] فقه الفلسفة، الفلسفة والترجمة، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، (1/ 39).
[10] لمزيد من التوسع في هذه الأُسس التي على أساسها بنيت هذه التصوّرات يمكن العودة إلى كتاب: النصّ الأدبي، لعبة المرايا، عبد الرحيم جيران، الدار المغربية العربية، الطبعة الأولى، 2016، الرباط.
[11] الأدب والغرابة، دراسات بنيوية في الأدب، عبد الفتاح كيليطو، ص16.
[12] النص وآليات الفهم في علوم القرآن، دراسة في ضوء التأويليات المعاصرة، محمد الحيرش، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، يونيو، 2013، ص219.
[13] النص وآليات الفهم في علوم القرآن، مرجع سابق، ص220.
[14] لأن اهتمامنا هنا يتعلق بالمفهوم فقط، أشرنا إلى هذه الأبعاد عن طريق التلميح والإشارة، ونحيل القارئ إلى الكتاب إن أراد التفصيل في الموضوع، إِذْ يعرض فيه الباحث لمسألة الإعجاز القرآني متوقفًا عند كثير من التفاصيل سواءٌ ما ارتبط منها بالدراسات التراثية المقارنة بين النصّ القرآني وغيره من النصوص الأخرى وبيان تفرده عنها، أو الدراسات التي كانت تسعى إلى بيان سر الإعجاز وبواعثه، والنقاش الكلامي/ البلاغي حول الموضوع.
[15] النص وآليات الفهم في علوم القرآن، مرجع سابق، ص240.
[16] النص وآليات الفهم في علوم القرآن، مرجع سابق، ص241.
[17] النص وآليات الفهم في علوم القرآن، مرجع سابق، ص241.
[18] النص وآليات الفهم في علوم القرآن، مرجع سابق، ص261.
[19] النص وآليات الفهم في علوم القرآن، مرجع سابق، ص276، وينبغي أن أؤكد على أن هذه الإشارات العامة غير كافية لتكوين تصور عن أطروحة البحث، غير أنها كفيلة بإثارة فضول القارئ ودعوته إلى مراجعة الكتاب/ الأطروحة؛ إِذْ قد بذل الأستاذ محمد الحيرش جهدًا جهيدًا في إعداد الأطروحة، يبدو واضحًا في عمق التحليل، وقوة المواقف التأويلية وتماسكها علميًّا ومعرفيًّا.
[20] مفهوم النصّ، دراسة في علوم القرآن، نصر حامد أبو زيد، مؤسّسة مؤمنون بلا حدود، نشر المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2014، ص10.
[21] مفهوم النصّ، نصر حامد أبو زيد، ص10.
[22] مفهوم النصّ، نصر حامد أبو زيد، ص10.
[23] مفهوم النصّ، مرجع سابق، ص20- 21.
[24] مفهوم النصّ، مرجع سابق، ص24.
[25] القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ترجمة: هشام صالح، دار الطليعة- بيروت، ص5.
[26] يمكن أن نشير هنا إلى أنّ نصر حامد أبو زيد قد غيّر موقفه من تصوّر النصّ بحيث انتقل من النصّ إلى الخطاب، خصوصًا في كتابه (التجديد والتحريم والتأويل، بين المعرفة العلمية والخوف من التفكير) الصادر عن المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2010، الدار البيضاء، ص214، إِذْ يصرّح بأنه قد حوّل منظوره في التعامل مع القرآن الكريم «من منظور كونه نصًّا، إلى النظر إليه باعتباره خطابًا أو خطابات لكلّ منها سياقه الذي لا تستبين دلالة الخطاب إلا به». ويشير في سياق حديثه ذلك إلى دراسات لمحمد أركون، وخلاصاته، وهما يتلاقيان في أكثر من نقطة. [للتوسّع في هذا الموضوع يُرجى العودة إلى دراسات للباحث طارق حجي، منشورة على موقع تفسير].
[27] الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، ص73.
[28] الفكر الإسلامي، محمد أركون، ص83.
[29] القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ص8.
[30] مفهوم النص، مرجع سابق، ص25.
[31] نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، ص203.
[32] آلية المقارنة وجدت في كتابات علمائنا القدماء لكنها كانت لغاية، وذلك من أجل بيان تفرد القرآن الكريم، خصوصًا في مجال الإعجاز، ويمكن أن نشير هنا إلى ما كتبه الباقلاني -مثلًا- في إطار بيان تمايز النصّ القرآني وبلاغته عن الشِّعْر، إِذْ يؤكّد على «كون كلام العرب غير مشتمل على فصاحة القرآن وغرابته، ولطيف معانيه، وغزير فوائده، وما إلى ذلك»، وأنه غير متفاوت في حين يقع التفاوت في كلام العرب، وغيرها من وجوه المقارنة، بل ينتقل من هذه المبادئ النظرية إلى دراسات تطبيقية مبينًا فيها مباينة كلام الله تعالى لكلام البشر، بدءًا بخُطَب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام البلغاء والفصحاء، والشعراء. (ينظر: إعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف بمصر، د.ت).
[33] مفهوم النص، مرجع سابق، ص138.
[34] مفهوم النص، مرجع سابق، ص141.
[35] القرآن، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ص30.
[36] روح الحداثة، طه عبد الرحمن، ص178.
[37] روح الحداثة، طه عبد الرحمن، ص180.
[38] النص وآليات الفهم في علوم القرآن، محمد الحيرش، ص201.
[39] الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، شرح الشيخ عبد الله دراز، دار الحديث، القاهرة، 2006، (3/ 241).
[40] روح الحداثة، طه عبد الرحمن، مدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، ص176.
[41] النص الشرعي وبناء مفهوم التأويل، د. عبد الرحمن العضراوي، مقال منشور على موقع الرابطة المحمدية للعلماء، www.arrabita.ma، تاريخ زيارة الصفحة: 2/ 8/ 2022م.
[42] النص وآليات الفهم في علوم القرآن، محمد الحيرش، ص81.
[43] النصّ وآليات الفهم في علوم القرآن، محمد الحيرش، ص114.
[44] النصّ وآليات الفهم في علوم القرآن، محمد الحيرش، ص150.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

كريم التايدي
أستاذ اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي، وباحث بسلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة عبد المالك السعدي - تطوان
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))