أثر القرآن في الحياة العربية (1-2)
أثر القرآن في الحياة العربية (1-2)
الكاتب: مصطفى السباعي
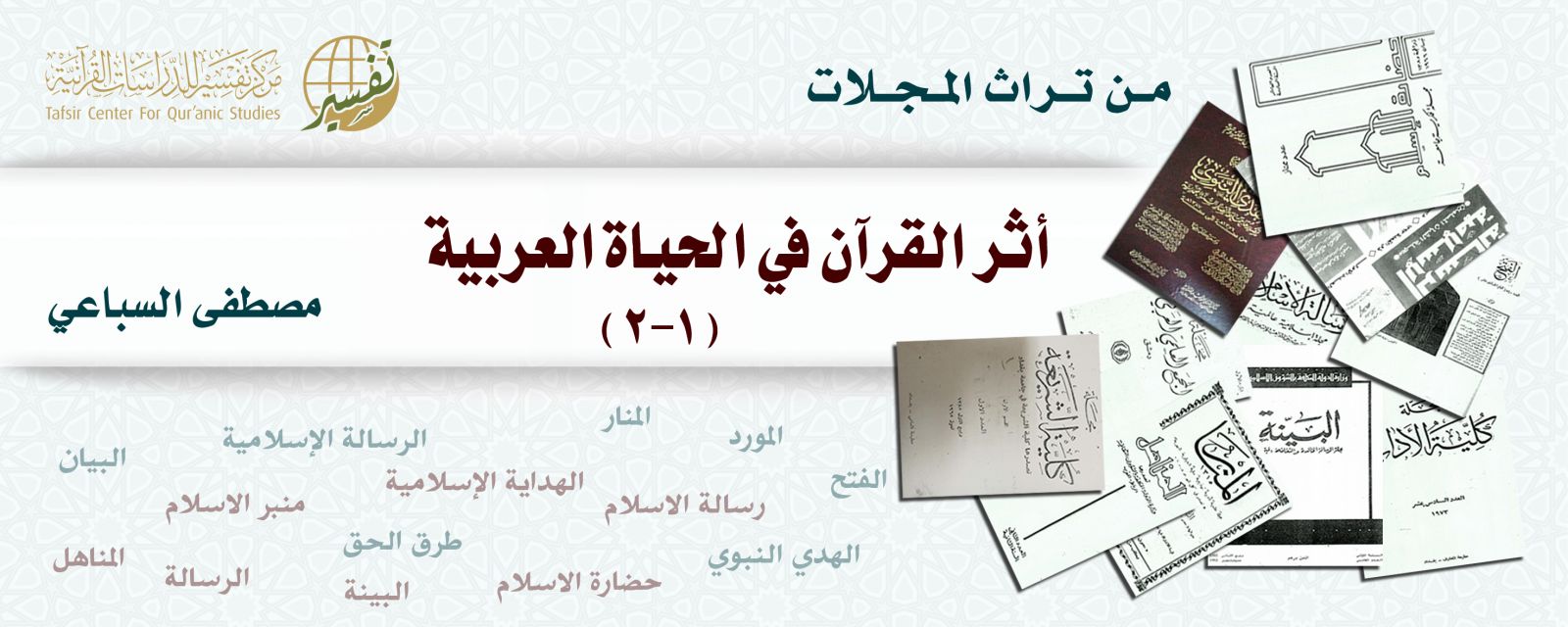
أثر القرآن في الحياة العربية[1]
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة: 185].
{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [الجمعة: 2].
{وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الجمعة: 3-4][2].
مما يذكره العلماء من حكمة فرض الصيام في شهر رمضان؛ أنه هو الشهر الذي ابتدأ فيه نزول القرآن على رسوله الكريم -صلى الله عليه وسـلم-، فبدأت فيه الرسالة التي غيرت تاريخ العرب وأوضاعهم حتى لكأنما خلقوا خلقًا جديدًا، وحولت مجرى الحضارات الإنسانية حتى لكأنما ولد الإنسان من بعدها ولادة جديدة، فكان من تمام شكر الله على هذه النعمة أن يكون شهرها دائمًا وأبدًا شهر طُهر وبِرٍّ وعبادة؛ مما يجدد في نفس المسلم كلّ عام أهداف هذه الرسالة العظيمة، ويذكّره بفضل القرآن العظيم عليه، وعلى قومه وعلى الناس أجمعين.
ولقد كان الرعيل الأول ممن شرفه الله بصحبة رسوله، وتبليغ رسالته، وحمل مشاعل النور لشعوب العالم المتردّية في الغفلة والجهالة والضلالة، يعرف من فضل الإسلام عليه وأثر القرآن في نقلته من الظلام إلى النور ما يجعله يستقبل رمضان في كلّ عام كما يستقبل أعز الذكريات لديه وأحبها إليه، فلما بعد العهد وانتقل ذلك الجيل إلى جوار ربه أصبح أبناؤه وأحفاده الناشئون في أحضان الإسلام في أشدّ الحاجة إلى من يذكّرهم بجلال نعمة القرآن، وجميل صنع الله بالإنسان، في بعثة رسوله وإنزال كتابه، وهذا هو ما عناه عمر -رضي الله عنه- بقوله: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة؛ إذا نبت فيه من لا يعرف من أمر الجاهلية شيئًا»، ولم تصدق نبوءة الفاروق هذه في عصر كصدقها في عصرنا هذا.
ومنذ انتشرت الجيوش الإسلامية في أنحاء الأرض فأزالت دولًا وأقامت دولًا، وحطمت عروشًا باغية وزعامات طاغية، وأقامت حكومات تعنى بأمر الشعب وتهتم بمصالحه؛ أخذ الحاقدون الموتورون يعتمدون تشويه تاريخنا بمختلف الأساليب، بالجهر تارة وبالسر أُخرى، حتى بات انحرافهم عن الحقّ واتباعهم للهوى أمرًا معروفًا يكادون يعترفون به هم أنفسهم، ومن ذلك حقيقة الوضع الذي كان عليه العرب قبل الإسلام، فقد صوّروهم في أبشع صورة وأحطّ صورة وأحطّ درك، وجردوهم من كلّ فضيلة وخلق نبيل، وكانت لذلك ردّة فعل تجلّت بشكلٍ معتدل في الماضي؛ إذ ردّت كلّ الأكاذيب وأثبتت ما كان يتحلى به العرب من فضائل، وتجلّت ردّة الفعل في الحاضر بأشكال مختلفة لا نزال نذكر من بينها أمر تلك الجماعة التي قامت في مصر وادّعت من الفضائل للعرب قبل الإسلام ما لا يثبته التاريخ ولا يؤيّده الإسلام نفسه، حتى زعمت تلك الجماعة أنّ رذائل العرب في الجاهلية خير من فضائل غيرهم في الإسلام! والحق بعيد عن هؤلاء وأولئك كلّ البعد، واتباع حقائق العلم والتاريخ أجدر بالذين يحملون القلم ويقرؤون الكتاب.
من المسلَّم به أنّ لكلِّ أمة فضائلها وعيوبها، ولا نعرف أمة كلّها عيوب، أو أمة كلّها فضائل، وكذلك كان شأن العرب قبل الإسلام؛ فقد كانت لهم فضائل من النجدة والشهامة والكرم والشجاعة والذكاء وتحمّل المشقات بصبر وجلد، إلى غير ذلك مما لا يستطيع إنكاره كلّ من قرأ الشعر العربي القديم -وهو ديوان العرب وسجل أعمالهم وخصالهم-، كما كانت لهم عيوب من الغزو والتفاخر فيما بينهم وعبادة الأوثان وشرب الخمور، وغير ذلك مما كانت لكلّ الأمم في عصورهم، فماذا كان موقف القرآن والإسلام من هذه الفضائل والرذائل؟
نريد أن نقول قبل كلِّ شيء: إنّ كلّ رسالة إنسانية لا بد لها من أمة جديرة بحمل أعباء الدعوة إليها، وبما يتفق مع طبيعة الأمة وأهداف الرسالة وظروف البيئة، ولقد كان العرب يومئذٍ أجدر الأمم المعاصرة لهم بشرف دعوة الإسلام وإبلاغ رسالته الإنسانية إلى الناس كافة، فأذهانهم صافية صفاء السماء التي يستظلونها، بعيدة عن التخبط الفكري الذي كانت تعيش فيه أبناء فارس والروم، وأخلاقهم لم تنحلل كانحلال أبناء الحضارات في كلّ من فارس والروم، لقد جاءت رسالة الإسلام منطقية معقولة تخاطب العقل، وتنفذ إلى أعماق النفس بكلّ يسر وسهولة، فليس كالعقل العربي يومئذ عقل يتجاوب مع منطق الإسلام، وليس كالفطرة العربية حينئذ فطرة نقية بيضاء تقبل سهولة الإسلام ويسره وسموّه، وتتجاوب مع واقعيته ومثاليته، وليس كالعربي حينئذ في جَلَدِهِ وصبره وبأسه، أمة تبذل من التضحيات في الأنفس والأموال ما تقتضيه الدعوة الجديدة ومكافحة أعداء أهدافها من رؤساء ومتسلطين، وبهذا كان العرب أجدر الأمم في عصر محمد -صلى الله عليه وسـلم- بحمل رسالة الإسلام، لا لأنهم قوم لا عيب فيهم، بل لأنّ خصائصهم الذهنية وأخلاقهم الاجتماعية تجعلهم جديرين بشرف التضحيات في سبيل الدعوة الجديدة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وليست جدارتهم بحمل أعباء الرسالة من الناحية التي أشرنا إليها تقتضي أن يكونوا أشرف الأمم قاطبة من الوجهة العرقية الجنسية، فقد يكون الإنسان أصلح من غيره لعملٍ معين، دون أن يكون أصلح من غيره في كلّ الوجوه، كما كان قواد الرسول -صلى الله عليه وسـلم- وولاته أجدر من غيرهم من الصحابة لكفاءتهم الشخصية وعبقريتهم العسكرية، وقد كان تحت إمرتهم من هو أزهد منهم أو أعبد أو أعلم، واعتبر في ذلك بأبي ذر -رضي الله عنه-، فقد شهد له رسول الله -صلى الله عليه وسـلم- بأنه: «ما أظلت السماء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»، ومع هذا فقد رفض -عليه الصلاة والسلام- أن يوليه الإمارة قائلًا له: إنك ضعيف، وإنك لا تصلح لها.
بعد هذه المقدمة التي لا بد منها نريد أن نبحث عن أثر القرآن في العرب وموقعه من فضائلهم وعيوبهم.
لقد ندد القرآن بكلّ ما لا يليق أن يتخلق به الإنسان العاقل الكريم الرحيم ذو الخلق المستقيم؛ فندّد بعبادة الأوثان، ووأد البنات، والعدوان على الأموال والأعراض والحرمات، وشرب المسكرات، وإتيان الفواحش، والتعصب بالباطل للقرابة والقبيلة، وأكل الخبائث، وقطع الأرحام، وغير ذلك مما كانت ولا تزال تغصّ به المجتمعات الجاهلية المتفككة.
وأما الفضائل فقد ثبتها الإسلام وأكّد عليها، ولكنه حوّلها من أهدافها الجاهلية إلى أهداف إنسانية اجتماعية نبيلة، فالكرم فضيلة لكنه كان يقصد منه التفاخر والسمعة والثناء، وكان الرجل منهم يفعله بدافع فردي من غير أن تلاحظ فيه مصلحة الجماعة عامة، فحوّله الإسلام إلى أن يفعل لوجه الله ورضوانه، وثناء الله وإحسانه، فعلى الكريم أن يبتعد كلّ البعد عن التفاخر بكرمه والتغني به والمنّ به على قومه، فإذا كان لشيء من هذا فَقَدَ أجره وثوابه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: 264].
وقل مثل ذلك في الشجاعة، فهي من أنبل ما يتحلى به الإنسان من خلق كريم، ولكنها لا يصح أن تكون للمباهاة والمفاخرة، ولا يصح أن يتغنى بها الشجاع، ويتيه بها على المنهزمين من أبناء عمومته، أو أن تكون وسيلة للعدوان على الضعفاء، بل يجب أن تكون دفاعًا عن الحقّ، وذودًا عن الحرمات، وحماية للمستضعفين، وتأديبًا للطغاة والظالمين {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39]، {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء: 75]، وقد سئل رسول الله -صلى الله عليه وسـلم- عن الرجل يقاتل حميّة، ويقاتل شجاعة، ويقاتل مباهاة؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». وكلمة الله أي شريعته؛ من إحقاق الحقّ، ومحاربة الباطل، ونصرة الضعيف، وهداية الضالّ، وإغاثة المحتاج، فكلّ ذلك من شريعة الله وكلمته، فمن قاتل للمبادئ الإنسانية النبيلة فهو المجاهد في سبيل الله حقًّا.
ولقد كان من أثر القرآن أن تحقق في المجتمع العربي بعد أن لم يكن:
- تأمين العدالة الاجتماعية لجميع الناس.
- إكرام المرأة وضمان حقوقها، ومنع العدوان عليها.
- إزالة الفوارق بين أبناء المجتمع، فلا طبقيّة ولا إذلال من فئة لفئة.
- سيادة الحقّ لا القوة، والعقل لا الخرافة، والبرّ لا العدوان.
ومن أهم آثار القرآن في المجتمع العربي أنه وضع للإنسان مثلًا عليا هي محض الخير والكرامة له ولقومه ومجتمعه، وإنّا لنتلمس المثل الأعلى في الحياة الجاهلية في قول طرفة بن العبد في معلقته:
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وَجَدِّكِ لم أَحْفل متى قام عُوَّدي[3]
فَمِنهُنَّ سبقي العَاذِلاتِ بِشَربةٍ كُمَيتٍ متى ما تُعلَ بالماء تُزْبِدِ[4]
وكرّي إذا نَادى المضــــــــاف مُحنبًا كَسيد الغَضَا -نبهته- المتوردِ[5]
وتقصيرُ يومِ الدجنِ والدَّجنُ معجِبٌ ببهكنــةٍ تحتَ الخبــاءِ المعمــدِ[6]
فهو هنا يعلن بأنّ هدفه من الحياة ثلاثة: الخمرة، والمرأة، وإغاثته للملهوف، ولولاها لما بالى متى مات، والهدفان الأوّلان من مفاسد الحياة الاجتماعية، والهدف الثالث وهو إغاثته للملهوف من فضائل الأخلاق، ولكنه يفعل ذلك ليتحدث عنه أبناء قبيلته بهذه المكْرمة كما هو المعروف في أجواد العرب وشجعانهم وشعرائهم في الجاهلية.
فانظر كيف حول القرآن المثل الأعلى للعربي في الحياة:
يقول الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، فعبادة الله هي هدف الإنسان المؤمن، وليست العبادة مجرد الصلاة والصوم كما يظنه كثير من الناس، بل هو في الخضوع لله وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه في كلّ شئون الحياة، مما علم الله أن الحياة الكريمة للإنسان لا تستقيم بدونها، وقد ذكر القرآن أمثلة للعبادة التي أراد الله من الناس أن يتصفوا بها فقال: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا} [الفرقان: 63-76].
هنا في هذه الآيات يتجلى التبدّل العظيم الذي طرأ على المثل العليا التي يحيا لأجلها الإنسان العربي قبل الإسلام وبعده، ومن ههنا نعرف السرّ العظيم في تطور التاريخ العربي بعد الإسلام تطورًا معجزًا لا يعرف تاريخ التطور للأمم والشعوب له مثيلًا.
[1]مجلة حضارة الإسلام، م:8، 1383هـ -1964م، العدد التاسع، ص: 947-953.
[2]تمَّ تخريج الآيات القرآنية داخل المقال من جانبنا (موقع تفسير).
[3] يقول: لولا ثلاث خلال -وهي التي ذكرها في البيتين التاليين- لم أبالِ متى متّ.
[4] يريد: أغدو على شرب الخمر قبل لوم العاذلات، والكميت الحمراء، ومعنى تعل بالماء تزبد: متى أضيف الماء إليها أصبح لها زبد.
[5]يقصد: ركوبه فرسًا شديد العدو لإسعاف من يناديني من المثقلين بالهموم، والمحنب: فرس أقنى الذراع، والسيد: الذئب، قالوا: وذئب الغضا أخبث الذئاب؛ لأنه يستخفي، ونبهته: هيجته، والمتورد: الذي يطلب ورود الماء، يشبه فرسه في شدة عدوها بذئب الفضاحين تهيجه وهو يرد الماء.
[6] يريد: وتقصير يوم الغيم باللهو مع امرأة تامّة الخلق تحت الخباء المرفوع بالعمد.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

مصطفى السباعي
مؤسس كلية الشريعة بدمشق عام 1955م، وأول عميد لها، له كثير من المؤلفات والمقالات في عدد من الصحف والمجلات.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))









