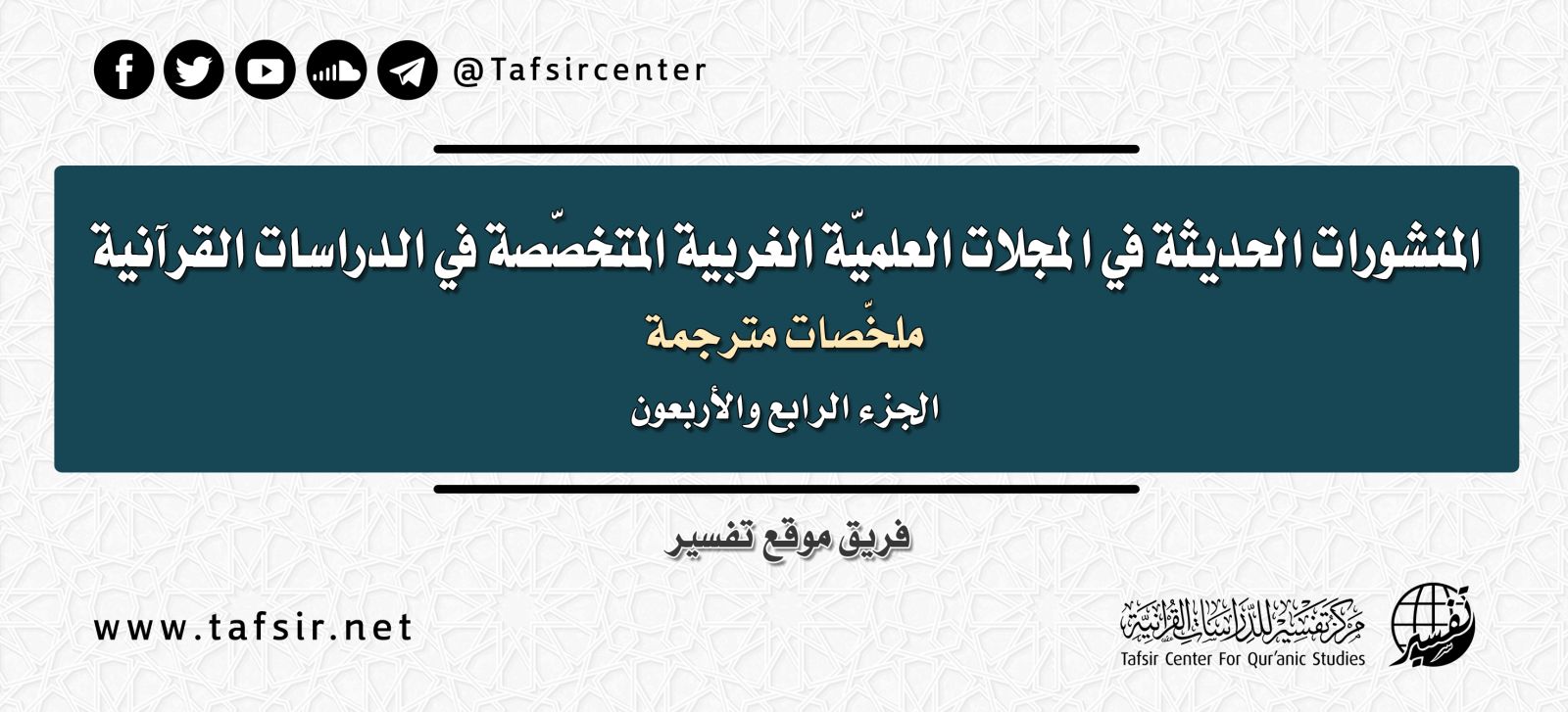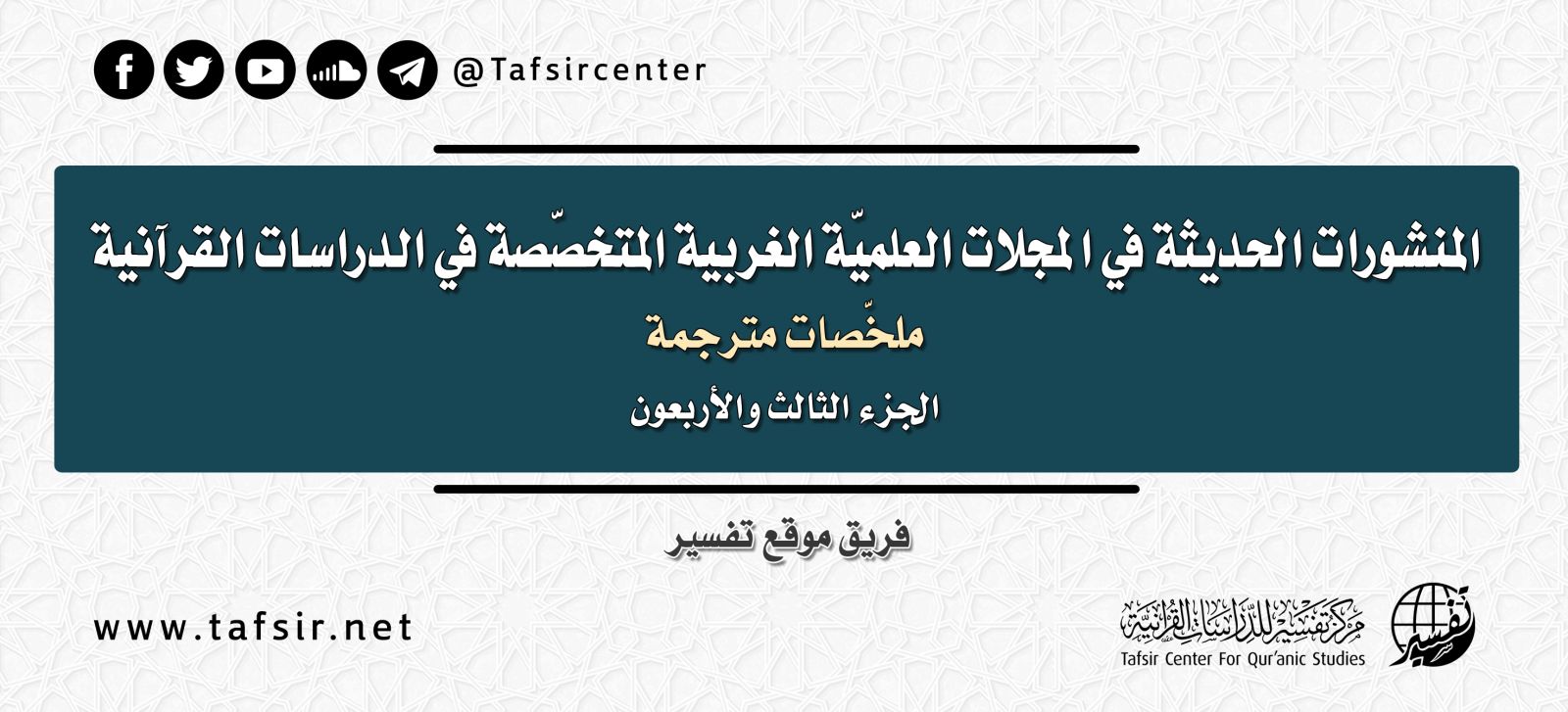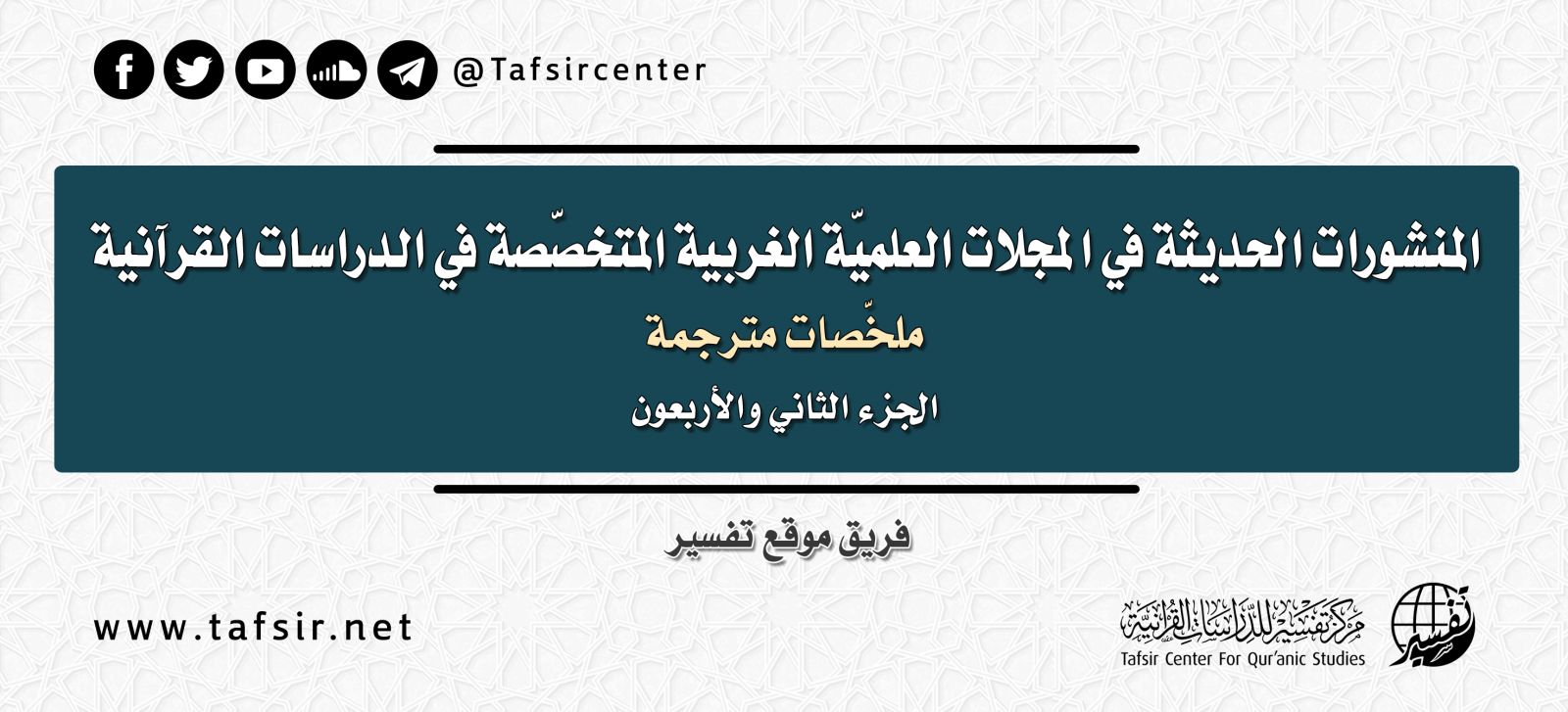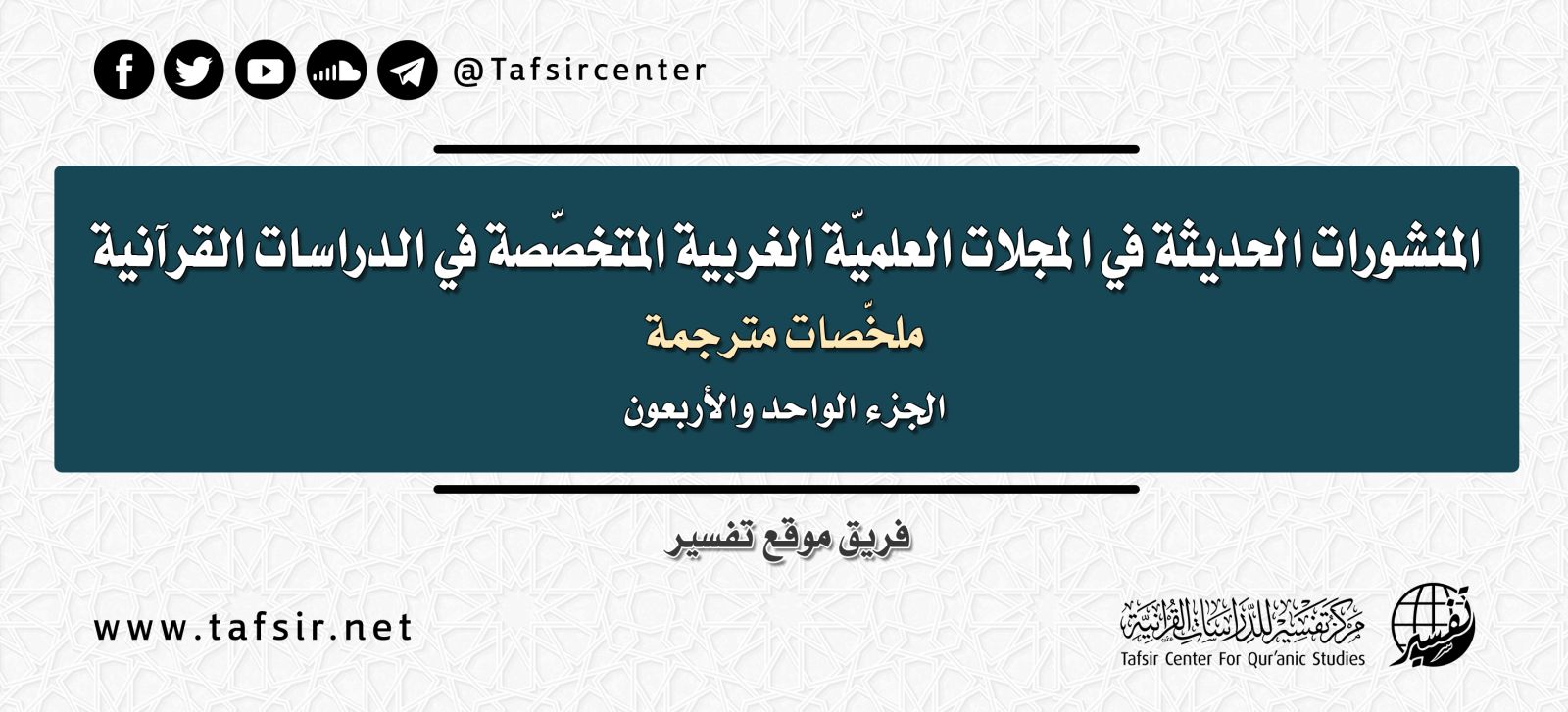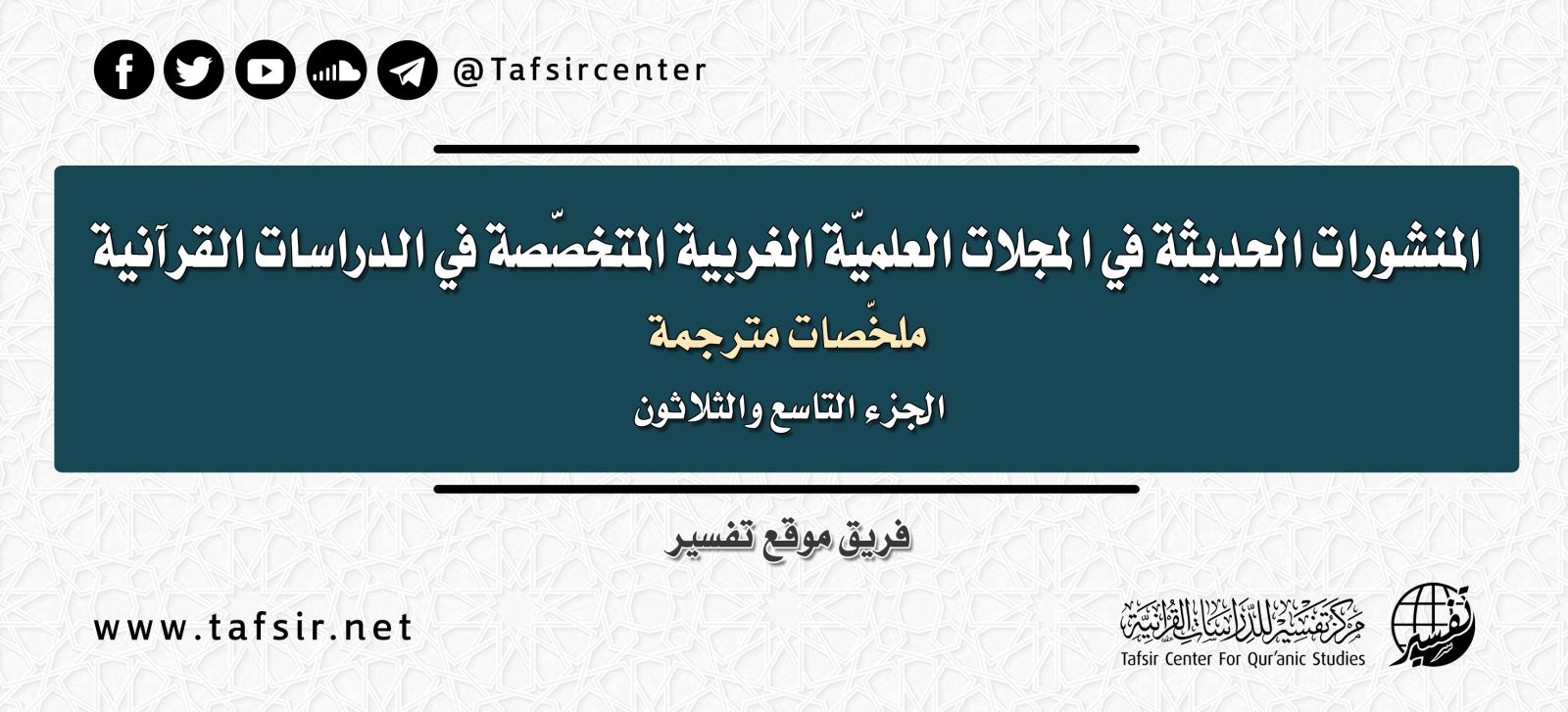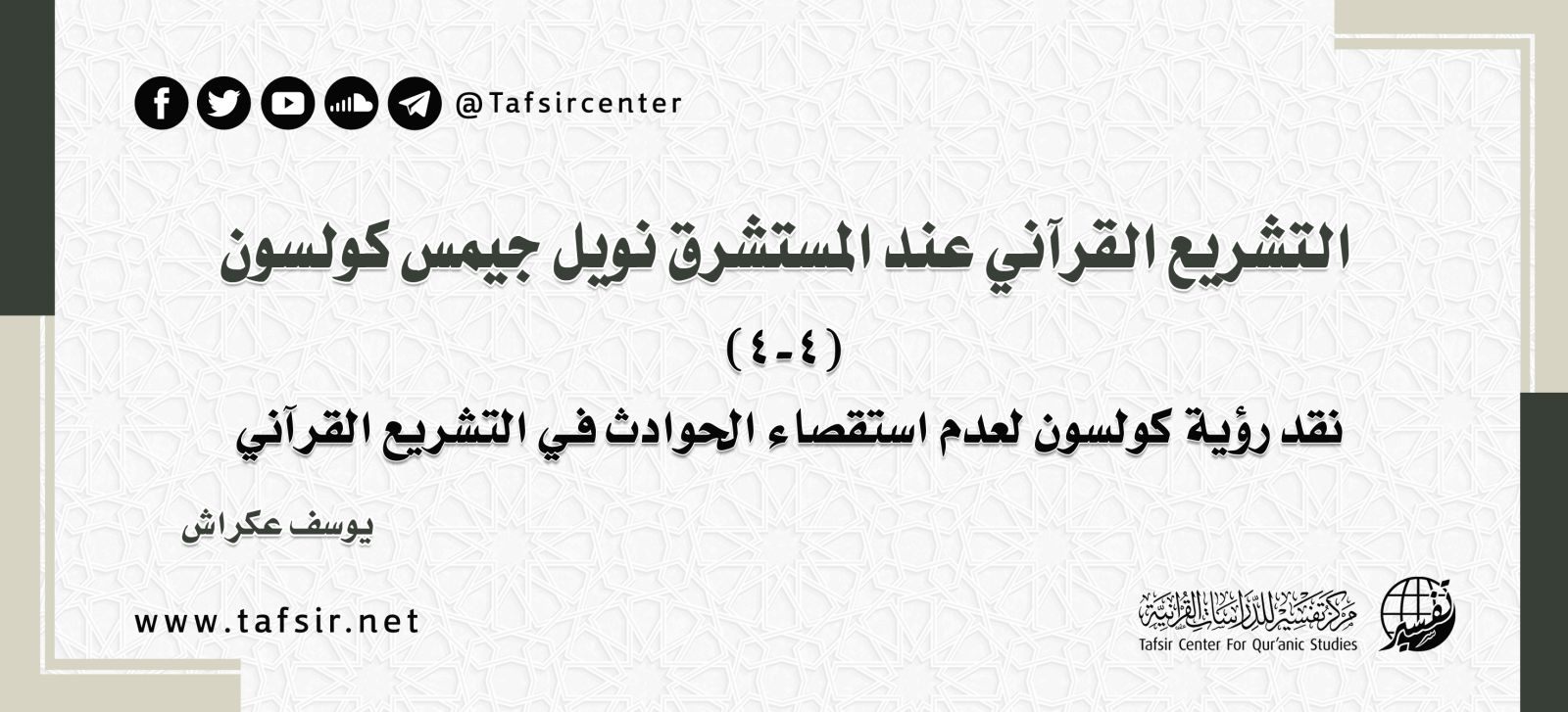فرضية (القرآن الليتورجي) في الدرس الاستشراقي المعاصر
فرضية (القرآن الليتورجي) في الدرس الاستشراقي المعاصر
الكاتب: طارق محمد حجي

برز في الآونة الأخيرة على ساحة الدرس الاستشراقي عددٌ من الفرضيات حول تاريخ القرآن وتاريخ الإسلام، تُعارِض تمامًا ما استقرّ في المدوّنات الإسلامية التقليدية، وكذا ما استقر في نظريات عددٍ كبيرٍ من المستشرقين الكلاسيكيين حول هذا التاريخ، حيث تمّ افتراض كون القرآن في أصله ليس كتابًا واحدًا كُتِب في عقد أو عقدين من حياة جيل واحد، بل هو مجموعة من النصوص التي تم جمعها من مصادر مختلفة ثم تحريرها على مراحل متباعدة ومتطاولة لتصبح في النهاية (القرآن) الذي نعرفه، من هنا فالقرآن المعاصر بين أيدينا ليس سوى تحرير لـ(نصّ أصلي) سابق، هذا النصّ -وفق كثير من هذه الفرضيات- هو نصٌّ ليتورجي أو شعائري، ينتمي إمّا إلى جماعة مسيحية أو يهودية، في الجزيرة العربية أو حتى خارجها (العراق-سوريا)، أو ينتمي إلى جماعة مسلمة أُولى تحاكي في بداية تأسيس هويتها الخاصّة التقوى المسيحية لمسيحيي الجزيرة قبل الانفصال عنها بهوية خاصّة، وقد برزت فرضية (القرآن الليتورجي) كفكرة أساس لمعظم هذه الفرضيات، وترتّب عليها عديد الآثار في النظر للقراءات القرآنية وللتقاليد الشفهية لنقل القرآن ولتاريخ القرآن وتاريخ المسلمين الأوائل، وغيرها من قضايا مطروحة على ساحة البحث المعاصر حول القرآن، مما يجعلها فرضية جديرة بالاهتمام والبحث لاستكشاف دلالتها الدقيقة والأساس النظري الذي تستند عليه.
في هذه المقالة سنحاول توضيح المعنى الدقيق لفرضية (القرآن الليتورجي) في الكتابات الاستشراقية المعاصرة، والمساحات التي تستخدم فيها والفرضيات التي تسندها، كما سنقدم نقدًا لهذا المفهوم (الليتورجي/ الشعائرية) يتساءل عن الدلالة المعطاة له، ومدى إمكان تطبيقه بهذه الدلالة على القرآن من عدمه، وسنخصّص نقدنا بتناول أنجيليكا نويفرت حيث تكتسب عندها الفرضية تركيبًا يجعلها أفضل نسخة نظرية منها، ثم في الجزء الثاني من المقال سنتساءل حول الأسباب الداعية لافتراض هذه الفرضية، كما سنتساءل إنْ كان ثمة شكل آخر ودلالة مختلفة لـ(شعائرية القرآن)، مفوَّتة ومتجاهلَة في الدرس الاستشراقي، مفيدة في النظر إلى القرآن تحتاج لتسليط النظر عليها.
فرضية القرآن الليتورجي؛ دلالتها، ومدى ملاءمتها لطبيعة القرآن:
ما يعنيه أن القرآنَ نصٌّ ليتورجي، أنه نصّ نشأ بالأساس كي يُستخدم في التلاوات الطقسية في الصلوات والأعياد، أيْ إنه كتاب يُقرأ في (احتفال ليتورجي بالمقدّس)، على غرار الكتاب المقدّس العبري بالنسبة للجماعة اليهودية المتأخّرة، وكذا وبالأخصّ على غرار الكتاب المقدّس العبري والعهد الجديد بالنسبة للجماعة المسيحية الأولى، والتي استخدمت المزامير وبعض الأسفار من أجل تأسيس ليتورجي مسيحي متمحور حول الكلمة، من هنا يصبح افتراض هذه النشأة للقرآن، هو افتراض لشكلٍ من اثنين لتاريخ النصّ القرآني؛ إمّا أن القرآن هو شكلٌ لاحقٌ ومتطوّر من (نصّ أصلي) كانت تملكه جماعة مسيحية يهودية أصلًا وتستخدمه ككتابها الليتورجي، ثُم تَم تحرير هذا النصّ لاحقًا والإضافة إليه والتعديل اللاهوتي فيه حتى صار القرآنَ الذي نعرف، وهي الفرضية التي قدّمها غونتر لولينغ اللاهوتي الألماني، حيث اعتبر في كتابه: (حول القرآن الأصلي، 1974) أن للقرآن أربع مراحل أو أربع طبقات نصيّة؛ تمثّل الطبقة الأولى والأعمق فيه مجموعة ترانيم مسيحية تخصّ مسيحيي مكة فيما قبل النبي محمد، ثم طبقة ثانية تحوي التعديلات التي تمّت في عهد محمد لتنسجم مع مبادئ الإسلام الناشئ، ثم طبقة ثالثة تحوي الإضافات الإسلامية في عهد محمد، ثم طبقة رابعة تحوي تلك التعديلات التي قام بها المسلمون في ما بعد محمد أثناء تحرير الخط العربي.
وقريب منها فرضية لكسنبرج عن وجود (قرآن أصلي) آرامي سرياني؛ أو للدّقة، قرآن كُتب بلغة مزيج بين السريانية والعربية، تَم تحريره عربيًّا في فترة لاحقة كي يصبح كتاب هذه الأمة.
أمّا الشكل الثاني المفترض لتاريخ القرآن وفق هذا الافتراض، فهو أن القرآن كتاب لجماعة دينية وُجدت في مكة في القرن السابع الميلادي، يحاكي إيمانها وتقواها إيمان الجماعتين اليهودية والمسيحية التي نشأ النصّ في سياقها ثم في مواجهتها وفي خضم الجدال اللاهوتي نحو تأسيس هوية خاصّة، وهي فرضية الألمانية أنجيليكا نويفرت.
ورغم هذا التفاوت في نتائج هذه الدراسات أو ما يرتّبه كلّ من هؤلاء الباحثين وغيرهم -مثل وانسبرو وغريغور شولر- على القول بـ(قرآن ليتورجي)، إلا أن ثمة اشتراك في اعتبار سمة (الليتورجية) هي سمة حاسمة في (القرآن الأصلي)، سواء في كليته أو في مراحله الأولى، وسواء كانت هذه المراحل الأولى بضع سنوات كما مع نويفرت، أو كانت أجيال مديدة كما مع لولينغ، سمة حاسمة بمعنى أنها -وفقًا لهم- تعدُّ مفتاحًا لفهم النصّ؛ تاريخه كما مع لولينغ، ومعناه كما مع لكسنبرج الذي يعتبر أن معنى القرآن محتجب وراء التصحيحات اللاحقة، وأنه يحتاج لفكّ شفرته عبر القراءة الآرامية السريانية له التي تمنح لمعظم مساحاته معانِيَ جديدةً، ومبناه كذلك مع نويفرت، حيث تعتبر أن الوحدة الأدبية للقرآن هي السورة بما هي (بريكوبس)، أي: نصّ من آيات مترابطة يُقرأ في جلسة ليتورجية. ونحن في انتقادنا لفرضية القرآن الليتورجي عامّة سنُولي اهتمامًا خاصًّا لنظرية نويفرت، حيث إنها أكثر تركيبًا وأعمق من جهة المفاهيم المستخدمة لتأسيس الفكرة نظريًّا، وكذا فهي تشمل فرضية لولينغ ولكسنبرج مما يجعل نقدها نقدًا لأفضل نسخة ربما من الفكرة.
تعدُّ الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفرت بكتابها: (دراسات في تركيب السور المكية، 1981) واحدة من أهم روّاد المنهج السانكروني (التزامني) في قراءة القرآن، والذي يفيد من التطورات الحاصلة في الدراسات الأدبية والكتابية في استكشاف بناء النصّ القرآني؛ فهي ممن كرّسوا في الدرس الغربي المعاصر للقرآن فكرة انسجام النصّ القرآني وكونه يحمل بنيةً خاصةً، في مواجهة القول الاستشراقي العتيق بتفكُّك النصّ. ويتمحور عمل الباحثة الألمانية حول محاولة استكشاف هذه البنية القرآنية الخاصّة والوحدات الأدبية التي يتشكّل منها النصّ، وكذا العلاقة التي تربط هذه الوحدات ببعضها وبالوضعية الاجتماعية للأمة Sitz imLebenـ[1]، وفي هذا السياق تجعل نويفرت السمة الليتورجية سمةً أساسية لافتراض بنية السور والمقاطع القرآنية، حيث إنّ تقسيم القرآن لمقاطع وسور يقوم عند نويفرت لا على أساس (الموضوع) أو (القواعدية-قواعد تركيب الجمل) أو (وحدة التلفظ بتعبير آدم فلاورز) وحدهم، بل يعدُّ المركز فيه هو (وحدة التعبد) إن صح التعبير، فهي تقسم القرآن لمقاطع تصلح كبريكوبس، أيْ: للصلاة الليتورجية، وتعتبر أن (السورة الطقسية) بما هي وحدة أدبية قرآنية أساسية للقرآن المبكّر، هي مقدمة وتمهيد لـ(السور الخطابية) التي نشأت لاحقًا؛ لذا فإنها وحين تنظر للسور القرآنية الكبيرة والتي لا تصلح كبريكوبس فإنها تعتبرها (أوعية حاوية) لهذه البريكوبس، بالإضافة للوظيفة الخطابية الجديدة لها والمرتبطة كذلك بالسياق الطقسي[2].
وهذه الوحدة (وحدة التعبد) -وفقًا لنويفرت- فاعلة تمامًا في تاريخ القرآن، تحديدًا في مراحل القرآن المبكّرة والتي توازي مرحلة استناد النصّ للتراث الكتابي السابق -خصوصًا المزامير- وانطلاقه منه، أمّا الانتقال اللاحق في المراحل المكية المتأخّرة والمرحلة المدنية إلى السور الطوال فهو تعبير عن استقلال النصّ -غير الكامل كذلك- عن الشعائر، والذي حدث وفقًا لها بسبب انتقال الأمة الناشئة من مرحلة (الاستمرارية الشعائرية) إلى مرحلة أخرى هي (الاستمرارية النصيّة)، وفقًا لمصطلحات تستعيرها من عالِم الأديان الألماني (يان إسمان)، وحدَث مع هذا الانتقالِ انتقالُ الأمة من الاستناد على التراث الكتابي والانطلاق منه إلى التغلغل فيه ثم السيطرة عليه[3]، هذا من حيث تربط نويفرت القرآن بشكل واضح بوضعيته الاجتماعية وبالسياق المسيحي اليهودي والوثني الذي يتم الجدال فيه بين النصّ والمخاطبين، حيث يمثّل القرآن وفقًا لها (دراما حية) متعدّدة الأصوات تشمل كلّ هذا النقاش وتعكسه، كما يعكس مراحل استقلال الأمة بهوية دينية خاصّة، رابطة الدراسة الدياكرونية الأسلوبية للنصّ المستفادة من نولدكه بالسياق الاجتماعي والتاريخي للنصّ[4].
في هذا السياق، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه على افتراض نويفرت عن (القرآن الليتورجي)، له شقّان؛ الشقّ الأول: هو التساؤل عن مدى كون (ليتورجية القرآن) تمثّل بالفعل سمة يمكن أن تكون محدِّدة للقرآن ولـ(طبيعته) النصيّة والدينية، حتى في مراحله الأولى. والشق الثاني: فهو التساؤل حول مدى دقّة هذا التصوّر لمراحل تاريخ الحضارات من الاستمرارية الشعائرية إلى الاستمرارية النصيّة، ومدى إمكان تطبيقه على القرآن وعلى المسلمين الأوائل وعلى النظام الشعائري الإسلامي، أو بمعنى آخر التساؤل حول الكفاءة المنهجية للمفاهيم التي تستعيرها نويفرت من (إسمان)، سواء في ذاتها أو في سياق تطبيقها على القرآن وعلى تاريخ الأمة الناشئة وصِلَتها به تحديدًا.
فبالنسبة للشقّ الأول من السؤال، فإن وجود الوظيفة الشعائرية للنصّ في مراحله الأولى لا يعني أنه بالإمكان إغفال بقية الوظائف والسمات التي يظهرها النصّ ضمن ذات المراحل، أيْ: كونه تذكيرًا بأفعال الله وبقدرته وتحذيرًا للمخالفين، وهذا من حيث إنّ هذه السمات هي وكما تعبّر بواليفو «مضمون الذِّكر والدعاء الشعائري» لهذه المرحلة، تلك التي تبرز -وفقًا لها- تأسيسًا أوليًّا لوضعية النصّ كقول الله، بما يتضمنه هذا من سلطةٍ للكتاب وحجيةٍ تنشأ تدريجيًّا، هذا يعني أن ثمة جوانب رئيسة في القرآن في مراحله المبكرة قد تكون أسبق منطقيًّا على استخدامه الشعائري، وهي ما يتضمنه مصدر الأمر بهذا الاستخدام، ثم ما يتضمنه الدعاء والذِّكر ذاته من إشارة لكتاب سماوي يضطلع بوظائف الإنذار والبشارة والتذكير بالله وفِعاله؛ لذا فإنّ اختزال ما يمكن اعتباره (ليتورجي القرآن) في (الليتورجي) وحده يعدُّ غير معقول بدايةً، حيث يتجاهل من جهة مصدر هذا الليتورجي القرآني ويتجاهل مضمونه من جهة أخرى، وهو المضمون الذي يكشف عن أبعادٍ أوسع للنصّ: (الحجية، الإنذار، كونه قول الله، كونه تذكيرًا بفِعال الله)، حاضرة وبارزة حتى في هذه المراحل المبكرة!
وهذا الاختزال للقرآن في الليتورجي وتجاهل الأبعاد الأخرى، هو ما يُنتج تصورًا غير دقيق لعلاقة النصّ بالشعائر الإسلامية وبتاريخ الأمة، والذي يظهر بكلّ وضوح في استعادة نويفرت مصطلحات (إسمان)، وهو ما ينقلنا للشق الثاني من تساؤلنا حول افتراض نويفرت.
فوفقًا لإسمان في كتابه: (الذاكرة الحضارية)، فإن الشعوب أثناء تطوّرها تمرّ بمرحلتين: مرحلة تعتمد فيها في حفظ ذاكرتها الحضارية على الطقوس، حيث تُعيد الطقوسُ الفعلية والتمركزُ حول أماكن وأزمنة بعينها ذِكرَى أحداثٍ مهمّة وحاسمة في تاريخ هذه الشعوب. ثم مرحلة ثانية تعتمد فيها الشعوب في حفظ ذاكرتها الحضارية على النصوص المدوّنة؛ لذا فحين نطبق هذه المفاهيم على القرآن والمسلمين الأوائل كما تفعل نويفرت، سيكون القرآن قد مثّل في البداية جزءًا من ليتورجي الأمة الناشئة حين كانت في مرحلة الاستمرارية الشعائرية التي تدوّن فيها تاريخها عبر الشعائر أو عبر النظام الشعائري (الشعائر- الأزمنة- الأمكنة)، ثم استقلّ في مرحلة لاحقة كنصّ مقروء، وهذا حين انتقلت الأمة إلى مرحلة الاستمرارية النصية، أيْ تلك التي تعتمد فيها على النصوص في حفظ تاريخها.
ونحن حين نتأمل مفهومَي (إسمان) وكفاءتهما التحليلية في ذاتهما قبل توظيفهما في دراسة القرآن -والذي أسلفنا صعوبة الحديث عن كونه نصًّا ليتورجيًّا بالمعنى الدقيق-، فنحن نجد أن هذين المفهومين يفتقدان الكفاءة في تفسير كثير من العلاقات بين النصوص والشعائر داخل كلية الظاهرة الدينية من جهة، وبين الشعائر والحوادث التي تستعيدها من جهة أخرى، أيْ إنها تفتقد الكفاءة في تحليل الشعائر داخليًّا في علاقتها بـ(الدين)، وخارجيًّا في علاقتها بالتاريخ والطبيعة؛ فمن الجهة الأولى يتجاهل هذان المفهومان التداخل الكبير والمعقَّد بين الشعائر والنصوص من حيث كونهما تَمَظْهُرَيْن لـ(البنية الدينية الأساسية)، وهي البنية التي تشمل السرد والشعائر والمعتقد كأوجه متآزرة؛ حيث تمثل الشعائر تحويل المعتقد لصورة حيّة أو تَضمن (تحيين المقدّس) -كما سنوضح تفصيلًا-، ويمثل النصّ التجلّي السردي للمقدّس في التاريخ، كما يتجاهل هذان المفهومان استمرار الشعائر حتى في مرحلة النصوص الكبرى ذاتها كما هو مشهود في عديد الأديان بما فيها الأديان الإبراهيمية، وكذا الانفصال الواضح الذي تشهده كثير من الشعائر عن تكريس أيّ ذكرى قد تحمل سمة تاريخية أو طبيعية أممية -فما الذي تستعيده الصلاة أو الزكاة في الإسلام، وما الحدث التاريخي الذي يستعيده الصوم الأربعيني في المسيحية على سبيل المثال؟![5]-، فهذا الحصر لأهمية الشعائر في بُعد حفظ الذاكرة التاريخية يؤدي لتجاهل الكثير من وظائف الشعائر المتعلقة ببنية الظاهرة الدينية ووضعيتها داخل هذه البنية، والتي حتّمت وجود الشعائر في مرحلة النصوص كذلك.
أمّا من الجهة الأخرى -أي: علاقة الشعائر بالتاريخ وبالطبيعة- فالحديث عن كون الأماكن والأزمنة والحوادث كانت تُستعاد في الشعائر بغرض حفظها في الذاكرة، يتجاهل كون هذه الأماكن والأزمنة والحوداث كانت تُستعاد لا باعتبارها حوادث أرضية بل باعتبار قدسيتها من الأساس، أي: اتصالها بـ(المقدّس) وتجلّيه، ومن ثَم اختلافها عن الزمان والمكان العادي من حيث هي انقطاع فيه وكسر لتجانسه، فهي لا تنتمي للعالم الطبيعي والتاريخي بل تنتمي لـ(العالم الديني) بتعبير إلياد[6]، من حيث هو عالم مؤسّس بفعلِ تجلّي المقدّس في قلب العالم العادي، مما يعني أن الاستعادة الشعائرية مؤسّسة على قدسية هذه الحوادث وليس على أهميتها التاريخية للأمة، وأن الهدف منها ليس الرغبة في تكريس هذه الحوادث في الذاكرة، بل في تحيين هذه المعاني الدينية؛ فمثلًا الاستعادة الشعائرية لحدث ذبح إبراهيم لإسماعيل ثم فدائه، ليست استعادة لحدث تاريخي، بل لحدث يقع في قلب العالم الديني الإسلامي، حيث يختبر سيدنا إبراهيم هنا «الأمر الإلهي المفارق للاجتماع والتاريخ»، كسمة أساسية للإله الإبراهيمي، ويقوم المؤمنون بتحيين الفعل من حيث هو كذلك اختبار لطاعة هذا الأمر، وعبر قراءة معمّقة أكثر نستطيع اعتبار فعل إبراهيم -عليه السلام- هو «تحيين مقلوب» لعصيان إبليس للأمر بالسجود «أمر إلهي مفارق كذلك؛ حيث يُؤمر بالسجود لغير الله»، مما يعني أن شعيرة الأضحى في عمقها هي استعادة لحدثٍ تَمّ في السماء، أيْ: إنه لا يخصّ أيّة أمّة تاريخية في حقيقة الأمر!
فهذان المفهومان اللذان يقدمهما عالم الأديان الألماني يتجاهلان الطبيعة الخاصّة للأحداث والأماكن والأزمنة المستعادة دينيًّا، ويسوِّيانها -دون دقة- بالأحداث التاريخية الصِّرْفة، مما يقلّل من كفاءتهما في تحليل وفهمِ الشعائر ووظائفها وعلاقتها بالنصوص وموقعها في البنية الأساسية للدين، سواء كان هذا بشكلٍ عامٍّ أو كان بشكلٍ خاصٍّ فيما يتعلق بالإسلام وبالقرآن.
أمّا فيما يتعلق بتوظيف أنجيليكا نويفرت لهذين المفهومين داخل القرآن ومدى كفاءتهما في هذا السياق الخاص عبر الطريقة التي توظفهما بها، فنحن لا نجد داخل القرآن في أيٍّ من مراحله تلك الاستعادةَ للأحداث التاريخية الخاصّة بالأمة التي تجعلنا نعتبره (أرشيفًا للذاكرة الحضارية)، ولعلّ أنجيليكا نويفرت ذاتها أشارت لهذا حين اعتبرت أن القرآن مختلف عن التوراة من حيث إنه لا يمثل على غرارها (تاريخ خلاص)[7]، كذلك فإن تطبيق نويفرت لمفاهيم (إسمان) هنا يفتقر للسلامة المنهجية من حيث إننا لا نجد فيه أيّ محاولة لموقَعة القرآن ضمن الشعائر الإسلامية الأخرى، بل وضمن النظام الشعائري الإسلامي الأشمل «النظام الشعائري أوسع من الشعائر، حيث ينضاف للشعائر الأزمنة المقدسة والأماكن المقدسة»، أو أيّ محاولة لاكتشاف هذه الصلة المفترضة بين النظام الشعائري الإسلامي عامّة -وفي قلبه القرآن- وبين تاريخ الأمة الناشئة الباحثة عن استقلال هُوِيّاتي، ولعلّ هذا يُفْقِد استخدامَ المفهومين وتطبيقَهما على القرآن عند نويفرت أيَّ كفاءةٍ، ويُوقِع فرضية القرآن الليتورجي في خطأ تجاهل ما عبّر عنه بعض الباحثين بكونه (حقائق بسيطة)، مثل كون الإسلام لا يحمل تقويمًا ليتورجيًّا وكون الصلاة الإسلامية ذاتها لا تحمل الكثير من القرآن ولا تفترضه أو تحتّمه[8]!
وبالطبع، لا يمكن تجاهل أن فرضية النصّ الليتورجي عند نويفرت أكثر تركيبًا بكثير منها عند لولينغ أو لكسنبرج، وهذا بسبب ارتباط هذه الفرضية لديها بمسائل مثل علاقة الشفاهة بالكتابة، وعلاقتها بمسائل مثل سلطة النصّ وعلاقته بالكتب السابقة، وعلاقتها كذلك بتصوّر السياق المتلقي للنصّ لفكرة الكتاب المقدّس ومعناه وحدوده، إلا أن هذا التركيب -مثله مثل المفاهيم المستعارة من دراسات الأديان- لم يستطع في ظنّنا إضافة أيِّ ثقلٍ للمحاجاة بهذه الفرضية، فإذا كان نويفرت وشولر يعتبران أن الكتاب المقدّس في سياق الجزيرة كان له بُعدان مهمان؛ أولًا: أنه نصّ مكتوب، وثانيًا: أنه نصّ شعائري، وأن هذا التصوّر عن سياق الجزيرة وصِلة القرآن به يُعطِي أولوية -وفقًا لهم- لفرضية (القرآن الليتورجي) كتحديدٍ لطبيعته، كذلك فإذا كانت العلاقة بين كتابة القرآن وشفاهيته تبدو -وفقًا لهم- وكأنها تؤيد فكرة المرحلتين (الاستمرارية الشعائرية) و(الاستمرارية النصية) في تاريخ النص، حيث إنّ كتابة النصّ كمظهر لاستقلاليته تجاه الشعائر لم تحدث فعليًّا إلا في مراحل لاحقة، في حين كان النصّ في البداية يتداول شفهيًّا ضمن الشعائر كجزء منها. إلا أنه بمزيد تدقيق فإننا نجد أنه لا شفاهة القرآن في المراحل الأولى، ولا صلته بالشعائر في هذه المراحل؛ يمكن لهما أن يسندا فرضية القرآن الليتورجي كمرحلة من مراحل تاريخ القرآن!
فالقرآن وفي وقت تنزله الشفهي لم يعارض كتابته كما تُلمِح إلى ذلك نويفرت بالفعل، بل يبدو متضمنًا لهذه (المكتوبية) -كإحدى سمات الكتاب المقدّس- إنْ صحّ التعبير؛ فالقرآن اعتبر نفسه «كتاب» قبل أن يصبح كذلك بالفعل كما يعبر ماديغان، أو قبل تحقيق شرط المكتوبية كأحد شروط الانخراط في سلطة وقداسة الكتب السابقة، وحين انتُقِد القرآن لأنه لم ينزل -وكحال الكتب السابقة- «جملة واحدة»، فإنه لم يبرر شفهيته ونزوله المنجَّم الظرفي أبدًا بالوظيفة الليتورجية له، بل وكما تعبر نويفرت فإنه في مواجهة تساؤلات وتوقعات السامعين هذه قام بتأسيس شكلٍ خاصٍّ من الشفهية «لا يعارض توقعات السامعين بكتاب مكتوب ومدوّن على غرار الكتب المقدّسة السابقة»[9]، كذلك فالقرآن في مراحله الأولى تضمَّن فكرة (الكتاب المقدّس)، لا بما هو كتاب صلوات كما يفترض شولر، بل بما هو مفهوم الكتاب المقدّس كالذي عند اليهود والمسيحيين (أهل الكتاب)، أيْ: إنه (كتاب ذو سلطة منزل بحَرْفِه من السماء ومكتوب)، حيث -كما تؤكد نويفرت- «هناك مجموعة من السور الأولى التي تؤسّس علاقةً وارتباطًا بالكتاب السماوي؛ ولذا نجد الآيات [11-16] من سورة عبس ترِد كأنها منبثقة أو مختارة من النصّ الأصلي السماوي: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ}[عبس: 11-16]»[10]، وحيث القرآن -وكما تقول بواليفو- اعتمد في تأسيسه سلطته على بعض الإستراتيجيات؛ منها هذه الإشارة للكتاب المقدّس بسلطته التي يحملها تجاه مجتمعاته الدينية.
هذا كلّه يجعل استقلال النصّ؛ (الكتابة اللاحقة له، والحجية والسلطة المعطاة له تجاه الكتب السابقة وتجاه المجتمع)، هو مصير النصّ المضمن في شفهيته الأولى ذاتها، وليس تحوّلًا حدث جرّاء (تطور تاريخيّ حضاريّ ما) للأمة بانتقالها للاستمرارية النصيّة كما تفترض نويفرت، وأيضًا يجعل الشفاهية والليتورجية نمطَ تلَقٍّ للقرآن وليس مرحلة من تاريخه[11] وانقضت، فلا تزال ليتورجية القرآن والتدوال الشفهي له فاعلة في مرحلة النصّ المكتوب والمدوّن، فالشفاهية والليتورجية أحد أبعاد النصّ وطرائق حضوره، وهي أبعاد مكرّسة داخل نسيجه عبر مفردات المرجعية الذاتية للنص: «(القرآن)، (الذكر)، (الترتيل)، وغيرها...»، غير أنها -بهذه المعاني المعطاة لها- لا تستطيع استيعاب مجمل أبعاد النصّ الأخرى -سلطته وكتابيته وحجيته تجاه الكتب السابقة وتجاه المجتمع- المكرسة كذلك في نسيجه ومفاهيمه وحجاجاته.
وإن لم يكن استحضار نويفرت لمسائل (علاقة الشفاهة/ الكتابة) (السلطة) (العلاقة بالكتب السابقة) في حجاجها عن فرضية الليتورجي مقنعًا في ظنّنا، فلا شك هو أفضل حالًا من غيابه التام في فرضيتي لولينغ ولكسنبرج، والذي أوقعهما في خطأ نستطيع القول عنه إنه شديد السذاجة، حيث يقوم جزء أساسي من افتراضهم عن (القرآن الأصلي) المحجوب والمختفي، على غياب أيّ تقليد شفاهي مستمر عبر الأجيال يمثّل وسيلة لضبط النصّ المجرد حرفًا ومعنى، من هنا ضاع تاريخ النصّ أو معناه في التصحيحات اللاحقة، وتحتّمت محاولة (فكّ شفرته)، إلا أن افتراضهم كون النصّ نصًّا شعائريًّا لجماعة مؤمنة، يحتّم وجود واستمرار وحفظ وتعهد هذا التقليد[12]!
كلّ هذا يعني أن فرضية القرآن الليتورجي لا تجد ما يسندها حقيقة لا في تحليل النصّ نفسه، حيث تتجاهل هذه الفرضية المضمون الذي يقدّمه النصّ حتى في آياته ذات الطابع الشعائري، ولا في تحليل سياقه التاريخي والنصي والذي يبرز تركيبًا في تناول القرآن لمفاهيم الكتابة والشفاهة يتضح منذ مراحل مبكرة في بيان موقعه بين الكتب وطبيعته الخاصة وموقفه من التدوين والتلاوة الشفهية، ولا في تحليل الصلة بين الشعائر والنصوص بشكل سليم يستند لوظائف الشعائر بشكلٍ عامّ كما تظهر في الأنثربولوجي وعلوم الأديان، ويستند كذلك بشكلٍ خاصّ لتحليل النظام الشعائري الإسلامي وموقع القرآن داخله وعلاقة معظم مرتكزاته بوضعية المسلمين، مما يجعل هذه الفرضية على شيوعها في الكتابات الاستشراقية المعاصرة مفتقدة لعمقٍ نظريّ ومنهجيّ سليم.
أسباب القول بالقرآن الليتورجي:
لا شكّ أن قضية (طبيعة النصّ) ووظائفه في سياق الجماعة المسلمة الأولى، هي مسألة لا يمكن فصل النقاش حولها والفرضيات تجاهها عن وضعية البحث التي أسميناها سابقًا بـ(وضعية ما بعد الاتجاه التنقيحي)، حيث خلخلت هذه الوضعية الكثير من الأسس النظرية والمنهجية للاستشراق الكلاسيكي؛ فعلى مستوى النظريات تمّ نبذ العديد من النظريات حول تاريخ الإسلام وتاريخ القرآن، وعلى مستوى المناهج تمّ تجاهل المصادر التي طالما اعتُمِد عليها في تركيب هذا التاريخ، ونستطيع القول بأن هذا الفراغ النظري والمنهجي الذي خلّفه هذا الشك المجاني، قد مثّل فضاءً لاستعادة الكثير من الرؤى الكلاسيكية التي تحاول نزع أصالة النصّ القرآني، لتعود هذه الرؤى للساحة بشكلٍ ربما أكثر جذرية من الطرح الكلاسيكي القائم على التأثّر، حيث -بدلًا عن فرضية التأثر بالكتب السابقة- تمّ افتراض كون تاريخ النصّ هو تاريخ مسيحي أو يهودي بالأساس؛ سرياني أو يوناني أو حتى إثيوبي، تم لاحقًا تعريبه وأسلمته.
ونحن نرى بكلّ وضوح هذه الرؤية للقرآن ككتاب مسيحي-يهودي، لا فقط في اعتبار القرآن كتابًا لأمّة مسيحية يهودية أو أخرى تحاكيها، بل في حقيقة الأمر نحن نراها بوضوح في هذه الفرضية ذاتها، أيْ: في اعتبار القرآن (نصًّا ليتورجيًّا) ولو في أحد مراحله وأيًّا كانت الأمّة الحاملة له، حيث إنّ فرضية النصّ الليتورجي ليست إلا فرضية كتابية مسيحية تتماشى تمامًا مع التصوّر المسيحي عن الكلمة المتجسدة، وتعدُّ استعادتها وتطبيقها على القرآن مجرد تجاهل تامّ لإمكان وجود تاريخ وسياق وبناء وطبيعة خاصّة للقرآن مختلفة عن الكتاب المقدّس في تصوّر المجتمعات الدينية الأخرى.
فحين نتحدّث عن نصّ ليتورجي، فإننا نتحدّث عن فهمٍ متأخرٍ وتلَقٍّ لاحق للكتاب المقدّس العبري وللإنجيل، حيث إنّ الكتاب المقدّس العبري -وبشكلٍ ما- شكَّل (استمرارًا نصيًّا) للشعب اليهودي، واستحضاره شعائريًّا في مراحل لاحقة تمّ جنبًا إلى جنب مع الاستعادات التشريعية والتنبُّـئِيّة وغيرها، ثم في التاريخ المسيحي تحوَّلَ تلقِّي الكتاب المقدّس إلى استحضار له كشعيرة كبيرة بالأساس، من حيث إنّ الكتاب تم كشفه وتحقّقه بتجسد المسيح/ الكلمة، فمن حيث المسيحية هي ليتورجي الكلمة المتجسدة أصبح الكتاب المقدّس كاملًا هو مضمون هذا الليتورجي للجماعة المسيحية المبكرة، وأصبح من الطبيعي وجود تقويم ليتورجي يمثّل الفضاء لهذه التلاوات، حيث إنّ المشاركة في (الكلمة) الإلهية مسيحيًّا تعني المشاركة في حياة المسيح/ الكلمة وإعادة تحيينها، من هنا حضر الكتاب المقدّس في كلّ تفاصيل الليتورجي المسيحي، فأضحى حقًّا (كتاب الأمة الليتورجي).
إلا أنه لا يمكن مَوْضَعَة القرآن ضمن هذا السياق بحال، فالقرآن -وكما ترى نويفرت ذاتها- لا يمثّل تاريخ خلاص كالكتاب المقدّس العبري ولا يمثل سردًا للكلمة كالأناجيل، مما يجعل طبيعته مغايرة لطبيعة هذين الكتابين -اللذين كذلك لا يمكن حصرهما في الليتورجي[13]-، وتظهر طبيعة القرآن عبر القراءة التزامنية والدياكرونية لمفردات المرجعية الذاتية والتي تعطيه سمات السلطة والقداسة والبيان كسمات مركزية، والتي تجعل (الهدى) الرأس الثالث لمثلث مفاهيمي قرآني مركزي واصف لطبيعته كما تقول نويفرت[14].
لذا فإن الليتورجية بهذا المعنى الضيق -كتاب صلاة- الذي يختزل القرآن ويتجاهل تعدّد أبعاده، أو بذاك المعنى الواسع الذي يجعله كالكتاب المقدّس العبري الـمُضاء عبر تجسّد الكلمة في الوسط المسيحي؛ لا تمثل سوى محاولة لدمج القرآن داخل تاريخ الكتب المقدّسة وأممها؛ كنسخة باهتة عنها تارة، أو كمحاكاة بارعة لها تارة أخرى! وفي هذا إهدار كبير للبناء الخاصّ والطبيعة الخاصّة لهذا النصّ وصلته التي يصطنعها مع الكتب السابقة ومع التاريخ ومع المتلقّين له.
القرآن كتاب شعائري؛ بأيّ معنى؟
إلا أن ما يشكّل المعضلة الأساسية لهذه المقاربة الليتورجية للقرآن في ظنّنا، ليس مجرد اختزال القرآن في هذا البُعد الوحيد من أبعاده المتعددة، بل وأيضًا اختزال مفهوم الليتورجي نفسه، حيث إنّ هذا المفهوم ذاته أوسع كثيرًا من الاستخدام الذي يظهر في هذه الكتابات، والتي تبدو -وكما قيل مرارًا- عاجزة حين تتعامل مع القرآن والإسلام عن استخدام المنهجيات ذات الكفاءة في تحليل الظواهر الدينية، والتي تستخدم في دراسة المسيحية واليهودية والكتاب المقدّس كاشفة الكثير من معانيهما، ونحن نستطيع القول: إنّ القرآن بالفعل كتاب شعائري للأمة المؤمنة بل هو (الكتاب الشعائري) لكن بمعنى مغاير تمامًا للدلالة التي يعطيها الدرس الاستشراقي المعاصر لمفهوم الليتورجي جرّاء ربط القرآن قسرًا بتاريخ الكتب السابقة وطبيعتها وأدوارها!
وسيتطلب توضيح ما نقصده بشعائرية القرآن أمرين؛ الأول: هو محاولة تحديد موقع القرآن في البناء العقدي الإسلامي، وما الذي يعنيه كونه (بيانًا) ضمن هذا العالم. والثاني: هو التساؤل حول الشعائر ومفهومها ووظيفتها في البناء الكلي للدين بشكل عامّ، ومن ثَم محاولة تحديد موقع القرآن في النظام الشعائري الإسلامي بشكل خاصّ.
بدايةً، لو استعرنا من إلياد مفهومه عن (العالم الديني) والذي يعني به العالم المصنوع في قلب العالم العادي عبر تجلي المقدّس مكانًا وزمانًا، طبيعةً وتاريخًا؛ فإننا نستطيع الحديث عن عالم ديني إسلامي له ملامحه الخاصّة التي تميّزه ضمن تاريخ الأديان، ونجد أنه ضمن هذا العالم فإنّ مفهوم البيان يعدُّ مفهومًا مركزيًّا، في مقابل مفهوم الالتباس ضمن المقدّس العام، فبينما تعدّ الصفة الرئيسة للقدسيّ -وكما يخبرنا أوتو- هي أنه ملتبس، يجمع بين كونه جذابًا ومنفِّرًا، خالقًا ومدمِّرًا[15]، فإنّ الألوهة التوحيدية الإبراهيمية سالمة من هذا الالتباس، فهي مُوحَّدة بالخير ومهيمنة[16]، وإذا اعتبرنا أنّ مفهومًا مثل (وحدانية التصريف) هو مفهوم مركزي ضمن العالم الديني الإسلامي، حيث يركز على كون الله وحده هو المصرِّف -على خلاف أديان أخرى تعطي مساحة تصريفية للشياطين؛ الزرادشتية على سبيل المثال، وكذا مفهوم (الأمر المطلق) حيث يركز على كون الله هو الآمِر فوق كل قانون، فكما يقول إلياد: «إله إبراهيم قادر على كلّ شيء»، فعلًا وأمرًا، فإن هذين المفهومين المركزيَّين يرتدّان في حقيقة الأمر إلى مفهوم سابق عليهما هو مفهوم (البيان)، حيث لا يمكن أن يوجدَا دون (سلامة البيان)؛ فهما متأسّسان عليه.
هذه المركزية لـ(سلامة البيان) وأهميته تتبدى تمامًا في القصص القرآني حول هذين المفهومين، (التصريف الإلهي الخارق للطبيعة= المعجزة) و(الآمِرية الإلهية الخارقة للقانون الأخلاقي والاجتماعي= الأمر المطلق المفارق)؛ فإبراهيم ومريم، لم يستطيعا الالتزام بالأمر الإلهي بالذبح أو تقبُّل المعجزة الإلهية بالمسيح، أي: لم يستطيعا الوجود ضمن العالم الديني المتمحور حول هذه المفاهيم، إلا بعد خطوة التأكُّد من (سلامة البيان) المعطى لهما وكونه خاليًا من أيّ التباس، حيث هذه الخطوة هي ما يُؤكِّد كون البُشْرَى بالغريب الخارق ليست سحرًا شيطانيًّا، وكون الأمر بالمفارق للاجتماعي والأخلاقي ليس مسًّا شيطانيًّا، وقد تجلَّت سلامة البيان وكونه إلهيًّا -والتي تعني غياب أيّ التباس في الألوهة- في قول إسماعيل: {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}[الصافات: 102]، أو في ثبات الملاك بعد استعاذة مريم {قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا}[مريم: 18، 19]. يظهر هنا كون (سلامة البيان الإلهي) هي مركز العالم الديني التوحيدي الإبراهيمي والإسلامي، والأساس الذي يتأسَّس عليه؛ الإيمان بالمعجزة السالمة من سحرٍ، والإذعان للأمر السالم من (تمنٍّ شيطانيّ)، ومن حيث يمثّل القرآن -وكما يخبر عن ذاته- (البيان)، المنزل بواسطة (القويّ الأمين)، فإنه بسِمَتِه هذه يمثل مركز هذا العالم الديني، ويمثل الراسم لحدوده، ويمثّل الفضاء الذي عَبْره ينخرط المؤمن في هذا العالم، لكن كيف يعني هذا كون القرآن نصًّا شعائريًّا؛ وبأيِّ معنى؟
هذا سيتطلّب توضيح معنى الشعائر؛ فالشعائر ليست جزءًا من الدين، بل هي أحد مكوناته الأساسية بتعبير السواح[17]، -أو بتعبير قد يكون أدقّ في ظنّنا- هي أحد (أوجُه الدين الأساسية)، فهي وكما يعبر كايو (المقدّس معيشًا)، وهي وعبر الجسد بما هو (جسد في العالم - نقصد مجمل الحركات والاستعدادات الجسدية وعلاقتها بالفضاء زمانًا ومكانًا)، هي من تقوم بخلقِ العالم الديني دوريًّا لينوجد فيه المؤمن، وهي من تقوم بصرف قيم المقدّس في الاجتماعي واليومي عبر «استبدان» هذه القيم، من هنا الأهمية الشديدة للشعائر داخل دينٍ ما، والعلاقة العميقة لها بالمعتقد وبالسرد الديني، والتي جعَلَت أنثروبولوجيِّين مثل مارسيل موس يعتبرون أنه لا يمكن دراسة الشعيرة بمعزل عن دراسة معتقد دينٍ ما؛ فهي خطاب عن هذه العقيدة[18].
الآن لو عُدنا إلى القرآن بما هو ومن حيث كونه -بيانًا- مركزَ العالم الديني الإسلامي، فعليه تتأسّس مفاهيمه المحورية حول الله؛ فسنجد أن العيش في المقدّس أو الانوجاد في عالمه (الدلالة العميقة للشعيرة)، يتم بالأساس عبر وسيط القرآن، فتلاوة القرآن وفهمه وتمثُّله هو الطريق للوجود في حضرة البيان الإلهي للكون وللتاريخ وللكتب السابقة وللذات، وهذا يجعل القرآن كتابًا شعائريًّا بالفعل، بمعنى أنه يمثّل حضور الله في العالم عبر بيانه المتمثل في القرآن الكريم، وأساس قيام العالم الديني للمؤمنين المؤسّس على سماع الهدى، وموضع إعادة تأسيس هذا العالم من قِبل المؤمنين دوريًّا آناء الليل وأطراف النهار، شعائرية القرآن بهذه الدلالة تستبعد تمامًا هذا الحصر الذي نجده في الكتابة الاستشراقية الذي يتجاهل الوظائف الأخرى للنصّ أو يؤجلها لمراحل لاحقة، لتصبح الشعائرية -وعلى العكس تمامًا من هذا- مفهومًا يجمع ويكثف أبعاد النصّ ووظائفه في قلب العالم الديني.
إذن فثمة فارقٌ كبيرٌ بين الدلالة التي يحضر بها مفهوم (القرآن الليتورجي) في الدرس الاستشراقي المعاصر، وتلك الدلالة لشعائرية القرآن المفوتة استشراقيًّا، وهذا الفارق ليس فارقًا سطحيًّا أو برّانيًّا، بل هو في حقيقة الأمر فارق بين نظرتين متباينتين للنصّ الديني، نستطيع أن نسميهما -استعارة من فتحي المسكيني-: بنظرة التاريخ ونظرة التفسير، أو دعنا نقول نظرة (الموضعة) ونظرة (الفهم)، ففي الأولى يكون اهتمام البحث منصبًّا على القرآن كأثر تاريخي يبحث تاريخ كتابته وتدوينه وكيف يفيدنا في فهم تاريخ الأمة الناشئة وعلاقتها ببقية الأمم في وسطها، إنها نظرة تُمْعِن في البحث وراء النصّ حتى تنسى وجوده، في حين تنطلق نظرة (الفهم) من التعامل مع القرآن كفضاءٍ للمعنى؛ من هنا يكون المهم، ما الذي يعنيه القرآن لهذه الأمة المؤمنة، وما هو العالم الذي يؤسسه لينوجدوا فيه، فهي نظرة لا تهدر التاريخ، لكنها تُولي الاهتمام المفترض للنصّ نفسه ومعناه، باحثة عن «ما يخلقه أمامه»[19].
[1] هذا المصطلح مستخدم في النقد الكتابي، ويعني تحديدًا سياق إنشاء نصٍّ ما، ووظيفته، والغرض منه في هذا السياق، وهو أشمل مما قد يفهم من الوضعية الاجتماعية ولا يوجد مقابل إنجليزي دقيق له.
[2] عرض كتاب القرآن بوصفه نصًّا، لشتيفان فيلد، دانييل ماديغان، ترجمة: هدى عبد الرحمن، منشورة ضمن الترجمات المنوعة على قسم الاستشراق بموقع تفسير، على هذا الرابط: tafsir.net/translation/39.
[3] للتوسّع في المراحل الثلاث لصلة القرآن بالكتاب المقدّس، انظر: القرآن والفيلولوجي التاريخي النقدي، أننجيليكا نويفرت، ترجمة: محمد عبد الفتاح، منشورة ضمن الترجمات المنوعة على قسم الاستشراق بموقع تفسير، على هذا الرابط: tafsir.net/translation/41.
[4] للتوسع انظر: مقدمة نويفرت لكتاب quran in context، حيث تعتبر نويفرت أن هذه الصلة بين نشأة القرآن ونشأة الأمة والوظائف الليتورجية والاجتماعية للنصّ مفوتة في تاريخ الاستشراق، الذي اهتم إمّا بربط القرآن بالكتب السابقة كاستعارة منها مع جيجر وشباير وغيرهم، أو اهتم بدراسة تاريخ النبي عبر كرونولجي القرآن.
انظر، Quran in context, historical and literary investigation into Quranic milieu, edited by: Angelica neuwirth, Nicolai Sinai, and Michael Marx, 10,11,12>
[5] يستعيد الصوم الأربعيني في المسيحية تجربة المسيح على الجبل مع الشيطان، لكن هذه التجربة لا تستعاد كتجربة تاريخية، بل باعتبارها إعادة تحيين لتجربة الشيطان وآدم، من حيث يمثل المسيح وفق الرؤية المسيحية آدم الثاني أو آدم الجديد.
[6] العالم الديني مفهوم يستخدمه الروماني مرسيا إلياد، ويقصد به العالم المخلوق عبر تجلّي المقدّس في الزمان والمكان، حيث يُحْدِث هذا التجلي انقطاعًا في الزمان والمكان ليقدّس بعض المساحات والأزمنة ويدنّس أخرى ويترك أخرى (عادية)، هذا التقابل بين العادي والمقدس/ المدنس هو جوهر العالم الديني عند إلياد، انظر، المقدس والعادي، مرسيا إلياد، ترجمة عادل العوا، دار التنوير، 2009، ص60.
[7] في الحقيقة إن اعتبار الكتاب المقدّس مجرد تاريخ خلاص هو ذاته غير دقيق، خصوصًا حين ننظر إليه وفق مفاهيم (إسمان) عن الاستمرارية النصية، حيث إن تاريخ الخروج من مصر لا يمثل الخلاص السياسي؛ بل في حقيقة الأمر، الخلاص من العبودية الروحية نحو التحرر الروحي بالتوحيد، فكما يرى (إيريك فروم) فإن مسيرة الشعب اليهودي للخروج من مصر، هي مسيرة تجاوز للتوثين والإله الحال نحو الإله المفارق المطلق. لتحليلات أوسع للكتاب المقدس كمسيرة تحرر؛ انظر: أن تصيروا آلهة، تفسير إشعاعي للكتاب المقدس وتقاليده، ترجمة: سليم اسكندر حنا، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، ط1، 2013.
[8] القرآن في أحدث البحوث الأكاديمية؛ تحديات وأمنيات، فرد دونر، ضمن كتاب، القرآن في محيطه التاريخي، تحرير: جبريل سعيد رينولدز، ترجمة: سعد الله السعدي، منشورات الجمل، بغداد- بيروت.
[9] وجهان للقرآن، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: حسام صبري، ص24، منشورة من الترجمات المنوعة على قسم الاستشراق بموقع تفسير، على هذا الرابط: tafsir.net/translation/42.
[10]نفسه، ص23.
[11] نظن أن هذه الحيرة من قِبل الباحثين تجاه شفاهة القرآن وكتابته، والتي تتجلى في حديث ماديغان أن مصطلح الكتاب يمثل تحديًا من حيث إنه يستخدم للدلالة على القرآن قبل أن يصبح كتابًا مدونًا بالفعل؛ سببها هو التعامل مع الشفاهة والكتابة كمرحلتين في تاريخ النصوص، وليس كنمطي حضورٍ للنص، وهي الحالة الواضحة تمامًا في القرآن، حيث إنه نصّ مدون حتى وهو يتنزل شفاهة، وهو نصّ يُتلى شفاهة وجهرًا حتى وهو مدون ومكتوب، وهذا وفقًا لنظرته إلى ذاته ككتاب مقدّس وككلمة الله المسموعة الباقية.
[12] لم نتناول هنا المساحات التفصيلية لنظرية لكسنبرج والخاصّة بفرضياته اللغوية حول العربية والآرامية حيث يبتعد هذا عن موضوع المقال؛ للتوسّع حول هذا، انظر: عرض كتاب (قراءة آرامية سريانية للقرآن)، فرنسوا دي بلوا، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، منشور ضمن ترجمات ملف (تاريخ القرآن) على قسم الاستشراق بموقع تفسير، على هذا الرابط: tafsir.net/translation/28.
[13] رغم الأهمية الكبيرة للكتاب المقدّس العبري وللأناجيل في التقاليد اليهودية والمسيحية -خصوصًا المسيحية- ككتاب ليتورجي، إلا أن الأبعاد الأخرى للكتاب تظلّ حاضرة؛ الأبعاد التشريعية، الأبعاد التنبئيّة، بل وحتى الأبعاد التاريخية، حيث يميل المعظم لكون المعنى التيبولوجي لأحداث الكتاب المقدّس لا تنفي المعنى الحرفي المباشر.
[14] الدراسات القرآنية والفيلولوجي التاريخي النقدي، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: محمد عبد الفتاح، ص13، 14، 15، منشورة ضمن الترجمات المنوعة، على قسم الاستشراق بموقع تفسير، على هذا الرابط: tafsir.net/translation/41.
[15] انظر تحليلات أوتو في كتابه الكلاسيكي المهم والذي يمثل منعطفًا في دراسة (المقدس) و(الدين): «فكرة القدسي»، دار المعارف الحكمية، ط1، 2010.
[16] بول تيليش: بواعث الإيمان، ترجمة سعيد الغانمي، منشورات الجمل، ط1، 2007، ص22. ولعلاقة التوحيدية بالعدالة والأخلاق؛ انظر: يان إسمان، التمييز الموسوي أو ثمن التوحيدية، ترجمة: حسام الحيدري، منشورات الجمل، (كولونيا) ألمانيا، ص68.
[17] يفرّق عدد من علماء ومؤرخي الأديان مثل فراس السواح بين المكونات الأساسية والمكونات الثانوية للدين، ويعتبر السواح أن العقائد والقصص والشعائر هي ما تمثّل المكونات الأساسية، بينما الأخلاق والتشريعات الاجتماعية تمثّل المكونات الثانوية، وهذا التفريق -وكما يؤكد السوّاح- لا علاقة له بمدى الأهمية المُعطاة لكلّ مكون من هذه المكونات، بل هو تفريق قائم على مقارنة الأديان من نظرة تاريخية وظواهرية، حيث ترى هذه النظرة أن ارتباط الأخلاق والتشريعات الاجتماعية والسياسية بالدين هو ارتباط خاصّ بأديان معيَّنة، وظهر على وجه التاريخ في فترة معيّنة، وبالتالي لا يمكن تعميمه على كلّ الأديان، عكس المكونات الأساسية التي تشكّل بنية حدٍّ أدنى للدين تُعْتَبر كالماهية له، هذه الأديان المُعيَّنة التي تشهد كون الأخلاق والتشريعات الاجتماعية مُكوِّنًا من مُكوِّنات الدين هي بالذات الأديان التوحيدية، فوفقًا لإسمان وعبر تفريقه بين الأديان التوحيدية وأديان مصر القديمة، فهذه الأديان التوحيدية هي التي ربطت العدالة بالسماء وجعلتها إلهية. انظر: دين الإنسان؛ بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، فراس السواح، منشورات دار علاء الدين، سورية، دمشق، ط4، 2002، ص47، ص71. وانظر: يان إسمان، التمييز الموسوي أو ثمن التوحيدية، ترجمة: حسام الحيدري، منشورات الجمل، كولونيا (ألمانيا)، بغداد، ط1، 2006، ص68.
[18] بل إن هذا الارتباط بين الشعائر وبعضها داخل دينٍ ما وبين الشعائر والمعتقد جعلَت مارسيل موس يعتبر هذا الارتباط كأحد وسائل النقد للوثائق داخليًّا عن طريق وضعها في سياقها (الشعائري الخاص). الصلاة (بحث في سوسيولوجيا الصلاة)، مارسيل موس، ترجمة: محمد الحاج سالم، دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، ط1، 2017، ص18، 19.
[19] نستعير هذا المفهوم من بول ريكور: من النصّ إلى الفعل، أبحاث التأويل، بول ريكور، ترجمة: محمد برادة وحسان بورقيبة، عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية، القاهرة، ط1، 2001، ص90.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

طارق محمد حجي
باحث مصري له عدد من المقالات البحثية والأعمال المنشورة في مجال الدراسات القرآنية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))