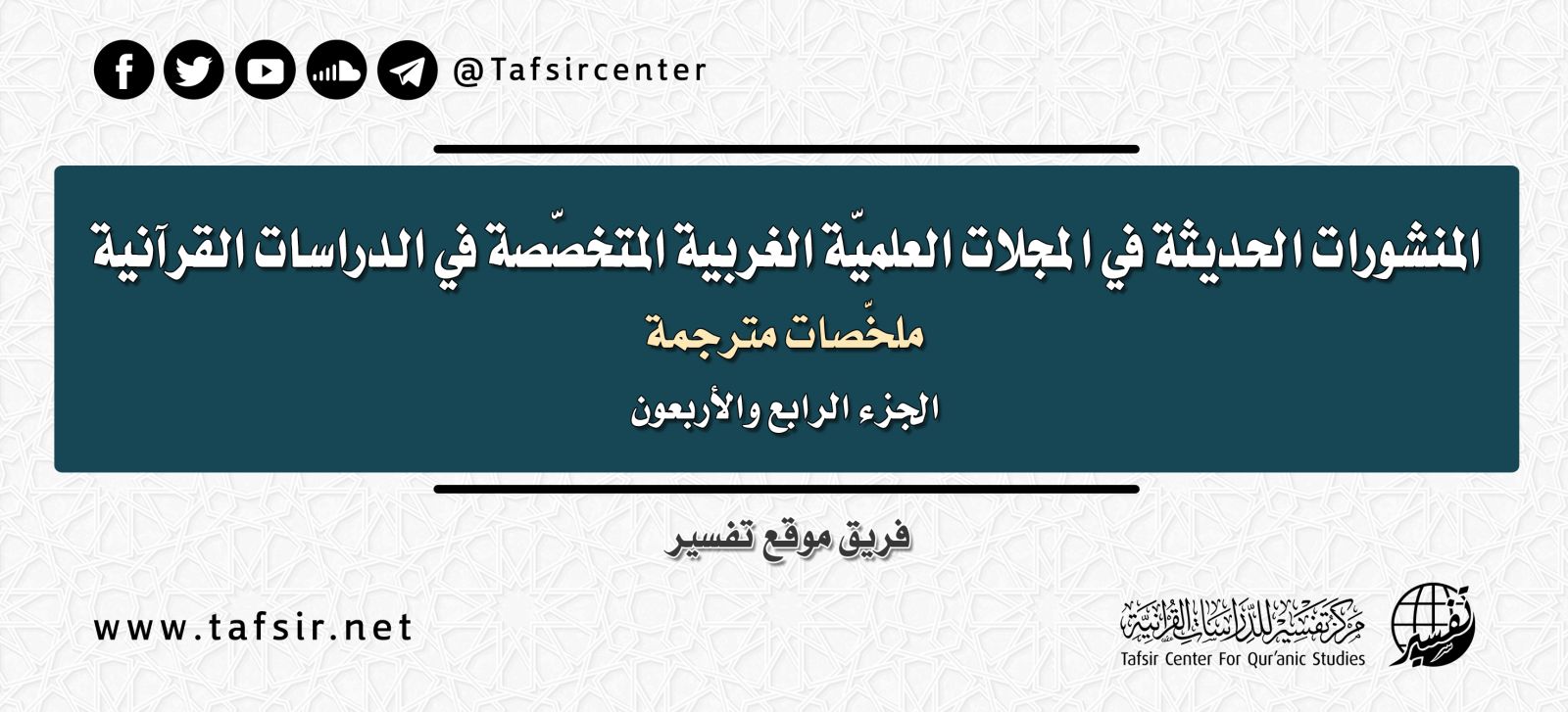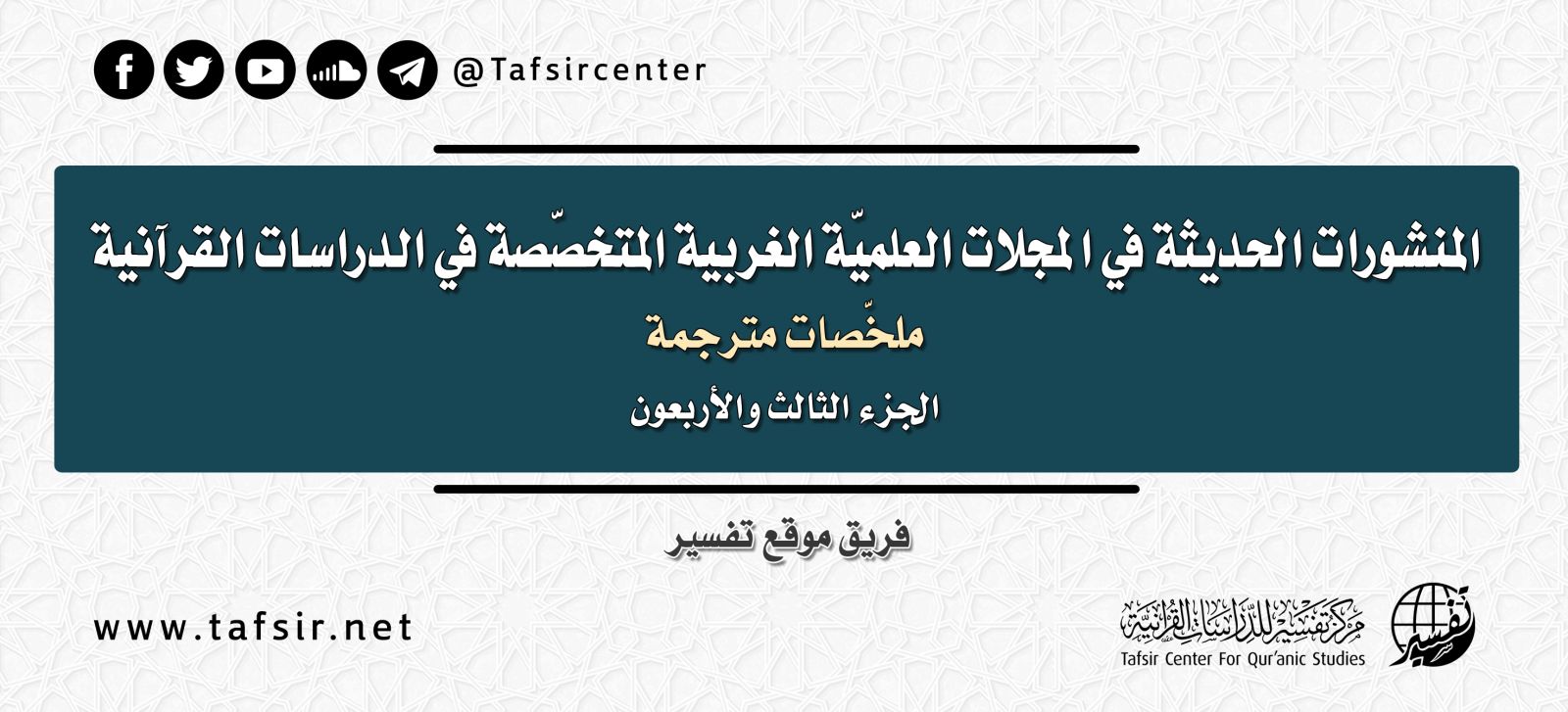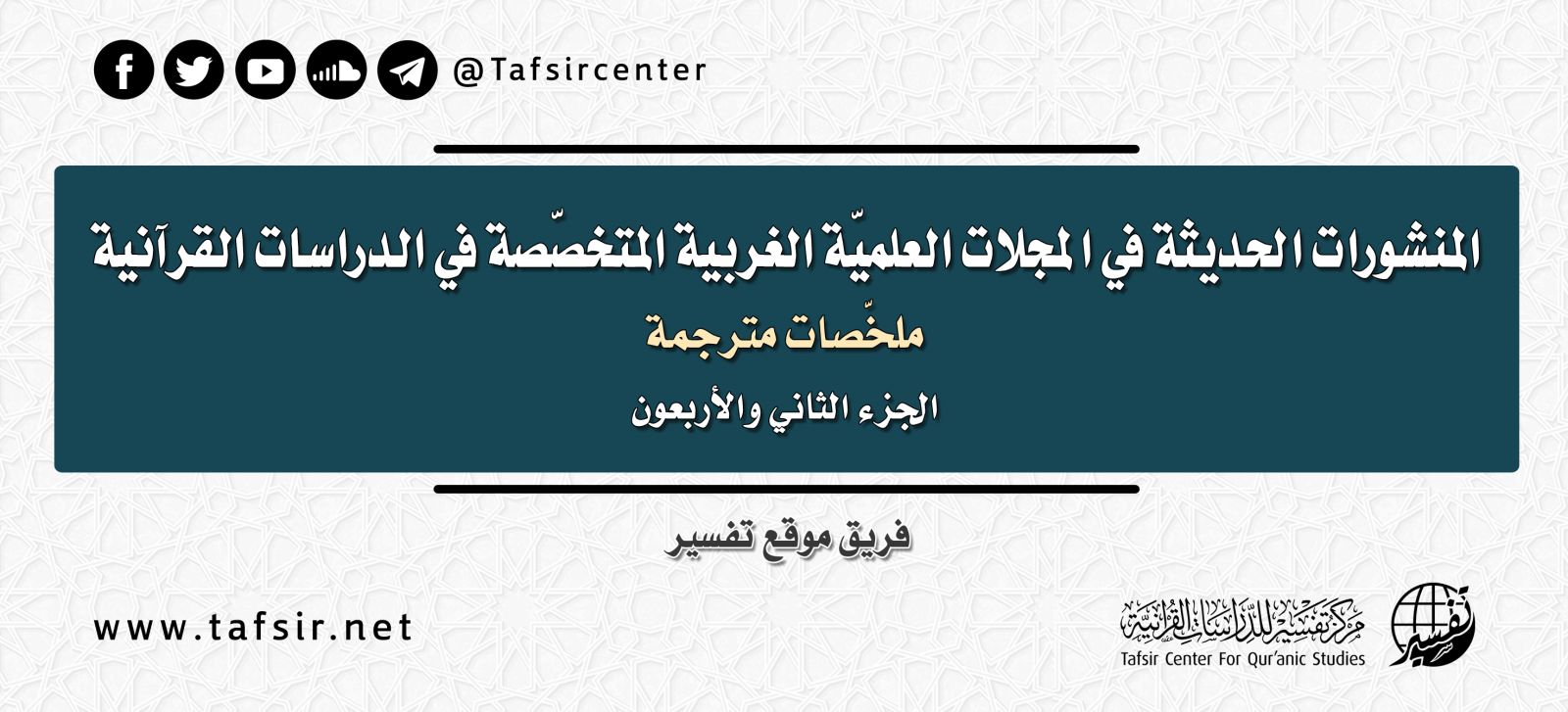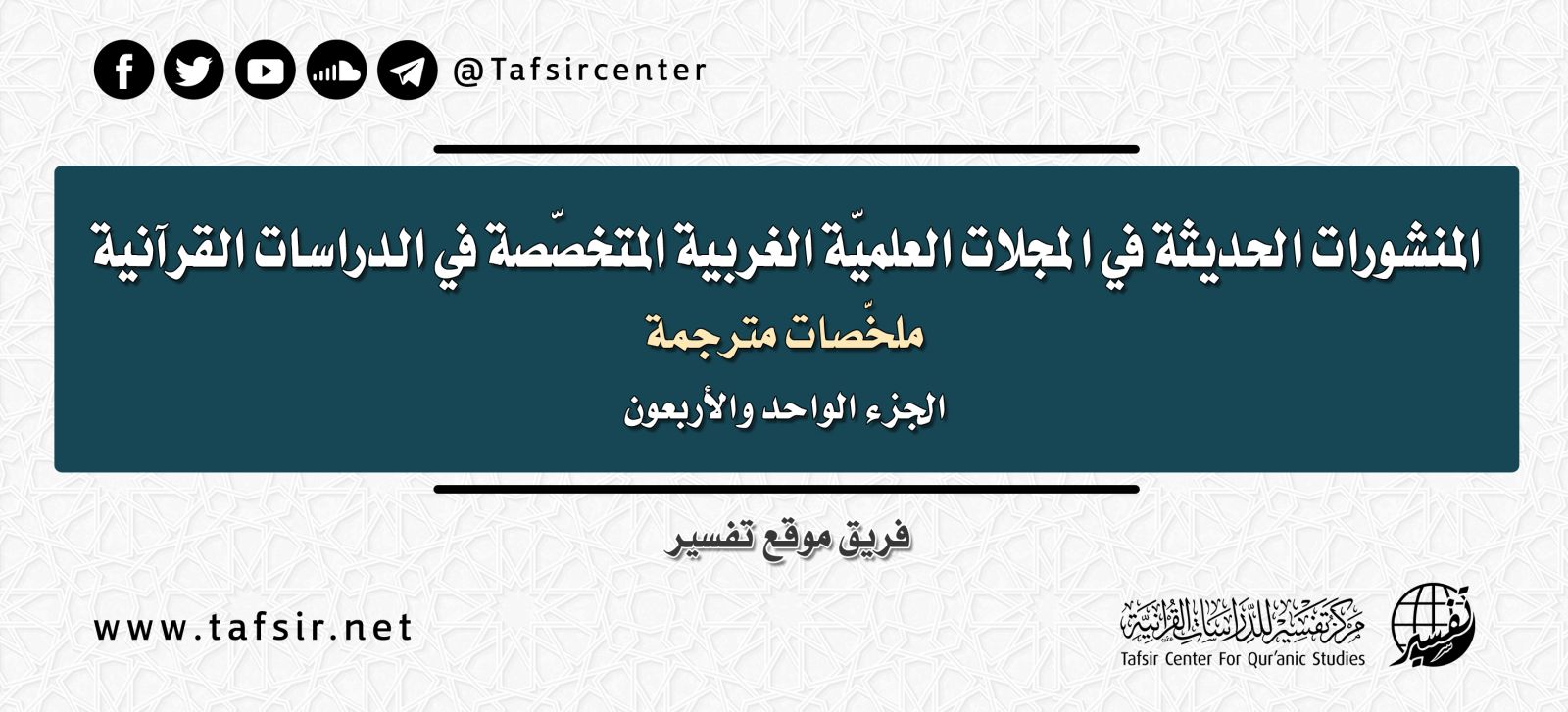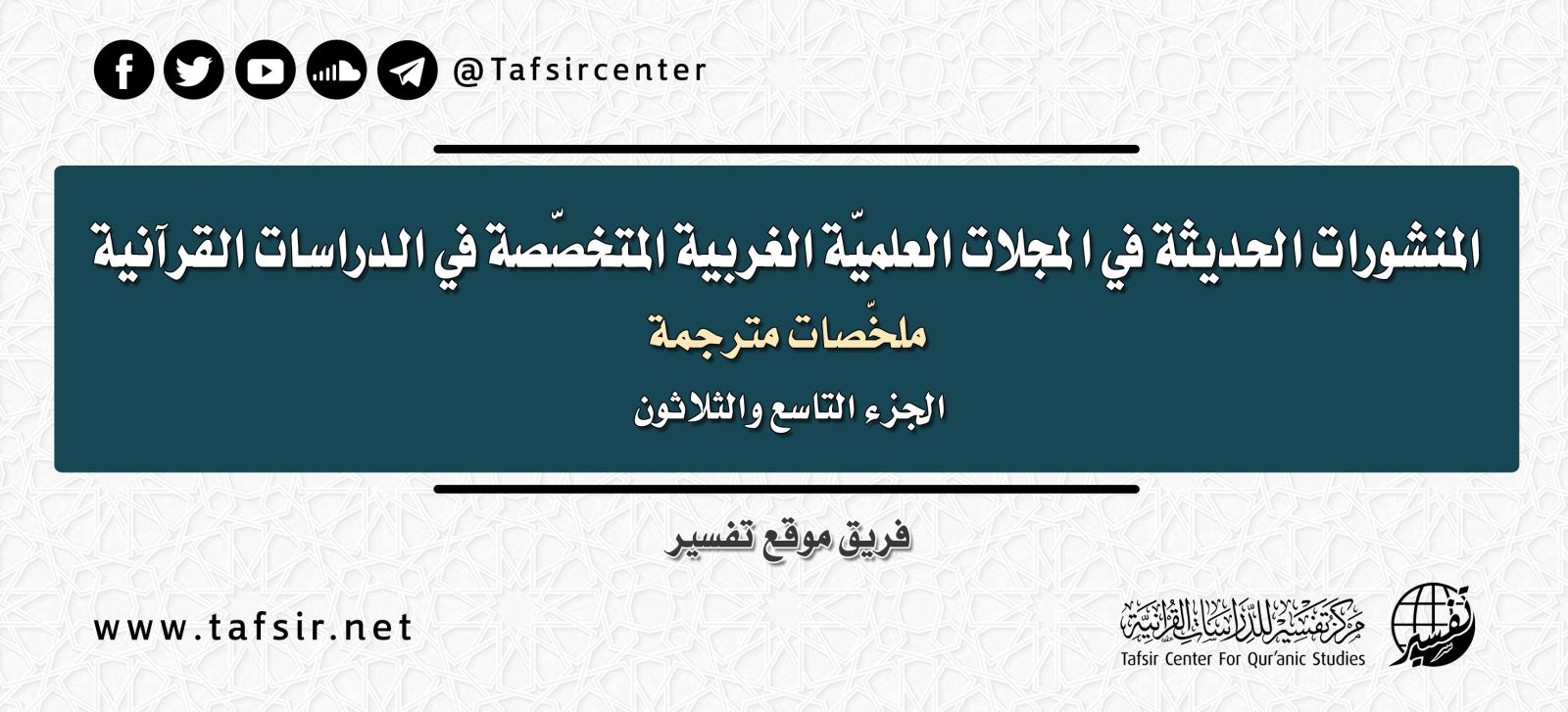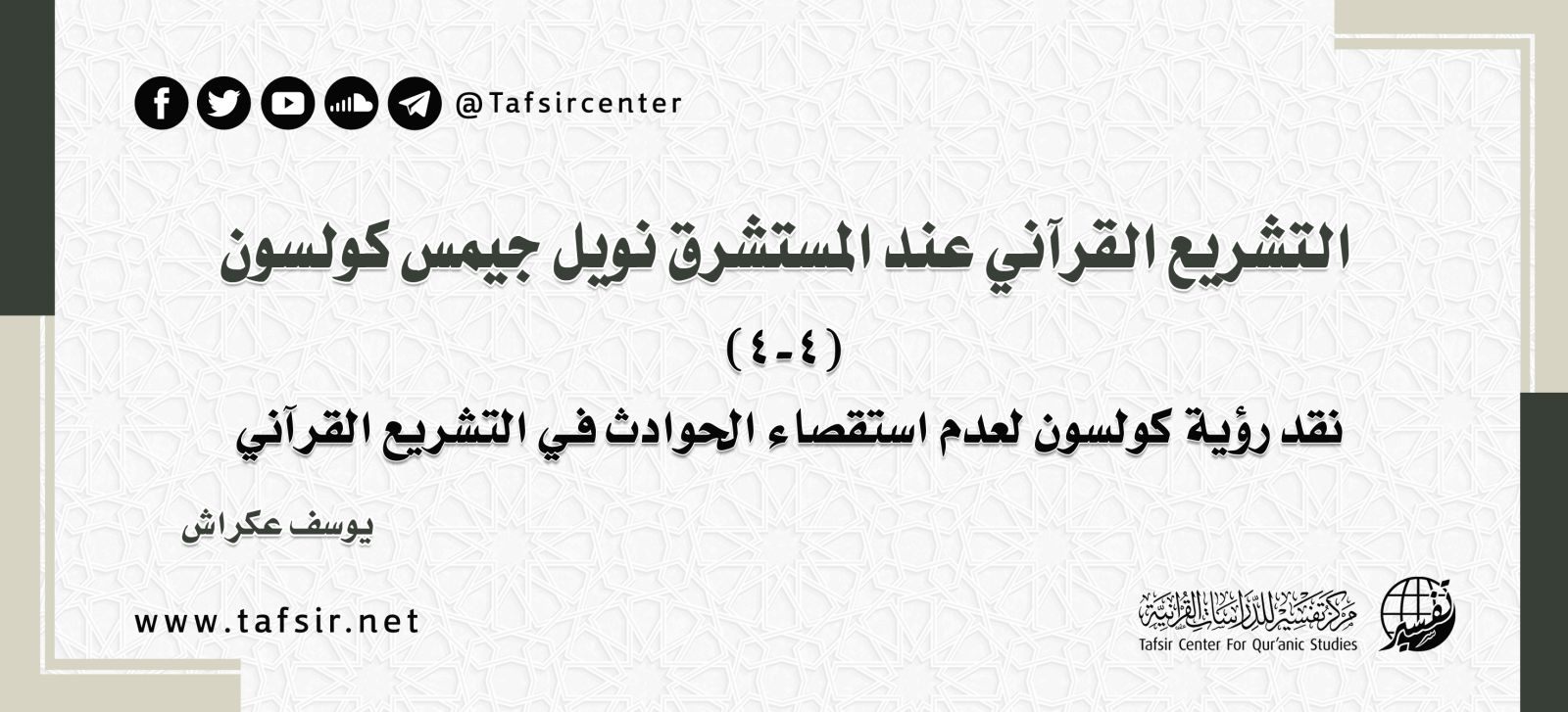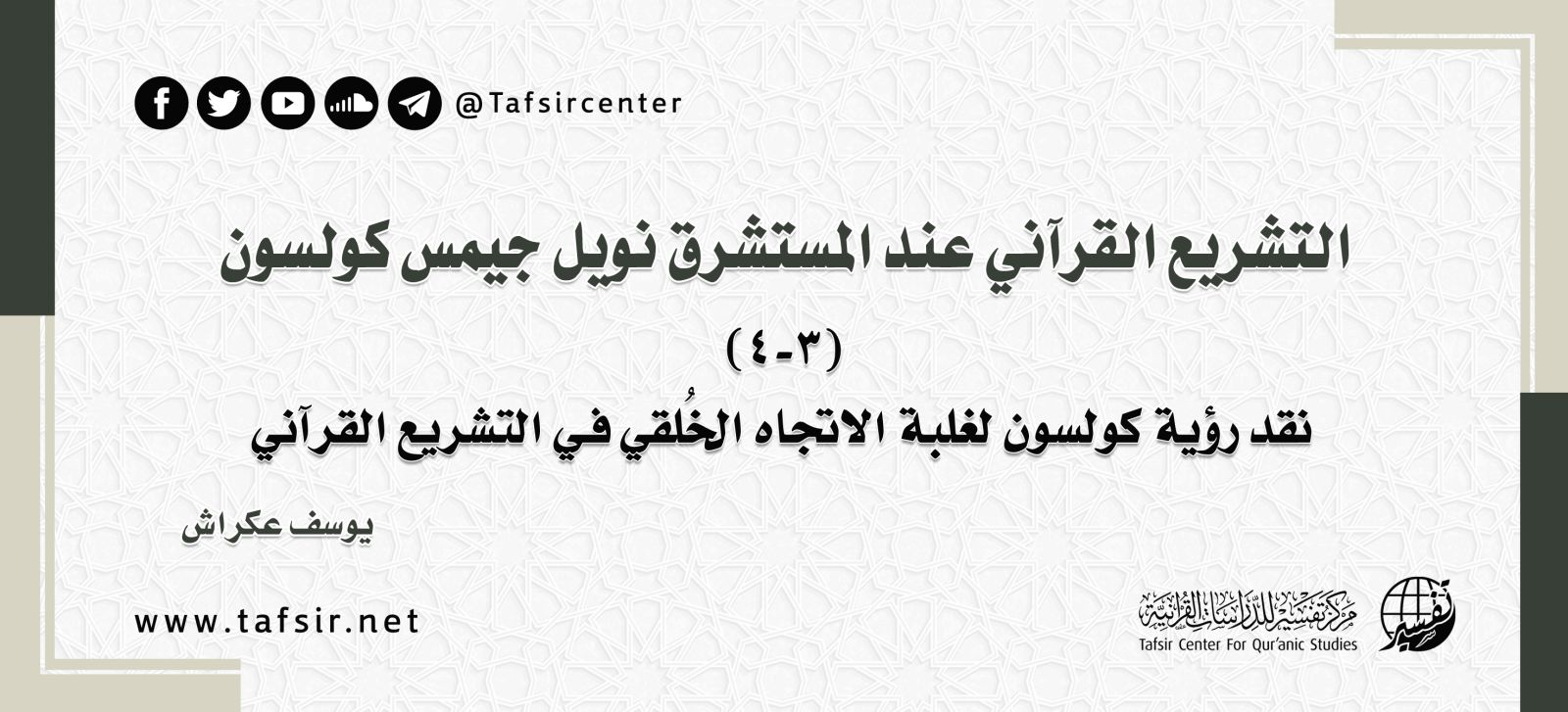"التيبولوجي" كتقنية لفهم القصص القرآني في الدرس الاستشراقي المعاصر
"التيبولوجي" كتقنية لفهم القصص القرآني في الدرس الاستشراقي المعاصر
الكاتب: طارق محمد حجي

إنّ الدارسَ المتابعَ للدراسات الغربية المعاصرة للقرآن، خصوصًا ذات الاهتمام بعلاقة القرآن بالكتب السابقة؛ يظهر له اتجاهُ عددٍ من الباحثين لاستحضار بعض التقنيات التفسيريّة المعروفة في حقل دراسات الكتاب المقدّس لاستخدامها في دراسة القرآن، وخصوصًا في فهم القصص النبوي الوارد فيه، ومن هذه التقنيات ما يعرف بــ(القراءة التيبولوجية)، والتي تعني ضمن دراسات الكتاب المقدّس الكلاسيكية: تفسير بعض الأحداث والأشخاص ضمن تاريخ العهد القديم باعتبارها تجلِّيًا جزئيًّا "type" لأحداث حياة الكلمة/ المسيح "antitypeـ"[1]، بالطبع تمثّل الأناجيل في هذا، بل وبعض طبقات الكتاب المقدّس ذاته، استعادة لقصص سابق ومحاولة صياغته في ضوء الإيمان الجديد ومن منظوره، بهذا تكون القراءة التيبولوجية -وحين تُطَبَّق على القرآن- محاولة لاستكشاف طريقة بناء القرآن لدَور النبيّ محمد -صلي الله عليه وسلم- ولوضعية الأمة الناشئة بحيث تمثّل التجلِّي الأكمل لأدوار الأنبياء ولوضعية الأمم السابقة.
في هذه المقالة سنقوم باستعراض استحضار بعض الباحثين المعاصرين لهذه التقنية والتساؤل حول هذا الاستحضار، وهذا من خلال مثالَيْن من اشتغال كلٍّ من الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفرت، وكذلك الباحثة المصرية نيفين رضا. وهذا من جهةٍ، لاهتمام الباحثتيْن بتناصّ القرآن مع الكتاب المقدّس واستعادة قصصه حيث لهما عديد الأبحاث في هذا[2]. ومن جهة أخرى، لكونهما من باحثِي الاتجاه التزامني في قراءة القرآن، والذي ينطلق من ضرورة التعامل مع القرآن -خلافًا لمعظم الرؤى الاستشراقية الكلاسيكية- كنصّ منسجم له بناؤه الخاصّ واستقلاله تجاه الكتب السابقة؛ مما سيفتح باب التساؤل حول مدى تلاؤم هذه التقنية مع هذا المنظور المتنامي ضمن الدرس الاستشراقي المعاصر، وسينصبّ تساؤلنا هنا على الأساس الفلسفي الذي تقوم عليه القراءة التيبولوجية للكتاب المقدّس وارتباطها ضمن التفسير المسيحي الكلاسيكي بالوضعية الخاصّة للمسيح ككلمة تجاه الكتاب المقدّس، وبالتالي مدى إمكان تطبيقها على القرآن وفقًا لوضعيته التي يرسمها لذاته تجاه الكتاب المقدّس والعلاقة التي يعقدها معه والمفاهيم الأساسية ضمن نسيجه التي تحكم هذه العلاقة، مثل: (البيان)، و(التصديق)، و(الهيمنة).
كما سنتساءل عن الأسباب وراء هذا الاستحضار الاستشراقي لتقنية التيبولوجي وتطبيقها على القرآن، وآثارها، ثم سنختم بالتساؤل حول إمكان وجود طريقة مغايرة لاستخدام هذه التقنية تنطلق من طبيعة العلاقة بين القرآن والكتاب المقدّس، وتفيد في ذات الوقت من هذه التقنية في فهم بعض المقاصد القرآنية من استحضارِ وتوظيفِ كثيرٍ من قصص الكتب السابقة.
القصص النبوي القرآني وواقع الدعوة والقراءة التيبولوجية:
بالطبع فإنّ الصلة بين قصص القرآن النبوي الذي يتناول النبيّ محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلاقته مع قومه في سنين الدعوة وبين قصص الأنبياء السابقين، بل وكذلك مدى تعبير قصص القرآن -الذي موضوعه الأنبياء السابقون- عن واقع الدعوة ذاته، وعن نفسية النبي؛ هي صلة طالما ألحّ عليها الكثيرُ من المستشرقين الكلاسيكيين المهتمّين بدراسة القرآن في علاقته بالكتب السابقة، فنجد مثلًا هاينريش شباير في كتابه الكلاسيكي (قصص أهل الكتاب في القرآن) يؤكّد على هذه الصلة؛ ففي تناوله قصة نوح يعتبر شباير أنّ ما يقوله نوح حول تمنِّي دمارِ الكافرين والغفران لوالديه وللمؤمنين فحسب هو تمَنٍّ محمدي تم إجراؤه على لسان نوح[3]، وفي تناوله قصة إبراهيم يعتبر أنّ «القصة القرآنية تظهر وكأنّ إبراهيم يلعب مع قومه الأدوار التي لعبها النبيّ العربي ذاته، بل إنه يحاول هدايتهم بالكلمات التي يحتاجها محمد في محاولته هداية قومه»[4]، وهي الفكرة التي سيستعيدها من منظورٍ خاصّ محمد أحمد خلف الله في كتابه: (الفن القصصي في القرآن) حين يربط قصة صالح والتسعة الرهط بوضعيةِ تآمُرٍ قرشيٍّ على النبيّ محمد. إلا أن هذا لم يكن يعني أنّ النبي محمدًا يمثل antitype لهؤلاء الأنبياء السابقين بالمعنى الدقيق المفهوم ضمن التقليد الكتابي المسيحي كما افترض بعض الباحثين[5]، بل إنه وكما رأى بعضهم، مثل: (جيجر ثم وانسبرو) فقد تمّ بكلّ وضوحٍ استبعادُ كون هذه الاستعادة تقع في باب الاستعادة التيبولوجية، ولعلّ هذا ما يفسّر جزئيًّا عدم التوسّع في استخدام هذه التقنية في قراءة القرآن من قِبل الباحثين الغربيين الكلاسيكيين.
لكننا نجد أنّ بعض الباحثين المعاصرين مثل أنجيليكا نويفرت وتود لاوسون ومايكل زويتلر ونيفين رضا وغيرهم (ومع تطوّر مناهج دراسة الكتاب المقدّس والتوسّع في تطبيقها على النصّ القرآني، وكذا أَخْذ دراسة العلاقة بين القرآن والكتب السابقة منعطفات خاصّة بحكم تطوّر المنهجيات الكتابية والأدبية) يستعيدون مرة أخرى هذا التساؤل حول إمكان اعتبار العلاقة بين النبيّ محمد والأنبياء السابقين في القرآن «علاقة تيبولوجية»، فتتساءل نويفرت في دراستها (الدراسات القرآنية والفيلولوجي التاريخي النقدي) عن علاقة النبي محمد بالنبيّ موسى في القرآن، حيث تتساءل عن إمكانية كون القرآن يقدّم النبيّ محمد كـ antitype للنبيّ موسى، وبالطبع هذا يستحضر علاقة المسيح بموسى في إنجيل متّى، وهي العلاقة المركزية في بناء هذا الإنجيل وفقًا لكثيرٍ من الباحثين[6]، مما يعني أن إعادة التركيب القرآني للعلاقة بموسى يُعَقِّد العلاقة التيبولوجية ويجعل المسيحَ أحد مراحلها كذلك (موسى type- المسيح type- محمد antitype)، إلا أن نويفرت تعود فتستبعد هذا من منطلق «عدم وجود توتّر عقدي بين الأحداث التوراتية والأحداث القرآنية، ولم يأتِ محمد لتحقيق وعد توراتي»[7].
أمّا نيفين رضا فإنها تتساءل في دراستها عن (طالوت القرآني) عن صلة النبي محمد بطالوت، حيث تعتبر أنه مع ما يبرز في الرسم القرآني له كشخصية تجمع بين الدَّور النبوي والدور العسكري فإنه يعدُّ صورة تيبولوجية مسبقة للنبيّ محمد ذاته الذي لعب الدَّوْرَين في دعوته[8].
والمهم ملاحظته هنا وما نريد التأكيد عليه هو أن قبول رضا للصلة التيبولوجية بين النبي وغيره من الأنبياء في القرآن، أو دعوة تود لاوسون للاستفادة من هذه التقنية ضمن الاستفادة من الدراسات الكتابية ومن إنجازات مثل نورثرب فراي في عمله على الكتاب المقدس، أو استبعاد جيجر ووانسبرو ثم تشكك نويفرت في هذه الصلة، ليس له علاقة بمدى اتساق فكرة (التيبولوجي) مع التصوّر الخاصّ الذي يقدّمه القرآن عن وضعية النبيّ محمد تجاه القرآن وتجاه الكتب السابقة، وكذلك عن وضعية القرآن تجاه هذه الكتب من عدمه، بل يتم القبول إما دون سبب واضح، أو لأسباب أدبية تتعلق بالفارق الخطابي بين التيبولوجية والمنطق السببي كما يرى لاوسون متابعًا فراي[9]، ويتم الاستبعاد لأسباب؛ (شكلية- أدبية) تتعلّق بعدم وجود دراسة شاملة تتيح القطع بوجود هذا الاستخدام التيبولوجي للرموز كنمط قرآني متكرّر[10]، أو لأسباب (لاهوتية) تتعلّق بكون القرآن لا يؤسّس عالمه في ضوء الوعود التوراتية بظهور المسيا، وفي ظنّنا فإنّ هذه الأسباب على وجاهتها وأهميتها فإنها لا تمثّل المحك الأساس لاختبار إمكانية القراءة التيبولوجية للقرآن من عدمها، والمتمحور حول وضعية النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ووضعية القرآن في مواجهة الكتب السابقة، حتى إننا لنستطيع القول أن الرغبة التي تحدو بعض الباحثين لتسييق القرآن ضمن تاريخ الكتب المقدسة كعلاج لخطأ استشراقي عتيق -كما يرى ويلفرد كانتويل سميث- وأيضًا تلك التي تحدو بعضهم الآخر لإقصائه منها بعلّة كونه محضَ انتحالٍ هي ربما ما تجعل هذه الوضعية ومدى حسمها لإمكان القراءة التيبولوجية ليست محلَّ امتحان دقيق من الجميع كما سنوضح تفصيلًا، إلا أن امتحان هذه الوضعية هو وحده ما يستطيع أن يبرز لنا بحسم حدود هذه القراءة وإمكان استخدامها ومدى قدرتها على استكشاف بعض المقاصد القرآنية، من حيث كونها معبّرة أَوْ لَا عن العلاقة التي يعقدها القرآن مع الكتب السابقة، وهذا من حيث إن التفسير التيبولوجي المسيحي للكتاب المقدّس كمحور أساس للعلاقة اللاهوتية والليتورجية (الشعائرية) بالعهد القديم لم يستقر هذا الاستقرار في التقليد الكتابي المسيحي بسبب كثرة الأنماط الأنجيلية والليتورجية أو تكرارها، أو كون المسيح يمثّل الوعد التوراتي فحسب، بل وقبل هذا لأن هذا التفسير معبّر تمامًا عن وضعية المسيح تجاه (الكتب)، أي: عن تلك العلاقة التي يعقدها المسيح ذاته كـ(كلمة) مع الكتاب المقدّس العبري، مما يجعل السؤال عن وضعية القرآن تجاه الكتب السابقة هو السؤال الحاسم في تناول هذه التقنية وإمكان تطبيقها عليه لاستكشاف بعض مساحاته.
القراءة التيبولوجية ووضعية المسيح/ الكلمة- النبي- القرآن، تجاه الكتاب المقدّس:
في الحقيقة إنّ القراءة التيبولوجية كتقنية في فهم الكتاب المقدّس وشخوصه وقصصه وأحداثه الحاسمة لا يمكن فهمها بعيدًا عن علاقة مفترضة بين الكتاب المقدّس وبين المسيح كـ(كلمة)، حيث حضور المسيح ككلمة أزلية متجسدة هو وحده ما أعطى إمكانية لقراءة الكتاب المقدّس كـ(كلمة جزئية أو إرهاصية أو تمثيلية)، تنتظر التكشّف النهائي في التجلّي الأكمل لها مع المسيح، هذا الحضور يبرز وفقًا للتقليد المسيحي في كلام المسيح نفسه كما تنقله الأناجيل؛ فقد جاء في ختام لوقا: «وَقَالَ لَهُمْ: (هذَا هُوَ الْكَلاَمُ الَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ وَأَنَا بَعْدُ مَعَكُمْ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَتِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِّي فِي نَامُوسِ مُوسَى وَالأَنْبِيَاءِ وَالْمَزَامِيرِ)، حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُب، وَقَالَ لَهُمْ: (هكَذَا هُوَ مَكْتُوبٌ، وَهكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ وَيَقُومُ مِنَ الأَمْوَاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ...) (لوقا 24: 44-47)»، كذلك في ربط المسيح نفسه تيبولوجيًّا بيونان، كما يخبرنا إنجيل لوقا: «وَفِيمَا كَانَ الْجُمُوعُ مُزْدَحِمِينَ، ابْتَدَأَ يَقُولُ: (هذَا الْجِيلُ شِرِّيرٌ. يَطْلُبُ آيَةً، وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلَّا آيَةُ يُونَانَ النَّبِيِّ لأَنَّهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ آيَةً لأَهْلِ نِينَوَى، كَذلِكَ يَكُونُ ابْنُ الإِنْسَانِ أَيْضًا لِهذَا الْجِيلِ...) (لوقا 11: 29-30)»، كذلك فقد قرأ المسيحُ الكثيرَ من نصوص الكتب وفسّرها باعتبارها تأكيدًا لكونه (المسيا)، ما يعني أن المسيح ذاته وجَّه المؤمنين للنظر له كمفتاح وحيد لفهم الكتاب المقدّس العبري.
بسبب هذا فإننا نجد أنّ التعامل التيبولوجي مع الكتاب المقدّس يحضر في التاريخ الكتابي المسيحي بما هو أكثر وأسبق كذلك من مجرد (تقنية تفسيرية) -حتى وإن كانت تقنية شديدة المركزية تمثّل المعنى الحقيقي للتفسير بما هي نهاية للفهم الحرفي وبداية للتمثّل الأخلاقي والأخروي-، حيث يحضر كأحد محددات التعامل المسيحي المبكّر مع الكتب والذي هو تلَقٍّ ليتورجي يحتفل بتجسُّدها الموعود في المسيح، ثم في رسائل الرسل، ثم في بناء متون الأناجيل ذاتها بما هي بشارة الكلمة وتجسُّدها، ثم في الأيقونات المبكّرة بما هي وسيط ليتورجي مترسّخ في الرؤية المسيحية عن التجسد والاحتفال الليتورجي بالكلمة.
فقد استخدمَت الجماعة المسيحية المبكّرة نصوص العهد القديم -خصوصًا المزامير- باعتبارها نصوصًا ليتورجية، أي: معاشة بفعل التجسّد الذي أعلن في المسيح، كذلك فكتب الرسل الأوائل: إكلميندس، وبوليكاربوس، وبولس، قد استحضرت بوضوح هذه الرؤية[11].
أمّا الأناجيل فقد استحضرت في بنائها بشارة المسيح الكثير من النصوص الكتابية، وقامت بإعادة تفسيرها في ضوء حدث الميلاد/ التجسد والصَّلْب والقيامة، أي: الأحداث المركزية للكرازة المسيحية والإيمان المسيحي، فأحداث مثل نبوءة أشعيا عن حبل العذراء بعمانوئيل، وخلق آدم، وطوفان نوح، وحوت يونان/ يونس، وغيرها تم إعادة بنائها باعتبارها أحداثًا لا تجد معناها العميق إلا في المسيح وميلاده وصَلْبه وألمه وقيامته؛ ففي إنجيل متّى -والذي اهتم لإثبات داوُدية المسيح- نجد اهتمامًا بتسييق ميلاد المسيح في نبوءات الأسفار من أجل ترسيخ كون المسيح هو المسيا في إيمان اليهودية المتنصِّرة، كذلك نجد موازاة واضحة بين المسيح وموسى عبر استعادة جبل موسى ووصاياه ليحلّ محلها جبل المسيح وتطويباته[12]، كذلك الموازاة بين المسيح وآدم والتي تبرز بكلّ وضوحٍ في بداية إنجيل متّى في التنسيب النجاري للمسيح[13]، كذا ففي إنجيل لوقا فإننا نجد أن قصة الميلاد تستحضر بوضوحٍ العديد من أبعاد أسفار الكتاب المقدّس، فتستعيد بوضوحٍ أبعاد سفر دانيال التوراتي، وظهور الملاك لموسى في العليقة، كذلك تحضر بكلّ وضوحٍ الموازاة بين المسيح ويونان، وبين مريم والعليقة[14].
أمّا عن الأيقونات المبكّرة والليتورجي المسيحي المبكر خصوصًا السرياني مع إفرام، فيظهر فيها كذلك بوضوح التوسّع الكبير في تلك التوازيات بين المسيح/ يونان، مريم/ هارون، مريم/ عليقة موسى، المسيح/ آدم، المسيح/ داوُد، حتى إنه ربما لا يمكن فهم الكثير من مساحات الأيقونات المبكرة والليتورجي المسيحي المبكّر بعيدًا عن هذه التوازيات التيبولوجية العديدة والمتكرّرة.
هذا كلّه يعني أنّ القراءة التيبولوجية كمرحلة مركزية ضمن مراحل التفسير الرباعي للكتاب المقدّس[15] تمثّل مدار هذا التفسير، راسخةٌ تمامًا في الرؤية المسيحية للمسيح وللعهد القديم، وأنها ليست مجرد تقنية تفسيرية قد تنضاف لغيرها كنوع من أنواع التوسّع في الفهم، فهكذا كان المسيح ذاته يفسّر (الكتب)، ويقدّم ذاته كمفتاح الفهم لهذه الكتب: «حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُب» كما يعبّر لوقا، فهو الهيكل والكلمة والأضحية والمسيا كما ترسمه الأناجيل.
لذا فإنّ السؤال حول تطبيق القراءة التيبولوجية على القرآن بغية فهم قصصه خصوصًا قصص النبي محمد التي تتناص مع قصص الكتاب المقدّس أو تستحضر بعض أنبياء العهد القديم كما رأينا في اشتغال نويفرت ورضا، ليس سؤالًا عن مدى تكرار نمط (الاستعادة)، أو سؤالًا عن (الاستكمال) و(الإتمام) كما يتحدّث وانسبرو ونويفرت، بل هو في عمقه سؤال عن طبيعة علاقة القرآن بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلاقته بالكتب السابقة عليه كما يقدّمها القرآن ذاته، وهل تقدّم هذه العلاقة أيّ إمكانية لقراءة تيبولوجية أم لا؟
وحين ننظر في هذه العلاقة بين (القرآن- النبي- الكتب السابقة) نجدها قطعًا علاقة لا يمثّل النبي محمد فيها (الكلمة) أو (جسد الكلمة) كما المسيح في المعتقد المسيحي، بل فقط حامل هذه الكلمة؛ لذا فلا يمكن اعتبار أنّ النبي محمدًا يمثل antitype لأيّ رسول سابق أو أن تمثّل أحداث حياته تحقُّقات لأحداث كان قد ذكرها الكتاب المقدّس «فعال الله في التاريخ المقدّس» وستجد تجلّيها الأكمل والأشمل في مسيرته على غرار المسيح/ الكلمة، ولكن تنحصر عملية موازاته القرآنية مع الأنبياء السابقين -والتي تَرِدُ مرارًا في القرآن- في مسألة تلقي النبوّة والوحي، ثم في دور النبوة والرسالة ضمن المخطط العام للقصص النبوي القرآني الذي يشمل النبيّ وقومه والمؤمنين والكفار وتدخُّل الله لنصرة المؤمنين في إبراز لهذا المخطط الإلهي العام وسننه الباقية في التاريخ، أمّا الذي يمثّل وضعية الكلمة في الإسلام في حقيقة الأمر فهو القرآن ذاته؛ لذا فهو وليس النبيّ ما يفترض أن يقع عنه التساؤل حول إمكان قراءته تيبولوجيًّا في اتجاه الكتب السابقة، أي: قراءته كمفتاح لفهمها، وهذا وفقًا للعلاقة التي يعقدها القرآن داخل نصّه مع هذه الكتب.
والحقيقة أنّ علاقة القرآن بالكتب السابقة والتي هي مدار دراسة أيّ علاقة (تفسيرية) بين القرآن وبين هذه الكتب، هي إحدى المساحات الرئيسة والواسعة لاهتمام القرآن، وقد لفت هذا نظرَ الكثير من الباحثين الغربيين الذين نظروا للقرآن من منظور منهجيات تزامنية تنطلق من انسجام النصّ القرآني وشموله لقصدٍ موحَّدٍ، مثل: شتيفان فيلد ودانييل ماديغان وآن سيلفي بواليفو وأنجيليكا نويفرت، حيث برز من هذا المنظور كيف أنّ القرآن (وعَبْر عددٍ من المفاهيم التي يحيل بها إلى ذاته ووضعيته، مثل: «الكتاب» «أُمّ الكتاب» «اللوح المحفوظ» «التنزيل» «القرآن...»، والتي منها ما يتناص ويستعيد تأثير مفاهيم كتابية، مثل: «قريانا» و«مشنا»، وكذا عَبْر عدد من الإستراتيجيات الحجاجية والتي تدور حول النبوة والقرآن) يؤسّس ذاته ككتابٍ مقدس منزل من السماء له نفس وضعية القداسة والتعالي التي للكتب السابقة، بل يُعَدّ -وكما يقول وليم جراهام- «أكثر الكتب وعيًا بهذه القداسة وتأسيسًا لها»، والأهمّ أنه يؤسّس ذاته ككتابٍ ذي سلطة في مواجهة هذه الكتب ذاتها، حيث -وكما ترى بواليفو- فإنّ القرآن باستعادة سلطة هذه الكتب الكلية مع اتهامها بالتحريف، فإنه يجرِّدها من سلطتها التفصيلية ليمنحها لذاته[16]، كموضع وحيد لحقيقة هذه الكتب، سواء على مستوى الحرف أو على مستوى المعنى، حيث إنّ القرآن وكما يصف ذاته فإنه يمثّل التجلّي الكامل والأمثل لــ(الكلمة الإلهية) { وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ }[الزخرف: 4]، كما يقدم ذاته لا باعتباره مفتاح فهم (المعنى) كما المسيح للكتب، بل باعتباره مفتاحًا تصحيحيًّا -لِمَا تم تحريفه- على مستوى الحرف وتفسيريًّا لكل ما سبق على مستوى المعنى، عبر مفاهيم (التصديق) و(الهيمنة) و(البيان) كمفاهيم حاكمة تمامًا للعلاقة القرآنية بما سبق.
بهذا يكون المدار الرئيس للاستفادة من هذه التقنية بما هي بشكلٍ مجرّد يتجاوز التطبيق المسيحي الخاصّ ليشمل علاقة الكتب الإبراهيمية ببعضها «علاقة تفسيرية بين كلمة متأخرة وكلمة سابقة» هو فهم طبيعة تأسيس القرآن لذاته ككلمة أخيرة في مواجهة الكتب السابقة، وبيان لها على المستويين الحرفي والمعنوي.
هذا على مستوى تأسيس القرآن لسلطته بشكل كلِّي -مفاهيميًّا وحجاجيًّا- في مواجهة الكتب السابقة وملامح علاقته بهذه الكتب، كذلك فعلى مستوى تفصيلي فإنّ القرآن يشملُ الكثير من الآيات التي تتحدّث عن كون القرآن يقدّم التفسير الصحيح لما اختلف فيه السابقون، وأنه يقصّ القصص الحقّ حسمًا لما اختلف فيه السابقون، ويظهر هذا تفصيليًّا سواء في القصص التي يبدو فيها مخالفًا تمامًا لقصص الكتاب المقدّس «حيث يكون بذلك بيانًا لحرف الكتاب المقدّس المحرّف»، أو في تلك التي لا يبدو أنّ القرآن مختلف فيها مع قصة من قصص الكتاب المقدس بعهديه «حرف الكتاب المقدّس» بقدر ما يبدو مختلفًا مع تفسير أهل الكتاب لهذه القصة «حيث يكون بهذا بيانًا لمعنى الكتاب المقدّس»، وأكثر ما يظهر هذا الأخير هو في اختلاف أهل الكتاب حول (الكلمة) ذاتها، حول المسيح.
فمثلًا عندما يؤكّد القرآن كون المسيح عند الله كمثل آدم، وهو ما يستعيد الرؤية التي يصدِّر بها متّى إنجيله في استعادة بناءٍ لسفر التكوين كما يرى جان دانيالو، والمستعادة في معظم النصوص الليتورجية والأيقونات المبكّرة باعتبار المسيح تيبولوجيًّا هو (آدم جديد) أو (آدم الثاني)، فإنّ القرآن يقدّم تفسيرًا مختلفًا لهذه الصلة بين آدم والمسيح نستطيع اعتباره (تفريغًا لتيبولوجيةِ الصلة) إنْ صحّ التعبير، فكما يقول شباير فليس المقصود هنا بهذه الموازاة أنّ المسيح هو آدم جديد أو بشرية جديدة كما هي الرؤية المسيحية، بل إنها تكريس للموقف القرآني الرافض للطبيعة غير البشرية للمسيح، فمقصود الآية بالتحديد أن المسيح كآدم خُلِق من تراب وليس أزليًّا[17].
إنّ القرآن لا يمثّل فقط الكلمة الخاتمة، بل بما هو كذلك فإنّه يمثّل البيان الإلهي الشامل، فهو وكما يقول: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل: 89]، وأحد أهم أوجه بيانه هي كونه البيان الأخير والشامل للكلمة السابقة، والذي يقدِّم -عبر سرده قصص السابقين- بيانَ هذه الكتب؛ حرفًا ومعنًى، جملةً وتفصيلًا.
أسباب اللجوء لهذه التقنية في قراءة القصص القرآني:
استخدام هذه التقنية وتطبيقها على قصص القرآن -أو حتى التساؤل حول هذا- مع افتقاره للأساس النظري المنهجي، ومع الاختلاف العميق والواضح بين وضعية المسيح تجاه الكتاب المقدّس وبين وضعية النبيّ محمد تجاه القرآن وتجاه الكتب السابقة، ووضعية القرآن تجاه هذه الكتب، على ما أوضحنا؛ يدفع للتساؤل حول سبب استعادة بعض الباحثين لها من الأساس! والسبب الرئيس في ظنّنا يتعلّق بموضع القرآن ضمن النصوص الكتابية المقدّسة في الدراسات الغربية منذ بداية (عصر البحثية النقديّة القرآنية) مع جيجر كما يقال؛ فبينما نجد أنّ الدراسات الغربية الكلاسيكية درَجَت على إخراج القرآن من (اللائحة المعتمدة للنصوص المقدّسة التوحيدية) بتعبير أنجيليكا نويفرت[18]، ولم تهتم بدراسته كما تدرس النصوص الكتابية وبالتقنيات المتقدمة التي تطبق عليه، «وإنما هي لا تزال تتبع مجموعة انتقائية ومحدودة من المناهج التي تميل لأن تكون جوهرانية في تعاملها مع القرآن»، دون سبب لهذا إلا الوضعية الاستثنائية المفترضة للقرآن «باعتباره نصًّا مقدسًا غير كتابي، أي: سوى (غيريته) المزعومة» كما يعبر العظمة[19]، ثم قامت بحصر صِلته بالكتاب المقدّس العبري ضمن إطار (الأثر والتأثر) فحسب، فنُظِر إلى القرآن ككتاب منتحل ومقتبس كما نجد مع هاينريش شباير ويوسف هورفيتس وإبراهام جيجر، فإنّ كثيرًا من الباحثين المعاصرين وعلى خلاف ذلك بدؤوا في استشكال هذا الإقصاء المتعمَّد للقرآن، وحاولوا دمج القرآن معرفيًّا داخل سياق النصوص الكتابية المقدّسة عبر تطبيق منهجيات دراستها عليه، ساعد في هذا أمران؛ الأول: تلك الانعطافة التي أخذتها دراسة العلاقة بين القرآن والكتاب المقدّس جرّاء تطور المناهج في دراسة النصوص، والتي خلخلت من فرضية (الأثر والتأثر) لصالح نظريات (التناص) الأدبية التي تدرس العلاقات الأكثر تركيبًا بين النصوص. والثاني: بروز الاتجاه التزامني المتأثّر بتطوّر الدراسات الأدبية والكتابية بفرضياته حول انسجام النصّ وبنائه الخاصّ على مستوى الموضوعات والقواعدية وأساليب الحجاج، والذي برز من خلاله كيف أنّ القرآن نصٌّ يؤسّس بكلّ وضوح سلطته ومرجعيته وصِلته بالكتب السابقة عليه واستقلاله تجاهها في ذات الوقت، نصٌّ يُظْهِر وعيًا بقداسته بشكلٍ يختلف عن الكتب السابقة التي تأسّست قداستها بأثر رجعي كما يعبر جراهام.
لكنه من المفارقة أن عدم التنبّه الكبير لاختلاف وضعية القرآن تجاه الكتاب المقدّس، عن وضعية المسيح تجاهها، والذي هو مدار السؤال عن إمكان قراءة تيبولوجية للقرآن؛ قد تم من الطرفين، أي: ممن يُخرِجون القرآن عن سياق النصوص الكتابية المقدّسة ومناهج دراسته، وممن يريدون موضعته ضمنها؛ فالأولون نفوا هذه الصلة (مبدئيًّا) جرّاء استبعاد القرآن من سياق هذه الكتب، فلم يحتاجوا للتعمّق في صلة القرآن التفسيرية بها بشكلٍ دقيق، حيث لا صلة إلا الانتحال والاقتباس. أمّا الآخرون فربما الرغبة في دمج القرآن ضمن سياق هذه الكتب ومناهجها علاجًا للخطأ الاستشراقي العتيق وتطويرًا لحقل الدراسات القرآنية غلب على التأسيس المنهجي السليم المفترض والذي يفرض ضرورة امتحان وضعية القرآن تجاه الكتب السابقة.
وربما الأثر الأهم لتطبيق هذه التقنية دون أساس منهجي سليم كالذي تحظى به ضمن دراسات العهد الجديد والقديم، هو أنها تمثّل تعارضًا مع المنطلقات التي ينطلق منها كثير من مطبقيها، حيث إنها -وبتجاهلها الوضعية الخاصّة التي يعطيها القرآن لنفسه تجاه الكتب السابقة- تجاهلت البناء الخاصّ للنصّ القرآني الذي تنطلق هذه الدراسات من افتراض وجوده موضوعيًّا وقواعديًّا وحجاجيًّا في القرآن جملةً وسورًا ومقاطع، حيث تهدر النظرة الخاصّة التي يحملها لذاته ولوضعيته تجاه ما سبق، فإذا كانت موضعة القرآن في الصلة بهذه الكتب هو مهم من حيث إنه «وبمجرد ما أن تُنفى مشاركة القرآن في الباراديم (النموذج) الكتابي الذي تتشارك فيه الأديان الكتابية الأخرى، تغدو العديد من سمات النصّ الأساسية غائمة»[20]، إلا أن افتراض كون هذه الصلة هي ذات الصلة بين (المسيح) والكتاب المقدّس في التقليد الكتابي، أو تغييبه لصالح مماثلة صلة النبي بالأنبياء الواردين في القرآن بصلة المسيح بأنبياء العهد القديم، لن يساعد أبدًا في تبديد هذه الغيومة بل في حقيقة الأمر سيزيدها.
مساحات للاستفادة من التيبولوجي في قصص الأنبياء:
إلا أنّ هذا لا يعني عدم وجود أيّ فائدة من استحضار هذه التقنية بشكلٍ جزئي ينضاف للاستخدام الأعمق والأشمل والمتعلق بعلاقة القرآن بالكتب السابقة، ونقصد بالاستخدام الجزئي، أيْ: ذلك الخاصّ بفهم بعض المساحات القرآنية الجزئية والتي تتعلق بالقصص القرآني عن الأنبياء بالفعل، إلا أن هذا سيكون في غير القصص النبوي حول النبي محمد، وإنما في قصص الأنبياء الآخرين خصوصًا تلك التي تتناص بوضوح مع الكتاب المقدّس أو الكتب الحافة به ليتورجيًّا وما تتضمنه هذه الكتب من تيبولوجيات يستعيدها القرآن؛ إمّا لاستخدام بعض دلالتها أو لتفريغها من مضمونها التيبولوجي كما ذكرنا في مثال المسيح/ آدم، ونستطيع هنا أن نذكر مثالَيْن على استعادةٍ قرآنيةٍ لتيبولوجيات من أجل استخدام مضامينها في تكريس دلالات معيّنة؛ مثالًا من اشتغال الباحثة الألمانية أنجيليكا نويفرت على قصة مريم في سورة آل عمران، ومثالًا ثانيًا من سورة مريم، يوضح لنا الفائدة التي يمكن جَنْيُها من وراء هذا.
ففي دراستها لقصة مريم في سورة آل عمران، اعتبرت أنجيليكا نويفرت أن نسبة القرآن مريم إلى عمران، ليست -بأيّ شكل- نوعًا من الخطأ التاريخي أو الخلط بين مريم أُمّ المسيح ومريم أخرى من الكتاب المقدّس (بنت عمران وأخت موسى وهارون) كما اعتادت الكتابات الاستشراقية أن تقول في مثل هذا، وإنما ترى الألمانية أنّ القرآن لا يقدِّم هنا نَسَبًا بيولوجيًّا لمريم، بل يقوم باستعادة تنسيب تيبولوجي لها، حيث يضع مريم أُمّ المسيح في وضعية مريم بنت عمران باعتبار الأولى تجسُّدًا أكمل لها[21].
كذلك نجد في سورة مريم أنّ القرآن يُجْرِي على لسان متهمي مريم مناداتها بــ{أُخْتَ هَارُونَ}، ويتم هنا استشراقيًّا استعادة ذات الاتهام بالخلط بين مريم أُمّ المسيح ومريم النبيّة -وفقًا للتقليد التوراتي- أخت هارون وموسى، وتقليديًّا يتم تفسير هذا بأن لفظة الأخ والأخت عربيًّا لا تعني بالضرورة الأخوّة البيولوجية، بل النسبة العامة، لكن نظنّ أنّ في هذا تنسيبًا تيبولوجيًّا لهارون كذلك، والأهمية الكبيرة هنا هي الدلالة المهمّة التي يبرزها هذا التنسيب في السياق الكلي للآيات؛ فاختيار هارون تحديدًا لا موسى أو عمران، يتماشى تمامًا مع العلاقة التيبولوجية التي تقيمها النصوص المسيحية الليتورجية بين مريم وهارون أو تحديدًا مريم وعصا هارون[22]، حيث نجد إقامة لتشابه بين عصا هارون التي أنبتت بغير ماء، وبين مريم التي أنجبت دون معرفة رجل، هنا يصبح هذا الاستدعاء التيبولوجي -تحديدًا- له دلالة كبيرة في بيان تبرئة مريم أمام اليهود عبر الاستناد لوضعية راسخة في التراث الكتابي اليهودي عن النبي هارون الذي أورقت عصاه دون ماء[23].
خاتمة:
نستطيع الخلوص من هذا بأنه لا يمكن اعتبار حضور النبيّ محمد في القرآن حضورًا تيبولوجيًّا مع أيّ نبيّ سابق بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة؛ لِمَا لها من انغراس في تصوّر خاصّ عن العلاقة بين الكلمة المسيحية والكتاب المقدّس بشكلٍ لا ينطبق بحال على وضعية النبيّ محمد كرسول حامل للرسالة، وأن الموازاة الحاصلة بين الأنبياء في القرآن تظلّ في إطار الموازاة ضمن المخطط القصصي الأكبر عن علاقة الرسول بقومه وبالله وعن مصير المؤمنين، وأنه بالإمكان عقد موازاة تيبولوجية مفيدة مع الكتاب المقدّس لكن مدارها سيكون علاقة القرآن ككلمةٍ بالمسيح والكتاب المقدّس ككلمةٍ إلهية سابقة، حيث يمثّل القرآن البيان والمفتاح التفسيري لكثير من مساحات الكتاب المقدّس وللكلمة/ المسيح حرفًا ومعنى.
كذلك فبإمكان الإشارات التيبولوجية المبثوثة في الكتابات الليتورجية المسيحية أن تفيدنا في فهم بعض إلماحات القرآن التي قد تكون استعادت هذا في مواجهة الجدل اليهودي-المسيحي حول عقائدهم أو حول القرآن وقصصه وعقائده، قبولًا أو رفضًا، لتكريس دلالات قرآنية خاصّة ربما يغيب فهمها إنْ تمّ تفويت الانتباه لهذه الإشارات، مما يعني أنّ أيّ استحضار لتقنية التيبولوجي في قراءة القرآن لا بد أن يشهد -بدايةً- تعديلًا منهجيًّا عميقًا لها عن استخدامها المستقرّ في دراسات الكتاب المقدّس.
[1] في ترجمته كتاب: (المدونة الكبرى، الكتاب المقدّس والأدب)، لنورثرب فراي، يترجم سعيد الغانمي "type, antitype" بــ(المثال) و(الممثول) على الترتيب، وآثرنا الاحتفاظ بالاسم الأصلي وعدم ترجمته حيث إنّ ترجمته لمثال وممثول أو رمز ومرموز إليه كما عند بعضهم، لا يُعِين القارئ على الوقوف على الدلالات الحافّة بهذه المصطلحات. انظر: المدونة الكبرى، الكتاب المقدّس والأدب، نورثرب فراي، ترجمة: سعيد الغانمي، كلمة، منشورات الجمل، بيروت، ط1، 2009.
[2] انطلاقًا من رؤيتها لعلاقة القرآن بالكتاب المقدّس والتي تقوم على كونه يستعيد الكتاب المقدّس في سياق حواري وحجاجي مع المخاطبين بالقرآن، فلأنجيليكا نويفرت عددٌ كبيرٌ من الدراسات والمقالات التي تهتم بها بصلة القرآن بالكتاب المقدس، منها: عيسى ومريم في القرآن، موازنة الآباء التوراتيين، ترجمة: حسام صبري، وهي منشورة ضمن ترجمات ملف (القرآن وعلاقته بالكتب السابقة) على قسم الاستشراق بموقع تفسير.
- Two Views of History and Human Future: Qur'anic and Biblical Renderings of Divine Promises, 2008
- Locating the Qurʾan in the Epistemic Space of Late Antiquity, 2015
- Qurʾanic Readings of The Psalms, 2010
بالإضافة لدراساتها حول بنية القرآن في كتابها المركزي (دراسات حول تركيب السور المكية، 1981).
كذلك لنيفين رضا بعض البحوث حول علاقة القرآن بالكتاب المقدّس، منها: طالوت في القرآن، وقيام مملكة إسرائيل القديمة، ترجمة: حسام صبري، وهو منشور ضمن ترجمات ملف (القرآن وعلاقته بالكتب السابقة) على قسم الاستشراق بموقع تفسير.
كما أن لها كتابًا مهمًّا حول بنية سورة البقرة بعنوان:The Al-Baqara Crescendo: Understanding the Qur'an's Style, Narrative Structure, and Running Themes.
تصاعدية سورة البقرة: فهم الأسلوب القرآني، وبنيته السردية، وسير الموضوعات، 2017.
وبالنسبة للأمثلة المذكورة هنا فهي فقط للتمثيل عن الفكرة الكلية، حيث ينصبّ اهتمام المقال على الأساس الفلسفي والمنهجي الأعمق للقراءة التيبولوجية ضمن دراسات الكتاب المقدّس، ومدى ملاءمة هذه القراءة للقرآن وفقًا لوضعيته التي يؤسّسها تجاه الكتب السابقة.
[3] قصص أهل الكتاب في القرآن، هاينريش شباير، ترجمة: نبيل فياض، دار الرافدين، بيروت، ط1، 2018، ص234.
[4] قصص أهل الكتاب في القرآن، هاينريش شباير، ترجمة: نبيل فياض، دار الرافدين، بيروت، ط1، 2018، ص292.
[5] اعتبر يانسن أن خلف الله في كتابه: (الفنّ القصصي في القرآن) قد طبّق تقنية التفسير التيبولوجي باعتباره قصص الأنبياء معبرًا عن قصص النبيّ محمد ذاته في واقع الدعوة، وهو في ظنّنا غير دقيق؛ حيث لا يستحضر البُعد الفلسفي الكامن وراء التفسير التيبولوجي والمتعلّق بوضعية المسيح/ الكلمة تجاه الكتاب المقدّس كما سنوضح، والربط الذي يعقده خلف الله بين قصص الأنبياء وواقع الدعوة راجع لنظرته عن القصص القرآني كقصص أدبي مشكل وفق وحدة غرضية، ومن الأغراض الرئيسة للقصص القرآني -وفقًا له- التعبير عن نفسية النبيّ محمد تثبيتًا له. انظر: تفسير القرآن في مصر الحديثة، يوهانس جانسن، ترجمة: حازم زكريا محيي الدين، مؤمنون بلا حدود، بيروت، ط1، 2017، ص52-53-54.
[6] من هذا المنطلق يحاول عمران البدوي دراسة علاقة القرآن بإنجيل متّى السرياني، حيث يعتبر أن القرآن في مواجهة اليهود يستعيد الكثير من ملامح هذا الإنجيل المبني في إطار إحلال المسيح محلّ موسى، بالطبع مع نزع القرآن السمات الإلهية الممنوحة للمسيح ومنحها لله. انظر: الإدانة في القرآن وإنجيل متّى السرياني، عمران البدوي، ترجمة: أمنية أبو بكر، منشورة على موقع تفسير ضمن ترجمات الملف الرابع (القرآن وعلاقته بالكتب السابقة).
[7] الدراسات القرآنية والفيلولوجي التاريخي النقدي، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: محمد عبد الفتاح، منشورة ضمن الترجمات المنوّعة في قسم الاستشراق على موقع تفسير، ص30.
[8] طالوت (شاول) في القرآن وقيام مملكة إسرائيل القديمة، نيفين رضا، ترجمة: حسام صبري، منشورة ضمن ترجمات ملف (القرآن وعلاقته بالكتب السابقة)، على قسم الاستشراق بموقع تفسير، ص36، 37.
[9] انظر:
Duality, Opposition and Typology in the Qur’an: The Apocalyptic Substrate, Todd Lawson, Journal of Qur’anic Studies, 2008, 38, 39.
[10] هاينريش شباير، قصص أهل الكتاب في القرآن، ترجمة: نبيل فياض، دار الرافدين، بيروت، ط1، 2018، ص118.
[11] قراءة الكتاب المقدّس وفقًا للكنيسة الأولى، رحلة استكشافية لمراحل تشكيل فكر المسيحيين الأوائل، رونالد إي هاينه، ترجمة: عادل زكري، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، ط1، 2016، ص40، 41.
[12] شكّلت العلاقة بناموس موسى في ضوء تجسّد الكلمة موضعَ نقاشات طويلة في اللاهوت المسيحي منذ بدايات الكنيسة ثم في عصر الإصلاح ثم عصر التنوير وإلى الوقت الحالي، وظهرت فيها الكثير من الأطروحات لضبط هذه العلاقة وفهمها، وكلّ هذه النقاشات والأطروحات تمحورت حول كيف يمكن فهم الناموس بعد تجسّد الكلمة؛ لذا فهذه العلاقة تبرز بكلّ وضوح العلاقة الأشمل بين المسيح والكتب.
[13] انظر: أضواء على أناجيل الطفولة؛ دراسة عن طفولة يسوع بحسب إنجيلي متّى ولوقا، الكاردينال جان دانيالو، ترجمة: الأب فيكتور شلحت اليسوعي، دار المشرق، بيروت، ط3، 1990، ص13.
[14] أضواء على أناجيل الطفولة؛ دراسة عن طفولة يسوع بحسب إنجيلي متّى ولوقا، الكاردينال جان دانيالو، ترجمة: الأب فيكتور شلحت اليسوعي، دار المشرق، بيروت، ط3، 1990، ص23، 24.
[15] يقوم تفسير الكتاب المقدّس على مرحلتين كبيرتين تُعرفان تفصيلًا بالتفسير الرباعي، حيث يتم تفسير الكتاب المقدس حرفيًّا في المرحلة الأولى، ثم روحيًّا في المرحلة الثانية، وهذه المرحلة الروحية تنقسم لثلاث مراحل: التفسير التيبولوجي، والتفسير الأخلاقي المتعلّق باستحضار معنى الكتاب المقدّس في عمل المؤمن ويسميه بعضهم بــ(المعنى التأويني)، والتفسير الروحي المتعلّق باستحضار الدلالة الأخروية للكتاب المقدّس ويسميه بعضهم بــ(المعنى النهيوي)، والتفسير الروحي بهذا المعنى الذي يشمل ثلاث مراحل قائم في فترة مبكرة من كتابات الآباء بشكل مترابط دون هذا التقسيم، وقد عرفَت العلاقة بين التفسير الحرفي والروحي خلافًا في بدايات تاريخ المسيحية إلا أنها لم تكن غالبًا معترضة على جوهر فكرة التيبولوجي وإنما على التوسّع في لفظ الحرف واستخدام الرمز خصوصًا مع تأثير المدارس الأفلاطونية على عدد من الآباء. انظر: التفسير في أوائل المسيحية والمعاني البيبلية، أنطوان عوكر، ضمن دراسات بيبلية 25، مقدمات في الكتاب المقدّس، الرابطة الكتابية، لبنان، ط1، 2002، ص194.
[16] للتوسع، انظر: إعلان سلطة القرآن في القرآن، آن سيلفي بواليفو، ترجمة: مصطفى أعسو، منشورة على قسم الاستشراق بموقع تفسير، ضمن ترجمات ملف (تاريخ القرآن).
[17] قصص أهل الكتاب في القرآن، هاينريش شباير، ترجمة: نبيل فياض، دار الرافدين، بيروت، ط1، 2018، ص159، 160.
[18] مساءلة التفسير البنيوي، رايتشل فريدمان، ترجمة: أمنية أبو بكر، منشورة ضمن الترجمات المنوعة، على قسم الاستشراق بموقع تفسير، ص19.
[19] الاستشراق في الدراسات الإسلامية، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: طارق عثمان، منشورة ضمن الترجمات المنوعة، على قسم الاستشراق بموقع تفسير، ص7.
[20] الاستشراق في الدراسات الإسلامية، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: طارق عثمان، منشورة ضمن الترجمات المنوعة، على قسم الاستشراق بموقع تفسير، ص23.
[21] نتّفق بشكل عامّ مع هذا، غير أننا نظنّ أن النسبة إلى عمران في القرآن وإن كانت تشمل التيبولوجي لكن لا تقتصر عليه، حيث تكون النسبة لعمران وهو من بيت لاوي، مع استبعاد القرآن النسب النجاري تمامًا، بمثابة خلخلة للشروط التوراتية لمن هو المسيح -حيث اشترطت داوديته-؛ لذا فمن الممكن النظر لقصة مريم في آل عمران كتفكيك لهذه الشروط لنزع حصرية النبوة في بني إسرائيل أكثر من كونها تفكيكًا للنسب الإبراهيمي البطريركي كما تحاجج نويفرت في دراستها هذه. انظر: مريم وعيسى في القرآن، موازنة الآباء التوراتيين، ترجمة: حسام صبري، منشورة على قسم الاستشراق بموقع تفسير، ضمن ترجمات ملف (القرآن وعلاقته بالكتب السابقة).
[22] انظر: أناشيد الميلاد، إفرام السرياني، ترجمة: يوحنا يشوع الخوري، منشورات كلية اللاهوت الحبرية، جامعة الروح القدس، بيروت، 1994، النشيد الأول، 17، ص9.
[23] هناك بعض المحاولات التي قام بها بعض الباحثين الغربيين لتفسير مناداة مريم بأخت هارون تفسيرًا تيبولوجيًّا، منها تفسير نيل روبنسون والذي اعتبر أن القرآن يقدم هنا موازاة تيبولوجية بين مريم وبين أخت هارون، من حيث أن أخت هارون أنقذت موسى من القتل عبر إلقائه في اليم مثل أم عيسى التي أنقذته من هيرودوس بالخروج إلي مصر، وقد اعتبرت فاطمة سروي أن هذه الصلة مبالغ فيها، ونحن نوافقها على ذلك، بل لا نرى أي إمكانية لهذه الصلة، حيث لو تعلق الأمر بموسى وإنقاذه لكانت المنادة "يا أخت موسى"، كما أن ثمة فارقًا مهمًّا بين قيام القرآن بتمثيل تيبولوجي، وبين استعادته تنسيب قائم بالفعل، حيث إن عملية التنسيب التيبولوجي -وكما حاولنا أن نوضح طوال المقال- مرتبطة بتصور خاص للكلمة وللتاريخ لا يتبناه القرآن، أما استعادة بعض التنسيبات في سياق المجادلة مع اليهود والنصارى تظل أمرًا أكثر احتمالية. انظر، التفسير الاستشراقي للنص القرآني في النص الثاني من القرن العشرين، فاطمة سروي، ترجمة: أسعد مندي الكعبي، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، ط1، العراق، 2020، ص194- 195.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

طارق محمد حجي
باحث مصري له عدد من المقالات البحثية والأعمال المنشورة في مجال الدراسات القرآنية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))