الرجولية في القرآن
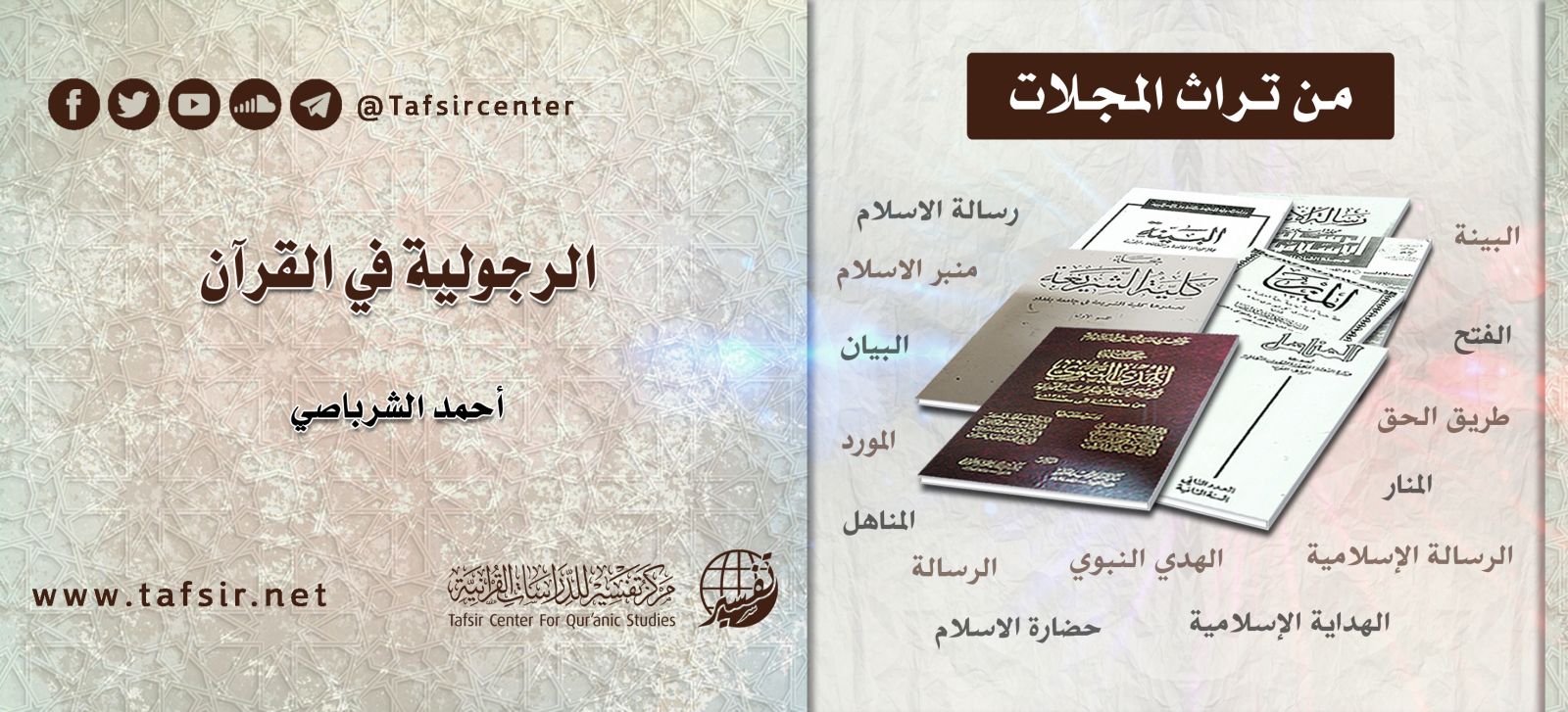
الرجولية في القرآن[1]
هناك بعض الألفاظ التي لا تقتصر في دلالتها على معناها اللغوي الأصلي، بل تُفْهِمُنَا مدلولًا عرفيًّا خاصًّا، ومِن بينِ هذه الألفاظ كلمة (الرجل)؛ فإنها في أصلها تدلّ على مقابل الأنثى، ولكنها تُطلق ويُراد منها في أغلب الأحيان مجموعة من صفات القوّة والشرف والكرم وحُسْن الخُلق، حتى صحّ لأبي حفص النيسابوري أن يجيب مَن سأله: مَن هُم الرجال؟ بقوله: «القائمون مع الله تعالى بوفاء العهود، قال الله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 23]»[2].
وصِرنا نقول في مدح الشخص: «إنّه رجل»، ولا نريد أنه ضدّ الأنثى، بل نريد الثناء عليه، ووصفه بأنه ذو نخوة وأريحية وكرم وشهامة، وأن عنده رجولية تدعوه إلى مكارم الفِعال، وتصدّه عن مواطن الرذيلة. والصِّلة بين هذا المعنى العُرفي وبين أصل المادة موجودة ملموسة.
جاء في (مفردات القرآن) للأصفهاني: «الرَّجُلُ مختصٌّ بالذَّكَر من الناسِ... ورجل بَيِّنُ الرجولةِ والرجوليّة... وقوله: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [غافر: 28]... فالأَوْلَى به الرجولية والجَلادة...»[3].
وجاء في (القاموس المحيط) لمجد الدين الفيروزآبادي: «الرجلُ معروفٌ... والرجلُ: الكامِلُ... ورجلٌ بَيِّنُ الرجوليةِ... وهو أرجَلُ الرجُلَيْن: أشَدُّهُما. والرجِيل الرأي: الصّلْب»[4].
وجاء في (أساس البلاغة) للزمخشري: «هذا رجل؛ أي: كامل في الرجال بيِّنُ الرَّجولية والرُّجولية، وهذا أرجَلُ الرّجُلَيْن... وهو من رِجَالات قريش: من أشرافِهم...»[5].
وفي (مجمع البيان) للطبرسي: «يُقال: رجل بَيِّنُ الرجلة أي القوّة، وهو أرجَلُهُما أي: أقواهما، وفرسٌ رجيل: قويّ على المشي، وسُمِّيَت الرِّجْل رِجْلًا لقوّتها على المشي... وارتجَل الكلامَ ارتجالًا؛ لأنه قَوِيَ عليه من غير ركوب فِكرة، وترجَّلَ النهار؛ لأنه قَوِيَ ضياؤُه بنزول الشمس إلى الأرض، ورجَّلَ شعرَه: إذا طوَّلَه، وأصل الباب القوّة»[6].
هذه قطوفٌ من نصوص اللغة في كلمتي الرّجُل والرجوليّة، وهي ترينا أصل المعنى لكلمة الرجل، والمعاني التي طرأتْ على المادة، وخاصّة كلمة الرجولية من مفرداتها.
ولقد تقصيتُ المواطن التي وردَت فيها مادة (الرَّجُل) في القرآن الكريم، فكدت أخرج بقاعدة عامة لها معناها ومغزاها؛ هي أن القرآن الكريم يُلْحَظ في استعماله لمادة (الرَّجُل) ذلك المعنى الجميل الطارئ على المعنى اللغوي الأصلي لها، وذلك في أغلب الأحيان، وفي المواطن التي يُراد فيها الحكم على الرَّجُل بأمر من الأمور زائد على المعنى الأصلي، وهو معنى الذكورة المقابل لمعنى الأنوثة.
نجد القرآن الكريم إذا ذكرَ مادة (الرَّجُل) بأصلها اللغوي أراد منها معنى الذَّكَر، وإذا ما ذكرها في مواطن تتعرّض لأكثر من هذا الأصل عَطّرَ ذِكْرَها بنفحات من التكريم والتعظيم، وإذا ما ذكرَ مادة (الرَّجُل) مقرونة بأوصاف مذمومة فإنه ينقل هذه الأوصاف ويُوردها منسوبة إلى المبطِلِين في القول، أو الخاطِئين في التفكير، وفي هذا القِسم الأخير تكريم مستور للرجل، وإنْ بَدَت العبارة المنقولة وفيها أوصاف تذمّ أو تقدح!
وكأَنَّ القرآن الكريم بإيثاره هذه الخطة الغالية التي تكاد تكون قاعدة -كما أسلفتُ- يريد أن يلفت أبصارنا إلى قيمة الرجل في المجتمع، وإلى التبعات التي يجب عليه أن ينهض بها؛ لأنه كفء لها. فإذا ما التفَتَ الرجال إلى هذا الذِّكْر الحميد، وإلى ذلك التوجيه السديد؛ ثارت في صدورهم عواطف الاستجابة للخير، ونوازع التدليل على أنهم أهلٌ لذلك الوصف الجميل، وخجلوا من مسبَّة التخلُّف عن هذا المرتقى الذي قيل لهم عنه: هلمّوا إليه، فإنه مقامكم!
وكأنَّ هذا لون دقيق عميق من ألوان التربية النفسية المطوية التي يُحْسِن القرآن المجيد بثّ عواملها، وتعميق جذورها في الإنسان.
ها نحن أُولاء نرى الذِّكْر المبين يَذْكُر الرجل والرجال بالمعنى الأصلي، وهو الذُّكُورَة، فيقول: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 7]، ويقول: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾[النساء: 32]، ويقول: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: 40].
نفهم من أمثال هذه الآيات الكريمة أنّ الرجل قد ذُكِرَ فيها وهو يُراد منه مقابل الأُنثى، ويجري الحديث عنه بأحكام عادية قد تتساوى معه فيها الأُنثى وقد لا تتساوى، ولكن لا يظهر فيها قصد التكريم. ولكننا ننتقل إلى آيات كريمة أُخرى، فنجد (الرَّجُل) فيها قد تعطَّرَت سيرته، ونجد التعظيم لشأنه مطويًّا أو منشورًا، ونتبيّن ذلك الهدف النبيل، وهو تغليب الذِّكْر الحَسَن على سواه فيما يتعلّق بالحديث عن الرَّجُل في القرآن الكريم.
يقول الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34].
وفي هذا ثناءٌ على الرِّجَال، وتفضيل لهم، وتنبيه على جلال تبعاتهم، إذ المعنى -والله أعلم بمراده- أنّ شأن الرجال هو القيام على النساء، بالأمر والنهي ونحو ذلك، مع الحكمة والعدل؛ وذلك لأنَّ الله وهَبَ جنسَ الرّجال فضلًا على الجنس الآخر، ويجب على الرجال أن يرعوا تَبِعَة هذا الفضل؛ ولذلك اختصّ الرجال بالنبوّة والرسالة والإمامة الكبرى والصغرى، وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والجمعة والطلاق وغير ذلك، ولأنّ الرجال يتعبون ويكدحون ويكسبون ثم ينفقون أموالهم على نسائهم.
وقريب من هذا قول الحقّ تبارك وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]. أي أنّ للرجال زيادة في الحقّ على النساء؛ لأنهم القُوّام والحُرّاس، وهم القائمون بواجب الرعاية والإنفاق، وذلك جمعٌ رائعٌ بينَ التشريفِ والتكليف. فهذه الدرجة التي للرجال، وهذه القَوامة التي شرَّفَهم الله بها؛ تستلزمان تكليفًا هو حُسن الرعاية، ولُطف الإنفاق، والعظائمُ كُفؤُها العظماء.
ويقول القرآن الكريم: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282].
أي: أَشهِدُوا على الـمُكاتَبات المالية بينكم رجُلَيْن يتمّ بهما نصاب الشهادة، فإن لم تجدوا رجُلَيْن، فأَشهِدُوا رجلًا وأَشهِدُوا معه امرأتين تقومان مقام الرجل الآخر، وتُذَكِّر إحداهما الأُخرى إذا نَسِيَتْ، فجعل القرآنُ الرجلَ في الشهادة باثنتين؛ لأن النسيان غالب على جنس النساء، بينما التذكُّر غالب على جنس الرجال، وتقريرُ ذلك في القرآن تكريمٌ مِن غيرِ شكّ للرجال، وإفصاحٌ عمّا خصَّهم اللهُ به من خصائص يجب عليهم أن يقدِّرُوها ويشكروها.
ويقول الحقّ تبارك وتعالى على لسان لوط -عليه السلام-: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: 78].
فهذا نبي الله لوط نراه وقد زارته الملائكة من عندِ ربّه، وجاءه المجرمون مِن قومه يُهْرَعُون إليه، ومِن قبلُ كانوا يعملون السيئات، ويأتون الذُّكْران من العالمين، وتلك هي الفاحشة الكبرى التي ما سَبَقَهُم بها من أحدٍ من العالمين، وأراد المجرمون أن يعتدوا على ضيوف لوط من عبادِ ربه المكرمين، فنصحهم بأن يتقوا الله بترك الفواحش، وألّا يفضحوه في ضيفه؛ لأنّ إهانة الضيف إهانة لمَن أضافَه، ثم ذَكَّرَهُم بحقّ الرجولية وما لها من صفات عالية، فقال: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾؟ أليس منكم فردٌ تتحقّق فيه صفات الرجولية الراشدة العاقلة، فيهتدي إلى الحقّ الصريح، ويرعوي عن الباطل القبيح؟!
وكأنَّ لوطًا -عليه السلام- يريد أن يقول لهؤلاء: لو كان فيكم رجل تتحقّق فيه الرجولية لَمَا سمحَتْ له نفسُه أن يُقدِمَ على ذلك الإجرام الفظيع، ولكن أين أنتم مِن رُشْدِ الرجولية وكمال الرجال؟
ويقول القرآن الكريم: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا﴾ [الكهف: 37].
نزلت هذه الآية مع آيات أخرى في أخوَيْن من بني إسرائيل كان أحدهما كافرًا، ويُسمَّى قرطوس أو قطفير، وكان الثاني مؤمنًا، ويسمَّى يهوذا أو يمليخا، وقد أنفق المؤمن في سبيل الله، واشتغل الكافر بزينة الدنيا وتنمية المال وكنزه، وكان لهذا الكافر جنتان مليئتان بالأشجار والأزهار والثمار، ولـمّا بغَى وكفر ونسي ربَّه قال له أخوه المؤمن: ﴿أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ﴾ -لأنَّ آدم وهو أبو البَشَر مِن تراب، فكلّ فردٍ من أبنائه له حظّ منه- ثم مِن نطفة، وهي مادّتك القريبة، ثم سوّاك وعَدَلَك، وفي أكرم صورة ركَّبَك، بأنْ جَعَلَكَ رجلًا؟
وكأنَّ جَعْلَهُ (رجلًا) هو غاية التكريم والتسوية، وفي ذِكْرِ ذلك بلا شكّ تذكيرٌ بنعمة الرجولية وإعظامٌ لشأن الرجل.
ويقول الله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [القصص: 20].
وهذا الرجل هو شمعون أو حزقيل، والمشهور أنه مؤمِنُ آل فرعون، جاء يُسرِع في السَّير اهتمامًا بأمرِ موسى وحرصًا على نجاته، وذلك بعد أن رأى موسى رجلًا إسرائيليًّا يقاتل رجلًا قبطيًّا، فنصر موسى الرجلَ الذي مِن شيعته، وضرب الغريب بوَكْزةٍ فقضَى عليه، وندم على ذلك، وقال: إنه مِن عَمَلِ الشيطان، واستغفرَ ربَّه من ذلك الظُّلْم.
جاء الرجل يسعى إلى موسى ويقول له: إنّ الكِبَار من أتْبَاع فرعون يتشاورون في قتْلِك والبطش بك: فاخرُج من المدينة -وهي منف- قبل أن يظفروا بك؛ لأني ناصحٌ لك أمينٌ؛ فخرج موسى عملًا بنصيحة هذا (الرجل) ونجا. وكان ذلك موقفًا من المواقف الحميدة التي قام بها رجل من الرجال!
وفي آية أُخرى يقول الله تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾[يس: 20].
فهذا رجل آخر أقبل من أقصى موضع في المدينة، وأبعدِ مكان في البلد -وهي أنطاكية- وهذا الرجل هو حبيب بن إسرائيل المعروف بصاحب يس، وكان قد آمَن وأقام بغارٍ يعبد الله فيه، ولـمّا سمع بتكذيب قومه لرُسُلِ الله ثارت فيه رجوليته، فأقبل يسعى ويُسرِع إليهم حرصًا على هدايتهم، ونَصَحَهُم خير نصيحة: ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ * إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ * إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾[يس: 20- 25].
فماذا كان الجزاء؟ وماذا كان ثواب هذا الرجل المِقدَام الذي حرَصَ على مصلحة قومه، وجهَرَ بكلمة الحقّ ودَعَا إليها ونصَرَ أهلها؟ ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس: 26- 27].
وأَنعِمْ به مِن جزاءٍ للرجل الكريم الرجولية!
وجاء في القرآن الكريم: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [غافر: 38].
كان هذا الرجل مؤمنًا عظيمًا في قومه وهم آل فرعون، وكان يطوي قلبه على الإيمان، فجاء يُدافِع عن موسى حين توجّه إليه الأذى، ويقول لقومه: أتريدون القضاء على رجل يريد مصلحتكم وخيركم، ولا ذنب له ولا جَريرة، ولكنه يقول لكم: ربي الله ولا ربَّ سواه، وقد جاءكم على صِدْقِه بالدلالات والمعجزات، فما أضَلَّكُم وما أبعدَكُم عن الهدى!
فأنت ترى أن الذي ذَكَّرَ بالحقّ قد وُصِف بوصف (الرجل)، وأن هذا الرجل حينما تحدث عن موسى الرسول النبي وَصَفَهُ أيضًا بأنه (الرَّجُل)، فكأنَّ الرجولية هنا تلقى حظّها أيضًا من التعظيم والتكريم.
ويقول القرآن الكريم: ﴿قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾[المائدة: 23].
هذا الرجلان هما يوشع بن نون وكالب بن يفنة، أو هما رجلان كانا من الجبابرة، ثم أسلَمَا وأنعَمَ الله عليهما بالإيمان والثبات والجُرأة في الحقّ. ولـمّا أمَرَ اللهُ موسى -عليه السلام- أن يدخل هو وقومه الأرض المقدّسة الطاهرة (فلسطين)، وحذَّرهم من الارتداد والانقلاب بالخسران، خافوا وجبنوا وقالوا: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ [المائدة: 22]؛ فجاء هذان الرجلان الـمِقْدَامَان ونطَقَا بكلمة الحقّ والشجاعة: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾[المائدة: 23]، فقدَّما بذلك دليلًا آخر على أنّ الرجل الأصيل الرجولية لا يتصرّف إلا تصرّف السادة الشرفاء.
وهذا موسى -عليه السلام- حينما أراد أن يذهب للقاء ربّه اختار من قومه سبعين (رجلًا)، وأمَرَهُم أن يصوموا ويتَطهَّرُوا ويُطَهِّرُوا ثيابهم، ثم خرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربه، فكان هذا تشريفًا أيّ تشريف لهؤلاء (الرِّجَال). يقول القرآن الكريم: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: 155].
وفي سورة الأحزاب يقول الحقّ -تبارك وتعالى-: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا * لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[الأحزاب: 23- 24].
هناك طائفة من المؤمنين المخلصين، هم رجال أيّ رجال، استجابوا لله وللرسول، وتمسَّكوا بالطاعات، وقاتلوا قتالًا شديدًا، وصَدَقُوا في عهودهم ووعودهم مع ربّهم، وفيهم نزل هذا الحديث الإلهي الكريم.
قيل: نزَلَتْ في أنس بن النضر حين غابَ عن بدرٍ فشقَّ ذلك عليه، وقال: أوّل مشهد شهده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غِبْتُ عنه! لئن أراني اللهُ تعالى مشهدًا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما بعدُ لَيَرَيَنَّ اللهُ ما أصنع. وشهد أُحُدًا، فقال له سعد بن معاذ: يا أبا عمرو، أين؟ قال: واهًا لِرِيحِ الجنة، أَجِدُهَا دونَ أُحُدٍ؛ فقاتَلَ حتى قُتِل، بعد أن أصابه فوق الثمانين ضربة وطعنة؛ فنزلت الآية فيه وفي أصحابه؛ لأنهم رجال لم يخونوا أماناتهم ولا مواثيقهم مع ربهم، بل صبروا وثبتوا. فمِنهم مَن وَفَى بنذرِه، وماتَ بعد جهاد واستشهاد، وبعضهم يتوقع ويَرقُبُ يومًا يلقَى فيه أعداء الله، ليؤدّي نذرَه، ويَفِي بوعده، ويموت في سبيل ربّه دون تغيير أو تبديل.
وهؤلاء يجزيهم اللهُ خير الجزاء بسبب صِدقهم ووفائهم، ويعذِّب المنافقين بنفاقهم، أو يرحمهم بتوفيقهم للتوبة.
وهذا موقف حميد مشكور من مواقف (الرِّجَال) الذين تجلَّت فيهم رجوليتهم، فوقفوا مُثُلًا عُليًا يُعَلِّمُون الناس كيف تكون المكارم.
ويقول الله تعالى في سورة التوبة: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108].
أراد طائفةٌ من الذين لم يستقم إسلامهم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينافسوا مسجد قُباء، وهو أوّل مسجد في الإسلام، فتجمّعوا وبنوا مسجدًا سُمّي (مسجد الضِّرار)؛ لأنهم لم يُخلِصُوا في بنائه، بل خدموا به الكفر المطويّ في صدورهم، وأرادوا به تفريق كلمة المسلمين، فأمَر اللهُ نبيَّه بأن لا يقوم فيه أبدًا، وأن يهدمه ويحرقه.
ثم وَصَف اللهُ مسجدَ قُباء بأنه بُنِيَ مِن أساسِه على تقوى الله وطاعته منذ إنشائه، وهو الحقيق بأن يُصلِّي فيه؛ ولذا قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (صلاةٌ في مسجد قُباء كعمرة)، ثم وَصَف القرآنُ أهْلَ قُباء بأنهم (رجال)، وأتْبَع هذا الوصف بأنهم طاهرون متطهِّرون، وأنّ الله يرضَى عنهم ويُكرِمهم ويعظم ثوابهم، وهذا هو المراد بمحبة الله لهم.
فأنت ترى أيضًا أن كلمة (رجال) قد ذُكِرَت محفوفة بصفات من صفات الخير والتقدير.
وجاء في سورة النور قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النور: 36- 38].
هذا وَصْفٌ لِـمَنْ مَنَّ اللهُ عليهم بالهداية لنوره، فهم يرفعون بيوت الله، وهم يَذكرون اسمَه فيها بالتحميد والتقديس والتكبير، وهم (رجال) لا صارفَ مِن زخرف الدنيا يلويهم، ولا عاطف من مغريات الحياة يثنيهم، وهم الجديرون بالمساجد، ولا يشغلهم البيع ولا التجارة عن الذِّكْر أو الصلاة أو الزكاة، ويخافون بطش ربهم خوفًا شديدًا، فماذا يكون جزاء هؤلاء (الرجال)، الذين تعطَّر الحديث بذِكْرِ رجوليتهم والثناء على مكانتهم؟ هو ما قاله العزيز الحميد: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[النور: 38].
وهناك آيات كريمة ذَكَرَتْ أن الكافرين عجبوا لإرسال الله رُسُلَهُ من الرجال، ثم بيَّنَتْ خطأهم في ذلك العَجَب، وأوضحَتْ أنّ الله لو استجاب لتعَـنُّـتِهم، بأنْ أرسَل لهم مَلَكًا لجَعَلَهُ رجلًا. يقول القرآن: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾[الأنعام: 9].
لقد طلبَ الكافرون أن يكون الرسول إليهم ملَكًا، فردّ اللهُ عليهم ذلك بأنه لو استجاب لهم وأنزل عليهم ملَكًا لجَعَله رجلًا؛ لأنهم لا يستطيعون معاينة الملَك على هيكله الأصلي، ولم يقل القرآن: «لجَعَلْنَاهُ بَشَرًا»، بل قال: «رَجُلًا»، وهذا تكريم للرجال وتخصيص لهم بالرسالة؛ لأنّ الرسول لا يكون امرأة، ومقام الرسالة أعلى مقامات البَشَر.
وفي سورة الأعراف: ﴿أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 63].
وَصَفَ الله نبيَّه هنا بأنه (رجل) جاء لِيُنذر قومه ويحذِّرهم، وليشرع لهم طريق التقوى وسبيل المرحمة، وليقودهم إلى صراط الغفور الرحيم.
وفي سورة يونس: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾[يونس: 2].
يُنكِر القرآن الكريم تعجُّب هؤلاء الكفار من إرسالِ الرسول رجلًا، ويبيِّن خطأهم، ويقرّر أنه لا محلّ للعَجَب من إرسالِ الرسول رجلًا، ما دام هذا (الرجل) قد سبق في إحراز الفضائل وحيازة الملَكات السَّنِيَّة، وقد صنعه الله عليه واختاره لرسالته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وفي سورة النحل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
لقد أنكَرَتْ قريش أن يكون الرسُل بشرًا رجالًا، فردّ اللهُ عليهم ذلك الإنكار، وافهمهم أنَّ الرسالات مِن قبلِ محمد -صلوات الله عليه- لم يحملها إلا رجال، فلا بِدع ولا غرابة أن يكون حامل الرسالة الأخيرة رجلًا.
وفي هذه الآيات إظهارٌ لفضل الرجال وتنويهٌ بشأنهم.
والقِسم الثالث والأخير هو القِسم الذي وردَتْ فيه كلمة (الرجل) موصوفة بأوصاف سيئة، ولكن هذه الأوصاف صادرة عن الكافرين الجاهلين الظالمين، فسجَّلها اللهُ عليهم، مخطِّـئًا لهم فيها، وكأنه يريد أن يقول: إنه لا يذمّ الرجل ذا الرجولية إلا الكافر الجاهل الظالم.
يقول القرآن على لسان هؤلاء: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ﴾[المؤمنون: 25].
يتطاولون على نوح -عليه السلام- فيصفونه بالجُنون والخبَل، ويتآمرون بالصبر عليه لعلّه يضيق، يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه أرجح الناس عقلًا وأرزنهم قولًا.
ومثل هذا قوله -تبارك وتعالى- على لسان الكافرين: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [المؤمنون: 38].
وفي سورة سبأ: ﴿مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ﴾[سبأ: 43].
وفي سورة الإسراء: ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ [الإسراء: 47].
وفي سورة الفرقان: ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ [الفرقان: 8].
لَكَأَنَّ القرآنَ الكريم أراد أن يُحسِن الدفاع عن (الرجل) وعن (الرجولية) فأوردَ مواطن ذمِّهما ومعها ما يُفْهِمُنا أنَّ ذلك الذمّ صادِر عن مغرِضِين أو مجرمين، فلا يليق بنا أن نقبله أو أن نخدع به، ومن هنا يَسْلَمُ للرجال رجوليتهم.
يا معشر الرجال..
هذا حديثُ القرآن الكريم عنكم، وهذا ذِكْرُهُ لكم، وتلك هي النفحات التي عطَّر بها الرجولية حينما تَسْلَمُ وتَصدُق فيكم؛ فأين أنتم مِن ذلك التكريم العظيم؟
أين أنتم مِن تحقيقِ تلك (الرجولية) لأنفسِكم؟ وأين أنتم من إيجاد صفات (الرجل) فيكم؟ وأين أنتم من ذلك المرتقَى السامي الذي رفعَ القرآنُ إليه النماذج الكريمة من جنسكم الرجال؟ أين أنتم؟
[1] نُشرت هذه المقالة في مجلة (الأزهر) مقسَّمة على عددين متتاليين من المجلد السادس والعشرين: الجزء الرابع، صَفَر، سنة 1374هـ، ص207، والجزأين الخامس والسادس، ربيع الأول سنة 1374هـ، ص302. (موقع تفسير).
[2] طبقات الصوفية، للسلمي، ص122.
[3] المفردات، ص188.
[4] القاموس، (3/ 381).
[5] الأساس، (1/ 325، 326).
[6] مجمع البيان، (1/ 326).


