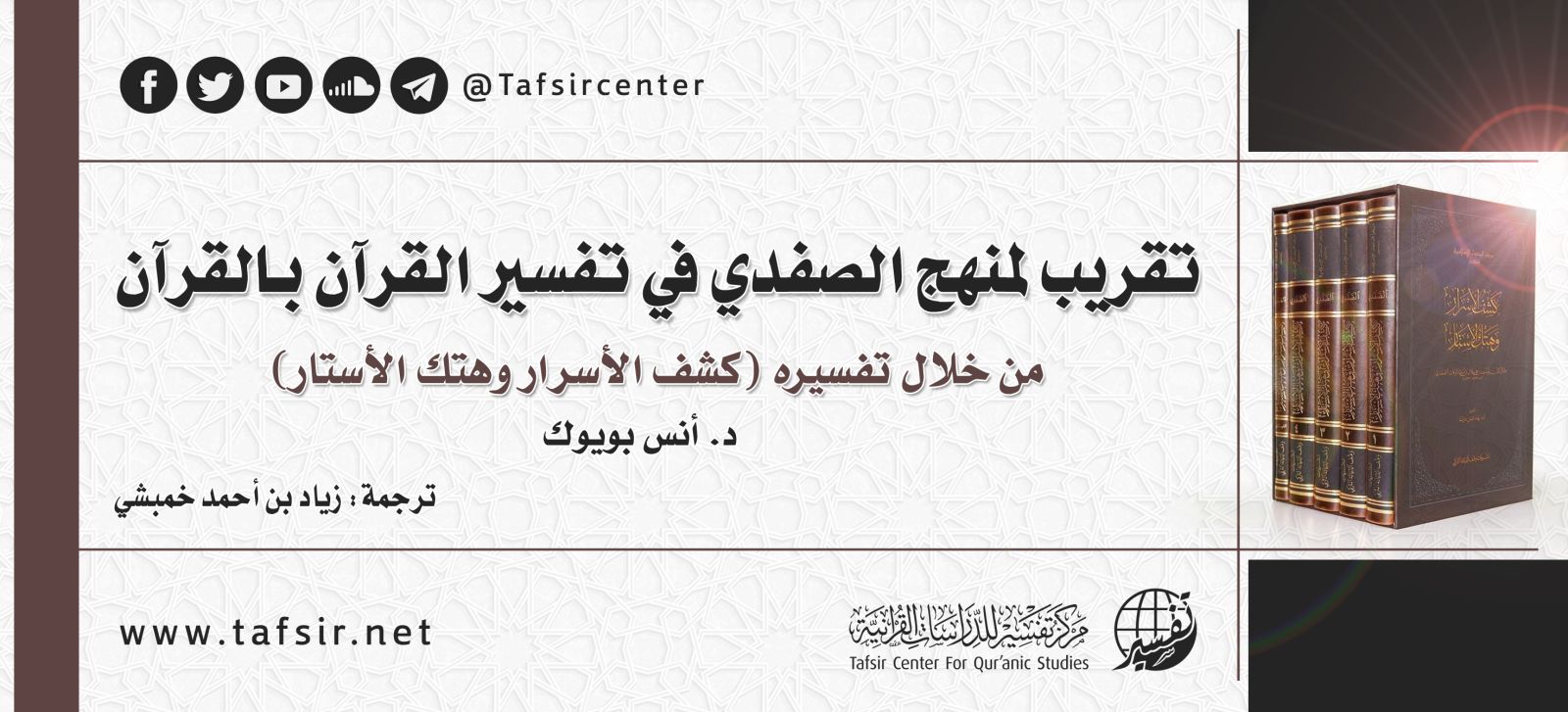متى كان التحدي بالقرآن؟
متى كان التحدي بالقرآن؟
الكاتب: عبد المتعال الصعيدي

متى كان التحدي بالقرآن؟[1]
اختار اللهُ تعالى محمدًا -صلى الله عليه وسلم- مِن بين العرب خاتمًا لرسله، وقد اقتضى هذا أمرين في المعجزة التي اختُصّ بها؛ أوّلهما: أن تكون من جنس ما اشتهر العرب بالنبوغ فيه؛ لأنّ معجزة كلّ رسول تكون من جنس ما نبغتْ فيه أُمّته. وثانيهما: أن تكون معجزة باقية على الدهر، لتبقَى بقاء الشريعة التي أُرِيد ختم الشرائع بها، كما أُريد ختم الرّسل بالرسول الذي اختِير لتبليغها. وقد اقتضى هذا وذاك أن يكون القرآن الكريم معجزة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقد كان بعض الرسل يُبْعَث ومعه معجزته، كما أُرْسِلَ موسى إلى فرعون ومعه معجزة العصا وغيرها من معجزاته؛ لأنه طلبها مِن ربه قبل أن يُرْسِله إلى فرعون.
ومعلوم أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أُرْسِل لم ينزل عليه من القرآن إلا هذه الآيات من سورة العلق: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ [العلق: 1- 4].
فلم يكن معه من معجزة القرآن حين بُعِثَ ما يتحقّق به التحدي المطلوب في المعجزة؛ لأنّ القرآن لم ينزل عليه جملةً حين بُعِث، وإنما نزل عليه مفرَّقًا في ثلاث وعشرين سنة، وكان ينزل عليه مفرّقًا على حسب الأحوال والوقائع.
ولم يتهيّب النبي -صلى الله عليه وسلم- ما بُعِث به أول أمره كما تهيّبه موسى، ولم يطلب مِن ربه أن يؤيّده بمعجزه كما طلبَ موسى منه؛ لأن قومه لم يبلغوا من القوة والطغيان ما بلغ فرعون، وكان له منزلة بينهم قبل بعثته حتى كانوا لَيُلقّبونه (الأمين)، فلم يتهيّب -مِن أجل هذا- أمْرَهُم، ولم يرَ نفسه في حاجة إلى طلب معجزة يذهب بها إليهم؛ وهذا إلى أنه أراد أن يسلك في دعوتهم طريقًا هادئًا غير طريق التحدي، وأن يتلطّف في دعوتهم ما أمكنه أن يتلطف معهم.
فأخذ في أول أمره يدعو في السِّر مَن آنَسَ منه قبولًا لدعوته؛ فآمنَت به زوجه خديجة، ثم آمنَ به ابن عمّه عليّ بن أبي طالب، وأقرب أصدقائه إليه أبو بكر الصديق. ولم يزل يتلطّف في دعوته ويدعو إليها في خفية، حتى آمن به نحو أربعين من قومه؛ وكانوا يكتمون إسلامهم عن قومهم خوفًا منهم، فإذا أراد أحدهم الصلاة ذهب إلى شِعاب مكة فصلى بها مستخفيًا. ولمّا بلغوا ذلك العدد اختار لهم دار واحد منهم ليجتمعوا بها سرًّا، وهي دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكانت بأصل الصفا منفردة عن غيرها من الدور، وقد مكث على هذا ثلاثًا أو أربعًا من السنين، يتلطّف في دعوته، ولا يتحدّى أحدًا بها، فلم يكن في حاجة إلى معجزة يتحدّى بها من يعارضه.
ثم أُمِرَ بعد هذا أن يجهر بالتبليغ، فتلطّف أيضًا في الجهر به، وابتدأ فجمع عشيرته الأقربين من بني عبد المطلب، فعرض عليهم دعوته، وطلب منهم أن يؤمنوا به، فتكلّم القوم كلامًا ليّنًا، ولم يشتدّ في جوابه إلا عمُّه أبو لهب، فإنه قال لهم: خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب، فإن أسلمتموه ذَلَلتُم، وإن منعتموه قُتِلتم. فقال أخوه أبو طالب: والله لَنمنعنّه ما بقينا!
ولمّا جهر بالدعوة لم يطالبه قومه بآية عليها في أول الأمر، بل كانوا يسخرون منه ويستهزئون به في مجالسهم، وكان إذا مرّ عليهم يقولون: هذا غلام عبد المطلب يُكلَّم من السماء! وكانوا لا يهتمّون في أمره بأكثر من ذلك، استخفافًا بدعوته، واستهانة بأمرها؛ لأنهم كانوا يظنونها سحابة صيف، ولا يظنون أنه سيكون لها شأن بينهم.
فلما ثابر عليها وأخذ في عيب آلهتهم وتسفيه عقولهم، ثارتْ حميّة الجاهلية في رؤوسهم، وأخذتهم الغيرة على آلهتهم؛ ولكنهم مضوا على استخفافهم بأمره، فلم يتوجهوا إليه أن يكفّ عنهم، ولم يطالبوه بمعجزة يؤيد بها دعوته، بل ذهبوا إلى عمّه أبي طالب فشكوه إليه، فردّهم ردًّا جميلًا، فانصرفوا عنه ينتظرون ما يفعل معه.
ولكنه مضى في دعوته لا يصدّه شيء عمّا يريد، فتزايد الأمر عليهم، وأضمروا له العداوة والحقد، ولكنهم مضوا في تغاضيهم عنه، وذهبوا إلى عمّه أبي طالب يشكونه مرّة أخرى، وقالوا له: إمّا أن تكفّه أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. فدعاه أبو طالب وقال له: يا ابن أخي، إنّ القوم جاؤوني فقالوا لي كذا، فَأبْقِ على نفسك، ولا تحمّلني من الأمر ما لا أُطيق. فظنّ أنّ عمه خاذله، فقال له: واللهِ يا عمّ، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلتُ، حتى يُظهره الله أو أهلك دونه! ثم بكى ووَلّى، فقال أبو طالب: أَقْبِل يا ابن أخي. فأقبَلَ عليه، فقال له: اذهب فقل ما أحببتَ، والله لا أُسلمك!
فلما رأوا أبا طالب لا يجيبهم إلى منعه عن عيب آلهتهم، أخذوا يؤذونه ويؤذون أصحابه، فلقوا مِن أذاهم شيئًا كثيرًا، ولكنهم صبروا على أذاهم، وثبتوا على إيمانهم، ولم يكفّ النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عيب آلهتهم، فاجتمعوا للشورى في أمره، فقال لهم عُتْبَة بن ربيعة العَبْشَمي: يا معشر قريش، ألَا أقوم لمحمد فأكلّمه وأعرض عليه أمورًا عَلّهُ يقبل بعضها فنعطيه إياها، ويكفّ عنّا؟ فأجابوه إلى ذلك، فقام إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي في المسجد، فقال له: يا ابن أخي، إنك منّا حيث قد علمتَ، من خيارنا حسَبًا ونسَبًا، وإنك قد أَتيتَ قومَك بأمر عظيم فَرَّقْتَ به جماعتهم، وسفَّهت أحلامهم، وعِبت آلهتهم ودينهم، وكَفّرت مَن مضى من آبائهم، فاسمع منّي أعرِضْ عليك أمورًا تنظر فيها، لعلك تقبَل منها بعضًا. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قل يا أبا الوليد، أسمع)، فقال: يا ابن أخي! إنْ كنت إنما تريد بما جئتَ من هذا الأمر مالًا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًا، وإن كنت تريد شرفًا سَوّدناك علينا، حتى لا نقطع أمرًا دونك، وإن كنت تريد مُلكًا مَلّكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رِئيًا من الجنّ لا تستطيع ردّه عن نفسك طلبنا لك الطبّ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نُبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُدَاوَى.
فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لقد فرغتَ يا أبا الوليد؟) فقال: نعم. فقال: (فاسمع منّي)، فقرأ عليه أوّل سورة فصِّلت: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم * حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: 1- 3]، إلى قوله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ * إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: 13- 14].
فأمسك عتبة بفِيه، وناشده الرّحم أن يكفَّ عن ذلك؛ فلما رجع عتبة سألوه، فقال لهم: واللهِ لقد سمعتُ قولًا ما سمعت مثله قط! واللهِ ما هو بالشِّعْر، ولا بالكهانة ولا بالسحر! يا معشر قريش أطيعوني فاجعلوها لي، خَلّوا بين الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فواللهِ لَيكونَنّ لكلامه الذي سمعتُ نبَأ، فإنْ تُصِبْهُ العربُ فقد كُفِيتُموه بغيركم، وإن يَظهر على العرب فعزُّه عِزكم. فقالوا له: لقد سَحرك محمد! فقال لهم: هذا رأيي.
ثم عرضوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك أن يشاركهم في عبادتهم ويشاركوه في عبادته، فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ السورة.
ثم طلبوا منه بعد ذلك أن ينزع من القرآن ما يغيظهم مِن ذَمِّ الأوثان والوعيد الشديد، فيأتي بقرآن غيره أو يبدّله، فأنزل الله جوابًا لهم في سورة يونس: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [يونس: 15].
فلمّا رأوا أن هذه المطالب التي يعرضونها عليه لا تُقبَل منهم، صاروا إلى تعجيزه بطلب الآيات، وكانوا يطلبونها على سبيل التعنّت، ولم يطلبوها ليؤمنوا بها، وكان هذا بعد أن مضى زمن طويل على بعثته إليهم؛ فكان مِن أوّل ما وردَ مِن هذا في آخر سورة الأعراف: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 203]، وهي السورة التاسعة والثلاثون من السور التي نزلت بمكة.
ثم ورد بعد ذلك في سورة الفرقان: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا * أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ [الفرقان: 7- 8]، وهي السورة الثانية والأربعون من السور التي نزلت بمكة.
ثم وردَ بعد ذلك في سورة طه: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ [طه: 133]، وهي السورة الخامسة والأربعون من السور التي نزلت بمكة.
ثم وردَ بعد ذلك في سورة القصص ما يشبه أن يكون تحديًا بالقرآن: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ * قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: 48- 50]، وهي التاسعة والأربعون من السور التي نزلت بمكة.
ثم وردَ بعد ذلك في سورة الإسراء تحدٍّ صريح لهم بمعجزة القرآن: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: 88]، وهي السورة الخمسون من السور التي نزلت بمكة، وكان نزولها بعد حادثة الإسراء، وكانت هذه الحادثة قبل الهجرة إلى المدينة بسَنة، أي: في السَّنة الثانية عشرة من البعثة، وهذه هي السَّنة التي اتخذ فيها التحدّي بمعجزة القرآن شكلَه الصريح، وكان هذا بعد أن نزل منه خمسون سورة؛ وهذا قدر صالح للتحدي به في أول الأمر، وإن كان التحدي قد تدرّج بعد هذا إلى أن صار بسورة واحدة من القرآن.
ولو كان هذا الادعاء صحيحًا لأمكنهم أن يأتوا به، ولكان أسهل وسيلة للفصل في تلك الخصومة التي طال أمرها بينهم وبين النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولقد بلغ من أمرهم في محاولة التخلّص منها أنْ عرضوا عليه أن يجعلوه ملكًا عليهم، وأن أغروه بمال كثير يجمعونه له؛ وهذا عرضٌ منه لا يكلفهم أن يجعلوه ملكًا، ولا أن يجمعوا له مالًا كثيرًا، فلو كان في قدرتهم لَمَا أحجموا عنه، ولوَصَلوا به إلى ما يريدون من إبطال أمره.
وهنا أمر لا بد مِن لفتِ النظر إليه؛ لأنه لم يلتفت أحد إليه إلى عصرنا مع أنه يتوقف عليه معرفة التحدّي بمثل القرآن على حقيقته، ويُعرف به السرّ في أنهم لم يمكنهم الإتيان به؛ وذلك أنّ أعظم ما يمتاز به القرآن أمران؛ أوّلهما وأقواهما: أنه كتاب هداية. وثانيهما أنه في أعلى أسلوب عربي. ولا بد أن يدخل الأمران في التحدّي بمثله، وإن كان المشهور بين الناس أن التحدي به كان في الأمر الثاني فقط؛ لأنّ التحدي به في الهداية قد صُرّح به في بعض صور التحدي؛ وهو ما سبق من قوله تعالى في سورة القصص: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [القصص: 49].
وإذا كانت الهداية داخلة في التحدي بمثل القرآن، وكانت هداية القرآن لها تأثير في إعجازه كما كان لقوّة أسلوبه؛ كان أولئك الناسُ في ضلالهم أعجزَ الناس عن ذلك التحدي، وإن بلغ أسلوبهم في القوة ما بلغ؛ لأنهم إذا تحدّوا القرآن لم يتحدّوه في أسلوبه فقط، بل تحدوه في هدايته أيضًا؛ لأن أمرها عندهم أهمّ من أمر أسلوبه، وهنا يكون عجزهم وضعفهم؛ لأنهم مُبطِلون في العقائد والشرائع، فينقصهم ركن الهداية في التحدّي، ومتى نقصهم ذلك الركن لم ينفعهم ما امتازوا به من فصاحة وبيان؛ لأنّ الأمر في التحدي لا يقتصر على الفصاحة والبلاغة، بل هناك ما هو أهمّ منهما فيه، وهو الحقّ وما له من روعة تعلو على روعة البيان، والباطل وما يقعد به من ضعف لا ينهض به قوة الأسلوب.
فلا غرو بعد هذا أن يقف أولئك الناس حيارى أمام ذلك التحدي، ولا غرو أن يداروا ضعفهم وعجزهم بالطعن في القرآن؛ فيقولوا فيه مرّة إنه سِحر، ومرة إنه شِعر، ومرة إنه أساطير الأولين، على غير هذا مما طعنوا به فيه، ثم تُحُدُّوا بعد هذا بسورةٍ مثل القرآن في سورة يونس: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: 38]، وهي السورة الواحدة والخمسون من السور التي نزلت بمكة.
ثم تُحُدُّوا بعد هذا بعشر سورٍ من القرآن في سورة هود: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: 13]، وهي السورة الثانية والخمسون من السور التي نزلت بمكة.
ثم تُحُدُّوا به بعد هذا في سورة الطور: ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور: 33- 34]، وهي السورة السادسة والسبعون من السور التي نزلت بمكة.
ثم تُحُدُّوا بعد هذا بسورة واحدة منه في سورة البقرة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 23- 24]، وهي أول سورة نزلت بالمدينة.
وكان هذا آخر ما تُحُدُّوا به في القرآن؛ وقد اختتم بمثل ما افتتح به من إعلان عجزهم صريحًا أن يأتوا بما تحُدُّوا به، ولكنهم لم يكفّوا بعد هذا التحدي عن الطعن في القرآن؛ ومما كانوا يقولونه فيه أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- يتلقّاه من بعض الأعاجم من أهل الكتاب: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: 103]، وقد بلغ مِن تبجُّحِهم في الطعن أنهم كانوا يدّعون القدرة على أن يأتوا بمثله، كما قال تعالى في الآية 31 من سورة الأنفال: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾.
وهو منهم تهرُّب عن ذلك التحدي، بل عن طعنهم فيه بذلك مما تنهض به الحجة عليهم؛ لأنه لو كان سحرًا أو شِعْرًا أو من أساطير الأولين، لكان من جنس كلامهم، ولم يكن من عند الله تعالى، فيكون التحدّي به أهون عليهم، ويكون الإتيان بمثله مما يدخل في مقدورهم.
وقد داروا ضعفهم أيضًا بإصرارهم على ما كانوا يطلبونه من الآيات قبل التحدي بالقرآن، كما حكى عنهم في سورة الأنعام: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ [الأنعام: 8].
فهذا تهرُّب أيضًا منهم عن التحدي بمعجزة القرآن؛ لأنّه قد جعل القرآن معجزته التي آثره الله بها، فكان من الواجب عليهم أن يقفوا عند تحدّيهم بهذه المعجزة، وأن يحاولوا الإجابة عن هذا التحدي، أو يقرّوا بعجزهم، وإذا كانت هذه الآية في نظرهم أقلّ من آيات الرسل السابقين، فإنّ هذا أيضًا مما تنهض به الحجة عليهم؛ لأنه مما يهوِّن أمر تحديهم بها، فيكون الواجب عليهم قبول هذا التحدي، لا التهرب منه بطلب آيات أخرى.
على أن الله تعالى قد أجابهم على طلب هذه الآيات بقوله مثلًا في الآية السابقة من سورة الأنعام: ﴿وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ [الأنعام: 8]، فهو لا يريد أن يأخذهم العذاب إذا لم يؤمنوا كما أخذ الأمم السابقة، وإنما يريد أن يمهلهم إذا لم يؤمنوا؛ رحمةً بهم، واستبقاءً لهم؛ لأنه يريد أن يختتم بهم رسالته، وأن يجعلهم آخر الأمم التي تحمل دعوته، وهذا إنما تناسبه معجزة القرآن؛ لأنه يقترن التحدّي فيها بمحاولة الاقناع بالدليل، ولا يقتصر الأمر فيها على التحدي الذي لا يكون فيه إعذار وإمهال.
[1] نُشرت هذه المقالة في مجلة «الأزهر»، الجزء التاسع من المجلد الثاني عشر، سنة 1366هـ، ص804. (موقع تفسير).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

عبد المتعال الصعيدي
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وله عدد من المصنفات، وتوفي عام 1966م.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))