التشريع القرآني عند المستشرق نويل جيمس كولسون
(1- 4)
تحليل الرؤية ونقد المنهج
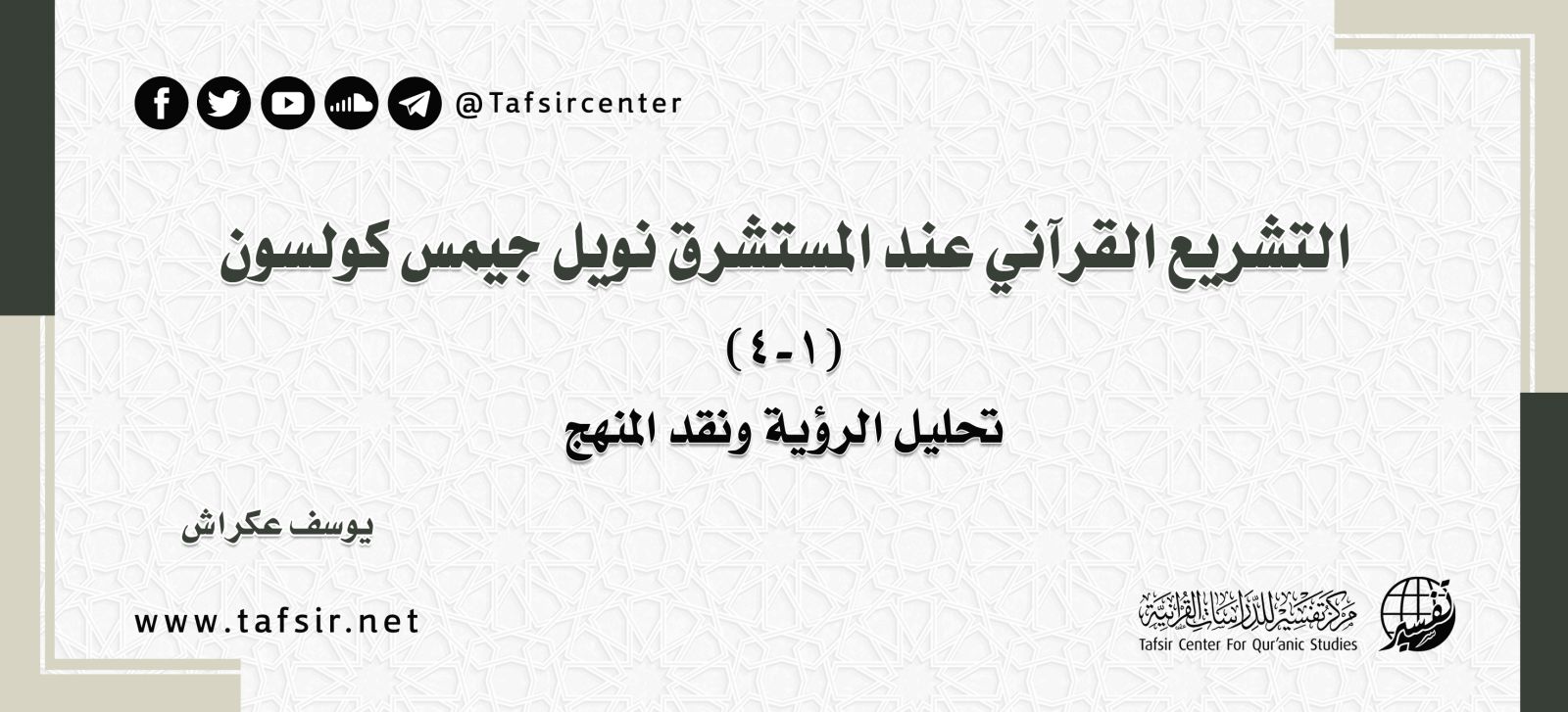
مقدمة:
يُعَدّ القرآن الكريم معجزة خالدة إلى يوم الدِّين، فهو كلام الله المنزَّل على عبده ورسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-، الذي استطاع أن يقهر العرب قاطبة؛ إِذْ تحدّاهم بما عندهم من الفنون والعلوم؛ كالبلاغة والفصاحة والتعبير شعرًا ونثرًا، ورغم نزوله على مبادئهم وقوانينهم وسننهم في التواصل والخطاب، فقد تجاوز ما عندهم، وجاء باستعمالات لم تعهدها بيئتهم من قبلُ، فوقفوا أمامه موقف المستسلم، فلم يسع الناس بعده إلا الانكباب عليه، عاملين بتشريعاته في كلّ صغيرة وكبيرة، فأصبح كل أمر إليه يردّ وعليه المعتمد.
فصار القرآن العظيم محطة كلّ اللغوين والمفسِّرين والمشرِّعين...، ومحورًا أساسيًّا لكلّ الدّارسين، قاصدين فهم قوانينه وتشريعاته، مع بيان معانيه وأحكامه وأوجه إعجازه وصولًا إلى غاياته، ولم يتبادر إلى المشتغلين به حينئذ أدنى شكّ في منظومته التشريعية المتكاملة والصالحة لكلّ زمان ومكان باعتباره وحيًا من عند الله عز وجل، وعاملين بعموم الآيات الدالّة على ذلك، ومنها قوله الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3]، وقوله عز وجل: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: 38]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]. وهذا لا ينفي وجود بعض التيارات في كلّ زمان ومكان، كانت لا تؤمن بالخطاب القرآني ومضامينه جحودًا، وتكفر بكلّ ما أَتى به، بيدَ أنّ هذه التيارات لم تشغل حيزًا واسعًا في بادئ الأمر.
وسيرًا على نفس منوال الاشتغال، بقي القرآن الكريم على مرّ العصور والأزمان من صميم اهتمامات الباحثين في كلّ الأقطار، لكن بعد اتساع رقعة الإسلام في العالم بأسره وبخاصّة دخوله الدول الغربيّة، وظهور ما يُسَمَّى بالنهضة الأوروبية والحركات الثقافية...، التي برزتْ معها الحركة الاستشراقية في نهاية القرن الثامن عشر في عدد من الدول الأوروبية كبريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا...، والتي اعتنت ابتداء بإنشاء كراسي علمية لتدريس اللغة العربية دون غيرها، لينتقل الأمر بعدها مباشرة لدراسة التديّن وما يتعلّق به، مكثِّفين الجهود البالغة حول القرآن الكريم باعتباره المرجع الأول لدين الإسلام وتعاليمه.
ومع مرور الزمن أصبح اهتمام الحركة الاستشراقية من أكبر الحركات التي انصبّت على دراسة الخطاب القرآني بكلّ مضامينه، فكان من صميم الاهتمام وقوفهم البالغ على التشريع القرآني بغرض دراسته من جميع جوانبه، لكن ليست الدراسة هنا كما هو معهود في الدراسات العلمية الموضوعية، بل هي دراسات وأعمال ومشاريع علمية كبرى بعيدة المدى ذات تخطيط محكَم ومعمّق، انطلقت من قاعدة موحّدة مسبقًا أساسها نفي التشريع القرآني وبيان مكامن نقصه والمشكلات التي تعتريه في زعمهم، وأنه غير صالح لكلّ زمان ومكان، تحقيقًا لأكبر أهداف الحركة الاستشراقية التي أبرزها فرض التبعية والركون ابتداء ثم التمكين لباقي أهداف الاستشراق، ما جعلهم يبثّون أنواعًا عدّة من التشكيك تتسلّل تباعًا لذهنية المسلم، والتي جعلوا رأس أمرها هو استهداف التشريع الرباني بتفسيرات وتأويلات تستند إلى المناهج المادية ومعايير القوانين الوضعية بدعوى التطوّرات والتغييرات اللامتناهية في كلّ مجالات الحياة.
وهكذا بقي التشريع القرآني محطّة بالِغة الأهمية في الحركة الاستشراقية قديمًا وحديثًا، ولم تفتر همّة المستشرقين تجاهه، بل زادت في ظلّ بروز التخصّصات العلمية، وبخاصّة التخصّص القانوني الذي صار يُدرس من خلاله الخطاب القرآني وفق نظريات ومناهج قانونية صرف لأسباب عدّة، فبعضهم يرى القرآن مدونة قانونية لزمن معيّن، وبعضهم يسعى لفهم أصل التشريع الإسلامي... وغيرها من الأسباب التي قد يُوردها المستشرقون في مقدّمة أعمالهم، بيدَ أن النتائج والمخرجات تُبدِي غير ذلك من طعنٍ ونقدٍ يروم إزالة خصائص هذا التشريع؛ كالربانية والشمولية والاستمرارية، انطلاقًا من أعمال غاب عنها المنهج القرآني وما تميّز به من تكامل.
ومن هنا يأتي الاهتمام بقراءة الإسلام من منظورِ الآخر وزاوية رؤيته، بحيث لا يُكتفى بالكتابةِ والتنظير في انعزال عما يفكرُ فيه الآخر ويعتقدُهُ تجاه أصول ديننا؛ لأنّ هذا الأخير -الانعزال- سوف يفقدنا بوصلة سير هذا الشقّ من الدراسات فضلًا عن تطويرها؛ والذي يتولّد نتيجة الحماية لهذا التراث من الأفكار الهدّامة التي تنشأ لدى الآخرين، بل إنّ الاهتمام بمرئيات وأطروحات الآخر الناقد لتراثنا الإسلامي يتمخّض عنها نوع مهمّ للغاية من حركية هذا التراث واستمراريته من خلال شقّ مسالك وفجوات جديدة تُسهِم في تجديده من حينٍ لآخر، وهذا ضرب من أضْرُبِ الإعجاز في ديننا الحنيف.
وعطفًا على ما تقدّم حول الأهمية التي تتمتع بها مقاربة الدّراسات التي تُعنى بالاشتغال على الدرس القرآني، وأخُصّ بالذِّكْر العمل الاستشراقي في مجال التشريع القرآني. برزت فكرة الاشتغال على رؤية كولسون للتشريع القرآني من وجهة نظر نقدية من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما رؤية كولسون للتشريع القرآني؟ وما المنهج الذي اعتمده في دراسته؟ وما المعرفة التي أوردها في بناء رؤيته؟ وما المشكلات التي أناطها كولسون بالتشريع القرآني؟ وما سُبل نقدها وبيان مكامن نقصها في ضوء الفلسفة التشريعية التي أتى بها الخطاب القرآني؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة إجابة وافية اقتضى العمل أن يكون في مقالات متتابعة تُشكِّل ملفًّا متكاملًا يناقِش فيه كلُّ مقال ركنًا معيّنًا من رؤية كولسون للتشريع القرآني.
وعليه، فإنّ المقالة الأولى تأتي مطوّلة لبيان رؤية كولسون للتشريع القرآني بشكلٍ عام، ثم الوقوف على ماهية رؤيته بشكلٍ خاصّ من نصّ كتابه المقصود، ثم ندلف بعدها لفهم وتحليل الرؤية وبيان المرتكزات والأُسس التي قامت عليها، وكذاك نقد معالم المنهج الذي صار عليه كولسون في بناء رؤيته للتشريع القرآني. وقبل ذلك نُورد تمهيدًا نروم من خلاله التعرُّف أكثر على المستشرق نويل جيمس كولسون، ومركزية كتابه: (في تاريخ التشريع الإسلامي)، الذي اكتنف في طياته الرؤية المعنية بالبحث والدرس.
تمهيد:
يُعَدّ المُستَشرق ن.ج كولسون Noel James Coulson من أبرز المستشرقين في المدرسة الإنجليزية المعاصرة، وُلِد في مدينة بلاكرود Blackrod بتاريخ 18 أغسطس/ غشت 1928م، واستهلّ دراسته الأولى بمدينة ويغان Wigan، ثم انتقل بعدها لكلية كيبل Keble، ثم دخل جامعة أكسفورد الشهيرة ليتخرّج منها متخصّصًا في اللغات الشرقية والآداب القديمة والفقه الإسلامي سنة 1950م، ليشرع بعدها في تدريس الفقه الإسلامي بجامعة لندن.
وقد «تتلمذ على يد المستشرق المشهور يوسف شاخت[1] J.schacht، كما درس القانون الإنجليزي، مما أتاح له القدرة على تناول مسائل الفقه الإسلامي من وجهة نظر جديدة. وقد زار بعض البلاد الإسلامية، وعمل أستاذًا زائرًا بإحدى الجامعات النيجيرية، وله مؤلَّفات أخرى في الفقه الإسلامي على قَدْر من الأهمية، منها كتاب في الميراث، والآخر يدور حول تحديد العلاقة بين الجوانب النظرية في الفقه الإسلامي وبين تطبيقاتها العملية»[2].
وقد تميّز كولسون بمنهج خاصّ في الفهم والتحليل، إضافة إلى أن خطابه وتحليله ليس كباقي المستشرقين؛ لذلك نجد عددًا من المتخصِّصين في الاستشراق قد أثنوا عليه، كما هو شأن الدكتور/ عبد اللطيف الطيباوي، قائلًا: «وهناك أستاذ جامعي آخر يستحقّ الثناء بجامعة لندن لا لأنه يتجنّب الخوض في مواضيع جدلية شائكة، ولكن أيضًا لتوجيهه المسار التدريسي ليكون قريبًا من التقليد الإسلامي. والإشارة هنا إلى أستاذ الشريعة (كولسون) الذي خلف الأستاذ (أندرسون) الذي كان يصرح علانية بهدفه التنصيري ولا يكتم كراهية الإسلام... والواضح أن الخلف أكثر تجردًا وموضوعية من السَّلَف»[3].
وقد هاجم شاخت تلميذه كولسون وعاب منهجه؛ لأنّ هذا الأخير يتناول التشريع الإسلامي من وجهة نظر قانونية كانت مطيّة للتقرّب من التشريع الإسلامي وفهمه أكثر فأكثر، في حين ركّز شاخت على الجانب التاريخي الذي سرعان ما يؤول إلى الجمود والركود، مما جعل أعماله لا تخرج في منهجها على من سبقه من المستشرقين.
وإنّ عناية كولسون بالبحث القانوني ودراسة التشريع الإسلامي من وجهة نظر هذا التّخصص -القانوني- هي على عكس كثير من المستشرقين الذين ركّزوا في دراسة التشريع على فقه اللغة والبحث التاريخي، ما جعل كتابه الذي اكتنف رؤيته، وهو الموسوم بـ: (في تاريخ التشريع الإسلامي)، يأخذ مكانة مرموقة في المكتبة العربية الإسلامية فضلًا عن المكتبة الغربية، ويمكن إجمال العوامل الرئيسة التي أسهمت في تشكيل مركزية كتابه في الآتي:
❖ تخصّص كولسون في القانون وامتلاك آلته مع العناية به تدريسًا وبحثًا.
❖ اطّلاعه الواسع على مصادر الفقه الإسلامي وتاريخه وتطبيقاته.
❖ نأيه عن الأسلوب الكلاسيكي للاستشراق الذي اتّسم بتحقير كلّ ما يتعلّق بالمسلمين، فضلًا عن الطعن والتشكيك في أصول الإسلام بشكلٍ فاضح، وهدوء خطابه، والتزامه بالنمط الأكاديمي الذي يستند في دراسة القضايا من وجهة نظر تخصصية.
وقد خصص الفصل الأول من الباب الأول لمناقشة التشريع القرآني -وهو موضوع هذه المقالات- باعتباره أصل التشريع ومنطلقه.
أولًا: كولسون والتشريع القرآني:
يرى كولسون أن التّشريع القرآني قام على سُلطة الطاعة والامتثال من خلال مجموعة من الآيات القرآنية التي دعت لهذا الأمر وأوجبته على الجماعة المسلمة تجاه التّشريع القرآني، ويعتبر كولسون أنّ هذه السلطة التي قامت على الطاعة هي بمثابة تمهيد لتوحيد البناء المجتمعي نحو الأخذ بالتشريعات التي أتى بها الخطاب القرآني على عكس ما كان سائدًا من التشريعات والقوانين القبَلية التي جعلت كلَّ عشيرة تُشرِّع ما يتناسب مع مكانتها وأعرافها الخاصّة، وقد كان العُرف يُمثِّل العمود الفقري والرّوح التي تَسري في كلّ القوانين القبَلية ما جعلها نافذة ومقبولة لدى أفرادها.
وإنّ القبيلة رغم افتقارها للجهاز الرسمي الذي يمثّل السلطة التشريعية، إلا أن فَضّ النزاعات وحلّها كان يقوم به المتضرِّرون أنفسهم أمام حاكم معيّن بشكلٍ شبه سَلِسٍ إيمانًا بالأعراف السائدة آنذاك، والتي تمثِّل القانون رغم أنها لم تكن مكتوبة، كما كانت هذه القوانين القبَلية قبل نزول القرآن تخضع لتعديلات وتغييرات بين الفينة والأخرى استجابة لرغبة القبيلة وتطوّرها والمستجدات التي قد تطرأ على أفرادها.
لنفهم أنّ كولسون لمّا تحدّث عن القانون القبَلي قبل نزول القرآن أشار فيه لأمرين اثنين؛ الأول: هو أنّ هذا النمط من القانون كان قائمًا ومستندًا على العُرْف القبَلي مما جعله نافذًا بين أفراد القبيلة، أمّا الثاني: هو أنّ القانون القبَلي كان يخضع لتعديلات وتغيّرات من حين لآخر بما يتناسب مع ما يريده المجتمع ويقبله.
وعليه، فإنّ ما أشار له كولسون في حديثه عن القانون القبَلي هو بمثابة المنطلق للحديث عن المشكلات القانونية التي يواجهها التّشريع القرآني في نظره الذي وصفه بالقصور في نهاية رؤيته وأنّ هناك بونًا شاسعًا بين الشقّ النظري والتطبيقي. وإنّ المتتبع لِما أورده كولسون في الفصل الأول الذي عقده للتشريع القرآني يُلْفِي مدى رؤية كولسون في بثّ عدد من الإشكالات أو بالأحرى شبهات كلّها تسعى لبيان أوجه النقص والضعف في نظره، وهو ما سيأتي بيانه وتحليله ونقده تباعًا.
ثانيًا: ماهية رؤية كولسون للتشريع القرآني من نصّ كتابه[4]:
بعدما قدّم كولسون في مطلع الفصل المخصّص للتّشريع القرآني بالحديث عن ماهية القانون القبَلي وبعض صور تطبيقِه مع الإشارة إلى تطوّره، شرع في الحديث عن نمط التّشريع القبَلي جاعلًا إيّاه في مقابل التشريع القرآني، لِيُبيِّن بعد ذلك العلاقة القائمة بينهما؛ والتي مفادها في نظره أن التّشريع القرآني حافظَ على العُرف الجاهلي الذي كان ينزل منزلة القانون قبل الإسلام، وأجرى تعديلات في بعض مواطنه قائلًا: «والخلاصة أنّ التشريعات القرآنية إنما عمدت لتعديل العُرف السائد وتغيير بعض جزئياته أكثر مما أرادت الإلغاء التام لقواعد العُرف»[5]، ليمثِّل بعدها بثلّة من الأمثلة التي يرى أنها تثبت ما ذهب إليه في هذا الطرح.
وبعد المسألة التمهيدية المتمثّلة في علاقة القانون العُرفي الجاهلي بالتشريع القرآني، انتقل للحديث عن قضية أخرى يراها من أكبر المشكلات التي تعتري التشريع القرآني، وهي غلبة الاتجاه الخُلُقِي على التشريعات التي جاء بها الخطاب القرآني، وهذه الغلبة كانت طريقًا لإهمال الجزاء العملي الذي يستحقّه كلّ مَن خالف التشريعات القرآنية.
وفي هذا السياق يقول كولسون في نصّ كتابه: «تتصل أُولى المشكلتين بمسألة القيم القرآنية التي تنزع منزعًا أخلاقيًّا في أساسها، من حيث أثرها على الواقع العملي. لقد حرَّم اللهُ الرّبا جُملة، مع أنه مما يبدو إسرافًا في البُعد الواقعي العملي أن نفترض أن المقرض أو المقترض سوف يُوليان اهتمامًا بالجزاء الأخروي... وقد كان المحتوى القانوني للقواعد الخُلُقية بالغ الوضوح أحيانًا»[6]، وفي مثال آخر يقول معلقًا على اتجاه التشريع القرآني: «وعلى الطريقة للقرآن نراه يبدأ في تناول موضوع الميراث أول ما يبدأ بتوجيه ذلك النداء ذي الطابع الخلقي»[7].
أمّا الشقّ الآخر المشَكِّل لرؤية كولسون تجاه التشريع القرآني، يتمثّل في كون هذا القسم من التشريع يعاني من قصور متجسِّد في عدم استقصاء التشريعات القانونية، ممّا جعلها أقلّ عددًا وتتبعًا قائلًا: «وتتصل المشكلة الثانية، ولعلّها أكثر وضوحًا من سابقتها، بظاهرة عدم استقصاء التشريع القرآني للمشكلات القانونية، وعدم الإشارة ولو بكلمة للعديد منها... ومن ذلك ما تواردت عليه الآيات على وجوب أخذ الزّكاة من فضول أموال الأغنياء لتُدفع إلى المحتاجين من الفقراء، دون بيان للتفصيلات العديدة التي تضبط جبايتها وتوزيعها»[8].
وكما هي عادة كولسون دائمًا يسعى للتمثيل لكلّ المشكلات التي يراها في التشريع القرآن، ومما مثّل به لهذا القصور مع العلم أنه لا يسلم له بهذه الأمثلة التي أوردها في سياق المشكلة الثانية قائلًا: «بالرغم من أنّ القرآن قد أتى في بعض مجالاته بقواعد جديدة تبدو غير مكتملة في ذاتها. ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد ما سبق عرضه من أحكام الميراث؛ فإنّ إحلال نظام الفرائض محلّ الأمر بالوصية للوالدين والأقربين كان لا بد أن يثير أسئلة لا نجد جوابها في القرآن: أهذه الوصية ما تزال جائزة؟ وإذا كانت كذلك فما حدّها؟ ولمن تصح؟»[9].
ثم ختم كولسون الفصل الأول الذي خصصه للتشريع القرآني بقوله: «لقد حاولنا في هذا الفصل تقديم تقويم موضوعي للدّور التشريعي للقرآن. وقد بدَا بما فيه الكفاية أن القرآن لا يقدِّم على نحوٍ صريح ومفصَّل حلولًا لكلّ المشكلات التي يتطلّبها بناء المجتمع، وقد أرسى القرآن بشكل قاطع المبدأ المتمثّل في أن الله [تعالى] هو وحده مَصدر كلّ حكم؛ وأن أمره يجب أن يُطاع في كلّ شأن من شؤون الحياة. غير أن هذا المبدأ لم يكن قد تُرجم بعدُ إلى بناء قانوني شامل أو مستوعب لمشكلات المجتمع الإسلامي»[10].
وعليه، تكون هذه رؤية كولسون للتشريع القرآني من خلال كتابه: (في تاريخ التشريع الإسلامي)، والتي عقد الحديث عنها في الفصل الأول الذي وسمه بالتشريع القرآني، وقد سعيت لاستخراجها وبسطها كما هي في فقرات منسجمة تشكّل نسق هذه الرؤية دون أدنى تحليل أو مناقشة تاركًا خصوصية هذا العنوان الصغير مقيدة برؤية كولسون من نصّ كتابه المذكور.
ثالثًا: فهم وتحليل رؤية كولسون للتشريع القرآني:
بعد عرض رؤية كولسون تبيَّن أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي بمثابة حلقات يشدّ بعضها بعضًا لتشكّل ما ذهب إليه كولسون في تصوّر التّشريع القرآني، وتتمثّل العناصر فيما يأتي:
أولًا: أنّ العلاقة القائمة بين التشريع القرآني والقانون الجاهلي هي علاقة تقويمية تكاملية، حيث قصدت التشريعات القرآنية تغيير جزئيات من القانون القبَلي السّائد قبل نزول القرآن.
ثانيًا: أنّ التشريع القرآني يفتقر للإجراء العملي جرّاء الإفراط في التركيز على الجانب الخُلقي مما طرح عدّة مشكلات مرتبطة بتطبيق التّشريعات التي جاء بها الخطاب القرآني.
ثالثًا: عدم استقصاء التشريعات القرآنية للمشكلات القانونية مما أدى إلى فراغ تشريعي في عدد من القضايا المطروحة وعدم الإشارة لها ولو من طرف خفي.
إنّ المتأمل في رؤية كولسون للتشريع القرآني يراها مغايرة تمامًا لِما ذهب إليه المستشرقون الذين عُرفوا بدراسة أصول الإسلام -وبخاصة التّشريع- مثل كولدزيهر[11] Goldziher وشاخت Schacht وغيرهما، حيث يتجسّد هذا التّغاير والتّمايز بين كولسون وغيره في أمرين يتمثّلان في أسلوب المناقشة والتحليل، ثم المنهج المعتمد في مقاربته للتشريع.
أمّا الأسلوب فقد عُرف كولسون بنمطه الأكاديمي وحسّه التحليلي الهادئ فلم يكن يعمد في كتابه: (في تاريخ التشريع الإسلامي) إلى ذلك الأسلوب الفجّ المبنيّ على التّحقير والتنقيص الصريح والمباشر الناتج عن التّعصب تجاه مواقف العلماء وإنتاجاتهم فضلًا عن الوحي[12] بصفة عامة والتّشريع القرآني بوجه خاصّ، بل كان أكاديميًّا وطّن نفسه على النّقاش العلمي بغضّ النظر عن النتائج التي خلص إليها ومدى صحّتها، والتي لا يُتّفَقُ معه فيها على الإطلاق.
وقد أورده الدكتور/ عبد اللطيف الطيباوي في كتابه: (المستشرقون الناطقون باللغة الإنجليزية)، قائلًا: «وهناك أستاذ جامعي آخر يستحقّ الثناء بجامعة لندن، لا لأنه يتجنب الخوض في مواضيع جدلية شائكة، ولكن أيضًا لتوجيهه المسار التدريسي ليكون قريبًا من التقليد الإسلامي. والإشارة هنا إلى أستاذ الشريعة (كولسون) الذي خلف الأستاذ (أندرسون) الذي كان يصرّح علانية بهدفه التنصيري ولا يكتم كراهية الإسلام... والواضح أن الخلف أكثر تجردًا وموضوعية من السلف»[13].
وهذا عكس الأسلوب الذي ينهجه كولدزيهر وشاخت، فمن رَجع إلى أعمالهما وبخاصّة التي لها علاقة بالتشريع يُلفِي مدى درجة الحقد الذي يظهر في صور استهزاء وطعن في أصول الإسلام، فما أن يناقشَا مسألة إلا ودسَّا فيها من التعصّب والحقد والتّهكم الأمر الكثير، والذي لا يكاد يَخفى على صغار القرّاء فضلًا عن العلماء الذين تجنّدوا للردّ على هذه الأساليب والافتراءات وما يكتنفها من شبهات مغلفة في قوالب تدّعي العلمية.
وما قيل في الأسلوب يُقال أيضًا في المنهج، فقد رام كولسون دراسة التّشريع القرآني من وجهة نظر تخصّصية دقيقة تنبثق من مجاله القانوني الذي عُرف به في ظلّ انتعاش الاستشراق بأعمال فئة قليلة بارعة متخصّصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذا على عكس ما ذهب إليه جُلّ المستشرقين في دراسة التشريع وبخاصّة في الاستشراق الكلاسيكي؛ إِذْ نجدهم يقحمون عددًا من المناهج المتعدّدة في العمل الواحد؛ كالمنهج التاريخي ومنهج الأثر والتأثر والمنهج الفيلولوجي والمنهج الإسقاطي... وغيرها من المناهج السائدة آنذاك.
لكن سرعان ما أحدثت العلوم الإنسانية والاجتماعية طفرة في أفق الاشتغال الاستشراقي بحيث لم يَعُد «محتكرًا من قِبَل فقهاء اللغة (الفيلولوجيين)، والمحترفين في اللغات الشرقية؛ بل شهد الحقل -كما يؤكّد المستشرق السويسري جاك واردنبرغ- دخول باحثين من مجالات معرفية أخرى؛ كالمتخصّصين في العلوم الاجتماعية، وهي: علم الاقتصاد، وعلم الاجتماع، والأنثربولوجيا، والعلوم السياسية... الذين اشتغلوا -على نحو متزايد- بدراسة المجتمعات، والثقافات الإسلامية»[14].
وهذا ما بيّنه الدكتور/ المبروك الشيباني المنصوري في حديثه عن منهج الحركة الاستشراقية مؤيّدًا ذلك بمقارنة منطقية بين نماذج للكتابات الاستشراقية قائلًا: ظلّت «بحوث استشراقية كثيرة تتميز بغياب شبه كليّ لأيّ منهج تحليلي حتى غدت أقرب إلى الدراسات الثقافية Cultural Studies التي لا تتميز بأيّ ضابط منهجي. وإذا نظرنا إلى الفكر الألماني مثالًا في هذا المجال، فإننا نجد ما كتبه ماكس فيبر Max WEBER بخصوص الفكر الإسلامي، في كتابه: (الاقتصاد والمجتمع Wirtschaft und Geselschaft) أعمق بكثير مما كتبه يوسف فن آس Josif Van Ess في كتابه: (العقيدة والمجتمعGeselschaft und Theologie) رغم أنّ ماكس فيبر لم يكن متخصصًا في الفكر الإسلامي فقط، أمّا كتاب يوسف فن آس فإنه موسوعة في الفكر الإسلامي تحديدًا. الفرق بينهما إذًا هو أنّ فيبر اختار منهجًا سوسيولوجيًّا والتزم به؛ لأنه كان من الأعلام والمؤسّسين له، وطبّق أُسسه ومبادئه وضوابطه بكلّ دقة وصرامة علمية ومنهجية، فأدى تحليله إلى نتائج عميقة»[15].
أمّا يوسف فن آس فهو على نقيض فيبر رغم كِبَر المنجز «فإنه لم يلتزم بمنهج محدّد ومضبوط، بل كان تحليله أشبه بالتّداعيات المسترسلة؛ ولذلك فرغم موسوعيّة معارفه وشموليتها وتنوّعها فإنه لم يتوصّل إلى نتائجَ نسقيةٍ مُبرهَنٍ عليها برهنة علمية صارمة، وتقدِّم إضافة دقيقة فعّالة للدراسات الإنسانية وللفكر الإسلامي»[16].
وإنّ أزمة المنهج التي عانت منها العديد من الكتابات الاستشراقية وبخاصّة القديمة قد بدت نتائجها بشكلٍ ملحوظ في الاستنتاجات التي تقدمها، ومن ذلك قول كولدزيهير: «وبالجملة فإن الحياة الفقهية الإسلامية، سواء في ذلك ما يتعلّق بالدِّين أو الدنيا، أصبحت خاضعة للتقنين. والقرآن نفسه لم يعطِ من الأحكام إلا القليل، ولا يمكن أن تكون شاملة لهذه العلاقات غير المنتظرة كلّها مما جاء من الفتوح، فقد كان مقصورًا على حالات العرب الساذجة، ومعنيًّا بها، بحيث لا يكفي لهذا الوضع الجديد»[17].
ونفس الأمر ينطبق على شاخت حين أشار إلى «أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد خرج في مكة باعتباره مصلحًا دينيًّا، وقد اعتبره قومه مجرّد كاهن كبقية الكهان. ونظرًا لسلطته الشخصية فإنه دُعِيَ إلى المدينة عام 622م للتحكيم في نزاع قبَلي هناك، وبصفته نبيًّا فإنه قد أصبح مشرع المجتمع الجديد المبني على القواعد الدينية، وهكذا حلّ المجتمع الديني محلّ المجتمع القبَلي. ولأنّ الرسول [صلى الله عليه وسلم] رفض أن يلعب دورَ الكاهن فقد رفض التحكيم طبقًا لما هو معمول به في الجزيرة العربية الوثنية»[18]، وغيرها من النتائج التي تبيِّن العطب الحاصل والجرح الغائر على مستوى المنهج في الدراسات الاستشراقية.
وما أوردته في هذا المقام من مقارنة فهي كفيلة بالإسهام في تجلي رؤية كولسون أكثر وفهمها واستيعاب أُسسها، وتجدر الإشارة أن تفرّد كولسون بمنهج خاصّ في تحليله ونظرته للتشريع القرآني لا يسلم له بكلّ ما قاله، وبخاصة على مستوى النتائج التي لا تخرج أحيانًا عمّا ذكره العديد من المستشرقين، لكن حسبي من هذه المقارنة المتقدّمة على مستوى الأسلوب والمنهج إدراك الحدود والمعالم العامة التي ينهجها كولسون في دراسته في مقابل مَن تصدّر لدراسة نفس الموضوع من المستشرقين الذين تحدّثوا عن التشريع القرآني من جوانبه التاريخية فقط.
وعودة لجوهر رؤية كولسون ورغم تمتّعه بحسّ خاصّ في دراسة التشريع الإسلامي وأسلوب هادئ، فإنه كان يرى أنّ التشريع القرآني ما هو إلا تعبير عن أصول الأخلاق الدينية التي يجب تمثّلها من لدن المسلمين لِمَا ينتج عنها من عدل ورحمة بين الناس، وما يترتب عنها أيضًا من طاعة لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ إِذْ يرى كولسون أنّ الآيات التي تأمر بطاعة الله وطاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لها دور كبير في التزام النّاس بهذه التشريعات في بادئ الأمر.
كما يرى أنّ ما يستند عليه التّشريع القرآني من نُظُم وسياسات ومفاهيم كلّها ترجع بالأساس إلى الأخلاق، باعتبارها المحور الجوهري للتشريع القرآني، سواء المتعلق بالنواهي أو الأوامر، وعلى سبيل المثال -كما أورد كولسون في كتابه- فإن تحقيق العدالة في الإرث، ومنع الربا...[19]، كلها تشريعات يلزم بها القرآن من الناحية القيمية الأخلاقية التي تفتقر إلى الإجراء العملي التطبيقي الواقعي القانوني المترتب عن ارتكاب هذا النهي.
وإنّ الغلوّ الذي يراه كولسون في البُعد عن الواقع العملي سيجعل النّاس أكثر عزوفًا عن تطبيق والتزام التشريعات القرآنية؛ لأن الرّقابة الواقعية والسُّلطة التّشريعية العملية غير حاضرة في نظره، لحديث التشريع عن الأخلاق والجزاء الأخروي الذي قلّ ما يُهْمِل الإنسان مصالحه الدنيوية ويلتفت له.
ثم يعود كولسون ليعلّق على هذه الإلزامات الأخلاقية التي جعلها من أبرز مشكلات التشريع القرآني بأنها غير واضحة في غالب أحوالها، بحيث يستنبط بعد دراسته أن المضامين القانونية لمبادئ القرآن الأخلاقية قد لا تتسم بالوضوح دائمًا؛ كعدم النّص على جزاء الخروج على من يتزوج بأكثر من أربع زوجات[20]، وغيرها من الأمثلة.
وإلى هنا نقف على تردّد في رؤية كولسون للتشريع القرآني فيما يخصّ المشكلة الأولى التي أبرزها، فتارة يذكر أن نمط هذا التشريع قد بالغ بشكل واضح في التركيز على الجانب الخُلقي كما تقدَّم معنا، وتارة يعود ليبيِّن أنّ هذا الجانب الخلقي للتشريعات القرآنية غير واضح مما يطرح العديد من التساؤلات التي ستأتي مناقشتها.
ثم يقول مرة أخرى أنّ «الظروف قد حتّمت فيما بعد بضرورة الانتقال من ذلك التّوجه الخلقي العام إلى قواعد أكثر ضبطًا للوقائع العملية»[21]، ليتبيَّن لنا أنّ كولسون يزيد ترددًا كلّما غاص في تتبّع التّشريعات القرآنية وحاول مناقشتها بشكلٍ مستقلّ.
وبعد بيان المشكلة التي يراها كولسون مرتبطة بالأخلاق فقد بنى عليها المشكلة الثانية التي تتمثّل في عدم استقصاء التشريعات القرآنية للمشكلات القانونية ممّا أدّى إلى فراغ تشريعي في عدد من القضايا المطروحة، وعدم الإشارة لها ولو من طرف خفيّ معللًا ذلك بقلّة الآيات التّشريعية من خلال جرد الآيات المباشرة في التشريع التي يقدر مجموعها بخسمائة آية، ثم يسعى ليستثني منها ما يتعلّق بالفرائض والشعائر الدينية من صلاة وصيام وحج، بحيث لا يبقى في نظره مما تقدّم إلا ما يقارب ثمانين آية[22].
ويسعى كولسون إلى تعليل قِلّة التشريعات القرآنية ببساطة الحياة آنذاك وعدم تشعّبها وقلّة الحوادث والمستجدّات، ثم ينقلب على هذه التشريعات القليلة -في نظره- ليبيِّن أنها تنزع للتحلّي بمظهر الحلول الخاصّة لمشكلات معيّنة أكثر ما يُقصد منها الإحاطة بموضوع المشكلة المتناول على نحو مستوعب وشامل.
رابعًا: مرتكزات رؤية ن.ج كولسون للتشريع القرآني:
لا يكاد يَخفى تبايُن آراء المستشرقين ومواقفهم تجاه التشريع القرآني؛ وجُلّها تسعى لتقويضه وبيان عدم استمراريته وصلاحيته في نهاية الأمر، إمّا عن طريق إنكاره قولًا واحدًا، أو بفصله عن التشريع الوارد في السنّة النبوية، أو الإقرار بنجاعته لكن زمن نزوله، أو كما يرى كولسون أن التّشريع القرآني رغم تميزه عن باقي التشريعات إلا أنه يعاني من عدّة مشكلات، وفي الحقيقة أن كلّ هذه الاتجاهات والرؤى والنتائج هي أوجُه لعُملة واحدة تتغيّا الحطّ من مكانة هذا الشقّ من التشريع وعدم الإقرار بصلاحيته لكلّ زمان ومكان.
ومَنْ تأمّل هذه الآراء والدراسات حول التشريع القرآني، وبخاصّة التي تقدم الحديث عنها -رؤية كولسون-، ألفاها تقوم على أُسس ومرتكزات بعيدة كلّ البُعد عن الموضوعية والحياد العلمي، رغم ادّعائهم المعقولية والمنطقية في دراسة التشريع الإسلامي بصفة عامة والتشريع القرآني على وجه الخصوص، ذلك أنّ طرقهم في دراسات القرآن الكريم وما يتعلّق به تكون محطّة استثنائية في أعمالهم العلمية، بحيث ينطلقون من مرتكزات مغلفة بقوالب علمية تمويهًا للمجتمعات الغربية والعربية الإسلامية، ويمكن إجمال كلّ المرتكزات التي انبثقت منها أو بالأحرى التي اعتمدت عليها رؤية كولسون وغيرها من الدراسات الاستشراقية التي سعت للقول في التشريع؛ في الآتي:
- إهمال المصادر الإسلامية الأصلية.
- اعتماد المقاييس المادية والمناهج الوضعية.
إهمال المصادر الإسلامية الأصلية:
لَطالما زعم المستشرقون الاستناد للمصادر الإسلامية بالإحالة عليها في دراساتهم وأعمالهم العلمية طلبًا للمصداقية، والحقيقة أنه ليس كلّ من أحال على شيء أو أشار إليه يُتفق معه عليه، وقد دأب على هذا الأمر زعيم الاستشراق الألماني ثيودور نولدكه، حيث كان يُحِيل كثيرًا على المصادر الإسلامية، ولكن لا يسلّم له بما أحال عليه بكلّ حال من الأحوال؛ إِذْ على ذلك مجموعة من الاعتراضات العقدية والعلمية المنهجية[23]، ولكن ما نودّ الإشارة له في هذه المسألة هو إهمال المصادر الإسلامية الأصلية في دراسة كولسون للتشريع القرآني، والتي يتجلى معها أكثر تفنيد ما زعمه من أنّ هذا الشقّ من التشريع يعاني من عدة مشكلات كما تقدّم.
ومَن تتبّعَ صنيع المستشرقين في التعامل مع التشريع الإسلامي، وبخاصّة رؤية كولسون، ألفى هناك ضربًا من الإهمال الممنهج المقصود للمصادر الأصلية المُعِينة على فهم التشريع القرآني؛ لأنّ من المعهود أن قيمة الدراسات التي تُعنى بمقاربة فكر معيّن لا بد أن تنطلق من مرتكزات الفكر المدروس باعتبارها المادة الأوّلية للوصول إلى المراد، لكن لما كانت المادة الأوّلية هي طريق للحقيقة العلمية، رام المستشرق الإبداع في إهمال هذه المادة الأولية -مصادر التشريع الإسلامي-، وهذا خلل منهجي فاضح ونتائجه أفضح، ومن صور هذا الإهمال الممنهج الذي ارتكزت عليه الرؤية الاستشراقية للتشريع القرآني وبخاصّة رؤية كولسون التي هي محل الدراسة:
أولًا: عزل الدلالات القرآنية بعضها عن بعض، وهذا منافٍ لمنهج القرآن ليس فقط فيما يتعلّق بالتشريع فحسب، بل في كلّ ما جاء به من عبادات ومعاملات وأخلاق وقصص...، فلا يمكن قطعًا فهم مصطلحات القرآن المشكِّلة لماهية تشريعاته، فضلًا عن الأحكام والمقاصد التي يروم الخطاب القرآني تحقيقها، وهذا ما حصل مع كولسون، حيث عمد لفهم دلالات القرآن بصورة سطحية لا ترقى لاستيعاب فلسفة التشريع القرآني، ومن ذلك على سبيل المثال حين فهم القوامة في سورة النساء بمعنى الاستعلاء والاستبداد، وخلط بين الشريعة والفقه في أكثر من موطن، وعدم التمييز بين الثابت والمتغير...
ثانيًا: عدم الاعتماد على السنّة النبوية بالشكل الكافي والمطلوب لفهم التشريع القرآني ومسالكه وفلسفته التي يقوم عليها؛ إِذْ نجد عددًا من المستشرقين يُنكِرونها، وممن رام نفيها: «جولدزيهر، وجونيبول، وروبسون، وشاخت باعتبارها مصدرًا تشريعيًّا أساسيًّا في هذه الفترة، ولم يؤكّد هذا المصدر إلّا في عبارات موجزة وبأمثلة قليلة. والحقيقة التي لا مراء فيها أن مصادر التشريع في هذه المرحلة تنحصر في القرآن الكريم، والسنّة النبوية، واجتهاد الرسول [صلى الله عليه وسلم] الشخصي وذلك على خلاف فيه، واجتهاد الصحابة [رضي الله عنهم] إبّان حياته على خلاف في ذلك»[24].
ورغم إقرار كولسون بالسنّة النبوية في كثير من الأحوال، إلا أنّه لم يستوعب مسألة الإسناد، بل لم يقبلها البتة، حيث عقّب على المحدِّثين وأهمل جهودهم بصورة لا تليق بما بذلوه من جهد جهيد في تصفية السُّنّة من الدخيل ومعرفة الصحيح من الضعيف، وعمومًا فقد كان توظيفها وحضورها في تصوره لفهم التّشريع القرآني قليلًا، الشيء الذي جعله يقول بقِلّة الأحكام التشريعية في القرآن وغموضها تارة وإجمالها تارة أخرى، ليلحق بجموع المستشرقين الذين قالوا بقصور التشريع القرآني واعتباره «المصدر الأساسي للتشريع في هذه المرحلة، ولم يختلفوا كثيرًا إلا في التفاصيل وإن كانوا متفقين على أن آيات الأحكام قليلة بالنسبة لمجمل القرآن. ووصفوا الأحكام الشرعية الواردة فيه بالقلّة والغموض والعموم»[25].
وإنّ إنكار السنّة بصفة عامة أو اعتبارها مصدرًا للتشريع في وقت متأخّر دون أن يؤدي هذا الاعتبار لفهم كُنْه التّشريع القرآني واستيعاب مراحله وتدرّجه وجُلّ خصائصه هو دليل على عدم وضع السنّة النبوية في مركزيتها ومقامها الحقيقي في التّشريع، مما يمكن أن نستخلص منه إهمال مصدر من مصادر التشريع الرئيسة.
ثالثًا: ومن صور الإهمال أيضًا للمصادر الأصلية عدم الاهتمام قطعًا بصحة المرويات وأصحابها رغم ضعفها وانقطاعها في كلّ الأحوال، بحيث يستعين كولسون «بكثيرٍ من الأخبار والروايات التي تصوّر حياة العرب القانونية قبل الإسلام، بدون أن يوجّه إلى هذه الأخبار أدنى قدرٍ من التّشكيك، على الرغم من أنّه سيرفض كثيرًا من السّنن التي تزيد عن هذه الأخبار في الصحة والقبول، وعلى الرغم من العناية الزائدة بهذه السّنن، ولا نلومه على القبول بقدر ما نلومه على الرّفض، أو أنه كان عليه -في الأقل- أن يبيّن منهجه الذي يبني عليه قبوله لما رَوى عن أعراف العرب وقوانينهم»[26].
وغير ذلك من صور الإهمال التي ارتكزت عليها رؤية كولسون للتشريع القرآني، ومعظمها يتمثّل في انتقاء ما يخدم الرؤية، سواء على مستوى المصادر الأصلية المتمثلة في القرآن والسنّة النبوية أو المصادر التبعية وإن لم يصرح بها، أو على مستوى الأمثلة التي يأتي بها أو الشواهد التي يتم توليدها من كتب السّير والتاريخ والأخبار، دون أدنى بيان لوجه هذا الانتقاء كما سيأتي معنا.
اعتماد المقاييس المادية والمناهج الوضعية:
لقد اعتاد المستشرقون في دراسة الخطاب القرآني وما يرتبط به بالاعتماد على المقاييس المادية والمناهج الوضعية متناسين «أنّ فعالية المنهج المتّبع في أيّة دراسة، يتوقّف على قيمة المصادر والروافد المعتمدة؛ إِذْ هي القاعدة المغذية والمادة الخام التي ترتكز عليها الدراسة، فكلّما كانت المصادر رئيسة وأصيلة وذات علاقة مباشرة بالموضوع، كانت الدراسة أقرب إلى الحصول على المراد المنشود والمبتغَى المقصود من طرف الباحث»[27].
وقد مارَس المستشرقُ القديم تجاه النصّ القرآني عدّة مناهج صار يُنظر لها اليوم بأنها مناهج بالية، ومن ذلك على سبيل المثال: تمسّكهم بالمنهج الافتراضي الذي مفاده هو الابتعاد عمّا أقرّه الأصل والعقل والمنطق، والأخذ بافتراضات يمليها الهوى بحيث تكون أقرب وأدنى إلى الكذب[28]، إذْ لم يَسعهم تقبُّل أصل الخطاب القرآني، فسعوا إلى افتراضات وتأويلات كثيرة، مما نتج عنه تضارب في الأقوال حول ذات الظاهرة المدروسة، ولم يقف الأمر عند الافتراض في تفسير الوحي فقط، بل تجاوز ذلك لتُبنى على هذه الافتراضات مداخل ورؤى تعدّ أخطر في الطعن تجاه مصدرية القرآن فضلًا عمّا تضمّنه من تشريعات هي موضوع بحثنا.
ومن المناهج الوضعية أيضًا التي يوظّفها المستشرق في دراسة القرآن الكريم، المنهج الإسقاطي، بحيث «يفسر الوقائع والنصوص بأمر دأَب المستشرقون على توظيفه في أبحاثهم القرآنية، ونعني بالمنهج الإسقاطي، إسقاط الواقع المعيش على الحوادث والوقائع التاريخية، إنه تصوّر الذّات في الحدث أو الواقعة التاريخية، وهكذا يتم تفسير الظواهر وفق المعتادات لدى الإنسانية، بحيث المستشرق عندما يضع في ذِهنه صورة معينة يحاول إسقاطها على صور ووقائع معينة فيخضعها إلى ما ارتضته مخيلته وانطباعاته»[29]، وهذا ما وقع فيه كولسون عندما شبه التّشريع القرآني بما كانت عليه قوانين الألواح الاثني عشر الرومانية[30].
ولا شك أنّ رؤية كولسون للتشريع القرآني قد نهلت من المناهج السابقة المتمثّلة في المنهج الافتراضي والإسقاطي من طرفٍ خفيّ، لكن لمّا كان كولسون رجل قانون بامتياز في عصر انتعشت فيه العلوم الإنسانية والاجتماعية وقلّت فيه مناهج الاستشراق الكلاسيكي، فإن كولسون قد غلب على منهجه المنهج[31] القانوني في مقاربة التشريع القرآني لا من حيث طريقة تحليله أو المصطلحات التي يوظّفها أثناء مناقشته.
وإنّ اعتماد كولسون للمنهج القانوني كمنهج أساسي في بناء رؤيته ودراسته للتشريع القرآني، هو أمر لا مِرْيَة فيه، وإنه من صميم اعتماد المقاييس المادية والمناهج الوضعية التي لا تخرج عن النسبية في منطلقاتها ومسالكها فضلًا عن نتائجها، وأنَّى لهذه المناهج التي تأسّست بفعل الغرب في بيئات غربية بخلفيات تُخالف أُسُس القرآن وغاياته أن تحيط به في كلّ معانيه وأن تفهم فلسفته التشريعية التي يروم تنزيلها.
وما دامت هذه المناهج الوضعية التي ينهجها المستشرقون في دراستهم للتشريع الإسلامي لا تتوافق في مرتكزاتها مع الرؤية القرآنية، وأنها مناهج وعلوم يُرْجَى من ورائها غايات معينة، فلا شكّ أن نتائجها ستكون محلّ رفض، وحسبي في هذا المقام ما ذكره الدكتور/ محسن صالح قائلًا: «لقد أنشأ الغرب علومًا أسماها (إنسانية): علم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم النفس، والأنثروبولوجيا، وغيرها من (العلوم المستحدثة)؛ بأقسامها وتشعّباتها المتعدّدة، فكانت إمّا تعبيرًا عن ثقافة ذاتية يُراد تعميمها، وإمّا استُخدمت لدراسة ثقافة أخرى؛ لمعرفتها وتدمير أُسُسها وقيمتها أو تشويهها؛ لأنها لا تتماهى مع ما يعتقده المستشرق الغربي»[32].
ولا شكّ أن رؤية كولسون للتشريع القرآني لا تخرج عن هذه المناهج التي أُنشئت بقيم ومعايير تخالف ما يقرّره القرآن في غالب مضامينها، كما أنها أُنشئت في بادئ الأمر لدراسة الإنسان لا دراسة القرآن، وما دامت أنها أُسّست لدراسة الإنسان فإنها «لم تَحِد عن المركزية الثقافية الغربية ومقاييسها في التقويم العام للثقافات الأخرى ومعتقداتها وعاداتها وتقاليدها؛ لهذا فإن ما نعتقده اليوم من (علوم إنسانية) إنما هي علوم ذاتية شعبيّة... ولا تكتسب حقائقها العالمية بالضرورة... اللهم إلا إذا استثنينا الأدوات البحثية التي ربما تكون صالحة عالميًّا، والتي تستند في دراستها البحثية إلى الميدان والإحصاء؛ يعني تستند إلى أجزاء من العقل العلمي المنتج للحقائق الكونية الإنسانية»[33].
وإنّ هذه المناهج وعلى رأسها المنهج القانوني الذي سلكه كولسون في مقاربة التشريع القرآني، وغيره من المناهج الأخرى التي لا تخرج عن دائرة العقل المحض والوضع والتجربة كمنهج الأثر والتأثر، ومنهج النفي والمنهج التاريخي والمنهج اللغوي، لا تنسجم قطعًا مع الوحي القرآني بصفة عامة والتشريع بوجه خاصّ، والذي يفوق إدراك هذه المناهج ومحدداتها بمعجزات يصعب تخيّلها، ومن جهة أخرى إذا كان المستشرق قد أَخضع الكتب المقدّسة عنده رغم التحريف العظيم الذي طالها في مختلف محطات تاريخها، ودرس ما فيها وفق هذه المناهج وأسعفهم ذلك حسب زعمهم، فإنّ الوحي القرآني وما يكتنهه من تشريعات عامة أو خاصّة تختلف تمامًا عن هذه الكتب التي عبثت بها العقول قبل الأقلام، وفي مقابل ذلك نجد التشريع القرآني لا يزال غضًّا طريًّا يتمتع بخصائصه التي جعلته عابرًا لحدود الزمان والمكان والإنسان إلى الآن، وعليه فإنّ دراسة التشريع القرآني بمناهج تختلف مرتكزاتها ومقاصدها عن روح القرآن ستؤول إلى نتائج محسومة ابتداء.
خامسًا: نقد المنهج في رؤية كولسون للتشريع القرآني:
إنّ المتأمّل في المنهج الذي اعتمده كولسون في دراسة التشريع القرآني، يُلْفِيه منهجًا غير جادّ، ودليل ذلك: المخرجات التي وصل إليها في نهاية دراسته لهذا الشقّ من التشريع؛ لذلك فإن عددًا من المؤاخذات والانتقادات توجّه له بشكلٍ مباشر وغير مباشر، ومن أبرزها: أن المنهج القانوني المعتمد جعل الرؤية التكاملية غائبة لدى كولسون لفهم التشريع القرآني وظلّت زاوية النظر ضيقة جدًّا، كما أنّ سيطرة هذا المنهج على ذهنية كولسون جعلته بمثابة قاضٍ يُحاكم إليه التشريع القرآني ويسعى للمقارنة بينها، في حين أن هذه المقارنة لا تصح بأيّ وجه من الوجوه، كما أنّ تأثير القانون الوضعي على دراسة كولسون كان واضحًا في عدد من المواضع في دراسته للتشريع الإسلامي بأكمله وليس فقط الشّقّ المتعلّق بالقرآن.
وقد سبقت الإشارة في معرض بيان مرتكزات رؤية كولسون للتشريع القرآني اعتماده على منهج خاصّ لم يُسبق له من لدن المستشرقين الدارسين للتشريع الإسلامي والمتمثّل في المنهج القانوني، ولا ريب أنه من صميم المناهج الوضعية التي لا تخرج عن النسبية في منطلقاتها ومسالكها فضلًا عن نتائجها، وأن هذا المنهج وغيره من المناهج التي تأسّست بفعل الغرب في بيئات غربية بخلفيات تخالف أُسس القرآن وغاياته، فكيف بها أن تمدّنا بمخرجات يمكن الاعتماد عليها وبناء تشريعات عليها؟
ولا يختلف اثنان أن الرؤية القانونية التي اعتمدها كولسون تستند على علم القانون أو بالتعبير الأكاديمي على التخصّص القانوني الذي أنشأه الغرب ابتداء لتحقيق أهداف معيّنة، مما ينطبق عليه ما ذكره الدكتور/ محسن صالح قائلًا: «لقد أنشأ الغرب علومًا أسماها (إنسانية): علم الاجتماع، وعلم النفس، والأنثروبولوجيا، وغيرها من (العلوم المستحدثة)؛ بأقسامها وتشعباتها المتعدّدة، فكانت إمّا تعبيرًا عن ثقافة ذاتية يُراد تعميمها، وإمّا استُخدمت لدراسة ثقافة أخرى؛ لمعرفتها وتدمير أُسسها وقيمتها أو تشويهها؛ لأنها لا تتماهى مع ما يعتقده المستشرق الغربي»[34].
وما دامت رؤية كولسون للتشريع القرآني لا تخرج عن المنهج القانوني في عمومها والذي أُنشئ في أصله بمرجعيات ومعايير تخالف ما يقرّره القرآن في غالب مضامينه، كما أنه وضع لمقاربة وتطوير التشريعات الوضعية لا لمقاربة التشريعات القرآنية، وما دام الأمر كذلك فإنها «لم تَحِد عن المركزية الثقافية الغربية ومقاييسها في التقويم العام للثقافات الأخرى ومعتقداتها وعاداتها وتقاليدها؛ لهذا فإن ما نعتقده اليوم من (علوم إنسانية) إنما هي علوم ذاتية شعبيّة... ولا تكتسب حقائقها العالمية بالضرورة... اللهم إلا إذا استثنينا الأدوات البحثية التي ربما تكون صالحة عالميًّا، والتي تستند في دراستها البحثية إلى الميدان والإحصاء؛ يعني تستند إلى أجزاء من العقل العلمي المنتج للحقائق الكونية الإنسانية»[35].
ولا ريب إذًا أن اختلاف المنطلقات مؤشِّر على اختلاف النتائج وبُعدها عن الصواب، وهذا ما وقع فيه كولسون عند مقاربته للتشريع القرآني جاعلًا إيّاه كباقي القوانين، بل نجده يصرح بهذا الأمر حين تحدّث عن بساطة التشريعات القرآنية وقلّتها، وهو الأمر نفسه الذي كان عليه القانون الروماني، مما يدلّ على نوع من التسوية والمقارنة بين ما هو وضعي نسبي وبين ما هو سماوي مطلق يتجاوز حدود الزمان والمكان، وما هذا إلا مثال مما وقع فيه كولسون، وإلا فإن تأثير المنهج القانوني على رؤية كولسون للتشريع القرآني قد اعتراها من عدة جوانب تتمثّل في الآتي:
غياب الرؤية التكاملية:
لقد تسرّع كولسون في إطلاق الأحكام على التشريع القرآني في مطلع كتابه، حيث قاربه بمعزل عن السنّة النبوية والإجماع والقياس باعتبارها من أصول التشريع التي تستمدّ مركزيتها من الخطاب القرآني بأدلة متعدّدة، كما لا يمكن استيعاب الفلسفة التشريعية للقرآن الكريم إلا في ظلّ وصل أركان هذه المنظومة التشريعية التي هي بمثابة مفاصل يشدّ بعضها بعضًا، بل إنّ الخطاب القرآني في حدّ ذاته لا يمكن فهم معانيه وإدراك مراميه والإحاطة بمصطلحاته إلا من خلال ضمّ الآيات ذات المعنى الواحد وربط مضامينها بعضها ببعض ومعرفة السابق منها واللاحق... مما قد يُعِين على استخلاص التشريعات وفهمها، وغير ذلك مما قد يَرُومه الدّارس للقرآن بصفة عامة.
وإنّ هذا العزل الذي جسّدته رؤية كولسون للتشريع القرآني في تجاهل المبدأ التكاملي الذي رسمه الخطاب القرآني في التشريع حين بيَّن مكانة السنّة النبوية في علاقتها بالقرآن وإجماع الأمة وكذلك تفسيرات العلماء للقرآن، جعل الدكتور/ محمد أحمد سراج في تعليقه على الكتاب أنْ يطرح ثلةً من الأسئلة المركزية تجاه رؤية كولسون تمثّلت في الآتي: «هل يصح إفراد دلالات معيّنة للقرآن، والوصول إلى فهمها فهمًا حقيقيًّا بعد عزلها عن غيرها؟ وهل يصحّ إفراد النصّ القرآني وفهمه بمعزل عن السُّنَّة؟ وهل يمكن للباحث الحديث فهم النصّ القرآني بمعزل عن تفسير الفقهاء والمفسِّرين الذين بذلوا جهودًا ضخمة في استبيان نصوص القرآن وفهمها والوقوف على معانيها»[36]، وغيرها من الأسئلة التي تجسّد الضعف الذي وقع في مقاربة كولسون للتشريع القرآني.
وإنّ الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يوضح الروابط التكاملية للتشريع القرآني، سواء داخل البنية القرآنية أو خارجها مما له علاقة بباقي أصول التشريع، كما يوضح من جهة أخرى أنّ منهج كولسون القانوني «منهج ناقض لا يؤدي إلا إلى نتائج مبتورة في تصوّره للتشريعات القرآنية. والمنهج الإسلامي في فهم معاني القرآن يتمثّل في وجوب ضمّ الدّلالات القرآنية المختلفة، والنظر فيها جميعًا، فالقرآن يفسّر بعضُه بعضًا على ما هو معروف، كما يصرّح المنهج الإسلامي على وجوب النظر إلى نصوص القرآن في ضوء السنّة فإنها تفسّره، وقد بذل المفسِّرون عبر الأجيال جهودًا ضخمة بحيث لا يصحّ للباحث الحديث أن يتجاهلها ويبدأ من جديد. وإنّ منهج المؤلِّف مبسّط للغاية، وكان الأَوْلى به أن يختبر منهجه هذا، ويعرضه على مناهج تفسير القرآن المقبولة، وذلك قبل أن يستخدمه بالفعل ويصل منه إلى النتائج المفرطة في الثقة»[37].
إذن لا يمكن قطعًا فهم التشريع القرآني مبتورًا أو الحكم عليه إِذْ «لا يتأتّى لمن ينظر إليه وحده منفصلًا عمّا يتصل به من سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب النزول ومن تفسير مأثور، فمن فعل ذلك وقع في أقلّ ما يوصف به التناقض والاضطراب، ولا يتجنب ذلك إلا مَن نظر في نصّ القرآن قارنًا ذلك بالنظر في السنّة الصحيحة والتفسير وأسباب النزول، فعندئذ يستقيم الحكم على النصّ التشريعي القرآني، ويرتفع ما توهّم فيه من عدم كمال الوفاء بالمتطلبات التشريعية للأُمة على نحو ما سبق إلى تصور كولسون»[38].
وعليه، فاضطراب رؤية كولسون بين الفينة والأخرى كان نتيجة غياب النظرة التكاملية للتشريع، فهي مطلب علمي آكد وضابط من ضوابط دراسة التشريع بصفة عامة، ولا يمكن الوصول إلى مخرجات معقولة لفهم التشريع فضلًا عن تطويره إلا بالإدراك التام لطبيعة النظام القانوني الذي جاء به الإسلام، وتكامل مصادره التشريعية، وشدّ بعضها لبعض، وهذا ما غفل عنه الأستاذ كولسون في دراسته للتشريع القرآني[39].
تأثره بالتقنين الحديث:
إنّ تخصّص كولسون في الدراسات القانونية الوضعية بحثًا وتدريسًا لفترة ليست بالقصيرة جعلته أكثر تأثرًا بهذه القوانين ولا يمكن لذهنيته الانفكاك والتجرّد من هذه النظرة القانونية الوضعية، بل يقرّر في كثير من المواطن -كما تقدّم معنا- أنه يسلك المنهج القانوني، مما جعله أثناء مقاربة التشريع القرآني أن يحاكمه للتشريع الوضعي؛ ما نتج عنه القول بأنّ من عيوب التشريع القرآني كثرة العموميات، وقلّة آيات الأحكام، وعدم الاستقصاء والتفصيل، بخلاف القانوني الوضعي الذي شكّل عقلية كولسون، إِذْ يراه أكثر قُربًا واستجابة لمتطلبات الواقع، وأن التشريع القرآني مثاليّ أكثر من اللازم ما جعله يحلّق فوق الواقع ولا يقاربه.
ولا شك أنّ ما دفع كولسون لتبنّي هذه المشكلات في نظره هو تأثّره البالغ بطبيعة التقنين الحديث وبخاصّة في البلدان الغربية، ويرى عدم السّير على هذا المنوال في التقنين الحديث عيبًا ونقصًا في التشريع القرآني، في حين لا يخفى أنّ القرآن ليس كتاب تشريع فقط ليأتي في نصوص ومواد صريحة تلامس المشكلات القانونية بشكلٍ مباشرٍ كما هو شأن القانون الوضعي، ما جعل كولسون يصف التشريعات القرآنية بالغموض أيضًا[40] في أكثر من موضع.
في حين أنّ النّصَّ القرآني لا يسلك أسلوب القوانين الوضعية في التشريع «فما يقرّره القرآن على سبيل الندب أو الوجوب أو الكراهة أو التحريم أو ما يَدَعَهُ على الإباحة الأصلية... كلّ ذلك تشريع. والقرآن في التشريع لا يسلك سبيلًا واحدًا في التعبير، إنما يسلك سبلًا عديدة في غاية الإعجاز... وكما يمكن أن يُعرف الوجوب أو التحريم أو غيره من الأحكام السابقة من صيغة أمر أو نهي أو من وضع عقاب، فإنه كذلك يُعرف الحكم من القصة والمثل المضروب»[41].
وما قيل في الأمثال والقصص يُقال في جميع آيات القرآن، فكلّ آية لا تخلو من حُكم مباشر أو ترشد له بترغيب أو ترهيب وغيرهما من الأساليب التي ينهجها القرآن في التشريع لتكون أدعى بالارتباط بعقيدة الإنسان ومخاطبة وجدانه وتنظيم حياته؛ ممّا يجعل الأمر أقرب للالتزام والامتثال وعدم المخالفة، كما تساعد أساليب القرآن المتنوّعة في التشريع على التذوّق والإحساس به -التشريع- بعيدًا عن جفاء القوانين الوضعية وما يصحبها من نفور يصعب معه التذوّق والشعور فضلًا عن الطاعة والامتثال.
ولعلّ ترعرع الأستاذ كولسون في بيئة القانون الوضعي مدى حياته جعله يميل إلى أن التشريع الحقّ هو ما كان على شاكلة التشريع الوضعي من حيث البنية والأسلوب، وأن منهج القرآن في التشريع منهج قاصر لا يلامس المشكلات الواقعية بشكلٍ مباشرٍ، في حين أن أسلوب القرآن وفلسفته في التشريع جعلته يتمتّع بخصائص عظيمة تتخطّى حدود الزمان والمكان كما تقدّم معنا في مطلب خصائص التشريع، مما لم ولن يرقى إليها القانون الوضعي مهما بلغ تحديثه وتطويره بين الفينة والأخرى، والواقع أعظم الشهود من خلال ما نراه من فشل القوانين الوضعية في حَلِّ عدد من الأزمات والمشكلات القانونية التي خرجت عن السيطرة ولا تزال كذلك، في حين أن في زمن تطبيق التشريع عبر التاريخ الإسلامي كانت مثل هذه الأزمات المستعصية في الوقت الراهن أَيْسَر لاحتوائها وتقويم اعوجاجها.
مقارنة التشريع القرآني بالتشريع الإنساني:
إنّ غياب النظرة التكاملية في مقاربة كولسون للتشريع القرآني وتأثره بالتقنين الوضعي جعله يحاكم التشريع القرآني للتشريع الوضعي بين الفينة والأخرى، وبمعنى آخر فهو يقارن بين التشريعَيْن ثم يقرّر بناء على هذه المقارنات مضامينَ مرتبطة بالتشريع القرآني والمشكلات التي يراها متجسّدة في هذا التشريع، في حين تعتبر هذه المقارنات التي يجريها كولسون في هذا الطرح وإن كانت خفية لا تصحّ جملة وتفصيلًا لأمور عدّة من أبرزها ما يأتي:
أولًا: اختلاف الأصول والمآخذ:
إنّ اختلاف أصول التشريعَيْن القرآني والوضعي لا تسمح بأيّ حال بالمقارنة بينهما أو بالأحرى استخلاص مضامين حول التشريع القرآني في ضوء رؤيته من زاوية القانون الوضعي وإبراز مخرجات متجسّدة في تقريرات وإشكالات، ذلك أن أصول القانون الوضعي بصفة عامة هي نتاج للبشر سواء القديم منها أو الحديث، ولو أخذنا على سبيل المثال القانون المدني الفرنسي فإن أصوله تتمثل في:
- «القانون الروماني: الذي كان معمولًا به في مديريات الجنوب من فرنسا إلى سنة 1785م.
- القانون الجرماني: وكان معمولًا به في شمال فرنسا، وتفرّع عنه قانون العوائد الذي كان معمولًا به أيضًا في مديريات فرنسا.
- القانون الكنائسي: وهو قانون الكنيسة الكاثوليكية.
- قانون الملكية المطلقة: الذي وُجد بأوامر لويس الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر.
- قانون الثورة: التي قرّرت حقوق الإنسان.
وهذه القوانين ساعدت على عمل وحدة قانونية جُمِعَت سنة 1804م، وهو القانون الموجود الآن في فرنسا 1926 –وإنْ غُيِّر، وبُدِّل، وزِيد، وأُنقِص، وهو المعروف بـ(كود نابليون)»[42].
أمّا أصول التشريع الإسلامي فإنها تتمثّل في القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للتشريع، حيث أرسى القواعد العامة عقيدةً وعبادات ومعاملات، وبيَّن الأُسس وأوضح الفرائض وجاء بالأوامر والنواهي تبيانًا لكلّ شيء، من خلال وضع الخطوط الكبرى لِما يصلح حال الناس دينًا ودُنيَا، ثم السنّة النبوية باعتبارها الأصل الثاني للتشريع إمّا مؤكدة، أو مبيِّنة ومجلِّية لمعاني القرآن، أو شارحة لألفاظه، أو مُنشِئة لتشريعات جديدة، وذلك بعد أن أُخضعت للشروط والضوابط التي وضعها المحدِّثون لتمييز الصحيح من الضعيف.
وكذلك الإجماع باعتباره أصلًا من الأصول المعتبرة في التشريع الإسلامي فيما يقرّره من أحكام، وماهيته «اتفاق أهل الحلّ والعقد من هذه الأمّة على أمر من الأمور، ونعني بالاتفاق: الاشتراك، إمّا في القول أو في الفعل أو الاعتقاد، وبأهل الحِلّ والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية، بأمر من الأمور: الشرعيات والعقليات والعرفيات»[43]، ولا بدّ في هذا الإجماع أن يستند لدليل معتبَر، ثم القياس الذي يأتي في المرتبة الرابعة من أصول التشريع الإسلامي، وهو «إثبات حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علّة الحكم عند المثبت»[44].
وعليه، فلا يمكن أن نجعل التشريعَيْن القرآني السماوي والوضعي البشري في ميزان واحد والمقارنة بينهما؛ إِذْ أصل الأول هو ربّ البشر، وأصل الثاني ثُلّة من التّجارب القانونية التي وضعها البشر عبر التاريخ.
ثانيًا: اختلاف صياغة التشريع وتنفيذه:
وهذا الاختلاف أيضًا يُسهِم في بيان أن المقارنة بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي لا تصح؛ ذلك أنّ عمل التشريعين يختلف جذريًّا، فالقانون الفرنسي الذي هو محلّ التمثيل باعتباره من أشهر القوانين فإنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم للبرلمان مشروع قانون، ويجوز لأيّ شيخ تقديم اقتراح بقانون... ثم ينتقل للمجلس الثاني فإِنْ صادق عليه أصبح قانونًا... بالإعلان عليه في الجريدة الرسمية... ويتولّى تطبيق القانون القوَّةُ التنفيذية بوضع قواعد التنفيذ، وتتولّى تنفيذ الأحكام القضائية بالقوّة الجبرية»[45].
أمّا في التشريع الإسلامي فإنّ تغيير حكمٍ ما أو إصدار حكمٍ معيَّن سواء لجلب مصلحة أو دفع ضرّ، فلا بد من معرفة أين مقام هذا الحكم؟ فإن كان في أصل الأحكام القطعية وقواعد الدين فلا تعديل أو تغيير، أمّا إن كان في الشقّ الثاني من التشريع الذي هو مرتبط بالفروع ومحلّ للاجتهاد فلا حرج في زيادة تقنينه أو تطويره بما يخدم المسلمين، شريطة ألا يتصادم مع أصول الدين التي هي بمثابة قواعد للإسلام. والمسؤول الأول عن التنفيذ هو وليّ أمر المسلمين ومن عينهم من الولاة.
ثالثًا: اختلاف قوّة التشريعات:
حيث نجد القوانين الوضعية كيفما كانت تنقسم إلى قسمين: «قوانين حتمية، ولا يمكن لأيّ شخص الاتفاق على مخالفتها لتعلّقها بالصالح العام أو الآداب العامة. وقوانين مبيحة تفسيرية أو تكميلية، وهي التي ترتّب النتائج القضائية على اتفاقات الأشخاص عند اختلاف وجهة نظر المتعاقدين، ويمكن للمتعاقدين اشتراط ما يخالفها، وهذا كتطبيق القانون المدني في العقود والالتزامات»[46].
أمّا التشريع الإسلامي فقوانينه منها ما هو «حقيقة حتمية، ولا يمكن لأحد الخروج عليها ولا الاتفاق على ما يخالفها؛ كالربا، والزنى، واللواط، والميسر... إلخ، فلا يمكن لأحد التعاقد على مخالفة ذلك، ولا يقتصر المنع على عدم الصحة أو البطلان أصالة، بل لو اعتقد المتعاقدان أو أحدهما حِلّ ذلك كَفَر، وخرجَ عن الدِّين.
أمّا القوانين المبيحة فهي التي في نصوصها اجتهاد، وليس النصّ فيها قطعيًّا في الدلالة على نفس الحكم؛ فيجوز مخالفتها بما لا يخالف كتابًا أو سنّة أو إجماعًا، وذلك كمواضع اختلاف المجتهدين»[47].
وما قيل باختصار في اختلاف أصول التشريع واختلاف الصياغات واختلاف القوة التنفيذية للتشريعين، يُقال أيضًا في اختلاف الخصائص والتطبيقات والعقوبات، والإلغاءات... وغيرها من مواطن الاختلاف بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي؛ لذلك فإنّ المقارنات التي كان يجريها كولسون من طرفٍ خفيّ بين التشريعَيْن قد أفرزت مجموعة من المضامين والخلاصات والتقريرات لا يمكن التّسليم بها.
وفي نهاية هذا الشقّ المتعلّق بالمنهج فإني ارتأيتُ الإشارة لأمر مهم جدًّا لا يتعلّق فقط بمقاربة كولسون القانونية التي اعتمدها، ولكن هو أعمّ من ذلك ليشمل كلّ الرؤى المنبثقة عن العلوم الاجتماعية والإنسانية التي نشأت في البيئات الغربية، وهي في حدّ ذاتها ليست محلّ اتفاق أصالة، سواء في أُسسها أو مسالكها أو غاياتها، ودليل ذلك ما نراه من تباين عظيم يطال المخرجات التي تبلغ درجة الخلاف الحاد، فضلًا عن الإشكالات التي تعتري مكامنها.
وقد رصد نصر محمد عارف أهم الإشكالات التي أُنيطت بالعلوم الاجتماعية والإنسانية وشكلت عائقًا أمام المخرجات التي تقدّمها نهاية كلّ دراسة ومن ذلك:
- عدم القابلية للتجريب أو إعادة تصوير الأحداث بصورة متكاملة كما هو الشأن في العلوم البحتة.
- عدم القدرة على التعميم، حيث تظلّ النتائج المتوصّل لها نسبية لا يمكن فصلها عن الزمان والمكان والثقافة والتاريخ.
خاتمة:
وختامًا للمقالة الأولى وانطلاقًا مما سبق يتضح لنا أنّ موضوع التشريع القرآني من أكثر المواضيع التي شغلت بال المستشرقين، مما جعلتهم يشتغلون عليها بوفرة في أبحاثهم ودراساتهم الأكاديمية الجماعية أو المستقلة، وتزداد الجهود المبذولة نحوه يومًا بعد يوم بغية نفيه، باعتباره هو المنطلق الأول والحجر الأساس الذي تُبنى عليه حياة المسلمين.
واتضح أيضًا أنّ الاستشراق الحديث عَرَفَ تغيُّرًا جذريًّا على مستويات عدّة بالمقارنة مع الاستشراق الكلاسيكي، أبرزها المناهج المعتمدة والمسالك المتخذة في دراسة الخطاب القرآني؛ كدخول العلوم الإنسانية والاجتماعية حيّز العمل بما هو معهود في الحقل الأكاديمي.
كما تبيَّن لنا أنّ المستشرق الإنجليزي كولسون كان له منهج خاصّ منبثق عن التخصّص القانوني الذي وظّفه في دراسة التشريع القرآني، على عكس باقي المستشرقين الذين كانوا يعتمدون على رؤى ومناهج تنبع من الدراسات التاريخية وفقه اللغة كما هو شأن أستاذه شاخت الذي انتقده وكولدزيهر من قبلهم.
وأنّ كتاب كولسون الموسوم بـ(في تاريخ التشريع الإسلامي)، شكّل مركزية مهمّة في المكتبة الاستشراقية والعربية الإسلامية جرّاء عوامل تمثّل أبرزها في تخصصِ كولسون في القانون وامتلاكِ آلته مع العناية به تدريسًا وبحثًا، واطّلاعهِ الواسع على مصادر الفقه الإسلامي وتاريخه وتطبيقاته، ونَأْيهِ عن الأسلوب الكلاسيكي للاستشراق الذي اتّسم بالتحقير المباشر إلى أسلوب هادئ وجذّاب لكن يعدّ الأخطر؛ لأن الأول ظاهر يسهل اكتشافه والثاني مخفيّ يصعب إدراكه.
وأنّ رؤية كولسون للتشريع القرآني من زاوية قانونية صِرف جعلته يقرّر المشكلات التي يعاني منها هذا الشقّ من التشريع في نظره، وهي: أنّ العلاقة القائمة بين التشريع القرآني والقانون الجاهلي هي علاقة قوية تكاملية، حيث قصدت التشريعات القرآنية تغيير جزئيات من القانون القبَلي السائد قبل نزول القرآن. وأن التشريع القرآني يفتقر للإجراء العملي جرّاء الإفراط في التركيز على الجانب الخُلقي مما طرح عدّة إشكالات مرتبطة بتطبيق التشريعات التي جاء بها الخطاب القرآني. وأنّ التشريع القرآني يعاني من مشكلة عدم الاستقصاء مما أدى إلى فراغ تشريعي في عدد من القضايا المطروحة وعدم الإشارة لها ولو من طرف خفيّ.
كما برز أيضًا أنّ مقاربة كولسون للتشريع القرآني قامتْ على أُسس عدة لا تخرج عن مرتكزات الحركة الاستشراقية بصفة عامة، وهي: إهمال المصادر الأصلية، واعتماد المناهج المادية والمقاييس الوضعية، وأن المنهج الذي وظّفه في دراسة التشريع القرآني منهج غير جادّ، ودليل ذلك المخرجات التي وصل إليها في نهاية دراسته لهذا الشقّ من التشريع، مما جعل عددًا من المؤاخذات والانتقادات توجّه إليه، ومن أبرزها: أن المنهج القانوني المعتمد جعل الرؤية التكاملية غائبة لدى كولسون لفهم التشريع القرآني وظلّت زاوية النظر ضيقة جدًّا، وأنّ تأثّره بالقانون الوضعي إلى حدّ كبير جعله يحاكم التشريع السماوي إلى التشريع الوضعي الإنساني.
وعليه، فإنّ الوقوف على رؤية كولسون للتشريع القرآني وتحليلها وبيان ماهية المنهج الذي وظّفه في بلورتها يُحيلنا بشكل مباشر على المعرفة التي وظّفها كولسون في بناء رؤيته، سواء تعلق الأمر بالمفاهيم أو الأساليب والمضامين أو الأمثلة والاستشهادات، وهو ما ستُعنى به المقالة الثانية.
[1] مستشرق ألماني متخصّص في الفقه الإسلامي، وُلد سنة 1902م في ألمانيا. ودَرَس الفيلولوجيا الكلاسيكية، واللاهوت، واللغات الشرقية، في جامعتي برسلاو وليپتسك. وحصل من جامعة برسلاو على الدكتوراه الأولى في 1923م. وبعد أن حصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة، عُيّن في 1925م مدرسًا في جامعة فرايبورج (في برسجاو، جنوب غرب ألمانيا)، حيث صار في 1929م أستاذًا ذا كرسي... وفي 1934م انتُدب للتدريس في الجامعة المصرية (جامعة القاهرة حاليًا) لتدريس فقه اللغة العربية واللغة السريانية بقسم اللغة العربية بكلية الآداب. واستمر أستاذًا في الجامعة المصرية حتى 1939م. ولمّا قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939م انتقل من مصر إلى لندن، ولم يَعُد إلى وطنه الأصلي ألمانيا بعد انتهاء الحرب في 1945م، ثم ترك بريطانيا في 1954م، وعين أستاذًا في جامعة ليدن (هولندا)، حيث استمر حتى 1959م. وفي ليدن اشترك في الإشراف على الطبعة الثانية من (دائرة المعارف الإسلامية). وفي خريف 1959 انتقل إلى نيويورك حيث عُيّن أستاذًا في جامعة كولومبيا، واستمر في هذا المنصب إلى أن توفي في أول أغسطس 1969م. وإنتاجه العلمي يدور حول دراسة مخطوطات عربية، وتحقيق نصوص مخطوطة في الفقه الإسلامي، ومؤلَّفات ودراسات في الفقه الإسلامي... موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة 1993م، ص366.
[2] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، مراجعة: حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، ص5.
[3] المستشرقون الناطقون باللغة الإنجليزية؛ دراسة نقدية، عبد اللطيف الطيباوي، ترجمة وتقديم: قاسم السامرائي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 1411هـ- 1991م، ص105.
[4] إنّ الغرض هو الوقوف التام على الخطوط العريضة المشَكِّلة لرؤية كولسون للتشريع القرآني من خلال نصّ كلامه، وليس الغرض التحليل والمناقشة؛ لأن هذا الأخير سيأتي في المواطن المخصصة له.
[5] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص35.
[6] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص37.
[7] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص35.
[8] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص39.
[9] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص40.
[10] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص40.
[11] مستشرق مجري، وُلِد في أسرة يهودية سنة 1850م، عُرف بعدائه الشديد للإسلام، وكان كثير الإنتاج ضده منذ صِغره حتى عُدّ من أكثر المستشرقين تأليفًا وتحقيقًا، تلقّى تعليمه في عدة جامعات؛ منها بودابست وبرلين...، وظفر بالدكتوراه الأولى سنة 1870م، وقد زار عددًا من البلدان العربية، من أبرزها القاهرة، وأقام فيها مدة يحضر محاضرات ودروس العلماء والمشايخ، وقد أحرز شُهرة كبيرة في وطنه، تتلمذ على يده كبار المستشرقين وبخاصّة لمّا صار أستاذًا للّغات الساميّة سنة 1892م، كما شغل عددًا من المناصب الدولية التي لها صِلة بالمجال الأكاديمي، وقد تميزت أعماله بميزتين؛ الأولى: أنه كان ينهج في أبحاثه منهجًا استدلاليًّا لا استقرائيًّا، أمّا الثانية: فقد كان يعتمد على الوجدان والبصيرة، حيث كان بارعًا في كلّ ما يتصل بالمقارنات براعة عظيمة، فكان مرهف الإحساس بما بين المذهب الواحد والمذهب الآخر من فروق ودقائق، وهو من محرري دائرة المعارف الإسلامية، ومن أبرز إنتاجاته: العقيدة والشريعة في الإسلام، ومحاضرات في الإسلام، واتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين. موسوعة المستشرقين، عبد الرحمن بدوي، دار العالم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة 1993م، ص197- 198- 199.
[12] تجدر الإشارة أنّ الوحي القرآني بصفة عامة لم يسلم من تنقيص المستشرقين وتهكمهم عليه في كتاباتهم؛ إِذْ نجدهم يضعون كلّ الآراء والمواقف والاحتمالات للتشكيك في مصدرية القرآن؛ فتارة يقولون إنه حالة مرَضية أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يصفون الوحي بالشعوذة والتّكهُّن، وأنه ضربٌ من ممارسة العرافين، وتارة بأنه تجلي الأحوال الروحية أو أنه -صلى الله عليه وسلم- عاش تجربة دينية خاصة، إلى أن قالوا بعد حين بما يعرف بنظرية النبوغ والعبقرية البشرية، وهذا الوحي إذا لم يسلم من تعنّت جُلّ المستشرقين فكيف الأمر بالتشريع الذي هو محل البحث والدراسة! ينُظر: الرُّؤيَة الاسْتشراقِيَّة للوَحِي القُرْآنِي: نَظَرِية النُّبُوغِ نَمُوذَجًا؛ دراسة تحليلية نقدية، يوسف عكراش، مختبر دراسات الفكر والمجتمع، جامعة شعيب الدكالي، الرباط، الطبعة الأولى 2023م، ص45.
[13] المستشرقون الناطقون باللغة الإنجليزية؛ دراسة نقدية، عبد اللطيف الطيباوي، ترجمة وتقديم: قاسم السامرائي، ص105.
[14] حول الاستشراق الجديد مقدمات أولية، عبد الله بن عبد الرحمن الوهيبي، ص43.
[15]صناعة الآخر المسلم في الفكر الغربي المعاصر من الاستشراق إلى الإسلاموفوبيا، المبروك الشيباني المنصوري، ص35.
[16] صناعة الآخر المسلم في الفكر الغربي المعاصر من الاستشراق إلى الإسلاموفوبيا، المبروك الشيباني المنصوري، ص35.
[17] العقيدة والشريعة والإسلام، إجناس كولدزيهير، نقله إلى العربية: محمد يوسف موسى، وعبد العزيز عبد الحق، وعليّ حسن عبد القادر، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1946م، ص37.
[18] نقد الخطاب الاستشراقي، ساسي سالم الحاج، دار المداد الإسلامي، الطبعة الأولى 2002م، (2/ 209).
[19] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص35- 36- 37.
[20] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص38.
[21] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص36.
[22] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص31.
[23] ينظر كتاب: تاريخ القرآن، للمستشرق الألماني تيودور نولدكه: ترجمة وقراءة نقدية: رضا محمد الدقيقي، الطبعة الأولى، الدوحة 1430هـ- 2009م، ج1.
[24] نقد الخطاب الاستشراقي، ساسي سالم الحاج، (2/ 226).
[25] نقد الخطاب الاستشراقي، ساسي سالم الحاج، (2/ 227).
[26] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص35- 36- 37.
[27] مناهج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن الكريم، حسن عزوزي (بدون معطيات)، بحث منشور على الإنترنت، ص13.
[28] مناهج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن الكريم، حسن عزوزي، ص25.
[29] مناهج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن الكريم، حسن عزوزي، ص33.
[30] قوانين الألواح الاثني عشر الرومانية صدرت في روما القديمة، وتمثل مرحلة مبكرة في تطور القانون الروماني. ينظر: في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص31.
[31] لا أقصد هنا بالمنهج تِلكم المناهج العلمية المعهودة في الدراسات؛ كالمنهج الاستقرائي والوصفي...، لكن حسبي من مصطلح المنهج هنا: «الطريق المؤدي إلى الكشف عن حقيقة العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل، وتحدّد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة»، ينظر: مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات الكويت، الطبعة الثالثة 1977م، ص5.
[32] العلوم الإنسانية بين الإسلام والغرب، محسن صالح، مجلة الحياة الطيبة، جامعة المصطفى العالمية- فرع لبنان، العدد 26، ص149.
[33] العلوم الإنسانية بين الإسلام والغرب، محسن صالح، مجلة الحياة الطيبة، العدد26، ص149.
[34] العلوم الإنسانية بين الإسلام والغرب، محسن صالح، مجلة الحياة الطبية العدد 26، ص149.
[35] العلوم الإنسانية بين الإسلام والغرب، محسن صالح، مجلة الحياة الطبية العدد 26، ص149.
[36] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص41.
[37] في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص41.
[38] مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، مؤلف جماعي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1985م، ورقة محمد سليم العوّا بعنوان: النظام القانوني الإسلامي في الدراسات الاستشراقية المعاصرة دراسة لمنهج المستشرق نويل ج. كولسون، (1/ 265).
[39] مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، مؤلف جماعي، ورقة: محمد سليم العوا، ص41.
[40] ينظر: في تاريخ التشريع الإسلامي، ن.ج. كولسون، ترجمة وتعليق: محمد أحمد سراج، ص38.
[41] مصادر الشرعية الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية، علي جريشة، مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة، 1407هـ- 1987م، ص10.
[42] المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله عليّ حسين، دراسة وتحقيق: محمد أحمد سرّاج، وعليّ جمعة محمد، وأحمد جابر بدران، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى 1421هـ- 2001م، (1/ 63- 64).
[43] شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدين القرافي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى 1436هـ- 2011م، ص291.
[44] شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدين القرافي، ص342.
[45] المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله عليّ حسين، (1/ 84).
[46] المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله عليّ حسين، (1/ 82).
[47] المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله عليّ حسين، ص82- 83.


