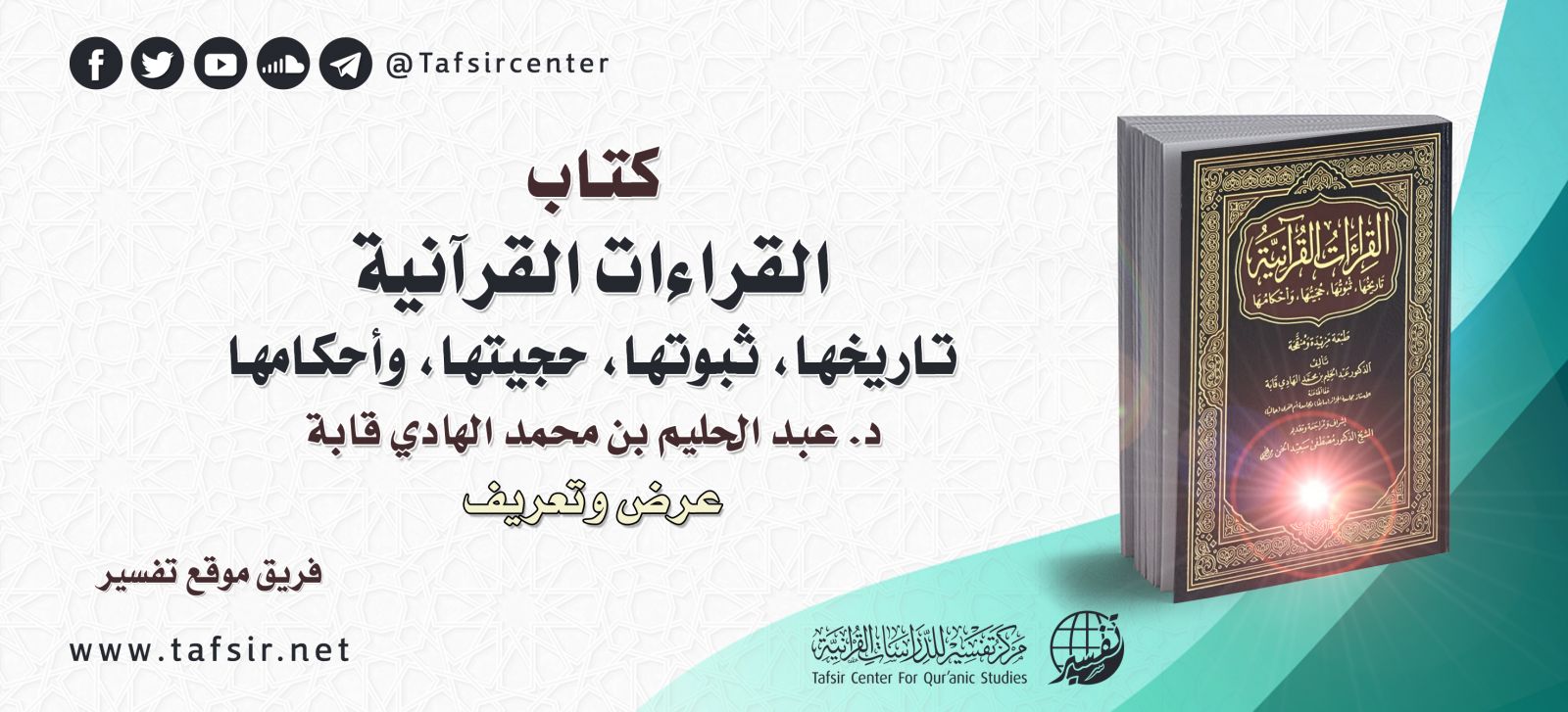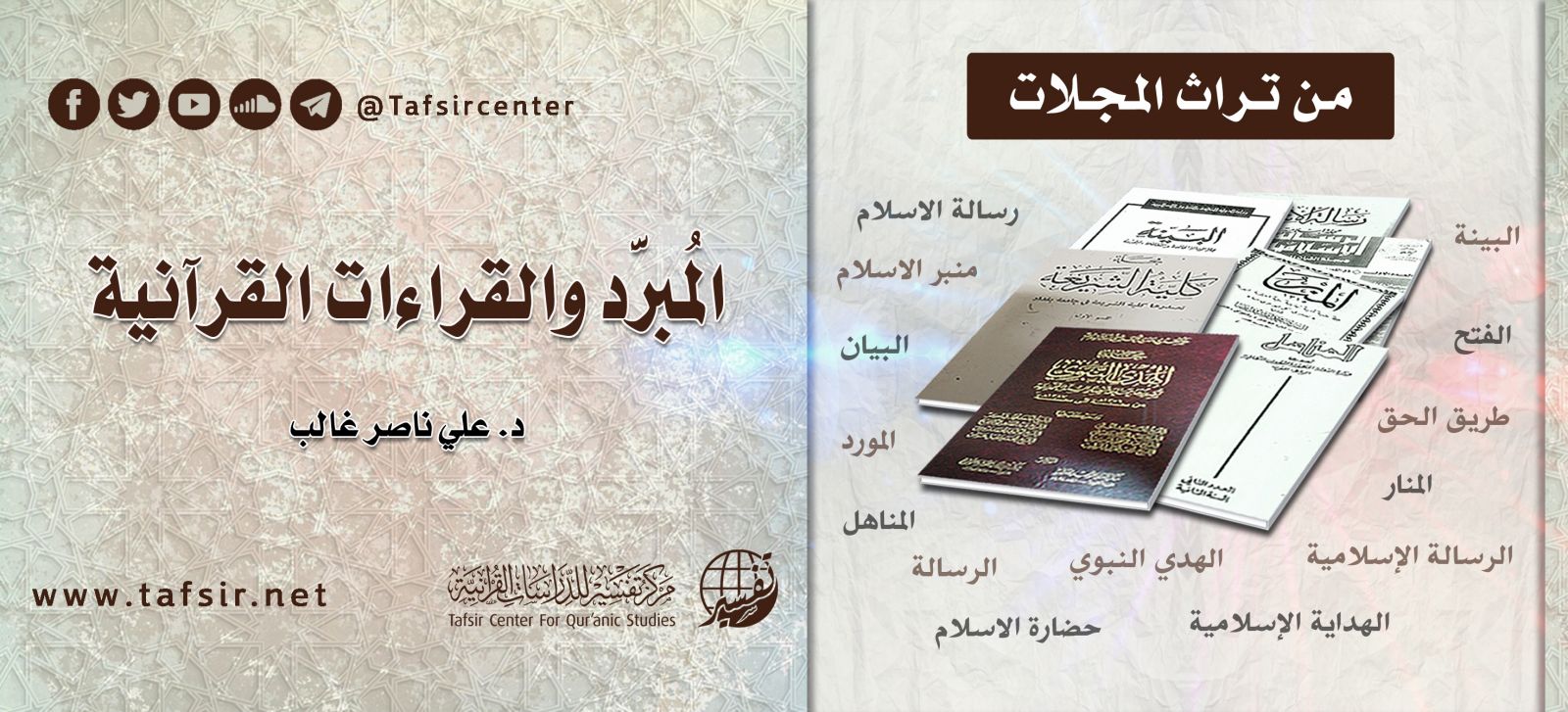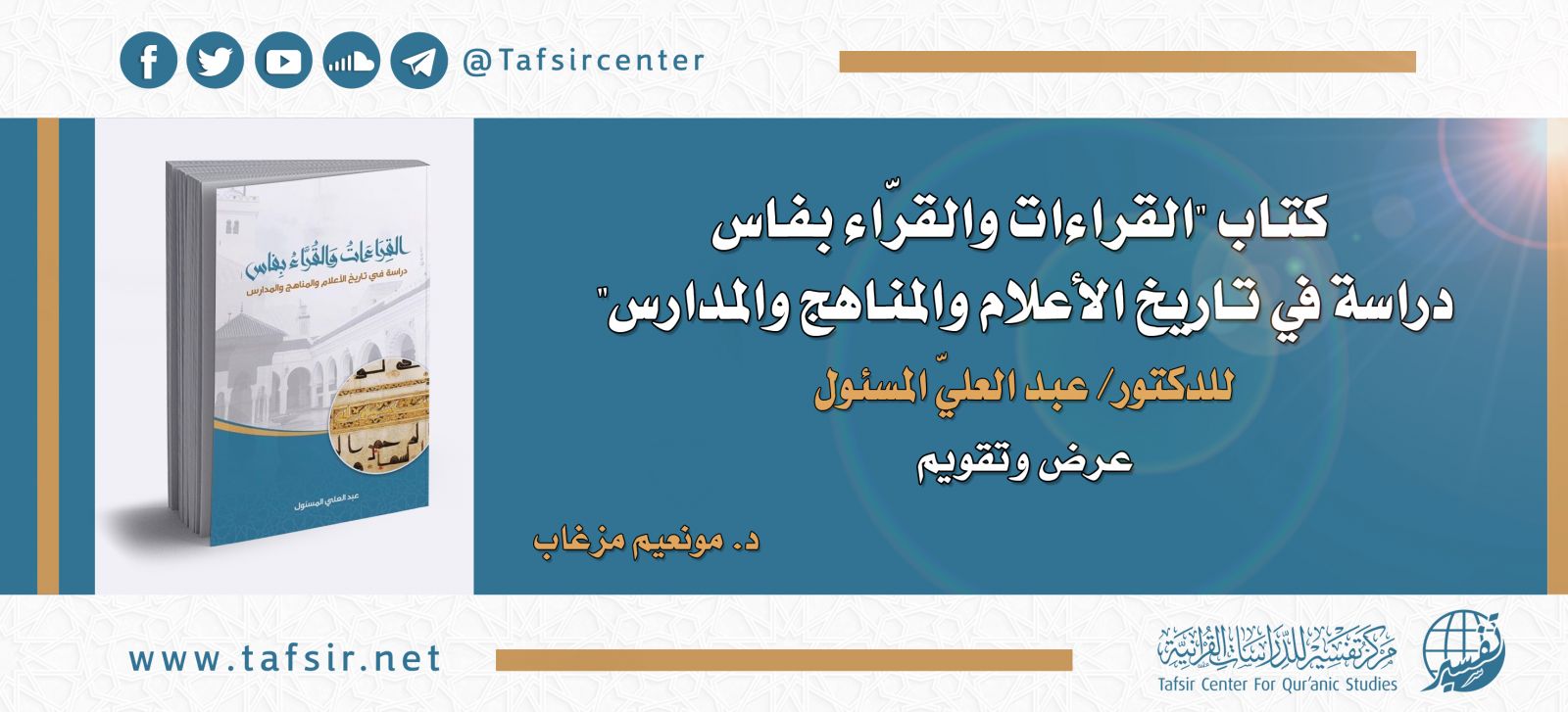القراءات الحداثية للقرآن (6)، يوسف الصديق والقراءة الفلسفية للقرآن
القراءات الحداثية للقرآن (6)، يوسف الصديق والقراءة الفلسفية للقرآن
الكاتب: طارق محمد حجي

ثمَّة عددٌ من الصعوبات التي ربما قد تُثيرها قراءة خطاب المفكِّر الفرنكفوني يوسف الصديق (1943) ضمن «القراءات الحداثية للقرآن»، وفقًا لتلك المُحدِّدات التي وضَّحناها في مقال المدخل[1]، حيث إنَّه من الصعوبة بالأساس تسييق فكر الصدّيق في تاريخ التعامل العربي الحداثي مع النصّ القرآني، فأستاذُ الفلسفة بجامعة السوربون لا يَرْبِطُ نفسه بصورة واضحة بهذا التاريخ استمرارًا أو تقويمًا أو تجاوزًا، مثلما يفعل نصر أبو زيد أو الشرفي أو أركون أو حتى فضل الرحمن، بل إنَّه يبدو وكأنه يبدأُ من نقطة صفر محضة في التعامل مع القرآن، لا في مواجهة التقليد التفسيري الطويل فحسب، بل وكذلك في مواجهة التراكم الفكري الحداثي الذي لا يتعرّض له إلا عَرَضًا في مقدّمة كتابه الأهمّ «هل قرأنا القرآن؟ 2006»، ما يجعل من الصعوبة بمكان ربطه بهذا السياق وانعطافاته الحاسمة التي اعتبرناها أحد المُحدِّدات الرئيسة للقراءات الحداثية، كسياق معرفي مُنشِئ لها، ينضاف إلى هذه الصعوبة الشديدة صعوبة أخرى تتعلّق بالمنهج الذي يتوسَّله الصدّيق في قراءته للقرآن، فرغم حضور مناهج حديثة بالفعل مثل الفيلولوجي والأنثروبولوجي ودراسة الأساطير، بل وحتى الأديان المقارنة داخل عدّته المنهجية المُشغَّلة على القرآن؛ ممّا برَّر للجميع وضعه ضمن سياق القراءات الحداثية[2]، إلا أنَّ كلّ هذه العدّة المنهجيّة لا تستطيع أن تُقلِّل من كون الحضور الأقوى منهجًا وغاية عند الصدّيق هو للفلسفة وتحديدًا للفلسفة اليونانية بنسقها الخاصّ من العقلانية قبل الحديثة، وهذا لا يجعل قضية المناهج الحديثة وحدها هي الإشكالية في خطاب الصديق، بل تصير مسألة «الحداثة» في خطابه إشكاليّة!
لكن رغم هذه الصعوبات إلا أنَّنا نظنُّ أنَّ دراسة الصديق في إطار دراسة «القراءات الحداثية للقرآن» يظلُّ لها مبرّرها وأهميتها حتى من منظور تلك المُحدِّدات التي ضمَّنَّاها مدخل هذه المقالات والمُتَعلِّقة بالمنطلقات والمناهج والرهانات والسياقات المعرفيّة المُنشِئة للقراءة الحداثية، وهذا لكون خطاب الصدّيق -ورغم ما ذكرنا من صعوبات- يُمثِّل من ناحية خاصة تكثيفًا لعدد من الملامح والمُحدِّدات الرئيسة للقراءات الحداثية للقرآن.
فمثلًا في قضية التعامل مع التراث التقليدي التفسيري، نجدُ أنَّ تعامل الصديق يُكثِّفها ويعطيها أبعادًا أقصى -وربما حتى أكثر عنفًا- من المعتاد في القراءات الحداثيّة الأُخرى، حيث لا يَعْتَبِرُ الصدّيق أنَّ هذا التراث ضيَّق النصّ أو جمَّد معانيه أو فوَّت بعض مقاصده فحسب على ما يُكرِّر روّاد القراءات الحداثيّة مرة مدينين وأُخرى معتذرين لهذا التراث بحكم سقفه المعرفي وسياقاته، بل يَعتبره خَتَم على أهمّ وأوسع مساحات القرآن ثراءً، وبسبب ما يشبه أن يكون مؤامرة سياسيّة من خليفة أُموي، إنَّنا وفقًا للصدّيق وبعد كلّ هذا التقليد التفسيري الطويل لم نُخطِئ القراءة، ولا حتى قرأنا القرآن قراءة لم تعد صالحة في عصرنا لارتباطها بسياقها الاجتماعي والسياسي وارتهانها لسقفها المعرفي الخاص والنسبي؛ بل إنَّنا وفقًا له (لم نقرأ القرآن بعد) كما هو عنوان ما يعتبره أهمّ كتبه، والذي عدَّله المُعرِّب لصيغة تساؤليّة تلطيفًا كي يصبح «هل قرأنا القرآن، أم على قلوبٍ أقفالها؟»[i]، فكلّ هذه القرون كانت وفقًا له «تلاوة تعبُّديَّة» لا قراءة بالمعنى الدقيق والحقيقي للكلمة، كلّ هذه القرون نحن لم نعامل القرآن إلا من وراء قضبان «محبس ارتُهِن فيه» هو المصحف المُدوَّن بفعل الخليفة الثالث أوّل خلفاء بني أمية!
أمَّا عن انطلاق الصدّيق من الفلسفة والذي لوهلة يبدو وكأنّه خروجًا عن استخدام المناهج الحديثة نحو أُفق عقلاني سابق على الحداثة؛ فإنَّه يعدّ في ظنِّنا -وبعد التدقيق- البلورة الأعمق والأبعد مدى للقراءة الحداثية للقرآن من ناحية المنهج، أو بمعنى أدقّ من ناحية التعاطي مع الحداثة منهجيًّا ومعرفيًّا وجوانيًّا لا نتائجيًّا وبرانيًّا على ما اعتبرناه سابقًا مُحدِّدًا لمنعطف «التأسيس الثاني للنهضة» السياق المعرفي المُنشِئ للقراءات الحداثية؛ حيث تُمثِّل الفلسفة الأساس المعرفي للمناهج الحديثة، فالفلسفة هي الأساسُ الأعمق للعقل الغربي الحديث بكلّ أنواره قيمًا ومناهجًا[3]، فكما يقول الصدّيق كان أساتذة الفلاسفة الذين درَّسوه في سوربون الأيام الخوالي هم من أرشدوه لتاريخ العقل الغربي (ومعارج الوعي الأوروبي أساسًا في تدرّجه البطيء، مُنطَلِقًا من بؤسه إلى أن بلغَ انتصار الروح فيه)[ii]، وكما يقول أيضًا فالقرآن وبقراءته فلسفيًّا يُمكِّننا من تتبع (هذا الخيط الرفيع الذي عملت المؤسسة التفسيريّة على إخفائه، وعلى امتداد هذا الخيط يوجد مجرى الفكر القادر على الالتحاق بالفكر الكوني والتواصل مع آونته الحاسمة)[iii]، إنَّ القرآن لا يُقرأُ هنا في خطاب الصدّيق من أجل توطين لبعض القيم الحديثة فيه، أو من أجل توطين الحداثة معرفيًّا في العقل العربي عبر اختراق مناهجها لأخصّ مساحات العقل والوجدان على ما هو أقصى طموح رهانات نصر والشرفي كما عرضنا سابقًا؛ بل يُقرأُ من أجل إظهار اتصال هذا القرآن بالفلسفة اليونانية -وهو الاتصال المنسيّ وفقًا له غربًا وشرقًا- التي تُمثِّلُ العُمقَ المعرفي المُؤسِّس لأرقى ما في العقل الغربي الحديث بكلّ قيمه وأُسسه ومناهجه.
كذلك فالصديق يوافق، بل دعنا نقول: إنَّه يُكثِّف بصورة كبيرة بعض الرهانات الأساسية للقراءة الحداثيّة للقرآن، مثل رهان التأويل الفردي والتعامل مع القرآن وجهًا لوجه، قراءة القرآن «كأن شيئًا لم يكن» (كما لو أنَّ صيغة الأمر «اقرأ» وقد تفتَّق عنها في يوم من سنة 610م وحي تَنَزَّل على رجل مكي في الأربعين يُقال له محمد، لم تُوجَّه لقارئ غيري أنا)[iv] ، بل إنَّنا نستطيع القول أنَّه ورغم إعلان هذا الرهان عند كثير من روّاد الكتابات الحداثية، مثلًا الشرفي واهتمامه الكبير بالبعد الفردي في الدّين حدّ كونه أحد مستويات دلالة مفهوم «إسلام»، إلا أنَّنا لا نجدُ عندهم تعميقًا وإلحاحًا على هذا الرهان مثل الذي نجدُ عند الصدّيق، والذي يتخلّل خطابه على الدوام محاولات تفكيك واسعة لما يعتبره «سلطة تفسيريّة» تصلُ بجذورها إلى الخليفة الثالث كما سنوضح، تفرض للقرآن تأويلًا أحاديًّا من قبل وساطة الراسخين في العلم «رجال الدين» المأذونة [v]، يقومُ بهذا عبر بعض التأويلات منها قراءة مختلفة لآية آل عمران: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}[آل عمران: 7]، مفادها أنَّ التأويل الموصوف بالزيغ هو هذا التعسّف للرأي الأحادي وادعائه امتلاك حقيقة «الكتاب الممتنع» أو «أم الكتاب»[vi]، فالصدّيق يعتبر أنَّ علينا اختراق كلّ هذا التراث التفسيري من أجل التعامل مع القرآن وكأنَّه يُخاطب كلّ فرد فينا كأنه فلكيٌّ يطَّلِع نجوم السماء، فالمعنى -وفقًا للصدّيق- هو بناء مشترك في تلك المساحة أو الفجوة بيننا وبين الله.
كذلك وأخيرًا، فإنَّ فكرة أساسية ومحورية في القراءة الحداثيّة أي مسألة «ختم الوحي من الخارج» بتعبير الشرفي، والتي تعني -وفقًا لهذه القراءة- أنَّ النبوّة المحمدية أنهت النبوة عبر النبوة لتحرير العقل والتاريخ من التدخل الإلهي بعد أن وصلت البشرية الرُّشد، تجد تحريرها الأعمق عند يوسف الصدّيق في أكثر من موضع في كتاباته، وتجد تكثيفها الأكبر في قراءته لسورة الكهف -أو منعطف الكهف على حدّ تعبيره- ذات المركزية الكبرى في تفكيره كما سنوضِّحُ تفصيلًا.
كلّ هذا يجعلُنا نعتبر أنَّ خطاب الصدّيق هو من أهمّ الخطابات التي ينبغي مقاربتها في سياق تناولنا القراءات الحداثية للقرآن، فإنَّ هذا الخطاب وكما يُضاء عبر هذه القراءات حين يُدْرَس في سياقها فإنَّه كذلك يُلقي عليها وعلى مُنطلقاتها وأبعادها ورهاناتها الكثير من الإضاءات المهمّة، ويُكثِّف الكثير من منطلقاتها ورؤاها ويذهب بمناهجها نحو عُمقها المُؤسِّس والأكثر جوانيّة على الإطلاق.
نبذة تعريفيّة بيوسف الصدّيق:
وُلِد يوسف الصدّيق في توزر من بلاد الجريد التونسيّة عام 1943، وتربَّى بالقرب من نهج العطارين؛ حيث كانت مكتبة والده التي نشأ فيها وشاهد عبرها نقاشات والده مع الطاهر بن عاشور، والفاضل بن عاشور، ومصطفى خريف، وغيرهم من أعلام الفكر التونسي الحديث.
حفظ القرآن في الحادية عشرة من عمره، وعلَّمه والده قراءة الشعر القديم، ثمَّ درس في المدرسة الصادقيّة التي تخرَّج فيها الكثير من قادة الفكر في تونس.
في عام 1966، حصل على درجة الماجستير في الفلسفة والآداب والحضارة الفرنسية، ودرس في المدرسة الفرنسية في كومبين في عام 1967، وحصل على درجة ماجستير في الفلسفة في اليونان القديمة.
عمل لفترة كمراسل صحفي؛ فغطَّى الكثير من الأخبار في كثير من البلدان، في السودان، ولبنان، وفلسطين، وإريتريا. ثم سافر إلى فرنسا في الثمانينيات بعد أن زاد المدّ الديني و(أصبح المفكر غير قادر على التنفّس) كما يعبّر، ودَرَس ودرَّس في السوربون، فحصل على الدكتوراه في اللغة اليونانية والحضارة عام 1988، ثمَّ عاد إلى تونس بعد الثورة التونسية في 2011، وحضرَ كثيرًا من الندوات واللقاءات لتوضيح فكره حول القرآن.
ترجم للفرنسية عددًا من الكتب العربية التراثية مثل كتاب البيوع من موطأ مالك، ومثل كتاب الأحلام الكبير لمحمد بن سيرين، ومثل أقوال الإمام علي بن أبي طالب. وترجم للعربية من اليونانية مباشرة قصيدة بارمنيدس، وجمهورية أفلاطون. من أهم ّكتبه أو كتابه المُركّز كما يعتبر هو كتاب «إنَّا لم نقرأ القرآن بعد».
المساحة الهيلينية كمدخل لتأويليّة الصدّيق:
يُشكّل هدف اكتشاف «المساحة الهيلينية في القرآن» على حدّ تعبير الصدّيق، والمنسيّة عربيًّا والمُتجاهَلة غربيًّا، كرهان أساس لخطاب الصديق، بوابة نستطيع من خلالها استجلاء أبعاد هذا الخطاب، والولوج إلى مساحاته التي تتفاوت جلاءً وغموضًا وعمقًا وبعدًا عن العمق، لكنَّنا مبدئيًّا نريدُ تدقيق هذا المدخل ذاته، والإشارة لتأثير هذا الرهان/المنظور على تشكيل رؤى ومُنطلقات الصدّيق، والتنبيه كذلك على أثر هذا الرهان/المنظور على العدّة المنهجيّة المُستلهَمة في القراءة.
فلا بد لنا مبدئيًّا أن نُدرك هذا الفارق بين اشتغال الصديق «لكشف المساحة الهيلينية» وبين بعض الاشتغالات التي قد تبدو شبيهة في اشتغالها به؛ مما يجعل خطاب الصدّيق كثيرًا ما يُقرأُ -في غير دقّة في ظنِّنا- في سياقها، نقصدُ بهذه الاشتغالات اشتغال «كريستوف لكسنبرج» و«آرثر جيفري» على البحث عن المعاجم غير العربية داخل القرآن «المعجم السرياني-الآرامي»، فرغم التشابه الذي قد يُظَنُّ مبدئيًّا بين اشتغالهم واشتغال الصديق بحيث يتمُّ جمعهم في إطار «التحرّي الفيلولوجي للمعجم القرآني» كما هو عنوان دراسة لبسام الجمل[vii]، إلا أنَّ الفارق في الحقيقة كبير[4]؛ فاشتغال الصديق يُعَدُّ في ظنِّنا أعمق كثيرًا سواء من حيث مساحة اشتغاله، أو من حيث تعقيد منهجياته، أو من حيث رهاناته، فالقضية وفقًا للصديق ليست استخدام القرآن لمعجم يوناني في التعبير، مهما اتّسع هذا المعجم (يصل حدّ ثماني مائة كلمة وفقًا للصديق)، ولا حتى عن كون النصّ القرآني هو نسخة عن نصٍّ أصلي كُتِب بلغة أخرى «القرآن الأصل المكتوب بمزيج من لغة آرامية وعربية كما هي فرضية لكسنبرج»؛ بل عن وجود «مساحة» هيلينية حضارية وفكرية وفلسفية ودينية داخل هذا النصّ تُمثِّل إعجازه الحقيقي في الإحاطة بالفكر الكوني السابق وفي الآفاق التي يرسمها للفكر اللاحق، وتشمل مواضيع مثل «الألوهة» و«الإنسان» و«النبوة»، وحتى بعض الطقوس، بالإضافة للتنظيم الجنسي والمدني؛ ممَّا يجعل ما هو محور دراسة لكسنبرج وجيفري مجرّد جزء من عدة منهجيّة أوسع عند الصدّيق، ويجعل ما يبدو لوهلة كاشتغال فيلولوجي تقليدي يقارن بين اللغات والنصوص بحثًا عن «وثيقة أصل» هو اشتغال في حقيقة الأمر على «طبيعة النصّ القرآني»، الذي يَستحيلُ مع تعميق هذه المساحة الهيلينية إلى «قول فلسفي»، ينطلقُ قولًا «كشذرات ما قبل سقراطية»، (يتدفّق فيها الخطاب حين يُطلِقُ فكرة منبعًا لن تنضب قط باستحالتها إلى حكم أو «وصية»، ولَّادة أبدًا لمعاني تتجاوز صياغتها، قادرة دومًا على ريّ مداءات الفكر والإبداع كلّما هدّدها التصحّر)[viii]، ويتقاطع في كثير من مساحاته ونظراته مع مساحات من النصّ الفلسفي اليوناني، خصوصًا تلك التمظهرات فيه المقارِبة للتوحيد، مثل نصوص بارمنيدس وزينوفان وفيثاغورس وأفلاطون.
هذا المنظور الذي يَنطلقُ منه الصدّيق، أي «القرآن كقول فلسفي» كأعمق ما يعنيه بـ«المساحة الهيلينية في القرآن»، هو الذي يُعطي لخطابه ملامحه الخاصة، ويُشكِّل آراءه بسمة خاصة حتى في مقاربة إشكالات طالما تثيرُها القراءات الحداثية كأحد منطلقاتها الأساسية، مثل (القول بجمود المعنى القرآني في المدوّنات التفسيرية، والرغبة في تحريره عبر القراءة الحديثة)، ومثل (موضع إدانة هذه القراءات للتراث التفسيري والمسئولية التي تُحمِّلها له عن هذا الجمود)، فرغم وجود هذين المنطلقين عند معظم القراءات الحداثيّة، إلا أنَّ حضورهما عند الصدّيق يتماشى تمامًا مع خصوصية منظوره هذا، حيث -وانطلاقًا من هذا المنظور- يعتبرُ الصدّيق أنَّ الخطيئة في قراءة القرآن والتي أحالت القراءة بمعناها الخاصّ عند الصديق، والذي يعتبره المعنى الحقيقي للكلمة أي (التفكيك والتركيب المُتجدِّد للوحدات المعنوية، ثمَّ وصلها مع غيرها من المعاني في ذات النصّ، مع تحديد المواقع والشخصيات والإشارات التي احتواها هذا النصّ)[ix]، إلى تلاوة تعبّدية شعائريّة صرفة تُهْدِرُ إمكانات هذا القول الإلهي، تبتدئ أولًا ورأسًا من عملية جمع القرآن وتدوينه مع الخليفة الثالث، فهذه العملية «السياسية» والتي قُصِد منها (مصادرة سلطة القراء، أمناء الذاكرة الشفويّة)، أدَّت فيما يرى الصديق لـ«حبس النصّ القرآني» المُنفتِح أساسًا عبر «اقتصاد الشذرة» على «الشطب/النسخ/الإنساء» -(فلا يكون الحرف بريئًا إلا إذا انفتح على الشطب)[x]-، بتثبيته ماديًّا (وتسليم المنطوق إلى المكتوب)[xi] بتعبير يستعيره الصدّيق من أفلاطون، وقطع الطريق على استعادة (زخم القول الشفوي بسكتاته العميقة والمُمتدَّة)[xii]؛ ممَّا يجعلُ الصدّيق يعتبر أنَّ هذه العملية هي بمثابة عملية قتل للقرآن، قتل قامت به «رؤى عالم البداوة» لهذا النصّ الحضاري ذي الفكر الكوني الحي، ثأر أموي من نبي بني هاشم، أبدل باقتصاد الشذرة مع عميق سكتاتها (وصمتها المُوحِي دائم التَجدُّد) (تسلسلًا بدويًّا) أُريد به محاكاة نموذج الصحراء[xiii] -يقصد ترتيب المصحف- لآيات فقدت في محبسها المصحفي معناها الأعمق، كأثر على حضور إلهي مُتجدِّد، وأبدلت بـ«النمط الرؤيوي في الوحي» (زيارات الملك جبريل برسالة تفصيليّة حرفية مدونة سلفًا)[xiv]، فقتلت معنى أكثر اتساعًا للوحي مفاده كونه «نشدان للتنزيل» من نبي مُفكِّر يسعى لتأمّل عالمه وهو (مُحمَّل بعبء الأمنيات) مُعرَّضًا (لخطر التشوّش والخلط والتسللات الخادعة)[xv] من فجوة بين الإنسان والإله يَمتَنِع وصلها (تنقض منها الشذرات)[5].
عملية القتل هذه والتي ابتدأت بالجمع وما نَتَج عنه من تثبيت تصوّر مُحدَّد للوحي «كإملاء حرفي» تَكرَّست لاحقًا -وفقًا للصدّيق- عبر تثبيت القول بعروبة النصّ القرآني مع الإمام الشافعي[xvi]، فهذا الرأي المُستَقِر لغويًّا وغير القابل للاختراق تفسيريًّا، هذا التثبيت -المُنطَلِق من هيمنة فكرة العروبة سياسيًّا- أدَّى لنفي الاهتمام بالمساحات الحضارية الأُخرى غير العربية داخل القرآن، وقَطَع الصلة بين القرآن وبين الفكر الكوني، وكان أهمّ المُهمَّشين طبعًا «المساحة الهيلينية»، فمع تَبَلور هذه النظرية أصبح المفسّرون يستبعدون أيّة استعانة بالمعجم اليوناني لتفسير كلمات القرآن، بل أدَّى هذا في كثير من الأحيان إلى التعسُّف الشديد في اشتقاق بعض الكلمات التي لا تتفِق مع الاشتقاق العربي وقواعده بسبب جذرها اليوناني -وفقًا للصدّيق- مثل، (لغة، وكوثر، وزُخرُف، وسيماهم، وأبابيل)، هذا فقط هربًا من حرج القول بيونانية هذه الألفاظ لما قد يفتحه هذا من باب البحث في (المسكوت) أي الحضور الكبير لمساحة غير عربية داخل القرآن.
ونحن حين نتحدّثُ عن «مساحة هيلينية في القرآن» كرهان أساس لخطاب الصدّيق، وعن معنى ودلالة مفهوم (القراءة) عنده، يظهر لنا بوضوح كبر هذه العدة المنهجية المطلوبة للقراءة؛ ولكشف هذه المساحة ولتحقيق ما يرتبط ويتشابك معها من رهانات خطاب الصديق، مثل إبراز القرآن كقول فلسفي، وتخليص القرآن من هيمنة التلاوة، وفتح الباب لإنجاز قراءة للنصّ حرّة ومنفتحة وشخصية؛ لذا يستعينُ الصدّيق بعدة منهجية تبتدئ من الفيلولوجي والأركيولوجي مرورًا بتاريخ الأديان وتاريخ الحضارات المقارن والأنثروبولوجي ولا تنتهي عند السرد من أجل تحقيق رهاناته تلك.
وربما من مميزات تأويليّة الصدّيق وحسناتها الكبرى هو أنَّها لم تفعل كمثيلاتها من القراءات الحداثيّة بالتحرّك ما بين محاولة بلورة تأويلية نظرية غالبًا لا تكتمل وبين تأويل لبعض آيات مُحدَّدة لا تكتمل ولا تتماسك هي أيضًا، وإنَّما قامت بإنجاز قراءة لسورة الكهف (أو لنجومها الأساسية)، وهي قراءة تستطيع أن تُضيء لنا الكثير من أبعاد خطاب الصدّيق، وتضعُ يدنا على ملامح أكثر دقّة لتأويليته للقرآن ولنظرته لرهاناتها، وهذا لأنَّ هذه السورة تحديدًا ذات مركزية كبيرة في فكر الصدّيق حيث تُكثِّف مجموعة من الإشكالات المركزية في فكره، مثل قضية الحكم والعقل والرشد الإنساني، كما تُمثِّل باستحضارها قصة الإسكندر ذي القرنين موضعًا خصبًا لتوضيح فرضيته عن المساحة الهيلينية، ولبحث مدى فاعلية المناهج الفيلولوجية واللسانية والأركيولوجية التي يتوسَّلها الصديق، كلّ هذا يجعلُ اشتغالنا على تأويليّة الصدّيق لهذه السورة يصلح أن يكون موضعًا مناسبًا لاكتشاف ملامح وأبعاد تأويليّته بصورة دقيقة.
لنقرأ «مُنعَطَف سورة الكهف»:
يعتبر الصديق أنَّ سورة الكهف سورة مركزيّة ومحوريّة في القرآن الذي يُمثِّل للصدّيق سماء صافية مُمتلِئة بالنجوم؛ لذا فإنَّه يُطلِق على هذه السورة -التي قال البعض عنها أنَّها نزلت كاملة[xvii]- اسم «مُنعَطَف الكهف»، فهي تُمثِّل وفقًا له مُنعَطَفًا حاسمًا، لا في تاريخ النبوة المحمديّة فحسب بل في تاريخ النبوة بأكمله؛ حيث إنَّ هذه السورة -وفقًا للصدّيق- هي التي تُعلِن عن خَتْم النبوة، «خَتْمها من الخارج» لو استخدمنا تعبيرات الشرفي، بوضع (حدّ نهائي لضرورة اعتماد الإنسان على مصدر في المعرفة والسلوك مُستَمَدَّيْن من غير مؤهلاته الذاتية)[xviii]، وإعطاء الإنسان غير النبي الحكم والعلم بعد أن وصل للرشد القادر على الاستغناء عن النبوة والتدخل الإلهي في العالم، (فما أن أعلنَ القرآنُ انقضاء زمن الأنبياء، حتى وضع الفكر الدنيوي لوحده أمام المخاطرة على التَبَصُّر في الكون، وعلى إدراكه ضمن الخطاب المتعقّل ثمَّ على إدراكه من جديد كلما طُمِسَت الحدود وتَعفَّرت المعالم)[xix]، وهذا عبر قراءة خاصّة تمامًا لقصتين واردتين في هذه السورة؛ قصة موسى والعبد الصالح، وقصة ذي القرنين.
فالقصتان -وفقًا للصدّيق- متداخلتان، حيث يُعبِّران عن انتهاء مركزية وأفضلية النبوّة في العلم إذا كان حديثنا عن قصة موسى، والتي يصغر فيها العلم النبوي في حضرة علم بشري (تمهيدًا للانسحاب من العالم والدخول في طور اختتامها مع بعثة محمد)[xx]، وفي الحكم إذا كان حديثنا عن ذي القرنين الذي حكَّمه الله في البشر دون أن يكون له سند من نبوة أو كتاب، وقال إنَّه (مكَّن له في الأرض) تمامًا كما قال عن يوسف الذي ولَّاه خزائن الأرض)[xxi].
وفي الحقيقة هذا التعامل مع قصتي الكهف هاتين تعامل مُعقَّد، ولا بد أن يَحْظَى باهتمام خاصّ انطلاقًا من كون الصدّيق ليس مجرد مفكر أو فيلسوف أو باحث في الأنثروبولوجي، بل هو وبصورة كبيرة صاحب اهتمام سردي كبير[6]، وله مقاربة مختلفة للقصّ القرآني تجعلُنا نَعُدُّها في ذاتها تقنية منهجية في قراءة القرآن تتشارك مع بقية آلياته لإنتاج تلك الرؤى الأساسية عنده، فتحتاج منّا لإضاءة خاصّة.
فإذا كانت نتائج الأركيولوجي ودراسة الأساطير والتواريخ اليونانية حين تُستحضَر في قراءة سورة الكهف هي التي تَقضِي -وفقًا للصدّيق- بكون الإسكندر والذي لُقِّب بذي القرنين كما دُوِّن في معابد الإله آمون في سيوة هو المقصود في هذه السورة -بالرغم ممّا يعتبره الصدّيق مماحكات المفسّرين لاستبعاد كونهما نفس الشخص خوفًا من تنزيل القول القرآني المُستخلِف لعبد من عباد الله على ملك وثني-، وكذلك هي التي تقضي بأنَّ قصة موسى وفتاه المحكيّة في سورة الكهف تُماثِل قصة روتها التواريخ اليونانية عن أحد جنود الإسكندر؛ ممّا يجعلُ من الممكن دمج موسى في هذه القصة، إلا أنَّ هذه النتائج لا يُمكِنُ تأطيرها لتكون صالحة للاشتغال على قصص الكهف إلا عبرَ آلية قراءة معيّنة للقصة القرآنية تستطيع أن تُفسِّر حضور هذه الشخصيات بهذه الطريقة وتُفسِّر هذا الدّمج الذي قام بها السرد القرآني بين شخصيات قصص السورة، موسى وفتاه وذي القرنين والعبد الصالح، فهذا الدمج لا تُفسِّره الأركيولوجي، وكما يبدو فالصديق ليس من مُشايعي القول بأخطاء تاريخية قرآنية.
ونستطيع أن نعتبر (القراءة عبر وحدة السورة)[7] هي مركز آليّة قراءة الصدّيق للقصص، فإذا قُمنا بتسييق قراءة الصدّيق في سياق أوسع قائم على أساس نوع الوحدة القرآنية المُستخدَمة لتفسير القصة، سنعتبرُ الصدّيق يتحدَّث عن «وحدة السورة» كوحدة فاعلة في عملية التفسير[8]، وينعى على المفسّرين السابقين عدم الانتباه لها، عبر هذه الوحدة كمبدأ تفسيري مُحدِّد يستطيعُ الصدّيق تفسير دمج شخصية موسى في إطار قصص الإسكندر وجنوده[9]، والتقريب بين شخصية العبد الصالح (الذي يُعلِّم موسى صناعة الاستنباط التي لم يألفها الأنبياء)[xxii]وأرسطو مُعلِّم الإسكندر، فهذا الدّمج غير ممكن إلا بالمبالغة الشديدة في اعتبار وحدة السورة (تجاوز النبوة وختمها من الخارج، في العلم والحُكْم) فاعلة في تشكيل الشخصيات وفي تكثيف شخصية الإسكندر كـ«ملك فيلسوف» على طريقة أفلاطون، وفي نزعها شخصية موسى عن عالمها القصصي في بقية السرد القرآني (فموسى هذه القصة الذي يتقارب من عالم الإسكندر، ويظهر كزي له أو لبعض جنوده أو كالإسكندر نفسه في مرحلة التتلمذ على أرسطو، هو غير موسى السور القرآنية الأخرى).
وفي الحقيقة نحن نعترضُ تمامًا على هذه الرؤية ومن منظور سردي، فهذه القراءة من الصدّيق والتي تُقرِّب عبر الدمج بين شخصيتي «موسى» «الإسكندر»، تجعل هذه الشخصيات لا تفقدُ فحسب شخصيتها التاريخيّة أو الواقعيّة، بل كذلك تفقدُ حتى شخصيتها القصصية، أو ما يمكنُ تسميته استعارة من إمبرتو إيكو بـ«شخصيتها التخيلية»[10]، فهذه الشخصية التخيلية تكتسب حضورها من القصة ذاتها (من الشرعية التجريبيّة الداخلية غير الممكن التشكيك فيها)، وكلّ ظهور للشخصية (أو هجرة لها في العوالم النصّية) يأتي مُتعالِقًا بعالمها القصصي المُنتزَعة منه، وإلا تفقدُ هذه الشخصية وجودها القصصي ذاته؛ لذا فقراءة الصدّيق بنزعها «موسى» من عالمه القصصي وجعل شبيهه لا «موسى» في السور الأخرى بل «ذي القرنين» في هذه السورة، وبدمجه في قصص الإسكندر وأساتذته وجنوده يُفقِد قصة موسى القرآنية وحدتها ويُفقِد شخصية موسى ملامحها، فيتحوّل القصّ القرآني لتخييل -للمفارقة- خالٍ حتى من أبسط مبادئ التخييل[11]!
أهمية هذا الاستدماج والتقريب بل والمماهاة -غير المقبولة سرديًّا حتى- كبيرة لنا في كشف الكثير من أبعاد خطاب الصدّيق.
هذا لأنَّ هذه القراءة تكشفُ عن كون «المساحة الهيلينية» ليست مُجرد مسألة يُراد اكتشافها كرهان للخطاب؛ بل على العكس إنها تبدو كمُحدِّد ومُنطلَق للقراءة، وهذا يتضح تمامًا في الطرف الغالب في هذه المماهاة، فالصدّيق لا يجعل شخصية الإسكندر هي من تُدمج في قصة موسى والعبد الصالح، بل يجعل شخصية موسى هي من تُدمج في قصة الإسكندر «ذي القرنين»، ويحيلُ العبد الصالح لشبح من أرسطو مُعلِّم الإسكندر، وهذا ليس فقط لأنَّ ثمّة قصة يونانية منسوبة لمؤرخ الملك المقدوني تحكي خبرًا عن أحد جنود الإسكندر شبيه بقصة موسى وفتاه والعبد الصالح في الكهف؛ بل لأنَّ القرآن أقرب في رأيه لليونان منه لتاريخ الأنبياء العبرانيين، فـ«القرآن لم يكن ليقطع مع الرسالة الموسوية أو القول الإنجيلي، بعد أن استكمل مراجعة كلّ عناصر هاتين الرسالتين، إلا ليلتحق باللوغوس، أي خطاب العقلانية في أبعادها الإنسانية»[xxiii]، وهذا لا شك ينسحب على حديث القرآن عن كلّ الأنبياء أو على مراجعة عناصر الرسالتين كما يُعبِّر، فالتاريخ النبوي نفسه لا يُقرأُ في سياق الإبراهيمية التي ينسب القرآن النبوة المحمدية لها، بل يُقرأ في سياق القول الفلسفي اليوناني؛ لذا فإنَّ الصدّيق قدَّم بالفعل قراءته لبعض هذا القصص ولهذه الشخصيات النبوية كصور للعقل اليوناني «خطاب العقلانية في أبعادها الإنسانية».
والأهمّ من قراءته التفصيلية لهؤلاء الأنبياء وقصصهم، المُستنَد التأويلي الذي يُبرِّر به الصديق قراءته تلك، أي نظرة الصديق لـ«الفعل القرآني في سرد هذا التاريخ»، حيث يعتبر الصديق أنَّ القرآن أعاد سردًا تشكيل هذا التحقيب الكوني والنبوي الإبراهيمي «فبات رقيبًا على السرد الأسطوري» كي يرسم «معالم طريق الوصول إلى العقل» عبر «نبوة جاءت للتذكير بأبرز محطات مسار جاءت هي لختمه»، حيث يُشكِّل هؤلاء الأنبياء معالم في طريقٍ مُرتَقٍ نحو التحرّر من ثقل المجاز إلى رحابة العقل ونوره، فآدم قد فشلَ في قراءة المجاز، وإبراهيم تمَّ تدريبه عليه، ثمَّ «موسى الذي يُشكِّل الحلقة الوسطى التي تربط زمنين من النبوة، أولهما ذلك الذي يَدفع فيه الرسلُ بالناس إلى مواجهة خطر مفعول المجاز، وهم العاجزون وقتئذٍ على امتلاك مخارج أفضل. أمَّا الزمن الآخر فقد انطلق مع النبي عيسى، أو المجاز المطلق (الكلمة) الذي انتهى بختمه محمد، وهو زمن يُفترَض بالمعرفة والعقلانية أن تَكشِف فيه خبايا المجاز والمتشابه»[xxiv]، حيث تمَّت مماهاة العقل بالإيمان، والفلسفة في قمتها اليونانية بالدّين في قمته الإسلامية، وجُعِلَ الرّجس على الذين لا «يعقلون» وعلى الذين لا «يؤمنون»[xxv].
أَمَانِيّ الصدّيق:
بهذا الشكّل فإنَّ الحال يتعدَّى مسألة البحث عن «مساحة هيلينية» في القرآن، إننا بالأحرى نتحدّث عن إيجاد مساحة للإسلام وللقرآن داخل الحضارة اليونانية وملوكها وجنودها ولوغوسها وفلسفتها ومسار ترقّي عقلانيتها، هذا ما يجعل أحيانًا حتى أدقّ التفاصيل تُقرأ يونانيًّا، فجمع القرآن يُقارَن بجمع هومير، والقرَّاء أمناء الوحي يُقارَنون بحفاظ الملاحم اليونانية من حُكْم الطغيان، وتصير حفصة أمينة الوحي «أبيقليرة»[xxvi]، إنَّها عملية قطع حقيقية للإسلام عن تراثه الروحي الذي ينسبُ نفسه إليه، وحتى عن تاريخه الواقعي وتهجيره للسكنى في أرض يونان، روحيًّا وسياسيًّا وعقليًّا!
مُشْكِلُ هذا التهجير هو أنَّه لا يقوم على أي أساس واضح، فنحن مهما دقَّقنا في قراءة خطاب الصدّيق لا نجدُ مُستَندًا لـ«يوننة القرآن» هذه إلا يوننة القرآن! فهذه القراءة التي يُقدِّمها الصدّيق للقرآن ولقصصه ولأنبيائه ولمسيرة النبوة هي قراءة قائمة بالأساس على التعامل مع القرآن انطلاقًا من كونه أصلًا «شذرات» ومن كونه يُقارِب «القول اليوناني الفلسفي» قبل أن يُحبس في النصّ المُدوَّن، وهذه الآراء شديدة الاتساع لا يُمكنها أن تنبني على عدد من كلمات تمَّ الظنّ بتشابهها مع اليونانية مهما كَثُرت هذه الكلمات.
إنَّ الصدّيق وهو ينتقل من نتائج الفيلولوجي والأركيولوجي عن بعض الكلمات والأحداث والإشارات في القرآن كي يُقارِب «القرآن وطبيعته» لم يسأل الأسئلة الأكثر طبيعيّة والأكثر مركزيّة كذلك لهذا الإشكال الجديد؛ وهي: ما هي طبيعة الكلام الوحياني؟ وما الفرق بينه وبين غيره من أنواع الكلام ومنه الفلسفي؟ ما هي طبيعة القول القرآني تحديدًا في سياق القول الوحياني؟ وهذه أسئلة تطرحها المناهج اللسانية والتأويليّة الحديثة التي يُطالِب الصدّيق دومًا بتطبيقها لفهم القرآن!
إنَّ الصدّيق يُصِرُّ على غياب الشّكل الأصلي لتنزّل القرآن في بُعده الشفهي بسكتاته العميقة والمُمتدَّة، وأنَّ الكتابة لم تكن ستتمُّ إلا بهذا القرار السياسي الصّرف، وهذه نفسها آراء تحتاج لتدقيقٍ كبيرٍ، فبالأساس قضية كتابة القرآن وتدوينه وجمعه ليست في ظنِّنا مجرد قضية تاريخية أو فيلولوجية، ولا تكفي فيها مداخل علاقة السلطة بالمعرفة التي ينطلق منها الصدّيق لمقاربتها، بل إنَّها كذلك قضية تتعلق بالقرآن ذاته وطبيعته، فـ«بأي قدر فَرَضَت طبيعة القرآن ذاتها كتابته؟»، هذا سؤال مركزي في هذا السياق، وهو سؤالٌ يُفضِي لمحاولة بحثٍ أكبر؛ سواء داخل القرآن ومفاهيم مركزية فيه، مثل الأوصاف التي يصفُ القرآن به نفسه («الذكر» و«القرآن» و«الكتاب» وما يتعالق بها من مفاهيم، مثل: «أم الكتاب» و«اللوح المحفوظ»)[12]، أو في علاقة القرآن بالإسلام كدين كتابي، أو السياق الخاصّ لجدل الشفاهة/الكتابة في حضور النصّ القرآني[13]؛ من أجل تحديد السمات الرئيسة لهذا القول الديني وعلاقتها بكتابته وتدوينه، لكن هذا السؤال للمفارقة لا يطرحه الصدّيق، ولا يحاول توسعة عدّته المنهجية من أجل مقاربته والسير فيما يفتحه من إشكالات، بل يقتصرُ على الفيلولوجي وجدل السلطة/المعرفة كمدخل كافٍ لاعتبار الكتابة خطيئة سجنت نصًّا هو في طبيعته الأصلية يشبه «الشذرات قبل السقراطية»[14]، لكن الطريف أنَّنا حتى لو سلمنا للصدّيق بمدخله ونتائجه، لو سلّمنا أن الكتابة كانت «خطيئة قارئ القرآن الأولى»، وأنَّها عملية قتل نفّذها ثأر أُموي، وأنَّها أبعدت للأبد القدرة على استعادة الزخم الشفوي للقرآن الموحى، فمن أين يا تُرى يلزم القول سريعًا هكذا بأنَّ طبيعة القول القرآني لا بد أن تكون الشذرة اليونانية تحديدًا؟! لماذا لا تكون طبيعة هذا القول ومن نفس المنظور المنهجي سريانية أو آرامية؟! فيما لو عمَّقنا نحن اشتغال آرثر جيفري ولكسنبرج على المعجم السيرياني - الآرامي وهو -وفقًا لهما- معجمٌ كبيرٌ كذلك كالمعجم اليوناني الذي يتحدّث عنه الصدّيق!
مما يعني أن هذا القول الذي يُؤسِّس عليه الصديق كلّ خطابه، لا يُمكنه أن يُبرِّر ذاته بنتائج الفيلولوجي والأركيولوجي التي تُشكِّل أساس عدّته المنهجية المُشغَّلة على القرآن والمُنتِجة للقراءة بـ«معناها الحقيقي»!!
إنَّنا في حقيقة الأمر أمام مداخل منهجية غير مُلائِمة -أو على الأقل غير كافية- لبحث ما تَدرِسه من ظواهر، وأمام عدد من التعسّفات في القراءة تجدُ مركزها في التعسّف الأول أي في اعتبار القرآن قولًا يونانيًّا دون أي سندٍ واضح إلا عددًا من الكلمات لا يُمكن حتى القطع بكونها يونانية[15]، وأمام قفزات كبرى من المعطيات القليلة التي تحتاج هي أصلًا لتَثَبُّت إلى نتائج ليس لاتساعها حدّ!
* * *
إنَّنا ونحن نتفكر في خطاب الصديق بمنطلقاته ومنهجياته ورهاناته ونتائجه، نجدُ أنفسنا أمام مسافة شديدة الاتساع بين المعطيات الفيلولوجية والأركيولوجية التي ينطلق منها الصدّيق ويؤسِّس على صلابتها -أو على هشاشتها- خطابه، وبين نتائج هذا الخطاب، مسافة مُتّسِعَة كأنَّها فجوة، كان يُراد لبقية العدة المنهجية التي يتوسَّلها الصدّيق -خاصة السرد- رأبها، لكنها لم تستطع، فهذه الفجوة كانت قد امتلأت مسبقًا بأمنيات الصدّيق المُتأمِّل في صفحة التاريخ والقرآن، والراغب في سحب القرآن لعالم الفلسفة كما سحب إيميل ليفيناس التوراة لعالمها، وعبر هذه الفجوة المُمتَلِئَة بالأمنيات تسلَّل الخطأ في اختيار المنهج تارة والخلط في تطبيقاته تارة فجاء الخطاب حاملًا لكلّ هذا التَشوُّش.
[1] يمكن مراجعة هذه المحددات في مقال المدخل «سلسلة القراءات الحداثية للقرآن (1): المحددات الرئيسة للقراءات الحداثية» على هذا الرابط: https://tafsir.net/article/5079.
[2] كذلك يفعل طه عبد الرحمن في «روح الحداثة»، ومحمد حمزة في «إسلام المجددين».
[3] كان طه حسين هو أول من لفت النظر لهذه الصلة بين الحداثة واليونان، وحاول العودة بالتأسيس الحداثي إلى هناك، فقد جعل طه حسين مادة اللغة اليونانية وآدابها جزءًا من مقررات الدراسة في كلية الآداب في الجامعة المصرية، التماسًا -كما يقول علي مبروك- لأسئلة التأسيس من الأصل الإغريقي، فخطاب الحداثة ينبني على أصول أولى ترتدّ إلى الإغريق؛ لذا فبناء الحداثة لا يمكن دون استيعاب ما بناه هؤلاء، والحقيقة أنَّ هذه الملاحظة والتفسير من علي مبروك شديدة الوجاهة، رغم أن ما يصرّح به طه حسين كسبب لإنشاء قسم اليونانية واللاتينية وآدابهما في كتاب «في الأدب الجاهلي» هو كونهما جزءًا من القول الشعري العربي الإسلامي، والذي استوعب هذا التراث داخل أعماله، فلا نستطيع فهم الأدب دون التعريج باللغة اليونانية وآدابها كما بغيرها من لغات مثل اللغة الفارسية وآدابها، كما التوراة والإنجيل، إلا أنَّ ما يجعل ملاحظة مبروك وجيهة هو أن اشتغال طه حسين نفسه على المتن اليوناني كان متسعًا كثيرًا عن مجرد المساعدة في فهم الشعر، فقد ترجم نظام الأثينيين لأرسطوطاليس وكتب قادة الفكر والذي يحتل معظمه قادة الفكر اليوناني. انظر: ثورات العرب خطاب التأسيس، علي مبروك، ص109، وانظر: نظام الأثينيين، طه حسين، وقادة الفكر، طه حسين، إدارة الهلال بمصر، 1935، وفي الأدب الجاهلي، طه حسين، مطبعة فاروق، القاهرة، ط3، 1933، ص12، 13.
[4] وهذا الفارق ينتبه إليه بسام الجمل في دراسته المذكورة بالأعلى، حيث يعتبر أنَّ قراءة الصدّيق جديدة بالنسبة إلى البحث الفيلولوجي المُجرَى على القرآن، وأنها مغرية للدارسين المعاصرين؛ لأنها تفتح أفقًا جديدًا في التحري الفيلولوجي. انظر: «القرآن: التاريخ والخطاب والدراسات»، ص65، لكن في ظنّنا فإن الفارق الرئيس بين الصديق وغيره -كما سنوضح- ليس في فتح أفق أوسع للتحري الفيولوجي ولا حتى في البحث عن الأصول المشتركة الجامعة بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة اليونانية، بل في كون بحث الصدّيق ينتهي إلى افتراض «طبيعة جديدة للقول القرآني».
[5] يربط الصديق هذا المعنى بدلالة من دلالات كلمة «قراءة» أشار إليها أبو عبيدة معمر بن المثنى مستشهدًا بعمرو ابن أم كلثوم في معلقته، حيث قال:
ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا
انظر: «هل قرأنا القرآن»، ص85.
[6] الصديق له اهتمامات سردية كثيرة، ومهتم بالسرد التراثي والسرد العربي الحديث، وقد قام بترجمة بعض النصوص السردية التراثية والمعاصرة للغة الفرنسية امتدادًا لهذا الاهتمام؛ منها: كتاب الأحلام الكبير لمحمد بن سيرين، بيروت، باريس، 1994، 2005، باب المساحة، رواية لسحر خليفة، 2000، بناية ماتيلد، رواية لحسن داوود، 2002، يوم الدين، رواية لرشا الأمير، 2008.
[7] بالطبع إشكال علاقة القصة بوحدة السورة إشكال قديم، تعرَّض له البقاعي في «نظم الدرر» على سبيل المثال، حيث يذكر في بداية سورة القصص أنه مع (إتيان هذه السورة بعد الوعد بكشف آياته فتُعرَف، وأن من هذه الآيات إعجاز أهل الكتاب بإيراد خفايا علومهم، وأنه يقصّ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون)، فقد (أورد هنا من الدقائق ما قلَّ من يعرفها من أحذقهم)، فالبقاعي هنا يربط بين شكل قصة موسى في سورة القصص وبين موضوع السورة بل وحتى موقعها في ترتيب السور، لكن الحديث سواء عند البقاعي أو أي من المفسرين المعاصرين بعد هذا (مثل ابن عاشور) هو عن علاقة بين القصة والسورة لا تُهدِر البنية الأصلية للقصة، فمناسبة ذكر قصة بشكلٍ ما في أحد السّور يعمل على تشكيلها وانتقاء ما يُحكى وما لا يُحكى، لكنه لا يُغيِّر القصة وشخصياتها تغييرًا تامًّا كما عند الصدّيق. انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، 1984، الجزء الرابع عشر، ص233، 234، وانظر كذلك: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، الجزء الأول، ص69.
[8] نستطيع اعتبار الخلاف المعاصر في التعامل مع القصة القرآنية والاتفاق بينها في إدانتها للتراث التفسيري وتعامله مع القصص؛ قائمًا في أحد أوجهه الرئيسة على اعتبار المدوّنة التفسيرية أخضعت القصة القرآنية لوحدات مستقاة من قصص العهد القديم والأساطير الجاهلية، في حين تريد التفاسير والدراسات المعاصرة المُنتقِدَة أن نقرأ القصة وفقًا لوحدة قرآنية، لكن هذه الوحدة نفسها مختلف في تحديدها، فهناك من ينطلق من وحدة القصص «باقر الصدر»، وهناك من ينطلق من وحدة القصة «الطبطبائي»، وهناك من ينطلق من وحدة الغرض «خلف الله»، وهناك من ينطلق من الوحدة المنهجية «أبو القاسم حاج حمد»، وهناك من ينطلق من وحدتي النبوة والرسالة كمصطلحات قرآنية «شحرور».
[9] الصديق يطابق قصة موسى وفتاه مع قصة من قصص جنود الإسكندر، ذكرها المؤرخ كاليستينس. «هل قرأنا القرآن، ص132، 133».
[10] يتحدث إيكو عن امتلاك الشخصيات التخيلية لملامح دقيقة تجعل من غير الممكن التشكيك في مآلاتها بنفس طريقة التشكيك في حدث تاريخي لم يحسم، فالملامح الدقيقة لشخصية مثل آنا كارنينا تجعل أي ادعاء بزواجها من بيار بيزخوف غير مقبول؛ لأنه يخالف الشرعية التجريبية الداخلية للنصّ، في حين يمكن قبول التشكيك في طريقة موت هتلر! هذه الملامح الدقيقة تجعل للشخصيات التخيلية وجودًا مستقلًّا عن التوزيع النصي الأصلي، ويجعل بالإمكان هجرتهم بين العوالم النصية، حيث يحتفظون بوجودهم رغم هذا الانتقال، فالشخصية تظل هي هي طالما تحافظ على ملامحها التشخيصية مهما تعددت العوالم النصية. انظر: فصل الشخصيات التخيلية في كتابه «اعترافات روائي ناشئ»، ترجمة: سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط1، 2014، ص81.
[11] رغم أنَّ الصدّيق يطابق شخصية موسى بشخصية أحد جنود الإسكندر، إلا أن التدقيق بصورة أكبر يجعلنا نقول أن المطابقة هنا هي مطابقة بين موسى والإسكندر لا أحد جنوده، فتلك القصة التي يستحضرها الصدّيق عن جندي يتعلم «الحكمة والحرب» لا يمكن أن تنطبق إلا على الإسكندر نفسه، هذا الذي تعلم الحكمة من أرسطو والحرب من أبيه فيليب، وأهَّله هذا التعليم لأن يكون ذا القرنين، وأن يتجاوز بتعبيرات الصديق عالم النبوة حكمة وحكمًا؛ لذا فموسى في قصة الكهف يصبح الإسكندر في أحد مراحل مسيرة ترقيه نحو أن يكون ملكًا فيلسوفًا، ويصبح العبد الصالح (الذي يعلم الاستنباط) بتعبير الصديق هو أرسطو المُعلِّم الأول.
[12] أثار الجابري مثلًا في كتابه «مدخل إلى القرآن الكريم» أسئلة كثيرة حول علاقات هذه المفاهيم ببعضها، ودلالة كلّ مفهوم على القرآن في تطوّر نزوله طوال سنين الدعوة، وأشار لكون وصف القرآن بـ«الكتاب» في سورة الأعراف لم يكن فحسب تعبيرًا عن كون القرآن أصبح يُكتب بعد أن زاد بصورة لم يعد كافيًا فيها الحفظ الشفهي، وإنما إعلان عن رفع العرب لمصافّ أمم الكتاب عبر القرآن، نفس الأمر كذلك أشار إليه جعيط في كتابه الثالث من السيرة «مسيرة محمد في المدينة وانتصار الإسلام»، حيث يعتبر السنة الرابعة والخامسة من الهجرة هي من أهم سنوات الدعوة حيث منح فيها النبيُّ قومَه الأميين كتابًا وشرائع رفعتهم لمصافّ أمم الكتاب.
أوردنا هذين الرأيين على خلاف منطلقات كاتبيهما؛ لنوضح مدى طبيعية طرح هذه الأسئلة عن وصف القرآن لنفسه بـ«الكتاب» وعن صلة هذا بالأديان «الكتابية» التي ينسب الإسلام نفسه إليها عند إثارة إشكال علاقة القرآن الشفهي بالمكتوب، فرغم أن اشتغال الجابري وجعيط يظلّ تاريخيًّا ولم يدخل إلى المساحات الفلسفية التي يناقشها الصدّيق، إلا أن هذه الأسئلة لم تغب عنهم ولو قاربوها وفق حدود عدتهم المنهجية. انظر: مدخل إلى القرآن الكريم، الجزء الأول «في التعريف بالقرآن»، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2006، من ص149 إلى ص166، وانظر: «مسيرة محمد في المدينة وانتصار الإسلام»، هشام جعيط، دار الطليعة، ط1، 2014، ص124.
[13] ربما هذه الثنائيات المعتادة في التفريق بين مرحلة شفهية ومرحلة كتابية في حياة الأمم والحضارات أو في حياة الكتب والنصوص غير فعالة بالصورة الكبيرة حين ينظر بها إلى نصّ ديني، أو حين ننظر بها تحديدًا إلى القرآن؛ حيث إنّ النصوص الدينية كتبت أم لم تكتب تظلّ نصوصًا شفهية، بمعنى أنها نصوص جهرية تأتي قوتها من تلاوتها جهرًا «تعبديًّا» حيث هي إعلان دائم، و(حدث لا بد أن يُسمع)، ولعلّ هذا يتضح من بعض آي القرآن، مثل آية: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6]، لكن في ذات الوقت فالقرآن كتاب من سماته أنه يُكْتَب ويُدوَّن، وهذا لأن القرآن هو بالأساس استعادة للكتاب الأصلي، لـ«أم الكتاب» القائم في «اللوح محفوظ»، بعد أن طالت كلمات الله المرسلة «الألواح» التحريف على يد اليهود، كما يكرّر القرآن دومًا، فهذه العلاقة التي يقيمها القرآن بينه وبين التوراة وبين ألواحها وبين اللوح المحفوظ، تقضي بكون الكتابة هي أحد سمات هذا النصّ الذي هو وبالأساس وقبل التنزيل هو مكتوب ومُدوَّن، والذي بعد تنزيله ومع الحفظ الإلهي له ينتهج كلّ ما يمكن له أن يجعله محفوظًا ومُدوَّنًا لهدي من أُرسِل إليهم حتى لا يقعوا فيما وقع فيه سابقوهم الذين ضيعوا الكتاب بعد أن جاءهم. انظر: فهم الفهم، مدخل إلى الهرمنيوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادمر، عادل مصطفى، دار رؤية، القاهرة، ط1، 2007، ص42.
[14] حتى حين يقارب الصدّيق قضايا «الكتاب» و«اللوح المحفوظ» و«أم الكتاب» الواردة في القرآن، فإنه يقاربها من منظور فيلولوجي بحت يصرّ على ربطها بالنصّ اليوناني، فينتهي لجعل كلمة «كتاب» تعني الكون أو العالم، و«المثاني» تعني «أم المعاني الثنائية»، (التي حين تشرف عليها النبوة المحمدية فإنها تجاوز كلّ موقع لنبي سابق)، وهذا جرّاء مقارنة هذا الموقع بما ورد في نصّ جمهورية أفلاطون عن القبان الثامن، دون أن تثير الصلة بين «الكتاب» وبين الأديان الكتابية التي ينسب القرآن نفسه إليها أي ملاحظة عند الصديق، فكما قلنا بالأعلى فالقرآن عند الصديق أقرب للنصّ اليوناني منه لتاريخ النبوات الإبراهيمية. انظر: هل قرأنا القرآن، ص112، 113، 114.
[15] كثير من الكلمات القرآنية التي يتم تناولها في إطار التحري الفيلولوجي للمعجم القرآني مُنازَع في نسبها السيرياني واليوناني، وهي لا تعني دومًا نفس المعنى في المعجمين؛ فالكوثر مثلًا في السيريانية تحيل إلى الثبات، وفي اليونانية إلى الطهارة، وهذا إن لم يكن موضوعنا الأساس هنا، لكن مثل هذه النتائج تشير لعدم انضباط المناهج المستخدمة للتحري الفيلولوجي هذا، وانحسام النتائج أحيانًا على أساس التفضيل المعرفي للباحث واللغة التي ينطلق منها في دراسته، فضلًا عن مشكلات أكثر دقة في هذه المنهجيات عن طريقة تحديدها للكلمات القرآنية المبحوثة وتحديد أسباب القول بعدم عروبتها ثم الطريقة التي يتمّ بها البحث عن ما يشابهها في المعاجم الأخرى، وهي مشكلات يطول شرحها؛ مما يجعل هذه الأبحاث في حاجة إلى تدقيق منهجي كبير قبل الانطلاق من نتائجها لتأسيس رؤى شديدة الاتساع كتلك التي يبلورها الصديق. انظر في هذا السياق: التحري الفيلولوجي للمعجم القرآني، بسام الجمل، ص66.
[i] الطبعة الفرنسية لكتاب الصدّيق كانت في عام 2005، والطبعة الأولى للترجمة العربية كانت في 2013، وقام فيها المعرّب منذر ساسي بتغيير طفيف في العنوان غرضه -وكما يقول- أن يكون إشارة أدقّ وأعمق وأقلّ استفزازًا للقارئ العربي.
[ii] هل قرأنا القرآن، يوسف الصدّيق، تعريب: منذر ساسي، التنوير، الطبعة العربية الأولى، 2013، ص22.
[iii] نفسه، ص17.
[iv] نفسه، ص25.
[v] نفسه، ص33.
[vi] نفسه، ص107.
[vii] التحري الفيلولوجي للمعجم القرآني (القراءة السيريانية الآرامية والقراءة اليونانية وجهًا لوجه)، بسام الجمل، دراسة ضمن أعمال ندوة (القرآن: التاريخ والخطاب والدراسات)، تونس، سبتمبر 2013، منشورة ضمن كتاب يحمل نفس الاسم، مؤمنون بلا حدود، 2014، ص53.
[viii] يوسف الصديق، مصدر سابق، ص33.
[ix] نفسه، ص7.
[x] نفسه، ص99.
[xi] نفسه، ص31.
[xii] نفسه، ص87.
[xiii] نفسه، ص86.
[xiv] نفسه، ص77.
[xv] نفسه، ص10.
[xvi] نفسه، ص160.
[xvii] انظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، الجزء الخامس عشر، ص242.
[xviii] الإسلام بين الرسالة والتاريخ، عبد المجيد الشرفي، ص91.
[xix] هل قرأنا القرآن، ص37.
[xx] نفسه، ص132.
[xxi] نفسه، ص230.
[xxii] نفسه، ص132.
[xxiii] نفسه، ص15.
[xxiv] نفسه، ص129.
[xxv] نفسه، ص191.
[xxvi] نفسه، 66، 67، 81.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

طارق محمد حجي
باحث مصري له عدد من المقالات البحثية والأعمال المنشورة في مجال الدراسات القرآنية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))