التنازع الدلالي والتداخل المفاهيمي
بين أصول التفسير وقواعده ومصادره
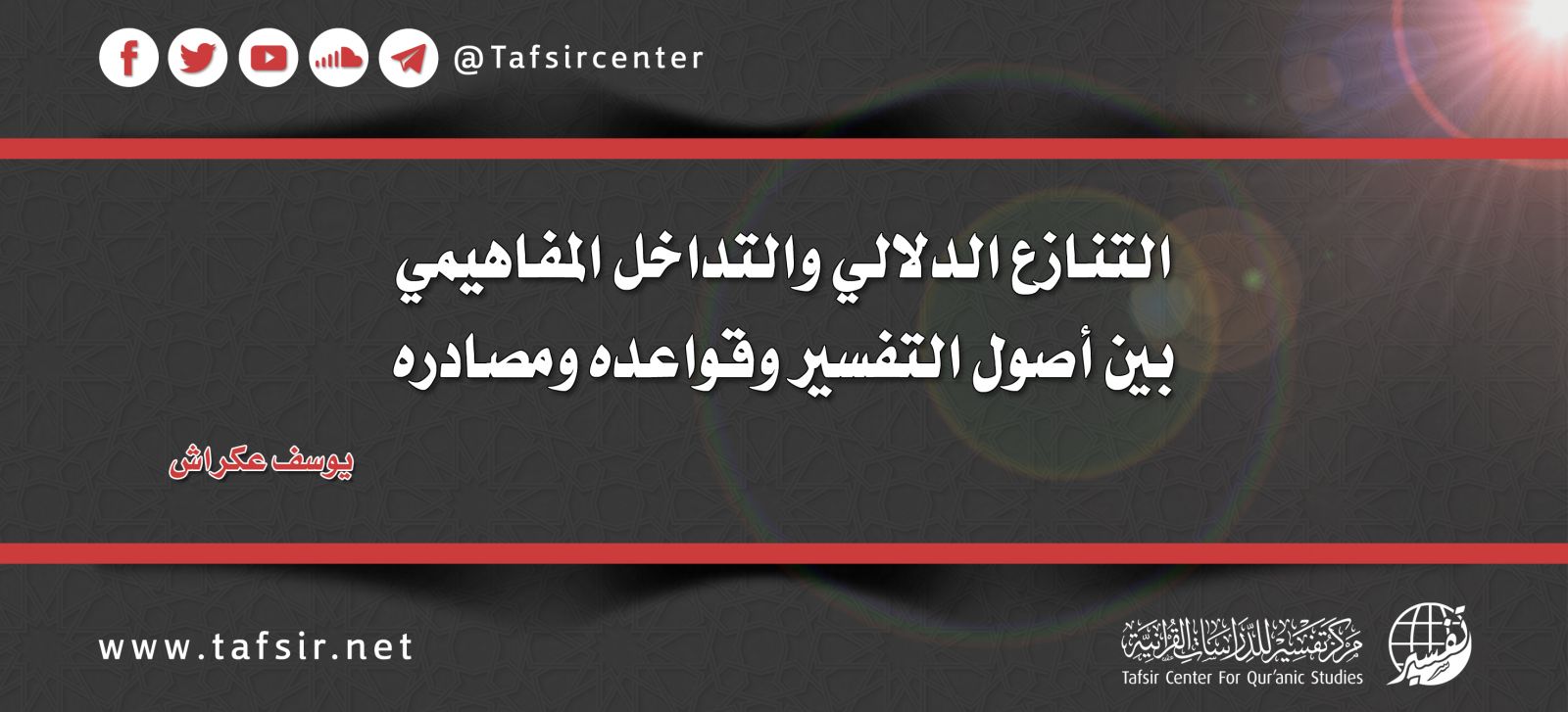
تمهيد:
لا ريب أنّ التداخل الحاصل في فهم مدلولات المفاهيم العلمية في حقل التفسير، سواءٌ كان بعلمٍ أو بغير علمٍ؛ له تأثيرٌ بالغٌ على مسار الدرس التفسيري وخاصّة الشقّ التأسيسي منه، وقد لا يُلحظ هذا التأثير في أنه بقدر ما يتجلى مع مرور الزمن عندما يصبح التداخل والتنازع متداولًا بكثرة كاثرة في الدراسات والأبحاث وغيرها من الأعمال العلمية المختلفة، الشيء الذي يجعل هذا الأخير -التداخل- يعرقل السَّيْر العادي للدرس التفسيري فضلًا عن تطويره وخدمته، بل يصعب تقويمه إذا ما استفحل بشكلٍ مبالغ فيه كثيرًا؛ لذا يجب تدارك هذا النمط الحاصل في المفاهيم العلمية ودلالاتها المركزية في الدرس التفسيري.
ولا شكّ أنّ تدارك ما يقع من تداخل وتنازع في حقيقة مفاهيم الدرس التفسيري لدى المهتمين به= مطلبٌ علمي ضروري لا يتحقّق إلا من خلال تحرير وبناء مفاهيم وتعريفات أكثر انضباطًا تكون محلّ إجماعٍ وتراضٍ لهذه المصطلحات العلمية الدقيقة في مجالها؛ بغية الرجوع لها والاحتكام إليها، بل البناء عليها في مختلف القضايا والمسائل التي تعترض سبيل الطالب والباحث في الدرس التفسيري.
وما أَرُومه في هذه المقالة هو شدّ الانتباه ولفت النظر لنموذج واقعي للتداخل الدلالي الحاصل في أهم المفاهيم العلمية في الدرس التفسيري، بحيث تعتبر هذه الأخيرة من صميم المفاهيم المنهجية التي تحرّر على طاولتها قضايا معرفية عدّة، وقد وقفتُ على هذا التداخل في العديد من الأعمال العلمية المختلفة (مقالات، أبحاث، كتب، دروس أكاديمية...)، مع العلم أنّ هناك مفاهيم أخرى عدّة يشوبها نفسُ الأمر -التداخل والتنازع- في عمليات الدرس والبحث والكتابة، وسأقوم بتتبّعها تدريجيًّا مع مراعاة أهميتها ومكانتها في الدرس التفسيري وبدءًا بما هو بين أيدينا الآن من مفاهيم.
وهذه المفاهيم المقصودة من المناقشة في هذا الطرح، هي: (أصول التفسير، وقواعد التفسير، ومصادر التفسير)، حيث شُهِدَ لها بالكثرة الكاثرة في تداولها بين الباحثين، وشيوع التداخل فيما تحمله من معانٍ ودلالات، فضلًا عن توظيفها في عدّة دراسات على وجه التنازع غير المنضبط، لتُحرّر في ضوئها قضايا ومسائل عدّة يصعب الاستفادة منها أو البناء عليها في القابل من عمليات البحث.
أصول التفسير، وقواعد التفسير، ومصادر التفسير:
يعدّ كلٌّ من مفهوم أصول التفسير وقواعد التفسير ومصادر التفسير من المفاهيم المركزية والمسارات البحثية المهمّة في الدرس التفسيري[1]، والتي كثرت حولها الكتابات وتجاذبتها حركية التعريف التي تشهدها كلّ المفاهيم في مختلف المجالات، بحيث تنوّعت حدودها وموضوعاتها من مفسِّر لآخر، حتى أصبحت تارةً تتداخل فيما بينها، وتارةً تترادف، وأحيانًا تتباين، الشيء الذي تمخّض عنه نوع من الاضطراب في استيعاب هذه المفاهيم لدى الناشئة من الباحثين، وصار هذا الاضطراب يشكّل مظهرًا من مظاهر الضبابية في الوقوف الحقيقي على ماهية كلّ من المفاهيم المذكورة -أصول التفسير، وقواعد التفسير، ومصادر التفسير-. وما أَرُومه في هذا الصدد هو إبراز جانب من أوجه التنازع المفاهيمي والتداخل الدلالي الذي طال هذه المصطلحات العلمية.
وبدايةً بأصول التفسير الذي شَهِدَ واقعُه قديمًا وحديثًا حظًّا وافرًا من الهمّ والاهتمام، الشيء الذي تمخّضت عنه مجموعة من التعريفات التي تدلّ بالأساس على اتساع رقعة الاختلاف بين المعرِّفين له، مما نتج عنه تداخل من حيث الحدود التي سرعان ما أثّرت في الوظائف والغايات، فصار استعمال «أصول التفسير بمعنى مصادر التفسير، وأصول التفسير بمعنى قواعد التفسير، وأصول التفسير بمعنى الفوائد المُعِينة على الفهم»[2].
ولا شك أن الترادف الحاصل في ضبط مفهوم أصول التفسير مع باقي المفاهيم المذكورة، أو بالأحرى التنازع بينها من حيث التعريف والتوظيف وبناء قضايا وتحرير مسائل على هذا الأمر كان نتيجة لعدم اعتبار أصول التفسير علمًا مستقلًّا برزت ملامحه مبكرًا، ويحتاج لتعريف اصطلاحي خاصّ به كباقي العلوم يرسم سياجه المعرفي ويميز موضوعاته، بالإضافة إلى أمر مهمّ ألَا وهو عدم ضبط حيثية اشتغال أصول التفسير التي «تتمثّل في اكتناز الممارسة التفسيرية ذاتها للنصّ القرآني، وليس النصّ القرآني نفسه من جهة كيفية فهمه»[3].
ومنه، فإنّ اعتبار أصول التفسير إطلاقًا على عِلْمٍ برزَت محاولات عديدة لتأسيسه[4]؛ فقد ظهرت تعريفات عدّة تتنازع دلالة هذا المصطلح، فضلًا عن الوظيفة التي يمكن أن يؤدّيها، ومن هذه التعريفات على سبيل التمثيل ما نجده عند خالد عبد الرحمن العك في كتابه: (أصول التفسير وقواعده)،حيث بَيّنَ أن أصول التفسير «هو العلم الذي يبين المناهج التي انتهجها وسار عليها المفسِّرون الأوائل في استنباط الأسرار القرآنية، وتُعرف الأحكام الشرعية من النصوص القرآنية التي تُبنى عليها، وتُظهر المصالح التي قصد إليها القرآن الكريم، فعلم أصول التفسير على هذا هو مجموعة من القواعد والأصول التي تبين للمفسِّر استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم بحسَب الطاقة البشرية، وتظهر منه مراتب العِبرة من أنبائه، وتكشف مراتب الحجج والأدلة من آياته الكريمة، فعلى هذا تعِين علوم التفسير على فهم معانيه وإدراك عِبره وأسراره، وترسم المناهج لتعرّفها، وتضع القواعد والأصول ليسير المفسِّر على منهجها القويم في سيره أثناء تفسيره»[5].
ومَن تأمّل هذا التعريف ألفاه قد حمل في ثناياه طرفًا من التداخل المفاهيمي المقصود بيانه، حيث جعل أصول التفسير مرادفًا لقواعده دون أدنى تفصيل أو بيان، كما شمل هذا التعريف بعض المسائل التي هي بمثابة ثمار لأصول التفسير كالمصالح والمقاصد، ولا يمكن إقحامها في رسم حدّ علمي منضبط لمصطلح أصول التفسير، كما أشار أيضًا أنّ أصول التفسير تُعِين على فهم القرآن، والحقيقة أنّ أصول التفسير مسلك علمي خالص لضبط الممارسة التفسيرية، وهي مرحلة تأتي قبل محطة فهم النصّ القرآني.
أمّا لطفي الصباغ في كتابه: (بحوث في أصول التفسير)، فقد جعل «أصول التفسير يضع القواعد للتفسير، ويبيّن الطريقة المثلى في شرح كلام الله عز وجل»[6]، ومَن تأمّل هذا التعريف وجده قد ضمّ أمرين، الأول: قواعد التفسير التي جعلها المعَرِّف -لطفي الصباغ- من صميم أصول التفسير، كما ضمنه أيضًا عبارة أخرى وهي قوله: «ويبين الطريقة المثلى في شرح كلام الله عز وجل»، ومَن تأمّلها وجدها كلامًا عامًّا يفتح الباب على مصراعيه للقول في التفسير، كما أن هذه العبارة تعتبر هي الغاية النهائية لعلم أصول التفسير، فلا يمكن الجمع بين غاية أصول التفسير وبين قواعد التفسير لرسم حد علمي لأصول التفسير.
أمّا عند الدكتور/ مولاي عمر بن حماد في كتابه: (علم أصول التفسير محاولة في البناء)، فقد عرّف أصول التفسير قائلًا: «هو علم يحدّد مصادر التفسير لكتاب الله تعالى ويضع القواعد، ويحدّد شروط المفسِّر لبيان الطريقة المثلى في التفسير وَفق مقاصد المفسَّر»[7]، ويلاحظ أن ما اشتمله هذا التعريف جاء قياسًا على واقع مفهوم أصول الفقه، كما يظهر فيه الاكتناز المدقّق للممارسة التفسيرية كهاجس مركزي في تأسيس أصول التفسير وعقد محاور الاشتغال في هذا الفنّ في ضوء ركائز هذه الممارسة، حيث أدخل فيها ما ليس منها... كقواعد التفسير ومقاصد النصّ المفسَّر[8].
أمّا محيي الدين الكافيجي في كتابه: (التيسير في قواعد التفسير)، فقد عرّف أصول التفسير بأنه: «علم يُبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث إنه يدل على المراد بحسَب الطاقة البشرية»[9]، وقريب من هذا التعريف ما قدّمه الدكتور/ مساعد الطيار في كتابه: (فصول في أصول التفسير)، حيث جعل أصول التفسير «هي الأُسس والقواعد التي يُعرف بها تفسير كلام الله، ويُرجع إليها عند الاختلاف فيه. ويدور محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين: كيف فُسّر القرآن، وكيف نفسّر القرآن»[10].
ومن التعاريف أيضًا ما ذكره صاحب كتاب أصول التفسير ومناهجه، أنّ أصول التفسير هي: «القواعد والأُسس التي يقوم عليها علم التفسير، وتشمل ما يتعلّق بالمفسِّر من شروط وآداب، وما يتعلّق بالتفسير من قواعد وطرق ومناهج وما إلى ذلك. وقيل: العلم الذي يتوصّل به إلى الفهم الصحيح للقرآن ويكشف الطرق المنحرفة أو الضالة في تفسيره»[11].
ومن التعاريف التي رسمت معالمها من خلال جزئية اشتغال أصول التفسير والمتمثلة في اكتناز الممارسة التفسيرية وهي جزئية أكثر وضوحًا وانضباطًا من غيرها، هو تعريف الدكتور/ خليل محمود اليماني الذي جعل أصول التفسير هو علم «يقوم على البحث في التفسير وموارده، وصناعة المفسِّر»[12].
وعموم القول في التداخل الحاصل على مستوى ماهية أصول التفسير يمكن تقسيمه إلى قِسمين، القسم الأول: وهو التداخل الحاصل في ذات المفهوم الواحد بحيث يقحِم المعرِّف أمورًا عدّة تتنازع فيما بينها ولا تسعف في بناء مفهوم منسجم أكثر انضباطًا يمكن التحاكم إليه عند الحاجة، ومثله تعريف خالد عبد الرحمن العك، وتعريف لطفي الصباغ -كما تقدّم-، أمّا القسم الثاني: ويشمل التداخل والتنازع الخارجي، أي: التنازع الحاصل في مفهوم معيّن إذا ما قرنّاه بمفهوم آخر حيث يصعب الجمع بينهما، ومن ذلك على سبيل التمثيل تعريف الدكتور/ مساعد الطيار، وتعريف الدكتور/ خليل محمود اليماني، بالإضافة إلى تعريف محيي الدين الكافيجي.
وبعد هذه المحطة اليسيرة من التعريفات لأصول التفسير وبيان طرف من واقع التنازع الدلالي الحاصل فيها، ندلف لتعريف يخصّ قواعد التفسير في مقابل أصول التفسير ثم مصادره، وتجدر الإشارة أن القول في قواعد التفسير ومصادر التفسير الذي سيأتي لا يجب فصله ألبتة عن القول في أصول التفسير الذي تقدّم معنا، إذ التداخل حاصل بين المصطلحات المذكورة من جهة أخرى تأتي الإشارة إليها؛ لذلك لا يحبذ فصل الكلام السابق في أصول التفسير عن الكلام في قواعده ومصادره، إِذْ به سيتجلى التداخل والتنازع المقصود من هذه المقالة.
وعليه، فإنّ قواعد التفسير هي: «الأحكام الكلية التي يتوصّل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية الاستفادة منه»، إذًا فهي ثلّة من الآليات المنضبطة التي يوظفها المفسِّر أثناء ممارسة عملية التفسير، ويكون توظيفه لها في حالتين؛ إمّا بتوظيفه لها في بداية الممارسة التفسيرية، وهذه القواعد في هذه الحالة تسمى القواعد الكبرى أو العامة، أمّا الحالة الثانية من التوظيف تكون عند تعدّد أوجه النتاج التفسيري، وحينئذ تسمى قواعد ترجيحية، وتكون مستقاة من شتى الفنون المتداخلة مع التفسير، وعلى رأسها باقي علوم القرآن واللغة والبلاغة والأصول...، وحتى يتّضح الأمر أكثر، فإنّ القواعد العامة هي: «القواعد التي يُعْمِلها المفسِّر عندما يفسّر آية من القرآن، أمّا القواعد الترجيحية فهي القواعد التي يُعْمِلها عند الترجيح بين أقوال المفسِّرين؛ إمّا بتقديم قول أو ردّ آخر»[13].
وبناء على هذا التعريف، فإذا كانت القواعد التفسيرية آليات توظّف أثناء الممارسة التفسيرية، فإنّ أصول التفسير محطة حاكمة ومتقدّمة عن توظيف قواعد التفسير، ومنه فلا يحسن حمل مفهوم أصول التفسير على أنه قواعد التفسير -كما تقدّم- أو العكس، وهذا أيضًا أحد أوجه التداخل المفاهيمي الحاصل على مستوى هذه المصطلحات المركزية.
أمّا مصادر التفسير فهي «المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسِّر عند تفسيره لكتاب الله، وهذه المصادر هي: القرآن، والسنّة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين وتابعيهم، واللغة، والرأي والاجتهاد، وإنما قيل: مراجع أولية؛ لئلا تدخل كتب التفسير»[14]، وتجدر الإشارة بعد هذا التعريف بخصوص تسميتها؛ حيث تنوّعت وتعدّدت، فذهب ابن تيمية في: (مقدمة في أصول التفسير) إلى تسميتها طرق التفسير، وعليه درج مساعد الطيار في كتاب: (فصول في أصول التفسير)، كما اختار الزركشي في: (البرهان في علوم القرآن) تسميتها بمآخذ التفسير، كما سميت أيضًا بالاستمداد... وغيرها من التسميات التي ليس المقام هنا للتفصيل فيها وذكر اعتبارات اختيارها أكثر مما نودّ إبراز أهم محطات التداخل الحاصلة بين أصول التفسير ومصادره.
وكما اختلفوا في تسميتها اختلفوا أيضًا في ترتيبها باعتبار أحسن مصادر التفسير، ومن ذلك على سبيل التمثيل، حيث جعل ابن تيمية أحسنها تفسير القرآن بالقرآن، أمّا الزركشي فجعل السنّة تعلو عرشها، كما اتّسع الخلاف أيضًا في إدراج بعض المصادر ضمنها مثل جعلِ الإسرائيليات من مصادر التفسير، حيث يقول مولاي عمر حماد: «ترددتُ كثيرًا في إدراج الإسرائيليات ضمن مصادر التفسير، مع كلّ الانتقادات التي وُجّهت لمن أدخلها في التفسير، حتى صار يُمْدَح الكتاب من كتب التفسير بأنه خالٍ من الإسرائيليات...»[15]، وعمومًا فيما يبدو أنّ الاختلاف حاصل على مستويات عدّة في تحديد مصادر التفسير، ولا شكّ أنّ هذا الاختلاف في تحديد مصادر التفسير دون غيرها له أيضًا حظّه في المساهمة في ضبابية هذا المفهوم وفي علاقته مع المفاهيم المتداخلة معه أو بالأحرى التي تتقاطع معه.
ومن خلال هذه التعريفات المنتخبة يظهر ابتداءً أن التنازعَ الدلالي والتداخل المفاهيمي بين كلٍّ من أصول التفسير وقواعده حاصلٌ لا محالة في عدّة تعريفات؛ إِذْ نجد عند خالد عبد الرحمن العك أنه جعل تعريفه لقواعد التفسير بمعنى أصوله، حيث قسم كتابه الذي تقدّم ذكره لستة أقسام كلّها معنونة بقواعد التفسير، فنجده يذكر في هذه الأقسام «قواعد التفسير في المنهج النقلي والعقلي، وقواعد التفسير في بيان دلالات النّظْم القرآني، وقواعد التفسير في حالة وضوح الألفاظ القرآنية وابهامها ودلالاتها على الأحكام...»[16]، وما دلّ على أنه أطلق القواعد ويريد بها الأصول، بل لا فرق عنده بينهما، هو مناقشته ضمن هذه الأقسام التي وسمها بالقواعد قضايا مهمّة من صميم أصول التفسير، ومن أبرزها مناهج المفسِّرين وضوابط توظيفها وشروط الاستفادة منها، مع مناقشة مسائل من صميم صناعة المفسّر وتكوينه، وعليه فلا فرق عنده في إطلاق عبارة أصول التفسير أو قواعد التفسير.
في حين أنّ أصول التفسير لا يمكن حملها على أنها قواعد التفسير أو العكس، سواء من حيث ماهية المفهوم أو مجالات الاشتغال والوظائف بل حتى الغايات، فأصول التفسير أعمّ من القواعد، وهذا يتجلّى من خلال المواضيع الدقيقة لكلّ مفهوم؛ فموضوع أصول التفسير هو العمليات التفسيرية من حيث هي وجعلها منضبطة ومحكومة بقوانين مع السعي لتطويرها والنهوض بها، في حين أن موضوع قواعد التفسير هو بيان مراد النصّ القرآني بشكل منضبط، فكلاهما يسعى لتحقيق الضبط ونبذ التسيّب، لكن الأصول تبقى أعم من خلال ما تقدَّم من التعريفات، فهي تشتغل على العملية التفسيرية وقواعد التفسير من حيث الوضع والتوظيف.
أمّا عند لطفي الصباغ، والدكتور/ مولاي عمر بن حماد، يلاحَظ أن ما ضمته تعريفاتهما جاء قياسًا على واقع مفهوم أصول الفقه، وذلك بجعل أصول التفسير تضع القواعد وكيفية الاستفادة منها من لدن المفسِّر وحال المستفيد، أي: ما يتعلق بشروط المفسر وآدابه، بالإضافة أنّ لطفي الصباغ أدرج في تعريفه إحدى الغايات النهائية لعلم أصول التفسير المتمثّلة في فهم مراد الله، التي هي بمثابة الثمرة الأخيرة للممارسة التفسيرية، وهذا الأخير -التعريف- لا يمكن أن ينتج لنا تعريفًا علميًّا منضبطًا يمكن من خلاله إبراز المعالم الكبرى لبناء علم أصول التفسير على غرار العلوم التي استوت واشتد عودها.
أمّا عند الكافيجي فتجدر الإشارة أولًا أنّ الكافيجي لم يعبّر بأصول التفسير بل عبّر بعلم التفسير وهذا شأن العديد من المتقدمين، لكن «صنيعه داخل الكتاب يُفهم منه أنه رام الحديث عن أصول التفسير من خلال محاولة النظر والتقعيد لفكرة فهم كتاب الله»[17]، أمّا مَن تأمّل التعريف الذي أناطه بأصول التفسير قائلًا: «علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد...»، نجده تعريفًا عامًّا يصعب من خلاله فهم الأصول التي تحكم الممارسة التفسيرية في حين أن الواقع العلمي لأصول التفسير أحوج ما يكون لتعريفات علمية منضبطة ومحرّرة بدقّة يمكن البناء عليها دود أدنى حرج علمي.
أمّا عند الدكتور/ مساعد الطيار، والدكتور/ فهد بن عبد الرحمن الرومي، فقد جعلَا أصول التفسير هي القواعد التي يتوصّل بها إلى فهم مراد الله عز وجل، أي: علم أصول التفسير بمعنى القواعد، والأَوْلى التفصيل والبيان فيما يقصد بقول: «الأُسس والقواعد» هل هي قواعد التفسير المعهودة التي يكون من خلالها أصول التفسير مرادفًا للقواعد، أم هي قواعد جديدة تخصّ أصول التفسير دون غيره، والتي تجعله غير مرادف لقواعد التفسير[18]؟
وما قيل في التنازع الحاصل بين أصول التفسير وقواعده يُقال في أصول التفسير ومصادره، حيث استُعملت أصول التفسير بمعنى (مصادر) في كثير من الكتابات، ومن ذلك ما نجده في كتاب: (دراسات في أصول التفسير) لمحسن عبد الحميد، حيث عنون كتابه بالوَسم المذكور، لكن في التمهيد المطوَّل الذي صدَّر به كتابه وخصّصه للحديث عن تطور تفسير القرآن الكريم خلال أربعة عشر قرنًا، والذي بيَّن من خلاله أنه سيسعى لمناقشة مصادر تفسير القرآن في ثنايا الكتاب؛ مثل تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنّة وبأقوال الصحابة... مع القول في القضايا المتعلقة بكلّ مورد منها[19]، الشيء الذي يبرز معه استعمال أصول التفسير بمعنى مصادره، وتقرير قضايا على ضوء هذا الترادف والتداخل، ونفس الشيء يقع في عدد من الأعمال العلمية وخاصّة الأبحاث.
خاتمة:
من خلال ما سبق درسه في هذه المقالة يظهر لنا أن أصول التفسير وقواعد التفسير ومصادر التفسير لا تستقر على مفاهيم موحدة تكون محلّ إجماع أهل هذا الفن، بل يعاني الواقع العلمي لهذه المفاهيم تنازعًا دلاليًّا وتداخلًا مفاهيميًّا كبيرًا جدًّا يصعب معه إيجاد خيط ناظم لهذه المفاهيم، ولا شك أنه إذا غاب المفهوم غاب ما يُبنى عليه من قضايا ومسائل، الشيء الذي استنتجنا منه أنّ لكل مفسِّر ومؤلِّف نسقًا خاصًّا ومسلكًا متفردًا يسير عليه في تحرير وبناء كلٍّ من مفاهيم أصول التفسير وقواعده ومصادره، فصارت المفاهيم تتداخل فيما بينها وتتنازع الدلالات وتستعمل بشكلٍ واسع أو مضيَّق دون أدنى تنبيه أو بيان أو ضابط أو معيار موحّد.
وما تقدّم فما هو إلا لشدّ الانتباه حول هذه المسألة التي تحتاج جهدًا جهيدًا من النظّار وأهل هذا الفنّ للخوض في بناء مفاهيم وتعريفات تكون محلّ إجماعٍ وتراضٍ لهذه المصطلحات العلمية الدقيقة في مجالها من أجل تدارك هذا التداخل المفاهيمي والتنازع الدلالي الذي يصير مع مرور الزمن إلى خلط مركّب يصعب تداركه والتنبيه عليه.
وإجمالًا للقول وتذكيرًا بخلاصة المقال، فإنّ التداخل الحاصل في دلالات هذه المفاهيم يمكن ردّه إلى ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: ويشمل التداخل الحاصل في ذات المفهوم الواحد بحيث يقحم المعرِّف أمورًا عدّة تتنازع فيما بينها، بل أحيانًا تتعارض ولا تسعف في بناء مفهوم منسجم أكثر انضباطًا يمكن التحاكم إليه عند الحاجة.
المستوى الثاني: ويشمل التداخل والتنازع الخارجي، أي: الحاصل في مفهوم معيّن إذا ما تمّت مقارنته بمفهوم آخر حيث يصعب الجمع بينهما أو إيجاد خيط ناظم لهما.
المستوى الثالث: ويشمل التداخل والتنازع بدائرة أوسع فيحصل هذا التداخل بين المفاهيم المتقاربة اللفظ والمتباينة المعنى كما هو الشأن بين أصول التفسير وقواعد التفسير ومصادر التفسير.
[1] ينسب كلّ من الأصول والقواعد والمصادر إلى التفسير باعتباره معقد الدوران والمحور العام للاشتغال، لكن لكل مصطلح حدّه وموضعه في خارطة التفسير ووظيفيّته المنوطة به والغاية المرجوّة منه.
[2] علم أصول التفسير محاولة في البناء، مولاي عمر بن حماد، دار السلام، القاهرة، ط1، 1431هـ= 2010م، ص46.
[3] تأسيس علم أصول التفسير قديمًا وحديثًا؛ قراءة في منهجية التأسيس مع طرح مقاربة لتأسيس العلم، خليل محمود اليماني، بحث على موقع مركز تفسير، ص66.
[4] ينظر: التيسير في قواعد التفسير للكافيجي، والتحبير في علم التفسير للسيوطي، فصول في أصول التفسير لمساعد بن سليمان الطيار، وعلم أصول التفسير محاولة في البناء لمولاي عمر بن حماد.
[5] أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت، ط2، 1406هـ= 1986م.
[6] بحوث في أصول التفسير، لطفي الصباغ، الطبعة الأولى 1408هـ= 1988م، ص10.
[7] علم أصول التفسير محاولة في البناء، مولاي عمر بن حماد، ص54.
[8] تأسيس علم أصول التفسير قديمًا وحديثًا؛ قراءة في منهجية التأسيس مع طرح مقاربة لتأسيس العلم، خليل محمود اليماني، ص62.
[9] التيسير في قواعد علم التفسير، محيي الدين الكافيجي، دراسة وتحقيق: ناصر بن محمد المطرودي، دار القلم ودار الرفاعي، الطبعة الأولى، 1410هـ= 1990م، ص150.
[10] فصول في أصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار، دار النشر الدولي، ط1، 1419هـ= 1993م، ص11.
[11] أصول التفسير ومناهجه، فهد بن عبد الرحمن الرومي، ط3، 1438هـ= 2017م، ص17.
[12] تأسيس علم أصول التفسير قديمًا وحديثًا؛ قراءة في منهجية التأسيس مع طرح مقاربة لتأسيس العلم، خليل محمود اليماني، بحث على موقع مركز تفسير، ص71.
[13] فصول في أصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار، دار النشر الدولي، ط1، 1419هـ= 1993م، ص87- 94، بتصرف.
[14] مصادر التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، مساعد بن سليمان الطيار، مقالة على موقع الصفحة الرسمية للكاتب من خلال الرابط الآتي: https://cutt.us/0BIZb
[15] علم أصول التفسير محاولة في البناء، مولاي عمر بن حماد، ص117.
[16] ينظر: أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، بيروت، ط2، 1406هـ= 1986م.
[17] تأسيس علم أصول التفسير قديمًا وحديثًا؛ قراءة في منهجية التأسيس مع طرح مقاربة لتأسيس العلم، خليل محمود اليماني، بحث على موقع مركز تفسير، ص12.
[18] تجدر الإشارة إلى بيان الواقع العلمي العام للمفهومَين، حيث يلفي كلّ متتبع ودارس لأصول التفسير وقواعده مدى حجم الاضطراب الذي يعاني منه كلٌّ من واقع الأصول والقواعد، بدءًا من المفهوم حيث لم يعرف كلٌّ من المفهومين تحريرًا وبناءً منضبطًا تتمخض عنه تعريفات تكون محلّ إجماع أهل هذا الشأن، وإذا غاب المفهوم غاب ما يبنى عليه، الشيء الذي صار معه لكلّ مفسِّر ومؤلِّف نسقٌ خاصّ يسير عليه في تحرير وبناء كلٍّ من أصول التفسير وقواعده مما يصعب الوقوف على خيط ناظم لكلّ الانتاجات العلمية التي عُنيت بهذا الطرح قديمًا وحديثًا، بل صارت المفاهيم تتداخل فيما بينها وتستعمل دون أدنى تنبيه أو بيان ومن ذلك ما أشرت إليه في معرض بيان الفروق، أم من جهة القضايا التي يتناولها كلٌّ من أصول التفسير وقواعده، فقد اعتراها أيضًا نفس الضبابية والاضطراب، ومن ذلك على سبيل التمثيل وليس الحصر: غياب القوة المنهجية في الطروحات، أزمة التمثيل والتطبيق في معرض بيان أصول التفسير وقواعده، طغيان النقل وقلّة التحرير... للمزيد حول هذا الشق ينظر: أصول التفسير في المؤلفات دراسة وصفية موازنة في المؤلفات المسماة بأصول التفسير، خليل محمود اليماني، محمود حمد السيد، باسل عمر المجايدة، مركز تفسير للدراسات القرآنية، الطبعة الأولى، 1437هـ= 2015م، التأليف المعاصر في قواعد التفسير دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية، محمد صالح محمد سليمان، خليل محمود اليماني، محمود حمد السيد، مركز تفسير للدراسات القرآنية، الطبعة الأولى، 1441هـ= 2019م.
[19] ينظر: دراسات في أصول التفسير، محسن عبد الحميد، دار الثقافة، المغرب.


