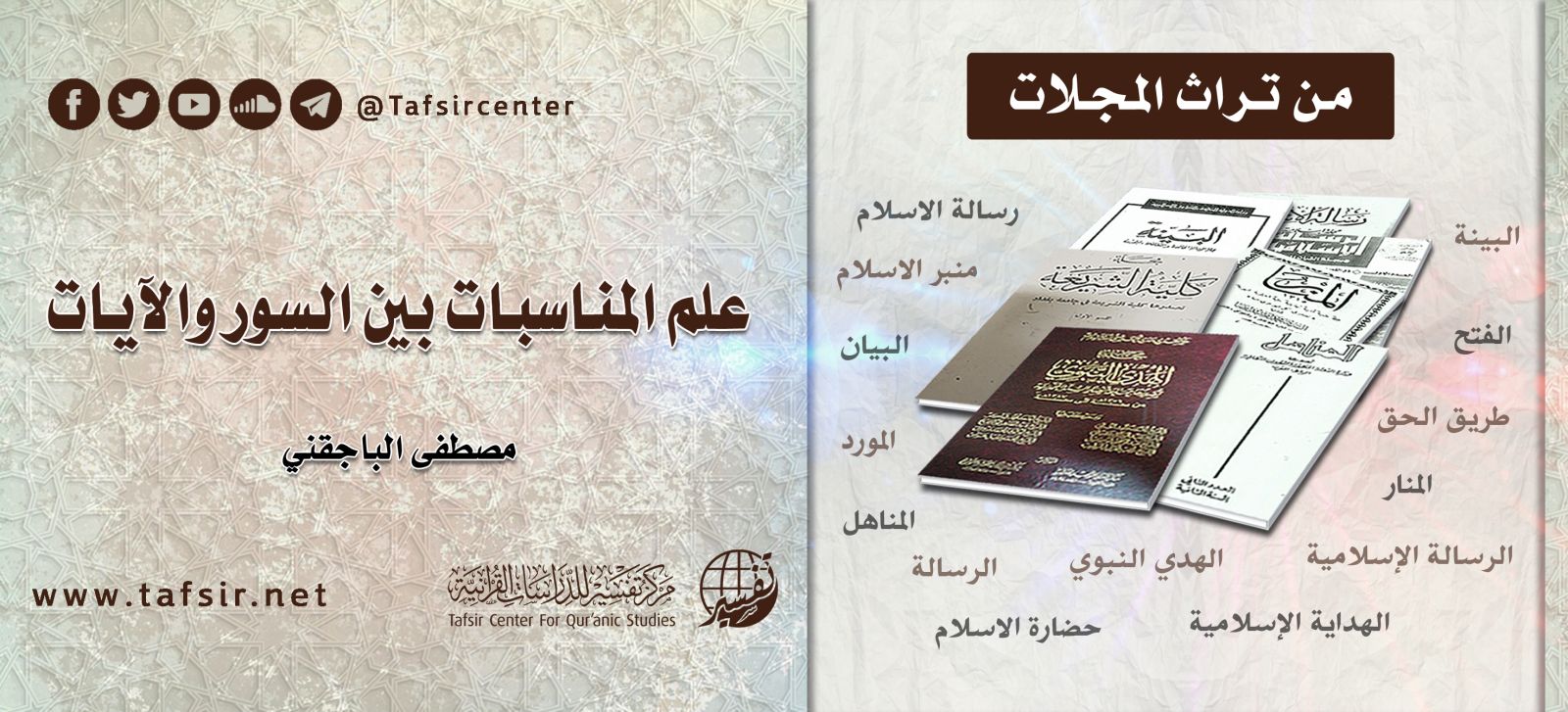بيان الفروق بين بعض المفاهيم في الدرس التفسيري
بيان الفروق بين بعض المفاهيم في الدرس التفسيري
الكاتب: يوسف عكراش

تقديم عام:
عادةً ما تعتري المفاهيمَ عامّةً غرابةٌ والتباس في فهم مدلولاتها فضلًا عن توظيفها؛ إمّا لندرةِ استعمالها في الأوساط الخاصّة بها أو بُعْدِ معانيها عن الفهم، فلا يُتَوَصّل لها إلا بجهد وبَذْلِ الوسع، لكن الشيء عكس ذلك في الأوساط العلمية المتخصّصة؛ فرغم كثرة التداول للمفاهيم العلمية وبيان معانيها تحريرًا وتوظيفًا، إلا أن الغرابة تأتي هنا من طريق الخلط والاستطراد غير المنضبط الذي شهدته المفاهيم العلمية في استعمالاتها ولا تزال كذلك، رغم مركزية المفاهيم داخل أنساقها العلمية المختلفة، الشيء الذي يفرض على مختلف المهتمّين إحكامَ المفاهيم وضبط مدلولها ومجالات توظيفها، فضلًا عن تحرير وبناء مختلف القضايا والمسائل المطروحة على طاولتها.
لكن الملاحظ في واقع الساحة العلمية غير ذلك؛ إِذْ شاع خلط المفاهيم بعضها ببعض لأسباب وأغراض عِدّة، ومن جنس هذا الخلط ما تَلَبّس بالمفاهيم داخل منظومة العلوم الإسلامية، التي يُعَدّ الدرس التفسيري أحد أعمدتها، إلا أنه لم يَسلم من هذا الخلط الذي طال عددًا من أبرز مفاهيمه التي قلّما يخلو بحثٌ أو درسٌ من توظيفها، ومن ذلك على سبيل التمثيل ما وقفتُ عليه في عدد من المواطن، أبرزها أنّ الباحث يخلط في درسه أو بحثه بين التفسير وعلم التفسير، فتجده يعبر عن المفهومَيْن بتعبير واحد أو تارة يصف التفسير بعلم التفسير أو العكس، في حين أنّ لكلّ مفهوم دلالته الخاصّة ومجال اشتغاله ومحدّدات توظيفه، فضلًا عن ماهية المفهوم وحقيقته من حيث وجوده أو عدمه.
ومن صميم الخلط كذلك في بعض الكتابات التي نجد مضمونها يناقش قضايا ومعانِيَ ودلالات من صميم الجديد في التفسير، ويعبرون عنها بالتجديد في التفسير، وشتّان بين المفهومين تعبيرًا ودلالةً وتوظيفًا...، وكذلك الخلط بين التاريخ العام والخاصّ للتفسير...، وغيرها من المواطن الكثيرة التي يقع فيها خلط وضبابية في استعمال المفاهيم ذات الصِّلَة بالدّرس التفسيري، التي ستأتي مناقشة أبرزها بعد التمهيد، الذي نعرِّج فيه على بيان ضرورة تدارك هذا الخلط من خلال الاهتمام بمباحث الفروق، بالإضافة إلى إبراز التوجّه المعتمد في سير المقالة، والمفاهيم المنتقاة للمناقشة ودواعي اختيارها دون غيرها ابتداءً.
تمهيد:
يُعتبر الخلطُ الحاصل في فهم مدلولات المفاهيم العلمية وتوظيفها -سواءٌ كان بعِلْم أو بغير عِلْم- أمرًا له تأثيره البالغ على مسار الدرس التفسيري، وقد لا يُلحظ هذا التأثير في آنِه، بقدرِ ما يتجلى مع مرور الزّمن عندما يصبح الخلط متداولًا بكثرة كاثرة في الدراسات والأبحاث وغيرها من الأعمال العلمية المختلفة، الشيء الذي يجعل هذا الأخير -الخلط- يعرقل السَّيْر العادي للدرس التفسيري فضلًا عن تطويره وخدمته، بل يصعب تقويمه إذا ما استفحل بشكلٍ مبالغ فيه كثيرًا؛ لذا يجب تدارك ما يحصل من خلط في توظيف المفاهيم العلمية ودلالاتها وخاصّة لدى الناشئة من الباحثين.
وإنّ تدارك ما يقع من خلط وتشابه في حقيقة مفاهيم الدرس التفسيري لدى المهتمين به، مطلبٌ علمي ضروري لا يتحقّق إلا من خلال الاهتمام بمباحث الفروق بين هذه المفاهيم؛ لِما للفروق من أهمية مشهودة في الضبط السليم لماهية المصطلحات والمفاهيم، وخاصّة التي تقاربت ألفاظها وتباينت مدلولاتها، كما تبرز أهمية الاعتناء بالفروق بدفع التوهّم والخلط الحاصل في توظيف مفاهيم الدّرْس التفسيري، بالإضافة لما تجليه من جهود أرباب هذا الشأن في بيان محدّدات المفاهيم ومسالك توظيفها وثمرات إِعْمَالِها.
وما أَرُومه في هذه المقالة هو تتبّع بعض المفاهيم العلمية باعتبارها من صميم المفاهيم المنهجية التي تحرّر على طاولتها قضايا معرفية عدّة في الدرس التفسيري، وقد وقفت على عدم التفريق فيما بينها في العديد من الأعمال العلمية المختلفة (مقالات، أبحاث، كتب، دروس أكاديمية...)، مع العلم أنّ هناك مفاهيمَ أخرى عدّة يشوبها نفسُ الخلط في عمليات الدرس والبحث والكتابة، لكن الاقتصار على هذه المفاهيم بعينها، والتي يأتي بيانها؛ راجعٌ لأهميتها ومكانتها في الدرس التفسيري، بالإضافة للكثرة الكاثرة في تداولها بين الباحثين، وشيوع الخلط فيما تحمله من معانٍ ودلالات فضلًا عن توظيفها في عدّة دراسات على وجه التشابه والتداخل غير المنضبط، لتحرّر في ضوئها قضايا ومسائل عدّة يصعب الاستفادة منها أو البناء عليها في القابل من عمليات البحث.
أمّا الحديث عن التوجّه المعتمد في سير المقالة لدراسة المفاهيم المنتقاة، فهو بيان أهم الفروق لأبرز الاصطلاحات في الدرس التفسيري، بما يُعِين على تيسير فهمها وإدراك مجالات اشتغالها مع الإشارة لأبرز المسالك البحثية لتوظيفها، وليس الغاية منها قطعًا هو التوجّه لتحرير المفاهيم وبنائها أو الاهتمام بمسائلها اللغوية، أو بسط القول في الاختلاف الواسع الذي تكتنفه هذه المفاهيم في طياتها؛ إِذْ هذا شأن آخر، ومَن تأمل النسق المنهجي لدراسة المفاهيم التي حصل فيها خلط، أو بالأحرى التي نسعى لتداركها، ألفَى أنّ إدراك المفاهيم عامة وتبصُّر مجالات اشتغالها وتوظيفها، له أولوية لدى الباحث من الخوض في تحرير المفاهيم وبنائها، فهذه مرحلة متقدّمة بعض الشيء، إذْ لا يلزم دخول مضمارها وإقحام الباحث في خضمّها، ولا يزال الخلط والتشابه قائمًا في المشهور من المفاهيم.
وفي ضوء ما سبق فإنّ المفاهيم المنتقاة في هذه المقالة تتمثّل في الآتي: التفسير وعلم التفسير، باعتبار هذين المفهومين منطلقَ الاشتغال، وعليهما مدار هذا الشأن، بل سنستحضر مفهوميهما في إبراز بعض الفروق الأخرى جرّاء التداخل الحاصل بينهما، وكذلك تفسير القرآن وفهم القرآن، وتاريخ التفسير وتحقيب التفسير، والمنهج التفسيري والاهتمام التفسيري، وألفاظ القرآن ومصطلح القرآن، والتجديد في التفسير والجديد في التفسير.
أولًا: التفسير وعلم التفسير:
يُعَدّ مفهوم التفسير وعلم التفسير من أهم المفاهيم الشائكة التي يستسهلها العديد من المهتمّين بهما، في حين أنهما من أبرز المفاهيم التي ينبغي الوقوف عليها ومعرفة حقيقتها وإدراك الفروق بينها ومجالات اشتغال كلّ منها؛ وخاصة أنه يُلاحظ شيوع خَلْط كبير جدًّا بين هذين المصطلحَيْن من جهات عدّة في عدد من الدراسات والأبحاث...، ومما يزيد الأمر صعوبة هو بناء وتحرير العديد من قضايا الدرس التفسيري على هذا الخلط القائم والتداخل غير المنضبط الواقع في مفهوم التفسير وعلم التفسير.
في حين يُعتبر التفسيرُ هو حديثًا عن الاشتغال ببيان معاني الخطاب القرآني والكشف عنه وصولًا إلى مراد الله عز وجل، مع العلم أنّ هذا المفهوم يكتنف في طياته اختلافًا واسعًا؛ جرّاء المحطات والمنعطفات والعوامل المتنوّعة التي شهدها في سيرورته بدءًا من نشأته إلى العصر الحالي، بين مضيِّق لحدود مفهوم التفسير فيحصرها في: بيان مراد الله عز وجل، وبين من يتجاوز هذا التضييق إلى «استخراج الأحكام والنظر في الحِكَم والمقاصد التشريعية وسرد اللطائف البيانية والإعرابية والنّكات البلاغية وغيرها...»[1] من الأمور التي يعدُّها الطرف الأول المضيِّق للمفهوم أنها ليست من صميم بيان مُراد الشارع.
ويرجع هذا الاختلاف الواسع في رقعة مفهوم التفسير إلى اعتبارات عدّة، من أبرز ما وقفتُ عليه: طبيعة العلوم الموظّفة في التفسير من حيث مجالاتها، وأحيانًا بطبيعة التكوين الغالبة في شخصية المفسِّر؛ هل يغلب عليه الطابع اللغوي أو الطابع الفقهي أو الاهتمام الفلسفي...إلخ، كما أنّ محدّدات بناء مفهوم التفسير ترجع أيضًا لمقاصد المُفَسِّر ومراميه، بل من أكبر الاعتبارات في الاختلاف الواسع في ماهية التفسير أنه راجع لغيابٍ شِبه تامّ لعلم التفسير، الذي هو البوابة الكبرى للاعتناء بالتفسير نظريًّا وتطبيقيًّا...، وغيرها من الاعتبارات التي تسهم في بلورة وتوسيع دائرة الاختلاف الحاصل في تحديد مفهوم التفسير.
أمّا الحديث عن مفهوم علم التفسير، فتجدر الإشارة أولًا لضرورة التوقّف حول حقيقة هذا الوسم -علم التفسير- وما يحمل بداخله من معنى علمي مطابق لواقع الحال في الساحة المعرفية، وخاصّة بين العلوم الإسلامية، وهل هو علم قائم بذاته كغيره من العلوم الإسلامية التي استوت على سوقها؟ أم أنّ إطلاق اسم علم التفسير من باب المبالغة في الاصطلاحات أو من قَبِيل التساهل والعاطفة أو الترجّي بأن يكون هناك علم قائم الذات يتبلور في قابل الأيام؟
لا شك أنّ الناظر بعين العلم لحقيقة علم التفسير من خلال مدوّناته يدرك غياب المؤشّرات الحقيقية التي من شأنها أن يتمخّض عنها عِلْم قائم بذاته تنظيرًا وتطبيقًا يضبط التعاطي لعمليات الممارسة التفسيرية بكلّ مسالكها واتجاهاتها، ولعلّ هذا الغياب الملحوظ راجع لأمور عدّة، من أبرزها: «ضعف الإحاطة بالمدونة التفسيرية التطبيقية، بالإضافة لعدم بروز مسارات عناية مهمّة بالتفسير التطبيقي، وغياب مقرّرات ناضجة ومتكاملة في تدريس التفسير كما هو الشأن في باقي العلوم، وضعف نمو البحث في موضوعات التفسير، مع تشتّت الحركة التأصيلية للتفسير من حيث المنطلقات وأنساق البناء»[2]، وبناء على ما تقدّم، فإنه لا مبالغة في القول بأنّ هناك غيابًا شبه تام لعلم التفسير، الذي يضبط العمليات التفسيرية وكلّ ما يتعلّق بها، أمّا ما هو سائد من اشتغال في مختلف الأوعية باعتباره هو علم التفسير، لا يعدو إلا أن يكون معالجة ودراسة لمسالك وقضايا وأصناف في التفسير تكون مظنةً لبناء علم التفسير، إذا ما تم الاعتناء بها على الوجه الذي ينبغي.
لكن ما تقدمت الإشارة إليه لا يمنع من صياغة تعريف لعلم التفسير المنتظَر تَحققهُ في ظلّ الجهود المكثّفة والمتواصلة لبناء وتأسيس هذا العلم، الذي لا يتأتّى إلا من خلال تنمية حِسّ الوعي بحقيقة نتاج التفسير، وما يكتنف هذا المستودع الخام في طياته من مسارات معرفية مهمّة يجب الاعتناء بها وتوالي الجهود حولها، وكذلك الاهتمام بقواعد وأصول المفسِّرين وما كان على شاكلتها من النظريات التفسيرية من خلال إدراك أوجه توظيفها في الممارسات التطبيقية للمفسِّرين، بالإضافة إلى إدراك منعطفات القوة التي شهدها التفسير، والثروات التي برزت في مختلف محطّاته.
وبحسب أحد الباحثين المهتمين بطرح تصور تأسيسي لعلم التفسير، فإنّ هذا العلم المنتظَر تحقّقه في ظلّ الغياب المشهود هو:«العلم الباحث في التفسير وما يتعلّق به»[3] معنى ذلك: أنّ علم التفسير هو العلم الذي يقوم على البحث في التفسير للقرآن، والنظر في هذا التفسير وكلّ ما يتعلّق به من مرتكزات؛ كالتاريخ العام والخاص للتفسير، ومصنّفات التفسير وما حوته من مضامين تفسيرية على اختلاف منطلقاتها، بالإضافة إلى النظر في أصول المفسِّرين وقواعدهم ومناهجهم واهتماماتهم التي هي أصل في اختلاف التفسير، كما يشمل هذا العلم البحث في المفسِّرين، وغير ذلك من القضايا المطروحة على طاولة التفسير، التي يعدُّ علم التفسير ضابطًا لها[4].
وبالإضافة إلى ما تقدّم بيانه حول حقيقة مفهوم -التفسير وعلم التفسير- يمكن أيضًا رصدُ مجموعة من الفروق التي من شأنها أن تُعِين أكثر على فهمهما وإدراك مجالات اشتغالهما، وأبرز المسالك البحثية لتوظيفهما، ومن ذلك ما يأتي: أنّ التفسير يختصّ ببيان معاني الآيات القرآنية، وأنّ علم التفسير يختصّ بالنظر في التفسير ومرتكزاته وما تعلّق بها، كما تقدّم.
ومن جهة أخرى، فإنّ علم التفسير هو المؤطِّر والمحدِّد لعملية التفسير حتى لا تخرج من حيّز الانضباط إلى حيّز التسيّب، وبعبارة أَيْسَر فإنّ علم التفسير هو بمثابة السياج المعرفي لكلّ الممارسات التفسيرية وجُلّ القضايا البحثية المختلفة حول هذه الممارسات.
ومما يزيد الأمر وضوحًا هو بيانُ الغاية لكل من المفهومَيْن؛ فأمّا التفسير فغايته تتجلّى في تحرير مراد النصّ القرآني والكشف عنه، أمّا علم التفسير فغايته تتجلّى في تيسير الإحاطة بالواقع التفسيري القائم وفهمه والعمل على تقريبه، وصناعة الوعي بقضاياه[5].
أمّا من حيث الحاجة لكلّ منهما، لا شكّ أنّ الحاجة قائمة وملحّة تجاه كلّ من التفسير وعلم التفسير، لكن تتفاوت فيما بينهما باعتبار الباحث والمبحوث فيه، فالمبحوث فيه هو التفسير الذي تزداد الحاجة إليه في جميع مجالات الحياة، لكنّ الحاجة الكبرى تتمثّل في الإجابة عن التساؤلات العديدة، جرّاء ما تشهده حياة البشرية جمعاء -وخاصّة الأمة الإسلامية- من مستجدّات وتغييرات ونوازل في مختلف مناحي الحياة (دينية، معرفية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية...).
لكن الحاجة إلى علم التفسير تكون آكد وأقوى من التفسير، باعتباره هو الباحث في التفسير؛ إِذْ بدون علم التفسير لا تقوم قائمة رصينة يعوَّل عليها للتفسير، رغم الحاجة له أيضًا، فعلم التفسير هو الباعث على حُسْن الاستفادة من الرصيد التراكمي للتفسير، كما أنه باعث على الممارسة الراهنة لكلّ عمليات التفسير؛ بل أكبر من ذلك، فإن علم التفسير يمكِّن من استشراف مستقبل التفسير.
ثانيًا: تفسير القرآن وفهم القرآن:
لا شك أنّ القرآن كتاب للجميع وخطاب للعالمين، ومن حقّ كلّ شخص أن يلتمس معانيه وما يلبّي حاجاته الدينية والروحية والمعرفية، وإذا كان غير المسلمين جدّوا واجتهدوا في دراسة القرآن ودراسة ما يتعلّق به، فإنّ هذا ينبغي للمسلمين من باب أَوْلَى، وخاصة أن القرآن خاطبهم ابتداءً، ولا شك أن هذا الحقّ في حدّ ذاته تولّدتْ معه إشكاليات عديدة، أبرزها الخلط بين فهم القرآن وتفسير القرآن، وهو ما أودّ مناقشته في هذا السياق للالتباس الحاصل بين مفهوم تفسير القرآن وفهم القرآن؛ إِذْ يقع هذا الخلط والتشابه من جهتين:
الجهة الأولى: يقع لدى من يتصدى لبيان معاني القرآن والكشف عنها، وخاصة لدى غير المتخصّصين؛ فيتوهم الممارسُ نفسُه لعملية فهم آي القرآن حسَب ما يمتلكه من معارف متنوّعة أنه يفسِّر القرآن، وهذا خطأ وخلط، وهذا التوهُّم مردُّه غالبًا للجهل بمبادئ التفسير فضلًا عن أصوله وقواعده ومناهجه ومصنفاته...إلخ.
الجهة الثانية: يقع أيضًا الخلط بين تفسير القرآن وفهم القرآن لدى المتلقي وهو الأشدّ، بحيث لا يفرّق بين من يفهم القرآن بناء على ثقافته وتخصّصه وطبيعة تكوينه وخلفياته وانتماءاته، وبين من يفسِّر القرآن استنادًا إلى ما تم تسطيره حتى الآن من شروط وضوابط وقواعد وأصول ونظريات ومناهج داخل فلك التفسير؛ وشتان بين المفهومَيْن.
وعليه، فإنّ تفسير القرآن ليس هو فهم القرآن، فالأوّل كما تقدَّم معنا آنفًا هو بيان معاني الخطاب القرآني والكشف عنها وصولًا إلى مراد الله عز وجل، فهو تفسير منهجي منضبط يخضع لقواعد وأصول يعتمد عليها في بيان معاني الخطاب القرآني وضبط مدلولاته وتوجيه سياقاته والوقوف على أحكامه وحِكَمه.
أمّا فهم القرآن فهو ما يتبادر للإنسان عند سماع القرآن أو قراءته، ويعمّق هذا الفهم بناء على العُدّة المعرفية والثقافية التي يتمتع بها كلّ شخص بالإضافة إلا خلفياته التي ينطلق منها، مع استحضار المخرجات التي يودّ الوصول إليها؛ مما يجعل فهم القرآن الكريم يتفاوت ويختلف من شخص لآخر، فترى -على سبيل التمثيل وليس الحصر- التربوي يفهم من القرآن عددًا من الآيات بناء على عُدّته في مجال تخصصه، وترى الطبيب كذلك يفهم مواطن في القرآن مستعينًا بميدانه، وترى الكيمائي والرياضي والفلسفي... وغيرهم، كلٌّ يفهم من طرُقهِ، وهذا عين الفهم الخاصّ، ولا يخلو من الفهم أحد، حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب تراه يفهم القرآن عند سماعه من خلال تجربته وما اكتسبه في محطات حياته، وهذا الأخير ليس هو التفسير المنهجي المعتمَد، الذي يقوم على أُسُس ومحدّدات علمية دقيقة مسطرة من صميم القرآن.
ويَبْرُز لنا أنّ فهمَ القرآن مباحٌ لكلّ أحد ما لم يصطدم أو يخالف أصول الدين، لكن التفسير له حُرمته وهيبته التي تتشكّل وتنشأ من المرتكزات والأُسس التي ينبغي للمفسِّر الإحاطة بها ابتداءً؛ لذلك نجد في الواقع من يقول فهمتُ من هذه الآية كذا وكذا، ولا يمكن أن يقول فسّرتُ هذه الآية فتوصّلْتُ لكذا وكذا؛ إلا مَن طال باعه في التفسير وذاع صيت اشتغاله بهذا الفنّ، فيجمع حينها بين الفهم والتفسير.
ومن جهة أخرى، فإنّ فهم القرآن غير ملزِم لكلّ أحد؛ إِذْ هو فهم شخصي يُبنى على ثقافات ومعارف مختلفة ومتنوّعة داخل وخارج العلوم الإسلامية، بل يفهم أيضًا بناءً على إيديولوجيات وخلفيات لا تكاد تُحْصَى، فيفهم منه المسلم ابتداء، ويفهم منه غير المسلم من اليهود والنصارى، بل أحيانًا يفهم القرآن بغية الردّ عليه في صور عدّة كمراحل كتابته أو جمعه أو لغته، كما هو حال جُلّ المستشرقين.
أمّا تفسير القرآن فهو ينطلق للوصول إلى الكشف عن مراد الله عز وجل، وهذا يَلْزَم كلَّ أحد، وخاصة فيما يقع عليه الإجماع في تفسيره، وللتوضيح أكثر فمثلًا: «نحن تجاه علم القانون يُنظر لنا كمثقفين لا غير، نستطيع أن نقرأ أيَّ نصٍّ قانوني، وأن نفهمه بالقدر الذي تتيحه لنا عقولنا ومستوى ثقافتنا، ونناقشه فيما بيننا، بل قد نلقّنه لغيرنا، ولكن دوائر القضاء والتشريع لا تعترف بغير ذوي الاختصاص في القانون، ولا تجيز لأيّ مثقف منّا غير قانوني متخصّص أن يتصدّى ليُعتمَد قولُه في إفتاء الناس في هذا النصّ أو الحُكْم به أو الدفاع بمقتضاه»[6]، وهذا حال مَن يفهم القرآن بعيدًا عن قواعده وأصوله ومناهجه...، فيبقى خارج الدائرة المعرفية التخصّصية كثير الخطأ نادر الصواب.
أمّا من جهة عُدّة الاشتغال فإنّ التفسير يحتاج لعُدة منهجية منضبطة، نشأت وبرزت منذ بروز التفسير وتطوّرت معه من خلال المراحل والمنعطفات التي شهدها التفسير في سيرورته. وعليه، فإنّ التفسير قام على منهج يؤطّره ويضبط ممارسته حتى لا تخرج من حيّز الانضباط إلى فضاء التسيّب، أمّا فهم القرآن فإنه ينطلق من العُدّة المعرفية والعلوم المتوفرة لدى الشخص الذي يسعى لفهمِ القرآن لا تفسيرِه، فيسعى جاهدًا لتكييف تلك العُدّة المتوفّرة مع الآيات التي يتوخّى فهمها، فالطبيب يفهم بطبّه، والفلسفي يفهم بفلسفته، والتربوي بتربويّاته.
أمّا من حيث مخرجات فهم القرآن وتفسيره فلا يمكن الحكم عليها قطعًا بالصحة أو الصواب إلا في حالة لها اعتباراتها، ولكن إذا قُمْنَا بمقاربة مخرجات تفسير القرآن وفهم القرآن، فإننا نجد المفسِّر للقرآن سواءٌ أصاب أو أخطأ فإنه يدور دائمًا في فلك المعاني والدلالات التي لها أدلّتها المعتبرة، دون الإخلال بنظام القرآن أو بترِ معانيه أو قطعِ سياقاته أو القفز على أسباب نزوله، أو الإتيان بالغريب والعجيب الذي لا يقبله العقل أو النقل، وذلك راجع للأُسس والمرتكزات التي تنبثق منها عمليات التفسير.
أمّا فهم القرآن بالمعنى المتقدّم فغالبًا ما يشتغل في دائرة بعيدة عن المقصود من التفسير، ويأتي هذا البُعد نتيجة البَوْن الذي يحصل بين مَنْ يريد فهم القرآن من خلال ثقافته أو تخصّصه، دون أدنى استحضار أو اعتبار لأصول التفسير وقواعده وما تقرّر في هذا الشأن، فيوظِّف الإسرائيليات من حيث لا يحتسِب، أو يهمل السياق أو يلوي معاني الآي، أو يأتي بالغريب والبعيد، ويتعسَّف ويتكلّف... وواقع هذا الفهم أعظم الشهود.
أمّا من حيث التقاطع والاجتماع والافتراق، فإنّ فهم القرآن إذا اعتمَد على المقرّر في علم التفسير بالمعنى المتقدّم من قواعد وأصول ونظريات ومناهج واتجاهات... فإنّ من الخطأ أن يُسَمّى فهمًا للقرآن، بل يُعَدّ أعلى درجات التفسير والاشتغال على النصّ القرآني وبيان معانيه وأحكامه وحِكَمه والوقوف على أسراره ولطائفه، هو مَن جمَعَ بين المعتمَد في علم التفسير، وبين ما يمتلكه الممارس لعملية التفسير من معارف وعلوم وثقافات ولغات خارجة عن ماهية علم التفسير وما يشتغل به.
ثالثًا: تاريخ التفسير وتحقيب التفسير:
يلحظ المتأمّل في مدونة التفسير مدى قيمة الجهود المبذولة من لدن علماء هذا الفنّ كتابةً وتأليفًا منذ بروز ملامحه الأولى إلى عصرنا الراهن، ويتجلّى ذلك من خلال المصنفات المتنوّعة في أغراضها وأساليبها واتجاهاتها، وكذلك جزئياتها وأحجامها، مما يجعلها تراثًا تفسيريًّا ضخمًا ذا أهمية بالغة، ومن داخل هذا المستودع الهائل من مدونات التفسير تنبع إشكالية الاستفادة منه، بحيث إن الباحث في التراث التفسيري يجد صعوبة كبيرة في فهم تشكّلاته ومراحله وغير ذلك مما يثري فهم التفسير والتعرّف عليه وحُسن الاستفادة منه.
وفي هذا السياق المتصل بالنظر في تاريخ التفسير فمن المهم التفريق بين مفهوم تاريخ التفسير وتحقيب التفسير، وإدراك طبيعة العلاقة الناظمة بينهما والمتمثّلة في العموم والخصوص، بحيث يعتبر تاريخ التفسير هو اشتغال عام بالتفسير فيشمل الاعتناء بالمفاهيم وأطوار تشكّلها، وكذلك المناهج والاتجاهات والكتب وأصحابها...إلخ، في حين أنّ تحقيب التفسير هو اشتغال خاصّ على التفسير من حيث هو، وسيتضح هذا أكثر في ثنايا نقاش المفهومَيْن والتمثيل لهما.
فتاريخ التفسير: عبارة عن تتبّع المسار العام للتفسير بمختلف تفاصيله، أمّا تحقيب التفسير: فهو تتبّع لمسار التفسير من حيث هُو، أي: تتبعٌ للتفسير ذاته والمنعرجات التي مَرّ بها خلال مسيرته، وذلك من خلال تحديد منضبط يخضع له هذا الحصاد التفسيري الضخم؛ ليسهل بعدها التقسيم وإلحاق التفسير بحقب زمنية معقولة بناء على ضوابط ومعايير معتمدة، بحيث يُسعِف هذا التحقيب في ترتيب وتنظيم ومعرفة مراحل تَشكُّلِ التفسير، ومعرفة المسارات والسياقات التي مَرّ بها، مع الوقوف على محطّات الركود التي عرفها لدراسة أسباب ذلك، وإدراك المنعطفات المركزية والثروات المعرفية والمنهجية التي نهضت بالتفسير في مسيرته بين الفينة والأخرى.
ومن التجارب المهمّة جدًّا لتقريب مفهوم تحقيب التفسير، تجربة الدكتور/ خليل محمود اليماني الذي قَدّم طرحًا لبناءٍ نظري معياري لتحقيب التفسير، وهو أمر جدير بالاهتمام والدراسة حيث بَيَّن أنّ: «بناء معيار ضابط لعملية تحقيب التفسير يجب أن يتم منهجيًّا بنظرنا من خلال تأمّل التفسير في ذاته والمعقِد الأكثر جذرية في ساحته، بحيث يؤدِّي وقوع التباين في هذا المعقد إلى وقوع تباينٍ جذري في ساحة هذا الفنّ وتغيّرٍ يَطال هويته وشخصيته، ومنه يصير هذا المعقد في هيئة معيار لقراءة تاريخ هذا الفنّ»[7]، الأمر الذي سيمكِّن المشتغل بالتفسير من امتلاك ناصيته بعد معرفة مساراته ومنعطفاته وأهم محطّاته التي لا شكّ أنها ستسهم في تفعيل هذا الرصيد حضاريًّا.
وقد أرجع هذا المعقد الأساس الذي هو بمثابة معيار للتحقيب المقصود الذي يمكن الاستفادة منه في العصر الراهن إلى حيثية التفسير باعتبارها «النَّسَق المؤطِّر لممارسة الفنّ والمحدِّد لأهدافه وغاياته ومقاصده، وبالتالي فمتى وقع تغيّر في حيثية المجال نتج عنه تغيّر شديد المركزية في هوية الفنّ، حيث يتغير مفهوم الفنّ وتتغير ثمرته وأهدافه وغاياته وغيرها من الأمور بالغة الأهمية... كما يتغيّر جانبه النظري والشروط المنهجية الخاصّة بممارسته»[8].
وعليه، فإنّ هذا النموذج الذي عُني بتحقيب التفسير جعله ينطلق من خلال حيثية التفسير التي تتمثّل في الاشتغال على المعنى قائلًا: بعد تبيان مركزية هذه الحيثية في التحقيب: «أنّ التفسير مرّ بثلاث مراحل رئيسة؛ فبدأ بتبيان معاني النصّ القرآني (على خلاف في مفهوم هذا المعنى)، ثم انتقل لتبيين المعاني إضافةً لأغراض أخرى تختلف بحسَب مشاغل المفسِّرين، ثم تحول كليًّا للكشف والبيان عن رؤى النصّ تجاه مختلف القضايا والشؤون التي عَرَض لها وعالجها»[9]. وبعد تحقيب التفسير بناء على الاشتغال بالمعنى وهو الأساس، رام بيان الفترة الزمنية الخاصّة بكلّ مرحلة، فالمرحلة الأولى وهي: الاشتغال بتبيين المعنى كانت من بداية انطلاق التفسير إلى نهاية القرن السادس، وقد تميّز هذا الاشتغال بالمعنى اللغوي والمعنى السياقي، وهو الغالب في هذه المرحلة. أمّا المرحلة الثانية التي اشتغلت ببيان المعنى وما فوق المعنى، كانت من أواخر القرن السادس حتى نهاية القرن الرابع عشر. أمّا المرحلة الثالثة التي عُنيت بالاشتغال على ما فوق المعنى، قد كانت من أواخر القرن الرابع عشر إلى العصر الحالي.
ومَن تأمّل الفرق بين تاريخ التفسير وتحقيب التفسير، تبيّن له أن تاريخ التفسير اشتغال عام بالجانب التاريخي للعمل التفسيري، مِن تتبّعِ مظاهرَ معينةٍ في مدوناته وكتاباته ومناهجه...إلخ، أمّا تحقيب التفسير فإنه تقسيم لمراحل التفسير نفسه، بحيث يمكِّن من الإحاطة بمسار ومسيرة التفسير من بدايته إلى العصر الحالي، كما يمكِّن أيضًا من إدراك مواطن القصور بُغية تقويمها والنهوض بها، بالإضافة لإبراز الفجوات البحثية[10] والفراغات العلمية في التراث التفسيري، بل أكبر من ذلك؛ إِذْ يسهم في بلورة معالم يكون لها حظ وافر في تأسيس علم التفسير.
رابعًا: المنهج التفسيري، والاهتمام أو الاتجاه التفسيري:
من الفروق المفاهيمية التي يجب أن يتبصّر بها المشتغل بالدرس التفسيري، التفريق بين المنهج التفسيري وبين الاهتمام التفسيري، فالأول عبارة عن: «الخطط العلمية الموضعية المحدّدة التي التزم بها المفسِّرون في تفاسيرهم للقرآن الكريم، وهذه الخطط الموضعية لها قاعدة وأُسس منهجية مرسومة، ولها طرق وأساليب وتطبيقات ظهرت في تفاسيرهم».[11] إذًا المنهج التفسيري هو الأساليب التي ينهجها ويتّبعها المفسِّر لبيان مراد الله تعالى من الخطاب القرآني، وتختلف مناهج التفسير من مفسِّر لآخر، وتزداد درجة عمق المنهج وقوّته باعتبار عُدة المفسِّر وإحاطته بالعلوم الموظَّفة في تفسيره.
ولا يتأتّى الوصول لهذه المناهج إلا من خلال مسلكَيْن اثنَيْن؛ الأول: هو إعلان وتصريح من لدن المفسِّر في مقدّمة تفسيره بالمناهج التي سلكها، وهذا أيسر المسالك وأسهلها لإدراك منهج المفسِّر. أمّا الثاني: أن يكون المنهج مبثوثًا في ثنايا التفسير ولم يصرّح به المفَسِّر في مقدّمته، وهنا يتكبّد الباحث المشتغل بمناهج المفسِّرين عناء ومشقّة الاستقراء التام لهذه المناهج شيئًا فشيئًا حتى تكتمل له الصورة النهائية لمنهج المفسِّر.
أمّا الاهتمام التفسيري الذي قد يعبّر عنه أيضًا بالاتجاه التفسيري، فهو التأثُّر الملحوظ والغالب لدى المفسِّر فيما يفسِّره ويُبرِزه من معاني القرآن، بحيث ينتج هذا التأثر إمّا لخلفيات المفسِّر وانتمائه كالتفسير الكلامي والفلسفي، أو يكون هذا التأثر راجعًا لبراعته في علمٍ ما؛ كالتفسير الفقهي واللغوي، كما يكون أيضًا هذا الأثر نتيجة لأهداف المفسّر، كالتفسير الإصلاحي والاجتماعي...، وغيرها من الاتجاهات والاهتمامات التي تبرز من خلال التفاسير.
وتعتبر معرفة الاهتمام التفسيري أيسر من معرفة مناهج المفسِّرين؛ ذلك أن الاهتمام التفسيري يكون بارزًا لدى المفسِّر، فتراه يميل نحوه وينجذب تجاهه، بل يقف معه وقفات مطولة كلّما سمحت له الفرصة خلال عملية التفسير، أمّا منهج المفسّر فلا يكاد يكون ظاهرًا وخاصّة إذا لم يصرح به المفسر ابتداءً، مما يحتاج لجهد وكثرة تأمّل لاستخراجه ونسبته لمفسّرٍ ما.
كما تعتبر مناهج المفسّرين من أبرز القضايا المعوَّل عليها في الرقي بعلم التفسير وتطويره، لكن شريطة أن يتجاوز الاشتغال عليها ما هو معهود من تتبعٍ ووصفٍ فقط، بل يتحقّق هذا التطوير لعلم التفسير من خلال مناهجه إذا ما تم «استقراء صنيع المفسِّرين في تفاسيرهم بحسَب القضية المدروسة أو في تفاسيرهم كلّها، من كيفية نقلهم للنّصوص، وكيفيات توظيفهم لها، وطرائق الاستدلال عندهم، والأدوات التي اعتمدوها، ومسالك النقد والترجيح لديهم، وتأثّرهم بالمصادر أو الأشخاص، ودرجات هذا التأثّر ومدى سريانها على مادّتهم العلمية، والآثار التي نجَمت فعليًّا عن مذهبهم الفقهي أو انتمائهم العقدي أو ترتّبت على ترجيحهم لقول معيَّن في مسألة معيّنة، وكيفية إيرادهم للأخبار، ومدارس الانتماء ومنهجها في قبول الأخبار أو نقدها، وكيفية توظيفهم للمرويات الضعيفة؛ وغير ذلك مما هو متعلّق بأمور لا يمكن أن ينصّ المفسّر عليها»[12].
وبناء على ما تقدّم، فإنّ من الضروري التفريق بين المنهج التفسيري، والاهتمام أو الاتجاه التفسيري لتفادي الخلط بينهما، وضبط القضايا التي تحرّر في ضوئهما. وخلاصة القول أنّ مناهج المفسِّرين إذًا هي الطريق والأسلوب الذي ينتهجه المفسِّرُ في تفسيره، أمّا الاهتمامات فهي المباحث التي يُولِيها المفسِّرُ اهتمامًا كبيرًا أكثر من غيرها مهمَا كان منهجه، كأنْ يَصُبَّ اهتمامَه على آيات الأحكام، أو البناء القصصي، أو اللغوي أو البلاغي للآيات المرادة بالتفسير؛ إذًا فالشقّ الثاني بعيد عن مناهج المفسِّرين.
خامسًا: ألفاظ القرآن ومصطلح القرآن:
لقد اعتنى الخطاب القرآني بألفاظه ومصطلحاته وأَوْلاها عناية خاصّة تركيبًا ودلالةً وتوظيفًا؛ وذلك وَفق ما يميّزها عن غيرها، وبين بعضِها بعضًا، مراعيًا في ذلك أهدافه وغاياته، إلا أنّ الناظر يلحظ خلطًا بين ألفاظ القرآن وبين مصطلحاته، وما أَرُومُه في هذا الطَّرْح هو تقريب مفهوم كلّ من ألفاظ القرآن ومصطلح القرآن مبرزًا بعض الفروق في ثنايا النقاش مع السعي للتمثيل ما أمكن.
وألفاظ القرآن؛ هي مفردات وافقَت اللغة العربية دلاليًّا، أي: وافقتْ وتطابقتْ مع ما عرفته العرب قبل نزول القرآن الكريم، ولم يُكْسِبْها الاستعمالُ القرآني حمولةً مفاهيمية خاصّة، والمقصود بالموافقة هاهنا من حيث الشّكل والمضمون، وما أضفاه الخطاب القرآني على هذه المفردات هو تمتيعها بصفة القدسية والتأثير المعجِز. ومن أمثلة ذلك تجسيرًا للمراد:
- فلفظ (العبودية)، الذي هو دالّ في أصله على الخضوع والتذلّل، وكلّ خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة، والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقّه إلا من كان له أعلى منزلة من الإنعام، ومفهوم هذا اللفظ في القرآن لا يخرج عن المعنى اللغوي المعروف، فمعناه العبادة من قِبَل العبد الخاضع لربه، المستسلم المنقاد لأمره، وبهذا المعنى استُعمل اللفظ قبل نزول القرآن وبعده، فكان مفهومه واحدًا[13].
- أمّا لفظ (الكعبة)، وهي بيت الله الحرام، وقد أخذتْ تسميتها من شكلها الهندسي، فكل بناء مربع عند العرب فهو كعبة، والكعبة اسم عربي صميم، وقد أطلقوه على هذا البناء لمكانته السامية، وهذا المعنى الذي دلّ عليه مصطلح (الكعبة) هو المعنى نفسه الذي ورد في القرآن الكريم، فلم يطرأ عليه أيُّ تغيير قبل نزول القرآن أو بعده[14].
أمّا المصطلح القرآني فهو: عبارة عن كلّ لفظ قرآني بيَّنَ مفهومًا قرآنيًّا، معنى ذلك: هو لفظ من ألفاظ القرآن الكريم، مفردًا كان أو مركبًا، اكتسب داخل الاستعمال القرآني خصوصية دلالية قرآنية جعلتْ منه تعبيرًا عن مفهوم معيّن له مَوقع خاصّ داخل الرؤية القرآنية ونسقها المفهومي[15]. فيدخل في ذلك كلّ أسماء المعاني وأسماء الصفات المشتقة منها في القرآن الكريم، مفردة أو مركبة، مُطلَقة كانت أو مقيّدة، وعلى الصورة الاسمية الصريحة، أو على الصورة الفعلية التي تؤوّل بالاسمية[16]. وبيّنَت الدكتورة/ فريدة زمرد بأنه: كلّ لفظ دلَّ على مفهوم قرآني خاصّ لم يكن متداولًا عند العرب قبل نزول القرآن الكريم[17].
ويُستخلص مما سبق أنّ كلّ لفظ -سواءٌ كلمة أو جملة- له دلالة خاصّة في نسق القرآن الكريم. وقد عبّر بعض العلماء عن المصطلحات القرآنية بالمفردات الشرعية أو الإسلامية، إلا أنّ هذه التسمية تبعدها عن حقيقتها بعض الشيء؛ إِذْ توحي أنها وليدة الإسلام، في حين أن هذا الأمر ليس على عمومه ولا يشمل كلّ المصطلحات -كما سيأتي في الأنواع-؛ إذ العديد منها ذات جذور تاريخية ولغوية قبل نزول القرآن؛ لذلك فإن التعبير عنها بالمصطلحات يبقى هو التعبير الأمثل، ومن جهة أخرى فإن المصطلح القرآني يتميز بأنواع عدّة، أبرزها:
مصطلحات ضاقت دلالاتها:
بمعنى أنّ هناك مصطلحات عامة الدلالة فخصّص القرآن مدلولها، وتخصيص الدلالة يعني أن تقتصر الدلالة العامة على بعض أجزائها فيضيق شمولها بحيث يصبح مدلول الكلمة مقصورًا على أشياء أقلّ عددًا مما كانت عليه في الأصل[18]، ومن الأمثلة على المصطلحات التي ضاق مدلولها ما يأتي:
- مصطلح (الرسول)، في أصله اللغوي الانبعاث على التؤدة، ومنه الرسول المنبعث، ثم تطوّر اللفظ ليدلّ على الرِّفق تارة، والانبعاث تارة أخرى. و(الرسول) لفظ يصدق على كلام المرسل، وعلى حامل الخبر، وفي النصّ القرآني دلّ على الإنسان الذي يختاره اللهُ -عز وجل- لينشر في الناس الرسالة، ويبلغ الناس دين ربه، فالقرآن خصّص معنى اللفظ (الرسول) وجعله مرتبطًا برسول الله الذي يبلّغ عن ربه أحكامه ودينه وشرائعه[19]. وغيرها من المصطلحات التي ضاق معناها اللغوي في القرآن بعد نزوله؛ كالشفاعة، والصلاة. بحيث جعلها القرآن تدلّ على العبادة المعهودة التي علّمَنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم.
مصطلحات اتّسعت دلالاتها:
وهذا الصنف هو ما كانت دلالته اللغوية ضيّقة ومحدودة في مدلولات معيّنة إلا أن النصّ القرآني أكسبها توسعة لتشمل العديد من المعاني والمدلولات أكثر مما كانت عليه، ومن نماذج هذه المصطلحات ما يأتي:
- مصطلح (الفِسْق)، العرب تقول إذا خرجت الرُّطَبة عن قشرتها: قد فسَقت الرطبة من قشرتها، وسُمّيت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها على الناس، وفي النصّ القرآني دلّ مصطلح (الفسق) على العصيان والترك لأمر الله -عز وجل- والخروج عن طريق الحقّ، وقيل: الفسوق الخروج عن الدِّين، والميل إلى المعصية، مثلما فسق إبليس عن أمر ربه[20]. ومثل هذا المصطلح أيضًا: (الكفر)، و(النفاق).
مصطلحات انتقلت دلالاتها:
وهذا الصّنف من المصطلحات يفارق دلالته الأصلية، حاملًا في طياته دلالات جديدة منَحَه إياها الخطاب القرآني، ومن الأمثلة التي تخصّ هذا الصنف من المصطلحات ما يأتي:
- مصطلح (الركوع)، معناه اللغوي هو (شدّة الانحناء)، ولكن المعنى الأول قد نُسِي ولم يَعُد يُستعمل إلا عند اللزوم، ثم انتقل معناه ليصبح دالًّا على الخضوع والتذلّل، وهو معنًى مجازيٌّ متطوّرٌ عن المعنى اللغوي الأساس وهو الانحناء والانخفاض، ومن هذا المعنى تفرّعت معانٍ مجازيةٌ كثيرة، فقالوا: ركع الرجل، إذا افتقر بعد غنًى كأنما حَنى الفقرُ ظهره بعد أن كان مستويًا، ويبدو أنّ العرب ساروا خطوة ضيّقة نحو معناه الاصطلاحي فكانوا يسمُّون الحنيف راكعًا. ولم تنتشر دلالة المصطلح إلا بعد نزول القرآن فصار إذا أُطلق فهو لا يعني إلا الركوع في الصلاة، وسميت أجزاء الصلاة بالركعات؛ لأنه يمثل الحد الفاصل بين كلّ قيامين أو وقفتين يقفهما الإنسان في صلاته[21]. ومثل ذا أيضًا من المصطلحات التي انتقلت دلالاتها اللغوية: الجنة، الطواف، الفرض، الغيّ، المغفرة، المناسك.
مصطلحات قرآنية جديدة:
وهذا النوع يعبّر عن مصطلحات لم تكن مألوفة أو معهودة في البيئة العربية، كما أنها لم تكن أجزاء من كلمات أخرى معروفة في كلام العرب، إِذْ لم تعرفها العرب حتى ظهور شمس الإسلام، وهذه المصطلحات استحدثها النصّ القرآني وأعطاها دلالات جديدة وخاصة لم تتطرّق لها العرب من قبلُ، ومن أمثلة هذه المصطلحات:
- مصطلح (جاهلية)، بحيث لا يوجد لهذا المصطلح مثيل قبل نزول القرآن الكريم، وهي صيغة أوجدها القرآن الكريم وانتشرتْ فيما بعد لتكون عَلَمًا على الفترة التي سبقت نزول القرآن، وهو مستمدّ في دلالته من الجهل بمعنى السَّفَه والطّيش والحميّة الزائفة للتعبير عن الحياة التي كان يحياها الإنسان في العصر الجاهلي وليس من قَبِيل الجهل ضدّ العلم[22].
سادسًا: التجديد في التفسير والجديد في التفسير:
من المعلوم في نسق المعرفة ونظامها عامة أن كلّ عِلْم يجب أن يشهد حركة تسهم في النهوض به بين الفينة والأخرى، حيث تكون هذه الحركة على سبيل الاستمرارية والدوام تحقيقًا لمقاصده المرجوّة منه، وهذا الحركة هي التي تسمى تجديد العلم، وإن ارتباط حركة التجديد بعلم التفسير قضية مركزية من أولويات العصر، لكن ثمة إشكالات تحيط بهذه القضية، ومن أبرزها الخلط بين التجديد في التفسير والجديد في التفسير؛ إذ الأول هو عبارة عن حركة منهجية خالصة تطال علم التفسير باعتباره أحد العلوم الإسلامية وله مبادئه وأُسسه ومرتكزاته، بحيث يقوم هذا التجديد في التفسير على قواعد وشروط منضبطة تسعف في تحقيق هذا المطلب المنهجي الذي نحن في أمسّ الحاجة إليه، كما أن هذا التجديد لا يشتغل ببيان المعاني والدلالات بل يبحث في بنية علم التفسير ومرتكزاته وأُسسه.
أمّا الجديد في التفسير فعلى أهميته لا يعدو إلا أن يكون اجتهادًا في تقديم دلالات وفهوم ومعانٍ جديدة في ضوء أحوال الناس وظروفهم ومستجدّاتهم بما يتناغم مع مختلف مناحي الحياة، ومن صور الجديد في التفسير على سبيل المثال: ربط التفسير بالاكتشافات والأحداث العلمية الحديثة، وكذلك استخراج معانٍ لم يُتَوصل لها من قبلُ، ومن ذلك أيضًا توثيق الصِّلة بين التفسير والواقع، وشقّ سبلٍ جديدة لهداية الناس، مع الإجابة على مستجدّات ومتغيرات الحياة...، وغيرها من صور الجديد في التفسير وليس التجديد.
ويدخل في الجديد في التفسير بعض الاشتغالات التي تثري الواقع البحثي في علم التفسير؛ كتحقيق وتنقيح ما أُثِر في علم التفسير بكلّ اتجاهاته من التصحيف والتحريف الذي شكّل نوعًا من الدَّخَنِ والوهن، وكذلك توسيع مباحث القواعد والنظريات التفسيرية؛ إمّا عن طريق تعميقها أو تقويمها وتحريرها مع تحديد مواطن النُّضج والقصور كيفًا وكمًّا، مع تثمين وتتمة جهود الأوائل في هذ العلم عن طريق المواكبة الإيجابية للعصر وتفسير مستجدّاته، مع الإسهام في إيجاد حلول لوقائعه ونوازله عن طريق علم التفسير، ومحاكمة الأقوال القديمة في التفسير والاختلافات الواقعة فيها.
ومما تقدّم يتبيّن أن التجديد في التفسير هو مطلب عِلْمي واشتغال منهجي صرف، أمّا الجديد في التفسير فهو ضرورة دعوية وغالبًا ما يرتبط بمعاني الآيات ودلالاتها، كما أن التجديد في التفسير يشتغل على مرتكزات علم التفسير وأُسسه، أم الجديد في التفسير فغالب ما يشتغل على آي القرآن.
خاتمة:
لا شكّ أنّ مباحث الفروق من أبرز المباحث والمسالك التي يجب الاعتناء بها في الدّرس التفسيري؛ لِمَا لها من أثر بالغ في ضبط وتحرير كلّ القضايا والمسائل المتعلّقة بها، والتي بدورها توظَّف في الدرس التفسيري، بل توظَّف أحيانًا في بناء مرتكزات وأُسس هذا الفنّ، وما تقدّمَت به هذه المقالة ليس سوى جذب الانتباه وإثارة البحث حول فروق في الدرس التفسيري.
ومما يمكن توسيع دائرة البحث فيه من خلال هذا الطرح من الكتابة بُغية أن يتخطّى المشتغل بالدرس التفسيري ما يقع من خلط أو التباس في توظيف مفاهيم الدرس التفسيري وخاصّة العلمية منها =هو الاشتغال على إبراز فروق المفاهيم والتنبيه عليها داخل حدود الدرس التفسيري المعهود على وجه التعجيل؛ لِمَا لُوحظ من استفحال ظاهرة الخلط لدى الدارِسين، ثم توسيع الدائرة لتشمل المفاهيم المرتبطة بسياق القراءات الحديثة للقرآن التي أناطها أصحابها بالتفسير، ثم توسيع الدائرة أكثر لتغطي المفاهيم التي برزت في الساحة الغربية لدى المعتنين بهذا الشأن تفاديًا لإشكالية الخلط بين المفاهيم ودلالاتها وحدود مجالات اشتغالها.
[1] مقاربة في ضبط معاقد التفسير: محاولة لضبط المرتكزات الكلية للعلم ومعالجة بعض إشكالاته، خليل محمود اليماني، مقالة على موقع مركز تفسير على الرابط الآتي: tafsir.net/article/5299، ص: 8- 10- 12، 13- 16، بتصرف.
[2] تأسيس علم التفسير أسبابه وأهميته، مع طرح مقاربة تأسيسية، خليل محمود اليماني، بحث منشور على موقع مركز تفسير على الرابط الآتي: tafsir.net/research/72، ص26، بتصرف.
[3] تأسيس علم التفسير؛ أسبابه وأهميته، مع طرح مقاربة تأسيسية، خليل محمود اليماني، ص25- 27.
[4] يُراجع: تأسيس علم التفسير؛ أسبابه وأهميته، مع طرح مقاربة تأسيسية، خليل محمود اليماني، ص25- 27.
[5] ينظر: تأسيس علم التفسير أسبابه وأهميته، مع طرح مقاربة تأسيسية، خليل محمود اليماني (المبحث الثاني الذي خُصص للحديث عن تأسيس علم التفسير، المطلب الأول: علم التفسير: المبادئ والمحاور).
[6] القرآن الكريم بين الفهم والتفسير، من مجلة شهرية: الدراسات الإسلامية وشؤون الثقافة والفكر، على الرابط الآتي، بتصرف: www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/3192
[7] تحقيب التفسير؛ قراءة في التحقيب المعاصر مع طرح تحقيب معياري للتفسير، خليل محمود اليماني، بحث على موقع تفسير للدراسات القرآنية تحت الرابط الآتي: tafsir.net/research/60، ص30.
[8] تحقيب التفسير قراءة في التحقيب المعاصر مع طرح تحقيب معياري للتفسير، ص39.
[9] تحقيب التفسير قراءة في التحقيب المعاصر مع طرح تحقيب معياري للتفسير، ص86.
[10] الفجوات البحثية: هي المسائل أو القضايا العلمية الراهنة في التخصّص المذكور، وقد غاب عنها الباحثون والمهتمّون، أو أنها معلومة ولم يوجد لها حلّ بعدُ، بحيث تشكِّل فراغًا أو بالأحرى نقصًا علميًّا يمكن تداركه لتحقيق إسهام فعّال في خدمة التخصّص المذكور بشكلٍ جذري، وعادة ما تترجم هذه الفجوة البحثية إلى إشكاليات كبرى رئيسة أو مجموعة من الأسئلة بغية إخضاعها للبحث الجادّ والدراسة المعمّقة.
[11] تعريف الدارسين بمناهج المفسِّرين، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 1428هـ/ 2008م، ص16.
[12] حوار فريق موقع مركز تفسير مع د/محمد صالح سليمان، على موقع مركز تفسير على الرابط الآتي: tafsir.net/interview/32.
[13] التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، عودة خليل أبو عودة، دراسة دلالية مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة المنار، 1425/ 2004، ص141- 143، بتصرف.
[14] التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، ص143- 146، بتصرف.
[15] دراسات مصطلحية، الشاهد البوشيخي، الطبعة الأولى، دار السلام، القاهرة، 1433هـ، 2011م، ص109.
[16] القرآن الكريم والدراسة المصطلحية، الشاهد البوشيخي، ص20.
[17] جهود العلماء في خدمة المصطلح القرآني؛ المسار والمصير، فريدة زمرد، بحث مقدّم للمؤتمر الدولي الأول حول القرآن الكريم وعلومه، دار الحديث الحسنية، د.ط، ص551.
[18] دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، الطبعة الثالثة، بيروت، 1990م، ص52.
[19] التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، عودة خليل أبو عودة، ص130- 131.
[20] الكلمات الإسلامية في الحق القرآني، عبد العال سالم مكرم، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة 1417هـ= 1997، ص124.
[21] التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، عودة خليل أبو عودة، ص189- 190.
[22] التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، عودة خليل أبو عودة، ص149- 150.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

يوسف عكراش
باحث في الدراسات الإسلامية والقضايا الفكرية والتربوية، وله عدد من الأعمال العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))