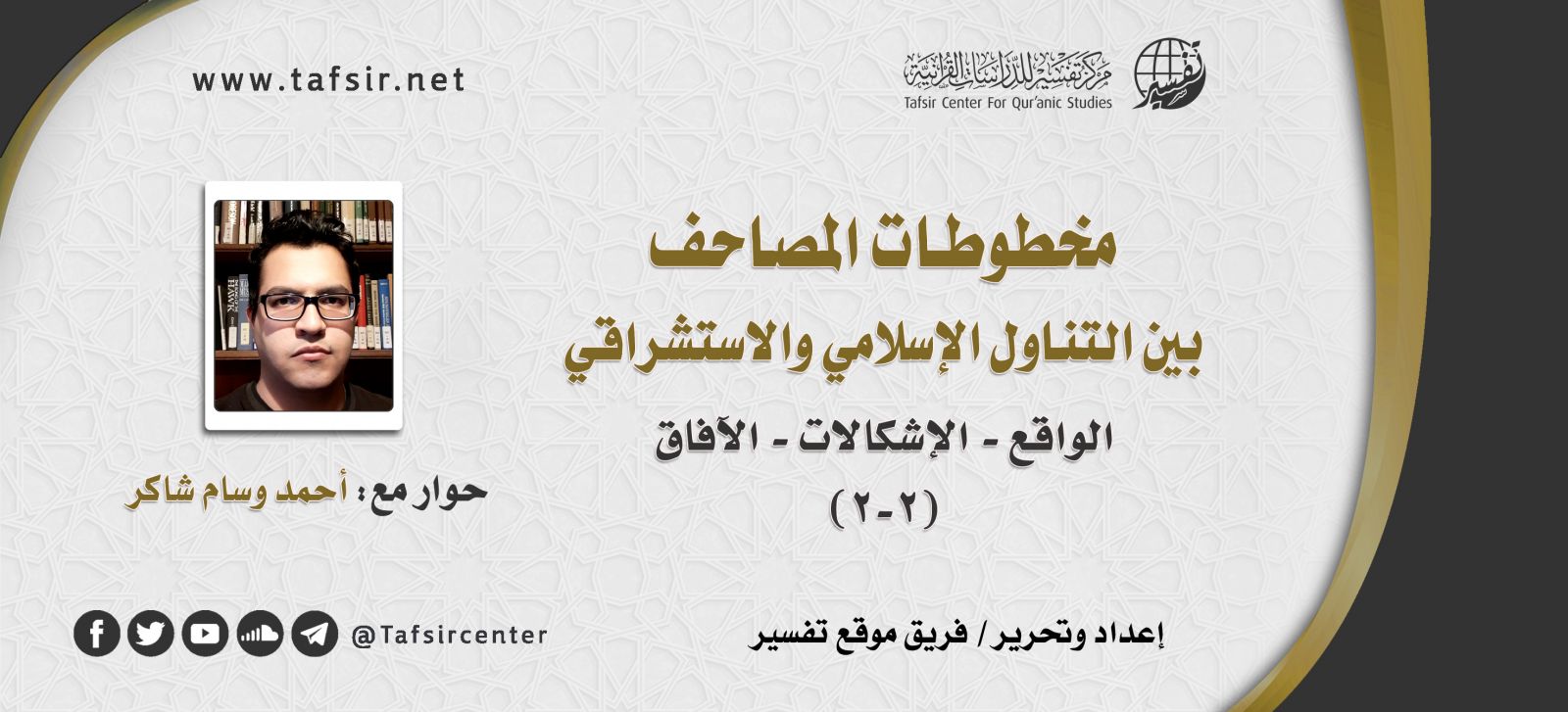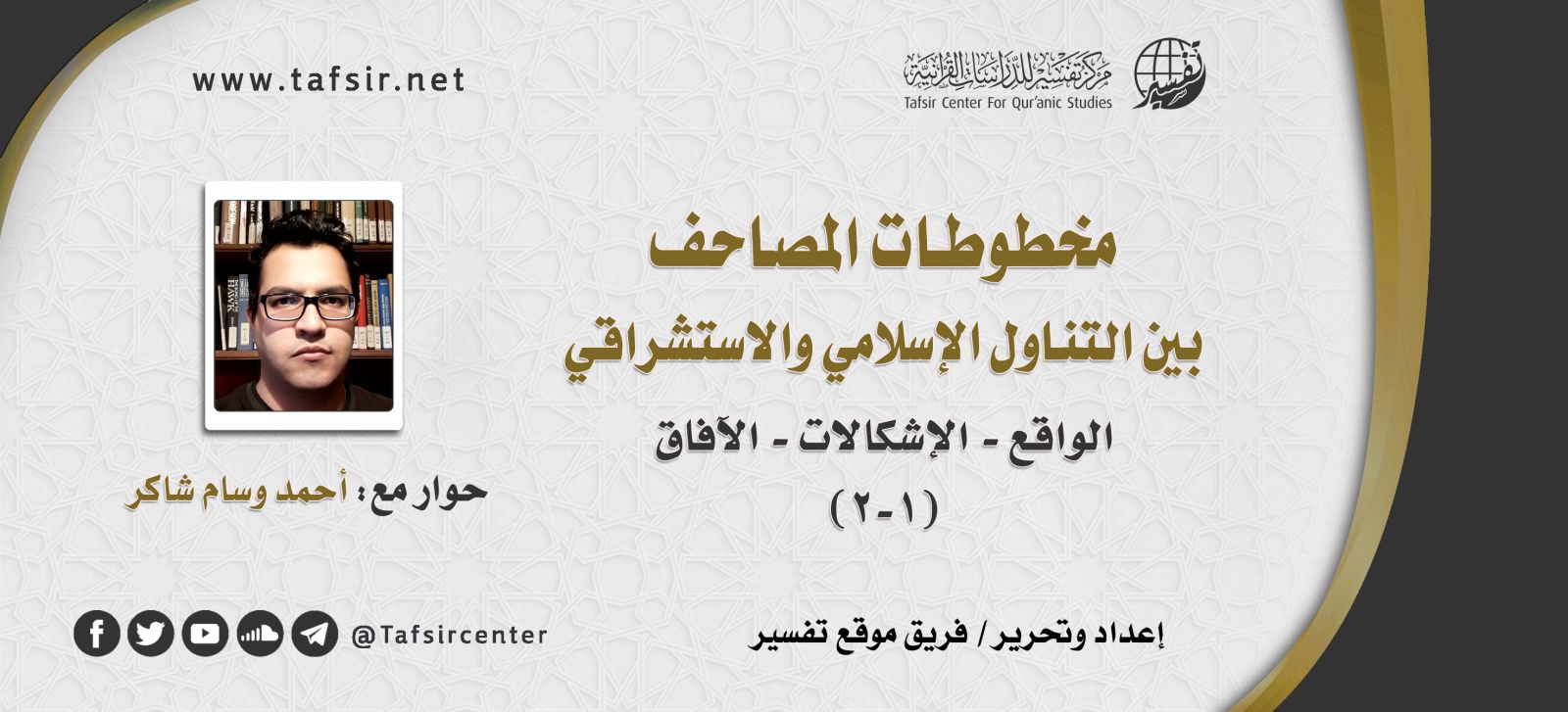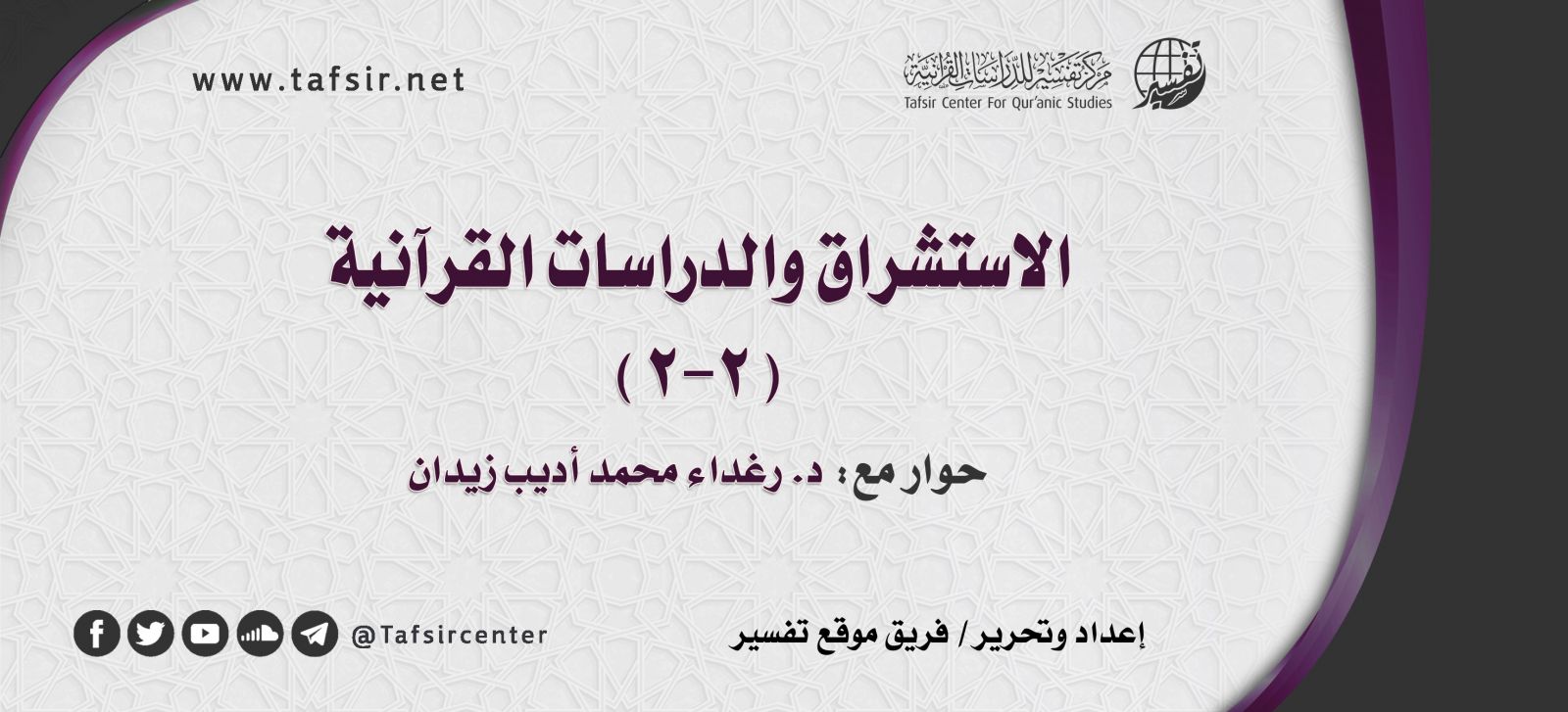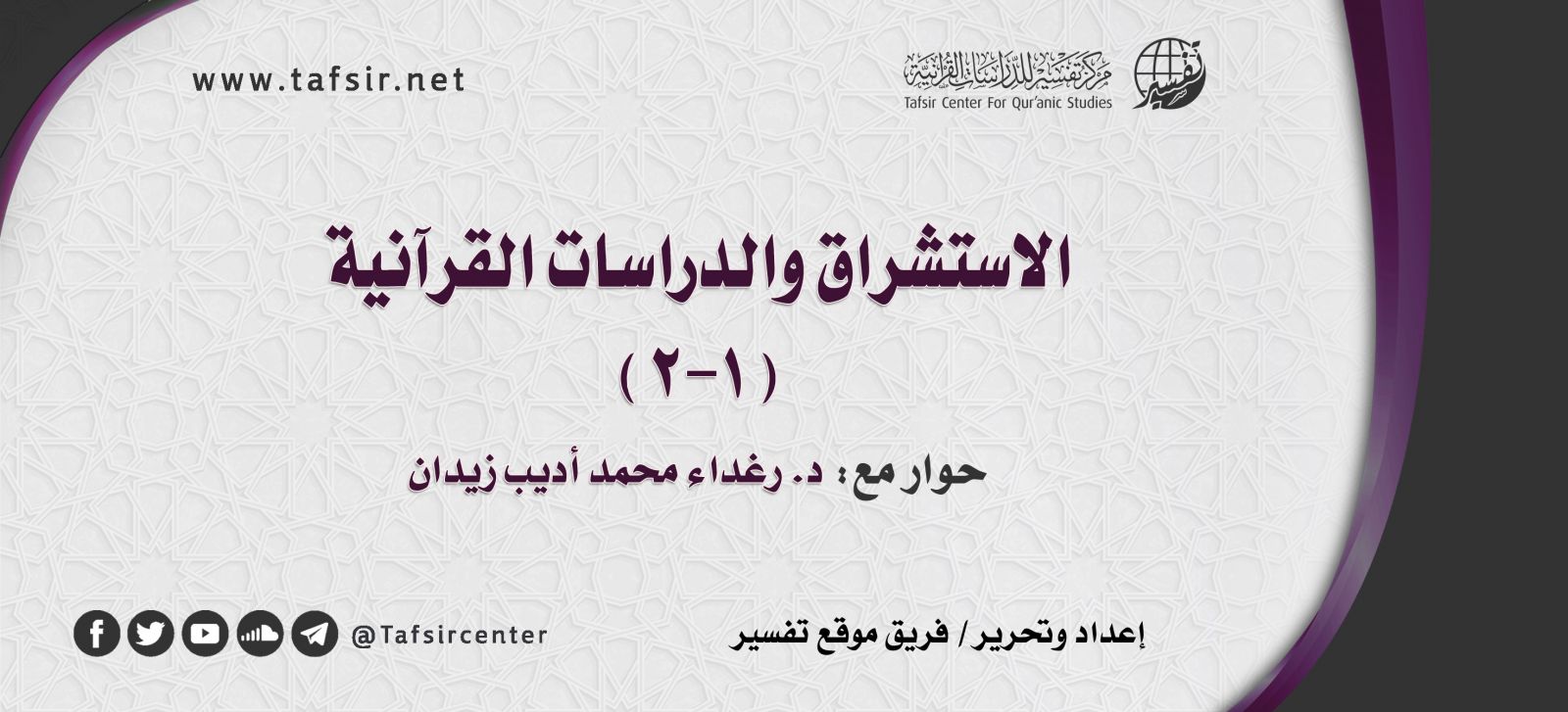الاستشراق الألماني؛ نشأته وسماته ومستقبله
الاستشراق الألماني
نشأته وسماته ومستقبله
إعداد: ليلى ثمراوي

الاستشراق الألماني أحد أهم المدارس الاستشراقية الغربية، يتناول هذا الحوار مع د/ عبد الملك هيباوي نشأة الاستشراق الألماني، وأهم السمات التي يتميَّز بها عن غيره من المدارس، كما يلقي الضوء على مستقبل هذا الاستشراق.
مقدمة:
يمثّل الاستشراق ظاهرةً معرفيةً وسياسيةً مهمّة في تاريخ العلاقة بين الشرق والغرب، وقد أصبح نتاج الاستشراق حول الشرق والإسلام والقرآن جزءًا من الخريطة المعرفية المعاصرة لدراستهم، مما يحتِّم علينا محاولة فهم الظاهرة وطبيعتها وحدودها وطُرق التعاطي المعرفي معها. ويعتبر الاستشراق الألماني تحديدًا من أهمّ المدارس الاستشراقية؛ بسبب توسّع نتاجه حول الإسلام واللغة العربية والقرآن.
يتناول هذا الحوار -الذي أجرته الأستاذة/ ليلى ثمراوي، مع الدكتور/ عبد الملك هيباوي- الاستشراق الألماني، فيبين نشأة هذا الاستشراق، ويحدّد السِّمات الخاصّة التي تميّزه عن غيره، كذلك يحاول استشراف مصير هذه المدرسة في ظلّ الواقع المعاصر في ألمانيا.
س1: كيف ترى أهمية التفاعل مع الاستشراق عمومًا؟ وكيف ترى الاستشراق الألماني؟ وهل ثَمّ خصائص له تجعلنا أمام مدرسة استشراقية ألمانية؟
د/ عبد الملك هيباوي:
يبدو الاهتمام العربي والإسلامي بإنتاجات المستشرقين -ولا سيّما الألمان منهم- ضرورةً علميةً وثقافية مُلِحّة، إذا ما قُورن بحجم العناية التي أَولاها هؤلاء لحضارة الشرق عامة، وللحضارة الإسلامية خاصّة. فالباحث العربي مدعوّ اليوم، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إلى دراسة هذا الإنتاج الاستشراقي دراسة واعية، لا تكتفي بالاطّلاع السطحي، بل تنفذ إلى تاريخه، وقضاياه، ومناهجه، وأهدافه، والظروف الفكرية والسياسية التي أسهمت في تشكيله. ولا يهدف هذا الجهد إلى الردّ أو الدفاع فحسب، بل إلى تمكين القارئ العربي من أدوات معرفية وخلفية نظرية رصينة، تساعده على الانخراط في حوار متوازن مع الغرب، حوار تفرضه تحديات العصر، وينسجم في جوهره مع الرؤية الإسلامية التي تؤكّد قيمة التعارف والتواصل بين الشعوب، كما جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13].
وما دام الاستشراق ظاهرة متعدّدة الخلفيات، متباينة الأهداف، مختلفة النتائج، فإنّ التعامل معه يقتضي قدرًا عاليًا من الفحص العلمي الدقيق؛ تجنُّـبًا للتعميمات والأحكام الانفعالية المسبقة التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الموضوعية. كما يقتضي هذا التعامل التمييز بين المدارس الاستشراقية المختلفة، وفهم منطلقاتها في مقاربة التراث الإسلامي وحضارته. ويُعَدّ امتلاك ناصية اللغات الغربية، وفي مقدمتها الألمانية، شرطًا أساسًا في هذا السياق؛ إِذْ إنَّ ضعف الإلمام بهذه اللغة أسهم في بقاء عدد كبير من أعلام الاستشراق الألمان، قديمهم وحديثهم، شبه مجهولين في الوسط الثقافي العربي، وهو ما حَدّ من فُرَص الحوار والتفاهم بين الإسلام والغرب في قضايا الفكر والدِّين والسياسة، ولا سيّما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها من توترات متصاعدة.
وقبل الخوض في تعريف الاستشراق الألماني وخصائصه، تجدر الإشارة إلى ثلاث ملاحظات منهجية أساسية.
أوّلها: أنّ أهمية البحث في الاستشراق الألماني تنبع من الحاجة الملحّة إلى التعريف به، من حيث نشأته ومباحثه ومناهجه، ومقارنته بغيره من المدارس الاستشراقية. فالاستشراق الألماني، من جهة، لم يسْعَ كثيرًا إلى تقديم نفسه خارج حدوده اللغوية، ومن جهة أخرى لم يُعرَّف به عربيًّا بالقدر الكافي، بسبب محدودية عدد الباحثين العرب المتقِنين للألمانية، وهو ما خلّف فراغًا واضحًا في المكتبة العربية.
ثانيها: تتعلّق بحجم الإنتاج العلمي؛ إِذْ إنّ ما أنجزه المستشرقون الألمان وحدهم يفوق في كمّه ونوعه ما قدّمه نظراؤهم في المدرستين الفرنسية والبريطانية مجتمعتَيْن. وقد شمل هذا الإنتاج مجالات واسعة، من فهرسة المخطوطات وتحقيقها، ونشر النصوص وترجمتها، إلى تأسيس المعاهد والمكتبات، وتعليم اللغات، وبناء التخصّصات الأكاديمية، والبحث الأثري، فضلًا عن الاهتمام بالقضايا المعاصرة في أبعادها السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وبهذه المناسبة أودّأن أشير إلى أنه صَدَرَ لي كتاب سنة 2022 بعنوان: (الاستشراق الألماني: دراسة في النشأة والتطور ومجالات البحث)، الصادر عن الإيسيسكو، والذي عالج معظم هذه القضايا، مع الإشارة إلى صدور طبعة تجارية منقّحَة ومزيدة منه قريبًا بإذن الله.
ثالثها: تتمثّل في ندرة الدراسات العربية التي تناوَلَت الاستشراق الألماني تناولًا شاملًا ومنهجيًّا، باستثناء بعض الأعمال القليلة التي اهتمّت بتاريخه العام أو عالجت بعض قضاياه الجزئية. ومن أبرز ما أُنجز في هذا الباب ترجمات ودراسات قام بها مستشرقون ألمان، مثل أعمال: (رودي بارت)، و(هانس روبيرت رومر)، و(إينو ليتمان)، فضلًا عن الجهود العربية المحدودة، مثل ما ألّفه محمد أحمد منصور ورضوان السيد، وهي -على أهميتها- لا تزال غير كافية لسدّ الحاجة المعرفية القائمة.
أمّا عن سؤال: ماهية الاستشراق الألماني؟ وهل يمكن الحديث عن مدرسة استشراقية ألمانية بخصائص مميزة؟ فإن تعريف الاستشراق، في معناه العام، قد تعدّد بتعدّد المقاربات. ومن أبرز هذه التعريفات ما ورد في (موسوعة دائرة المعارف)، حيث يُنظر إلى الاستشراق بوصفه عِلْمًا يُعنى بدراسة شعوب الشرق في لغاتها، وأديانها، وتاريخها، وجغرافيتها، وآدابها، وعاداتها، وأنماط عيشها، وحضاراتها. وبهذا المعنى، يكون الاستشراق جهدًا معرفيًّا شاملًا ومتعدّد الاختصاصات، هدفه فهم الشرق والتعرّف على مكوّناته الحضارية. أمّا من حيث الصيغة اللغوية، فإنّ لفظ (الاستشراق) يدلّ على طلب معرفة الشرق، وهو يمتدّ جغرافيًّا من نهر الدانوب غربًا إلى اليابان شرقًا، ومن شمال إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا.
غير أنّ هذا المعنى العام لا يعبّر عن المقصود في هذا الحوار؛ إِذْ إنّ المقصود هنا هو المعنى الخاص للاستشراق، كما عرّفته (الموسوعة العربية العالمية)، بوصفه دراسات أكاديمية يقوم بها باحثون غربيون حول الإسلام والمسلمين من الجوانب التاريخية والعقدية والثقافية والحضارية. ووفق هذا المعنى، ينحصر مجال الاستشراق في دراسة العالم الإسلامي وتراثه قديمًا وحديثًا، وهو الفهم السائد لدى الأوساط الأكاديمية والثقافية في العالمين العربي والإسلامي.
ومن هذا المنطلق، يتقاطع الاستشراق في معناه الخاصّ مع معناه العام؛ إِذْ بدأ بدراسة الإسلام واللغة العربية، ثم اتسع ليشمل سائر ديانات الشرق وتاريخه وآدابه ولغاته.
وعلى نحو مماثل، يحمل مفهوم الاستشراق في ألمانيا دلالة عامة وأخرى خاصّة. ففي دلالته العامة، كما ورد في (موسوعة دائرة المعارف)، يشير الاستشراق في ألمانيا إلى مجموعة واسعة من الدراسات اللغوية والتاريخية التي تُعنى بثقافات ولغات الشرق الأدنى، وشمال إفريقيا، وآسيا، بل وتمتدّ إلى دراسة التأثيرات الشرقية في مناطق مثل الأندلس والبلقان والقوقاز. ويظهر هذا الاتساع بجلاء في التخصّصات الأكاديمية المعتمدة في الجامعات الألمانية، من الدراسات المصرية القديمة، واللغات الساميّة، والعبرية، والعربية، وعلوم الإسلام، إلى الدراسات الإيرانية والتركية والهندية والصينية واليابانية والكورية والإفريقية. وقد لخّص المستشرق الألماني (رودي بارت) هذا التوجّه حين حصر الاستشراق في كونه علمًا يشتغل بدراسة الشرق أو العالم الشرقي بمختلف مكوّناته.
ويعكس هذا التنوّع حجم الاهتمام الذي أَوْلته المؤسّسات الأكاديمية الألمانية للشرق، كما يعكس طبيعة العقلية الألمانية القائمة على الجدية والصبر والدقة في البحث العلمي. ويلاحظ الدارس لتاريخ ألمانيا الثقافي والسياسي أنّ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية شكّلَت منعطفًا مهمًّا في تطور مفهوم الاستشراق، حيث اتجه نحو مزيد من التخصّص، وبرَزَت إلى جانب الدراسات اللغوية والتاريخية التقليدية علومٌ اجتماعية واقتصادية جديدة، وظهرت تسميات، مثل: (الدراسات الإسلامية)، و(الأبحاث العلمية في آسيا وإفريقيا).
وهكذا، أصبح الاستشراق الألماني في دلالته الخاصّة أكثر تركيزًا على الشرق الأدنى والعالم الإسلامي، وانحصرت مجالاته الأساسية في الدراسات الإسلامية، والدراسات الساميّة، والعربية، وعِلْم الشرق المسيحي، إلى جانب الدراسات الفارسية والتركية. وأسهم هذا الغنى والتعدّد في تطور هذا الحقل المعرفي وتشعّب مجالاته، بتأثير عوامل سياسية وثقافية وفكرية، واضطلع به جيل من الأكاديميين الذين شكّلوا ما يمكن بحقّ تسميته بالاستشراق الألماني، بسِمَاته ومناهجه وخصوصياته.
أمّا بخصوص الجزء الثاني من السؤال، فإنني أرى من خلال دراسة مسار الاستشراق الألماني في تعاطيه مع التراث الإسلامي والحضارة العربية أنه تميّز، مقارنةً بغيره من المدارس الاستشراقية الأوروبية والأمريكية، بجُملة من الخصائص المنهجية والفكرية التي منحته طابعًا خاصًّا داخل حقل الدراسات الإسلامية. ويمكن تلخيص هذه الخصائص في أربعة محاور كبرى مترابطة.
أولها: تتمثل في ضعف خضوع الاستشراق الألماني للغايات السياسية أو الدينية أو الاستعمارية المباشرة. فقد نشأ هذا الاستشراق في سياق تاريخي لم تَعرف فيه ألمانيا -بخلاف فرنسا وبريطانيا- توسعًا استعماريًّا واسعًا في العالم العربي والإسلامي، كما لم تكن لها مشاريع تبشيرية كبرى في الشرق. وقد أسهم هذا المعطَى في تحرّر نسبي للبحث الاستشراقي الألماني من الإملاءات السياسية والإيديولوجية التي أثّرَت في مدارس أخرى. كما أن تركيز معظم المستشرقين الألمان على التراث الكلاسيكي والتاريخ القديم للمسلمين أبعد أبحاثهم -في الغالب- عن الانخراط في رهانات السياسة الآنية.
وتتجلّى الخصيصة الثانية في غياب النزعة العدائية الممنهجة تجاه العرب والمسلمين. فقد عالج كثير من المستشرقين الألمان الحضارة الإسلامية بروح اتّسمت بالإعجاب والتقدير والإنصاف، بعيدًا عن خطاب التشويه المتعمّد. ويبرز هذا التوجّه في أعمال عدد من الأسماء البارزة التي دافعَت عن اللغة العربية، وأبرزَت القيمة الحضارية للإسلام، وأسهمَت في إدماجه ضِمن التاريخ الإنساني العام. كما أنّ الانجذاب الجمالي والفكري للثقافة الشرقية، ولا سيّما في مجالات الأدب والتصوف والفنّ، شكّل سمة واضحة لدى طيف واسع من المستشرقين الألمان، بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك بالانخراط الوجداني العميق في الإسلام، أو اتخاذ مواقف نقدية صريحة من الصور النمطية السائدة عنه في الثقافة الغربية. وقد انعكس هذا المسار في إنتاج علمي وأدبي واسع أسهم في تقريب صورة الإسلام إلى المخيال الألماني، وأرسى تقليدًا استشراقيًّا أقلّ حدّة وعداءً من نظائره الأخرى.
أمّا الخصيصة الثالثة، فتتمثّل في إعمال المنهج العلمي الدقيق والصرامة المنهجية العالية. فقد تميّز الاستشراق الألماني بغلبة الروح العلمية، والتجرّد النسبي، والالتزام الصارم بقواعد التحقيق والنقد التاريخي. وبرز الألمان -على نحو خاصّ- في مجال تحقيق التراث العربي ونشر المخطوطات وفق معايير علمية دقيقة، شملت الضبط النصِّي، والدراسة النقدية، والفهرسة الشاملة. كما اتّسم هذا التقليد العلمي بثقافة نقد ذاتي صارمة، حيث لم يتردّد المستشرقون الألمان في تصحيح أخطاء بعضهم بعضًا، ورفض أيّ بناء معرفي لا يستند إلى أساس لغوي ونحوي متين. وقد ارتبط هذا التميز بثقافة أكاديمية عامة تقوم على الدقة والصبر واحترام المنهج، وأسهم في جعل الإنتاج الألماني مرجعًا تأسيسيًّا في الدراسات العربية والإسلامية.
وتبرز الخصيصة الرابعة في الاعتماد الواسع على الفيلولوجيا والدراسة المقارنة للّغات الساميّة. فقد جعَلَت المدرسة الاستشراقية الألمانية من المقارنة اللغوية أداة مركزية لفهم النصوص الدينية والتاريخية، على نحو يذكّر بمنهجية الدرس الكتابي في التعامل مع العهدَيْن القديم والجديد. واهتمّ المستشرقون الألمان بدراسة العلاقات بين العربية وبقية اللغات الساميّة؛ مثل العِبرية والآرامية والسبئية وغيرها، بهدف إعادة بناء التطور الدلالي والتاريخي للمفاهيم. ويُعَدّ هذا المنحى الفيلولوجي من أبرز إسهامات الاستشراق الألماني، وقد تُوّج بأعمال مرجعية كبرى في مقارنة اللغات الساميّة، ما زالت تؤثّر في البحث الأكاديمي إلى اليوم.
س2: ما السياق الفكري والسياسي الذي أدّى إلى ازدهار الاستشراق الألماني منذ القرن الثامن عشر؟
د/ عبد الملك هيباوي:
يُرجِع عددٌ من الباحثين المهتمّين بتاريخ الاستشراق الألماني بدايات الاتصال الألماني بالشرق إلى قرون سابقة على تشكّل الاستشراق بوصفه حقلًا معرفيًّا مستقلًّا، وبالتحديد إلى مرحلة الحروب الصليبية. فقد شكّلَت الحملة الصليبية الثانية (1147- 1149)، وما أعقبها من عودة الحُجّاج الأوروبيين من الأراضي المقدسة، مناسبة أُولى لانتقال صور وأوصاف عن المشرق الإسلامي، وعن بعض مظاهر حضارته العمرانية والثقافية. كما أسهم نشاط الرهبان ورجال الدِّين، ومن بينهم علماء ألمان، في الترجمة عن الأندلس الإسلامية، في فتح قنوات مبكرة للتعرّف على التراث العربي والإسلامي.
غير أنّ هذا الاهتمام بالشرق سيعرف منعطفًا أكثر حِدّة بعد فتح العثمانيين لمدينة القسطنطينية (إسطنبول) سنة 1453؛ إِذْ بدأ عدد من العلماء الأوروبيين يوجّهون اهتمامهم نحو المراكز الحضارية الإسلامية الكبرى، خاصة إسطنبول ودمشق، بغرض اقتناء المخطوطات العربية وتعلّم اللغة العربية. وقد تزامَن هذا التوجّه مع تحوّلات فكرية ودينية عميقة داخل أوروبا، أبرزها الإصلاح الديني، خاصة مع عالم اللاهوت (مارتن لوثر) -Martin Luther-(1483- 1546)، داخل ألمانيا، الذي أعادَ الاعتبار إلى النصوص الأصلية واللغات القديمة، ووسّع من دائرة الاهتمام بالدراسات اللغوية المقارنة.
في هذا السياق، أرسل الملك الفرنسي (فرانسوا الأول) سنة 1534 المستشرق (ولهلم بوستل) Wilhelm Postel- (1510- 1581)-، إلى مصر ثم إلى إسطنبول في مهمة لاقتناء مخطوطات شرقية. وقد تعلّم بوستل العربية وعددًا من اللغات الشرقية، وعُيّن بعد عودته أستاذًا للغات الشرقية في (معهد فرنسا) (College de France) عام 1539، وأسهمت المخطوطات التي جلبها -والتي انتهى بها المطاف في مكتبة هايدلبرج الألمانية- في وضع الأساس المادّي الأول للدراسات العربية في ألمانيا. ومن هذه النقطة بدأت ملامح اهتمام ألماني منظّم بالتراث العربي تتشكّل، خصوصًا في مدينة هايدلبرج التي ستغدو لاحقًا أحد المراكز المبكّرة لهذا النوع من الدراسات.
وقد تعزز هذا الاهتمام في أواخر القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر مع جهود (يعقوب كرستمان) -Jakob Christmann- (1554- 1613)، الذي سعى إلى تأسيس كرسي جامعي لدراسة اللغات الشرقية، وخاصة اللغة العربية في جامعة هايدلبرج عام 1590، لكن ذلك المشروع لم يرَ النور إلا عام 1609 بعد مرحلة من الإعداد الطويل. وبهذا تعتبر محاولة (كرستمان)، كما يرى كثير من الباحثين، أول محاولة في ألمانيا لتأسيس الدراسات العربية هناك، حيث ألّف كتيبًا لتعليم اللغة العربية، وأعدّ للمطبعة الحروف العربية في قوالب من الخشب. فكان من نتائج هذا الانفتاح أن ظهرت أول ترجمة للقرآن إلى اللغة الألمانية من طرف (سلومون شفايجر) -Salomom Schweiger- (1551- 1622) عام 1616، في سياق لا يزال محكومًا باعتبارات لاهوتية وجدلية، لكنه يعكس في الوقت نفسه انتقالًا تدريجيًّا من الاهتمام العرضي إلى الاهتمام المؤسّسي. غير أن هذه المرحلة، الممتدة من القرن الثاني عشر إلى القرن السابع عشر، تظلّ في جوهرها مرحلة تمهيدية، لم يكن الاستشراق فيها بَعْدُ علمًا قائمًا بذاته، بل نشاطًا متفرّقًا تحكمه دوافع دينية أو لغوية أو جدلية. أمّا الازدهار الحقيقي للاستشراق الألماني، بوصفه مشروعًا معرفيًّا واسعًا، فيرتبط أساسًا بالسياق الفكري والسياسي الذي تشكّل منذ القرن الثامن عشر.
ففي القرن الثامن عشر، دخلت ألمانيا مرحلة التحوّل العميق التي عرفتها أوروبا عمومًا مع عصر التنوير. وقد أسهم هذا السياق في إعادة تعريف العلاقة مع (الآخر) غير الأوروبي، لا بوصفه خصمًا دينيًّا فحسب، بل بوصفه موضوعًا للمعرفة التاريخية والعقلانية. وأدّى هذا التحوّل إلى تراجع المنهج الجدلي اللاهوتي لصالح المقاربة الفيلولوجية والنقدية، حيث أصبحت اللغات الشرقية، وفي مقدمتها العربية، تُدْرَس بوصفها مفاتيح لفهم نصوص وحضارات، لا مجرّد أدوات للجدل الديني. كما لعب غياب الوحدة السياسية الألمانية حتى القرن التاسع عشر دورًا مهمًّا في تشكيل خصوصية الاستشراق الألماني. فبخلاف فرنسا وبريطانيا، لم تكن ألمانيا قوّة استعمارية كبرى ذات مصالح مباشرة في العالم الإسلامي خلال المراحل الأولى من تشكّل الاستشراق، وهو ما أتاح للمستشرقين الألمان هامشًا أوسع للاشتغال الأكاديمي البعيد نسبيًّا عن الإملاءات الاستعمارية المباشرة. وقد انعكس ذلك في تركيزهم على الفيلولوجيا، وتحقيق النصوص، ودراسة التاريخ الديني والفكري للإسلام، بدل الانخراط المباشر في الإدارة الاستعمارية أو توجيه السياسات.
إلى جانب ذلك، أسهم تطوّر الجامعات الألمانية الحديثة في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وبروز نموذج الجامعة البحثية القائمة على التخصّص والدقة، في توفير البيئة المؤسسية اللازمة لازدهار الدراسات الاستشراقية. فقد أصبحت الدراسات الشرقية جزءًا من منظومة علمية متكاملة، تقوم على البحث طويل النّفَس، والتحقيق النصّي، والمقارنة التاريخية، وهو ما سيُفضي لاحقًا إلى بروز أعلام كبار في الدراسات العربية والإسلامية.
وفي هذا السياق، تحوّل الاهتمام بالشرق الإسلامي من فضول ثقافي أو دافع ديني إلى مشروع معرفي يسعى إلى فهم البنية الداخلية للحضارة الإسلامية، ولغتها، ونصوصها التأسيسية. ولم تَعُد اللغة العربية تُدْرَس بوصفها لغة (الآخر)، بل بوصفها لغة علم وفكر وتاريخ، لها منطقها الداخلي وقوانينها الخاصة. وأسهم هذا التحوّل في انتقال الاستشراق الألماني من مرحلة الجمع والترجمة إلى مرحلة التحليل والتأصيل العلمي.
وهكذا، يمكن القول: إنّ ازدهار الاستشراق الألماني منذ القرن الثامن عشر كان ثمرة تفاعل معقّد بين تراكم تاريخي سابق، وتحوّلات فكرية كبرى أفرزها عصر التنوير، وسياق سياسي خاصّ اتّسم بضعف التورّط الاستعماري المباشر، إضافة إلى بنية جامعية وفيلولوجية متينة. وقد مهّدت هذه العوامل مجتمعة لظهور الاستشراق الألماني بوصفه أحد أكثر التيارات الاستشراقية عمقًا وتأثيرًا في دراسة الإسلام وتراثه، ومهّدت الطريق لتحوّله، في القرنين التاسع عشر والعشرين، إلى مدرسة قائمة بذاتها، ذات مناهج واضحة وحقول بحث متشعّبة.
س3: كيف انعكس الطابع (اللاهوتي) للدراسات الأوروبية على بدايات الاستشراق الألماني؟ وكيف حاول رايسكه تجاوزه؟
د/ عبد الملك هيباوي:
يختلف واقع الدراسات العربية في الجامعات الأوروبية باختلاف السياقات الفكرية والسياسية التي نشأت فيها، وهو اختلاف انعكس بوضوح على بدايات الاستشراق الألماني وطابعه اللاهوتي المبكِّر. ففي القرن السابع عشر، ازدهرت دراسة اللغة العربية في كلّ من هولندا وإنكلترا في سياق مرتبط أساسًا بالمصالح التجارية، وتوسيع شبكات التبادل، والبحث عن أسواق جديدة في المشرق العربي، وهو ما جعل تعلُّم العربية هناك أداة وظيفية تخدم أغراضًا اقتصادية مباشرة. أمّا في فرنسا، فقد انصبّ الاهتمام في الفترة نفسها على التراث المسيحي العربي، وتعاليم الكنائس الشرقية، ولا سيّما المارونية في سوريا ولبنان، حيث تضافرت الجهود لطباعة الكتاب المقدّس ونصوص الأناجيل والكتب الطقسية، في سياق يبرز فيه البُعد التبشيري بوصفه دافعًا رئيسًا لتوظيف اللغة العربية.
في المقابل، اتخذَت دراسة اللغة العربية في ألمانيا مسارًا مختلفًا؛ إِذ ارتبطت منذ بداياتها بدراسة اللغة العبرية القديمة والسريانية ضِمن ما عُرف بفقه اللغات المقدّس (Philologia Sacra). فقد ركّز البروتيستانت الألمان، في إطار حركة الإصلاح الديني، على دراسة الكتاب المقدّس في لغاته الأصلية وترجماته القديمة، وكانت العربية تُدْرَس بوصفها لغة مساعدة لفهم النصّ العبري، لا باعتبارها موضوعًا معرفيًّا قائمًا بذاته. ومن ثمّ، ظلّت الدراسات العربية في ألمانيا، لأكثر من ثلاثة قرون؛ من القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر، مادة فرعية ضمن مناهج اللاهوت، ولم يُنظر إليها إلّا بوصفها امتدادًا لدراسة العبرية، التي كانت تشكّل جوهر الاهتمام العلمي آنذاك.
وقد أسهمت حركة الإصلاح الديني التي قادها (مارتن لوثر) في ترسيخ هذا التوجّه؛ إِذْ دعا إلى العودة إلى نصّ العهد القديم بلغته الأصلية، أي العبرية. ونظرًا للصِّلَة الوثيقة بين العبرية والعربية، بوصفهما لغتين ساميّتين متجاورتين تاريخيًّا وجغرافيًّا ولسانيًّا، أصبحت الاستعانة بالعربية أداة ضرورية لفهم الألفاظ العبرية الغامضة، في سياق إعادة تفسير الكتاب المقدّس بعيدًا عن التصوّرات التي تبنّتها الكنيسة الكاثوليكية. وفي هذا الإطار أشار المستشرق الفرنسي (سيلفستر دي ساسي) -Silvestre de Sacy- (1758- 1838)، إلى أنّ دراسة الآثار الأُولى للدين المسيحي دفعت العلماء إلى تكريس جهودهم للغة العبرية، ثم إلى إدراك الحاجة إلى دراسة اللغات الساميّة المجاورة، وفي مقدمتها العربية، لا لذاتها، بل لخدمة تفسير النصوص التوراتية.
يُستفاد من هذا السياق أنّ اللغة العربية لم تكن تُدْرَس في هذه المرحلة لقيمتها الأدبية، أو لفهم تطور أدب العرب والمسلمين، أو للتعمق في تاريخهم وحضارتهم، بل كانت تُوظَّف أداة تفسيرية لخدمة علم اللاهوت. وقد عزّز هذا الوضعَ ضعفُ الكراسي الجامعية المخصصة لتدريس العربية، وهيمنةُ تصوّر إصلاحي متشدّد كان يتحفّظ على أيّ انفتاح حقيقي على نصوص غير مسيحية. ووفق ما يذكره (يوهان فوك) -Johann Fück- ـ(1894– 1974)، كان الباحث الألماني يكتفي غالبًا بالبحث عن أصول كلمات عربية في المعاجم، ثم مقارنتها بنظائرها العبرية، واختيار المعنى الذي يخدم غرضه التفسيري.
ظلّ هذا الوضع قائمًا حتى منتصف القرن الثامن عشر، حيث بقيت العربية في ألمانيا أداة لاهوتية تُستخدم للكشف عن المواضع الغامضة في العهد القديم. وتجدر الإشارة إلى أنّ عددًا من العلماء الألمان في مطلع القرن الثامن عشر تلقّوا تكوينهم في اللغات الشرقية في هولندا، التي تميّزت آنذاك بدراساتها العربية بفضل جهود (يعقوب جوليوس)- Jakob Golios- (1596- 1667)، الذي أسهم بنشر نصوص عربية مهمّة، ووضع أول قاموس عربي-لاتيني ظلّ مرجعًا أساسيًّا لقرنين، وجعل من مدينة (لايدن) (Leiden) مركزًا بارزًا للأبحاث العربية. وعندما عاد هؤلاء العلماء إلى ألمانيا، سعوا إلى تعليم العربية في جامعاتها، ومحاولة إخراجها تدريجيًّا من الإطار التوراتي الضيّق إلى مجال الثقافة العامة. ومع ذلك، فإنّ الاهتمام باللغة العربية في ألمانيا ظلّ-خلال الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر- أضعف مقارنة بدول أوروبية أخرى، مثل: فرنسا وهولندا وبريطانيا وإيطاليا والنمسا، حيث ارتبط دعم العربية هناك بمصالح اقتصادية وسياسية مباشرة، فضلًا عن الدوافع الدينية. أمّا في ألمانيا، فإنّ الاهتمام بالعربية بوصفها علمًا قائمًا بذاته لم يبدأ في التشكّل إلا في مرحلة لاحقة، متزامنًا مع تطور الدرس الفيلولوجي نفسه.
ويُعَدّ النصف الثاني من القرن الثامن عشر نقطة تحوّل حاسمة في هذا المسار؛ إِذْ شهدت الدراسات العربية في ألمانيا انتقالًا نوعيًّا من التبعية اللاهوتية إلى الاستقلال العلمي، في سياق عام طبعته تحوّلات عصر التنوير. فقد أسهم انفتاح فلاسفة الأنوار على حضارات غير أوروبية، مثل الصين التي عرّف بها المبشرون اليسوعيّون، في إعادة النظر في الصور النمطية عن الإسلام والحضارات الشرقية، وأدرك مفكرو التنوير أنّ الإسلام، الذي شكّل حضارة كبرى في آسيا وإفريقيا وأوروبا، لا يمكن اختزاله في التصورات الساخرة التي سادَت خلال العصور الوسطى. وتعزّز هذا التحوّل بظهور موضوعات إسلامية في الكتابات الأوروبية خلال القرن الثامن عشر، وكذا انتشار ترجمة (ألف ليلة وليلة) إلى الفرنسية سنة 1704، فضلًا عن روايات الرحّالة والقصّاصين حول مظاهر العمران والفن في إيران والعالم العثماني. وفي هذا المناخ الفكري، ومع صعود الحركة الرومانسية، بدأت اللغة العربية تتحرّر تدريجيًّا من موقعها التابع لعلم اللاهوت، وظهرت تصوّرات جديدة تنظر إلى الدراسات الشرقية عمومًا، والعربية خصوصًا، بوصفها حقولًا معرفية مستقلة.
وقد تزعّم هذا التحول في ألمانيا المستشرق (يوهان ياكوب رايسكه) - Johan Jakob Reiske- ـ(1716- 1774)، الذي يُعَدّ بحقّ الرائد الأول للدراسات العربية العلمية، وأول مستعرب وعالم إسلام جعل من العربية موضوعًا للدراسة لذاتها. فقد اهتم بالأدب العربي والأمثال، وترجم نصوصًا شِعرية، ولا سيما من شِعر المتنبي، ونشر دراسات نقدية، وقاد معركة فكرية حقيقية لتحرير الدراسات العربية من هيمنة اللاهوت. ولم يكن هذا المسار دون ثمن، إذ عاش (رايسكه) في ضائقة مالية شديدة، إلى حدّ أنه لقّب نفسه بـ(شهيد الأدب العربي). وقد أشاد (يوهان غوتفريد هيردر) -Johann Gottfried Herder-(1744- 1803)، بمكانة (رايسكه)، معتبرًا أنّ العلماء الألمان يمتلكون الهمة والمعرفة، لكنهم يفتقرون إلى الدعم المؤسسي، على خلاف بلدان أخرى تملك مؤسسات قوية لكنّ علماءها يفتقرون إلى الحيوية العلمية. كما رأى في (رايسكه) أنه مات شهيد حماسِه لكلّ ما هو عربي وإغريقي. وتجدر الإشارة أن (رايسكه) واجه معارضة شديدة من علماء اللاهوت وبعض المستشرقين، وفي مقدمتهم أستاذه (شولتنز) Schultens- -، الذي كان يرى أن العربية لا ينبغي أن تتجاوز كونها لغة مساعدة لدراسة العبرية، وأن الشِّعر العربي لا قيمة له إلا بقدر ما يخدم تفسير التوراة.
غير أنّ (رايسكه)، من خلال تأريخه للنصوص العربية وتحليلها بوصفها نصوصًا قائمة بذاتها، أسهم في إحياء العربية كلغة مستقلّة ذات قيمة أدبية وتاريخية خاصّة. وكان الوحيد في عصره الذي وقف بوعي ضد فقه اللغات المقدّسة، مصرّحًا بأن خدمة العربية لا يمكن أن تتحقّق ما دامت تُعامَل بوصفها أداة لاهوتية. وبهذا الموقف، يُعَدّ (رايسكه) المؤسّس الحقيقي للدراسات العربية في ألمانيا، وصاحب الفضل في تمهيد الطريق أمام أجيال لاحقة من المستشرقين، ليس في ألمانيا فحسب، بل في أوروبا وخارجها، ليتحوّل الاهتمام بالأدب والتاريخ العربيين إلى حقل علمي مستقلّ يجد صداه لدى جمهور أوسع من المتخصّصين.
س4: كيف تطوّرت اهتمامات المستشرقين الألمان من الفقه واللغة إلى التاريخ الإسلامي والقرآن؟
د/ عبد الملك هيباوي:
ظلّ الاتجاه الفيلولوجي، القائم على العناية الدقيقة بالنصوص وتحقيق الجزئيات اللغوية والوثائقية، مسيطرًا على الاستشراق الألماني إلى حدود منتصف القرن التاسع عشر. وقد تشكّل هذا الاتجاه في سياق منهجي متأثّر بدراسات اللغات الكلاسيكية وبالدراسات الكتابية، ولا سيّما دراسات العهدَيْن القديم والجديد، فضلًا عن التأثير العميق لمدرسة باريس، ممثلة في أعمال (دي ساسي). وكانت القاعدة السائدة آنذاك أنّ الأستاذ الجامعي يدرّس اللغات الساميّة مجتمعة، بما في ذلك العربية والعبرية والسريانية، ويُضيف إليها الفارسية والتركية، دون تمييز حاسم بين اللغة بوصفها أداة، والتاريخ بوصفه موضوعًا قائمًا بذاته. وفي هذا الإطار، كان المستشرقون الألمان، حتى عند تعاملهم مع مدوّنات تاريخية، ينظرون إليها أولًا وقبل كلّ شيء بوصفها نصوصًا لغوية وأدبية، لا بوصفها مصادر لإعادة بناءٍ تاريخي شامل. فالكلمة النادرة، أو الصيغة الفريدة التي لا تَرِد إلا مرة واحدة، كانت تحظى بقيمة علمية أعلى من قيمة التحوّل التاريخي أو الاتجاه الحضاري الذي يشير إليه النصّ. وقد أدّى هذا المنظور إلى تأخر الاهتمام الحقيقي بالتاريخ الإسلامي بوصفه مجالًا مستقلًّا للبحث.
غير أنّ البدايات الأولى لهذا التحوّل ستظهر مع (رايسكه) نفسه، الذي ارتبط اسمه بتحرير اللغة العربية من التبعية اللاهوتية كما أوضحنا من قبل. فدراسة (رايسكه) للعربية لم تقتصر على هدفها الأول المتمثّل في فصلها عن خدمة العبرية، بل تجاوزت ذلك إلى اعتبارها مدخلًا أساسيًّا لفهم التاريخ الإسلامي ودوره في التاريخ العالمي. ومن ثمّ لم يتعامل مع المتون العربية بوصفها مادة لغوية صرفة، بل قرأها قراءة المؤرّخ الذي يمنح تاريخ الإسلام مكانته ضمن التاريخ الإنساني العام. ويتجلّى هذا الموقف بوضوح في ترجمته لمقدمة كتاب (تقويم التواريخ) لحاجي خليفة، حيث رفض، كما أوضح مؤلِّف موسوعة المستشرقين عبد الرحمن بدوي، وصف (شرقي) لعدم دقّته، واستبدل به وَصْف (إسلامي) أو (محمدي)؛ لأنّ الأمر يتعلّق بتاريخ المسلمين أينما وُجدوا، في المشرق والمغرب وأوروبا على السواء. وقد جرّ عليه هذا الموقف معارضة شديدة من اللاهوتيين، لكن هذه المرة لأنه رفض الاتهامات التقليدية الموجّهة إلى الإسلام ونبيّه، وامتنع عن تقسيم التاريخ العالمي إلى شطرين: مقدّس ودنيوي. وبذلك وضع العالم الإسلامي وتاريخه في قلب التاريخ العالمي، لا في هامشه.
ورغم أنّ (رايسكه) لم ينجح في تأليف عمل متكامل عن تاريخ الإسلام كما كان يطمح، فإنه وضع الأساس النظري لما سيُعرف لاحقًا بالعلوم الإسلامية الحديثة، بوصفها علمًا تاريخيًّا يقوم على معرفة اللغة العربية، لا على استخدامها كأداة تفسيرية فحسب. ومع ذلك، فإنّ الاستشراق الألماني، في عمومه، لم يكتشف العرب باعتبارهم موضوعًا تاريخيًّا مستقلًّا إلّا في القرن التاسع عشر، وبخاصة في نصفه الثاني؛ إِذ ظلّ اقترابه منهم، لفترة طويلة، لغويًّا ولسانيًّا بالدرجة الأولى.
وفي هذا السياق، وعلى خلاف مدرسة باريس ذات النزعة الفيلولوجية الصارمة، برز في النصف الأول من القرن التاسع عشر المستشرق النمساوي (جوزيف فون هامر بورغشتال) -Joseph vom Hammer Purgstall- (1774- 1856)، الذي مَثّل نقطة انعطاف مهمّة في توسيع آفاق الاستشراق الألماني. فقد سعى، انطلاقًا من تجربته الدبلوماسية في تركيا وزيارته لمصر، إلى تعريف الأوروبيين بالعالم الإسلامي في شموليته التاريخية والأدبية. وأسهم حماسُه في إصدار أول مجلة متخصّصة في الدراسات الشرقية سنة 1809 بعنوان (ينبوع الشرق) (Fundgruben des Orients)، وواصل إصدارها لمدة خمسة وعشرين عامًا، نشر خلالها عددًا كبيرًا من الترجمات والدراسات. وقد شكّلَت أعماله الموسوعية، مثل: (تاريخ الإمبراطورية العثمانية) عشرة أجزاء، و(تاريخ الأدب العربي) سبعة أجزاء، و(تاريخ الأدب التركي) أربعة أجزاء، محاولة مبكِّرة لتقديم رؤية شاملة للتاريخ والأدب الإسلاميين، كما أثّر كتابه: (تاريخ فنون البلاغة الفارسية الجميلة)، الذي صدر عام 1818، تأثيرًا واضحًا في شاعر ألمانيا (يوهان فولفغانج غوته) -Johann Wolfgang von Goethe- ـ(1749- 1832)، في عدّة ملاحظات أفادها في ديوانه: (الديوان الشرقي للمؤلف الغربي)، كما شكّل نفس المؤلف مصدرًا أساسيًّا بالنسبة للمستشرق (فريدريش روكيرت) -Friedrich Rückert -(1788- 1866)، في خطواته الأُولى نحو عالم التصوّف الفارسي. ومع أن منهج (بورغشتال) تعرّض لانتقادات بسبب ما وُصف بالإهمال، فإنّ أثره التحفيزي في نقل الاستشراق الألماني من دائرة الاهتمامات الضيقة إلى الأفق التاريخي الواسع لا يمكن إنكاره.
وهكذا، بعد قرابة قرن من هيمنة الفيلولوجيا، الممتدة من منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، بدأت تتبلور مدرسة تاريخية جديدة داخل الاستشراق الألماني، أخذت مكانها تدريجيًّا حتى فرضتْ نفسها في أواخر القرن التاسع عشر. وقد تجلّت ملامح هذه المدرسة بوضوح في أعمال عدد من المستشرقين، من بينهم (نيبور كارستن)-Niebuhr Carsten-(1733- 1815)، و(هيرمان رانكه)-Hermann Ranke-ـ(1878- 1953)، وعلى نحو أكثر وضوحًا (غوستاف فايل)-Gustav Weil- (1808- ـ1889)، و(ألفرد فون كريمر)-Alfred von Krehm -(1828- 1889)، اللذان مهّدَا لدراسة عصر صدر الإسلام، واشتغلَا على تاريخ الخلافة الإسلامية في امتدادها الطويل. ويُضاف إلى هؤلاء المستشرق (جوزيف هوروفتز)- Joseph Horovitz -(1874- 1931)، الذي كرس معظم أعماله لبحوث صَدْر الإسلام، ثم (يوليوس فلهاوزن)-Julius Wellhausen -(1844- 1918)، الذي شكّلَت مؤلَّفاته، مثل: (الدولة العربية وسقوطها)، و(أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام)، و(المدينة قبل الإسلام)، و(تنظيم محمد للجماعة الإسلامية في المدينة)، و(مقدمة إلى أقدم تاريخ للإسلام)، أساس كتابة التاريخ السياسي الحديث للإسلام. وبفضل هذه الإسهامات، تحوّلَت النظرة التاريخية إلى تيار فكري راسخ داخل الاستشراق الألماني، وأصبح لها أثر مباشر في انتشار الدراسات العربية والإسلامية داخل الجامعات الألمانية.
وقد مثّل القرن التاسع عشر، في هذا السياق، مرحلة حاسمة؛ إِذْ تراجع الاهتمام بترجمة الشِّعْر الشرقي، وانفصل علماء الفيلولوجيا والمؤرِّخون عن الشعراء، وتحول الاستشراق الألماني إلى عِلْم موضوعي غايته نشر النصوص المحققة، وتوفير أساس علمي موثوق لفهم تطوّر العالم الإسلامي. ومع بداية القرن العشرين، انتقل هذا التحوّل خطوة أبعد، حيث لم يعد العالم الإسلامي يُدرس بوصفه مادة لغوية أو تاريخية فحسب، بل باعتباره ثقافة مستقلة قائمة بذاتها. وفي هذا السياق، تنبّهت المستشرقة المعاصرة (آنا ماري شيمل) إلى أنّ فهم تطور صورة الشرق والإسلام في الدراسات الاستشراقية الألمانية في القرن العشرين يقتضي النظر إلى التحوّلات السياسية الكبرى التي سبقت تلك المرحلة، بدءًا من حملة نابليون على مصر، مرورًا بالاستعمار الأوروبي في العالم الإسلامي، وما رافق ذلك من تقارير ورحلات غيّرت جزئيًّا صورة الإسلام في الوعي الاستشراقي، وإِنْ ظلّ التصور العام متأثرًا بالسرديات الأدبية والفنية.
ومع صدور طبعة (غوستاف فلوجل)-Gustav Flügel-(1802- 1870)، للقرآن سنة 1834، ثم تطوّر البحث القرآني لاحقًا، بدأ الاهتمام المنظّم بالإسلام بوصفه دينًا أنتج حضارة قائمة بذاتها. وينسب المستشرقون الألمان تأسيس (علم الإسلام) إلى شخصيات، مثل: (إجناس جولد تسيهر)-Ignaz Goldziher-(1850- 1921)، و(سنوك هورجرونيه)-Snouk Hurgronje-(1857- 1936)، اللذين أسهمَا في تحويل دراسة الإسلام إلى حقل معرفي مستقلّ، يتناول العقيدة، والتفسير، والحديث، والكلام، في إطار تاريخي شامل. وقد تعزّز هذا التوجّه بعوامل سياسية، كما أشار (رودي بارت)، خاصّة بعد حصول ألمانيا على مستعمرات إفريقية تضمّ سكانًا مسلمين في أواخر القرن التاسع عشر، وهو ما أمدّ البحث في الإسلام بدوافع إضافية. وتوّج هذا المسار في مطلع القرن العشرين بجهود المستشرقين (مارتن هارتمان)-Martin Hartmann-(1851- 1918)، و(كارل هنريش بيكر) -Carl Heinrich Becker- ـ(1876- 1933)، هذا الأخير الذي أعلن نهاية المرحلة التي كان يُختزل فيها الإسلام في ظواهر لغوية، ودعا إلى دراسته بوصفه واقعًا تاريخيًّا حيًّا. وبذلك انفصلت الدراسات الإسلامية نهائيًّا عن فقه اللغات الشرقية، وأصبح الإسلام مادة تعليمية مستقلّة في الجامعات الألمانية، تتناول دينه، وتاريخه، وثقافته، وعلومه، عبر مدى زمني وجغرافي واسع، يشمل علم الكلام (اللاهوت)، والفقه، والتفسير، والحديث، والتصوّف، والفلسفة، وعلوم الطبيعة، والفنون. وهكذا اكتمل التحوّل من استشراق لغوي ضيّق إلى علم إسلامي تاريخي شامل، شكّل أحد أهمّ إسهامات الاستشراق الألماني في الفكر الغربي الحديث.
س5: تحدثنا سابقًا عن تميز الاستشراق الألماني عمومًا بعدم الخضوع للأطماع الاستعمارية، وكذلك ابتعاده عن العدوانية في التعامل مع الإسلام، كيف أثر هذا على طبيعة هذا التقليد العلمي؟ وهل يعني هذا غياب أيّ أثر للتحيز الأيدولوجي؟
د/ عبد الملك هيباوي:
يتيح الاحتكاكُ المباشر بالمؤسّسات الأكاديمية الألمانية، من خلال التدريس والبحث والمشاركة في المؤتمرات المتخصّصة، إلى جانب الاطّلاع على ما كتبه الباحثون المسلمون في نقد الظاهرة الاستشراقية، استخلاصَ ملاحظات عامة حول طبيعة المنهج الألماني في الدراسات الإسلامية. وانطلاقًا من هذه المعاينة المركّبة، يمكن القول إنّ الاستشراق الألماني تميّز -في مجمله- بغلبة الروح العلمية الصارمة، وبنزعة واضحة نحو التجرد والموضوعية والإنصاف، مقارنة بعدد من المدارس الاستشراقية الأوروبية الأخرى.
ويُدرِك المستشرقون الألمان أنفسُهم هذا التمايز؛ إِذْ يرون أن أبرز ما يميّز الدراسات الاستشراقية في ألمانيا هو التركيز المكثّف على النصوص اللغوية والأدبية، ولا سيما خلال القرن التاسع عشر، إلى جانب العناية الفائقة بتحقيق التراث العربي تحقيقًا علميًّا دقيقًا. فقد اشتهر الباحثون الألمان بإصدار طبعات محقّقة للكتب التراثية، مرفقة بدراسات نقدية، وفهارس شاملة، وضبط صارم للنصوص، وهو ما جعل ألمانيا من أكثر البلدان الأوروبية إسهامًا في نشر مخطوطات التراث العربي والإسلامي ونقدها نقدًا علميًّا، من حيث الكمّ والنوع، مقارنةً بغيرها من البيئات الأكاديمية الغربية.
ولا يمكن فَصْل هذا التميّز عن المناخ العلمي العام الذي ساد أوروبا في تلك المرحلة، ولا عن شبكة التعاون الوثيق بين المستشرقين الألمان ونظرائهم في الجامعات الأوروبية الأخرى. فلولا هذا التعاون العلمي البنّاء، لَمَا أمكن إنجاز أعمال كبرى، مثل: تاريخ الرُّسل والملوك للطبري، وطبقات ابن سعد، ولا المشروع الموسوعي الضخم المعروف بـدائرة المعارف الإسلامية. وقد شارك في هذه الجهود علماء من بلدان أوروبية مختلفة، من أمثال: (دي خويي) (1836- 1909)، في هولندا، و(غولد تسيهر) (1850- 1921)، في هنغاريا، و(فيلهاوزن) (1844- 1918)، و(إدوارد ساخاو) (1845- 1930)، في ألمانيا، وغيرهم من المستشرقين، في نموذج يُبرز الطابع العابر للحدود الذي ميّز البحث الاستشراقي العلمي في ذروته.
وفي هذا السياق، يمكن ردّ هذا التميّز إلى خصال راسخة في الثقافة العلمية الألمانية؛ من دقّة منهجية بالغة، وعناية فائقة بالتفاصيل، وصبر طويل النَّفَس، والتزام صارم بالمنهج العلمي وفق أعلى المعايير الأكاديمية المتعارَف عليها. وقد انعكست هذه الخصائص في طريقة تعامل المستشرقين الألمان مع النصوص، وفي حسّهم النقدي الذي لا يقبل المسلّمات دون فَحْص وتمحيص.
وإذا كان المستشرقون الألمان يحتلّون مكانة متقدّمة بوصفهم خبراء في التراث العربي والإسلامي، وفي دراسة أثره في تاريخ أوروبا الوسيط، فإنهم يحتلّون المكانة نفسها من حيث الالتزام بالمناهج العلمية الصحيحة. وفي هذا الإطار، يعبّر المستشرق الألماني (رودي بارت) -Rudi Paret- (1901- 1983)، بوضوح عن هذا الموقف حين يؤكّد أنّ الدراسات العربية والإسلامية لا تُنجز لإثبات دونية العالم الإسلامي، بل للتعبير عن تقدير عميق للحضارة التي يمثلها الإسلام ولمظاهرها المتنوعة التي عبّر عنها الأدب العربي، مع التشديد في الوقت نفسه على إخضاع الروايات التاريخية والدينية للنقد التاريخي الصارم، وعدم قبولها إلا بقدر ما تصمد أمامه.
غير أن الإقرار بهذه الخصائص لا يعني إنكار ما شابَ بعض أعمال المستشرقين الألمان من نقص أو أخطاء منهجية. إلا أن ما يميّز هذا التقليد العلمي، في نظر عدد من الباحثين، هو قدرة المستشرقين الألمان على ممارسة النقد الذاتي، واستدراك الأخطاء بعضهم على بعض، وتصحيح الانحرافات المنهجية بروح علمية خالصة. وقد أفرز هذا المناخ علماء صارمين في النقد العلمي المجرّد، يأتي في مقدّمتهم (أوجوست فيشر) -August Fischer- (1865- 1949)، الذي اشتهر بدقته البالغة وصرامته المنهجية؛ إِذْ لم يكن يَقبل أيّ إفادة علمية دون التثبّت منها، وانتقد بشدة كلّ مَن أهمل الأصول اللغوية والنحوية في الترجمة أو البحث، سواء عن العربية أو التركية إلى اللغات الأوروبية. وقد رفض (فيشر) كلّ بناء علمي لا يقوم على أساس نحوي متين، وكان يرى أن البحث في التاريخ أو الأدب أو الدين الإسلامي لا يستقيم دون إتقان عميق للّغة العربية، نحوًا ومعجمًا ودلالة.
وفي السياق النقدي نفسه، برز (هاينريش ليبرتخت فلايشر) - Heinrich Leberecht Fleischer- (1801- 1888)، الذي وجّه نقدًا حادًّا لترجمة (هامر بورغشتال) لكتاب (أطواق الذهب) للزمخشري، وأعاد نشر ترجمة جديدة له، كما صحح كتاب (طبقات نفح الطيب). وبرز كذلك (هيلموت ريتر) -Hellmut Ritter- (1892-1971)، الذي راجع ونقد عشرات الطبعات التي صدرت في أوروبا والعالم العربي، إلى جانب (أدولف فريدريش فون شاك) -Adolf Friedrich von Schack- ـ(1815- 1894)، الذي انتقد المستشرقين الذين تناولوا اللغة العربية دون كفاءة علمية أو صدق منهجي. وتكشف هذه الأمثلة عن ثقافة نقدية داخلية لا تتسامح مع الهفوات العلمية، وتضع الانضباط اللغوي في صميم البحث في الدراسات الإسلامية.
ومع ذلك، لا يمكن الادّعاء بأنّ الاستشراق الألماني كان بمنأى تام عن التحيزات الأيديولوجية أو الأهداف السياسية. فقد وُجد بين المستشرقين الألمان من ارتبطت أبحاثهم بمشاريع استعمارية واضحة، ومن أبرزهم (كارل هاينريش بيكر) -Carl Heinrich Becker- (1876- 1933)، الذي كانت له صِلات مباشرة بالسياسة الاستعمارية الألمانية خلال فترة الجمهورية الفيمارية؛ فقد شغل مناصب أكاديمية وإدارية مؤثرة، منها عمله في معهد هامبورغ الاستعماري ثم تولّيه وزارة الثقافة، وأسهمت بعض دراساته في خدمة الأهداف الاستعمارية لبلاده. وقد أثار هذا التوجّه انتقادات حادة داخل الوسط الاستشراقي نفسه، حيث ندد به (كارل بروكلمان) - Carl Brockelmann- (1868- 1956)، واصفًا إيّاه بأنه: (وزير ضدّ الثقافة الألمانية).
وفي السياق ذاته، يرى (أولريش هارمان) -Ulrich Haarmann- (1942- 1999)، أن الدراسات المتعلقة بالعالم الإسلامي قبل عام 1919 كانت أقلّ براءةً وصفاءَ نية مما يُتصوّر أحيانًا، مشيرًا إلى انخراط (بيكر) في نشاطات سياسية مكثفة، بلغت حدّ الحماس لمخطّط توظيف الإسلام في إفريقيا والهند أداة سياسية في مواجهة النفوذ البريطاني. وقد تركت هذه الممارسات أثرًا سلبيًّا عميقًا في الوعي الاستشراقي الألماني اللاحق، وأصبحت مصدر شعور بالخجل والمرارة لدى عدد من الباحثين الألمان المعاصرين.
ويعبّر عن هذا الوعي النقدي أيضًا بوضوح المستشرق المعاصر (شتيفان فيلد) - Stefan Wild-، الذي أشرف على رسالتي في الدكتوراه، بالقول أنّ هناك جماعات ادّعت الانتساب إلى الاستشراق، لكنها سخّرت معرفتها بالإسلام وتاريخه في سبيل معاداة الإسلام والمسلمين. وهو اعتراف مؤلم، لكنه ضروري، يؤكّد أن التقاليد العلمية الجادة داخل الاستشراق الألماني لم تكن غافلة عن انحرافات بعض ممثليها، بل واجهتها بالنقد الصريح.
وخلاصة القول؛ يمكن القول: إنّ الاستشراق الألماني تميّز، في عمومه، بدرجة عالية من الصرامة المنهجية والجدية العلمية، لكنه لم يكن معزولًا كليًّا عن السياقات الأيديولوجية والسياسية لعصره. وتكمن خصوصيته في كونه أنتج -إلى جانب نماذج متحيّزة أو مسيّسة- تقليدًا علميًّا نقديًّا قويًّا، امتلك القدرة على مراجعة ذاته، وكشف انحرافاته، والتمييز بين البحث العلمي الخالص وتوظيف المعرفة في خدمة أغراض خارجية.
س6: ما الفرق بين الجيل المبكِّر من المستشرقين (رايسكه، نولدكه)، والجيل المتأخّر (آنا ماري شيمل)، من حيث التوجّه والموقف من الإسلام؟
د/ عبد الملك هيباوي:
يمثّل الانتقال من الجيل المبكِّر من المستشرقين الألمان إلى الجيل المتأخّر تحوّلًا معرفيًّا عميقًا في كيفية فهم الإسلام وتحديد موقعه داخل الدرس الغربي. ويبرز هذا التحوّل بوضوح عند المقارنة بين رمزين من الجيل الكلاسيكي، هما: (يوهان ياكوب رايسكه) و(تيودور نولدكه)، وبين رمز بارز من الجيل المتأخر هي المستشرقة (آنا ماري شيمل) -Annemarie Schimmel- (1922- 2003). فالفارق بين هذه الأسماء لا يقتصر على اختلاف التخصّصات أو موضوعات البحث ومناهجه فحسب، بل يتجذّر في تغيّر الأُفق الفلسفي الذي يُنظر من خلاله إلى الإسلام ذاته.
تشكّل الجيل المبكِّر داخل مناخ أوروبي هيمنَت عليه العقلانية الصارمة، والنقد التاريخي التفكيكي للدِّين بوجهٍ عام. وضِمن هذا الإطار، عُومل الإسلام بوصفه ظاهرة خارجية، قابلة للتحليل الموضوعي البارد، لا تجربة وجودية أو منظومة روحية تُفهم من الداخل. وقد مثّل (رايسكه) لحظة انتقالية مهمّة في هذا السياق؛ إِذْ تحرّر جزئيًّا من الإرث اللاهوتي العدائي الصريح الذي طبع الاستشراق المبكِّر، وتعامل مع النصّ العربي بجدّية علمية غير مسبوقة في عصره، كما بينّا سابقًا. غير أنّ هذا الإنصاف اللغوي لم يتحوّل إلى اقتراب وجودي من الإسلام، إِذْ ظلّ تصوّره محكومًا برؤية تعتبره نتاجًا تاريخيًّا بشريًّا خاضعًا بالكامل لشروط السياسة والمجتمع. أمّا (نولدكه) فقد ارتقى بهذا التوجّه إلى مستوى أكثر شمولًا ومنهجية. ففي مشروعه حول (تاريخ القرآن)، تعامل مع النصّ القرآني لا بوصفه خطابًا مقدّسًا حيًّا في وجدان المسلمين، بل بوصفه بنية نصِّية تشكّلَت عبر مراحل زمنية يمكن إعادة بنائها علميًّا. لم يكن اهتمامه منصبًّا على السؤال الإيماني أو البُعد الروحي أو الدلالي للنصّ، بقدر ما انشغل بسؤال نشأة النصّ وتكوّنه التاريخي؛ أي: كيف تكوّن النصّ؟ وكيف انتقل من الشفاهة إلى التدوين؟ وكيف استقرّ في صورته النهائية؟ وهنا يتجلّى الموقف الجوهري للجيل المبكِّر: الإسلام موضوع بحث ومادة للدراسة لا تجربة للإنصات.
ومن هنا يمكن القول: إن الاستشراق الكلاسيكي لدى (رايسكه) و(نولدكه) كان استشراقًا يُعْرَف من الخارج، وامتلك أدوات دقيقة في التفكيك اللغوي والتاريخي، لكنه لم يعترف بشرعية السؤال الوجداني أو الروحي للنصّ. فالدِّين، في وعي هذا الجيل، قابل للاختزال في شروط نشأته وسياقاته الاجتماعية والنصّية، ولا يحتاج -من منظورهم- إلى مقاربة داخلية تُنصت إلى معناه المتجاوز للتاريخ.
مع المستشرقة (آنا ماري شيمل) حدث تحوّل نوعي في زاوية الرؤية. فالإسلام لم يعد مجرّد نصّ أو حدث تاريخي، بل أصبح تجربة إنسانية حيّة، تتجسّد في التصوّف، والشِّعر، والرموز، والوجدان الديني. بتعبير آخر، لا تتقدّم (شيمل) نحو الإسلام بعقل الجرّاح، بل بعقل المستمع. وهي لا تنتمي إلى استشراق التفكيك، بل إلى استشراق التعاطف المعرفي، حيث لا يعني الفهم السيطرة، بل الإصغاء. ولا يعني هذا التحوّل أن (شيمل) تخلّت عن المنهج العلمي، بل إنها أعادت تعريف موضوع النقد نفسه. فبينما كان النقد عند (نولدكه) موجّهًا إلى بنية النصّ وتاريخه، أصبح عند شيمل موجّهًا إلى الصورة التي صنعها الغرب عن الإسلام. لقد انصبّ جهدها على تفكيك الصور النمطية، ونقل التجربة الإسلامية كما تُعاش في داخلها، لا كما تُعاد صياغتها ضمن مفاهيم غريبة عنها. وبهذا المعنى، انتقل الاستشراق معها من تمثيل الإسلام إلى مساءَلة تمثيله، كما تغيّر الموقف من (حقيقة) الإسلام تغيّرًا جذريًّا. فالإسلام عند الجيل المبكِّر ظاهرة يمكن تفسيرها بالكامل بأدوات التاريخ واللغة والسياسة. أمّا عند (شيمل)، فيظهر إدراك واضح بأنّ الدِّين لا يُختزل في شروط نشأته، وأن للمعنى طبقات تتجاوز المنهج الوضعي الصلب. فالإسلام، في قراءتها، ليس وهمًا تاريخيًّا ولا مجرّد بناء ثقافي، بل لغة كونية للبحث عن المطلق.
هناك عامل مهم يُميّز جيل (رايسكه) و(نولدكه)، عن جيل (شيمل)؛ فقد اشتغل (رايسكه) و(نولدكه) على الإسلام من داخل النصوص والمخطوطات، ومن خلال أدوات التاريخ واللغة، دون تجربة ميدانية مباشرة للعالم الإسلامي، فبقي الإسلام عندهما موضوعًا معرفيًّا يُفكَّك ويُعاد تركيبه تاريخيًّا. أمّا (شيمل)، فقد اقترن بحثها بمعايشة طويلة للبلدان العربية والإسلامية، واحتكاك مباشر بالمسلمين وثقافتهم الدينية، وهو ما منح قراءتها بُعدًا إنسانيًّا وروحيًّا واضحًا، ونقل موقفها من الإسلام من مستوى التحليل الخارجي إلى أُفق الفهم القائم على التجربة الحيّة. إذن نحن نتحدث هنا عن فرق بين استشراق النصّ واستشراق المعايشة.
ولمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع، فقد أوضحت بتفصيل رؤية شيمل للإسلام والحضارة الإسلامية مقارنة مع رؤية غيرها من المستشرقين الكلاسيكيين في الكتاب الذي صدر لي سنة 2022 بعنوان: (آنا ماري شيمل: جسر بين الإسلام والغرب)، وستصدر -بإذن الله- طبعة ثانية مزيدة ومنقَّحة بداية سنة 2026.
خلاصة القول؛ فإنّ الفرق بين (رايسكه) و(نولدكه) من جهة، و(شيمل) من جهة أخرى، لا يمثّل اختلاف مدارس فحسب، بل اختلاف رؤيتين للعالم: رؤية تؤمن بأنّ كلّ شيء قابل للتشريح، ورؤية أدركت أن بعض الحقائق لا تُشرَّح، بل تُعاش وتُفهم من الداخل. وبين التشريح والعيش، يتحدّد التحوّل العميق في مسار الاستشراق من عقل التفكيك إلى أفق الفهم.
س7: كيف يُقارن تأثير المدرسة الألمانية في الدراسات الإسلامية بتأثير المدرسة الفرنسية أو الأنجلوساكسونية؟
د/ عبد الملك هيباوي:
أود أن أنبّه مرّة أخرى إلى أن ما أنجزه المستشرقون الألمان، من حيث الكمّ والنوع، يفوق مجموع ما قدّمه نظراؤهم في المدرستين الفرنسية والبريطانية مجتمعتَيْن. وانطلاقًا من هذه الحقيقة، يمكن القول: إنّ تأثير المدرسة الألمانية في الدراسات الإسلامية يُعَدّ من أعمق التأثيرات وأبعدها أثرًا في البنية المعرفية لهذا الحقل، لا بسبب عدد الباحثين فحسب، بل بسبب طبيعة الأسئلة التي فرضتها، ونمط التفكير الذي رسّخته، والمعايير العلمية الصارمة التي جعلت منها ما يشبه (العقل البنيوي) الكامن خلف كثير من المناهج اللاحقة، سواء في المدرسة الفرنسية أو الأنجلوساكسونية. فالتأثير الألماني لم يكن تأثيرًا مباشرًا أو ظرفيًّا، بل تأثيرًا بنيويًّا متغلغلًا في صميم أدوات البحث ذاتها.
تشكّلَت المدرسة الألمانية في إطار تقليد فيلولوجي صارم، كما ذكرتُ مِن قبل، ينظر إلى المعرفة بوصفها بناء تراكميًّا دقيقًا، يقوم على نقد النصوص، وتتبع تطوّر الألفاظ، وإعادة بناء السياقات اللغوية والتاريخية وفق أعلى درجات الانضباط المنهجي. وقد تجسّد هذا الاتجاه بوضوح في الأعمال الكبرى التي تعاملَتْ مع النصوص الإسلامية، وفي مقدّمتها الدراسات القرآنية، حيث لم يعد القرآن يُقرأ بوصفه نصًّا دينيًّا فحسب، بل بوصفه وثيقة تاريخية مركّبة ذات طبقات تشكّل يمكن تحليلها وإعادة تركيبها. ولم يقتصر أثر هذا المنهج على البيئة الألمانية، بل تحوّل إلى نموذج مرجعي صامت، تسرّب إلى كثير من المشاريع البحثية الأوروبية اللاحقة، حتى لدى مَن خالف نتائجه أو أعاد مساءلتها.
في المقابل، تشكّلَت المدرسة الفرنسية في سياق ثقافي وسياسي مختلف، ارتبط منذ وقت مبكِّر بسؤال الاستعمار، والهوية، والأنثروبولوجيا السياسية. فبينما انشغل المستشرق الألماني بالنصّ بوصفه بنية تاريخية ولغوية، توجّه المستشرق الفرنسي إلى الإسلام بوصفه ظاهرة اجتماعية حيّة. ولذلك كان تأثير المدرسة الفرنسية أكثر حضورًا في مجالات تاريخ الذهنيات، والأنثروبولوجيا الدينية، وتحليل أنماط التديّن الشعبي، وبُنى السلطة الرمزية داخل المجتمعات الإسلامية. وإذا جاز القول بأن المدرسة الألمانية أسّست ما يمكن تسميته بـ(علم النصّ)، فإنّ المدرسة الفرنسية أسّست في المقابل (علم المجتمع الإسلامي).
أمّا المدرسة الأنجلوساكسونية، فقد دخلت ميدان الدراسات الإسلامية في مرحلة متأخرة نسبيًّا، لكنها عوّضَت هذا التأخّر الزمني باتساع منهجي ملحوظ. فقد أدخلت بقوة أدوات السوسيولوجيا الحديثة، والدراسات الثقافية، وتحليل الخطاب، ونظريات ما بعد الاستعمار. وبدل التركيز على تاريخ النصّ كما فعل الألمان، أو على بنية المجتمع كما فعل الفرنسيون، انشغلت المدرسة الأنجلوساكسونية بسؤال إنتاج المعنى داخل شبكات السلطة والهوية والتمثيل. وهنا انتقل مركز الاهتمام من النصّ والمجتمع إلى الخطاب والتمثّل. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التنوّع الظاهر في مجالات التأثير، تبقى المدرسة الألمانية الأكثر رسوخًا في تشكيل البنية العميقة للدراسات الإسلامية. فمعايير التحقيق العلمي للنصوص، وقواعد النقد التاريخي الصارم، وأدوات المقارنة اللغوية السامية، والتعامل المتشدّد مع المصادر، كلّها عناصر ذات منشأ ألماني، انتقلَت لاحقًا إلى المدرستَيْن الفرنسية والأنجلوساكسونية، حتى عندما تغيّرت الأطر النظرية العامة. وبهذا يمكن القول إنّ المدرسة الألمانية قدّمت (الهيكل العظمي) للبحث، في حين أضافت المدرستان الأخريان (العضلات الاجتماعية) و(الأعصاب الثقافية).
ويظهر الفرق من ناحية أخرى بين هذه المدارس في نوع التأثير الذي مارسته كلّ واحدة منها. فالتأثير الألماني تأثير تأسيسي عميق وبطيء، يعمل في طبقات المنهج غير المرئية، ويُعيد تشكيل طريقة التفكير ذاتها. أمّا التأثير الفرنسي فهو تأثير إشكالي وجدلي، ارتبط بالأسئلة الكبرى للهوية، والاستعمار، وتحليل المجتمعات الإسلامية الحيّة. في حين أنّ التأثير الأنجلوساكسوني تأثير شبكي سريع الانتشار، ارتبط بالدراسات العابرة للتخصّصات، وبالتحوّلات السياسية والثقافية المعاصرة.
ومن زاوية تركيبية، يمكن القول: إنّ المدرسة الألمانية علّمَت الباحث كيف يقرأ النصّ، والمدرسة الفرنسية علّمَته كيف يرى المجتمع، بينما علّمَته المدرسة الأنجلوساكسونية كيف يفسّر السُّلطة والتمثيل والمعنى. غير أنّ هذه المستويات الثلاثة ما كانت لتتبلور على هذا النحو لولا القواعد الصلبة التي أرسَتْها المدرسة الألمانية في التعامل مع النصوص والمصادر. ومع ذلك، فإنّ هذا التفوّق التأسيسي للمدرسة الألمانية لم يمنحها الهيمنة الرمزية نفسها التي حظيتْ بها المدرسة الفرنسية في الفضاء الفرنكوفوني، أو المدرسة الأنجلوساكسونية في المجال الأكاديمي العالمي المعاصر. فقد ظلّ التأثير الألماني عميقًا لكنه نخبويّ، موجّه أساسًا إلى المختبر الأكاديمي، لا إلى المجال العام. ويُعزى ذلك، من جهة، إلى أن الاستشراق الألماني لم يسعَ كثيرًا، كما ذكرت في مطلع هذا الحوار، إلى تقديم نفسه خارج دائرته اللغوية، ومن جهة أخرى إلى محدودية عدد المثقفين العرب المتقنين للغة الألمانية، وهو ما حالَ دون التعريف الواسع به.
في المقابل، تحوّل التأثير الفرنسي إلى خطاب فكريّ عام، فيما تحوّل التأثير الأنجلوساكسوني إلى خطاب عالمي مهيمن في الجامعات ووسائل الإعلام ومراكز القرار.
والخلاصة؛ أن المقارنة بين هذه المدارس ليست مقارنة تفاضل يسير، بل مقارنة بين أنماط مختلفة من التأثير: مدرسة بَنَت الأساس المنهجي الصلب، وأخرى وسّعت مجال الرؤية نحو المجتمع، وثالثة نقلَت الحقل إلى فضاء الخطاب العالمي والجدل الثقافي والسياسي. وبين مستويات النصّ، والمجتمع، والخطاب، تشكّلَت خريطة الدراسات الإسلامية المعاصرة. غير أن الأساس العميق الذي لا يزال يحمل هذا البناء، حتى اليوم، يبقى إلى حدّ بعيد ألماني الصنعة، مهما تغيّرت الواجهات النظرية وتبدّلت العناوين الكبرى.
س8: إلى أيّ مدى ترى درجة الإنصاف والعلمية عند النظر للاستشراق الألماني؟ وهل هناك أغراض أيدولوجية في بنيته؟
د/ عبد الملك هيباوي:
يثير الاستشراق الألماني مفارقة خاصّة نادرًا ما تجتمع بهذا الوضوح في تقاليد استشراقية أخرى؛ إِذْ يجمع بين صرامة علمية عالية وانخراط سياسي استعماري محدود نسبيًّا. فمن جهة، تميّز هذا الاستشراق بانضباط منهجي صارم، ودقّة بالغة في التعامل مع النصوص والمصادر، ونقد حادّ للمرويات التاريخية والدينية. ومن جهة أخرى، لم يتشكّل، بخلاف الاستشراق الفرنسي والبريطاني، بوصفه ذراعًا معرفيًّا مباشرًا لمشروع استعماري واسع في العالم الإسلامي. ومن هنا تنبع إشكاليته: كيف يمكن أن يجتمع قدرٌ كبيرٌ من الإنصاف المنهجي مع نتائج معرفية ظلّت صادمة للوعي الإسلامي؟
من حيث العلمية الصّرفة، يصعب إنكار أنّ الاستشراق الألماني يمثّل إحدى الذُّرى الكلاسيكية في البحث الأكاديمي في الدراسات الإسلامية. فقد نشأ داخل تقليد فيلولوجي لا يهادن المسلّمات، ولا يعترف بالسلطات غير القابلة للنقد، ويخضع النصوص لمنطق المخطوطات والمقارنة اللغوية والتحليل التاريخي الصارم. وقد أسهم هذا التقليد في تحقيق التراث العربي، وتنظيم دراسة القرآن والحديث واللغة والتاريخ على أُسس علمية دقيقة، ما جعله مرجعًا تأسيسيًّا لكثير من المناهج اللاحقة داخل الغرب وخارجه.
غير أنّ هذه الصرامة نفسها كانت سلاحًا ذا حدّين. فمِن جهة، حرّرت البحث من التبعية اللاهوتية ومن القراءات الجدلية الساذجة، ومن جهة أخرى نزعتْ عن النصوص الإسلامية حصانتها الرمزية في الوعي الإسلامي. وهنا نشأت المفارقة المركزية: أدوات منصفة تُنتج نتائج قاسية. فالمستشرق الألماني لا ينطلق من نية الطعن، لكنه لا يتراجع عن نتائجه حين يفرضها المنهج. ولذلك بدا هذا الاستشراق، في نظر كثير من المسلمين، منصفًا في أدواته، عنيفًا في آثاره المعرفية.
أمّا عن صِلَته بالأغراض الأيديولوجية والاستعمارية، فالصورة أكثر تركيبًا مما هو عليه الحال في النموذجين الفرنسي والبريطاني. فغياب مشروع استعماري ألماني واسع في العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين حالَ دون تشكّل علاقة عضوية بين المعرفة الاستشراقية والإدارة الاستعمارية. وغالبًا ما كان المستشرق الألماني يكتب للجامعة والمخطوط والمختبر العلمي، لا للحاكم أو الضابط الاستعماري. غير أنّ هذا الاستقلال النسبي عن الاستعمار السياسي لا يعني غياب البُعد الأيديولوجي كليًّا. ففي العمق، اشتغل الاستشراق الألماني داخل أفق فلسفي يرى في العقل الأوروبي المرجع الأعلى لإنتاج المعرفة، وفي المنهج التاريخي-الفيلولوجي الأداة النهائية لفهم جميع الظواهر الدينية. لذا يمكن القول أنّ الاستشراق الألماني لم يخدم الاستعمار العسكري والإداري بقدر ما أسهم في ترسيخ شكلٍ آخر من الهيمنة: هيمنة معرفية رمزية، يُعاد من خلالها ترتيب الإسلام داخل سلطة التفسير الغربية، لا عبر السلاح، بل عبر المنهج.
وعلى مستوى الإنصاف، يقتضي التحليل التمييز بين مستويين؛ فعلى مستوى الأدوات، يظهر قدرٌ واضح من النزاهة: احترام النصوص، التعامل الجادّ مع اللغة، وتجنّب التشويه العقائدي الفجّ الذي وسم مراحل أقدم من الاستشراق الأوروبي. وفي هذا المستوى، يتفوّق الاستشراق الألماني بوضوح. أمّا على مستوى الافتراضات الفلسفية العميقة، فإنّ الإنصاف يصبح إشكاليًّا؛ إِذْ يُفترض مسبقًا أنّ الدِّين ظاهرة قابلة للتفسير التاريخي الكامل، وأنّ الوحي نفسه يمكن اختزاله في شروط لغوية واجتماعية وثقافية. وهذا ليس معطى علميًّا خالصًا، بل اختيار فلسفي يحمل موقفًا ضمنيًّا من ماهية الدِّين.
ومن هنا تتحدّد حدود إنصاف هذا الاستشراق: فهو منصف في التقنية، غير محايد في الأنطولوجيا؛ دقيق في التحليل، لكنه يعمل داخل تصوّر يرى التجربة الدينية مادة قابلة للتشريح الكامل. إنه لا يهاجم الإسلام بوصفه معتقدًا، لكنه يفكّكه بوصفه بناء تاريخيًّا على نحو يحدّ من الاعتراف بخصوصيته الوجودية.
وفي ضوء ذلك، تبرز أهمية ربط هذه المسألة بنقد إدوارد سعيد للاستشراق. فقد أصاب سعيد حين كشف العلاقة البنيوية بين المعرفة والسلطة، ولا سيما في السياقات الاستعمارية الفرنسية والبريطانية. غير أنّ الحالة الألمانية تفرض تعديلًا في زاوية النظر؛ إِذْ تُظهر أنّ الهيمنة لا تمرّ دائمًا عبر الإدارة الاستعمارية، بل قد تُمارَس عبر سلطة المنهج ذاته. فالاستشراق الألماني لم يقل للإسلام: (أنا أحكمك)، بل قال له: (أنا أفهمك علميًّا على نحو أعمق)، وهي صيغة من السلطة لا تقلّ أثرًا، وإن بدتْ أقلّ صخبًا.
وبذلك، لا يُلغي الاستشراق الألماني أطروحة سعيد ولا يؤكّدها بالكامل، بل يكشف حدودها. فهو يبرهن أنّ الاستشراق ليس نمطًا واحدًا، وأنّ العلاقة بين المعرفة والسلطة قد تكون علاقة خطاب وتمثيل، لا بالضرورة علاقة إدارة وهيمنة مباشرة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى توسيع نقد سعيد من تحليل (الاستعمار بالسلاح) إلى تحليل (الاستعمار بالمنهج).
والخلاصة أنّ الاستشراق الألماني يتمتّع بدرجة عالية من النزاهة المنهجية، وهو أقلّ ارتباطًا بالاستعمار السياسي المباشر، لكنه يظلّ منخرطًا في إعادة إنتاج مركزية العقل الغربي بوصفه المرجع الأعلى لفهم الإسلام وتاريخه. وبين الإنصاف العلمي والهيمنة المعرفية، تتشكّل خصوصيته الإشكالية التي تجعل منه، في آنٍ واحد، إنجازًا علميًّا كبيرًا وسؤالًا نقديًّا مفتوحًا.
س9: ما مستقبل الاستشراق الألماني في ظلّ التغيرات الفكرية والسياسية في أوروبا تجاه الإسلام؟
د/ عبد الملك هيباوي:
مستقبل الاستشراق الألماني يُكتب اليوم على ثلاث جبهات متقاطعة: الجامعة، والدولة، والشارع السياسي. وما كان قديمًا (استشراقًا فيلولوجيًّا خالصًا)، صار اليوم محاطًا بأسئلة ساخنة عن الإسلام كدين حي، وكأقلية، وكـ(مسألة أمنية) في آنٍ واحد. لذلك لا يكفي أن نسأل: أين يتجه الاستشراق الألماني؟ بل يجب أن نسأل أيضًا: مَنْ يملك حقّ تعريف ما هو (الاستشراق) أصلًا في السياق الألماني الجديد؟
أول ما يلفت النظر أنّ الاستشراق الألماني الكلاسيكي يتفكّك من الداخل؛ لا بمعنى انهيار الدرس، بل بمعنى انتقاله من"Orientalistik"(استشراق) إلى"Islamwissenschaft" (علم الإسلام) ثم إلى برامج (اللاهوت الإسلامي) أو (الثيولوجية الإسلامية) (Islamische Theologie) في الجامعات الألمانية. فالدولة الألمانية دعت منذ 2006 إلى مؤتمر أطلقت عليه اسم (المنتدى الإسلامي الألماني) كإطار للحوار بين الهيئات الإسلامية في ألمانيا والدولة الألمانية، يُعقد كلّ أربع سنوات. وقد دُعِيتُ شخصيًّا للمشاركة فيه في الفترة الممتدة ما بين 2006- 2018، وكان من مخرجاته إنشاء كراسي ومعاهد خاصة بتدريس (الثولوجية الإسلامية) (Islamische Thologie)، أو ما يُعرف عندنا في البلاد العربية بـ(الدراسات الإسلامية الشرعية)، تابعة للجامعات الألمانية. تهدف هذه المعاهد إلى تكوين مدرِّسي التربية الإسلامية في المدارس الحكومية الألمانية، وتكوين المرشدين الروحيين والأئمة، وتعزيز حضور الإسلام كموضوع أكاديمي من داخل المنظور الإسلامي نفسه، لا فقط من خارجه، بتمويل تجاوز عشرات الملايين من اليوروهات على مدى أعوام التأسيس الأولى. وقد أُسّس أول معهد عام 2011 بجامعة توبنجن تحت مسمّى: (معهد الدراسات الإسلامية)، وقد اشتغلتُ فيه كأستاذ محاضر لمدّة تسع سنوات (2012- 2021). هذا وقد بلغ عدد هذه المعاهد إلى حدود إعداد هذا الحوار سبعة معاهد، تتوزّع على سبع جامعات ألمانية (توبنجن، فرانكفورت، إرلانجن، مونسنتر، أوسنابروك، هامبورغ، وبادربورن). هذا يعني أنّ الإسلام لم يعد حقلًا يُدرَس فقط من خارج، بل أصبح أيضًا حقلًا يتكلّم فيه الفاعل المسلم بلغته الخاصّة داخل الجامعة الألمانية.
في الوقت ذاته، تشهد الساحة توسّعًا في برامج الشراكة الأكاديمية مع العالم الإسلامي، التي تربط دراسات الإسلام مع حقول أخرى ضِمن شراكات متكافئة مع جامعات في المغرب وتونس ومصر ولبنان وتركيا والبوسنة وغيرها، أو برامج (الحوار الأكاديمي مع العالم الإسلامي) التي تدعمها (الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي) (Deutscher Akademischer Austauschdienst) المعروفة اختصارًا بـ"DAAD" بتمويل من وزارة الخارجية. مؤسّسة "DAAD" هذه، تؤشّر إلى انتقالٍ من استشراق أُحاديّ الاتجاه إلى نماذج إنتاج مشترك للمعرفة. فالمعادلة القديمة كانت: (ألمان يدرسون مسلمين)، والآن تُستبدَل تدريجيًّا بصيغ جديدة: فِرَق بحث وطلبة ومناهج تُصاغ في فضاء تفاعلي متعدد المراكز. إلى جانب ذلك، ترسّخت في العقود الأخيرة مراكز بحث متخصّصة في المجتمعات المسلمة المعاصرة، مثل مركز (الشرق المعاصر) (ZMO) في برلين الذي يركّز على دراسة المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة في أقاليم متعدّدة ضمن مقاربات تاريخية وأنثروبولوجية مقارنة. أو (مدرسة الدراسات العليا لثقافات ومجتمعات المسلمين) في برلين (BGSMCS) أيضًا التي تُعلن صراحة هدف تفكيك مركزية الشمال العالمي عبر نظريات من الجنوب العالمي. هذه المؤسّسات وغيرها تتحرّك، نظريًّا على الأقلّ، في اتجاه ما بعد-الاستشراق: أي نقد الصور الكلاسيكية للشرق، والانفتاح على أصوات ومرجعيات معرفية غير أوروبية.
لكن الصورة ليست وردية؛ فبموازاة هذه الديناميات، يتصاعد في ألمانيا وأوروبا خطاب أمني/سياسي حول الإسلام، ينعكس مباشرة على تمويل واتجاهات البحث. فوزارة التعليم والبحث الاتحادية في ألمانيا تموِّل، مثلًا، برامج موسّعة لدراسة ما يسمى بـ(الإسلاموية)، أو الإسلام السياسي والتطرّف، مع تخصيص ملايين اليوروهات لتمويل أبحاث عن أسباب وآثار (الإسلام الراديكالي) في ألمانيا وأوروبا، ويُدمَج الإسلام في أجندات البحث حول الهجرة، والاندماج، والأمن الداخلي. هذا لا يعني أنّ كلّ هذه الأبحاث غير علمية، لكن يعني أنّ جزءًا معتبرًا من الاهتمام البحثي بالإسلام بات يتحرّك تحت ظلّ سؤال الأمن والتهديد أكثر مما يتحرّك تحت ظلّ سؤال الفهم والمعنى. هنا بالضبط يتشكّل التوتّر الذي سيحدّد مستقبل (الاستشراق الألماني): قطبٌ أوّل يسير في اتجاه تسييس خفيّ للدراسات الإسلامية، حيث يُختزل الإسلام في ملفّات مثل الراديكالية، التطرّف، الإسلاموية، الاندماج، الحجاب، العنف، إلى آخر لائحة العناوين الإعلامية. وقطبٌ ثانٍ يحاول أن يؤسّس لخطاب علمي نقدي مستقلّ، يدرس الإسلام كدِين وتاريخ وثقافة من دون أن يتحوّل الباحث إلى خبير دائم في (مكافحة التطرف) أو الوقاية منه.
بين هذين القطبين تتحرك الجامعات: فهناك مَنْ ينجرف تدريجيًّا إلى موقع (المزوّد المعرفي للسياسات الأمنية)، وهناك مَنْ يقاوم ويحاول الحِفاظ على مسافة نقدية من الخطاب السياسي والإعلامي، مستندًا إلى تقاليد البحث العميق في النصوص والتواريخ واللغات.
العنصر الثالث الحاسم في رسم المستقبل هو التغير الديمغرافي والمعرفي داخل الحقل نفسه. فعدد متزايد من الباحثات والباحثين في الإسلام في ألمانيا اليوم يحملون خلفيات مهاجرة أو جذورًا مسلمة، ويجمعون بين التكوين الأكاديمي الألماني والانخراط الوجودي في التجربة الإسلامية. هذا يفتح الباب لإعادة تعريف مَن يملك الحقّ في (الحديث عن الإسلام): هل هو الخبير الخارجي، أم العالِم المسلم، أم الاثنان في حوار نقدي متكافئ. إذا نجح الحقل في تحويل هذا التنوّع إلى ثروة معرفية، سنرى تشكّل نماذج بحثية تتجاوز ثنائية (الاستشراق / الدفاعيات الإسلامي)، نحو مساحة وسيطة: نقدية، واعية ذاتيًّا، لا تعظِّم الإسلام ولا تُشَيْطِنه، بل تحلّله كظاهرة إنسانية معقّدة. في المقابل، إذا استسلم الحقل لضغوط الاستقطاب السياسي والإعلامي، فالمستقبل قد يذهب في اتجاهين مقلقين: إمّا تحوّل الدراسات الإسلامية إلى ملحق معرفي لسياسات الهوية والخوف، وإمّا انسحاب الباحثين الجادّين من الفضاء العام، وترك الساحة لـ(خبراء) الصوت العالي والعمق المحدود.
يُضاف إلى كلّ ذلك بُعْدٌ رابع غالبًا ما يُهْمَل في النقاش: التحوّل الرقمي والمنهجي. فمشاريع الرقمنة، والأرشفة الرقمية للمخطوطات، وتحليل النصوص آليًّا، تُعيد اليوم تشكيل أدوات البحث في النصوص الكلاسيكية، بينما تفرض شبكات التواصل الاجتماعي موضوعات جديدة (إسلام أونلاين، فتاوى رقمية، سلفية رقمية، نسوية إسلامية رقمية...). إذا استطاعت المدرسة الألمانية أن تمزج بين تقاليدها الفيلولوجية الثقيلة وهذه الأدوات الرقمية الجديدة؛ فستحتفظ بتفوّق نوعي في التحقيق والنقد النصِّي. أمّا إذا بقيت أسيرة الحنين إلى (المخطوط في المكتبة) وحده، فستخسر جزءًا من قدرتها على مواكبة تحوّل الإسلام نفسه إلى ظاهرة رقمية عابرة للحدود.
في ضوء كلّ هذا، يمكن تلخيص ملامح مستقبل الاستشراق الألماني، أو لِنَقُل: مستقبل الدراسات الألمانية حول الإسلام، في ثلاث كلمات متصارعة:
1- التحوّل: من استشراق كلاسيكي يراقب من بعيد، إلى شبكة حقول (استشراق، دراسات إسلامية، لاهوت إسلامي، دراسات أمنية وثقافية) تتقاطع وتتصارع.
2- التسييس: ضغط دائم لجعل الإسلام موضوعًا أمنيًّا وهويّاتيًّا، وما يرافق ذلك من خطر انزلاق البحث العلمي إلى دور المبرّر لسياسات جاهزة.
3- التكافؤ: إمكان (وليس ضمان) بناء شراكات معرفية متكافئة مع باحثين وباحثات من العالم الإسلامي، ومع الفاعلين المسلِمين داخل ألمانيا نفسها، بما يخفّف من مركزية (النظرة من فوق). المستقبل إذن ليس خطًّا مستقيمًا صاعدًا نحو مزيد من (العلمية المحايدة)، بل هو ساحة صراع بين مَنْ يريد تحويل الإسلام إلى ملف أمني دائم، ومن يريد استعادته كموضوع بحث إنساني مفتوح، ومن يحاول أن يفرض حضورًا مسلمًا نقديًّا داخل اللعبة المعرفية ذاتها.
في هذه الساحة سيتقرّر ما إذا كان الاستشراق الألماني سيتحوّل إلى نموذج متجدّد لدراسات ما بعد استشراقية أكثر توازنًا، أم سيتفتّت بين التعامل مع الإسلام تعاملًا أمنيًّا من جهة، وردود فعل دفاعية من الجهة المقابلة، مع خسارة الإرث المعرفي العميق الذي راكمه في القرنين الماضيين.
كلمات مفتاحية
ضيف الحوار

الدكتور عبد الملك هيباوي
دكتوراه في الدراسات الاستشراقية الألمانية من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة بون بألمانيا. رئيس قسم حوار الأديان والحضارت بالمعهد الألماني للحوار والتفاهم "مواطنة" بألمانيا. أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة توبنجن الألمانية، ومنسق ماستر الدراسات الإسلامية التطبيقية للرعاية الروحية والخدمة الاجتماعية-سابقا-.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))