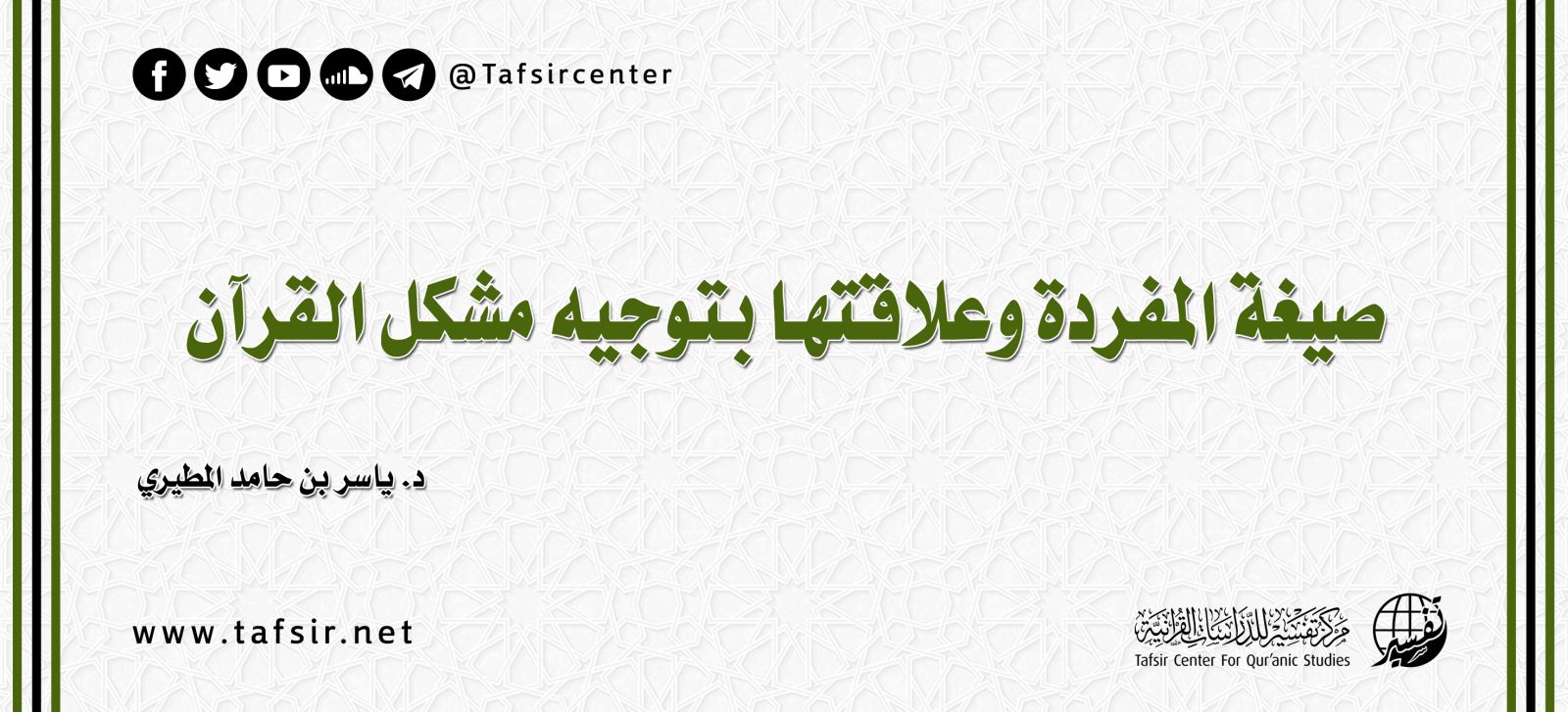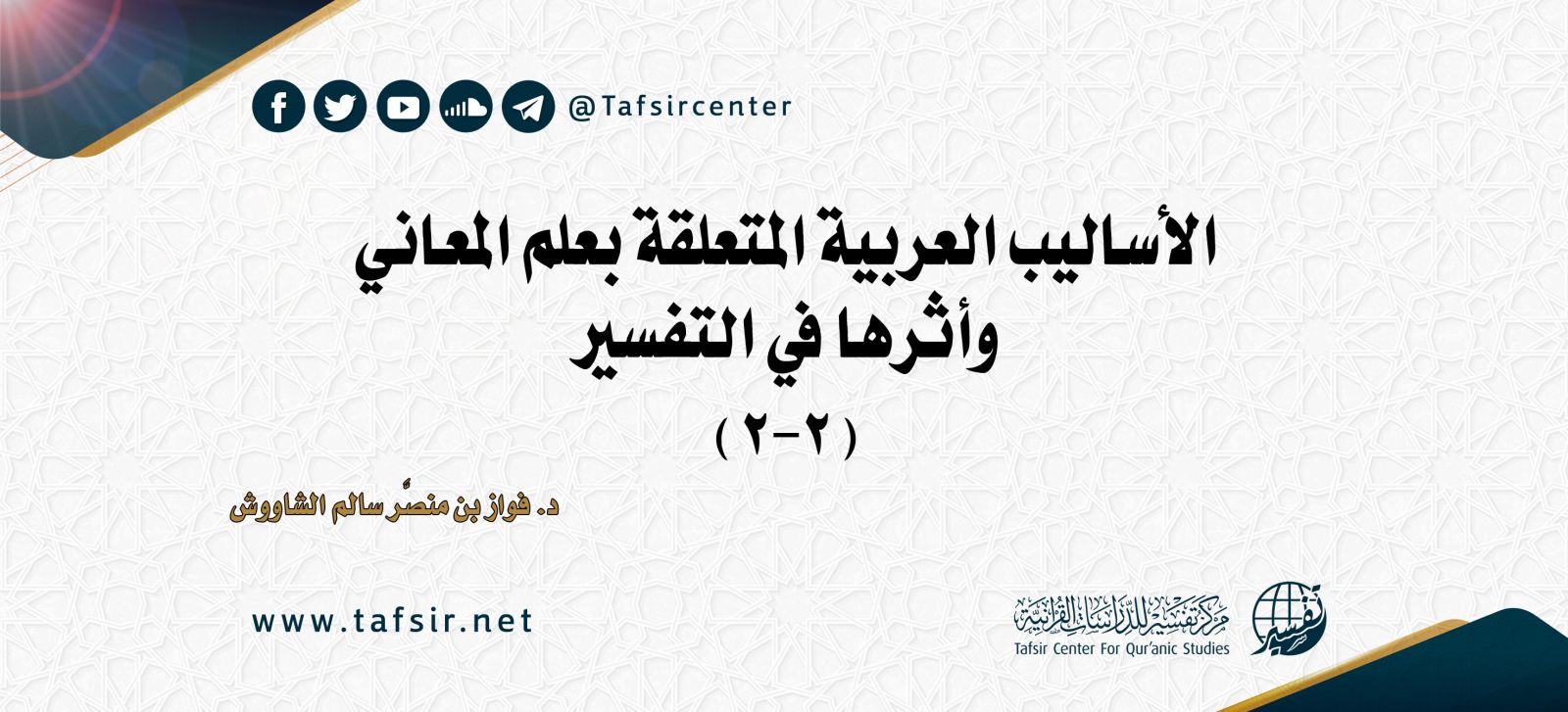قراءات المنهجية القرآنية (1- 4)؛ مدخل: المُحدِّدات الرئيسة لقراءات المنهجية القرآنية
مدخل: المُحدِّدات الرئيسة لقراءات المنهجية القرآنية
الكاتب: طارق محمد حجي

مقدمة:
هذا هو المقال الأول ضمن سلسلة مقالات تتناول (قراءات المنهجية القرآنية) كإحدى المدارس المعاصرة لقراءة القرآن ذات الملامح الخاصّة والناشئة على ساحة التأويلية العربية المعاصرة، في هذا المقال الذي يعدّ بمثابة مدخل للسلسلة سنتناول بالأساس الملامح العامة لهذه القراءة؛ سياقها المعرفي المنشئ ورهاناتها الخاصّة، وأهم مفاهيمها وأهم أعلامها الذين سنتناولهم تفصيلًا في المقالات القادمة، وهذا بعد تمهيدٍ نُشير فيه لعلاقة هذه القراءات بالقراءات الحداثية ضمن تصوّر لتاريخ التأويلية العربية في صِلَتها بالتقليد.
تمهيد:
كنّا قد حاولنا سابقًا في مقالنا الأول حول (القراءات الحداثية للقرآن) -مقال المدخل: المُحدِّدات العامة للقراءات الحداثية- أن نقترح معيارًا لتصنيف الدراسات القرآنية الحديثة والمعاصرة، يستند إلى واقعة صلبة مستقلَّة تجاه رؤانا الفكرية عن النهوض والتقدّم والإصلاح، واقعة (معرفية) بالأساس، هي واقعة (اهتزاز التقليد)، وهذا حتى نضمن كون هذا المعيار معيارًا منهجيًّا غير (مضموني) أو (اتجاهي) يستطيع أن يتجاوز عيوب المعايير الأخرى خصوصًا سكونيتها، فيطلعنا على حركية التعامل (المنهجي) العربي الحديث والمعاصر مع النصّ القرآني، ونستطيع عَبْره موقعَة مجمل هذه الاشتغالات واكتشاف العلاقات فيما بينها كجزء من تحديدنا لملامحها الرئيسة.
وبناءً على هذا المعيار المُستَنِد لواقعة (اهتزاز التقليد) كنّا قد صنَّفنا القراءات المعاصرة حول القرآن إلى: (قراءات خارج التقليد) و(قراءات تقليدية)، وصنَّفنا القراءات خارج التقليد لـ(قراءات ضد التقليد)، أي: تلك القراءات التي تتخفَّف من حمولة المدونات التقليدية دون أن تبلور بالضرورة منهجيات جديدة في قراءة النصّ القرآني، وقراءات تحاول ملء هذا الفراغ المنهجي لتأسيس نفسها في مواجهة (التأويليات الكلاسيكية)؛ إمّا عَبْر استخدام مناهج حديثة مُستقاة من العلوم والمنهجيات الغربية المعاصرة فتكون (قراءات حداثية)، أو عَبْر استنباط مناهج لقراءة القرآن من القرآن نفسه فتكون (قراءات المناهج القرآنية).
وكنّا قد مَوْقَعْنَا (القراءات الحداثية للقرآن) في خريطة التعامل العربي المعاصر مع القرآن انطلاقًا من هذا المعيار، أي: انطلاقًا من الموقف تجاه واقعة (اهتزاز التقليد)، واستنادًا كذلك للسياقات المعرفية الخاصّة التي نشأ فيها الدرس الحداثي للقرآن والمنعطفات التي مرّ بها التيار الحداثي في التعامل مع القرآن، والتي تعطي لهذه القراءات رهاناتها الخاصّة التي تُميِّزها عن غيرها مهما تشابهت معها في بعض المنطلقات أو مهما تغيَّت نفس الأهداف؛ ليصبح لدينا بهذا صورة مبدئية عن منطلقات ورهانات ومُحدِّدات القراءة الحداثية حاولنا تثبيتها وتعميقها عبر الدراسة المُفصَّلة لخطابات أعلام هذه القراءة.
في هذا المقال الذي نبتدِئ به تَناوُلَـنَا لمدرسةٍ أخرى من المدارس المعاصرة في قراءة القرآن هي (قراءات المنهجية القرآنية)، نحاول كذلك تحديد الملامح العامة والرئيسة لهذه القراءة اعتمادًا على نفس المعيار، أي: على موقع هذه القراءات من واقعة (اهتزاز التقليد)، وكذلك على السياقات المعرفية المُنشِئة لها والتي تعطيها رهاناتها ومنطلقاتها الخاصّة وتُشكِّل القضايا التي ربما تُطرح في كلّ القراءات الأخرى بطابع هذه القراءة الخاصّ.
وربما علينا الاعتراف في البداية بكونِ مهمَّتِنا هنا في تحديد ملامح (قراءات المناهج القرآنية) وموقعتها في خريطة درس القرآن المعاصرة أصعبَ من مهمتنا في التعامل مع القراءات الحداثية، حيث إنّنا هناك كنّا نتعامل مع مدرسة أضحى وجودها بارزًا وواضحًا بالفعل على ساحة الدرس المعاصر للقرآن، وأضحى مصنفًا ومموقعًا بالنسبة لغيره من الاشتغالات، حتى لو اختلفنا مع بعض هذه التصنيفات ومعيار تصنيفها ومع المصطلح المستخدم للدلالة عليها ومع تصوّر علاقاتها بغيرها من المدارس، وهو ما حدانا لاقتراح معيار آخر للتصنيف ولمحاولة تحديد ملامح هذه القراءة وإعادة موقعتها في الدرس المعاصر للقرآن، أمّا هنا فالوضع مختلف، حيث نتعامل مع قراءة ربما ورغم وضوح التشابهات في خطابات روادها -بالأخص طه جابر العلواني وأبو القاسم حاج حمد- من حيث الرهانات والمنطلقات والأدوات والسياقات المعرفية المُنشِئة بما يسمح باعتبارها تيارًا خاصًّا في قراءة القرآن، إلا أنها لم تُدرَس ربما كمدرسة أو كتوجّه في قراءة القرآن، بل طالما تشهد دراستها الحيرة في إيجاد تصنيف وموقع مُلائِم ومُناسِب لخطابات روّادها[1]؛ لهذا فإنّ جزءًا كبيرًا من مجهودنا في هذا المقال- المدخل، بل وفي المقالات القادمة؛ سينصبّ على محاولة البرهنة على وجود هذه المدرسة من الأساس، وجودها ولو بصورة أوّلية كخط فكري ناشِئ ومُتَنامٍ، إن كانت له بعض التداخلات والتشابهات مع قراءات أخرى للقرآن إلا أنه وبسبب تجذُّره في سياقات معرفية مخصوصة تعطيه رهاناته الخاصّة فإنه يظلّ خطًّا مُميَّزًا كاشِفًا عن مدرسة خاصّة في التعامل مع النصّ القرآني كما سنحاول أن نوضح.
وقبل الدخول في مضمون المقال ومحاولة تحديد ملامح هذه القراءة ومُحدّداتها الرئيسة، أي (بنينتها) بتحديد تصوراتها ورهاناتها ومنطلقاتها والعلاقات بينهم، نودّ فقط التأكيد على أنّ ما نعنيه بـ(المنهجية القرآنية) في مصطلح (قراءات المنهجية القرآنية) الذي اخترناه للدلالة على هذه المدرسة؛ هو أن هذه المنهجية هي قرآنية في رؤية أصحاب هذه القراءة فحَسْب، بعيدًا عن كوننا نقتنع بهذا أو لا نقتنع، فكما سنوضح فإنّ الوصول لمنهج قرآني يسدّ أزمة فراغ المنهج بعد (اهتزاز التقليد) هو أحد الرهانات المركزية لهذه القراءة، بل هو العنوان الرئيس لاشتغالها بعيدًا عن نصيب هذا الرهان من التحقّق أو عدمه.
السياق المعرفي لنشأة قراءات المنهجية القرآنية؛ الخطاب الإسلامي الجديد:
تظلّ أهم خطوة ربما في الوصول لمحدِّدات أيّ خطاب هي تعيين السياقات المعرفية المُنشِئة له، حيث إن هذه السياقات هي التي تعطيه رهاناته ومنطلقاته الأساس، و(قراءات المنهجية القرآنية) هي وليدة سياق معرفي خاصّ تمامًا، فهذه القراءات وليدة سياق بروز عدد من النخب الإسلامية التي تجمع بين الهمّ النهضوي والإصلاحي الإسلامي وبين التكوين -أو الاحتكاك- الأكاديمي في الجامعات الغربية[2]، فهذا السياق سياق تصاعد الهمّ النهضوي بزيادة الأزمات والإخفاقات التي عاينها التيار الإسلامي في البلاد الإسلامية وتعثُّر مشروع الإصلاح الديني والنهضوي من جهة، وسياق المعرفة المنهجية بالفكر الغربي وبأزمات علومه ومجتمعاته وبالتيارات النقدية المنتشرة فيه نتيجة التكوّن -الاحتكاك- الأكاديمي في الغرب من جهة أخرى، أدَّت للشعور بتأزُّم كافة مشاريع النهوض العربية والإسلامية؛ المشروع الإسلامي التقليدي، والمشروع التغريبي المُنبَهِر بالحضارة الغربية، والمشروع التلفيقي الذي يظنّ إمكان استعارة بعض نتاجات الحضارة الغربية معزولة عن نظامها المعرفي وزرعها في النظام المعرفي الحضاري الإسلامي، وتبيُّن عدم قدرة هذه المشاريع وبسبب موقفها من الغرب ومن التراث ونمط تعاملها معهما على تحقيق معادلة النهوض وتأمين حلّ للأزمة الفكرية العربية بل وللأزمة الفكرية العالمية، فضلًا عن أنها أدَّت لإدراك التباين بين النظامين المعرفيين التوحيدي والغربي بصورة جلية، فكما يقول الفاروقي مُتحدثًا عن جيله صاحب الهمّ النهضوي الإسلامي والتكوين الأكاديمي الغربي: «فجيلنا فقط هو مَن أدرك هذا التناقض؛ إذ عاشه في حياته»[3]، بالإضافة لإدراك كون النظام الحضاري الغربي ليس سقفًا للعالم كما كان يُتخيل من قبل حيث تبلورت تيارات نقدية له في الغرب ذاته، هذه الإدراكات الجديدة التي عاينها هؤلاء كانت أساسًا لمنعطف حاسم في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر هو بزوغ ما أسماه المسيري بـ«الخطاب الإسلامي الجديد»[4][5].
هذا المنعطف (الخطاب الإسلامي الجديد) المُتأسِّس على هذه الإدراكات الجديدة أدَّى لمحاولة إعادة صياغة مشروع النهضة والإصلاح بحيث يتجاوز مُركَّب عيوب المشاريع السابقة التي لم يتوفر لها نفس مثل هذه الإدراكات، فيتجاوز التلفيق البراني بين المنظومات الفكرية ويتخلّص من فكر المقاربات والمقارنات الذي شاع في فترة خطاب النهضة والإصلاح[6]، إلى محاولة تقديم قراءة نقدية للإبستيمات المُؤطِّرة للتراث وللفكر الغربي كليهما تكون أساسًا لمشروعٍ فكري جديد تمامًا ذي بُعد حضاري شامل ينطلق من التوحيد هاضمًا الحداثة[7] ومستوعبًا لها ومتجاوزًا لأخطائها ونقصها، ليُمثِّل الحلّ للأزمة الفكرية العربية والعالمية التي عايشها وعاينها هؤلاء[8].
فهذا التيار الذي نشأ في بعض الجامعات الغربية ثم تطوّر بعدها في رابطة للعلماء المسلمين في الغرب (علماء الاجتماع) ثم وصل لاحقًا لبلورة مؤسّسة (المعهد العالمي للفكر الإسلامي) ولتأسيس مشروع (أسلمة المعرفة) الفكري كمشروع رئيس للإصلاح ولتقديم البديل الحضاري مع روّاد أربعة، هم: إسماعيل راجي الفاروقي (1921- 1986)، وطه جابر العلواني (1935- 2016)، ومنى أبو الفضل (1945- 2008)، وعبد الحميد أبو سليمان (1936-...)، قد انطلق من كون أزمة الفكر العربي الإسلامي المعاصر -بل وأزمة الفكر العالمي المعاصر- هي (أزمة منهجية)[9] بالأساس، تتعلق إمّا بغياب المنهج (لو كان الحديث عن الفكر الإسلامي) أو بفساده وعدم صلاحيته بسبب انقطاعه عن مشكاة الوحي وعن (التوحيد)، وعن (مصدر المعرفة الإلهي)[10]، (لو كان الحديث عن الفكر الغربي).
والشعور بغياب (المنهج) يبلغ عمقه هنا مع تبلور هذا التيار في ستينيات القرن الماضي، حيث نجد عنده رفضًا أكثر حِدَّة للتقليد ولبناه المعرفية المُؤسِّسة حيث إهمالها درس الواقع والطبيعة[11] (وهي إحدى القراءتين المفروضتين في المنهجية المعرفية الإسلامية وفقًا لرواد هذه المدرسة كما سنوضح)، وفرضها مناهج من خارج القرآن عليه (وحاكمية القرآن مُحدِّد منهجي أساس عند رواد هذه القراءة كما سنوضح كذلك)، وكذلك رفضًا أكثر حِدَّة للفكر الغربي ولبناه المعرفية ومناهجه خصوصًا في العلوم الاجتماعية والإنسانية المُفوِّتة للأبعاد الروحية والأخلاقية للإنسان التي تقرّر الظاهرة الإنسانية[12]، ومقطوعة الصلة بـ(التوحيد) لا كمعتقد فحَسْب وإنما كمُحدِّد إبستمولوجي ناظم للمعرفة الإنسانية[13] انطلاقًا من (وحدانية الله، ووحدة الخليقة، ووحدة المعرفة)، والمُنفَصِلَة عن القيمة في تنظيراتها وتطبيقاتها، مما يجعلنا مع هذا التيار أمام واقعة اهتزاز مُضاعَفَة في الحقيقة، واقعة «اهتزاز النظام الحضاري الغربي» منضافة لواقعة «اهتزاز التقليد الإسلامي»، وأمام محاولة لا للخروج من التقليد خروجًا سلبيًّا ولا لتقديم نقدٍ جزئي للغرب ينتهي للاستعارة الجزئية والتلفيق، بل أمام محاولة لتقديم «بديل حضاري منهجي» للمنظومتين؛ الغربية المعاصرة المهيمنة، والإسلامية الموروثة «العاطِلَة» عن الإبداع.
هذا الإدراك المُعمَّق لغياب المنهج، وهذا التحديد للأزمة (العالمية) كأزمة منهجية، جعل الرهان الرئيس لهذه القراءات هو اكتشاف منهج جديد لقراءة القرآن والواقع/ الكون مُستَقى مباشرةً من النصّ الخاتم ومن الديانة الخاتمة ذات السمات العالمية والشاملة، يستطيع أن يُشكِّل هذا البديل الحضاري المطلوب في مقابل المشروع الغربي الذي بدا غير قادر على تأمين نظام حضاري إنساني شامل ومتوازن للإنسان المعاصر.
وهذا البحث عن منهج داخل القرآن يعني بالأساس تحولًا ربما يكون جذريًّا قام به هذا التيار في التعامل مع النصّ القرآني يتساوق تمامًا مع التعامل الإبستمولوجي الفريد من قِبَلِه مع التوحيد، حيث لم يعدّ القرآنُ كتابَ هديٍ إيماني فحَسْب ولا كتابَ قوانينَ وعلومٍ كما ساد في بعض التفاسير التراثية والحديثة، بل بالأساس هو كتاب منهج، كتاب أخير له وحده الحاكمية يقدِّم للإنسان في كلّ عصر منهجية معرفية متكاملة يستطيع بها قراءةَ الوحيين؛ المسطور (القرآني)، والمنظور (الكون)، وبناءَ نظامٍ معرفي وأخلاقي مُتكامِل يُحقِّق مهمّة (الشهود الحضاري) لـ(أمة الإسلام) (الوسطية) (الشاهِدَة)[14].
لهذا، فقد كان رهان هذه المدرسة لا الوقوف فحَسْب عند مهمّة تقديم قراءة جديدة للقرآن[15]، أو حتى تقديم منهج تأويليّ جديد، بل كان الرهان هو اكتشاف المنهج القرآني الثاوي في النصّ الخاتم والمُرسَل عبر الكلمة الإلهية الأخيرة، ثم تشغيل هذا المنهج في إعادة بناء العلوم والمعارف، فهو مشروع هدفه العودة للنصّ القرآني واستلهامه ككتاب منهج، وإعادة بناء العلوم التراثية والحديثة كلتيهما انطلاقًا منه، مما يعني كونه مشروعًا حضاريًّا شاملًا يُمثِّل اكتشافُ المنهجية القرآنية أساسَه ومركزَه.
فاكتشاف هذا المنهج هو الرهان المركزي لهذه القراءة التي ربما لا تبغي الوصول لفهوم جديدة بالضرورة للنصّ القرآني، وإنما الأهم والأكثر مركزية وإلحاحًا عندها هو الوصول للفهم عبر النصّ القرآني ومن خلاله، أي: إبرازه كطريق للفهم.
وهذا الرهان الـمَرْكَز لهذه القراءات والمُتجذِّر في السياق المعرفي المُنشِئ لها ورهاناته الأوسع كان له أثرُه على تصوّر هذه القراءات لطبيعة النصّ القرآني وقيامها بتأطيره في طبيعة جديدة تُناسِب الموقع المُتصوَّر والمُقتَرَح له -مُقتَرَح على الجميع مسلمين وغير مسلمين- ككتاب منهج وكحلّ للأزمات العالمية، ونستطيع القول أن كلّ الاشتغالات المضمونية لهذه المدرسة على القرآن لا توجد قيمتها في ذاتها كتفسيرات جزئية لبعض الآيات أو القصص أو السور أو المفاهيم، بل في كونها لَبِنات في طريق بلورة/ اكتشاف هذه الطبيعة الجديدة للنصّ التي تُمهِّد لاكتشاف المنهجية القرآنية الناظمة للمعرفة والمُنقِذَة للوجود الإنساني من أزماته المنهجية بالأساس.
الدين الخاتم و«حاكمية الكتاب»:
إذا كنّا قد ذكرنا في تناولنا للقراءة الحداثية، أن قراءة القرآن وفقًا للدرس العلمي الحديث وإخضاعه للمناهج المعاصرة في القراءة تتطلَّب عملية تسييقٍ للقرآن في التاريخ، وتغييرٍ لطبيعته المُستَقِرَّة طوال القرون الأربعة عشر الماضية، كنصّ أزلي مُفارِق قادم من خارج التاريخ، إلى نصّ موصول جذريًّا بسياقاته الاجتماعية والتاريخية التي وحدها تمنحه معناه، أو ما أسميناه هناك بـ«الأرخنة كمُحدِّد منهجي للقراءة الحداثية»[16]، فكذلك فإنّ قراءة المناهج القرآنية تتطلب هي الأخرى تأسيسًا يتعلّق بتغيير طبيعة النصّ القرآني ليتناسب مع الدور الذي تفترضه له في سياق (الأزمة المنهجية) وتقديمه للجميع -بما في ذلك غير المتدينين- كحلّ لهذه الأزمة.
وربما هناك من يستشكل بصورة مبدئية قضية تغيير طبيعة النصّ في هذا السياق، حيث إن هذه القراءات -وعلى خلاف (القراءات الحداثية)- تنطلق من اعتبار النصّ القرآني نصًّا أزليًّا مُفارِقًا كما الرؤية التقليدية، مما يجعل الحديث عن تغيير لطبيعة النصّ أمرًا مُشكِلًا، لكن تصور علاقة النصّ بالتاريخ (محور خلاف القراءة التقليدية والقراءة الحداثية)، هي فقط أحد أوجه ما نقصد بطبيعة النصّ (المُؤطِّرة له والمُحدِّدة لوظيفته ولمنهجيات قراءته)، وفي ظنّنا فإنّ ما يفرض بلورة تأطير جديد للنصّ القرآني (طبيعةً ووظيفةً ومنهجًا) عند قراءة المنهجية القرآنية، هو وجه آخر لهذه الطبيعة، أي: تصوّر هذه القراءات لموقع القرآن في سياق الدين الإبراهيمي السماوي ومضمون رسالته في مقابل الرسالة الأولى (التوراة) وعلاقته بالنصوص السابقة واللاحقة عليه، أي: مجمل ما تُعبِّر عنه هذه القراءة بـ(حاكمية القرآن)، فقد كان على هذه القراءاتِ الطامحةِ لتقديم القرآن للعالم كبديل منهجي وحلّ للأزمة =تأسيسُ تصوّرها هذا عن موقع النصّ/ طبيعة النصّ القرآني كنصّ له (الحاكمية)، وهي الطبيعة التي تفرض إطارًا منهجيًّا معيّنًا للتعامل معه وتكشف كونه مصدرًا للمنهجية المعرفية، فهذا الموقع وهذه الطبيعة هو ما يُفسِّر -للمسلمين ولغير المسلمين- إمكان الانطلاق من النصّ القرآني كأساس لبديل حضاري وكمصدر للمنهجية وبيان كيف أنّ هذا الحصر للحلّ في (القرآن) «ليس حصرًا عصبويًّا دينيًّا يجتزئ المعرفة الإنسانية ويصادرها» كما يُعبِّر حاج حمد[17].
لذا فقد قامت هذه القراءات بمحاولة تأسيس هذا الموقع/ الطبيعة للنصّ القرآني؛ من جهة في سياق الدين السماوي «التوحيدي الإبراهيمي» عبر المقارنة بين الشريعتين؛ الإسلامية والموسوية، ومن جهة أخرى في سياق الأنظمة الحضارية الكبرى الأخرى.
فبالنسبة للمحور الأول، ترى هذه القراءة أنّ الشريعة المحمدية لها ملامح خاصّة (نسخت) ملامح الشريعة الموسوية؛ فالشريعة الموسوية هي شريعة تقوم على حاكمية الله المباشرة لشعب بني إسرائيل، ويرتبط بهذه الحاكمية المباشرة وجود العقاب الحسِّي المباشر والجزاء الحسِّي المباشر فتظهر المعجزات كجزء أساس في هذه الشريعة المتنزلة في سياق المشيئة الإلهية، أمّا الشريعة المحمدية الخاتمة فهي شريعة تقوم على حاكمية الكتاب، وهي شريعة تخفيف فلا يظهر فيها العقاب الحسِّي المباشر، ولأنها تقوم على حاكمية الكتاب المتنزل على مستوى الأمر الإلهي لا الحاكمية الإلهية، فلا تشيع فيها المعجزات بل تتمثّل معجزتها في المنهج الذي تقدّمه لفهم الكون وتحرير الإنسان في التعامل معه من قيود الخرافة من جهة، وقيود التملك من جهة أخرى.
فالفارق بين الشريعة المحمدية والشريعة الموسوية هو فارق بين؛ أمر إلهيّ/ أرض حرام/ خطاب عالمي/ شريعة تخفيف/ أمّة شاهدة/ حاكمية الكتاب، في مقابل مشيئة إلهية/ أرض مقدّسة/ خطاب حصري/ شريعة إصر/ أمة مستبدَلَة/ حاكمية إلهية[18].
أمّا في المحور الثاني فتَعتبر هذه القراءة أنّ القرآن كوحي إلهي خاتم مُرسَل للبشرية جميعها، فإنه مَودَع الرؤية الإبستمولوجية الكونية التي لا تستطيع كل حضارة بشرية جزئية ونسبية سوى الوصول لبعض أبعادها، وتفويت أبعاد أخرى تفقد التكامل الذي لا يُحقِّقه إلا الاهتداء بالكتاب الخاتم.
لذا فإنّ مقولة (حاكمية الكتاب) تُعدّ هي المقولة الأساس في هذه القراءة، والتصور المركزي فيها، فهي السمة المُميِّزة للشريعة الخاتمة العالمية، وهي الكلمة الأخيرة من السماء إلى الأرض التي ينبغي الانصات لها من أجل تجاوز الأزمة والوصول للشهود الحضاري والتكامل المعرفي، وهي المقولة التي تُحدِّد موقع القرآن في سياق الوحي الإبراهيمي السماوي وفي مواجهة النصوص السابقة واللاحقة عليه وفي مواجهة كل الأنظمة الحضارية وتؤطِّره منهجيًّا وتفترض طريقة التعامل معه؛ لذا فإن هذه القراءة تحاول صقل هذه (المقولة/ الطبيعة) المركزية بحيث تتحول لـ(مُحدِّد منهجي) للقراءة، وبحيث تصلح كأساس لاكتشاف (المنهجية المعرفية القرآنية).
هذا الصقل لهذه المقولة تم عن طريق تحديد سمات النصّ القرآني المُودَعة فيه والتي تمنحه هذه (الحاكمية)، والتي ينبغي تشغيلها واستحضارها في تلقي النصّ والتعاطي معه؛ في مواجهة النصوص التوحيدية السابقة المُتسرِّبة للتفاسير والمُشوِّشَة على بيان النصّ وجلاء منهجيته، أو في مواجهة اللسان العربي، أو في مواجهة علوم المدونة التراثية، أو في مواجهة المناهج الغربية المعاصرة النسبية، ونستطيع الوقوف على سمتين مهمتين اعتبرتهما هذه القراءة مُحدِّدتين لهذه الحاكمية/ الطبيعة الجديدة للنصّ، السمة الأولى «الوحدة البنائية للنصّ القرآني»، والسمة الثانية «تَميُّز اللسان القرآني واختلافه عن لسان العرب».
السمة الأولى التي يعتبرها رواد هذه القراءة مُشكِّل أساس لحاكمية النصّ، هي وحدة النص (البنائية) و(المنهجية) و(المقاصدية) -وهي أوصاف مُتداخِلة ومُترابِطة-، ورغم أن سمة وحدة القرآن هي سمة ركَّزَت عليها الكثير من الدراسات القرآنية المعاصرة، إلا أنّ ما يميّز رؤية هذه المدرسة لها، هو كونها تتخطى عندها مجرّد كونها تعبيرًا عن نظام قرآني ما، أو مجرّد ربط بين النصوص الكلية والجزئية، أو حتى مُحدّد للقراءة، إلى كونها وحدةً منهجية ثاوية في النص، تصل القرآن لا ببعضه فقط، بل تصله بالكون وبالواقع المُوحَّد وغير المُجزَّأ كذلك، في إطار (الجمع بين القراءتين)، كفكرة محور في هذه القراءة مُنطلِقَة من (التوحيد) كوحدة للحقيقة وللخليقة وللمنهج[19].
السمة الثانية التي تعتبرها هذه القراءة سمة أساسية في القرآن ومُشكِّلة لحاكميته، هي تَميُّز لسانه عن اللسان العربي، وكونه (لسانًا خاصًّا)، له قواعده الخاصة النحوية والتركيبية والبلاغية، مما يجعله مُحتاجًا لمنهج قراءة يتخطى مناهج الأقدمين والتي تُحَكِّم اللسان العربي على لسان القرآن، أو مناهج المحدَثِين التي تنطلق من نتائج لسانية نشأت في سياق لغات أخرى وتُطبِّقها على القرآن دون مراعاة خصوصية لسانه.
وقد قدَّمت هذه القراءة -وكما سنوضح في المقالات القادمة تفصيلًا- كثيرًا من مجهودها في إطار بلورة وتأسيس هاتين السمتين كأساس لـ(حاكمية النص) حتى إنها أفردت لها مؤلفات خاصة بها.
يرتبط بهذا الموقع/ الطبيعة للنصّ القرآني (النص صاحب الحاكمية)، وأساس المنهجية المعرفية، والمُرتَبِط بسمات الشريعة الخاتمة، القائمة على التخفيف، وعلى حاكمية الكتاب المُتنَزِّل على مستوى عالم الأمر وكفايته، وعلى دور الأمة كشاهد حضاري، التركيز على تيسير القرآن للذِّكْر، أو التركيز على كونه (بيانًا)، ومحاولة التخلُّص من الحمولة التقعيدية -الوساطة- في قراءة النصّ القرآني، وتحرير التعامل الفردي -العملي مع القرآن في مقابل التعامل العلمي- النظري معه، إلا أن هذا لا يعني التخلُّص تمامًا من كلّ قواعد في قراءة النصّ، فكما قلنا فإن السياق المعرفي لنشأة هذه القراءات وتصورها للقرآن وللتوحيد يفرض عليها الالتفات الدائم لإشكال المنهج؛ لذا فنحن نجد محاولة لبلورة منهجيات أو مداخل منهجية للتدبُّر من قِبَل روّاد هذه القراءة، لكن وكما سنحاول في المقالات القادمة أن نوضح تفصيلًا، فإن هذه المداخل المنهجية تُقدَّم باعتبارها نتاجَ اشتغالٍ ورشي جماعي على النص المُنفَتِح بذاته على الواقع وعلى ملَكات الإنسان الإدراكية وكذا المُستوعِب للواقع وللتاريخ وللصيرورة، كما أنها تُقدَّم بحيث تكون قابلة للتطوير أثناء التعامل الفردي مع النصّ (البيان).
وبهذا الشكل الذي يجمع بين افتراض المنهج والتحرّر من الوسائط في التعامل مع النص تكون هذه القراءات قد استطاعت (مبدئيًّا- نظريًّا) الوفاء لنظرتها للنصّ ولدوره ولعلاقته بالأمة وبالعمران من جهة، واستطاعت الخروج من مأزق تحجير النصّ وعزله والذي كان يمكن أن يصيبه بحبسه في حقل النقاشات الأكاديمية المشاريعية الكبرى من جهة أخرى.
قراءات المنهجية القرآنية، منظور خاصّ لإشكالات قديمة:
الكثير من الإشكالات والقضايا التي طرحتها قراءات المنهجية القرآنية هي إشكالات وقضايا مطروحة سابقًا ولاحقًا وفي كثير من الدراسات المعاصرة عن القرآن ومن كثير من الأوجه والزوايا، غير أن ما نريد الإشارة إليه هنا في ختام هذا المقال - المدخل تاركين لبقية المقالات مهمة تفصيله، هو كون ما يُميِّز قراءات المنهجية القرآنية ويعطيها طابعها الخاص حتى في مقاربة إشكالات طالما طُرِقَت من أكثر من جهة =هو الإطار المعرفي الخاص الذي تُؤطِّر فيه هذه القراءات تناولها لتلك المسائل، وهو ما اعتبرناه افتراضًا لـ«طبيعة جديدة/ موقع» للنصّ يتناسب مع المهمة المُتصوَّرة والمُقترَحَة للقرآن، فقضايا مثل (وحدة القرآن)، ومثل (تَميُّز لغته)، و(نفي وقوع الترادف فيه)، ومثل علاقة الكون بالقرآن (الكتاب المنظور والكتاب المسطور) هي قضايا مطروحة بالفعل مسبقًا في كثير من الكتابات، لكنها في سياق هذه القراءات تصل إلى حد المُحدِّد المنهجي، ومُؤطَّرة في إطار معرفي يبتدئ من قراءة إبستمولوجية للتوحيد، وينطلق من الطابع المنهجي المعرفي للنصّ/ الخاتم/ الحاكم/ البيان الذي يُمثِّل المخرج من الأزمة؛ لهذا فالوحدة القرآنية مثلًا تظهر هنا بكونها وحدة منهجية أو كاشفة عن المنهجية وليس مجرّد ربط للنصوص الكلية بالجزئية، أو نصوص الأحكام بنصوص العقائد أو ما شابه، ويظهر هدف الوصول لـ(نظام القرآن)، لا بمجرد بيان الإعجاز ولا بمجرد الوصول للهدي، بل باكتشاف المنهجية المعرفية القرآنية الناظمة لمعرفة النصّ والكون والنفس، ويظهر تجديد التفسير لا بكونه محاولة لفتح آفاق فهوم جديدة جزئية، بل بالتعامل مع النصّ في كليته كطريق للفهم، ثم بتعديل معنى الفهم ودلالة المعنى وإدخال البعد العملي والواقعي والكوني كبعد أساس في التعاطي مع النصّ.
ولعل هذه السمات الخاصة لهذه القراءات -حتى في تناول قضايا وإشكالات مطروحة سلفًا- ستتضح لنا تمامًا حين نتناول في المقالات القادمة، تفصيل طرق تعاملها مع التراث، وطريقة بنائها للعلوم الجديدة، وتصورها لمفهوم الوحدة وعلاقته بالمقاصد، وطريقة تعاملها مع قصص القرآن؛ فكلّ هذه المساحات ستكشف لنا تمامًا الأبعاد الخاصّة لهذه القراءة، لكن ما ندَّعي أننا قد قمنا به هنا في هذا المدخل هو تحديد الملامح الرئيسة لهذه القراءة، فنستطيع إجمال حديثنا بالقول أن هذه القراءة:
من حيث موقعها في سياق التعامل الحديث والمعاصر مع القرآن، هي جزء من قراءات خارج التقليد، ومن حيث السياقات المعرفية المُنشِئة لها، فقد نشأت ضمن سياق الخطاب الإسلامي الجديد بما هو انعطاف في النظر للعلاقة بالتراث والحداثة، لها رهان مركزي، هو البحث عن المنهج القرآني أو القرآن كمنهج للفهم يقدّم بديلًا منهجيًّا حضاريًّا عالميًّا، وأنها تحمل تصوّرًا رئيسًا للنص القرآني يُؤطِّر طرق التعاطي معه، فهذه هي الملامح التي تجعل هذه المدرسة مدرسة خاصّة في التعامل مع النصّ القرآني.
وبالطبع فإنّ هذه الملامح والأبعاد لن تتضح إلا بالقراءة التفصيلية لخطابات رواد هذا القراءة، وهو ما سنحاول القيام به في المقالات القادمة التي ستتناول خطابي المفكِّـرَيْن: العراقي طه جابر العلواني، والمفكر السوداني محمد أبو القاسم حاج حمد؛ رائدَي هذه القراءة، التي لم تتوقف عندهما بالطبع.
[1] فنجد مثلًا أحميدة النيفر في: «الإنسان والقرآن وجهًا لوجه»، يضع (أبو القاسم حاج حمد) في القراءة الأيديولوجية إلى جانب سيد قطب وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد شحرور وحسن حنفي، ونجد مثلًا بعض الدارسين مَن يدرس حاج حمد مع محمد شحرور في إطار الدرس المصطلحي للنص القرآني، أو يدرسه مستقلًّا ودون الالتفات للعلاقات التي تربط منهجه ومنطلقاته ورهاناته بغيره من المتكونين في نفس السياق المعرفي. انظر: الإنسان والقرآن وجهًا لوجه، التفاسير القرآنية المعاصرة، قراءة في المنهج، أحميدة النيفر، دار الفكر، دمشق، ط1، 2000، ص101. كما أننا لا نجد اهتمامًا بهذه المدرسة ضمن الاشتغال الغربي على القراءات العربية المعاصرة، فلا نجد التفاتًا لهذه الأسماء عند سها الفاروقي أو كينيث كراج أو كامبانيني أو غيرهم ممن تناولوا القراءات المعاصرة.
[2] في البداية تشكلت جمعية لعلماء الاجتماع المسلمين في أمريكا وكندا (AMSS) وكان يترأسها إسماعيل راجي الفاروقي.
[3] يُراجع: أسلمة المعرفة، المبادئ العامة وخطة العمل، إسماعيل راجي الفاروقي، ترجمة: عبد الوارث سعيد، دار البحوث العلمية، الكويت، 1983.
[4] معالم الخطاب الإسلامي الجديد، عبد الوهاب المسيري، مجلة المسلم المعاصر، العدد 86، يناير، 1998، ص49.
[5] يتوازى هذا المنعطف (الخطاب الإسلامي الجديد) مع منعطف (التأسيس الثاني للنهضة) الذي اعتبرناه السياق المعرفي المنشئ للقراءات الحداثية للقرآن، فالمنعطفان يمثلان شعورًا بتفاقم أزمة المنهج، وشعورًا بضرورة تجاوز التعامل التجزيئي والبراني مع الحداثة ومع التراث إلى التعامل المنهجي الذي يتعاطى مع هذه المنظومات انطلاقًا من أسسها المعرفية المنتجة للمعرفة لا مع نتاجاتها؛ لذا نجد عند المنعطفَين نفس الرفض للتلفيق والتجاور والتساكن ونفس الانطلاق من أولوية التغيير الفكري على السياسوي، لكن مع اختلاف بعض منطلقات النقد ومآلاته بالطبع، ومن الطريف أن عليّ مبروك صاحب مفهوم (التأسيس الثاني للنهضة) قد كتب دراسة حول مقالة عبد الوهاب المسيري (معالم الخطاب الإسلامي الجديد)، ليدرس فيها نوع الجدة في هذا الخطاب، واعتبر فيها أنّ ملاك تغيّر وجدة الخطاب الإسلامي ليس تغيًرا في نمط العلاقة مع الغرب، بل في نوع الغرب الذي يتم التعاطي معه بنفس الآلية القديمة (التفكير بالأصل)، فعلاقة الخطاب الإسلامي (الجديد) هي نفس العلاقة القديمة لكن مع غرب جديد هو المدارس النقدية للحداثة، مما يجعل هذا الخطاب خطابًا محددًا بالغرب وفقًا لمبروك، وربما لو قُدِّر للمسيري صاحب مفهوم (الخطاب الإسلامي الجديد) أن يكتب عن (التأسيس الثاني للنهضة) الذي اعتبره مبروك منعطفًا في تاريخ الفكر الحداثي، لربما اعتبر كذلك أن العلاقة بالغرب لم تتغير في عمقها في هذا التأسيس الثاني، فلا يزال الغرب أصلًا وأفقًا لهذا الفكر، والفارق هو في البحث عن أفضل الطرق لضمان احتذائه بعد فشل الطريق السياسوي ومجمل العيوب التي تبلورت في خطابه والتي تُعطِّل الخطاب العربي عن إنجاز التحديث، فهو ليس تأسيسًا ثانيًا ربما بل إعادة وتعميق لنفس التأسيس الأول انطلاقًا من تصور خاص عن نشأة الحداثة الغربية كنشأة فكرية ثم سياسية! انظر: لعبة الحداثة بين الجنرال والباشا، عليّ مبروك، دار رؤية، القاهرة، ط1، 2006، ص402.
[6] إصلاح الفكر الإسلامي؛ مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر، طه جابر العلواني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط5، 2009، ص34.
[7] إصلاح الفكر الإسلامي؛ مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر، طه جابر العلواني، ص99.
[8] إصلاح الفكر الإسلامي؛ مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر، طه جابر العلواني، ص68.
[9] إصلاح الفكر الإسلامي؛ مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر، طه العلواني، ص64.
[10] معالم في المنهج القرآني، طه جابر العلواني، دار السلام، القاهرة، ط1، 2009، ص77.
[11] أزمة العقل المسلم، عبد الحميد أبو سليمان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط1، 1991، ص68.
[12] صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية، إسماعيل الفاروقي المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ط1، 1989، ص14.
[13] يرى الفاروقي في صفحات مهمة من مؤلَّفه (أطلس الحضارة الإسلامية)، أن جوهر الحضارة الإسلامية هو التوحيد وأن هذا الجوهر له بعدان: منهج ومحتوى، ويحاول الفاروقي بيان عناصر البعد المنهجي للتوحيد، وهي الوحدة والعقلانية والتسامح كمبادئ معرفية، ويرى أن العقلانية مبدأ إسلامي منهجي أساس يظهر في رفض الإسلام لما لا يتطابق مع الواقع والذي يحمي المسلم من الظن وادعاء المعرفة، ورفضه للتناقضات المطلقة والذي يحمي المسلم من التناقض البسيط والظاهري، والثالث انفتاحه على الأدلة الجديدة أو المناقضة والذي يحمي المسلم من الجمود والتعصب، ونحن نظن أن هذه الصفحات من كتاب الفاروقي هذا بالإضافة لحديثه عن وحدة المنهج في كتابه: (صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية) يمكن النظر لها كتأويل إبستمولوجي للإسلام يُعدّ هو الأساس الأعمق للرؤية المنهجية للنصّ القرآني، وإن كنّا نظن اشتغال الفاروقي يظلّ أوسع وأشمل من اشتغال زملائه من رواد نفس المشروع انطلاقًا من كونه عالم أديان بارزًا يُوظِّف منهجًا ظاهراتيًّا في مقاربة الإسلام، وهذا يفتح له كثيرًا من الآفاق التي ربما لا تظهر لغيره، وسيتضح هذا بصورة أكبر في المقالات القادمة. انظر: أطلس الحضارة الإسلامية، إسماعيل راجي الفاروقي، لويس لمياء الفاروقي، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1998، من ص134 إلى ص138.
[14] ترتبط مفاهيم (الأمّة) و(الشهادة) و(الوسطية) و(الإخراج) ببعضها عند رواد هذه القراءة؛ فأمّة الإسلام هي الأمة المُخرجَة التي تشهد على بقية الأمم من موقعها كأمّة وسط تنطلق من المنهج القرآني الحاكم. انظر: إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ أسلمة المعرفة والمنهج، محمد أبو القاسم حاج حمد، دار الهادي، ط1، 2004، ص318، 319، وانظر كذلك محاولة الدكتورة منى أبو الفضل تأسيس مفهوم الأمة وعلاقته ببقية هذه المفاهيم في كتابها المهم والذي أصبح من الكتب الكلاسيكية في سياق هذا التيار، كتاب: (الأمة القطب؛ نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمّة في الإسلام)، منى أبو الفضل، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط1، 2005.
[15] إصلاح الفكر الإسلامي، طه العلواني، ص34.
[16] انظر: القراءات الحداثية للقرآن (3)، القراءة الحداثية عند نصر حامد أبو زيد، ثانيًا: تأسيس التاريخية، طارق حجي، موقع تفسير.
[17] إبستمولوجية المعرفة الكونية؛ إسلامية المعرفة والمنهج، محمد أبو القاسم حاج حمد، دار الهادي، ط1، 2004، ص229.
[18] كما سنوضح في مقالاتنا القادمة عن طه العلواني وأبي القاسم حاج حمد، فإن هذه المفاهيم المتقابلة كانت محور اشتغال ومحاولة تحرير من داخل القرآن عبر قراءة في مفاهيم (النسخ) و(الحرام) و(المبارك) و(الأمّة) وعبر قراءة للقصص القرآني عن الأنبياء الثلاثة؛ إبراهيم وموسى ومحمد -عليهم السلام-، في محاولة لتأسيس هذا التقابل وتبريره.
[19] صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية، إسماعيل الفاروقي، ص20.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

طارق محمد حجي
باحث مصري له عدد من المقالات البحثية والأعمال المنشورة في مجال الدراسات القرآنية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))