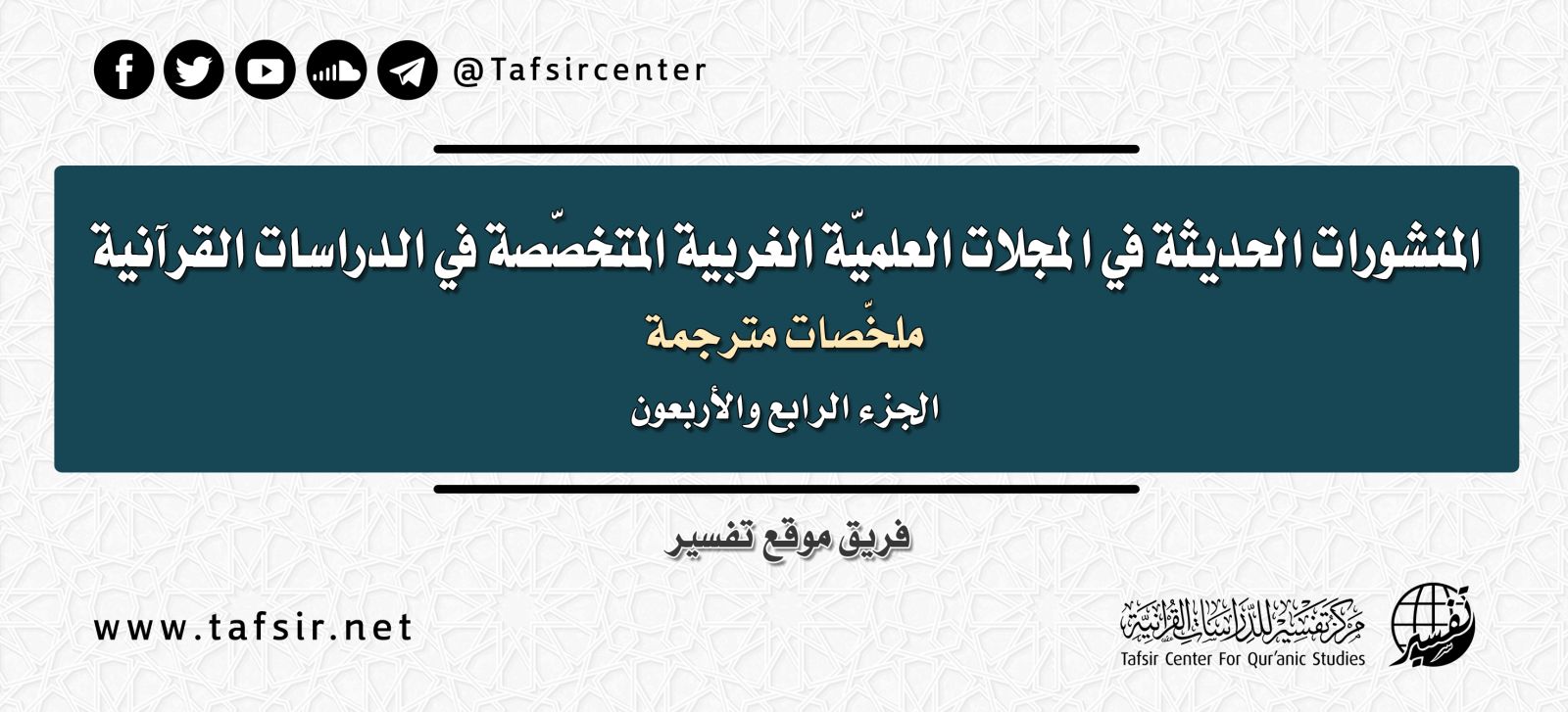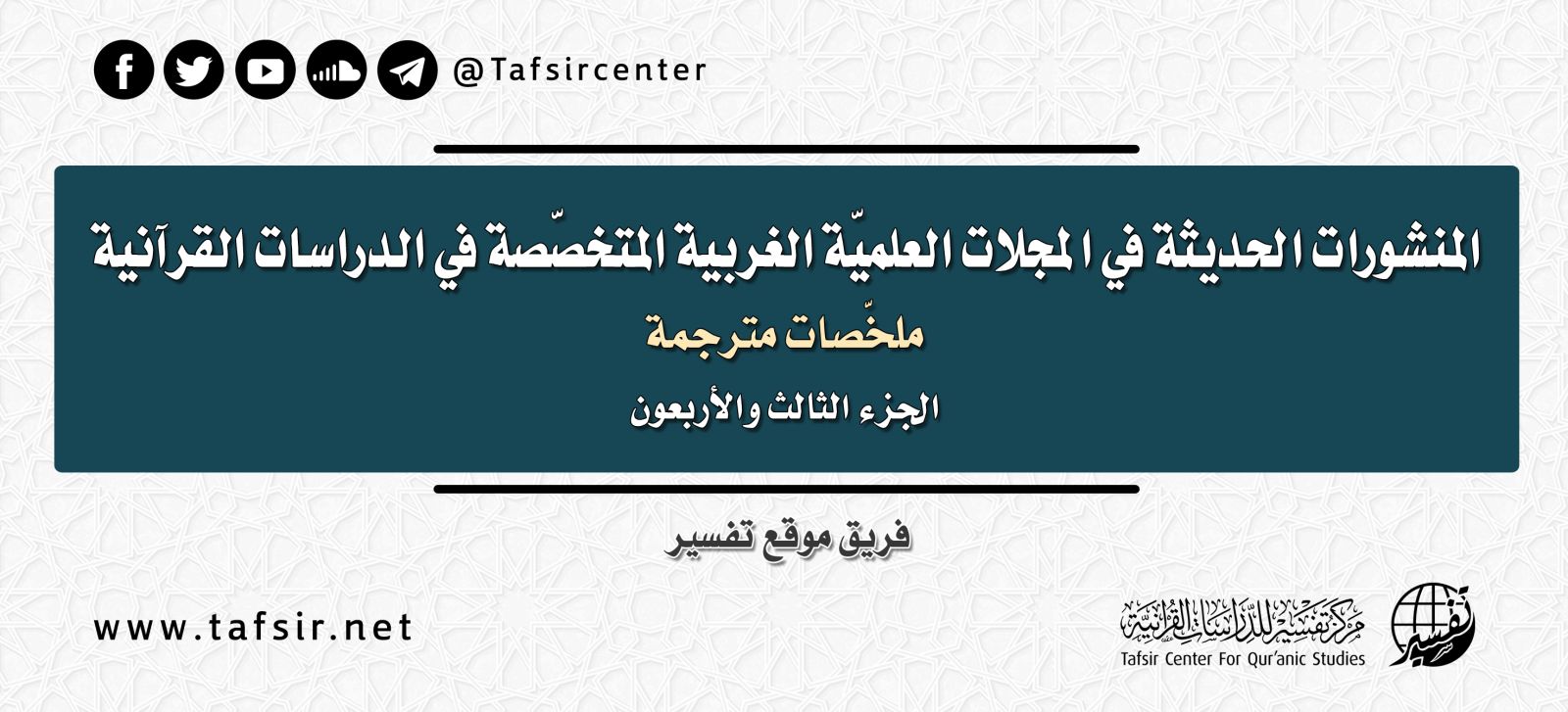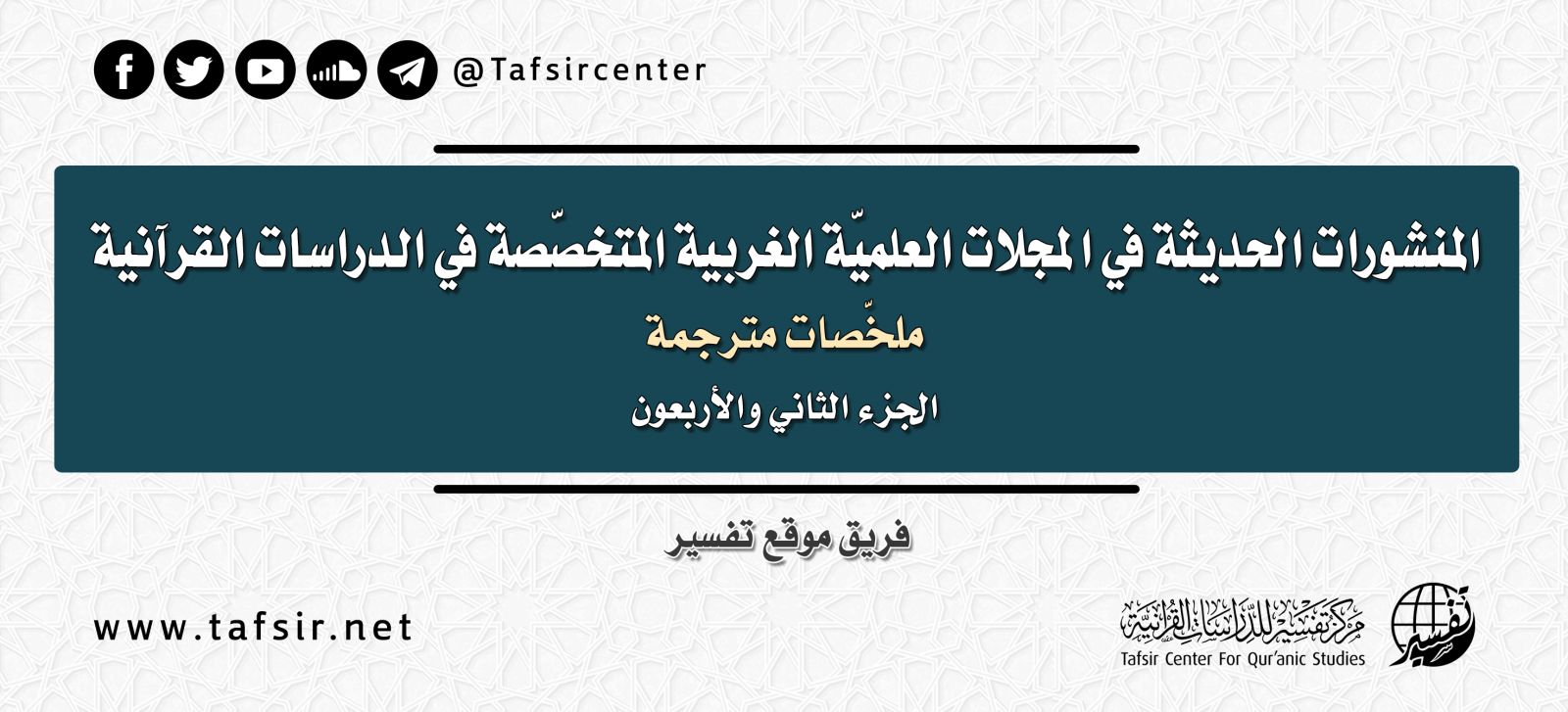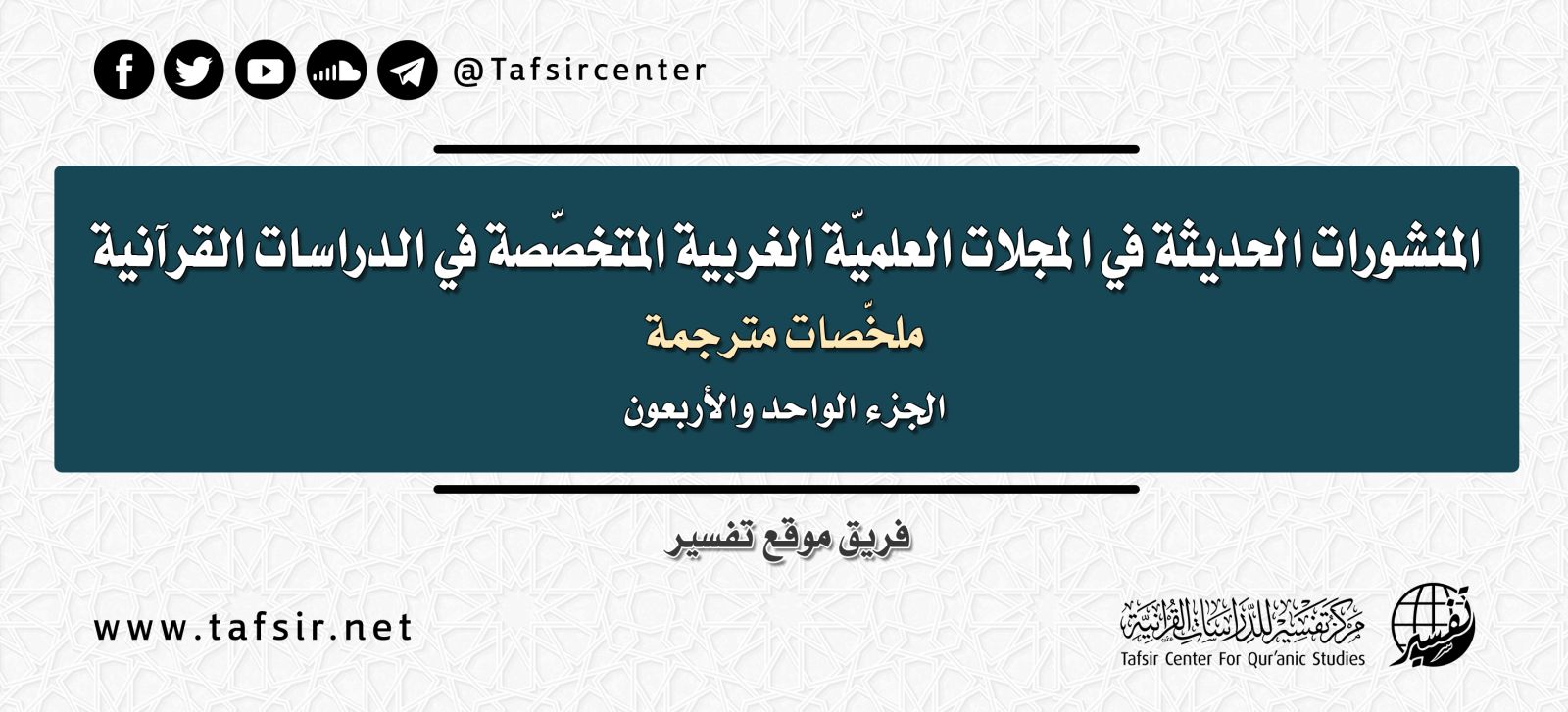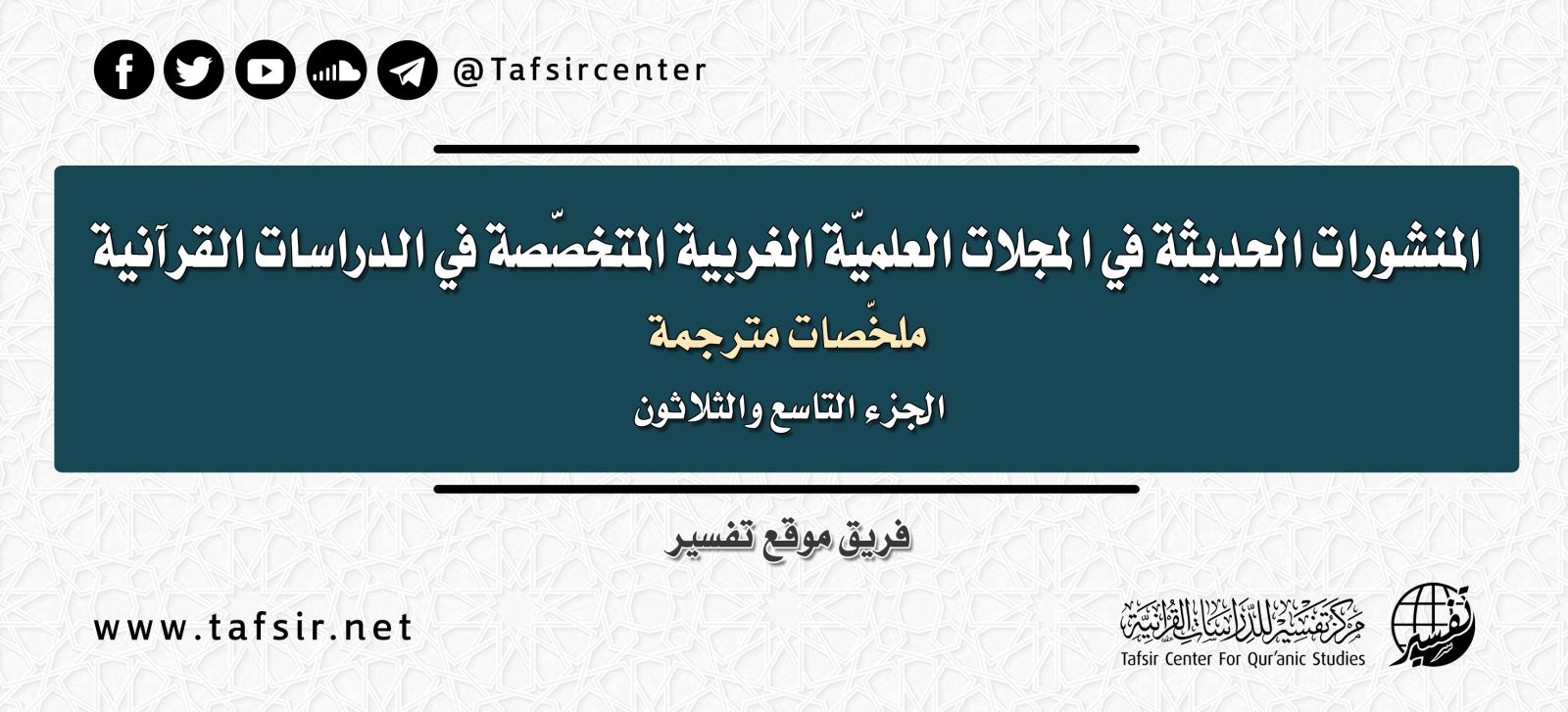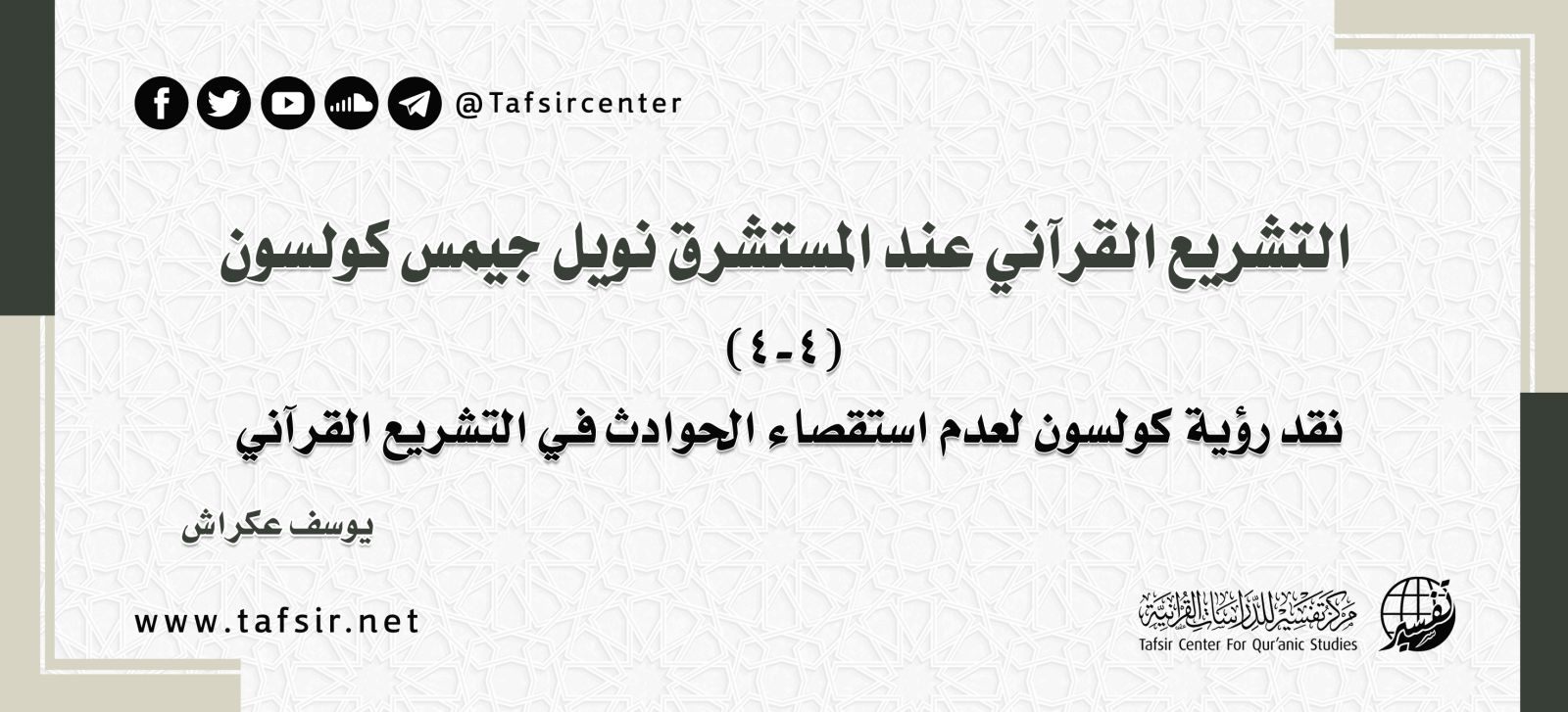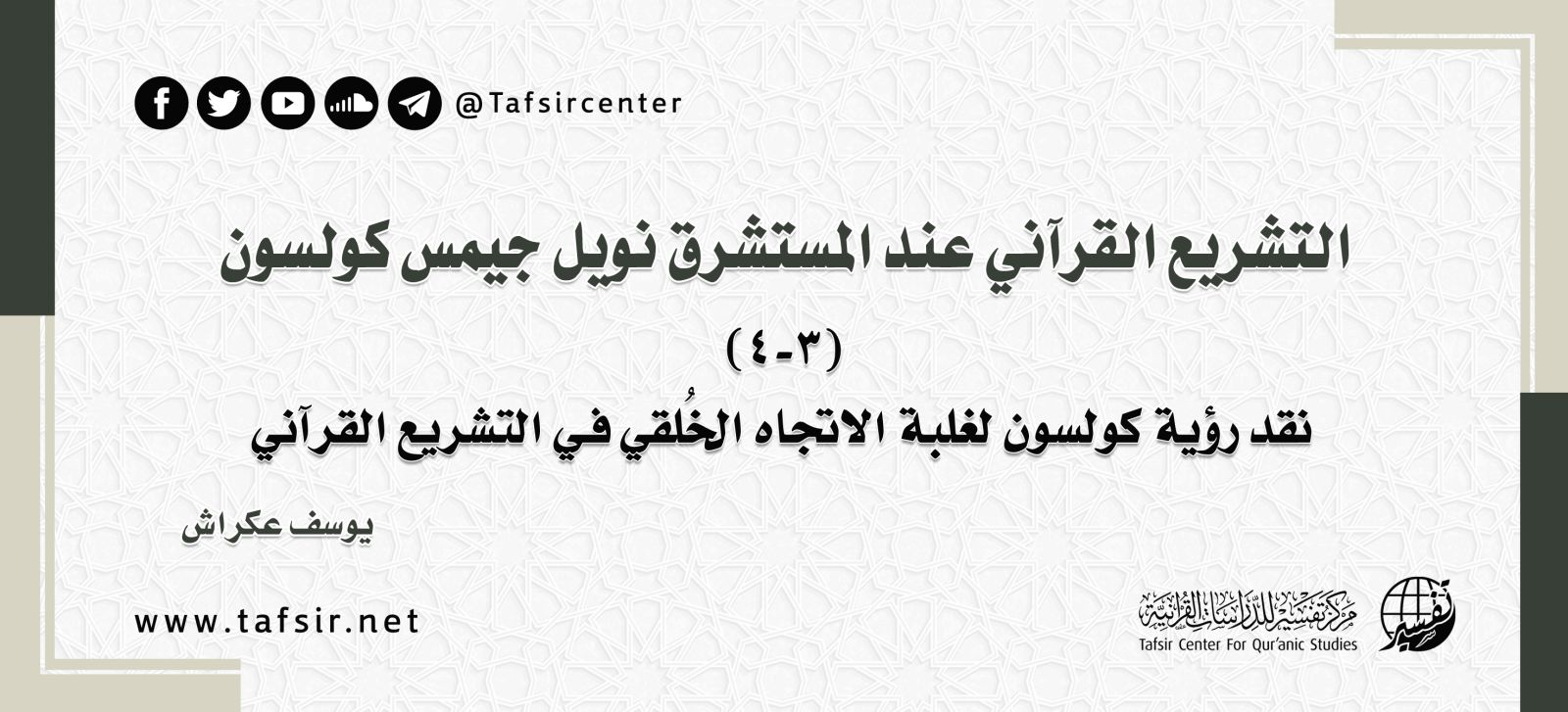التشابه بين القصص القرآني والكتابي في الدراسات التراثية
التشابه بين القصص القرآني والكتابي في الدراسات التراثية
الكاتب: محمد عبيدة
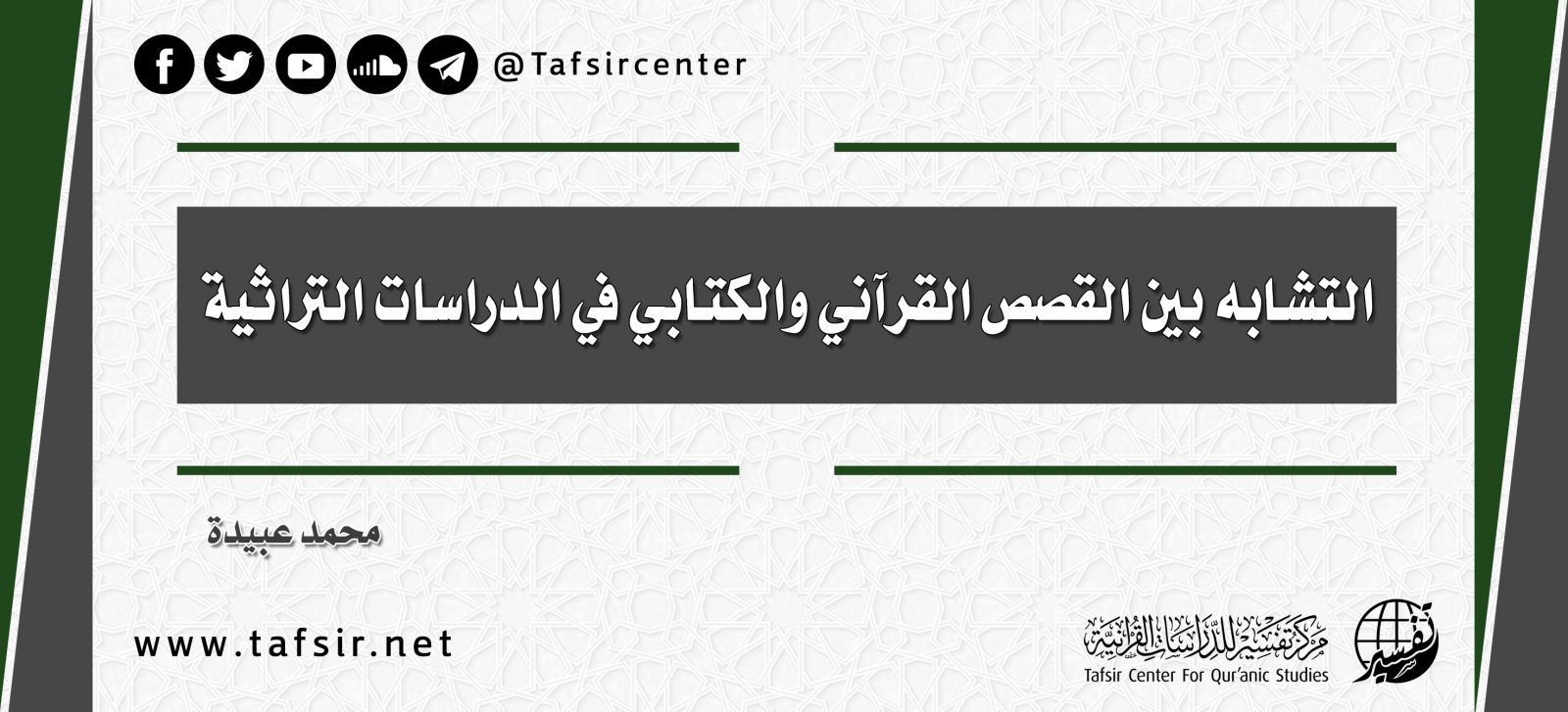
تمهيد:
غالبًا ما تتمّ قراءة التراث الإسلامي بمنظورِ المناهج الغربية الحديثة، بُغية تقديم تأويلات جديدة للتراث، أو إعادة إضاءة بعض زواياه، أو تطويرها؛ وأحيانًا يكون هدف القراءة إسقاطيًّا؛ إمّا بإسقاط نتائج الحاضر على الماضي وجعل التراث قائلًا بهذه النتائج، أو بتحميله همومًا معرفية لم يكن السياق المعرفي المتاح حينها يتيح إمكان الوصول إليها أصلًا. وغالبًا ما تتأسّس هذه القراءات على القول بحاجَة التراث إلى التجديد، بِحُكْم تراكم المعارف وتطوّرها. غير أنّ هذه المقالة تنحو منحًى مغايرًا؛ إِذْ تَزعم أنّ بالتراث إمكانات معرفية كبيرة، يمكنها أنْ تُغني الأنظار الحديثة، وتطوِّرها، بل وتجاوز مآزقها المعرفيّة أيضًا. وهنا، تقترح المقالةُ إقامةَ حوارٍ بين بعض مناهج البحث والنظر التاريخي في التراث، والمنهج البحثي الاستشراقي الحديث، بُغية الكشف عن الإمكانات المنهجية التراثية -خاصّة في البحث التاريخي- التي بمقدورها تجاوز مآزق البحث الاستشراقي المتأثّر بالمسلّمات الوضعيّة، وإبراز كيف أنّ في تراثنا المنهجي ما يمكن أن يُغني البحث الحديث ويمدّه بوسائل ومفاهيم تسدّ هذه الثغرات.
وتسعى المقالةُ إلى الإجابة عن الإشكال الآتي: ما المسلّمات الفلسفية التي تستضمرُها الكتابات الاستشراقية وهي تعمَد إلى تفسير بعضِ الظواهر في تراثنا الإسلامي؟ وكيف تمارِس هذه المسلّماتُ تأثيرَها في عمليات التأويل والتفسير وتوجيه الافتراضات؟ وإلى أيّ حَدّ يمكن اعتبارها قراءات علمية، خاصّة إذا علمنا أنه ما من ممارسة (علميّة) إلّا وتنطوي على مسلّمات قبلية غير قابلة للبرهنة؟
وتتّخذ المقالةُ من إشكال التطابق البيِّن بين القصص القرآني والقصص الكتابي نموذجًا تتجلّى فيه بعض المآزق المنهجية للبحث الاستشراقي؛ ذلك أنّ هذا التشابه دَفَع البحث الاستشراقي إلى طرح أسئلة تتعلّق بالتناص والأخذ والاقتباس؛ إِذْ تم افتراض أخذ القرآن للقصص الكتابي وإعادة توظيفه على نحو يخدم الدعوة المحمدية.
والحقّ أنّ هذا الافتراض لا يتعلّق بالبحث التاريخي الصّرف، الذي ينظر في الوثائق التاريخية التي تثبت الأخذ والنقل، وما يتطلبه هذا من نصوص كتابية مترجمة إلى العربية حينها، ووفْرَتها بمكة، وحصول محمد -صلى الله عليه وسلم- عليها، أو إثبات أنّ محمدًا -عليه السلام- كان يُتقن لغات النصوص الكتابية، الأمر الذي مكّنه من الاطلاع عليها، بل يتأسّس هذا الافتراض أيضًا على فرضية بحثيّة وضعية، تلغي من اعتبارها التفسير الغيبي القائم على الوجود الإلهي وإمكان النبوّة. ويوجّه هذا الافتراض عملية البحث وقبول التفسيرات، فكلّ تفسير ذي مستند غيبي لعلاقة القرآن بالنصوص الكتابية يصبح مرفوضًا. وهذا ما يجعل السردية الإسلامية التقليدية مرفوضة في الاستشراق المعاصر، على أنّ هذه المسلّمة الوضعية الموجهة لعملية تفسير التشابه بالنقل والاقتباس ليست مسلّمة علمية تجريبية، بل هي مسلّمة فلسفية ميتافيزيقية، تتطلّب هي نفسها إثباتًا نظريًّا قبل تشغيلها، وبناء الفرضيات والاستدلالات عليها؛ غير أنّ هيمنة الاتجاه الوضعي وتفرّعاته جعلتها «غير مفكَّر فيها»، ومسلّمة ابتدائية لا تقبل الجدل، وكلّ خروج عنها خروج عن نهج العلم ونَسَقه لا يستحقّ الالتفات إليه.
على أنّ في تراثنا نقدًا لهذه المسلّمة، وتحررًا من أسرها، مما يجعل عمليات تفسير الظواهر أكثر تحرّرًا، وأبعد عن التحكّم والإبعاد القبلي للاحتمالات التفسيرية كما سنرى بإذن الله. ولا تكتفي المناهج التراثية بالتحرّر من هذه المسلّمة، بل إنها تتجاوزه إلى إبراز عجز العلم الوضعي عن تفسير هذه الظاهرة. لكن يجدر التنبيه إلى أن هذه المسألة -أعني أَخْذ القرآن الكريم من قصص أهل الكتاب- قد طُرحت قديمًا في سياق آخر مختلف عن السياق المعاصر؛ إِذْ برزت في البحوث العقدية والكلامية، كما طُرحت أيضًا في ظلّ السِّجال الإسلامي المسيحي. وهنا تأتي أهمية تسليط الضوء على النقاشات الإسلامية حولها، لبيان طبيعة الحجج التي تقدّمها السردية الإسلامية، وللكشف عن أُسسها العقلية والتاريخية، والإفادة منها في مناقشة الكتابات الاستشراقية وتقويمها ونقدها. ويهمّنا في هذا السياق ما كتبه علماءُ التفسير والقرآن والمتكلّمون حول علاقة القرآن بالنصوص الكتابية، وكيف أبرزُوا استحالة تفسير التشابه بين القرآن وتلك النصوص بالنقل والأخذ، وكيف استدلّوا على كون القرآن وحيًا، انطلاقًا من تأصيلهم للمعرفة، ومن بحثهم في شروط المعرفة التاريخية.
أولًا: قصور المعالجة الاستشراقية لمسألة الاقتباس والأَخْذ:
تعاني المعالجة الاستشراقية -من عدّة أوجه- من القصور في مقاربتها لمسألة التشابه بين القصص القرآني والقصص الكتابي. وتعود أهم أوجه القصور إلى:
أ- الانطلاق من التصوّر الوضعي للعلم:
يحدّد الإطار الوضعي التفسيرات الممكنة للظواهر، من خلال كونها تفسيرات (طبيعية)، تختزل الظواهر إلى العوامل والمسببات الماديّة -بالمعنى الفيزيائي أو الطبيعي للمادة-. وضمن هذا الإطار يتم النظر إلى النبوّة باعتبارها ظاهرة لا تخرج عن هذا الإطار. وفيما يتعلّق بمسألة التشابه بين القصص القرآني والكتابي، فإنّ التفسير الوحيد المقبول هو القول بفرضية النقل والاقتباس، ويتم ابتداءً استبعاد إمكان الوحي، لكونه -حسب الإطار الوضعي- تفسيرًا غيبيًّا وأسطوريًّا لا يخضع لمقتضيات العلم.
على أنّ هذا الإطار الوضعي نفسه ينبني على افتراضات فلسفية غير مبرهنة تجريبيًّا -كما سنبيّن لاحقًا-؛ وهذه المسلّمات الفلسفية يعتريها القصور من جهة اختزالها الشديد للوجود ولمصادر المعرفة، ومن جهة جعلها عدم العلم دليلًا على العدم. وبالتالي، فإنّ نقد هذا الإطار الوضعي يستلزم إعادة النظر في استبعاد فرضية الوحي، وفي مدى كون الاقتباس والنقل هو التفسير الوحيد المقبول (علميًّا).
ب- الاكتفاء بالتشابه النصّي للحُكم بالاقتباس:
انطلاقًا من النموذج الذي حلّلناه في مقالة سابقة[1]، يمكنُنا استخلاص أنّ البحث الاستشراقي في نظره لمسألة اقتباس القرآن الكريم من القصص التوراتي يؤسّس نَظَرَه على مسألة التشابه في عناصر هذا القصص، ويركّز جهده على المقارنات، وعلى البحث في النصوص الكتابية، وعلى نُسَخها، والبحث في أعمار هذه النُّسَخ، ومدى كونها سابقة على القرآن، وكون هذه الأسبقية تُعَدّ دليلًا على أخذ اللاحق من السابق. وفي حال أعوزه البحث في هذه النصوص يلجأ إلى تعويض هذا الغياب بالافتراض؛ فيفترض وجود نسخ سابقة على القرآن، أو انتشار المعرفة الكتابية شفهيًّا في مجتمع الحجاز، أو وجود جماعات دينية من الـ(ممكن) أنها شكّلت مصادر للقرآن الكريم.
غير أن هذا النظر قاصرٌ من جهتين؛ فأولًا: لانبنائه على المسلّمات الوضعية المُشار إليها سابقًا، وبالتالي، اعتبار النقل والاقتباس التفسير الوحيد والممكن (علميًّا)، واستبعاد فرضية الوحي من التفكير ابتداءً. وهذا يؤدّي إلى التعسّف في التأويل، وملء الفراغ بالافتراضات. وثانيًا: من جهة تجاهله لبحث إمكان النقل نفسه؛ إِذْ قَبْل البحث في تجليات النقل وشواهده، لا بد من النظر في إمكان النقل والاقتباس وتحقّق شروطه في مجتمع مكة والمدينة. وهي المسألة التي تكاد تغيب في هذا البحث، أو يتم بناء (تاريخ بديل) منسجم مع هذا التفسير، من خلال التشكيك في المصادر الإسلامية باعتبارها مصادر مُنحازة لفرضية الوحي، مما يجعلها غير موثوقة.
ثانيًا: نقد المعالجة الاستشراقية في ضوء المعالجة الإسلامية التقليدية:
يمكن الاستفادة من المعالجة التراثية لإشكال التشابه بين القصص القرآني والقصص الكتابي في نقد التصوّر الاستشراقي. وقد عالج النُّظّار المسلمون قديمًا هذا الإشكال انطلاقًا من مستويين:
- المستوى النظري:
في هذا المستوى، كان البحث منصبًّا على إثبات وجود الله تعالى، ثم إثبات إمكان النبوّة، ثم البحث في شروط معرفة النبيّ وكونه صادقًا في ما يأتي به، ثم النظر في نبوة محمد -عليه السلام- وإثباتها. وهنا حين يثبت بالعقل كونه نبيًّا، يصير مصدَّقًا في دَعْواه أنّ القرآن كلام إلهيّ. وتَسقط دَعْوى النقل عن أهل الكتاب بالتّبع. وهذا الطريق يُعَدّ نقدًا غير مباشر لردّ دعوى الاقتباس.
- المستوى التاريخي:
وهو الطريق الذي يهدف إلى بيان استحالة الأخذ عن النصوص الكتابية؛ بالنظر إلى واقع الجزيرة العربية زمن البعثة، وغياب الترجمات، وأمّية محمد -عليه الصلاة والسلام-، واستحالة تعلُّم النبيّ من أهل الكتاب مع سكوت قريش وعدم افتضاح النبيّ أمام المؤمنين به، ويأتي هذا المستوى للحاجة إلى الردّ على الاعتراض الموجّه من قِبَل المشكِّكين، ويكون هدفه بيان استحالة النقل، وتبعًا لذلك يكون المصير ضروريًّا إلى تفسير التطابق بالوجود الإلهي الذي أَوحى بها إلى محمد -عليه السلام-.
ونحن في هذا المقام، يهمّنا التركيز على الطريق الثاني؛ لأهميته في السجال مع الموقف الاستشراقي المعاصر أولًا. وثانيًا، لكونه يُعين على إبراز عجز المنهج الوضعي وقُصُوره عن تفسير ظاهرة التشابه بين القرآن والكتاب المقدّس، وبالتالي، إعادة النظر في الموقف الوضعي عمومًا، وفي سلامة منطلقاته الفلسفية والمعرفية.
ولإبراز طبيعة هذه المعالجة، لا بد أولًا من بيان اختلاف الإطار المعرفي للمقاربتَيْن، ثم الخوض في تفاصيل المعالجة؛ انطلاقًا من جهود ابن تيمية الحرّاني، لخصائص ميّزت معالجته:
1. مفهوم العلم في السياق الإسلامي:
يختلف الإطار المعرفي التراثي عن الإطار المعرفي الاستشراقي في الأُسس التي تنهض عليها المعرفة الإنسانية عمومًا. فالمعرفة الإنسانية في الممارسة التراثية لا تنطلق من كون الواقع الفيزيائي هو الواقع النهائي والوحيد، بل ترى أنّ ثمة عوالم أخرى، غير أنها غيبيّة. والسبيل للوصول إلى هذه العوالم يتم من خلال الوحي، وأمّا العقل، فهو يدلّ على إمكان وجودها، وعدم استحالتها. وهذا الاختلاف في الإطاريْن المعرفيّيْن هو الذي يفسّر اختلافهما في النظر إلى إشكال علاقة القصص القرآني بالقصص الكتابي؛ فكلتا المعالجتين تقرّان بوجود التشابه -والتطابق أحيانًا- بين القَصَصَيْن، غير أنهما تختلفان في تفسير هذا التشابه. وهنا تتدخّل المرجعيات الفلسفية في التفسير؛ حيث تحرص كلّ معالجة على تقديم التفسيرات المنسجمة مع خلفياتها الفلسفية. وهنا تحديدًا، ينبغي التنبيه إلى مسألة دعوى علمية المقاربة الاستشراقية في مقابل غيبية أو أسطورية المقاربة التراثية؛ فحدود العلم تنتهي عند وصف الواقعة. وأمّا مسألة ضرورة أن يكون التفسير المقدّم (وضعيًّا) فليست مسألة علمية، بل فلسفية، خاضعة لافتراضات سابقة على الممارسة العلمية نفسها؛ فقبل الممارسة العلمية يسلِّم الوضعي بوجود الواقع المادي المستقِلّ عن الذّهن، ويسلِّم بقابليته للإدراك، وبكونه متّسقًا ومنسجمًا ومنظمًا وغيرها من الفرضيات التي لا يمكن قيام العلم التجريبي بدونها. يهمّنا هنا من بين المسلّمات الوضعية: مسألة كون الواقع المنظور أو المشهود هو الواقع النهائي، واستحالة وجود عوالم أخرى غيبية، انطلاقًا من مبدأ: كلّ ما لا يمكن البرهنة عليه تجريبيًّا فهو غير موجود. والحقّ أنّ هذه المسلّمة ليست (علميّة) بالمعنى التجريبي للكلمة؛ إِذْ لا يمكن اختبارها علميًّا، بل هي مسلّمة فلسفية، وليس عليها دليل يثبتها إلا بجعل عدم العلم دليلًا على العدم، ولا يخفى خطأ هذه المسلّمة فلسفيًّا؛ إِذْ كثير من الموجودات لم يكن العلم بها حاصلًا، ثم حصل العلم بها بعد ذلك، فلم يكن عدم العلم بها دليلًا على عدم وجودها. وفي الممارسة التراثية نجد مقولة تُبرز هذه القاعدة: فعدم الوجدان ليس دليلًا على عدم الوجود. وبصيغة أخرى: عدم العلم لا يعني العلم بالعدم. وبالتأسيس على هذا المبدأ، أَمْكَنَنا نقد الردّ الوضعي للتفسير التراثي، بعد أن بينّا أنّ التفسير الغيبي ممكن، وأن ليس هناك ما يمنعه لدى الوضعيّين.
على أنّ هناك طريقًا آخر في الممارسة المعرفية التراثية يفيد في نقد الإطار المعرفي الوضعي، وهو بيان استحالة التفسير الوضعي، فلم يبقَ إلا التفسير الغيبي -وهو الإقرار بكون القرآن وحيًا-. ويقوم هذا البيان على إظهار أنّ القرآن يستحيل أن يكون بشريًّا؛ نظرًا لفائقيته، ولسموّه عن القدرات البشرية. وفي ما يتعلق بهذا المستوى، نجد العلماء في التراث يعتمدون على البحث التاريخي، وعلى القوانين التاريخية التي يسمّونها (العادة) لنفي إمكان النقل عن النصوص الكتابية. ويستند مفهوم العادة على ما اعتاده الناس في خبراتهم المعرفية من أفعال وسلوكيات.
2. إمكان الاقتباس في ضوء مفهوم العادة التاريخية:
لا شكّ أن النبوّة ظاهرة تاريخية؛ لكونها تعتمد أساسًا على (الأخبار) و(النقل) و(الصدق). وتزداد الروابط بين النبوّة والتاريخ بعد انقضاء عصر النبوّة، خاصّة وأن الأخبار تصبح عُرضة للأهواء، وتدخلها الزياداتُ والكذبُ والخطأُ. ومن ثمّ، تطلّب الأمر بحثًا في شروط صحة الأخبار، وتمييز صحيحها من سقيمها، والتأكّد من مصداقيتها.
وبالنظر في البحث التاريخي التراثي، ثمة مبدأ مهم جدًّا يحكم التعامل مع المرويات التاريخية، وهذا المبدأ يسبق عملية محاكمة المرويات المفردة والنظر في رواتها وصِدقهم. وهذا المبدأ يتعلّق بمدى إمكان الحدث قبل النظر في صِدْق نَقْله؛ فإذا كان الحَدَثُ المنقول مستحيلَ الوقوع أصلًا، كان هذا مغنيًا عن النظر في إسناده ورواته ونقَلَته. وهذا الإمكان أو الاستحالة راجع إلى معيار معرفي مهم، هو: العادة. فإنّ الخبرة الإنسانية -من خلال طول معايشتها للتاريخ وأحداثه- شكّلت مجموعة من الكليات أو الحقائق التي تمكّنها من التعامل مع الأخبار، وهذه الحقائق تستمد قوّتها من وقوعها المتكرّر إلى الحدّ الذي يجعلها معتادة للناس، وتصير بذلك قانونًا. ولا يمكن بحال القبول بأيّ رواية تخالف العادة إلا إذا بَلغَتْ حدّ التواتر الذي يحيل التكذيب، مع الإمكان العقلي لهذا الخرق -كما في حالة معجزات الأنبياء-؛ يقول ابن خلدون موضحًا هذا الأساس -وهو يسعى إلى حصر دوافع شيوع الكذب في التاريخ-:
«ومن الأسباب المقتضية له أيضًا وهي سابقة على جميع ما تقدّم: الجهل بطبائع الأحوال في العمران؛ فإنّ كلّ حادث من الحوادث -ذاتًا كان أو فعلًا- لا بدّ له من طبيعة تخصّه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله، فإذا كان السّامع عارفًا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها، أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصّدق من الكذب، وهذا أبلغ في التمحيص من كلّ وجه يعرض، وكثيرًا ما يعرض للسّامعين قبول الأخبار المستحيلة وينقلونها وتُؤْثَر عنهم...كما نقله المسعوديّ أيضًا في حديث مدينة النحاس وأنّها مدينة كلّ بنائها نحاس بصحراء سجلماسة، ظفر بها موسى بن نصير في غزوته إلى المغرب، وأنّها مغلقة الأبواب، وأنّ الصّاعد إليها من أسوارها إذا أشرف على الحائط صفّق ورمى بنفسه فلا يرجع آخر الدّهر، في حديث مستحيل عادة من خرافات القصّاص، وصحراء سجلماسة قد نفَضَها الرّكّاب والأدلّاء ولم يقفوا لهذه المدينة على خَبر، ثم إنّ هذه الأحوال التي ذكروا عنها كلّها مستحيل عادة، منافٍ للأمور الطبيعية في بناء المدن واختطاطها، وأنّ المعادن غاية الموجود منها أن يصرف في الآنية والخُرْثِيّ، وأمّا تشييد مدينة منها فكما تراه من الاستحالة والبُعْد، وأمثال ذلك كثيرة، وتمحيصه إنّما هو بمعرفة طبائع العمران، وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها، وهو سابق على التمحيص بتعديل الرُّواة، ولا يرجع إلى تعديل الرّواة حتى يُعلم أنّ ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع، وأمّا إذا كان مستحيلًا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح، ولقد عدّ أهلُ النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا يقبله العقل»[2].
في هذا النصّ المهم يحدّد ابن خلدون أساسَيْن للتعامل مع المرويات التاريخية للتحقّق من مصداقيتها وصحّتها التاريخية؛ فأولًا: لا بد من التحقّق من الإمكان العادي للحَدَث أو الواقعة التاريخية؛ وابن خلدون هنا ينطلق من مفهوم العادة، ويريد به القوانين والسّنن التي تنتظم وفقها الأشياء. وهي قوانين عادية وليست عقلية، والفرق بينهما أنّ العادة تقبل الخرق في حالة المعجزة، وأمّا الأحكام العقلية فلا تقبل الخرق مطلقًا. غير أنّ المعجزة لمّا كانت حدثًا (استثنائيًّا) لا يتكرّر ولا يحصل إلّا في ظروف خاصّة على يد أشخاص محدودين -الأنبياء-، فإنّ العادة تحتفظ بانتظامها واستقرارها واطّرادها. وعندئِذٍ، لا يمكن تصديق الأخبار والمرويات التي تزعم انخراق هذه القوانين. إِذْ كما يقول ابن خلدون أعلاه، فـ«الأحوال التي ذكروا عنها كلّها مستحيل عادة، منافٍ للأمور الطبيعية في بناء المدن واختطاطها، وأنّ المعادن غاية الموجود منها أن يصرف في الآنية والخُرْثيّ، وأمّا تشييد مدينة منها فكما تراه من الاستحالة والبُعْد، وأمثال ذلك كثيرة، وتمحيصه إنّما هو بمعرفة طبائع العمران». من هنا فالعلم بطبائع العمران وأحواله وقوانينه يشكّل معيارًا أساسيًّا للتأكّد من صِدْق الخبر أو استحالته.
ثم يأتي البحث في الرُّواة وصِدْق الناقلين بعد التأكّد -انطلاقًا من المعيار السابق- من إمكان وقوع الحدث، وعندها يُنظر في عدالة الناقِلين وصِدقهم ونزاهتهم.
وبناء على هذا البيان لمفهوم العادة، فما مدى إمكان فرضية النقل عن أهل الكتاب وفق معيار (العادات وأحوال العمران وطبائع الاجتماع البشري)؟
3. إمكان اقتباس القصص القرآني من النّصوص الكتابية:
إنّ الطريق الذي اعتمده علماء التراث يقطع النظر في مسألة النبوّة، ولا يجعلها مفتوحة أمام احتمالات الكشوف المستقبلية لعلم التاريخ، أو العثور على نصوص أو مخطوطات تعزّز من فرضية النقل؛ وذلك لأن هذا الطريق يلغي إمكان النقل أصلًا، فيصبح من العبث البحث عن شواهد تعزّزه، فقَبْل البحث عن شواهد النقل لا بد من بيان إمكانه أولًا. وهذا الإمكان لا نجد في البحث الاستشراقي تأسيسًا له، بل يتم مباشرة القفز إلى البحث عن شواهده. وهذه ثغرة مهمّة جدًّا تنبَّه إليها العلماءُ قديمًا؛ إِذْ سدّوا باب النظر في شواهد النقل انطلاقًا من بيان استحالة النقل في بيئة النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، منطلِقين من حقائق التاريخ الصّلبة، وهي العادات التي ترسّخت في الخبرة المعرفية البشرية خلال معايشتها الطويلة لأحوال العمران والاجتماع البشري. وهنا، يمكننا استحضار معالجة ابن تيمية للمسألة؛ إِذْ بناها وفق هذا المفهوم، حيث يستحضر شيخ الإسلام السياق التاريخي الذي بُعث فيه النبيّ -عليه الصلاة والسلام- وظهر فيه القرآن، لينظر في واقعية النقل عن أهل الكتاب وإمكانه. ومن خلال هذا السياق يحدّد ابن تيمية ثلاث فئات أساسية شكّلتْ مجتمع مكة والمدينة:
- فئة المؤمنين والمصدِّقين بالنبوّة.
- فئة أهل الكتاب الرافضين لها.
- فئة المشركين من أهل مكة.
وبتحليل دوافع هذه الفئات الثلاث يستخلص ابنُ تيمية استحالةَ النقل عن أهل الكتاب؛ لأنه بالقول بإمكانه فإنّنا سَنُجَابِهُ إشكالًا عويصًا: هو سلوك هذه الفئات سلوكًا مضادًّا لدوافعها، وهذا ما يستحيل حصوله من العقلاء والأسوياء.
وبالنظر إلى هذه الفئات، يمتنع -حسب ابن تيمية- أنْ يكون القرآن قد نَقل عن أهل الكتاب لجملة أمور؛ ففيما يتعلّق بالفئة الأولى، وهي الفئة المؤمنة، فمن المستحيل في العادة وطبائع البشر أن يؤمِن الجَمْع الكثير بصِدْق رجل يعلمون أنه كاذب وناقل، ثم يضحّوا بحياتهم وأُسَرِهم وأموالهم في سبيل تصديقه. ولا يمكن أن يقال: إنه نجح في خداعهم، وإخفاء أُميّته عنهم، وإخفاء لقاءاته ببعض أهل الكتاب للنقل عنهم، أو إخفاء النصوص التي اعتمدها في النقل، طِيلة سنوات نزول القرآن، دون أن يكشفه رجلٌ واحد. ومثل هذا لو حصل، فإنه لا شكّ سيشيع وينتشر بين الناس، ويظهر كَذِبه وزيفه. لكن هذا لم يحصل، فبطل احتمال النقل من هذا الوجه: «أنّ مثل هذا لو كان فلا بد أنْ يعرفه ولو خواصّ الناس، وكان في أصحابه الذين آمنوا به من يَعْرف ذلك، وكان ذلك يشيع ولو تواصوا بكتمانه، كما شاع ما كُتم من أمر الدول الباطنية، ولكان خواصّه في الباطن يعلمون كَذِبَه، وكان علمهم بذلك يناقض تصديقه في الباطن كما عُرف في مثل ذلك. فكيف، وكان أخصّ أصحابه وأعلمهم بحاله أعظمهم محبةً وموالاةً؟ بخلاف حال من يُبطن خلاف ما يُظهر، فإن خواصّ أصحابه لا يعظِّمونه في الباطن»[3].
فابن تيمية هنا يعطي أمثلةً من التاريخ عن أكثر الحركات تحرزًا في حفظ أسرارها، وهي الحركات الباطنية، ومع ذلك تشيع أخبارها بين الناس، ولا تَبْقَى سرية لمدة طويلة، وإذا صَعُب جدًّا كتمان السّر في هذه الحركات، فهو أشدّ صعوبةً واستحالةً في أمر النبوّة، لكون النبوّة ذات تكاليف على المؤمنين بها، إِذْ تُعِيد تشكيل حياتهم، وتدفعهم لتضحيات كثيرة، خاصّة في المجتمع المكّي، حيث فرض على المؤمنين الجُدُد الحصار، وهُدّدوا وانتُزِعت منهم أموالهم وهاجروا من ديارهم وفارَقوا أهاليهم، ومثل هذه التضحيات الشديدة يمتنع الإقدام عليها لأجل رجلٍ كاذب، مع غياب المقابِل، إِذْ هو رجل ضعيف ومنفرد عن قومه، والقوّة الفعلية في المجتمع تقف ضِدّ دعوته. وبالتالي، فإنّنا عند افتراض أن هؤلاء اطّلعوا على النقل وبقوا مؤمنين، فهذا يعني أنهم غير أسوياء أصلًا!
وأمّا بخصوص الفئة الثانية، وهي فئة أهل الكتاب، فإنه من الممتنع أيضًا في العادة وفي طبائع البشر أن ينقل النبيّ عن أهل الكتاب ثم يرميهم بالتحريف ويتّهمهم بالكُفر وخيانة الأمانة، دون أن يفضحُوه ويبرزوا كَذِبه أمام أتباعه؛ ولو فرضنا أنّ هذا حصل فعلًا، فمن المستحيل أنْ يظلّ المؤمنون الجُدد على إيمانهم، وهذا ما لم يحصل، فثبت أنهم لم يفعلوا. وإذا ثبت أنهم لم يَفْضحوه، فهذا يعني أنه لم يَنْقل عنهم؛ لأنّه من المستحيل أن لا يفعلوا وهم قادرون على تكذِيبه مع عداوتهم الشديدة له: «لو كانتْ هذه القصص المتنوّعة قد تعلّمها من أهل الكتاب مع عداوته لهم لكانوا يُخْبِرون بذلك، ويُظْهِرونه، ولو أَظْهروا ذلك لنُقل ذلك وعُرف، فإنّ هذا من الحوادث التي تتوفّر الهِمَم والدواعي على نقله»[4].
وأمّا بخصوص الفئة الثالثة، وهي فئة المشركين من أهل مكة، فإنه من الممتنع أيضًا أنْ يدّعي رجلٌ أنه أُميّ عقودًا من الزّمن، ويُخْفِي عنهم تعلُّمَه للّغات، وجمعه للمخطوطات والنصوص والكتب، ولقاءاته مع رجال الدّين من أهل الكتاب، ويتعلّم منهم، ثم مع ذلك لا يفضحون أمرَه ولا يكشفون خِداعه لهم. ومن المستحيل أيضًا أن يكون قد وُجِد فيهم من يَعْلَم هذه القصص وعلّمها للنبي -عليه الصلاة والسلام-؛ إِذْ لو وُجِد فيهم من يعلم هذه القصص والأخبار لانهدم مشروع الدعوة في حينه وبطل تصديق المنخدعِين به، وهذا ما لم يحصل: «أحدها: أنّ قومه المعادِين له، الذين هم من أحرص الناس على القَدْح في نبوّته، مع كمال عِلْمهم لو علموا أنه تعلّم ذلك من بشرٍ؛ لَطَعَنُوا عليه بذلك وأَظْهَرُوه، فإنهم مع علمهم بحالِه يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو كان، ومع حِرْصهم على القَدْح فيه، يمتنع أن لا يَقْدَحوا فيه، ويمتنع أن لا يظهر ذلك»[5]، «وقد عَلِمَ الناسُ بالتواتر أنّ المشرِكين من قريشٍ وغيرهم لم يكونوا يعرِفون هذه القصص، ولو قدر أنهم كانوا يعرفونها فهم أوّل من دعاهم إلى دينه فعادوه وكذّبوه، فلو كان فيهم من علمه، أو يعلم أنه تعلّم من غيره لأظهر ذلك»[6].
خاتمة:
إذن فبهذا التحليل التيمي للسياق المكي والمدني، والذي انطلقنا منه في هذه المقالة، يظهر أنه من المستحيل -بناءً على معرفتنا بالطبيعة البشرية وبسنن التاريخ- تفسير المطابقة بين قصص أهل الكتاب والقصص القرآني بفرضية النقل والأخذ والتناص. وهنا، يظهر أنّ المقاربة الإسلامية قويّة جدًّا في حُججها؛ نظرًا لكونها تبني موقفَها على أصول المعرفة التاريخية، وعلى السنن التاريخية، وطبيعة السلوك الإنساني المعتاد، وهي أمور راسخة في خبراتنا وتجاربنا الإنسانية. فهي قَبْل النظر في النصوص التي يُزعم أنها مصادر للقرآن، تَنْظُر أولًا في إمكان النقل نفسه. وإذا ثبت استحالة هذا الإمكان، فقد صارت المحاولات الباحثة عن هذه النصوص غير ذات جدوى؛ لأنّ قصارها إثبات التشابه أو التطابق بين القرآن والنصوص الكتابية، وهو ما يعتبر معزّزًا للرواية الإسلامية ولدعوى الوحي، لا نقضًا لها.
وبهذا الامتناع، لا يتبقّى من تفسيرٍ مقبولٍ سوى مسألة الوحي الإلهي. وتصير هذه الأخبار والقصص نفسها دليلًا على النبوّة.
[1] انظر: بحث: مَنْ هم أصحاب الأخدود؟ آيات سورة البروج في سياق الشرق الأدنى، لآدم سيلفرستاين، عرض وتقويم، منشور على موقع تفسير، يمكن مطالعته على هذا الرابط:tafsir.net/paper/16
وبحث: بعض المظاهر شبه الكتابية في قصة هاروت وماروت، لجون سي. ريفز، عرض وتقويم، يمكن مطالعته على هذا الرابط: tafsir.net/paper/14
[2] التاريخ، ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، (1/ 46- 48).
[3] الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تح: علي بن حسن وآخرون، دار العاصمة، السعودية، ط2، 1999، (5/ 326- 237).
[4] الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، (5/ 326).
[5] الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، (5/ 326).
[6] الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، (5/ 326).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد عبيدة
حاصل على ماجستير النص الأدبي وفنونه، وأستاذ اللغة العربية للتعليم الثانوي التأهيلي.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))