أهمية تحقيق التكامل المعرفي عند المفسِّر
في ظلّ المعرفة المعاصرة
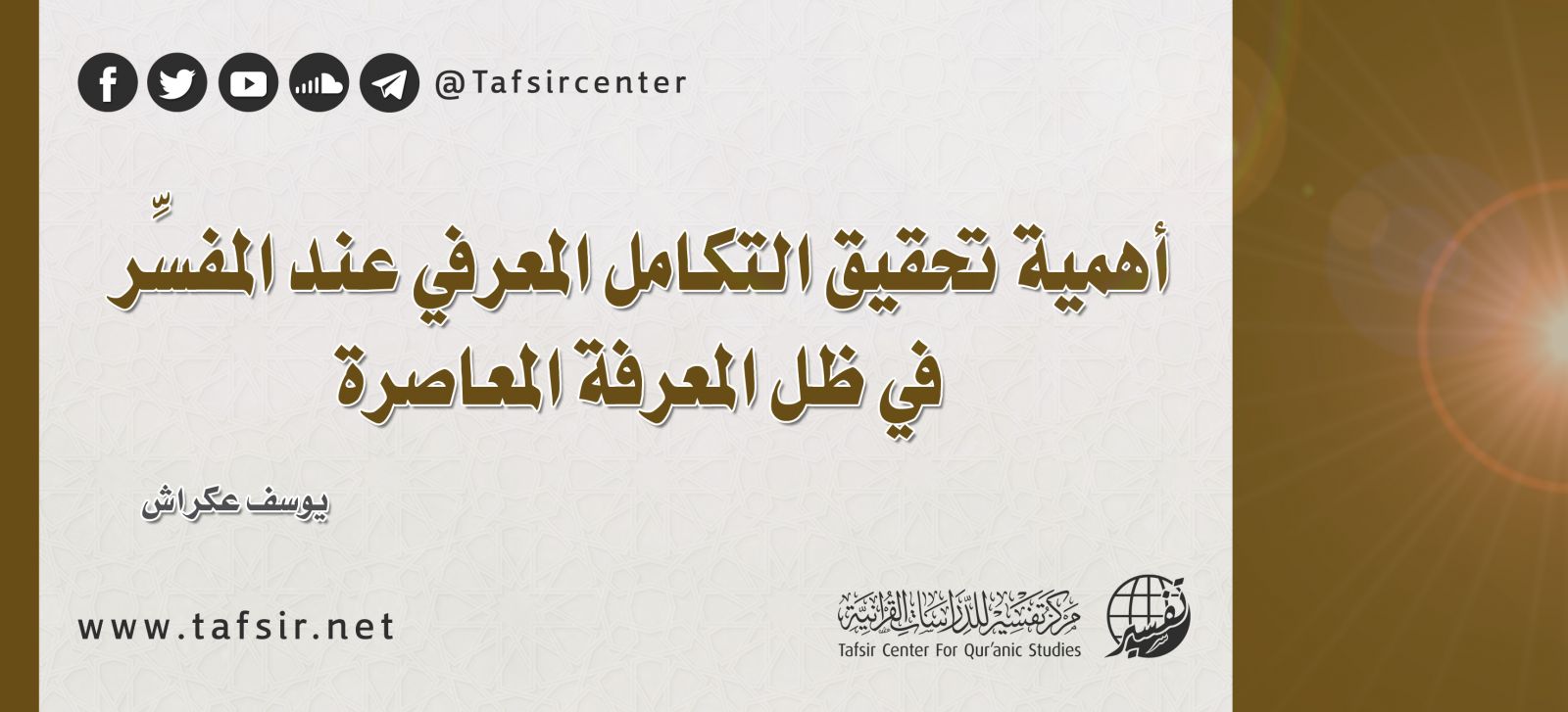
يُلْفِي الناظر في التراث التفسيري مدى جهود العلماء المبذولة في النهوض بهذا العلم، ويتجلّى ذلك في المصنَّفَات المتنوّعة والمختلفة في أغراضها، وأساليبها، واتجاهات مؤلِّفيها، وجزئياتها، وأحجامها. لكن رغم بذل ما في الوُسْع للارتقاء بعلم التفسير، إلا أنّ الحاجة له تزداد إلحاحًا عصرًا بَعْدَ عصرٍ، وخاصّة لِمَا يشهده الوقت الراهن من تفجّرٍ للمستجدّات على مستويات عِدّة، أهمّها الجانب المعرفي، ونخصُّ بالذِّكْرِ الحديثَ عن حركية المعرفة في اتجاه ما بعد التخصّصات، والتي تُحِيلنا على قضية التكامل المعرفي التي باتتْ تشغل حيزًا واسعًا في التداول العلمي المعاصر، وخاصّة أنّ الأمة الإسلامية تعيش واقعًا شبهَ حرجٍ أمام هذا الزّخَم المعرفي الهائل في مختلف الفنون والعلوم؛ الشيء الذي جعل بعضَهم يتجاسَر على العلوم الإسلامية وينعتها بالمحدودية أو الانعزالية والانطوائية، والمفسِّر ليس ببعيد عن دائرة هذا الطَّرْح؛ مما خلّف أثرًا سلبيًّا لدى العديد من المسلمين وجُلّ المهتمين، ومن هذا المنطلق تجَدَّدَتْ صحوة المعتنين بهذا الفنّ -علم التفسير- لتحقيق التكامل المعرفي أثناء تفسير الخطاب القرآني.
لكن ثمة إشارة مهمّة جدًّا وهي: أن الحديث عن تجسيد التكامل المعرفي في التفسير يُعَدّ نتيجةً للعُدّة التكاملية التي يمتلك ناصيتها المفسِّر؛ لذلك وجب الحديث ابتداءً عن التكامل المعرفي عند المفسِّر، أي: في آلياته وأدواته[1] التي يستعين بها في تفسير الخطاب القرآني دون تضييع أو تمييع. وهو ما تتوخَّى هذه الورقة بَسْطَه من خلال إشارات عامة نحسَبُها بَوْصَلة تدلّنا على أهمية تحقيق التكامل المعرفي في آليات وأدوات المفسِّر في المعرفة المعاصرة.
وتأسيسًا على هذا المفتتح تروم هذه الورقةُ الحديثَ عن مدى أهمية التكامل المعرفي في عُدّة المفسِّر من خلال منطلقات عامة؛ والتي من شأنها أن تكون مفتاحًا لإبراز هذه الأهمية في ظلّ الزخم الهائل من المعارف والعلوم الحديثة من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما طبيعة مفهوم التفسير المنتظَر من التكامل المعرفي في عُدّة المفسِّر؟ ما أهمية الوعي النظري بالتكامل المعرفي عند المفسِّر؟ وكيف يستفيد المفسِّر من علوم الإنسان وعلوم الطبيعة؟ وأين تتجلّى أهمية هذه الاستفادة؟ وما مدى أهمية إلمام المفسِّر بالواقع ومستجداته بغية تأسيس معرفته التكاملية؟ وما السبيل للمواءَمة بين علوم الإنسان وعلوم الطبيعة عند المفسر؟
أولًا: في مفهوم التفسير المنتظر من التكامل المعرفي في عُدّة المفسِّر:
لا شك أنّ مفهوم التفسير يكتنف في طيّاته اختلافًا واسعًا؛ جرّاء المحطات والمنعطفات والعوامل المتنوّعة التي شهدها في سيرورته بدءًا من نشأته إلى العصر الحالي، ومَنْ تتبّع الكتابات والمؤلَّفات التي عُنيتْ بتحرير مفهوم التفسير وقفَ على هذا الاختلافِ الواسعةِ دلالاتُه «بحيث يمتدّ من بيان المعنى إلى استخراج الأحكام والنظر في الحِكَم والمقاصد التشريعية وسرد اللطائف البيانية والإعرابية والنكات البلاغية وغيرها...»[2]، ولكن مَن تأمّل منشأ الاختلاف ألفاه يرجع بصورة كبرى إلى الضوابط والمعايير التي يسير عليها أرباب هذا الشأن لبلورة مفهوم التفسير الذي يقصدونه من كتاباتهم.
وإنّ هذا الاختلاف بين المعرِّفِين له تأثيرٌ بالغ على القضايا المطروحة على طاولة الدَّرْس التفسيري أو بالأحرى التي تتقاطع معه، ومن ذلك قضية التكامل المعرفي عند المفسّر الذي تسعى هذه المقالة لمناقشتها؛ إذ الحديثُ عن تكامل المعارف في العُدّة التي يحتاجها المفسِّر أمرٌ يرتبط بتحديد مفهوم التفسير المنتظر منه، ومَنْ أمعن النظر في ماهية التفسير وجدها تضيق وتتسع تبعًا للعلوم الموظَّفة في عملية التفسير، وعلى سبيل التمثيل: فإنّ التفسير اللغوي للقرآن: هو بيان الخطاب القرآني بما ثبت من لغة العرب، وإن كانت تتخلّل هذا النوعَ من التفسير وغيره أمورٌ أخرى من مصادر التفسير الرئيسة، إلا أنّ وسم نوع التفسير يرتبط بالغالب، وهو استعمال اللغة، وعليه فإنّ تعريف التفسير هنا قد ضاق كثيرًا؛ وهذا راجع لتضييق دائرة العلوم المستعملة في هذا التفسير، وهي الاقتصار على اللغة دون غيرها.
وما نحن بصدد مناقشته والوصول له من خلال بسط أهمية التكامل المعرفي في ذهنية المفسِّر؛ هو مفهوم التفسير الذي يتجاوز تبيُّنَ المعاني والكشفَ عنها ليغطي أيضًا استخراج الأحكام والحِكَم والمقاصد التشريعية...، وهو مفهوم يتّجه نحو الوجهة الموسّعة بالمقارنة مع تعريفات أخرى، ذلك أنّ مَرَدّ أمر اتساع هذا التعريف مبنيٌّ على اتساع رقعة العلوم والمعارف الموظَّفة بحيث تتجاوز لغة العرب إلى باقي العلوم الإسلامية لتغطي أيضًا الاستفادة من علوم الإنسان وعلوم الطبيعة.
ومما يزيدنا توضيحًا بأنّ التكامل المعرفي في عُدّة المفسِّر يُفْضِي بنا لمفهوم التفسير الموسّع؛ ذلك أنّ نمط هذا التفسير لا يستثني آيةً إلا ودرسها وكشفَ عنها وبَيَّن مراد الشارع منها، ووقف على ما حَوَتْه من حِكَم وأحكام بناءً على العلوم الكفيلة بتفسيرها، فلو وقفَ -افتراضًا- المفسّرُ اللغوي وغيرُه ممّن ينحو نحو تضييق معنى التفسير على الآياتِ التي بُثّتْ فيها مؤشّرات علمية بحتة دقيقة جدًّا لم يُتَوَصَّل إليها إلّا حديثًا، لا شَكّ أنه سيقف معها وقفة المستأنس ولا يمكنه الخوض في قضايا علمية دقيقة تتطلّب معارف أخرى كالحساب والفلك والطب وغيرها من العلوم الحقّة، وإنّ اكتساب هذه المعارف وتفسير هذه الآيات من خلالها يلزمنا بتوسيع دائرة تعريف التفسير للوقوف على الِحكَم والمقاصد الربانية وغيرها من الأمور التي تشكِّل مفهومًا موسّعًا للتفسير...
ومنه، فإنّ مفهوم التفسير المنتظَر من خلال تحقيق التكامل المعرفي في آليات المفسِّر، هو التفسير بمفهومه الواسع الذي يشمل بيانَ المعنى والكشفَ عنه، مع استخراج الأحكام والنظر في الحِكَم ومقاصد الشارع والوقوف على اللّطائف والنكت وغيرها، وهذا التعريف الموسّع للتفسير يفرض نفسه في الحديث عن قضية التكامل المعرفي لدى المفسِّر من خلال أمرين مهمّين:
أ. اتّساع رقعة العلوم والمعارف الموظَّفة في عملية التفسير، وقد سبق الإشارة -مع التمثيل بالتفسير اللغوي- أنّ مفهوم التفسير يضيق ويتّسع تبعًا للعلوم التي سيتم توظيفها، ومناقشة التكامل المعرفي في عُدّة المفسِّر هو حديث عن منظومة كبيرة من المعارف التي سيتمخض عنها حصادٌ تفسيري واسع المعنى، يلزم منه اتساع مفهوم التفسير ابتداءً.
ب. يرجع اتّساع المفهوم إلى طبيعة ما اكتنفته مواطن عديدة في النصّ القرآني التي تتحدّث عن مؤشّرات علمية بحتة دقيقة جدًّا، ومنه يتعيّن على المفَسِّر أن يكون على دراية بهذا الجانب من المسائل العلمية التي أثبتها العلم الحديث ولم تكن معروفة من قبل، فيسعى من خلالها إلى كشفِ الصِّلَة الوثيقة والعلاقة الناظمة بينها وبين مقاصد القرآن وغاياته في صورٍ تشقّ سبلًا جديدة لهداية الناس، وتَخَطِّي قضية الاستئناس في فهم ما ورد في القرآن حول الظواهر والاكتشافات، وهذا يقتضي اتجاهًا نحو الوجهة الموسّعة لمفهوم التفسير وعدم تضييقها ونحن بصدد الحديث عن قضية التكامل المعرفي لدى المفسِّر.
ثانيًا: الوعي النظري بالتكامل المعرفي عند المفسِّر:
لقد أصبحتْ قضية التكامل المعرفي ذات أولوية كبرى في التداول العلمي المعاصر، وخاصّة داخل أسوار المعرفة الإسلامية التي «كانت نموذجًا بارزًا لتداخل المعارف؛ فهي معرفة انبثقت أَوَّلَ أَمْرِها من نصٍّ مؤسِّسٍ وهو القرآن الكريم»[3]، وهذا يستوجب على المفسِّر أن يكون على دراية برؤية تكامل العلوم في الخطاب القرآني فهي بمثابة مفاصل يشدّ بعضها بعضًا، وخاصّة أن الأنساق العلمية المتخصّصة والتقسيمات التي تخلّلت عِدّة مجالات صارت تعاني من أزمة امتداد؛ ضيّقة المسالك مغلقة الأُفُق، مما نتج عنه الدعوة مجددًا لإحياء الاهتمام بالتكامل والتداخل المعرفي في شتى ميادين المشهد العلمي الراهن. وعلم التفسير ليس ببعيد عنها، وهذا ما نودّ الإشارة إليه في جانب اشتغال المفسِّر على النصّ القرآني دون أدنى قطيعة أو حواجز بين مختلف المعارف والعلوم.
وفي المقابل فإنّ المتأمّل في التفاسير التراثية من حيث الإجمال ألفاها تأثّرَت بميول أصحابها وتشرّبَت من تخصصاتهم العلمية، حتى صرنا نسمع عن تنوّع التفاسير وتصنيفها لأسبابٍ عِدّة قد تكون علمية أو أخرى فكرية ومذهبية، «فلو أخذنا على سبيل المثال: تفسير أبي حيان الأندلسي وتفسير القرطبي؛ فإنّنا نجد التفسير الأول قد برزت فيه العناية الفائقة لدراسة الآيات القرآنية من جهة لغوية أكثر من غيرها، وما هذا إلّا لأنّ أبا حيان الأندلسي كان ضليعًا في النحو واللغة. وإذا ما انتقلنا إلى تفسير القرطبي نجد الجهةَ الفقهية -أو قُل إنْ شئت- الاتجاهَ الفقهي قد بَرَزَ بُرُوزًا واضحًا في هذا التفسير، وما ذلك إلّا لأنّ القرطبي من كبار فقهاء المذهب المالكي، وهكذا...»[4]، وكذا شأن التفسير الفلسفي، وغيرها من التفاسير التي ملأتْ تراث المكتبة القرآنية واصطبغت بميولات مؤلِّفيها، ولا شَكّ أنّ هذا الضَّرْب من التفاسير لا تخفى أهميته المعرفية وخاصّة في جانب التأصيل وتكوين الملَكَات، لكن أحوج ما تكون له الأمة الآن إلى تحقيق التكامل المعرفي من خلال التفسير لتخرج من دائرة التقهقر الذي ينتابها إلى حيّز الريادة وتشييد صرحها الاستخلافي الذي كان لها. ولا يتأَتّى هذا إلا عن طريق الوعي الفكري بقضية التكامل وامتلاك عُدّة منهجية ومعرفية متكاملة يشدّ بعضها بعضًا لدى المفسِّر.
ولا ريب أنّ الوعي بالرؤية التكاملية لدى المفَسِّر سبيلٌ لتناص وتناظر عملية التفسير، وتجسيرٌ بين أركانها ومختلفِ العلوم التي بثّت مؤشّرَاتها المنهجية في النصّ القرآني مع انسجامٍ فائقِ العناية لمختلف مراحلها، بحيث تكون لها -عملية التفسير- ريادةٌ في استخلاص مضامينها، وخاصّةً المتصلة بالوقائع والنوازل المطروحة دون أدنى خصومة أو قطيعة مع المستجدات والمتغيرات.
كما أنّ هذه الرؤية تُسْهِمُ أيضًا في دَفْعِ كلّ الاعتراضات التي غرضها التشويش على المفسِّر وتعطيله. كما أنّ عدمَ وضع هذه الرؤية التكاملية نصب الأعين وتضييعَها أو تمييعَها من لدن المشتغلين بالدرس التفسيري، يشكّل صعوبات وعقبات وجيهة وحقيقية تَحُول بين التفسير ومخرجاته التي أبرزها الوصول إلى مراد النصّ القرآني في كلّ أبعاده.
ومنه، فإنّ إدراك الرؤية التكاملية والوعي بها من لدن المفسِّر تعدّ منطلقًا صِرفًا لتحقيق التكامل المعرفي المنشود، وخاصةً في الوقت المعاصر الذي يشهد انفجارًا في العلوم وصار الجميع ينادي بتجاوز القطيعة المعرفية جرّاء ما ينتج عنها من أزمات معرفية بين الفَينة والأخرى.
ثالثًا: الإحاطة بآليات من صميم علم التفسير:
لقد أجاد وأفاد علماء هذا الفنّ قاطبةً في بيان كلّ ما من شأنه أن ينضبط به كلُّ من تَصَدّى لبيان الخطاب القرآني العظيم حتى صارت رُكْنًا رَكِينًا لمن أراد أن يُؤخَذ عنه التفسير، وسنُورِدُ في هذا المقام أهم ما يمكن أن يحيط به المفَسِّر باقتضاب، والتي بسطها أهل الاختصاص في أكثر من موضع والتي لا يمكن إغفالها من لدن المفَسِّر، وهي كالآتي:
أ. الإحاطة بعلوم اللغة:
لا شَكّ أنّ القرآن أعظم وأقدس كتاب على الإطلاق، وقد حوى من العلوم والمعارف ما لا يعلمه إلا الله، فصار بما فيه بحرًا زخّارًا، لا يُدْرَك له قرار، فكان ولا يزال مفجّرَ العلوم ومنبعَها، ودائرة شمسها ومطلعها، ومن ذلك علم اللغة؛ إذ القرآن مرجع النحاة، ومصدر البلاغيين والأدباء؛ لذلك كان من أهم الضوابط الـمُسْهِمَة في تجديد التفسير -وخاصة على المستوى الأول الذي سبقت الإشارة إليه- الاعتناءُ الجادّ باللغة العربية وعلومها التي من شأنها أن تعيد الجدة والقوّة إلى علم التفسير على الوجه الذي كان عليه الجيل الأول، وقد مُزِجَ وجدانهم به، بحيث يصبح علم التفسير حِسًّا متذوَّقًا ذا أهمية عظمى في نفوس العلماء وكلّ الباحثين والمهتمين بالدرس التفسيري، ويُعطى حقّه من التنظير ومستحقه من التنزيل.
وقد ثبت بالتتبُّع أنّ من بين عوامل الميل التفسيري عن الصواب ومجانبته؛ عدمَ الإحاطة باللغة العربية ومسائلها؛ إِذْ لا بد في تفسيرِ الخطاب القرآني ومعرفةِ مراد الله =من اللغة وما انبثق منها من علوم؛ فهي مما يُعِين على أنْ نفقَه مرادَ الله بكلامه، وكذلك معرفة دلالات الألفاظ على المعاني؛ فإنّ عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب[5]، فالقرآن قويّ بعربيته ولا يقبل أن يُفْهَمَ إلا بالإحاطة بها؛ إذ «الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا تُفهم حقّ الفهم إلا من فهم اللغة العربية حقّ الفهم»[6]. ومنه، لا يخفى دور اللغة العربية وأهميتها في خوض غمار تفسير النصّ القرآني، فهي مُعِينة على الفهم، كما هي مُعِينة على الترجيح والاختيار، ولا يمكن أبدًا أن نوفي دور اللغة ومركزيتها في تفسير القرآن، ولو أُفردت الكتب والمجلدات في الحدِيث عنها، لكنْ حَسْبُنا من القِلادة ما أحاط بالعنق.
وتجدر الإشارة لمسألة مهمّة؛ فليس كلّ مَن درسَ اللغة العربية وتبحّر في آدابها أصولًا وفروعًا يُسمح له بتزكية نفسه بِوُلُوجِ ميدان بيان النصّ القرآني، وخاصّة ممن اشتغل واعتنى بما تمخض عن مناهج النقد الأدبي في السياق العلمي المعاصر؛ إِذْ هذه المناهج لا تبارك عملية تفسير النصّ القرآني وتُجِيزُها.
ب. الإحاطة بقواعد وأصول التفسير:
تُعَدّ اللغةُ العربية وقواعدُ التفسير وجهين لعملة واحدة، ولا غِنى لأحدهما عن الآخر؛ إِذْ أصول التفسير وقواعده هي أيضًا مِن أَوْلى ما يهتم به المفسِّر، ومن أهم ما يحرص عليه المشتغل بالدرس التفسيري، فهي جزء لا يتجزّأ من ماهية هذا العلم وجوهره، فلا يمكن الانكباب على التفسير تنظيرًا وتطبيقًا من دون الاستناد لها، فهي من بِنْيَةِ علم التفسير، وركنٌ ركينٌ من أركانه، كما لا يمكن بيان مسألة أو حُكْمٍ أو حِكْمَةٍ في القرآن بعد العدول عنها؛ وهذا ما دفع جهود العلماء لأنْ تُصْرَفَ نحو هذا الشقّ من التفسير، ومن ذلك ما أَوْرَدَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدّمته الشهيرة: «فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدّمة تتضمن قواعد كلية تعين على فَهم القرآن، ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز -في منقول ذلك ومعقوله- بين الحقّ وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأَقَاويل، فإنّ الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغثّ والسمين، والباطل الوضح والحق المبين»[7].
وليست أهمية قواعد التفسير محصورة في استجلاء معاني القرآن، بل تظهر مركزيّتها أيضًا في غربلة وتخلية ما سبق وكُتِب في دواوين التفسير من آراء منحرفة وأفكار هدّامة كالعقائد الفاسدة التي غزت عددًا مهمًّا من كتب التفسير.
كما يندرج هنا أيضًا شقّ الطريق لتوسيع مباحث القواعد والأصول والنظريات التفسيرية، إمّا عن طريق تعميقها أو تقويمها وتحريرها[8]، مع تحديد مواطن القوّة والضعف ومواطن النضج والقصور كَيْفًا وكمًّا ومنهجًا ومعرفةً، أو سلك مسالك لاجتراح وإخراج قواعد تفسيرية جديدة تستثمر كلّ الفرص والإمكانات المتاحة في المعرفة المعاصرة، بحيث تسدّ كلّ الثغرات والإشكالات المطروحة في الوسط العلمي، وتجدر الإشارة أن هذا الاجتراح لا يتم إلا عن طريق الإقدام وبقوة للاستفادة من مما كتب في هذا الفنّ، والإفادة من الآليات والمقاربات التي أبرزتها المعرفة الحديثة، من هنا تظهر أهمية قواعد وأصول التفسير التي لها طابع خاصّ في حركية تحقيق التكامل المعرفي لدى المفسِّر.
ج. معرفة مناهج المفسِّرين:
لا تكاد تنقضي الصعوبات والتحديات التي يواجهها المفسِّر المعاصر للإسهام في التكامل المعرفي داخل أسوار هذا الفنّ؛ إذ الأمر ليس بالسهل الهيّن، بل يحتاج لاستفراغ جهدٍ وبذلِ ما في الوسع، ومما يجب أن تشمله هذه الجهود هو إدراك مناهج المفسِّرين[9]، والتي هي: «الخطط العلمية الموضوعية المحددة التي التزم بها المفسِّرون في تفاسيرهم للقرآن الكريم، وهذه الخطط الموضوعية لها قواعد وأُسس منهجية مرسومة، ولها طرق وأساليب وتطبيقات ظهرت في تفاسيرهم»[10]. إذًا المنهج التفسيري هو مجموعة من الأساليب التي يسلكها ويتّبعها المفسِّرون لبيان مراد الله تعالى من آيات القرآن الكريم حسَب الطاقة البشرية[11].
ولا يتأتّى الوصول لهذه المناهج إلا من خلال مسلكين اثنين؛ الأول: هو تصريح من لدن المفسِّر في مقدمة تفسيره للمناهج التي سلكها، وهذا أيسر المسالك للوصول للمراد. أمّا الثاني: أن يكون المنهج مبثوثًا في ثنايا التفسير ولم يصرّح به المفَسِّر في مقدمته، وهنا يتكبّد الباحثُ المشتغِلُ بمناهج المفسرين عناءَ ومشقةَ الاستقراءِ التامِّ لهذه المناهج.
ولا شك أنّ بذْلَ هذا الجهد في معرفة مناهج المفسِّرين لا يذهبُ سُدًى، أو يُوصَفُ بأنه مادة تاريخية خالية الفائدة مما جعل بعضَ الدارسين يعدل عنها، والصواب؛ وإن كانت مادة تتعلّق بمدونات التفسير على مَرِّ العصور؛ إلا أنها ذات أهمية بالغة جدًّا، والتي تتمثل في تحقيق ورصد مجموعة من الأهداف، من أهمها: استشعار عظمة ما بذَلَ علماء هذا الفنّ من أجلِ استمرار حركيته، مع الكشف عن أساليب المفسِّرين وطرقهم التي سلكوها في أعمالهم التفسيرية، وإدراك مكامن التوافق والتباين بين المفسِّرين، وإبراز مواطن القصور ومكامن القوة، الممزوجة بالإسهام في تنقيح التفاسير مما دُسَّ فيها بقصدٍ أو بغير قصد.
وإنّ العلاقة بين معرفة مناهج التفسير وتحقيق التكامل المعرفي عند المفسِّر، هو أنّ إدراكَ الأساليبِ واختلافِ الطرق وتنوعِ الوسائل المعتمدة للكشف عن مراد الله =يجعلُ المفسِّر المجدِّد أمام خارطة تصوُّرية تنظيرية يلمح من خلالها مكامن الضعف فيسعى لتقويمها، ومواطن القوّة فيجتهد في تثمينها، كما أنّ معرفة مناهج المفسّرين تجعله مُبصِرًا مَنْفَذَ الفراغ المنهجي والفجوات البحثية الحاصلة على مستوى مدونات التفسير؛ ليشمِّر عن ساعد الجدّ للاشتغال عليها.
رابعًا: الاستفادة من المعارف الحديثة (علوم الإنسان وعلوم الطبيعة):
أ. الاستفادة من علوم الإنسان:
إنّ أمر استفادة المفسِّر من المعارف والعلوم الحديثة مُهِمّ للغاية؛ لما يثمر عن ذلك من الإسهام في بناء منهج متكاملٍ ومتداخلٍ لدى المفسِّر، وفي ذات السياق نودّ لفت الانتباه إلى تحقيق الاهتمام اللازم بهذه المسألة، المتجلية في استنطاق المناهج والعلوم الحديثة التي اشتدّ عُودُها في بيئات مختلفة، وخاصّة ما تمخض داخل أسوار العقل العربي. ومن هذه العلوم الحديثة التي نضجت آلياتها وبرزت مناهجها: العلوم الإنسانية[12] والاجتماعية[13]، فلماذا لا تُطرق هذه الأبواب ثم يتمّ سبر أغوارها والاغتراف من نظريتها والاستعانة بآلياتها وفق شروط وضوابط متينة[14]، ورؤيتها من زاويةِ مقاربتها المنهجية لتكون مطيةً لبناءِ مسالكَ وقنواتٍ متكاملةٍ لدراسة النصّ القرآني في ظلّ هذه المتغيرات والمستجدات اللامتناهية، مع ضرورة الانضباط وعدم التسيّب أو الانسياق وراءها.
وفي ضوء ما سبق فإننا نعتقد في النصّ القرآني؛ هو نصّ خاصّ له قدسيته، كما أنه نصّ مطلق ليس كباقي النصوص، فهو عابرٌ لأبعاد الزمان والمكان لا يخضع للأرخنة أو الأنسنة أو العقلنة كما يدّعي الحداثيون وبعضُ العلمانيين؛ إِذْ من خصائصه أنه مظنة للعديد من العلوم الحديثة، ومن ذلك على سبيل التمثيل وليس الحصر؛ علم الاجتماع[15] الذي يُعَدّ من أبرز العلوم المعاصرة بل صارت له ريادة في الساحة المعرفية، ومَن تأمل الخطاب القرآني في مقارنته بالقضايا التي يهتم بها هذا العلم، ألفى أن هناك حيزًا مهمًّا من النصّ القرآني يتقاطع مع هذا الفنّ -علم الاجتماع-، إمّا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ومن ذلك ما تشكّله مادة القصص القرآني بحيث بلغت رقعةً واسعةً بأنماطها وأساليبها العديدة، وخاصّة في القرآن المكي.
وإنّ دراسة القصة القرآنية كمثالٍ لمناهج وآليات هذا الفنّ ومقارباته دون المساس بأصول القصة القرآنية وخصائصها الشرعية، لا شَكّ سَيُسْهِم بشكلٍ كبيرٍ في استجلاء معاني جديدة لهذه القصص، واستعراض مواطن العظة المتضمنة فيها بمسالك ومرتكزات حديثة، والتي قد يصل ضوؤها لأماكن لم يصلها من قبل. وخصوصًا أنّ القصة القرآنية قد قدّمتْ أنواعًا من الأفراد والمجتمعات، وبيّنتْ أسباب انحطاطها وتقهقرها أو أسباب رِفعتها وريادتها الحضارية، كما بسطت طريق العِزّة وطريق المهانة، ومصير الظُّلْم ونور العدل... وغيرها من الأغراض التي وَفت القصة القرآنية في طرحها، وهي ذات صلة مباشرة بوقائع العصر التي عجزت أساليب الدعوة الحالية عن تقويمها أو تصحيح مسارها، في حين هي من صميم هذا العلم الحديث؛ فحبذا لو يُستنطق هذا العلم وغيره لشقّ طرق جديدة في الدعوة بعد استجلاء معانٍ ومضامينَ حديثةٍ، وخاصة أننا صرنا في مجتمعات لا تؤمن إلا بالعلم.
وهذا المثال الذي تقدَّم ما هو إلا غيض من فيض مما يزخر به النصّ القرآني؛ إِذْ إن البضاعة الاجتماعية غزيرة في القرآن وتحتاج لالتفاتةٍ واهتمام، ومن ذلك أيضًا النصوصُ الدالّة على الإيمان في اقترانه بالعمل فهي مادة مشبعة لدراسة الفكر العقدي في علاقته بالفعل وكيف يؤثر أحدهما على الآخر؟ وربطِهِ بسياق الظواهر الإلحادية التي باتت تغزو بلاد المسلمين من كلّ حدب وصوب، وكذلك النصوصُ الدّالة على التربية والأخلاق التي فُتحت بها بلدان عديدة في الجيل الأول، وأيضًا المعاملاتُ التي اعتراها تغيُّر لا نظير له من قبل... وغيرُها، فكلّ هذه المادة الاجتماعية قادرة على الوفاء بالمطلوب شريطة أن تحظى بالعناية اللازمة من لدن المشتغلين بعملية التفسير.
إنّنا إذا ما أمعنّا النظر واستنطقنا هذه المناهج والأساليب المتمخّضة عن العلوم الحديثة -الإنسانية والاجتماعية- مع أخذِ الحيطة والحذر حتى لا يصبحَ النصُّ القرآني أسيرَ هذه العلومِ، أو انسياق المعتني بالدرس القرآني خلف صروحها، لا ريب أنّنا سنكون أمام مادةٍ خام ومستودع متكامل الآليات والأساليب والطرق يسعفنا للجواب على عدة أسئلة شغلت الناس في واقعنا المعاصر، كما أنّ هذا الاهتمامَ بالعلوم الحديثة بُغية تحقيق التكامل المعرفي سيولّدُ لنا نوعًا جديدًا من الاشتغال في الدرس التفسيري بعدما تتمخّض اتجاهاتٌ غير مسبوقة في التفسير تخدم قضايا الأمة الراهنة في كلّ أبعادها.
ب. الاستفادة من علوم الكون:
إنّ المفسِّر اليوم قد يطالَبُ بمعرفة ما لم يُحِط به المفسِّرون من قبلُ لاعتبارات عِدّة، وبتعبير آخر «فالعربي في الماضي قد فهم القرآن ضمن خصائص تكوين الإنسان الموضوعية التي كانت بطبيعتها بسيطة بالمقارنة مع خصائص التكوين الراهن»[16]. ومنه، تبقَى الاستفادة من العلوم الطبيعية مسألة ضرورية لدى المفسِّر المعاصر، وخاصة العلوم التي بثّت معالمها في ثنايا الخطاب القرآني، وذلك من أجلِ البحث عن العلاقة الناظمة بينها وبين مقاصد القرآن وغاياته في صور تشقّ سبلًا جديدة لهداية الناس إلى خالقهم، كما تمكِّن هذه الاستفادة من العلوم الطبيعة من تخطِّي قضية الاستئناس في فهم ما ورد في القرآن حول الظواهر والاكتشافات الحديثة إلى الربط الوثيق بين هذا الشقّ المنبثق عن العلوم الطبيعية وبين مرامي الخطاب القرآني.
ومن جهة أخرى فإنّ الاستفادة من العلوم الطبيعة تمكِّن المفسِّر أيضًا من ردِّ المدّ الجائر الذي يزعم روّادُه أن هناك عداوة بين النصّ القرآني والعلم الحديث خاصّةً في شتى جوانبه؛ كالاكتشافات العلمية وغيرها، متناسِين أن من خصائص القرآن أنه تضمن مؤشرات منهجية علمية كونية للخليقة والتكوين، حين يتحدّث على سبيل المثال عن التخليق الكوني للإنسان والنفس فيما تعرض له سورة الشمس من متقابلات كونية متفاعلة...، بحيث يقدِّم معطيات علمية دقيقة في أسرار الكون ولطائفه التي تم اكتشافها حديثًا[17]... وغيرها من المواطن التي بيَّن فيها القرآن صِلته الوثيقة بالعلوم الحديثة -الطبيعية- عن طريق بثّ مؤشرات علمية بحتة دقيقة جدًّا لم يُتوصَّل لها إلّا حديثًا، ومنه يتعيّن على المفَسِّر أن يكون على دراية بهذا الجانب من المسائل العلمية التي أثبتها العلم الحديث ولم تكن معروفة في العصور الأولى، فيسعى من خلالها إلى كشف الصلة الوثيقة بين آيات القرآن والمكتشفات العلمية على وجه يتجلى منه بيان مصدرية القرآن، وأنه عابرٌ لحدود الزمان والمكان[18]، ومُخَاطِبٌ للإنسانية قاطبة، وأنْ لا عداوة أو خصومة البتة بين النصّ القرآني والعلوم الطبيعية بمجالاتها المختلفة.
خامسًا: الإلمام بالواقع ومستجدّاته:
يعدّ النظر في الواقع والإلمام بمستجدّاته من أبرز ما يحتاجه المفسِّر الذي يتوخّى تحقيق التكامل المعرفي في عملية التفسير، ذلك أنّ العلوم بنَت الأصول الفكرية من جهة وبنت الواقع من جهة أخرى، ولا شكّ أنّ الأمة شَهِدت في واقعها وما تزال تشهد نوازل جسيمة على عدّة مستويات، مما جعل المفَسِّر المعاصر أمام ضرورة ملحّة للمزاوجة بين مصالح العباد ونصوص الخطاب القرآني، ولا يتأتى هذا الأمر إلا بمعرفة واقع الأمة وتوقعاته، فَبِهِ يتمكّن المفَسِّر من إدراك مقدار التحديات الراهنة بكلّ أشكالها وألوانها وتأسيس المعارف التكاملية التي سعى لاكتسابها ويروم تنزيلها، ومما قيل في أهمية إدراك الواقع: «فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر؛ في أطوارهم وأدوارهم، ومناشِئ اختلاف أحوالهم، من قوّة وضعف، وعزّ وذلّ، وعلم وجهل، وإيمان وكفر، ومن العلم بأحوال العالم الكبير عُلويِّه وسُفليِّه... وأنَا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسِّر قوله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيئِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ}[البقرة: 213]، وهو لا يَعرفُ أحوال البشر!»[19].
إذًا فالنظر في واقع الناس وما يعتريه له فضلٌ على المفَسِّر في تكوين وتحقيق رؤية تكاملية أثناء ممارسة التفسير؛ إِذْ به -معرفة الواقع- تتحقّق الصلة الوثيقة بين الأصل -وهو القرآن- وبين الواقع المتغير أثناء ممارسة التفسير من خلال إنتاج معادلة قابلة لحلّ القضايا العالقة، ولا تَمسُّ بثوابت الدين ولا تغيِّرُها، كما لا تجعل المفَسِّر في خصومة بين تفسيره وتحوّلات الواقع، ومنه يكون المفَسِّر أقربَ لتحقيق المواءمة والتَّنَاص بين شمولية الخطاب القرآني وكُلِّيِّ الزمان الذي تتخلّله مستجدات لا متناهية على مستويات مادية وأبعاد معنوية؛ إذًا فالمفَسِّر في حاجة ماسّة بل ضرورة لا محيد عنها، وهي معرفةُ أحوال الناس والنَّظَرُ فيها وفي متغيراتها وضغوطاتها، حتى لا يظلّ البَوْنُ شاسعًا بين مخرجات عملية التفسير وبين واقع المسلمين.
وتجدر الإشارة في ختام هذه النقطة أنّ النظر في الواقع كما له أهميته بالنسبة للمفَسِّر له أيضًا خطورته التي تتربص بهِ بين الفَيْنَةِ والأخرى، والتي تتمثل في الانسياق وراء هذا الواقع وتضييع النصّ القرآني أو تمييعه، أو الخروجِ من دائرة الانضباط إلى حيز التسيّب، الشيء الذي يجعل الواقعَ هو منطلقَ الحكم وليس النصّ القرآني، والأصل المزاوجة بين التفسير الصحيح والإلمام الصريح لإنتاج مقاربة متكاملة الأركان تتناغم أسسها دون أدنى تنافر، وهذا هو الطريق السليم لعلاج المعضلات التي تعاني منها الأمة من خلال جعلِ الإلمامِ بالواقع ومستجداته جزءًا لا يتجزأ من المعرفة التكاملية التي يسعى المفسِّر لاكتسابها بغية فهم القرآن.
سادسًا: المواءمة بين علوم الإنسان وعلوم الطبيعة عند المفسِّر:
تُعتبر المقاصدُ الدينية هي أنجعَ سبيلٍ للمواءمة بين هذه العلوم عند تفسير النصّ القرآني بعد اكتساب عُدّةٍ تكاملية، ذلك أنّ للمجالات المعرفية الكبرى التي سبق الحديث عنها مقاصدَ عِدّةً تتنوع بتعدد اعتباراتها، وما يهمنا في هذا السياق هو الإشارة لأبرز المقاصد الدينية لهذه العلوم، فبالرغم من اختلاف مناهجها وأساليبها واتجاهاتها إلا أن الغاية الدينية تبقى واحدة، وهي التي يتوخى المفسِّر الوصول إليها بعد تحقيق مقدار الاستفادة المرجوة منها، كما أن المقاصد الدينية لهذه العلوم سبيلٌ ومعيار يسهم في ترشيد بعض المواطن في التفسير والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعلوم الإنسان والطبيعة.
وإنّ مواءمة المقاصد الدينية لهذه العلوم وتناغمها وشدّ بعضها بعضًا هو من أبرز مظاهر أهمية التكامل المعرفي عند المفسِّر وتجاوز القطيعة بين العلوم، سواء وظّفَ عُدّةً من صميم عُلومٍ إسلامية أو استعان بعلوم الإنسان أو بعلوم الطبيعة، ومنه فإن المقاصد الدينية الكبرى لبيان النصّ القرآني لا تتغير رغم اختلاف المعارف والعلوم، ومن أبرزها:
إبراز الغاية من نزول القرآن: فإذا توخّى المفسِّر بيان غايات الخطاب القرآني وتقريرها؛ فإنّنا نكون أمام تفسير سليم وقويم يؤتمن عليه في اختيارات الحياة ومستجداتها الراهنة رغم اختلاف المسالك التي سلكها للوصول إلى هذه الغايات، أمّا إن نَحَتْ عكس هذا المقصد -إبراز الغاية من نزول القرآن- بطريقة أو أخرى فإننا نكون أمام تفسير قد يكون سبب هلاكنا.
بيان أن القرآن كتاب هداية: فعلى المفسِّر أن يتوخَّى من تفسيره الناتج عن العُدّة التكاملية التي سعى لاكتسابها من مختلف المعارف والفنون =بيانَ أنّ القرآن كتابُ هداية جاء ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنه منهجُ صلاحهم وصلاح أحوالهم وسبيل خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأنه لا كتابَ يقوم مقامَه في هداية الناس.
بيان أن القرآن منهج حياة: وذلك من خلال إبراز تشريعاته التي تنتظم بها شؤون الحياة، وما يحتاجه الناس من أمور تتعلّق بدينهم ودنياهم من العبادات والمعاملات والأخلاق... إلخ، إذًا فإن تحقيق التكامل المعرفي عند المفسِّر يجب أن يقودنا نحو دستور الحياة المتكامل ألا وهو القرآن الكريم.
القرآن كفيل بحلّ النوازل والمستجدات: ويبرز المفسِّر ذلك من خلال الممارسة التفسيرية بعُدّته التكاملية التي يبين بواسطتها أن الخطاب القرآني بأصوله وفروعه كفيلٌ بإيجاد الحلول الفورية الناجعة لكلّ المعضلات التي تواجه المسلمين في كلّ عَصر ومِصر، وذلك بما تميز به من خصائصَ وقواعدَ ومقاصدَ مكّنته من الإحاطة والشمولية مع المرونة والقدرة على استيعاب مختلف القضايا المعاصرة، والمستجدة في واقع الحياة.
شقُّ سبلٍ جديدة لهداية الناس: وذلك بعد أن يُلمّ المفَسِّر بنصيبٍ من العلوم الحديثة -علوم الإنسان وعلوم الطبيعة- يسلك بها أثناء عملية التفسير مسالك جديدة في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الإسلام، بغية بيان أن القرآن من لدن خبير حكيم يخاطب البشرية قاطبة، وخاصة في زمنٍ أصبح الناس لا يؤمنون فيه إلا بالعلم والمعرفة. ومنه يكون إلمامُ المفسّر المعاصر بحظّ من العلوم والمعارف الحديثة مطيةً لتجسيد التكامل المعرفي الذي بدوره يسهم في بلورة سبل جديدة لهداية الناس.
الخاتمة:
وبعدما أشرفَتْ رحلتُنا البحثية اليسيرة والتي انعقدت حول مسألة موسومة بـ(أهمية تحقيق التكامل المعرفي عند المفسِّر في ظلّ المعرفة المعاصرة)، فقد أسفرت عن مجموعة من الإشارات، نُورد أهمها بتركيز في الآتي:
- ضرورةُ الوعي النظري بقضية التكامل المعرفي من لدن المفسِّر.
- الرؤيةُ التكاملية عند المفسِّر سبيلٌ لتناصِّ وتناظرِ عملية التفسير وتجسيرِ أركانها مع مختلف العلوم التي بثّت مؤشراتها المنهجية والمعرفية في النصّ القرآني.
- ضرورةُ استنطاق العلوم الحديثة -علوم الإنسان وعلوم الطبيعة- والاغتراف منها وَفق شروط وضوابط متينة لبناءِ مسالكَ وقنواتٍ تكامليةٍ تحقّق غاياتِ ومراميَ النصّ القرآني في ظلّ المعرفة المعاصرة.
- إدراكُ الواقع والإحاطة بمستجدّاته سبيلٌ لترتيب وتأسيس المعرفة التكاملية عند المفسِّر.
- ضرورةُ تناسُبِ وتناغُمِ المقاصد الدينية لعلوم الإنسان وعلوم الطبيعة.
[1] إنّ التكامل المعرفي في أدوات وآليات المفسِّر الذي تتوخّى هذه الورقة بيانه هو: تكامل المعرفة الحديثة المتمثّلة في علوم الإنسان وعلوم الطبيعة التي وَسَمْتُها في عنوان الورقة بالمعرفة المعاصرة، ولا أروم بيان التكامل بين العلوم الإسلامية في عُدّة المفسر؛ لأنّ هذا الأمر لا يختلف فيه اثنان، بل هو شرط من الشروط لولوج مضمار تفسير القرآن، ولا بأس بالتذكير به كما سيأتي.
[2] مقاربة في ضبط معاقد التفسير: محاولة لضبط مرتكزات الكلية للعلم ومعالجة بعض اشكالاته، خليل محمود اليماني، مقالة على موقع مركز تفسير على الرابط الآتي: tafsir.net/article/5299
[3] تداخل المعارف ونهاية التخصّص في الفكر الإسلامي العربي: دراسة في العلاقات بين العلوم، همام محمد، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت- لبنان، ط1، 2018م، ص156.
[4] التجديد في التفسير: مادة ومنهجًا، جمال أبو الحسن، ص9.
[5] مجموع الفتاوي، ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 1416هـ، (7/ 116)، بتصرف.
[6] الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ، (5/ 53).
[7] مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، اعتنى به: فواز أحمد زمرلي، دار ابن حزم، الطبعة الثانية، 1433هـ/ 2016م، ص15.
[8] ينظر: التأليف المعاصر في قواعد التفسير: دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية، مؤلَّف جماعي: محمد صالح محمد سليمان، خليل محمود اليماني، محمود حمد السيد، صادر عن مركز تفسير، وهو دراسة ذات أهمية خاصّة، لما تميزت به من تقويم منهجي لكتب القواعد في التفسير، تأريخًا، ووصفًا، وتحريرًا لمفاهيمها، مع إبراز إشكالاتها.
[9] تجدر الإشارة في هذا الطرح إلى ضرورة التفريق بين أمرين مهمّين لطالما وقع التساهل فيهما؛ الأول: مناهج المفسرين، والثاني: اهتمامات المفسرين؛ إِذْ مناهج المفسرين، وهي التي أشرت إليها في بداية هذا الحديث، وجماع القول فيها أنها الطريق والأسلوب الذي ينتهجه المفَسِّرُ في تفسيره، أمّا الاهتمامات فهي المباحث التي يُولِيها المفَسِّرُ اهتمامًا كبيرًا أكثر من غيرها مهما كان منهجه، كأن يصبّ اهتمامه على آيات الأحكام أو البناء القصصي، أو اللغوي والبلاغي للآيات المرادة بالتفسير، إذًا فالشق الثاني بعيد عن مناهج المفسرين.
[10] تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 1469هـ/ 2008م، ص16.
[11] مناهج المفسرين؛ القسم الأول: التفسير في عصر الصحابة، مصطفى مسلم، دار المسلم، الطبعة الأولى، 1415هـ، ص15.
[12] يقصد بالعلوم الإنسانية أنها: «الدراسات التي تستهدف الإحاطة المنهجية الوصفية والتفسيرية، بالظواهر الإنسانية...». مشكلة العلوم الإنسانية، يمني طريف خولي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ص12.
[13] العلوم الاجتماعية: هي العلوم التي تدرس الجنس البشري -أفرادًا ومجتمعات- إمّا على المستوى الأفقي؛ أي: على علاقة الأفراد بالمجتمعات، وإمّا العكس، أو على المستوى العمودي، أي علاقة الإنسام بالبيئة، وغالبًا ما يطلق هذا المفهوم المركّب ليُقصد به: علم الاجتماع، وعلم النفس، والفلسفة، والأنثروبولوجيا... إلخ.
[14] ويمكن في هذا الأمر التأصيل لشروط يجب توفّرها في المفَسِّر، وضوابط لتحصين المُفَسَّر، ونطرح هنا ضربًا وجيزًا ليكون مطية لاستجلاء عدد من الشروط والضوابط الأخرى. فمن الشروط الرئيسة التي يحتاجها المفَسِّر لاستنطاق آليات العلوم الحديثة، أولًا: الدراية بالعلوم والمعارف التي يودّ طرق أبوابها للاستعانة بها. ثانيًا: توفر المفَسِّر على دائمِ تحصُّنِه من الانجراف وراء أصول هذه الآليات. أمّا فيما يخصّ (ضوابط لتحصين المُفَسَّر)، فيمكن إجمالها في أمرين رئيسين؛ أولًا: عدم مخالفة أصول العقيدة وفروعها (كالإيمانيات والغيبيات... إلخ)، ثانيًا: عدم مخالفة ما صح من المأثور... وغيرها من الضوابط والشروط التي من شأنها أن ترسم معالم الطريق لكلّ من أراد استنطاق مناهج العلوم الحديثة.
[15] لقد حدّد (أوغست كونت) علم الاجتماع في القرن الماضي بكونه «دراسة علمية لتنظيم المجتمعات الإنسانية؛ وهو بذلك يمتاز -كغيره من العلوم- بمجالات خاصّة بالبحث والتقصي ووسائل التحليل، والمصطلحات». معجم مصطلحات علم الاجتماع، جيل فيريول، ترجمة وتقديم: أنسام محمد الأسعد، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، ص27. وعرف أيضًا بأنه: «مجموعة قواعد معرفية متنوعة ومتعددة... لكلّ منها حقائقها التي تستند إليها». علم الاجتماع؛ المفاهيم الأساسية، تحرير: جون سكوت، ترجمة: محمد عثمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى- بيروت، 2009. ص27 (بتصرف).
[16] إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم، طه جابر العلواني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1418هـ/ 1996م، ص22، بتصرف.
[17] أبستمولوجيا المعرفة الكونية، إسلامية المعرفة والمنهج، محمد أبو القاسم حاج حمد، دار الهادي، الطبعة الأولى، 1460هـ/ 2004م، ص88.
[18] اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد الرومي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1418هـ/ 1998م، (2/ 549)، بتصرف.
[19] تفسير القرآن الحكيم، المشتهر بتفسير المنار، السيد محمد رشيد رضا، دار المنار، الطبعة الثانية، 1366هـ- 1947م، (1/ 23).


