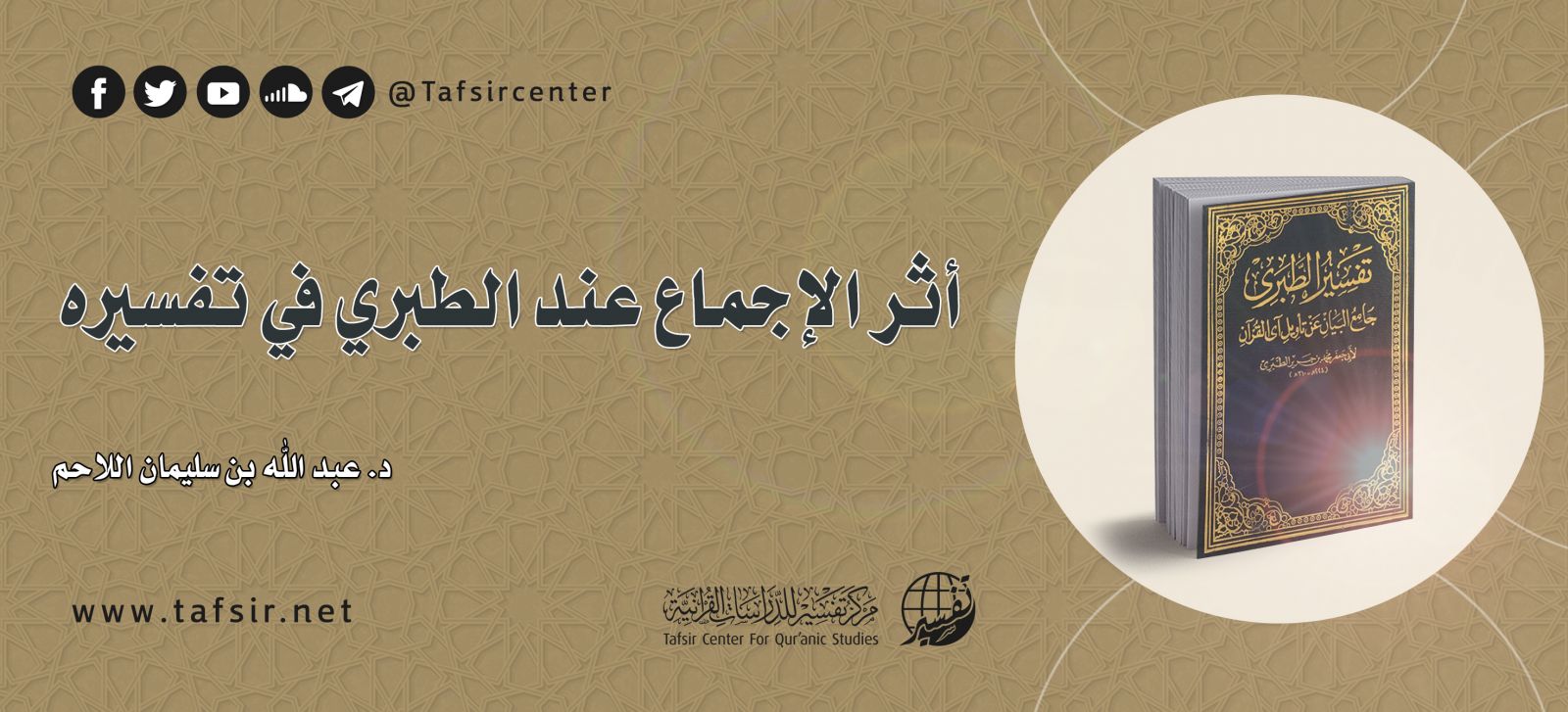أَثرُ القراءات القرآنية في عدم انعقاد إجماع النحويين
أَثرُ القراءات القرآنية في عدم انعقاد إجماع النحويين
الكاتب: أحمد فتحي البشير

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإنّ القراءات القرآنية وعلاقتها بصناعة العربية أمرٌ طال النظرُ فيه قديمًا وحديثًا، وأخَذ حيِّزًا كبيرًا من دراسات الباحثين، وأكثر هذه الدراسات كانت منافِحة عن القراءات في مقابل مَن ردَّها أو نسَبها إلى اللحن، من خلال الإتيان بالشواهد المؤيِّدة لها من كلام العرب، وذِكر مقاييس العربية التي تدعمها.
بعضهم ذَهَبَ إلى أنه بمجرد ورود القراءة بشيء فيجب اعتباره والبناء عليه، وجَعْله مقيسًا وإن كان قليلًا شاذًّا بالنسبة لغيره من كلام العرب.
إلا أنّ ثمة أمرًا متعلِّقًا بهذا الذي تناوله الباحثون، بل هو أصلٌ من أصول النظر في هذه القضية، لا يستتبّ الكلامُ فيها دون الإحاطة به، لكني لم أقف على مَنْ تعرَّض له، أو أشار إليه، وهو علاقة القراءات القرآنية بانعقاد الإجماع النحوي؛ إذ لا يُتصوَّر أن ينعقد إجماعٌ مع وجود النصّ الصريح على خلافه.
فإنّ وجود النصّ الصريح الذي لا يَحتمل التأويل غير المتكلَّف، لا يصح انعقاد الإجماع على بطلان الحكم الذي جاء في النصّ، والذي دلَّ عليه دلالة صريحة؛ إذ الإجماع في كلّ فنّ لا بد له من مستنَد، وعلى هذا المستنَد يَنبنِي الإجماع، فإذا حُكِي الإجماع على أمرٍ وثمة نصٌّ صريح يخالِف هذا الإجماع، فإنّ في ثبوت هذا الإجماع نظرًا؛ إذ لا يكون الفرع مُبطِلًا لأَصْلِه.
إلا أن المتتبِّع لصنيع النحاة -لا سيما المتقدمين منهم- يجد تصرُّفات بعضهم مخالفة لهذا التقرير، بل قد يَنقُل بعض النحويين الإجماع على منع حكم مع كون هذا الحكم قد جاءت به القراءة القرآنية، وبعضهم يحكم على بعض الأحكام أنها خاصة بضرورة الشعر، مع كونها واردة صريحة في دلالتها على هذا الحكم في أفصح النثر، وهو القرآن، وبعضهم يَرُدُّ القراءة وينسبها إلى اللحن، وكلُّ هذا مشكِل مع هذا الذي قررناه.
وهذا ما نروم بيانه وتقريره في مقالتنا هذه، والنظر في ضوابطه وأصوله والتعرّض لبيان مخالفته من قِبَل بعض النحويين، والموقف من ذلك وكيفية التعامل معه، وقبل الولوج إلى قضية المقالة والشروع فيها نتقدَّم بين يديها بتمهيد، نقرِّر فيه القواعد والأصول الحاكمة التي يجب مراعاتها عند درس تلك القضية.
القواعد والأصول الحاكمة لمسألة البحث:
أولًا: لمَّا كانت القراءات القرآنية هي أفصح الكلام باتفاق أهل العربية؛ إذ نَقَلَ الإجماعَ ابنُ خالويه (ت370هـ) على أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح من غيرها، ثم قال: لا خلاف في ذلك[1]. فانظر كيف أثبت الاتفاق على هذا، ثم نفى أن يكون ثمة خلاف فيه! وهو من متقدمي النحاة؛ ممَّا يدلّ على أن ذلك الأمر كان مستقِرًّا في صناعة النحو في مراحله المتقدمة، بل الأقوى من إجماع أهل العربية إقرارُ العرب أنفسهم الذين نزَل القرآن بلُغتهم بذلك، وعجزُهم عن مضاهاته[2]. وقد اعتمد النحاة عليها كأحد روافد السماع، الركن الركين الذي انبنت عليه صناعة النحو. فإنّ السماع بالنسبة لصناعة النحو كالقرآن والسنة بالنسبة للفقه، فالقراءات القرآنية على هذا أصلٌ من أصول النحو؛ ولهذا فإنه لا خلاف بين النحاة في الاحتجاج بكلّ أنواع القراءات متواترها ومشهورها، بل والشاذة منها؛ فإن القراءات الشاذة وإن فقدت بعض شروط القراءة المقبولة عند القرّاء، إلا أن الاعتماد عليها من جهة العربية مقبول؛ لأنها كلّها ثابتة الفصاحة معزوَّة إلى عربي فصيح[3].
فنظرة النحويّ إلى القراءة الشاذة تختلف عن نظرة صاحب القراءات إليها؛ فهي مقبولة عند النحوي لموافقتها شروط القبول في صناعته، بخلاف شروط القبول بالنسبة لصاحب القراءات؛ فلهذا يَنصُّ النحويون على أن القراءة سواء أكانت متواترة أم آحادًا، فإنها حُجة في النحو[4].
بل ما نشأت صناعة النحو ابتداءً إلا من أجل الحِفاظ على القرآن من جهة الخوف من اللحن في قراءته وعدم فهم آياته بسبب الجهل بقواعد العربية[5]، بل «أَوَّلُ مَن خدَم القرآنَ، وعلَّق عليه التفاسير هُم النُّحاةُ؛ ويقال لهم: أصحابُ المعاني...، وهؤلاء الذين أرادَهم البغويُّ في «معالم التنزيل» من قوله: قال أصحابُ المعاني»[6] [7].
وإذا علِمنا أن بعض أصحاب القراءات المشهورة المتواترة كانوا من أئمة الصناعة النحوية كالكسائي وأبي عمرو بن العلاء، وغيرهما كان معروفًا بالتمكُّن في العربية كالإمام عاصم؛ فإننا بعد هذا نستطيع أن نُقرِّر أنّ القراءات القرآنية كانت ماثلةً منذ بداية التقعيد أمام أئمة الصناعة ومؤسّسيها، ومَن طالَع كتاب سيبويه -وهو أوَّل كتاب في النحو وأنضجه- يَجِد هذا العدد الكبير من الشواهد القرآنية التي أودعها كتابَه، وقد بلَغت -وَفْقًا لإحصاء أحد الباحثين- سبعًا وخمسين وأربع مائة آية[8].
وبذلك نستطيع أن نقرِّر أنّ القراءات القرآنية مصدر من مصادر السماع المتّفق على الرجوع إليها في صناعة النحو.
ثانيًا: العلوم الإسلامية بعد عصر التصنيف، وتميُّز كلّ عِلم بموضوعاته ومباحثه، أصبح بينها من التكامل والتداخل ما فرَضته طبيعة نشأة هذه العلوم، وهي أنها جميعًا إنما نشأت لغرض واحد، وهو خدمة القرآن والسُّنة المصدرَيْن الرئيسَيْن للتشريع، وفي هذا يقول ابن حزم (ت456هـ): «فالعلوم كلُّها متعلِّق بعضها ببعض...، محتاجٌ بعضها إلى بعض»[9].
ولهذا فإنّ تقرير مسائل هذه الفنون دون استحضار هذا المعنى، قد يترتب عليه قصور في تقرير بعض تلك المسائل، وفي ذلك يقول القرافي (ت684هـ): «العلوم والفنون يمد بعضها بعضًا، فمن غاب عنه فقد غاب عنه نور فيما هو يَعْلَمه، وحينئذ لا يَكمُل النظر إلا بالشمول؛ ولذلك إنّ النحوي الذي لا يُحسِن الفقه ولا المعقولات تجده قاصرًا في نحوه بالنسبة لمن يَعْلَم ذلك، وكذلك جميع الفنون»[10]، وعلى هذا فــ«لا بُدَّ لكلِّ علم في الغالب من علم آخَر أو علوم حتى تُنوَّر مظلماته، وتَتَحقَّق غوامضه وخَفيَّاته»[11].
ثالثًا: ثمة قواعد عامة محكَّمة تضبط قواعد الاستدلال العامّة لكلّ علوم الإسلام، فما من صاحب فنّ من هذه الفنون إلَّا يحتاج إلى معرفة تلك القواعد حين يقرّر مسائل فَنِّه أو يستدلّ لها أو ينافح عنها، ودُون معرفة هذه القواعد -وَفق هذا- يكون مقصِّرًا في فنِّه، وهذه القواعد مبثوثة في مصنفات العلماء في شتى الفنون، ولكن قد جمَع كثيرًا من تلك القواعد التي يَحتاجها علماء سائر الفنون علمُ أصول الفقه؛ إذ هو «مناط الشرائع، فضلًا عن الصنائع»[12]؛ ولهذا وُصِف بأنه «رئيس العلوم الشرعية على التحقيق»[13].
فهذه الأصول الثلاثة لا شك أن استحضارها في التعامل مع ما تثيره هذه المقالة من إشكالية وأشباهها بصورة عامة -أمرٌ له أهميته في تحريرها وضبط التعامل معها، وعليها سنبني ما نقرّره في هذه المقالة بإذن الله تعالى.
القراءات القرآنية والإجماع النحوي:
إجماع أيّ أهل فنّ هو إجماع أهل هذا الفنّ كلّهم على أمر من أمور صناعتهم، وبذلك يكون هذا الاتفاق منهم كلهم حجةً، لا تجوز مخالفتهم فيه[14].
إلا أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند، أيْ: أصل ينبني عليه[15]، وأوّلُ الأصول التي ينبني عليها الإجماع عند الفقهاء والأصوليين الكتابُ والسُّنة، فهما أصل الأدلة، وكلّ الأدلة الأخرى في الحقيقة راجعة إليهما.
وكذلك النحو؛ فهو في ذلك كالفقه، فالسماع هو الركن الركين لصناعة النحو، وسائر الأدلة راجعة إليه[16]، والسبب في هذا التشابه في هذا الأمر بين الفقه والنحو هو أن النحو «معقول من منقول، كمَا أنّ الفقه معقول من منقول، ويَعْلَم حقيقة هذا أربابُ المعرفة بهما»[17].
والصورة التي نريد أن نعرض لها بعد تقريرنا أن الإجماع لا بد له من مستند هي ورود القراءة القرآنية الدالّة دلالة صريحة على حكم نحوي، فهي نصٌّ في دلالتها على هذا الحكم أو كالنصّ من حيث ظهورها، لكننا قد نرى النحويين قد اتفقوا على عدم جواز هذا الحكم الذي جاءت به القراءة، أو جَعْله من باب الضرائر أو ما أشبه ذلك من العبارات التي تدلّ على عدم اعتباره، فإننا في هذه الحال لا نقبل هذا الحكم منهم؛ لأنّ الإجماع لا يكون إلا عن السماع الوارد في المسألة، فإن كان نصًّا فيها فلا يُتصوَّر أن ينعقد الإجماع على كون هذا الحكم غير جائز؛ إذ الإجماع فرع عن أصله، ومبنيٌّ عليه، فكيف يعود الفرع على أصله بالإبطال؟!
وقد تكلم الأصوليون في صناعتهم على قريب ممَّا نتكلم فيه، وهو كلامهم في مسألة ورود النص على خلاف الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، فقالوا: إن في هذا مذاهب:
الأول: يُرْجَع إلى النصّ.
الثاني: يُرْجَع إلى الإجماع.
الثالث: لا يُتصوَّر انعقاد الإجماع ابتداءً[18].
فإذا كان هذا في النصوص الشرعية التي يُتعامل معها من أجل معانيها، فإنّ هذا يكون أظهر فيما يتعلَّق بالألفاظ والتراكيب التي هي محطّ نظر النحوي؛ لأن إثبات قطعية المعاني أصعب من إثبات قطعية هيئة اللفظ أو التركيب المراد إثباته، لكثرة الاحتمالات الواردة على المعنى، ممَّا لا يَرِد على هيئات الألفاظ والتراكيب في الغالب.
فإذا ثبَت هذا فإننا نقول: إذا وردت القراءة القرآنية بحكم نحوي، وكانت في دلالتها على هذا الحكم نصًّا أو ظاهرةً، فإن إجماع النحاة إن حُكِي على عدم جواز هذا الحكم الآتي في القراءة، فإننا نستطيع أن نقول: إن هذا الإجماع لم ينعقد على شرطه؛ لوجود النصّ المخالِف له، هذا على التسليم بأن إجماع النحاة حُجة[19].
فإجماع النحاة لا ينعقد، ولا يكون حجة مع وجود القراءة المثبِتة للحكم -سواء أكانت القراءة في دلالتها على هذا الحكم نصًّا أم ظاهرةً؛ لأن الظهور يفيد غلبة الظنّ، وغلبة الظنّ كافية في إثبات أحكام اللغة، كالأحكام الشرعية الفرعية[20]- الذي أجمعوا على منعه أو جَعْله خاصًّا بضرورة الشعر.
ولم أرَ من نبَّه على هذا المنزَع إلا ما قد يؤخذ من إيماء ابن الحاجب في أثناء كلامه على إدغام نحو: قَرْمُ مالك. و: عَدُوُّ وليد. إذ ذكَر «أن النحويين مُطبِقون على أنه لا يَصِحُّ الإدغام، والمُقرِئون مُطبِقون على أنه يَصِحُّ الإدغام؛ فَيَعْسُر الجمع بين هذين القولَين مع تعارُضهما»[21]، وبعد أن عجز أن يَجمع بين القولين قال: «والأَولى الردُّ على النحويين، فلا يَكُون إجماع النحويين حُجَّة مع مخالَفة القُرَّاء لهم، ثُمَّ لو قُدِّر أن القُرَّاء ليس فيهم نحوي، فإنهم ناقِلون لهذه اللغة، وهُم مشارِكون النحويين في نقل اللغة، فلا يَكُون إجماع النحويين حُجَّة دُوْنهم»[22].
فقد اعتمد ابن الحاجب في ردّ إجماع النحاة على عدم جواز هذه الصورة من الإدغام على أمرين:
الأول: أن من القُرَّاء نحاة، فإذا أجمع النحاة على أمر، ووجدنا القُرَّاء يذهبون إلى خلافه، فإنّ إجماع النحاة حينئذ ليس على شرطه من اتفاق كلّ النحاة؛ لأن القُرَّاءَ منهم نحاةٌ.
الثاني: أن القُرَّاء -على فرض أن ليس فيهم نحوي- نَقَلة سماع كالنحاة، والإجماع لا يَنعقِد ابتداءً مع وجود السماع الصريح على خلافه.
فالقُرَّاء على فرض عدم وجود نحوي فيهم، فإنهم نَقَلة للسماع، الركن الركين والمصدر الرئيس لصناعة النحو، والسماع الذي يَنقُلونه هو أفصح أنواع السماع، وهو القرآن الكريم وقراءاته المتواترة، وقد اتفق أهل العربية على الاحتجاج بالقراءات القرآنية متواترها وشاذِّها كما سبَق تقريره.
وقد ثبَت الإدغام بالسماع الصريح كما ذكَر ابن الحاجب، وذلك في قراءة أبي عمرو من إدغام الدال في الجيم في قوله: {دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً}[فصلت: 28]، وإدغام الميم في الميم في قوله: {مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ}[البقرة: 120][23].
ولا يُتصوَّر ابتداءً انعقاد الإجماع مع وجود السماع الصريح غير المحتمِل خِلافَه، وهو الأصحُّ من المذاهب في هذه المسألة، كما تقدم بيانه[24].
فإذا ثبت إجماع النحاة على مسألة كالتي عرَض لها ابن الحاجب، ووجدنا القُرَّاء يَنقُلون سماعًا صريحًا -لا يَحتمل تأويلًا معتبَرًا- مخالِفًا لِما أجمع عليه النحاة، فإنّ إجماع النحاة حينئذ لا يُعَدُّ إجماعًا معتبرًا؛ لوجود هذا السماع الصريح خلافَه.
وقد اعتمد القسطلاني (823هـ) على هذا المَنزَع، وقرَّر أن السماع الصريح في المسألة لا يقال عنه إنه غير جائز من أجل أنّ النحاة أجمعوا على خلافه، وقد اعتمد في تقرير هذا على كلام ابن الحاجب السابق، وقَبْل نقلِه لكلام ابن الحاجب ذكَر قريبًا ممَّا نريد تقريره، فقال: «لا نُسلِّم أنّ ما خالف قاعدتهم غير جائز، بل غير مقيس، وما خرَج عن القياس إن لم يُسمَع فهو لحنٌ، وإن سُمِع فهو شاذٌّ قياسًا، ولا يمتنع وقوعه في القرآن»[25].
وبعد أن ذكَر القسطلاني كلامه هذا نقَل كلام ابن الحاجب مستدِلًّا به على ما قرَّره في كلامه السابق من أن السماع الصريح في المسألة إذا خالف إجماع النحاة لا يقال عنه إنه غير جائز.
ويَحسُن التنبيه على أمور تُعتبَر كالضوابط لهذه القاعدة التي قرَّرها ابن الحاجب والقسطلاني:
1- أن الجمع بين قول النحاة وقول القُرَّاء هو الأَوْلَى من إثبات التعارُض بينهما، وهذه قاعدة يُعوَّل عليها في سائر العلوم، ويَفزَع إليها أهل كلّ الفنون، وقد نصَّ على ضرورة إعمال هذه القاعدة في هذا الموضع ابن الحاجب والقسطلاني[26].
2- أن المكانة الدينية للقراءات القرآنية المتواترة قد تجعل بعض النحاة يقيس على كلّ الوارد في القراءات القرآنية، لا سيما مع طعنِ بعض النحويين في بعض القراءات ونسبتها إلى اللحن.
والإنصاف هو التأكُّد أوّلًا من أن القراءة الواردة نصٌّ في المسألة أو ظاهرة، وإلَّا فإذا كانت تحتمل تأويلًا غير متكلَّف، فلا يصح البناء عليها؛ لأن الدليل إذا دخَله الاحتمال سقَط به الاستدلال، وهذه أيضًا قاعدة معمول به في سائر العلوم، ومنها علم العربية[27].
فإذا ثبَت أنها نصٌّ في ما تدلُّ عليه أو كانت ظاهرة فيه، فهذا لا يَعنِي أنها مقيسة بمجرد ورودها في القرآن، فالقياس لا يكون إلا على المطَّرِد الشائع، على خلاف في القياس على الشاذّ الوارد في القرآن، ليس هذا مَوضِع بيانه[28]، وقد دلَّ على ذلك قول القسطلاني السابق، بل هي شاذَّة، ولا يمتنع وقوع الشاذ في القرآن كما قال القسطلاني، وقد بيَّنتُ عِلة عدم امتناع وقوع الشاذ في القرآن، وأن هذا هو الموافق لحِكمة الشارع الحكيم، في كتاب (أصول العربية بين متقدمي النحاة ومتأخريهم)[29].
لكن الذي نستطيع أن نقرّره هو أنّ الظاهرة النحوية الواردة في القراءة نصًّا أو ظاهرةً، لا يقال عنها إنها لحن أو غير جائزة، بل هي جائزة بغضّ النظر عن كون هذا الجواز على قِلة أو باطراد؛ للخلاف السابق في القياس على القليل الوارد في القرآن.
وبهذا نستطيع أن نَرُدّ الإجماع الذي ادَّعاه أبو إسحاق الزجاج من أنه يقبح العطف باسم ظاهر على اسم مضمر في حال الجَرّ إلا بإِظهار الجار، ردًّا منه قراءة مَن قرأ: {والأرحامِ} بالكسر، وهي قراءة حمزة[30]؛ وذلك لأن هذه القراءة ظاهرة في جواز ما نقَل الزجاج الإجماع على قُبحه، إِذْ كلّ التأويلات التي أرادوا تأويل ظاهر هذه القراءة بها لا تنهض[31].
ويترتب على ذلك من باب أولى رفضُنا ما يَحْكُم عليه بعضُ النحاة أو كثير منهم على الظاهرة النحوية بأنها خاصَّة بضرورة الشعر وقد وردت بها القراءة الصريحة أو الظاهرة في إثباتها، ومن ذلك قراءة ابن عامر: {وكذلك زُيِّن لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شُركائِهم}[الأنعام: 137][32]، بالفصل بين المتضايفين بمعمول المضاف، فقد ذكَر الرضي في «شرح الكافية»[33] أن أكثر النحاة خصوا ذلك بالشعر، ومنعوه في السَّعة، وكذا جعَله الزمخشري من أقبح الضرورات[34]، ومِن قبلهما ذكَر الفراء أنه لا يَعرِف وجهها في العربية[35].
فهذا الذي قرّروه بأن الفصل بين المتضايفين في قراءة ابن عامر خاصٌّ بالضرورة، كلام لا يَقْبَله النظر الصحيح وَفق قاعدتنا التي نقررها؛ لأنّ الخاصّ بالضرورة هو الذي لم يأتِ إلا في شعر مخالِفًا ما جاء في الكلام النثري على رأي الجمهور[36]، أما إذا جاء في الكلام النثري الفصيح، فلا يُقال عنه إنه ضرورة، فما بالك بمجيئه في أفصح النثر باتفاق، وهو القرآن!
ولا شكّ أن الاحتجاج العملي للقراءات الواردة مع التنبيه على هذه القاعدة يَزيد من قوة الاحتجاج ويدعمه، بخلاف الاحتجاج بمجرد ورود القراءة داعمةً للظاهرة النحوية المراد الاحتجاج لها بالقراءة؛ إِذْ قد لا تكون القراءة نصًّا ولا ظاهرة في الحكم المراد الاستدلال عليه بها، وحينئذ لا يصلح التمسُّك بها.
ولهذا نقرِّر أن من يَحتج بالقراءات مطلقًا دون النظر إلى هذه القاعدة التي قرَّرناها، وهي ضرورة أن تكون القراءة نصًّا أو ظاهرةً فيما تَدل عليه من الحكم النحوي، فإنه لا يستتبّ له الاحتجاج بها؛ لأنها محتملة، والمحتمل لا تقوم به حجة ما لم يكن ظاهرًا في ما يدلّ عليه.
ومن هنا فإننا لا نوافِق على ما يُنادِي به بعض المعاصرين من البناء على الوارد في القراءات مطلَقًا[37] دون التنبُّه إلى ضرورة التعويل على قاعدتنا هذه؛ لأن في دعوتهم هدمًا لهذه القاعدة، وهي قاعدة متفقٌ عليها عند علماء الإسلام جميعًا في كلّ الفنون، وفي إغفالها إغفال لقواعد العلم والخروج عنها إلى تحكيم الظنون والأهواء.
وكذلك يجب التنبُّه إلى عدم جَعْل ما جاء في القراءة -وإن كان نصًّا أو ظاهرًا- مقيسًا مطَّرِدًا لمجرد مجيئه في القراءة، وإن كان في الحقيقة قليلًا بالنسبة إلى باقي كلام العرب، إلا أن هذه القاعدة يُمكِن أن يتسامح فيها كما سبَق التنبيه عليه، أما قاعدتنا الأُم فلا سبيل إلى التسامح فيها أو الغفلة عنها.
وثمة نصٌّ لابن جني يُشير من طرفٍ خفيّ إلى ما قررناه، وذلك في قوله عن الإجماع: «اعلم أنّ إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالِف المنصوص والمقيس على النصوص، فأمَّا إن لم يعطِ يده بذلك، فلا يكون إجماعهم حجة عليه»[38].
فابن جني لا يَمْنع من مخالفة الإجماع إلا إذا كان الإجماع على المنصوص أو المقيس على المنصوص، ويؤخذ من تقريره هذا أنّ ما كان نصًّا أو في حكم النصّ لا يُخالَف، بمعنى أنه لا يُرَدُّ، ولا يقال عنه إنه غير جائز. وإن كان غيره أَدخلَ في قياس العربية منه، وأكثر شيوعًا في كلام العرب.
ولا يُعترض على ما قررناه من أنه لا خلاف في كون القراءات القرآنية أصلًا سماعيًّا محتجًّا به في صناعة النحو، بأنّ قومًا من متقدِّمي النحويين قد طعَنوا في بعض القراءات ورموها بالبُعد عن العربية، ونسبتها إلى اللحن[39]؛ لأنَّا نقول: إنّ هذا لا يقدح في ما نقلناه من الاتفاق؛ لأن فعلهم هذا لا يكون قدحًا في القراءة إلا بعد ثبوتها عندهم، لأن القول بتواتر القراءات وثبوتها عند القدماء لم يكن كما كان عند المتأخرين الذين استتب القول بتواتر القراءات عندهم، بالإضافة إلى أن البحث عن تواتر تلك القراءات يحتاج إلى جهد ونظر ليس من صناعة النحوي الصِّرْف، وقد كان دائمًا الأمر في الصدر الأول أن علماء القراءات والحديث غير علماء العربية[40].
وممَّا يدل على ذلك ما نُقِل عن الإمام أحمد من كراهة قراءة حمزة لِما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك[41].
ولا يُظَنّ بعاميٍّ مُسلِم بَلْهَ أن يكون عالمًا انتفع الناس بعلمه واتفق الناس على إمامته في العلم أن يَقُول مثل ذلك فيما ثبَت عنده أنه قرآن.
وممَّا يَزيدك يقينًا بهذا أن هؤلاء الذين ورَد عنهم ردُّ بعض القراءات أو نسبتها إلى اللحن، تجدهم يَذكُرون أن أفصح الكلام هو القرآن وأن القراءة سُنة لا تَجُوز مخالفتها.
ومن هؤلاء الزجاج فقد نسَب قراءة: {والأرحامِ} بالكسر -وهي قراءة حمزة[42]- إلى الخطأ[43]، ومع ذلك تراه يُقرِّر في أكثر من موضع أن القراءة سُنة متّبَعة، لا تُخالَف، ولا تُتجاوَز، فالأصل فيها الاتباع[44]، فلو كانت قراءة حمزة عنده ثابتةً لقال فيها مثل هذا.
ومن هذا فإننا نقرِّر أن مَنْ قَبِل القراءة على أنها سُنة، لكن لم يُجز القياس عليها، لقلّتها أو معارضتها ما هو أقوى منها، فهذا غير داخل في حيِّز مَن رَدَّ القراءة أو نسبها إلى اللحن؛ لأن القرآن وإن كان أفصح الكلام إلا أن القياس في العربية له شروط، وقد أشار الشاطبي إلى هذا المعنى[45].
وبهذا فإننا نستطيع أن نُقرِّر أنه لا خلاف في فصاحة القرآن والاحتجاج به في اللغة والعربية في الجملة.
وعدم التنبُّه إلى هذا الأمر تسبب -في رأينا- في افتعال ما هو ذائع مشهور بمعارك النحويين مع القُرَّاء، وقيام كثير من الدراسات حول هذا، وما قيل في بعضها من التعدِّي على أئمة النحو، ونزاعات وردود كان يُمكِن الاستغناء عنها، ووضعها في مسار أكثر فائدة!
فالأمر لا يعدو أن يكون سوء فَهم منَّا لتصرُّفات القدماء من النحويين، بسبب عدم استصحاب الأصول العامة التي اتفقوا عليها، وعدم تحكيمها في كلامهم، بسبب إغراقنا في تتبُّع المسائل الفرعية والقضايا الجزئية دُوْن التنبُّه إلى الأصول العامة والقواعد الكلية الحاكمة لها، والتي يجب ردّ هذه التصرُّفات إليها.
فالأمر في نظرنا شبيهٌ بعدم عمل الأئمة المتّفق على عِلمهم وعدالتهم بالحديث في بعض الأحيان، بسبب أنّ الحديث لم يَثْبُت عندهم، ولم يَقُل أحدٌ عن تَرْك هؤلاء الأئمة العملَ بالحديث في هذا أنّ ذلك منهم عدم تبجيل له، ولا ترَك الناس الاحتجاج بالحديث في هذا الموضع بسبب تركهم له، وإنما استصحبوا أصلهم الثابت: إذا صح الحديث فهو مذهبي[46].
هذا بالإضافة إلى أن ردّ القراءات من جهة الثبوت وعدم الثبوت ليس بابه النحو ومقاييسه، وإنما هو ثبوت القراءة بشروط ثبوتها عند أهل القراءات، وهذا الأمر كان مستقِرًّا منذ عهد السلف المتقدمين من العلماء؛ فقد قال شبل بن عباد (تُوفي بعد 160هـ) -وهو من أصحاب ابن كثير المكي صاحب القراءة السبعية المشهورة-: «كان ابن محيصن وابن كثير يَقرآن: {وأنُ احْكُم}[المائدة: 49]...[47]، ونحوه. قال شبل بن عباد: فقلتُ لهما: إن العرب لا تَفْعَل هذا، ولا أصحاب النحو. فقالَا: إنّ النحو لا يَدخُل في هذا، هكذا سمِعنا أئمتنا ومَن مضَى من السَّلَف»[48] والنحاة الصِّرف لا يُرجَع إليهم في تقرير هذا.
ويُمكن أن يُضاف إلى ذلك أنّ النحاة وهم يُقرِّرون قواعدهم ينظرون إلى القياس، وما هو مطَّرِد؛ إذ القواعد لا تُبنَى إلا على هذا، ولهذا عرَّف الأنباري السماع بأنه الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حدّ القلة إلى حدّ الكثرة[49]، ولمَّا اعتُرض عليه بكون هذا «خلطًا بين السماع بوصفه أصلًا مستقِلًّا من أصول النحو، وبين السماع بوصفه ركنًا من أركان القياس، وهو المقيس عليه؛ إِذْ إنّ المقيس عليه هو الذي يُشترَط فيه الاطِّراد»[50]، أُجيب عنه بما نريد تقريره، وهو أنه كان «يُركِّز في تعريفه للسماع على النقل باعتباره ركنًا من أركان القياس؛ إِذْ لا يَجُوز القياس إلا على ما اطَّرَد من تلك المادة المنقولة»[51].
فغلبة هذا الأصل في صناعة النحويين أسهَم -مع عدم ثبوت بعض القراءات عند بعضهم- في ردّ بعض القراءات ونِسبتِها إلى اللحن.
فثبت بذلك أن اعتبار القراءات أصلًا من أصول السماع في صناعة النحو محلّ إجماع، وأن الحكم الصريح الآتي في القراءة لا يصح انعقاد الإجماع ابتداءً على عدم جوازه -وهذا غير عدم القياس عليه، كما تقدَّم التنبيه عليه-، ولا يقدح في هذا ما جاء عن بعض النحويين من ردّ بعض القراءات أو تلحينها أو ما أشبه ذلك.
ولعلَّ قاعدتنا التي أقمنا مقالتنا هذه لبيانها كانت على بالٍ من هؤلاء المتأخرين من النحاة الذين نافحوا عن القراءات القرآنية، ولكنهم لم ينتبهوا إلى النصّ عليها:
- إما لوضوحها عندهم، وانشغالهم بالدفاع عن القراءات بالإتيان بالشواهد العربية الفصيحة المؤيِّدة لها، مع بيان وجه موافقتها لمقاييس العربية؛ إذ هذا هو اللائق بطريقة الردّ على مَنْ طَعَن فيها من جهة الأصل، إذ الطاعنون أقاموا طعنهم على عدم وجود الشواهد المؤيدة للقراءة، وعدم موافقتها لمقاييس العربية.
- وإمَّا لعدم غلبة صناعة الأصول عليهم، وهذا هو الأظهر؛ إذ لا يُقرِّر مِثل هذه القواعد والضوابط في أثناء التكلُّم في الجزئيات -في الغالب- إلا مَن غلَبتْ عليه صناعة الأصول، ولهذا رأينا إيماء ابن الحاجب لقاعدتنا هذه في كلامه السابق ذِكره، إذ هو من أئمة الأصوليين، ومَن طالَع مَثلًا كتاب «المقاصد الشافية» لأبي إسحاق الشاطبي، يجد مِثل هذا جليًّا فيه، لغلبة صناعة الأصول عليه، ومن هذا تظهر لك أهمية كتب أمثال ابن الحاجب والشاطبي في علوم العربية؛ فإنهم يُقرِّرون مسائلها مع الاعتناء بضبطها وربطها بقواعدها الأصولية.
إيرادٌ وجوابُه:
فإن قيل: فإنَّ ما ذكرتموه من أنّ الإجماع النحوي لا ينعقد عند وجود السماع الصريح بخلافه، يدخل فيه سائر أنواع السماع من النثر العربي غير القرآن والشعر، فإذا جاء السماع الصريح منها فلن ينعقد الإجماع حينها، شأنها في ذلك شأن القراءات، فإنّ السماع من الشعر والنثر الثابت عن العرب الفصحاء وإن كان أقلّ فصاحةً من فصاحة القرآن، إلا أنه فصيح مثله في الجملة، والقرآن نفسه ليست آياته على رتبة واحدة من الفصاحة؛ لأن «التزام الأفصحية ممنوع في التنزيل المُعجِز»[52]، فلماذا إذًا اختصصتم القراءات بهذه القاعدة دون سائر أنواع السماع الفصيح، وأقمتم كلامكم عليها.
قلنا: إنما خصَّصنا القراءات دون باقي كلام العرب الفصيح؛ لأمور رأيناها تنهض بذلك، وهي:
1- أنّ إثبات أنّ القراءة نصٌّ أو ظاهرة فيما تَدلّ عليه من الحكم النحوي أظهرُ من جهة الثقة به منه في غير القرآن من الشعر أو النثر وأسهلُ؛ لِمَا يُحيط بالقرآن من أدوات تُحْكِم الوصول إلى معرفة ذلك من معاني الشريعة وقواعدها، وأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء، ممَّا يجعل الوصول إلى ذلك سهلًا ميسورًا محاطًا بنوع من الثقة التامّة، وهذا ما لم يَتَوَفَّر للشعر والنثر العربي.
ولهذا فإنّ العلماء نصّوا على عدم جواز حمل القرآن على التقادير والمجازات البعيدة التي يجوز حمل الشعر عليها؛ ولهذا قال أبو حيان: «كلام الله تعالى أفصح الكلام، فلا يجوز فيه جميع ما يُجوِّزه النحاة في شعر الشَّمَّاخ والطِّرِمَّاح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة»[53]، فلا يُحْمَل القرآن إلا على أفصح الوجوه وأظهرها[54].
2- أن القراءات القرآنية أوثق من جهة الثبوت من الشعر وغيره من كلام العرب، وذلك للمكانة الدينية التي تتمتع بها القراءات، والتي أوجبت على المسلمين الاعتناء الشديد بنقلها وحفظها، ومن قَبل ذلك حفظ الله تعالى لها، كما في قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[الحجر: 9].
والشعر وكلام العرب وإن كان محفوظًا في الجملة للاحتياج إليه في الشريعة إلا أنه في درجة الثبوت لا يَصل إلى الدرجة التي وصلت إليها القراءات؛ ولهذا وجدنا نزاعات بين النحاة حول ثبوت بعض الشواهد، والاختلاف في روايات الشعر المنقول وغير ذلك ممَّا يجعل الشعر أقلّ رتبةً من جهة التوثيق من القراءات القرآنية[55]؛ ولهذا فإنّ القراءات تتمتع «بدرجة من التوثيق والصحة لا تتمتع بها كثرة من الشواهد الأخرى...، شعرية كانت أم نثرية»[56].
ولهذا كان تقديم ابن الحاجب قول القُرّاء على قول النحاة حول النزاع في جواز الإدغام في الحالة التي نقلناها في كلامه بمثل هذا الذي قلناه، إِذْ قال: «وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القُّرَّاء أولى؛ لأنهم ناقلوها عمَّن ثبتت عصمته من الغلط، ولأن القراءة ثبتت تواترًا، وما نقله النحويون آحاد، ثم ولو سُلِّم أنه ليس بمتواتر، فالقرّاء أعدل وأكثر، فكان الرجوع إليهم أولى»[57].
3- أنّ القرآن خطاب عامٌّ لكلّ العرب، وقد تلقَّاه العرب جميعًا بالقبول من هذه الجهة، وليس الشعر والنثر العربي غير القرآن كذلك، ومن هذه الجهة يَصح تقديم القرآن على سائر كلام العرب، وهي واضحة في تقديم القرآن عليه من جهة البناء عليها في صناعة النحو؛ لأن الغرض من صناعة النحو تقرير القواعد الكلية لكلام العرب التي كان يحصل بها الفَهم والإفهام، والإفهام لا يكون إلا بالمعهود المتداوَل؛ ولذلك بُنِيت القواعد على الكثير المطَّرِد، وهذه الصفة يتمتع بها القرآن بسبب أنه خطاب الله للناس جميعًا، وليس هذا لسائر كلام العرب.
فثبَت من خلال هذا التقرير أن إجماع النحاة لا يَنعقِد دون الرجوع إلى القُرَّاء؛ إما لأنهم نحاة، ولا ينعقد الإجماع إلا باتفاق كلّ النحويين، وإما لأنهم نَقَلة سماع كالنحاة، ولا ينعقد الإجماع مع وجود السماع الصريح المخالِف له.
ولهذا؛ فعلى النحوي المجتهد أن يَكُون مطَّلِعًا على القراءات متواترها ومشهورها وشاذِّها مستحضرًا لها في أثناء تقريره القواعد، وهذا لأمرين:
الأول: أن شرط تقرير القواعد استقراء الوارد من السماع.
الثاني: لئلا يُقرِّر إجماعًا مع وجود قراءة صريحة مخالِفة لهذا الإجماع، وما يترتب على ذلك من القياس عليها.
وبعد هذا التقرير فإننا ننبِّه على أمرين:
الأول: ينبغي عدم تقرير القضايا التي حصَل حولها نزاع، والمشاركة فيها برأي إلا بعد الوقوف على منازع الأقوال فيها، وعدم الإغراق في تفاصيلها التي تَمنَع من إدراك القواعد الكلية الحاكمة لها، كمسألة ردّ جماعة من متقدِّمي النحويين لبعض القراءات التي أشرنا لها قبلُ.
الثاني: ضرورة مشاركة النحوي في سائر العلوم، وأخذه منها ما يحتاج إليه في نحوه، فقد تبيَّن ممَّا قررناه أن إغفال هذا الأمر يجعله مقصِّرًا في تقرير بعض مسائل فنِّه، أو على أقل تقدير يُضعِف من حجته وبيانه لِمَا هو بصدد الاحتجاج له أو بيانه ممَّا يَمُتُّ إلى مسائل فنّه وقضاياه بصلة.
[1] راجع: شرح الفصيح، لابن خالويه، ص402، تحقيق: أ.د. عبد الله بن عمر الحاج، وزميليه، مركز البحوث والتواصل المعرفي، الرياض، ط1، 1438هـ-2017م.
[2] راجع: إعجاز القرآن، للباقلاني، ص24، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف - مصر، ط5، 1997م.
[3] المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني (1/32)، وزارة الأوقاف - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1420هـ- 1999م.
[4] الاقتراح في أصول النحو، للسيوطي، ص22، ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطية، دار البيروتي، دمشق، ط2، 1427هـ - 2006م.
[5] راجع: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، لابن خلدون (المقدمة) (1/756)، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ط2، 1408هـ - 1988م.
[6] راجع: معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي (1/122، 160)، (2/87،)، (3/307).
[7] فيض الباري على صحيح البخاري، محمد أنور شاه الكشميري (4/146)، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط1، 1426هـ - 2005م.
[8] راجع: الشواهد القرآنية في كتاب سيبويه؛ عرض وتوجيه وتوثيق، د. محمد إبراهيم عبادة، ص2، مكتبة الآداب، القاهرة، (د/ط)، (د/ت).
[9] رسالة مراتب العلوم، لابن حزم (4/90)، ضمن رسائله، تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1983م.
[10] شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص438، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط1، 1393هـ - 1973م.
[11] الخصائص، لشهاب الدين القرافي، ص2750، حولية كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، الزقازيق، مجلد 3، العدد 29، 2009م-1430هـ.
[12] فيض نشر الانشراح من روض طيّ الاقتراح، لابن الطيب الفاسي (1/640).
[13] حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح، لمحمد الطاهر بن عاشور (1/5)، مطبعة النهضة، تونس، 1341هـ.
[14] البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (4/465)، قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط2، 1413هـ- 1992م.
[15] البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (6/397).
[16] المقاصد الشافية (7/124).
[17] نزهة الألباء في طبقات الأدباء، للأنباري، ص76، إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء- الأردن، ط3، 1405هـ - 1985م.
[18] البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي (4/408).
[19] وذلك لأن هناك من منع حجيته كابن جني؛ ولأن صورته التي يحكيها النحاة لم يتحقق فيها شرط الإجماع، وهو إجماع كلّ المجتهدين في العربية. راجع في ذلك: أصول العربية بين متقدمي النحاة ومتأخريهم، ص341، 358.
[20] راجِع: المقاصد الشافية (9/429)، وأجوبة في الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات القواعد النحوية، لسراج الدين البلقيني، وولي الدين ابن خلدون، ص231، 232، تحقيق: د. بدر العمراني، مجلة قطر الندى، العدد الثاني، السنة الأولى، ذو الحجة، 1429هـ.
[21] الإيضاح في شرح المفصل، لابن الحاجب (2/494)، تحقيق: د. إبراهيم محمد عبد الله، دار سعد الدين، دمشق، ط1، 1425هـ- 2005م.
[22] الإيضاح في شرح المفصل (2/495).
[23] راجع: الإقناع في القراءات السبع، لابن الباذش، ص80، دار الصحابة، (د/ت). والنشر في القراءات العشر، لابن الجزري (1/299).
[24] راجِع: البحر المحيط، للزركشي (6/408).
[25] لطائف الإشارات لفنون القراءات، للقسطلاني (1/498)، تحقيق ودراسة: عبد الرحيم الطرهوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2013م.
[26] راجع: الإيضاح في شرح المفصل (2/495)، ولطائف الإشارات لفنون القراءات، للقسطلاني (1/499).
[27] راجع: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، لأبي إسحاق الشاطبي (3/274)، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرِين، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط1، 1428هـ- 2007م. وفيض نشر الانشراح من روض طيّ الاقتراح، لابن الطيب الفاسي (1/640)، تحقيق: د. محمود يوسف فجال، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط2، 1423هـ- 2002م.
[28] راجع في ذلك: أصول العربية بين متقدمي النحاة ومتأخريهم؛ دراسة في فكر أبي إسحاق الشاطبي، أحمد فتحي البشير، ص123 وما بعدها، دار الذخائر، القاهرة، ط1، 1439هـ-2018م.
[29] راجع: أصول العربية بين متقدمي النحاة ومتأخريهم، ص267.
[30] راجع: جامع البيان، للداني (3/1003).
[31] راجع: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي (3/555)، تحقيق الدكتور: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.
[32] راجع: جامع البيان، لأبي عمرو الداني (3/1065).
[33] شرح الكافية، للرضي (2/261)، تحقيق وتصحيح وتعليق: أ. د. يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس- ليبيا ، 1395- 1975م.
[34] الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري (2/66)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
[35] معاني القرآن، للفراء (1/357)، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي وآخرَين، دار المصرية للتأليف والترجمة- مصر، ط1، (د/ت).
[36] راجع: ضرائر الشعر، لابن عصفور، ص13، تحقيق: السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، ط1، 1980م. وفيض نشر الانشراح (1/635).
[37] راجع على سبيل المثال: الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين، الدكتور أحمد مكي الأنصاري، القسم الأول، ص188، دار الاتحاد العربي، توزيع دار المعارف، 1393هـ- 1973م. والقرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم، ص347، المكتبة الأزهرية للتراث، (د/ت).
[38] الخصائص، لابن جني (1/190)، تحقيق: محمد علي النجار، الهيئة العامة المصرية للكتاب، طبعة مصورة، عن الطبعة الثالثة، 1406هـ- 1986م .
[39] راجع: الاقتراح، ص40.
[40] راجع: فيض نشر الانشراح (1/452، 453)، تحقيق: د. محمود يوسف فجال، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دبي، ط2، 1423هـ- 2002م.
[41] راجع: طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى (1/74)، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة- بيروت.
[42] راجع: جامع البيان في القراءات السبع، لأبي عمرو الداني (3/1003)، جامعة الشارقة- الإمارات، ط1، 1428هـ- 2007م.
[43] راجع: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (2/6)، عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب- بيروت، ط1، 1408هـ- 1988م.
[44] راجع: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (1/290)، (2/93، 147، 321).
[45] المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، للشاطبي (4/179)، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرِين، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط1، 1428هـ- 2007م.
[46] راجع: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لابن تيمية، ص33، تحقيق: أحمد بن محمد السمين، مكتبة العلوم والحكم، ط1، 1432هـ- 2011م.
[47] راجع: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري (2/225)، المطبعة التجارية الكبرى، (د/ت)، (د/ط).
[48] أخرجه عن شبل أبو عمرو الداني في جامع البيان (1/147)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (4/413)، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط1، 1422هـ- 2002م.
[49] لمع الأدلة، ص82، تحقيق: سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، 1371هـ- 1957م.
[50] أصول النحو في معاني القرآن للفراء، محمد عبد الفتاح العمراوي، ص32، 33، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 1992م.
[51] أصول النحو؛ دراسة في فكر الأنباري، ص154، دار السلام القاهرة، ط1، 1427هـ- 2006م.
[52] راجع على سبيل المثال: شرح الكافية الشافية، لابن مالك (2/979- 988)، تحقيق: د. عبد المنعم أحمد هريدي، (د/ط)، (د/ت). والبحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي (3/500)، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر- بيروت، والدر المصون، للسمين (3/555)، الطبعة: 1420هـ.
[53] البحر المحيط، لأبي حيان (1/12)، وراجع: (1/615)، (5/43).
[54] راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري (2/693)، (7/27، 502)، (11/447)، تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، دار هجر، ط1، 1422هـ- 2001م. والبحر المحيط، لأبي حيان (1/13)، وقواعد التفسير، خالد عثمان السبت (1/213)، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ- 1997م.
[55] راجع: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، ص338 وما بعدها.
[56] مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، دكتور: شعبان صلاح، ص375، دار غريب، القاهرة، 2005م.
[57] الإيضاح في شرح المفصل (2/495).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

أحمد فتحي البشير
حاصل على الدكتوراه في النحو والصرف والعروض من كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ويعمل باحثًا بمكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))