تقرير تقويمي لرؤية إعادة بناء علوم القرآن
للدكتور/ خليل محمود اليماني
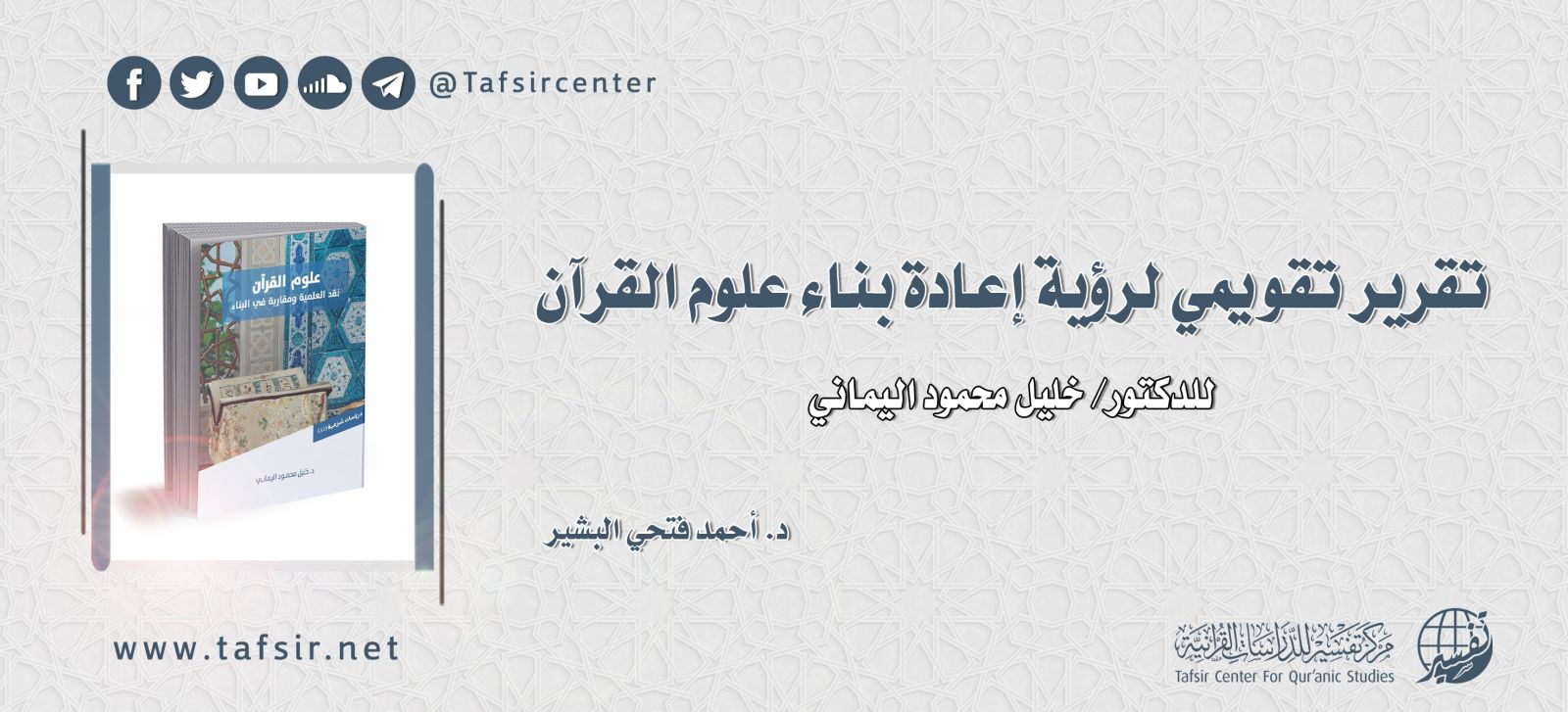
مقدّمة:
إنَّ من علومنا الموروثة التي لها تعلُّق بالقرآن -وكلُّها لها تعلُّق- ما عُرِف بعلوم القرآن، غير أنّ الناظر في كتابات هذا العلم ومدوّناتِه يَجِد أنه لم يُحَط بسياج وأُطُر منهجية صارمة تضبط مساراته ومباحثه كما ضُبِط الأمرُ مع الفقه وأصوله مَثَلًا، ممَّا أصابه بإشكالات منهجية في بنائه، عادت عليه بالتراجع والخمول وعدم التثوير بخلاف غيره من علومنا التراثية.
هذا الأمر كان على بالِ جماعةٍ قليلةٍ من الباحثين المعاصرين، نَبَّهوا الساحةَ البحثية على هذه الإشكالات، وعلى أنّ العلوم القرآنية بحاجة إلى مراجعةٍ وضبطٍ وإعادةِ بناء؛ نظرًا لوجود إشكالات كثيرة تحتفّ بإقامتها، وقد تضاربَتْ أنظار الباحثين واختلفَت اختلافًا كثيرًا حول كيفية القيام بذلك كما هو معلوم في هذا السياق.
وقد اطّلعتُ على مشروع الدكتور خليل اليماني الذي أقامه من أجلِ مناقشةِ عِلميةِ علوم القرآن، واستعراض واقعها، ومحاولات بنائها، وبيان الإشكالات المنهجية التي أخَلَّت بها، مع تقديم رؤية جديدة نظرية لبناء هذه العلوم، وفيما يأتي سأُقدِّم تقويمًا علميًّا لهذه الرؤية البنائية الجديدة التي طرحها هذا المشروع والموقف منها.
قدَّم الدكتور خليل محمود اليماني مشروعًا نقديًّا لعلوم القرآن؛ حيث انتقد هذه العلوم منهجيًّا، وأرسَى تصوّرات نظرية لإعادة بنائها، وقَدَّم تطبيقًا عمليًّا موسَّعًا لاستثمار هذه الرؤية في بناءِ عِلْمٍ قرآني بصورة جديدة هو (علم التفسير)، وذلك في أعماله الثلاثة:
1- تصنيف أنواع العلوم؛ قراءة في المنجز، وتصنيف معياري مقترح.
2- علوم القرآن؛ نقد العلمية ومقاربة في البناء.
3- تأسيس عِلْم التفسير؛ مقاربة تأسيسية مقترحة.
وقد أقام الدكتور خليل مشروعه على نقض معيار العِلْمِيّة المطروح في التراث وتقديم معيار جديد للحُكْم بما يكون عِلْمًا وما لا يكون.
وهذا المعيار عنده هو كون العلم قضيّة كلية قابلة لإنتاج حركة بحث هائلة.
وقد قسّم الدكتور أنواع العلوم/ القضايا الكلية إلى قسمين، يرى أنّ هذا التقسيم يحفظ لنا تثوير حركة تقويم العلوم، وتوفير أداة لمعايرة حركة تفريع الموضوعات داخل العلوم، وضبط حركة تفريع محاور الاشتغال داخل العلوم، وضبط العلوم في الواقع وحِفْظها من التشوّش والاختلاط، وتحقيق العناية بالعلوم الخاصّة، وضبط النّظر التاريخي لنشأة علوم التراث، وبناء مسارات بحثية رائدة في العلوم.
وهذا ما أخفق فيه -حسب رؤية الدكتور- الطرحُ التراثي في تعريفه للعِلْمِيّة ومعاييرها التي ذكروها.
وهذان القسمان هما:
الأوَّل: علوم تقنِّن كيفيات مزاولة الممارسة في العلم.
الثاني: علوم تصنع الوعي بالواقع القائم للممارسات.
وتحت كلّ قسم ذَكَرَ المحاور التي تندرج تحته.
وقد طبَّق هذا التقسيم على عِلْم التفسير في كتابه (تأسيس عِلْم التفسير).
ويُمكنني عرض وجهة نظري في طرح الدكتور من خلال النقاط الآتية:
أولًا: تعريف العلم ومعيار العِلْمية:
وَضَع الباحثُ تعريفًا محدّدًا للعلم، فعرَّفه بأنه قضية/ موضوع كلّي، وبيَّن أنه لا يعني بالقضية المراد بها في السياق المنطقي، وإنما الموضوع القابل لإنتاج حركة بحث هائلة، وفي ضوء ذلك رأَى أنّ معيار اعتبار العلمية هو كلّية القضية، وأنّ ما كان موضوعًا كليًّا هو الذي يصِحّ وصفه بالعِلْمِية، وأمّا الموضوعات الجزئية فلا يطلق عليها هذا الاصطلاح، وإنما تكون موضوعات بحث لا علومًا، ورأى أنّ هذا الطرح يضبط اصطلاح العلم، ويجعلنا نستعمله اصطلاحيًّا في مفهوم محدّد، وغير ذلك من المزايا التي أبداها[1].
وقد ناقش الباحثُ معايير العلمية في السياق الغربي والعربي التي منها ما شاع في علوم القرآن من إطلاق العِلْم على كلّ موضوع قابل للإفراد بالتأليف، وبَيَّن أنه ضابطٌ بالغ المرونة، وتتفاوت فيه الأنظار بدرجة كبيرة، ما يجعل من غير المتيسّر معه ضبط ما يكون عِلْمًا وما لا يكون من الموضوعات، وقد توسّع الباحثُ في كتابه (علوم القرآن؛ نقد العلمية ومقاربة في البناء) في تفصيل ذلك، وبيان الإشكالات المترتبة على إقامة عِلْمِيّة علوم القرآن في ضوء ذلك.
وتعريف العِلْم والمعيار الذي وضعه الدكتور خليل اليماني للعِلْمِية، أراه مُناسِبًا جدًّا أن يُفَعَّل في الساحة القرآنية وإقامة علوم القرآن عليه -مع عدم ظهور وجاهة ما طرحه من عدم تسمية الممارسات الجزئية عِلْمًا لا سيّما في غير علوم القرآن، وسيأتي ذِكْرُ هذا وبيانُه-، لا سيّما أنّ هذا الطرح مُسْتَلْهَم من علومنا التراثية، ويتوافق مع طبيعتها ومفاصلها العامة، وليس صادرًا عن العلوم الطبيعية كما هو شائع في فلسفة العلوم، وهذا لا يتناسب مع طبيعة علومنا الشرعية، وهذا الجانب في هذه الرؤية ممَّا يُحْمَد فيها، فمهما اختلفنا في بعض تفاصيل هذه الرؤية إلا أنه سيظلّ انطلاقها أصيلًا نابعًا من تراثنا ليس أجنبيًّا عنه، وهو استلهام طَرْحِه من نَسق عِلْم الفقه وأصوله.
كما أنّ طَرْحَه يقوم معه في الجُمْلة بناءٌ لهذه العلوم بطريقة صحيحة منهجية.
ثانيًا: التصنيف المقترح للعلوم:
رأَى الدكتور خليل اليماني أنّ العلوم من حيث هي تنشأ بالأساس لخدمة الممارسات، وأنها من حيث موقفها من هذه الممارسات يمكن تصنيفها وتقسيمها لقسمين:
الأول: علوم تقنِّن كيفيات مزاولة الممارسة في العِلْم.
الثاني: علوم تصنع الوعي بالواقع القائم للممارسات.
وفي كتابه (علوم القرآن؛ نقد العلمية ومقاربة في البناء)[2]، تكلَّم على كيفيات ذلك في إقامة علوم القرآن من خلال عددٍ من الخطوات، وبَيَّن أن هذا التصوّر من شأنه ضبط هذه العلوم بصورة معيارية دقيقة وتجاوُز مختلف الإشكالات التي رصدها قبلُ في مناقشته لعلوم القرآن، حيث أفاد أنّ هذا التصوّر الذي يقدِّمه يضبط تفريع العلوم القرآنية واتساعها المفرِط، ويهذِّب الدخيل عليها، وغير ذلك.
ومن خلال تأمُّل هذا الطرح ظهر لي أنّ عِلْم التفسير لم يلقَ بالفعل هذا الاعتناء الذي كان للفقه، واعتراه كفَنٍّ إشكالاتٌ وإهمالٌ لضبط مفاصله وأصوله، وهذا حاصل أيًّا كانت الأسباب.
ولـمَّا كان إدراك الأشياء والوقوف على حقائقها مما يشترك فيه العقلاء، وللحكيم فضل تبصُّر ومزيد تيقُّظ وتنبُّه؛ فإنّ هذه المقاربة التأسيسية لعِلْم التفسير وعلوم القرآن التي عرضها الدكتور في كتابَيْه، هي محاولة جادة مقبولة من وجهة نظري، للآتي:
1- اتخاذ علم الفقه وأصوله نسقًا معرفيًّا يستهدي بخُطاه، وهذا مقبول جدًّا؛ إِذْ أتمُّ العلوم نضجًا وخدمةً ووضوحًا ومعقوليةً وانضباطًا هو الفقه وأصوله، فهو صالح لِأَن يُنطلَق من نسقه المعرفي مع الاحتفاظ بالقطاعات الخاصّة لعِلْم التفسير.
2- أنّ تقسيمه للعلوم مقبول فيما يخصّ عِلْم التفسير؛ لأنه كما قُلنا يحتاج إلى هذا بالفعل، وأنّ انطلاقه كان انطلاقًا واقعيًّا؛ إِذ انطلق من المقصد الرئيس للتفسير، وهو إنتاج المعاني القرآنية، وكان تأسيسه المقترَح تابِعًا لهذا، ولا شك أنّ بناء أيّ عِلْم يكون بالنظر إلى مقصده وموضوعه الرئيس.
غير أنّ ما ذهب إليه من عدم تسمية ثمرة الممارسة عِلْمًا مشكِلٌ، وصحيحٌ أنّ الباحث يؤكّد على أهمية الممارسة وأنّ العلم يُقام أصلًا لخدمتها، بل وصنّف من أصناف العلوم «العلم المقنّن لمزاولة الممارسة»، يختصّ أحد محاوره بصناعة مَلَكة هذه الممارسة حتى لا تضمر في الواقع، إلا أنّ سَلْب صفة العلمية عن الممارسات يبقَى في نظري في غاية الإشكال؛ إِذْ ما يُسمِّيه ممارسة هو مقصودٌ تحصيله لذاته، وقد يكتفي المرء به دون تفريع فيه وفي مساراته البحثية؛ كالتجويد والنحو والفقه، إِذْ مجرّد معرفة المسائل فيها مقصودٌ في ذاته، وما وراء المسائل إنما يصلح للباحث فيه المتبحِّر، وليس كلّ الناس كذلك، ولا هو مطلوب منهم هذا، وليس في مقدورهم.
وكيف ننفي صفة العِلْمِيّة على كيان كامل تحته كمٌّ هائلٌ من المسائل الـمُبَوَّبة وَفق معايير وأنساق معرفية وعِلْمية، تحت كلّ باب مباحث ومطالب موضوعة وَفق معايير وأنساق عِلْمية ومعرفية، بل المسائل نفسها بينها صِلات وتعلُّق بعضها ببعض وَفق أنماط علمية رتَّبَها المصنِّفون وَفْقها.
فكيف ننفي العلمية عمَّا كان هذا شأنه؟! لا سيّما مع اتفاق كلّ أهل العلوم قاطبةً على تسميتها عِلْمًا، وما المصلحة من وراء مخالفة الاصطلاح هنا! والخوفُ من الاعتناء بها دون الأمور المنهجية المعيارية فيحصلُ خبط في الحراك داخل الفنّ، فهذا كما قلنا راجع إلى سوء التلقّي وسوء التعليم، على أننا نخاف أن ينقلب هذا على العكس، فيعتني الناسُ بالأمور المنهجية المعيارية دون هذه الممارسات، فتكون الانطلاقات نظريّة محضة فاقدة لروح الفنّ الكامن في هذه الممارسات؛ والمتلقون للعلم ما لم يؤخَذ على أيديهم، فيُنبَّهون دائمًا على ما هو من صُلْب العِلْم وما ليس من صُلْب العِلْم، فلن ينتبهوا إلى ذلك سواء وسَمْنَا الممارسات الجزئية بالعلم أو لا.
وعلى كلٍّ فإنّ هذا الاعتناء المنهجي لضبط عملية الممارسة لا يحتاج إلى سَلْب وصف العِلْمِية عن الممارسات نفسها، لِمَا بيَّنَّا.
وقد كان ابتداء انطلاق الدكتور خليل في هذا التقسيم من نقد تصنيف العلوم في التراث، فقد قَرَّر أنّ تصنيف أنواع العلوم في الطرح العربي الإسلامي فيه إشكالات منهجية، ويعتوره خَلَل يعوق دون إمكان الارتكاز عليه في النظر لأنواع العلوم، مما يؤثِّر بالسَّلْب على فَهم هذه العلوم وحُسْن التعاطي معها.
وهذا الذي قرَّره الدكتور من وجهة نظرنا لا يصحّ، لأمرين:
الأوَّل: أننا لا نرى ابتداءً أن هذا التقسيم كان المقصد منه وَضْع معيار منهجي للتمييز بين أنواع العلوم.
بل كان الغرض منها كما يُفهَم من تقريرات أصحاب هذه التقاسيم إنما هو التنبيه إلى جهات مُعَيَّنة يُمكِن أن يكون لها تأثيرٌ ما في تصوُّر العلم، بدليل أنّ الغزالي -كما نقل الدكتور خليل نفسُه- قَسَّمها إلى أكثر من تقسيم، ممَّا يدلّ على أن الأمر لا يعدو ما ذكرناه.
هذا إلى أنّ اعتراضات الدكتور خليل نفسها لهذه التقسيمات اعتراضات غير واردة، وليس من غرض التقرير تتبُّع النقاشات الجزئية، ولكن لا بأس من ذِكْر مثال واحدٍ:
ذكر الدكتور خليل أن تصنيف العلم إلى نقلي وعقلي مشكِل، ولا يبرز معه أثر فارق في طبيعة العلوم من حيث هي.
وهذا كما قلنا لم يكُن غرضهم من هذا التقسيم وغيره، بالإضافة إلى أن هذا التقسيم ذاته مؤثِّر من جهة إقدام المريدين على العلم وتحصيل شروطه.
ثُم ذكر الدكتور خليل أنّ هذا التقسيم مشكِل في ذاته؛ إِذ العلوم كلّها يهتدي الإنسانُ إليها بعقله وتفكيره، ولا فرق بينها في هذه الزاوية.
وهذا عَدَم وقوف على مُرادهم من وصف بعض العلوم بالعقلية؛ إِذْ لا يخفى عليهم أن كلّ العلوم لا بدّ فيها من إعمال العقل والتفكير، لكنهم يقصدون من وصفها بالعقلية أنّ مصدرَها وسبيلَ تحصيلها والنظرَ فيها العقلُ مجرَّدًا عن غيره، وقد ذكرنا أنّ هذا مؤثِّر في الإقدام على هذه العلوم وتصوّرها وتحصيل شروطها.
وكذلك فإنّ المتكلِّمين في خواصّ العلوم ومناهجها من المتكلِّمين والأصوليين لا يفتَؤُون على التنبيه على أنّ العلوم الإسلامية ليس بينها هذا الفصل التام، بل يحتاج بعضها إلى بعض، ويُبرهَن على مباحث بعضها في بعضها الآخر.
الأمر الثاني: أن المتكلِّمِين في ماهية العلوم وأنواعها وصنوفها كانوا مدرِكِين لحيثيات العلم وما هو من صُلْبه وما ليس من صُلْبه وما هو المؤثِّر في موضوعه وما ليس مؤثِّرًا، كلُّ هذا منثور في ثنايا كتبهم في سائر العلوم في إشارات وتنبيهات؛ إِذْ كانت على بالٍ منهم قائمةً في أذهانهم، ومِثل هذه الكليات المنهجية التي تُدْرَك بالاستقراء وحُسْن التأتي لكلام العلماء بعدَ النظر الطويل فيه إنما يذكرها العلماءُ في الغالب عند التنكُّب لها والغفلة عنها، فينتهضون لذِكْرها لهذا، وإلا فهي كامنة في نفوسهم، كما فعل ابن خروف الأندلسي مع ابن مضاء عندما طعن الأخير في الصناعة النحوية بسبب تزيُّد النحاة في عِلَل القواعد، فبيَّن له ابن خروف أنّ العِلَل النحوية ليست من صُلْب الصناعة وقواعدِها الرئيسة حتى يُزري بهم لذلك، وقرَّر ذلك ابن خروف في كتابه (تنزيه أئمة النحو ممَّا نُسِب إليهم من الخطأ والسَّهو).
فليست هذه الأمور ممَّا تُقرَّر مِثل مسائل العلم نفسها، وإنما هذه يُشار إليها وقت الحاجة إلى التنبيه عليها، لا سيّما أنه لا يُنبِّه عليها إلا أهلُ الاستقراء والنظر، وهذا شأن كثير من ضوابط النظر وتنبيهات أهل العلم على المنهجيات العامة المتعلِّقة بالتلقي والتأليف والتصنيف.
فأهل كلّ عِلْم كان عندهم تصوُّر كامل منضبِط واضح لمعالم عِلمهم وحيثياته وما هو مؤثِّر في موضوعه وما ليس كذلك، لكن هذا يحتاج إلى تتبُّع مصنَّفاتهم؛ إِذْ ليسوا جميعًا ينصُّون على مِثْل هذه الأشياء، ولا هي في مقدور جميعهم؛ لأنه يوقَف عليها بعد استقراء تام وحُسْن فَهْمٍ وتأتٍّ.
وإنما يدخُل الخَلل في مخالفة هذه الضوابط للشادِي غير الراسخ، فيكمُن الخطأ في تصوير العلوم من الدخيل أو غير الكامل فيها.
والدليل على ما قلناه أنّ الدكتور خليل نفْسَه في تصنيفه المقترح لأنواع العلوم ذَكَر أن تقسيمه هذا المقترَح استلهمه بالأصالة من تأمُّل النَّسَق المنهجي لعِلْمَي الفقه وأصوله، ويُعَلِّل ذلك بأنّ مباني العِلْمَيْن أنموذج معرفي ناضج يُمكِن بسطُه ليكون بناءً معياريًّا للعلوم ككلّ مع بعض التعديلات.
وهذا النَّسق العِلْمَي معمول به في سائر العلوم بما يتناسَب مع طبيعة كلّ عِلْم، لكن كما قلنا: النصّ على معالم هذا النّسق متناثر في كلام أهل كلّ صناعة، نَعَم قد يغفُل بعضهم عن بعضها، لكن لا تضيع بين أهل الصناعة، لكن يحتاج الوقوف عليها كما قلنا إلى تتبُّع واستقراء لمقالات أهل هذا العلم أو هذه الصناعة، وليس كلّ أحد يسهل عليه ذلك.
فالجلال السيوطي وهو يتكلَّم عن رُتبة الاجتهاد في العربية نَبَّه على هذا الأمر حين ذكر أنّ من شرطِ الاجتهاد الإحاطة بعِلْم أصول النحو وقواعد النحو الكلية الضابطة للأبواب، فقال في كتابه (التحدُّث بنعمة الله): «وهذا شيء دَرَسَ الآن فلا يعرفه إلا متبحِّرٌ في الفنِّ».
ثُم قال مثل ما قد ذهب إليه الدكتور خليل من استلهام نسق الفقه وأصوله فيما يتعلَّق بالنحو وأصوله: «وقد ألَّفْتُ كتابًا في أصول النحو التي هي بالنسبة إليه كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه، وكتابًا في قواعده كـ(قواعد الزركشي) في الفقه».
وسبب استلهام السيوطي لنسق الفقه وأصوله -وقد استلهمه قبله الأنباري- هو أنّ الفقه والنحو كلاهما معقولٌ من منقول، فالدلائل تُشْبِه الدلائل والتعليل يُشْبِه التعليل، لكن قطعًا ستبقى خصوصيات تفرضها طبيعة كلّ فنٍّ.
الشاهد أنّنا لا نرى أن المعوِّق لمسيرة العلوم هو واقع تصنيفها في الطرح التراثي، لكن السبب هو عدم رسوخ الناظر فيها المقرِّر لمباحثها وأصولها، الذي لا يستطيع التمييز بين حقائقها وعوارضها.
خاتمة:
قدَّمنا في هذه الورقة تقويمًا للرؤية التي قدَّمها الدكتور/ خليل محمود اليماني لإعادة بناء علوم القرآن، وأرَى في الختام أنّ هذه المقاربة -في وجهة نظري وحدود معرفتي غير ما نَبَّهتُ عليه- ليس فيها تعارُض مع أصول العلوم الكبرى، ولا منطلقات التأسيس للعلوم والصناعات.
إلا أنّ هناك جزئيات لا تعود بالإبطال على هذه المقاربة التأسيسية، وهي محاكمة بعض الأنساق التفسيرية لمعطيات هذه المقاربة دون ملاحظة مقاصد هذه الأنساق، مثل نسق التفسير اللغوي، فالناظر فيه لا يَرَى أنه يوصَف بالتناقض كما فعل الدكتور خليل.
ومثل هذه المحاكمات موجودة في مقاربة الدكتور خليل، وهي تحتاج إلى إعادة نظر، فعليه أن يُبيِّن أوَّلًا مقاصد انطلاقات هذه الأنساق من مدوّناتهم، ثُم يُحاكمها إلى هذه المقاصد، لا أن يُحاكمها إلى مقاربته ابتداءً.
بعض التوصيات:
هذه بعض التوصيات التي تتعلَّق بهذه المقاربة التي أرى أنها تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها:
1- إذا تمسَّك الدكتور خليل بما ذهب إليه من عدم وصف الممارسات الجزئية بالعلمية، فعليه أن يدعم -من وجهة نظرنا- هذه الرؤية بأدلّة أخرى غير التي ذَكَرها.
2- مناقشة أوضاع العلوم الأخرى وَفق هذه الرؤية والمقاربة، وهذا مهم جدًّا في نظري، ويعود -مهما كانت النتائج- على أوضاع العلوم بالنفع والإثراء.
3- تحتاج هذه المقاربة إلى تدعيمها بنصوص المتقدِّمين من علماء التراث ممَّن تكلّموا في العلوم وأنواعها وحيثياتها، سواء بالموافقة عليها أو المخالفة لها؛ إِذْ هي نصوص تأسيسية في هذا الحقل لا يصحّ إغفالها.


