مفهوم المفسِّر
نقد وتحرير
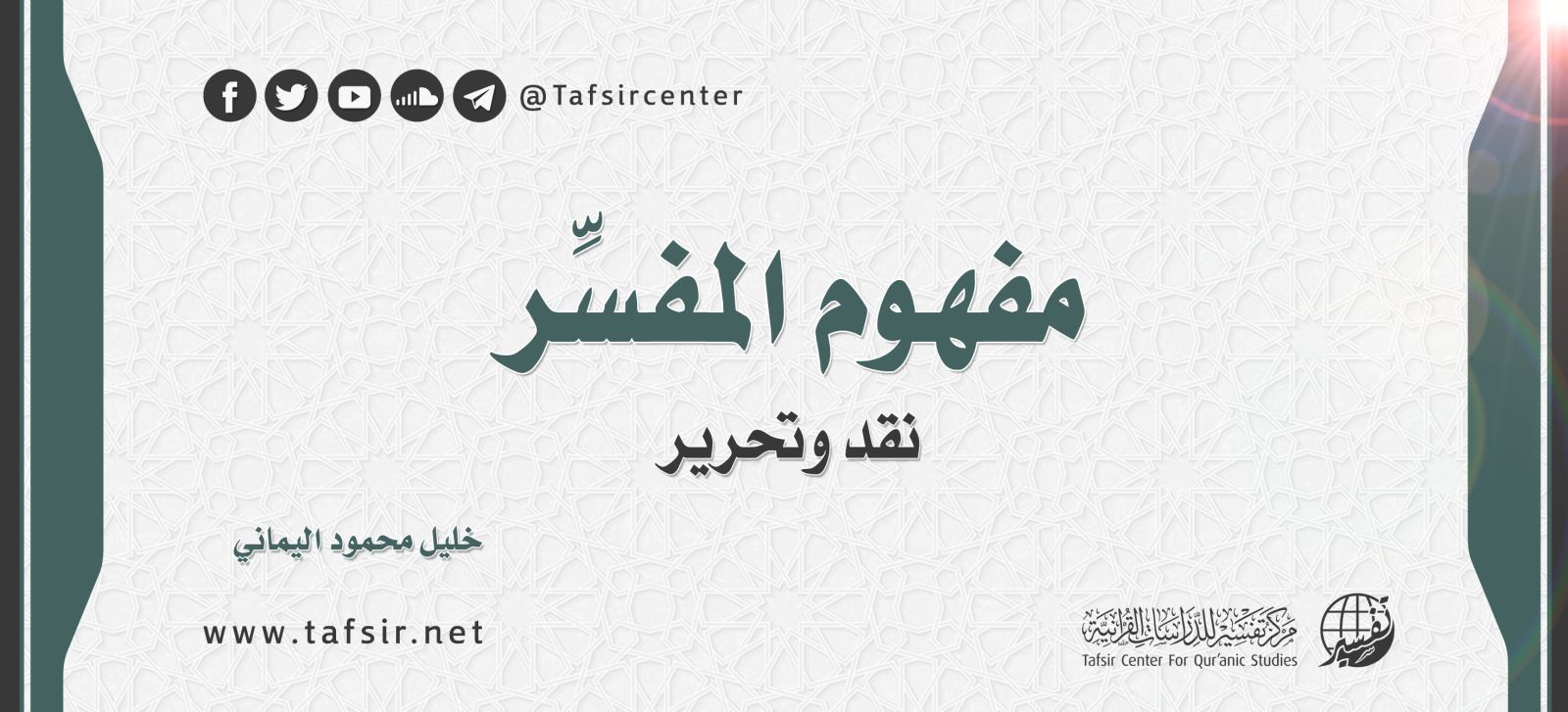
يُعَدّ ضبط مفهوم المفسِّر إحدى القضايا المهمّة التي لها انعكاس على تصوّرنا لطبيعة القائم بالتفسير وتحديده ومعرفة ملامح اشتغاله، وأيضًا تتّصل بالكتابات في طبقات المفسّرين ومن يدخل فيها ومن لا يدخل، وغير ذلك، وهذا المفهوم لم يحظَ بكبير عناية في ضبطه وتحديده في الدرس التراثي، كما أنّ المحاولات المعاصرة التي تجشَّمَت القيام بذلك قليلة ولا تخلو من إشكالات كما سنبيِّن.
في هذه المقالة سنحاول الإسهام بطرح مقاربة في تجلية هذا المفهوم وترسيم حدوده، وبيان صور الاشتغال التفسيري التي يتأهّل معها صاحبها لأنْ يكون في زمرة المفسِّرين وعِدادهم، وطَرْح تقسيم للمفسِّرين، وبيان عامّ لدرجاتهم بحسب مسالك اشتغالهم، وستنتظم المقالة في قسمين؛ أحدهما لنقاش ما هو قائم من محاولات ضبط مفهوم المفسِّر، والموقف من هذه المحاولات. والثاني لطرح ما لدينا من نظر تجاه هذا المفهوم[1].
القسم الأول: محاولات ضبط مفهوم المفسِّر وتحديده؛ قراءة نقدية:
الناظر في الدرس التفسيري التراثي يجد عدّة تعريفات تبيِّن لنا مفهوم التفسير وتحدُّه كما هو معلوم، في حين أننا إزاء اصطلاح المفسِّر لا نجد إلا إيرادًا مباشرًا للمفسِّرين كما في كتب طبقات المفسِّرين، كما نجد حديثًا على شروط المفسِّر وآدابه وما يجب عليه كما في مقدّمات بعض التفاسير وكتب علوم القرآن[2]، ومن ثَمّ فإننا لا نظفر بالفعل في الدرس التراثي -كما أشار بعض الدارسين[3]- بتعريف مباشر للمفسِّر، وإن كان ما ذُكِر في هذا الدرس لا سيما الوارد في كتب التراجم وطبقات المفسِّرين[4] يظلّ مفيدًا بصورة ظاهرة في تجلية حدود المفهوم عند هؤلاء الكتبة، ورؤيتهم لمن يدخل فيه ومن لا يدخل من خلال تتبّع أحوال المفسِّرين المثبَتين في هذه التآليف، كما سنبيِّن لاحقًا.
وقد تصدَّى بعضُ المعاصرين لطرح تعريفات للمفسِّر، فعرَّفه الدكتور/ مصطفى مسلم بأنه: «مَن وُجدت لديه أهلية الكشف والبيان عن معاني القرآن الكريم حسب الطاقة البشرية»[5]، وعرَّفه الدكتور/ حسين الحربي بأنه: «مَنْ له أهلية تامّة لمعرفة مراد الله تعالى بكلامه المتعبَّد بتلاوته، قدر الطاقة، وراضَ نفسَه على مناهج المفسِّرين، مع معرفته جُمَلًا كثيرة من تفسير كتاب الله، ومارَس التفسير عمليًّا بتعليمٍ أو تأليف»[6]، وبَيَّن أنه وضع القيد الأخير في تعريفه «ليدخل في مسمّى "المفسِّر" مَن عَرَف جُمَلًا من التفسير، ومارَسَه بالتعليم دون التأليف، وهم كثير من علماء الأمّة»[7].
وفضلًا عن أنّنا لا نظفر لدى أرباب هذه التعريفات بتأصيل ونقاش متوسّع، فإنّ تعريفاتهم تغفل صور اشتغالٍ تفسيريّ يتعذّر إخراجها من المفهوم؛ فمفهوم المفسِّر لا يمكن أبدًا قَصْره -كما في التعريف الأول- على مَنْ يتصدّى للكشف والبيان عن المعاني؛ إِذِ العمل التفسيري للمفسِّرين أوسع من ذلك بلا نزاع، ولا يمكننا أبدًا سلب أو نزع اصطلاح المفسِّر عن الجامِعِين للمعاني التفسيرية مثلًا كالثعلبي والماوردي وابن الجوزي، أو المختصِرين للمعاني كالإيجي وغيره، وكذلك يصعب أن لا نُدْخِل في المفهوم -كما في التعريف الثاني- مَن يتصدّون مثلًا لشرح التفاسير وتحشيتها كما سنشير.
إن الكتابات في مناهج المفسرين وإن كانت مظنة لتحرير مفهوم المفسر، إلا أن كثيرا منها لا يعالج هذا المفهوم أصلا ولا يهتم بتعريف المفسر، وبعضها يكتفي فقط بذكر تعريفات كالتي أوردنا قبل مع تعديل يسير في بعض العبارات[8]، وكذلك الحال مع كتاب (المفسر؛ شروطه، آدابه، مصادره: دراسة تأصيلية)[9]، حيث اكتفى بإيراد تعريفي مصطفى مسلم والحربي ولم يقدم معالجة تأصيلية للمفهوم.
إنّ المحاولة الأهمّ في السياق المعاصر للكلام في مفهوم المفسِّر هي التي تعنّاها الدكتور/ مساعد الطيار في كتابه: (مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبّر والمفسِّر)، حيث تعرّض لمفهوم المفسِّر بقدرٍ من التوسّع، فعرَّج على الكتابة في طبقات المفسِّرين، وذكرَ تقسيم السيوطي لأنواع المفسِّرين[10]، وبَيَّن أنّا إذا تابعنا السيوطي ومَن كتب بعده في طبقات المفسِّرين لقلنا بأنّ «المفسِّر: مَن كان له مشاركة في علم التفسير، أو كَتَبَ فيه»، وعلّق بأن هذا «سيكون من باب التسامح في المصطلح، دون التحرير له»[11]، وذكر أنّ «مَن كَتَبَ في طبقات المفسِّرين لم يكن قصده تعريف المفسِّر، بل كان قصده إيراد مَن له كتابة في التفسير، دون تحليل لنوع هذه الكتابة، من حيث كونها نقلًا أو اجتهادًا من المفسِّر»[12]، وأشار إلى أننا لا نكاد نجد ضابطًا في إيراد فلان من العلماء في عِداد المفسِّرين، وأنه من خلال سَبْر المفسِّرين المذكورين في كتب طبقات المفسِّرين، والاطلاع على منجزاتهم في التفسير، فإن المفسِّرين لا يخرجون عن أربعة أنواع:
النوع الأول: طبقة المجتهدين الأُوَل: وذكر أنهم مفسِّرو السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأنه كان لهؤلاء اجتهاد واضح في التفسير، وكانوا أصحاب آراء فيه.
النوع الثاني: نَقَلَة التفسير: وذكر أنهم جُملة من المحدِّثين وغيرهم، لم يكن لهم إلا النقل لتفسير من سبقهم، ولم يكن لهم فيه أيّ رأي واجتهاد أو نقد ونقاش لِمَا يروونه، وبَيَّن أن هؤلاء يمكن أن يُطْلَق عليهم (مشاركون في التفسير).
النوع الثالث: المفسِّر الناقد: وذكر أنه الذي يجمع مرويات المفسِّرين ويرجِّح بينها، وأنه: «صاحب رأي؛ لأنه يستعرض الأقوال المذكورة في الآية، ثم يختار منها ما يراه راجحًا، فاختياره قولًا من الأقوال دون غيره رأيٌ واجتهاد منه»[13].
النوع الرابع: المفسِّر المتخيّر قولًا واحدًا: وذكر أنه الذي يختار قولًا تفسيريًّا دون غيره ولا يتعرّض لِمَا سواه، وبَيَّن أنه بهذا التخيُّر «يوافق المفسِّرَ الناقدَ، غير أن المفسِّر الناقد يتميّز عنه بنقده الغالب لِمَا لا يختار»[14].
وبعد ذلك أورد تعريفَه للمفسِّر وأنه: «مَنْ كان له رأيٌ في التفسير، وكان متصديًا له»[15]، ثم قال: «فمَن انطبق عليه أحدهما خرج بذلك عن أن يكون مفسرًا بالمعنى المصطلح عليه للتفسير، وهو بيان معاني القرآن. فإن كان بعض المشاركين في التفسير لا رأي لهم؛ كناقلي التفسير الذين لا رأي لهم فيه، بل كان هَمّ أحدهم أن يجمع المرويات التي بلغته عن السلف =فإنهم لا يدخلون في عداد من يبيِّن كلام الله. وإن كان ممن يُقْرَأ عليه كتابٌ من كتب التفسير، وليس له عليه أيّ تعليق تفسيري =فإنه لا عمل له في التفسير، وليس من المفسِّرين ما دام هذا سبيله. وإن كان له آراء، لكنها قليلة =فإنه لا يدخل في هذا المصطلح»[16].
ومما يلاحظ على محاولة الدكتور/ مساعد: أنه في نَظَرِه للمفسِّرين وأنواعهم سقط منه المفسِّرون الجامِعون للتفسير وكذلك المشتغِلون بتعليم التفسير، فهذه صنوف قائمة بالفعل للمفسِّرين في كتب التراجم والطبقات.
يقول الدكتور حسين الحربي مبينًا أنه: «...كثيرًا ما يجد القارئُ في كتب التراجم وطبقات المفسِّرين مَنْ كان ينتصب لتدريس تفسير كتاب الله في المساجد والمدارس، ولم يُعرف عنه أنه ألَّف في التفسير كتابًا»[17].
لقد استدرك الدكتور مساعد بالفعل فأدخل في تعريفه مَنْ يشتغلون بتدريس التفسير، ففي كتابه: (التحرير في أصول التفسير)، عَرَّف المفسِّر بأنه المبيِّن لمعاني القرآن، ثم قال: «ويدخل في هذا: كلّ مَنْ كان له آراء في التفسير، وكان ممن تصدَّى له بالتأليف أو التدريس»[18].
كما يلاحظ أن الدكتور مساعد كأنه يحصر الاجتهاد في التفسير في المفسِّرين الأُوَل، في حين أنّ هذا الاجتهاد الذي قاموا به في توليد المعاني ليس قاصرًا عليهم عمليًّا؛ فهناك مفسِّرون قاموا به بعدهم بغضّ النظر عن الموقف من صنيعهم ومنهجهم وما أتوا به قبولًا أو ردًّا، ومن ثم فالأمر الاجتهادي في توليد المعنى لا مساغ لحصره في الأوائل وقصره عليهم.
وأيضًا فإنّ الدكتور مساعد يركّز في مفهومه على المشتغل بذات التفسير، وهو بذلك يجاوز صور اشتغالٍ تنشأ في رحاب الممارسات ولها أهميتها الشديدة؛ كالاشتغال الخاصّ بشرح التفاسير والتعليق عليها، فهذا اشتغال وإن لم يتصدَّ مباشرة للقول في التفسير نفسه، لكن مهم جدًّا، ويسهم في تقريب وتدويل المعرفة التفسيرية ونشرها وحُسن الاستفادة من مراجعها المركزية، كما أنّ القائم به صاحب مكنة ظاهرة في التفسير وكثير من تعليقاته هي رأي في التفسير في نهاية الأمر، ومن ثم لا يمكن إخراجه بحال من زُمْرة المفسِّرين في ضوء التعريف الذي ذكره الدكتور مساعد.
وكذلك، فإنّ بناء التعريف في نهاية الأمر على الرأي في التفسير والتصدي له فهذا مما ليس له حدود واضحة حتى يمكن النظر للموضوع من خلاله، وإلا فما هو قدر الرأي المطلوب والتصدّي اللازم حتى يكون القائم به ضِمْن عداد المفسِّرين؟
وأيضًا فإن الدكتور مساعد ذَكَر أنه لو تابع الكَتَبة في طبقات المفسِّرين لأدخل في مفهوم المفسِّر كلَّ مَن له مشاركة في علم التفسير، أو كَتَب فيه؛ وعلّل عدم متابعته لذلك بأن هذا سيكون من باب التسامح في الاصطلاح، وبَيَّن أنّ الكَتَبة في طبقات المفسِّرين لم يكن قصدهم تعريف المفسِّر، وإنما إيراد من له كتابة في التفسير، دون تحليل لنوع هذه الكتابة... إلخ، وهذا الذي ذكره مشكل، فمَن يكتب في طبقات المفسِّرين فإنه وإن لم يعرّف المفسِّر بصورة مباشرة، إلا أنّ مَن أَوْرَدَهُم من المفسِّرين فيه دلالة واضحة على رؤيته لمفهوم المفسِّر ومَنْ يدخل فيه ومَنْ لا يدخل؛ إِذْ هو يُورد رجالًا معيَّنِين تحت اصطلاح محدّد، ومن ثم فالكلام معه -حال أرَدْنَا- من المفترض أن يتّجه مباشرة في تصوّره للمفهوم الذي حرّرناه عنده[19]، وبيان سلبيات هذا التصوّر وتثوير الإشكالات عليه بصورة منهجية من خلال رؤيتنا للصحيح الواجب في المفهوم، وليس من باب عدم قصديته لتعريف المفسِّر... إلخ مما لا مدخل له أصلًا في مثل هذا النقاش المفهومي الذي يقوم به الدكتور مساعد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور نايف الزهراني تعرّض بإيجاز شديد لمفهوم المفسِّر، فتكلّم تحت عنوان: (التعريف بالمفسِّر) عن أن المتكلِّمين في معاني القرآن على ثلاثة أقسام[20]:
الأول: المفسِّر، وهو -بحسب د/ نايف- مَنْ مَلَكَ آلة التفسير «العلم بأدلّته ومناهج استعمالها»، وهو يرى أن هؤلاء (أهل التفسير) و(أهل التأويل) عند الإطلاق، ولا يدخل في اصطلاح المفسِّر غيرهم.
الثاني: المشارِك، وهو مَن مَلَك بعض آلة التفسير على التحقيق، ونزل عن ذلك القدر في الباقي، من غير فقْدِ شيء منها.
الثالث: المقلِّد، وهو مَن فقدَ آلة التفسير أو بعضها.
ومما يلاحظ إجمالًا على طرح د/ نايف أنه جعل مصطلح المفسِّر يُطلق على طائفة مخصوصة، والبقية من المفسِّرين لهم اصطلاحات أخرى (مشارِك - مقلِّد)، وبذلك لم يَعُد لرجال الممارسة التفسيرية اصطلاح عامّ يجمعهم كلّهم وبه نتحدث عنهم جميعًا، وهو مشكل كما سنبيِّن في القسم التالي.
وبهذا نكون قد أنهينا تعليقنا على ما هو قائم من محاولات ضبط مفهوم المفسِّر، لندلف لطرح ما لدينا فيه.
القسم الثاني: ضبط مفهوم المفسِّر؛ مقاربة مقترحة:
لقد تصدّى عمليًّا للقول في التفسير عددٌ كبيرٌ من المفسِّرين عبر التاريخ، ومن خلال نظرنا في مسالك عمل مَنْ يصحّ أن يُطلق عليه وصف المفسِّر، أمكننا مَيْز هذه المسالك لمسلكين رئيسين:
المسلك الأول: الاشتغال بالممارسة التفسيرية نفسها:
الممارسة التفسيرية هي مزاولة الفِعْلِ التفسيري نفسِه، والتشاغل بهذا الفعل ذاتِه، والمفسرون المنخرطون في هذا المسلك هم مَنْ يقومون بالتصدِّي المباشر لتعاطي الممارسة التفسيرية بأيّ مسلك من مسالك الاشتغال التفسيري التي هي:
• إنتاج التفسير[21]: الانشغال بتوليد المحتوى التفسيري نفسه.
• تحرير التفسير: الموازنة بين مضامين التفسير وبيان الراجح منها.
• جمع التفسير: جمع المضمون التفسيري وترتيبه.
• اختصار التفسير: اختصار المضمون التفسيري وتقريبه[22].
وهذا الانخراط في الممارسة التفسيرية قد يقوم به المفسِّر عبر:
- تأليفه لكتاب تفسير، حيث يقوم بكتابة هذا التفسير بنفسه بِغَضّ النظر أَكْمَلَه أم لم يكمله.
- قيامه بالتفسير بصورة شفوية، ثم يُنْقَل عنه هذا التفسير ويُجمَع لاحقًا، وهذا الجمع قد يقوم به صاحبُ التفسير نفسه، أو يقوم به غيره كما الحال مثلًا مع جُلِّ المفسِّرين من السلف وغيرهم ممن جُمِعَ تفسيرهم.
- كتابته للتفسير بصورة متفرّقة تُجْمَع لاحقًا؛ كمن يكتبون التفسير في مجلات وغيرها، ثم يُجمع تفسيرهم لاحقًا من خلالهم أو من خلال غيرهم.
المسلك الثاني: الاشتغال بالتفسير والتفاسير:
ويشمل هذا المسلك الصور الآتية:
• شرح التفاسير: أي الانشغال بالتعليق على التفاسير وتناولها بالتوضيح والبيان والاستدراك... إلخ.
• تعليم التفسير: أي الاشتغال التدريسي بالتفسير نفسه وتعليمه للطلاب والدارِسين.
• نقل التفسير: أي التشاغل بنقل مادة التفسير[23].
والرسم الآتي يبين لنا مسالك اشتغال مَنْ يُطْلق عليهم وصف المفسِّر:
إنّ المتأمّل في هذه المسالك والصور الداخلة تحتها يجد أن دخولها في مفهوم المفسِّر سائغ جدًّا ولا إشكال فيه[24]، فالتشاغل بالممارسة التفسيرية نفسها ظاهر جدًّا في وصف صاحبه بالمفسِّر، ولا غرو فهو اشتغال يراكم في الممارسة ذاتها وتنعكس فائدته عليها بصورة مباشرة، والقائم به من المفترض حيازته لعُدّةٍ معرفيّة خاصّة تمكِّنه من خوض عُباب الممارسة، وهو يُعتبر من أهم صور الاشتغال وأعلاها كما سنشير.
إنّ حضور ثمرة الممارسة وتجسّدها في تآليف يولِّد بطبيعة الحال مسالك أخرى من العمل إن لم تكن مزاولة للممارسة نفسها، لكنها تظلّ لصيقة جدًّا بها، ولها فائدة مهمّة في شأنها، ويعدّ صاحبها ضِمْن رجال الممارسة، وهو ما نلحظه في بقية الصور التي مرّت بنا، فالانشغال بشرح التفاسير مَطْلَب مهمّ في رحاب الممارسة، وتقريب تآليفها المركزية والمحورية، والمشتغل به يحتاج عُدّة معرفية هائلة تُقارِب ما لدى المفسِّرين المتشاغلين بالممارسة التفسيرية نفسها وقد تزيد على بعضهم أحيانًا؛ لذا فالقائم بذلك لا يمكن إخراجه أبدًا من عِداد المفسِّرين.
وما ذكرناه مع شرّاح التفاسير نقول مثله مع مَشْغَل تعليم التفسير وتدريسه، فهو مَشْغَل مهمّ جدًّا يسهم في تذليل التفسير لطالبيه، والقائم به يحتاج لعُدّة معرفية متميزة في التفسير حتى ينهض به، ومثل هذا يتعذّر إخراجه من دائرة المفسِّرين.
وأمّا نَقَلَة التفسير فصحيح أنهم الحلقة الأضعف، وأكثر من يُظَنُّ خروجهم عن مفهوم المفسِّر، لكن نَقَلَة المعرفة يظلّون من أهلها، فنَقَلَة التفسير أهل معرفة بالتفسير، واشتغالهم يُعِين على إيصال المادة التفسيرية لغيرهم بشكلٍ أو بآخر، ويسهم في تدويلها، فهم مشاركون حتمًا في العمل التفسيري كما ذكر الدكتور مساعد فيما سلف، والمشاركون لا يمكن إخراجهم من دائرة المفسِّرين، ولكن فقط تكون درجتهم ليست كغيرهم.
وفي ضوء ما ذكرنا من صور يمكننا صياغة تعريف للمفسِّر كالآتي:
المفسِّر هو: المشتغل بممارسة التفسير، أو شرح مؤلَّفاته، أو تدريسه، أو نقله.
والمشتغل بممارسة التفسير هو المتصدي عمليا لمزاولة هذه الممارسة بالإنتاج للتفسير أو تحريره أو جمعه أو اختصاره، وأما بقية مكونات التعريف وعناصره فظاهرة، وعليه فمفهوم المفسِّر إذًا يشمل تفصيلًا ما يلي:
أ- القائم بإنتاج المادة التفسيرية وتوليدها.
ب- القائم بالموازنة بين المادة التفسيرية، وبيان صحيحها مِن ضعيفها.
ج- الجامع لمادة التفسير.
د- المختصِر لمادة التفسير.
هـ- الشارح لأحد التفاسير.
و- معلِّم التفسير.
ز- ناقل التفسير.
والرسم الآتي يبيِّن لنا من يصح أن يطلق عليه اصطلاح المفسِّر:
وتجدر الإشارة هاهنا لأمور:
الأول: لم ندرج في مفهوم المفسِّر مَنْ يكتبون حول التفسير وقضاياه، ولا مَنْ يكتبون في أصول التفسير وقواعده؛ إِذْ هؤلاء لا يزاوِلون عمليًّا في كتاباتهم الممارسةَ التفسيرية أو ما يرتبط بها كشرح مؤلَّفات التفسير وغيره، وإنما لهم اشتغال مغاير؛ فالأوّلون يدرسون المسائل المتعلّقة بالتفسير وبمؤلّفاته وبممارسته في بحوث ودراسات تقوم على إشكالات معينة، فهم باحثون في التفسير وليسوا مفسِّرين، والآخرون أصوليّون ومنظِّرون للتفسير، يتأمّلون الممارسة التفسيرية في الواقع التطبيقي حتى ينظِّروا ويقعِّدوا لكيفيات مزاولتها، ولا يمنع بطبيعة الحال أن يكون الباحثُ في التفسير أو الأصولي المنظِّر له لديه تأهيل يسمح له بأن يكون ضِمْن المفسِّرين، ولكن حديثنا عن عدم استحقاقه لوصف المفسِّر في ضوء طبيعة عمله الذي لا ينخرط في صور الاشتغال التفسيري التي ذكرنا.
الثاني: الكتابات التي تعرض لشروط المفسِّر وما يجب عليه تُورِد شروطًا وعلومًا عديدة، فيتكلّمون على أهمية حيازة المفسِّر لمعارف من اللغة والنحو والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع والقراءات وأصول الدين والفقه وأصول الفقه وعلم أحوال البشر، وغير ذلك مما يتّجه مع المفسِّرين المشتغلين بالممارسة التفسيرية، خاصّة من يقومون بالإنتاج أو الموازنة، وبِغَضّ النظر عن تحرير قصد هؤلاء الكَتَبَة بمفهوم المفسِّر، وأنهم ربما يتكلمون فحسب على الرُّتْبَة الأعلى في المفسِّرين لا غير، إلا أننا في ضوء ما ذكرنا من مفهوم المفسِّر، فإنّنا لا نزال بحاجة لجهد نظري مطوَّل في بيان الشروط الخاصّة بالصور الداخلة في المفهوم مما ذكرنا؛ حتى تنضبط هذه الصورة وتتضح حدودها بدرجة مدقّقة، وصَكّ الاصطلاحات التي تعبّر عن درجات المفسِّرين داخل المسلك الواحد؛ فالمفسِّرون في المسلك الواحد كإنتاج التفسير أو الموازنة بين مادته أو نقله... إلخ، متفاوتون في اشتغالهم؛ فابن عباس مثلًا الذي وردتْ عنه آلاف المرويّات التفسيرية ليس كغيره ممّن وردتْ عنهم عدة مئات من المرويات التفسيرية كابن مسعود وعليّ بن أبي طالب، ومَن له مئات من الروايات التفسيرية ليس كمن رُويت عنه أقوال دون المائة[25]، والمفسِّر الموازن الذي يتصدّى للموازنة في كلّ موضع ويستعرض الأقوال ويناقشها ويبدي مسوّغاته في النقد والترجيح ليس كمن لا يلتزم ذلك في كلّ المواضع، والذي يجمع ويتصدّى للتبويب ليس كمن يحشد الأقوال فقط، وهكذا؛ لذا نحتاج لاصطلاحاتٍ واصفة تعبِّر عن هذا التفاوت بينهم في المسلك الواحد، وأُسُسٍ عملية من داخل المسلك نبني عليها وضع هذه الاصطلاحات.
وكذلك نحتاج لجهد نظري في ضبط حزمة العلوم والمعارف التي يحتاجها كلُّ قسم، وما يجب عليه حتى يحسن النهوض بعمله، وغير ذلك، مما يجعلنا أمام ثروة نظرية تُعِين على تخليق هؤلاء المفسِّرين بصورة فاعلة، فكلّ جهودهم مطلوبة في الواقع العملي، وكذلك إعانتهم بالتنظير الذي يساعدهم على ضبط اشتغالهم التطبيقي، وهذا الباب من البحث نَرَى -حتى يحمى فيه البحث ويشتدّ- أن يكون ضِمْن علم أصول التفسير في المحور الثالث من هذا العلم والمختصّ بضبط مَلَكة الممارسة التفسيرية، وأمّا الحديث عن مفهوم التفسير فيناسبه أن يكون في المحور الأول من هذا العلم الذي يختصّ بضبط الممارسة التفسيرية وما يتصل بها، وذلك وفق رؤيتنا التأسيسية التي قدّمناها لعلم أصول التفسير والعلوم التي تقنِّن مزاولة الممارسات كهذا العلم وطبيعة المحاور الخاصّة بها[26].
الثالث: يشمل مفهوم المفسِّر صورَ اشتغالٍ تفسيري متعدّدة ومختلفة ومتفاوتة في طبيعتها وأهميتها، ويظلّ دخولها كلّها في المفهوم هو الأظهر عقلًا لما قدمنا، وكذلك رعايةً لأن يكون عندنا اصطلاح عام (المفسِّر) يعبر عن كلّ رجال الصناعة التفسيرية، وهذا هو المفترض في رجال الصناعات عمومًا وأن ينضووا جميعًا تحت اصطلاح صناعتهم، وأمّا بيان ما بين هؤلاء الرجال من اختلاف ورُتَب في مسالك عملهم؛ فهذا غرض بالغ الأهمية في إبرازه كذلك لإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، لكن لا يكون بإخراج بعض رجال الصناعة من الاصطلاح العام للصناعة وقصر هذا الاصطلاح على طائفة مخصوصة منهم كما فعل البعض، فهذا مشكل؛ لِمَا أسلفنا، ولكننا نبقيهم تحت الاصطلاح العام، ونحصّل الغرض الذي ذكرنا من خلال تقسيم المفسِّرين أنفسهم بعد ذلك لأقسام تبيّن طبيعة تَمَوْضِعهم في العمل التفسيري، بحيث يكون لكلّ طائفة تحت الاصطلاح العام اصطلاح آخر يعبّر عنها مباشرة بحسب طبيعة مسلكها ويكون عَلَمًا عليها، وكذلك من خلال بيان رُتَب هؤلاء المفسِّرين في ضوء مسالك اشتغالهم، وهو ما سنقوم به في السطور التالية.
أقسام المفسِّرين:
هناك اختلاف ظاهر في طبيعة مسالك عمل المفسِّرين، ويمكن قسمة هؤلاء المفسِّرين بحسب هذا الاختلاف إلى قسمين:
- مفسِّرين ممارسِين: وهم المنخرِطون عمليًّا في الممارسة التفسيرية؛ إنتاجًا لثمرتها، وموازنةً بين محصول هذه الثمرة، وجمعًا لها أو اختصارًا.
- مفسِّرين مشارِكين: وهم شرّاح التفاسير، ومعلمو التفسير، ونقَلَة التفسير.
إنّ المفسِّرين الممارسين تأتي تسميتهم بهذه الصورة وبهذا الاصطلاح باعتبارهم تصدّوا لخوض عُباب الممارسة نفسها، وقاموا بمزاولتها عمليًّا؛ لذا أُطلق عليهم ما يشير لاشتغالهم بالممارسة ذاتها، فهم مفسِّرون ممارسون يتركون لنا إرثًا تفسيريًّا مباشرًا في أيّ مسلك من المسالك التي ذكرنا، أو يجمع الواحد منهم أكثر من مسلك؛ كأن يوازن ويذكر معاني جديدة، وهكذا، فيصنّف في المسلك الغالب عليه ويكون مشاركًا وصاحب جهد في المسلك الآخر، ويمكن البحث عن اصطلاحاتٍ تعبّر عن هذه الجهود وأُسسٍ تقنِّن معايير الانخراط في كلّ واحدة منها، فهذا مهم لبناء الطبقات العلمية لهؤلاء المفسِّرين كما بينّا في غير هذا الموضع[27].
وأمّا بقية المفسِّرين فجهودهم وإن كانت حافّة بالممارسة ومرتبطة بها إلا أنها لا ينتج عنها تفاسير تزاول الفعل التفسيري نفسه وفق المسالك التي عند المفسِّرين الممارسين؛ لذا فهي جهود مهما تنوّعت فغايتها أن تكون مُسهِمَة في التفسير من جانب معيّن له إفادته ولكنه ليس مزاولة للممارسة التفسيرية ذاتها، ومن ثم فهم مشاركون في التفسير.
والرسم الآتي يبين لنا أقسام المفسِّرين:
مراتب المفسِّرين:
إنّ الناظر لصور الاشتغال التفسيري التي يحملها مفهوم المفسِّر يجد أنها وإن كان لكلّ منها فائدة وأهمية، إلا أنّ أهمها بطبيعة الحال التصدِّي لممارسة التفسير نفسها، فهذا ينتج عنه دفعٌ للممارسة نفسها إلى الأمام وإذكاءٌ لثمرتها وتنميةٌ لها، ومن ثم فالمفسِّرون المشتغلون بالعمل التفسيري نفسِه هم أرفعُ المفسِّرين درجةً على الإطلاق[28]، وأقلّ صور الاشتغال التفسيري أهميةً في قسم المشاركين في التفسير هم نَقَلَة التفسير كما هو بَيِّن.
وإنّ المفسِّرين الممارِسين وإن كانوا أرفع المفسِّرين رتبةً، فإنهم يتفاوتون كذلك في أهمية اشتغالهم، فما يتعلّق من صور اشتغالهم بإنتاج المعاني التفسيرية فهو أعلاها أهميةً وأكثرها أولويّة؛ فإنتاج معانٍ تفسيرية جديدة هو تكثيرٌ للمادة المركزية التي تكون أساسًا للاشتغال في بقية الصور ضمن هذا القسم؛ فوجود معانٍ تفسيرية منتَجَة هو الأساس الذي يبرِّر -من ناحية- حضورَ بقية الصور والعمل فيها؛ مِن جَمْعِ مادة التفسير والموازنة بينها واختصارها وتقريبها، ويُبْقِي كذلك -من ناحية أخرى- حالة البحث فيها حيّة وبحاجة لمتابعة العمل والمراكمة، فمتابعة الإنتاج للمعاني في الممارسة التفسيرية يجعل مسارات الجمع والموازنة... إلخ تظلّ باستمرار في تجدّد، والكتابات تعمل فيها لِتُلاحِق جديد المادة التفسيرية المنتَجة.
ويلي مَشْغَلَ إنتاج التفسير في الأهمية في ممارسة التفسير مَشْغَلُ الموازنة بين المادة التفسيرية؛ فبيان صحيح هذه المادة وضعيفها هو الأساس في تحرير تَرِكَة التفسير فهمًا لهذه التَّرِكة وتوجيهًا، ومَيْزًا للراجح منها من المرجوح، ومعرفة الصحيح من السقيم، وتقديم الحِجَاج العلمي اللازم لذلك، وبدون هذا العمل تبقى المادة التفسيرية مركومة لا يُعرف لها صحيح من فاسد، ومن هاهنا كان لهذه الصورة أهمية كبيرة جدًّا في الاشتغال التفسيري في الممارسة التفسيرية تكاد تجعلها مساوية لسابقتها، وإلا فالموازن حتى يحسن عمله فإنه يستوعب المادة التفسيرية المنتجة ويرتّبها وينظر دلائل تأسيسها، ثم يصوغ المسوغات العِلْمِية التي تبرز وجاهة قولٍ دون غيره، وغير ذلك من الجهود.
ويأتي بعد ذلك مَشْغَل جمع مادة التفسير؛ لأهمية ذلك في حِفْظ مادة التفسير وترتيب تَرِكَته، وهو أمر بالغ الأهمية في خدمة التفسير، وتيسير الإحاطة به، والتعرّف عليه والموازنة بينه وحفظه واستظهاره والمراكمة عليه... إلى آخر تلكم الأغراض المهمّة.
ويحلّ أخيرًا مشغل اختصار التفسير؛ لكونه مشغلًا عمليًّا ليس له أثر مباشر على ذات التفسير، وإنما ترجع إفادته في مزيد من التيسير والتقريب للمادة والعمل على تَدْوِيلها وتعليمها، وغير ذلك من الأغراض المفيدة في خَلْق حالة الاهتمام بالتفسير والوعي به.
والرسم الآتي يبيِّن مراتب المفسِّرين الممارسين:
تنبيه:
- لم تنضبط الممارسة التفسيرية عبر التاريخ بقضية وموضوع محدّد كما شرحناه مفصلًا في سياقات أخرى[29]؛ فهناك الاهتمام ببيان المعاني، وهناك الاهتمام بالمعاني وما فوق المعاني، وهناك الاهتمام بما فوق المعاني[30]، وكلّ هذا أنتَجَ لنا ثمارًا مختلفة للعمل التفسيري نسميها كلّها تفسيرًا، فهناك المعاني والأحكام والهدايات... إلخ، وَجَعَلَ المفسِّر ليس له تشاغل بثمرة محدّدة يعمل عليها، وهذا الحال مشكل جدًّا كما بينّا في غير هذا الموضع، وذكرنا أنه ينبغي مناقشة وضعية الممارسة التفسيرية بصورة جذرية والبتّ فيها، الأمر الذي سيَطال حتمًا اصطلاح هذه الممارسة نفسه ومن ثم اصطلاح القائم بها.
وعلى كلّ حال، فما قدّمناه في مفهوم المفسِّر يُعِين على ضبط هذا المفهوم بصورة طيّبة -بحسب رأينا- أيًّا كانت طبيعة الموضوع الذي ستختصّ به ممارسة التفسير لاحقًا، فحَال صارت ممارسة التفسير مختصة بتبيين المعنى المراد مثلًا، وصارت تأويلية لا تفسيرية كما رجحناه في غير هذا الموضع[31]، وصار القائم بها مؤوِّلًا لا مفسِّرًا؛ فإنّ المفهوم سيبقى كما هو وستبقى مكوناته كما هي، ولن نحتاج إلا لتغيير اسم القائم بالعمل فقط لا أكثر، ومسمّى الثمرة.
خاتمة:
عالجنا في هذه المقالة مفهوم المفسِّر، وقُمْنَا باستعراض المحصول القائم في سياق ضبط مفهوم المفسِّر، ونقاشه، وبيان بعض المآخذ عليه، ثم قدّمنا محاولة لضبط مفهوم المفسِّر، فبينَّا صور الاشتغال التفسيري التي يصحّ إطلاق اصطلاح المفسِّر عليها، وطَرَحْنَا تعريفًا للمفسِّر في ضوئها، وتقسيمًا للمفسِّرين بحسب مسالك اشتغالهم التفسيري في التفسير، وتوضيحًا لمراتبهم، ونرجو أن تكون هذه مقاربة مفيدة في النظر لمفهوم المفسِّر ومفيدة في تحريره، واللهُ الموفِّق.
[1] تكلمنا قبلُ في أحد بحوثنا على المفسِّرين وبينَّا طبقاتهم العلمية، وكنّا في ذلك مقيّدين بمن لهم تفاسير. (يراجع: بناء الرُّتب العلمية للمفسِّرين؛ الأهمية والآفاق، مع طرح تصوّر تأسيسي للسَّيْر في دراسة الرّتب العلمية للمفسرين- ضمن كتابنا: تأسيس علم التفسير؛ مقاربة تأسيسية مقترحة، مركز نماء، 2024، ص233 وما بعدها)، وفي هذه المقالة سننظر لمفهوم المفسِّر نظرة أعمّ، تحاول تحديد هذا المفهوم وتبيّن مكوّناته من حيث هي، وذلك بمعزل عن الجدل الخاص بالراجح في موضوع الممارسة التفسيرية ومفهوم التفسير مما حررناه في مواضع أخرى.
وأوجّه شكري الجزيل للصديق الفاضل/ محمد مصطفى عبد المجيد الذي طالع مسودة هذه المقالة، وأفادني ببعض الاقتراحات والتنبيهات التي أسهمت في تجويد وإثراء المقالة، ويبقى بالطبع كلّ خطأ وإشكال في المقالة من مسؤولية المؤلِّف وحده.
[2] يراجع مثلًا:
1) البرهان في علوم القرآن، الزركشي، مصطفى عبد القادر عطا، دار الفكر- بيروت، ط: الثانية، 1429هـ-1430 = 2009م، (2/ 170) وما بعدها.
2) الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ت: محمود مرسي- محمد عوض، دار السلام، ط: الثالثة، 1434هـ = 2013م، (2/ 963) وما بعدها.
[3] يراجع: قواعد الترجيح عند المفسِّرين؛ دراسة نظرية تطبيقية، حسين الحربي، دار القاسم، ط: الأولى، 1417هـ = 1996م، ص33.
[4] تكلّمنا على كتب طبقات المفسِّرين وقدّمنا نقدًا لهذا المسار، يراجع: بناء الرُّتَب العلمية للمفسِّرين؛ الأهمية والآفاق، مع طرح تصور تأسيسي للسير في دراسة الرُّتَب العلمية للمفسِّرين- ضمن كتابنا: تأسيس علم التفسير؛ مقاربة تأسيسية مقترحة، ص252- 253.
[5] مناهج المفسرين، مصطفى مسلم، دار المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الأولى، 1415هـ، ص15.
[6] قواعد الترجيح عند المفسِّرين؛ دراسة نظرية تطبيقية، حسين الحربي، ص33.
[7] قواعد الترجيح عند المفسِّرين؛ دراسة نظرية تطبيقية، حسين الحربي، ص33- 34.
[8] يراجع: التأليف المعاصر في مناهج المفسرين؛ دراسة وصفية تقويمية، ضيف الله بن عبد المحسن التميمي، مركز تفسير، 1446ه-2025م، (ص: 228) وما بعدها.
[9] يراجع: المفسر؛ شروطه، آدابه، مصادره: دراسة تأصيلية، أحمد قشيري سهيل، مكتبة الرشد، 1429ه-2008م، (ص: 71-72).
[10] قسّم السيوطي المفسِّرين إلى أربعة أنواع: النوع الأول: المفسِّرون من السلف: الصحابة، والتابعون، وأتباع التابعين. النوع الثاني: المفسرون من المحدِّثين، وهم الذين صنّفوا التفاسير مسندة مُورِدِين فيها أقوال الصحابة والتابعين بالإسناد. النوع الثالث: بقية المفسِّرين من علماء السُّنَّة، الذين ضموا إلى التفسير التأويل والكلام على معاني القرآن وأحكامه وإعرابه وغير ذلك. النوع الرابع: مَن صنَّف تفسيرًا من المبتدعة؛ كالمعتزلة والشيعة وأضرابهم. ويلاحظ هاهنا أن تقسيم السيوطي للمفسِّرِين ليس له معايير منهجية منضبطة في بنائه؛ ففي جانب منه يقسم المفسِّرِين بحسب الانتماء لشريحةٍ ما؛ فمفسّرون من طبقة السَّلَف، ومفسِّرون من المحدِّثين، وفي جانب آخر يقوم على النظر للجانب العقدي؛ فيقسم المفسِّرِين لمفسِّرِين من أهل السنّة والجماعة ومفسِّرِين من الفِرَق المبتدعة.
[11] مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسّر، مساعد الطيار، دار ابن الجوزي، 1423هـ = 2002م، ص208.
[12] مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسّر، مساعد الطيار، ص209.
[13] مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مساعد الطيار، ص214.
[14] مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مساعد الطيار، ص214.
[15] مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مساعد الطيار، ص215.
[16] مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مساعد الطيار، ص216.
[17] قواعد الترجيح عند المفسرين؛ دراسة نظرية تطبيقية، حسين الحربي، ص34.
[18] التحرير في أصول التفسير، مساعد الطيار، مركز الدراسات والمعلومات بمعهد الإمام الشاطبي، ط: الأولى، 1435هـ = 2014م، ص16.
[19] وهذا التحرير لمفهوم المفسِّر عند الكتبة في الطبقات من الأمور التي تحتاج لدراسات تحليلية موسّعة، تستجلي مكوّنات هذا المفهوم من خلال تتبّع المفسِّرين المُدْرَجِين في هذه التآليف، حتى نؤسّس أحكامنا ونقاشاتنا لهذه التآليف بصورة منهجية منضبطة.
[20] يراجع: متن الدليل في علم التفسير، نايف الزهراني، برعاية: مفسّر ومناهل العلم، 1445هـ = 2024م، ص16- 17. وقد ذكر الدكتور/ نايف ذلك النظر قبلُ في بحثه: (صناعة الدليل في علم التفسير)، نايف الزهراني، ضمن كتاب: صناعة التفكير في علم التفسير، تحرير: نايف الزهراني، تكوين للدراسات والأبحاث، ط: الثانية، 1443هـ = 2020م، ص24- 25.
[21] حديثنا عن العمل الإنتاجي للتفسير الغرض منه تحديد طبيعة المسلك التفسيري الذي يرتبط بتوليد التفسير بصورة واضحة، وهذا لا صِلَة له بطبيعة الحال بالجدل الهرمنيوطيقي الفلسفي الحديث، وأنّ النصّ بلا معنى محدّد ومعيّن، وأن المفسِّر هو من يُنْتِج المعنى بحسب مسبّقاته وقَبْلياته ويلقيه على النصّ، ولكن المعنى معين وحاضر في النصّ، والمفسِّر بفعله الإنتاجي يقوم ببيانه والكشف عنه.
[22] غنيّ عن البيان هنا أننا نتحدث في التصدي لاختصار التفسير نفسه، وكذا قبله جمع التفسير، وذلك بخلاف التصدِّي لجمع الأقوال التفسيرية لمفسِّر ما أو بعض المفسِّرين، أو القيام باختصار أحد التفاسير، فهذا ليس مزاولة للفعل التفسيري، وصاحبه ليس في عِداد المفسِّرين.
[23] في ضوء عدم انضباط موضوع الممارسة التفسيرية كما سنشير، فليس هناك ثمرة محددة للتفسير، وأهم ثمرة للعمل التفسيري هي المعنى الذي هو الصُّلْب والعَصَب في مكونات التفسير جميعًا. (راجع: معيار تقويم أهمية كتب التفسير في التفسير؛ تحرير وتأصيل- ضمن كتابنا: تأسيس علم التفسير؛ مقاربة تأسيسية مقترحة، ص181 وما بعدها)، وعليه فبعض المفسِّرين ممن لا يقتصرون على المعنى قد يكون ناقلًا للمعنى لكنه صاحب اجتهاد ورأي في جانب آخر من مكونات التفسير؛ كالأحكام والهدايات... إلخ.
[24] كلامنا سيكون تجريديًّا لبيان الوجاهة العقلية لاندراج ذات المسالك والصور تحتها في مفهوم المفسّر، وإن بقيت هذه المسالك والصور بحاجة بعد ذلك -كما سنشير- لمحددات تبيّن درجات المفسِّرين بداخلها واصطلاحات تعبّر عن هذه الدرجات.
[25] يراجع: تفسير الصحابة؛ إحصاؤه - أهم ملامحه المنهجية - طبقات رجاله - واقع الدراسات حوله، تقرير منشور على مرصد تفسير.
[26] يراجع:
- علوم القرآن؛ نقد العلمية ومقاربة في البناء.
- تصنيف أنواع العلوم، قراءة في المنجز، وتصنيف معياري مقترح، خليل محمود اليماني، بحث منشور على موقع نماء.
[27] يراجع: بناء الرُّتَب العلمية للمفسِّرين؛ الأهمية والآفاق، مع طرح تصوّر تأسيسي للسّيْر في دراسة الرُّتَب العلمية للمفسِّرين- ضمن كتابنا: تأسيس علم التفسير، ص252- 253.
[28] التفضيل هنا لبيان الرُّتبة الأعلى لصور الاشتغال من حيث هي، وأمّا الاشتغال العملي الواقعي للمفسِّرين فتترتب أولوياته ودرجات أهميته بحسب عوامل وسياقات عديدة.






