مداخل معرفية ومنهجية لتحقيق مبدأ الوظيفية في تدريس علم التفسير بالتعليم الجامعي
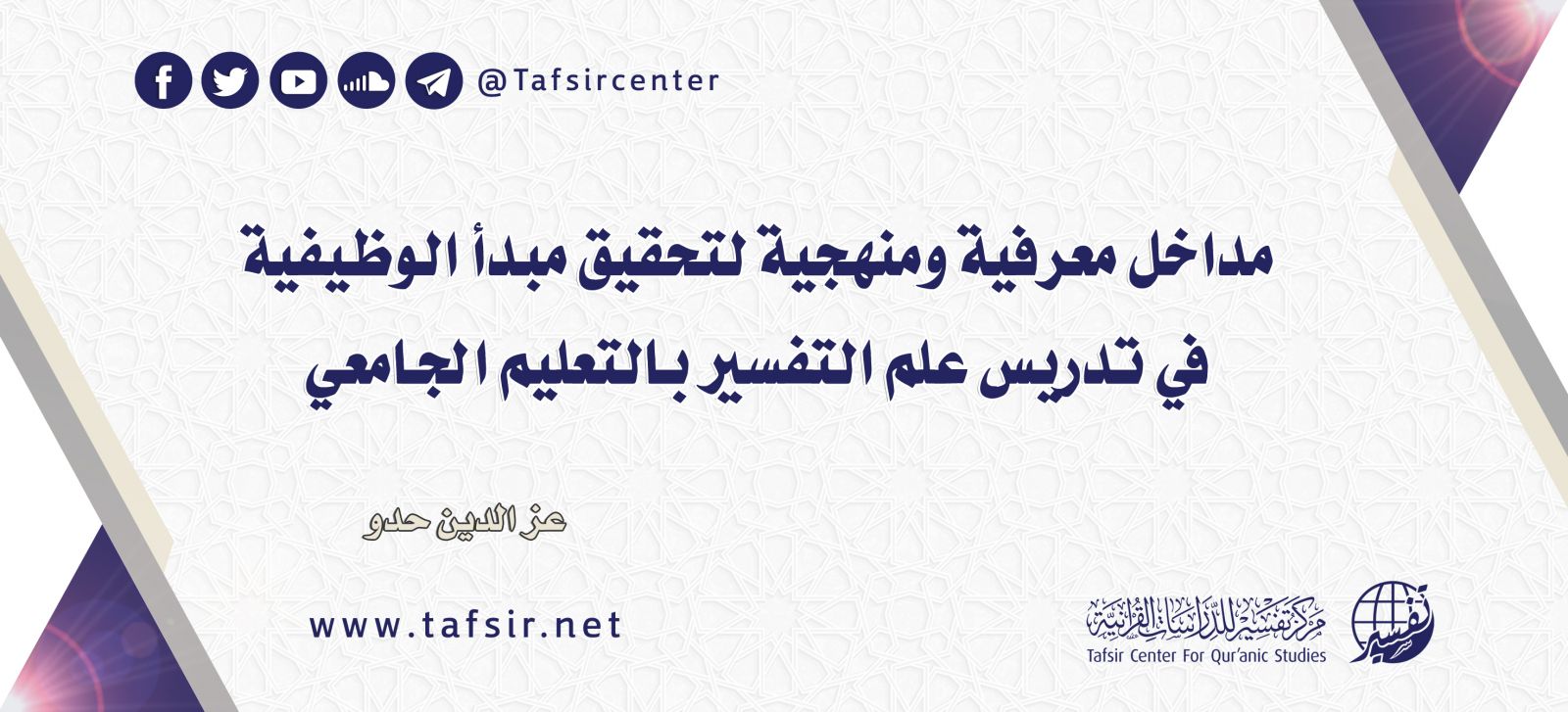
مقدمة[1]:
إنّ الحديثَ عن وظيفية العلوم الشرعية وتفاعلها مع قضايا المجتمع، معيارٌ مهم في تقويم هذه العلوم وغيرها؛ لكونه يُعنى بالنظر في المخرجات المعرفية والعملية التي يحققها هذا العلم أو ذاك. وإغفال هذه الوظائف أو الغايات هو الذي خلق الانفصام النَّكِد بين كثير من العلوم الشرعية فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين واقع الناس من جهة أخرى، حتى بات العلم يُطلَب لذاته بدَلَ أن تُستفرَغ الجهود حوله لما ينتج عنه من مقاصد وغايات تحقّق مبدأ وظيفيته.
وعلم التفسير في هذا السياق يُعَدّ من أكثر العلوم تأثيرًا وتأثرًا في باقي العلوم الأخرى وفي واقع الناس وأحوالهم، وهو «علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية»[2]. نعم، فالتفسير وظيفته الأولى والأخيرة بيان مراد الله تعالى سواءٌ تلميحًا أو تصريحًا «بقدر الطاقة البشرية»، أي: باستدعاء كلّ ما من شأنه أن يساعد في أداء هذه الوظيفة. وهو من أشرف العلوم الشرعية وأجلّها، يقوم على أصول وقواعد مضبوطة، وتتفرّع عن مباحثه علوم معلومة، وله كتبه المدونة الخاصّة به كما هي سائر العلوم.
يقول السيوطي -رحمه الله-: فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث: أمّا من جهة الموضوع فلأنّ موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كلّ حكمة، ومعدن كلّ فضيلة، فيه نبأ مَن قبلكم، وخبر مَن بعدكم وحُكم ما بينكم، لا يَخْلَق على كثرة الردّ، ولا تنقضِي عجائبه. وأمّا من جهة الغرض: فلأنّ الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى، والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. وأمّا من جهة شدّة الحاجة: فلأن كلّ كمال دينيّ أو دنيويّ، عاجليّ أو آجليّ، مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى[3].
وإذا تقرّر من ذلك أهمية علم التفسير ومكانته بين العلوم الشرعية وغيرها، فإنّ تحديثه بما يحقّق ويجلِّي وظيفيته المعرفية والاجتماعية يكون آكَد، بل هو ضرورة شرعية وحضارية؛ لتجاوز ما هو عليه اليوم من كونه علمًا -لا سيما بالدراسات الجامعية- يدرس من باب الترف الفكري، أو لِنَقُل من باب المحافظة على الموروث العلمي لا أكثر ولا أقلّ، بحيث تجد تدريس التفسير بالتعليم الجامعي يكون في غالبه رصدًا لحركة العلم وتطوّره عبر وصف وتعريف مراحله التي مَرّ بها وأعلامه واتجاهاته ومدارسه ومصنّفاته. حتى أصبحت «الدراسات الإسلامية، والعلوم الشرعية كما يجري تدريسها والتأليف فيها والكلام فيها، منغمسة أو منغمس أهلها في التاريخ مع الانسلاخ عن الواقع، فمثلًا الفقه الإسلامي الذي يدرس اليوم هو في معظمه صار فقهًا تاريخيًّا، أي صار تاريخًا»[4].
وعلم التفسير -وسائر العلوم الشرعية- لا يُطلَب لذاته أو لإرضاء الفضول المعرفي، وإنما الأصلُ في طلبه وتعليمه قبل ذلك وبعده تحقيقُ الصلاح الفردي والجماعي والعمراني، ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة وظائفه التي يحقّقها.
ومن هنا جاءت هذه المقالة لتكشف النقاب عن هذه الوظيفة لعلم التفسير من خلال معالجة السؤال الإشكالي الآتي: ما المقاصد الوظيفية التي ينبغي استحضارها أثناء تدريس علم التفسير والتي من شأنها أن تحقّق ملَكة التفسير لدى الطالب الذي نعدّه ليكون مفسِّرًا قادرًا على إحياء فريضة الاجتهاد والاستجابة لمستجدّات العصر ومتطلّباته؟
ويتفرّع عن هذا الإشكال الأسئلة الآتية:
- ما وظيفة علم التفسير على المستوى المعرفي؟ أي ما يتعلّق بفهم مقصد تفسير القرآن الكريم وكذا التقاطعات المعرفية التي يحققها علم التفسير مع باقي العلوم الأخرى.
- ما وظيفته على المستوى الاجتماعي[5]؟
وسيكون تناول الموضوع من خلال عنصرين رئيسين: الأول خصصته للحديث عن وظيفية علم التفسير على المستوى المعرفي، والثاني خصصته للحديث عن وظيفية علم التفسير على المستوى الاجتماعي، يسبقهما تمهيد، وتقفوهما خاتمة تضم أبرز الخلاصات والنتائج.
تمهيد:
إنّ الأساس الفلسفي للعلم والذي يُسائل المعرفة في جانبها الإبستيمولوجي، ويناقش إشكالية وظيفية المعرفة وتفاعلها مع قضايا المجتمع تأثيرًا وتأثرًا، يفرض ضرورة وضع حدّ نظري يقنّن ويضبط ممارسة العلم ويعصمه من الانحراف والزيغ؛ ولذلك نجد للعلماء -قديمًا وحديثًا- جهودًا علمية عِدَّة في محاولة تسييج العملية التفسيرية في جانبها النظري، لكون «وجود بناء نظري يختصّ بضبط الممارسة التطبيقية لأحد العلوم يَعني أن يكون بين أيدينا نسق نظري مرتَّب الخطوات لضبط الكيفية التي نتعامل معها عند تعاطي هذه الممارسة»[6].
والناظر في هذه الجهود يلفيها لا تخرج عن خطَّين؛ أحدهما ما يتعلّق بأصول التفسير ومناهجه، والآخر يتعلّق بقواعد التفسير، ولا أعرف أنّ هناك مَن أدرج ضمن هذا السياج وظيفية علم التفسير؛ على أهميتها في ضبط العملية التفسيرية وتحديد مقصدية العلم والغاية منه. وحديثنا عن وظيفية علم التفسير في هذا السياق يكون خطًّا ثالثًا مكملًا لذلك السياج النظري الضابط للعملية التفسيرية.
أولًا: وظيفية علم التفسير على المستوى المعرفي:
يتناول هذا العنصر الحديث عن وظيفية علم التفسير من جهة مقصد هذا العلم والغرض الذي يبتغي المفسِّر أن يحقّقه من بيان مراد الله تعالى من خطابه، ثم من جهة ثانية بيان التقاطعات التي تجمع يين علم التفسير وعلوم أخرى بما يساعد في تحقيق الفهم السليم للنصّ القرآني.
أ- وظيفية علم التفسير من خلال مقصده:
إذا تفحّصنا الملفات الوصفية للجذع المشترك بشُعب الدراسات الإسلامية بالتعليم الجامعي المغربي على سبيل المثال، وتتبعنا المادة التفسيرية بها، سيتجلّى بالملموس إغفالُ القائمين على برمجة هذه الملفات استحضارَهم لوظيفة علم التفسير باعتباره علمًا من العلوم المدرَّسة بهذه الشُّعب، ومعرفة وظيفة العلم هي التي تمكِّن المدرِّس من وضع العلم في موضعه الصحيح من المعرفة الإسلامية عمومًا، كما تكمن معرفة وظيفية العلم المدرَّس بالنسبة للطالب في المساعدة على تبيُّن الحاجة مِن تعلُّم هذا العلم أو ذاك، وبالتالي الاقتصار في تعلُّمه على ما يحقّق هذه الوظيفة بدل استفراغ الجهد في التوسّع في مباحث نظرية لا تكون إلا مشوّشة عليه ويفني عمره كلّه ولا يدركها.
وإنّ معرفة وظيفية العلم متوقّفة على معرفة مقاصده التي يمكن أن تستنبط في علم التفسير -لكونه بيان مراد الله تعالى من الخطاب القرآني- من القرآن نفسه؛ أي مقصد علم التفسير من مقصد الخطاب القرآني. فما هي هذه المقاصد القرآنية التي ينبغي أن يسبح كلّ مَن تصدّى للتفسير في تيارها ولا يخرج عنها؟
تحدّث العلماء قديمًا وحديثًا عن مقاصد القرآن الكريم، وميزوا في حديثهم بين ثلاثة مستويات، وهي: «مقاصد الآيات، ومقاصد السور، والمقاصد العامة للقرآن»[7]، وما يهمّنا هنا هو المستوى الثالث؛ أي المقاصد العامة للقرآن الكريم، وتعني: «الأغراض العليا الحاصلة من مجموع أحكام القرآن»[8]. وقد اجتهد قلّة من العلماء في محاولة استقراء ثم عدِّ هذه المقاصد، منهم الإمام الرازي الذي جعلها في أربعة مقاصد: (الإلهيات، والمعاد، والنبوّات، وإثبات القضاء والقدر لله تعالى)[9]، والإمام الغزالي الذي جعلها ستة مقاصد: (تعريف المدعو إليه، تعريف الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه، تعريف الحال عند الوصول إليه، تعريف أحوال المُجيبين للدعوة ولطائف صُنع الله فيهم، حكاية أحوال الجاحدين وكَشْفُ فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمُحاجَّة على الحقّ، تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية أَخْذِ الزاد والأُهبة والاستعداد)[10]، وجعلها رشيد رضا في عشرة مقاصد: (بيان حقيقة أركان الدين الثلاثة، بيان ما جهل البشر من أمر النبوّة والرسالة ووظائف الرسل، إكمال نفس الإنسان من الأفراد والجماعات والأقوام، الإصلاح الإنساني الاجتماعي السياسي الوطني، تقرير مزايا الإسلام العامة في التكاليف الشخصية من الواجبات والمحظورات، بيان حكم الإسلام السياسي الدولي، الإرشاد إلى الإصلاح المالي، إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها وقصرها على ما فيه الخير للبشر، إعطاء النساء جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية، تحرير الرقبة)[11]، أمّا الإمام الطاهر ابن عاشور فحصرها في ثمانية مقاصد: (إصلاح الاعتقاد، تهذيب الأخلاق، التشريع وهو الأحكام خاصّة وعامّة، سياسة الأمّة، القصص وأخبار الأمم السالفة، التعليم بما يُناسب حالة عصر المخاطبين، المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، الإعجاز بالقرآن)[12].
وبإمعان النظر في تلك المقاصد يظهر أن اختلاف العلماء في ضبط وتحديد مقاصد القرآن الكريم إنما هو اختلاف في التعميم والتفريع فحَسْب (بمعنى؛ قد تجد مقصدًا واحدًا ذكَره أحدُهم قد فرّعه غيره إلى مقاصد عِدّة، فمثلًا مقصد البناء العمراني جامع للمقصدين اللذين ذكرهما الإمام الطاهر ابن عاشور وهما مقصد سياسة الأمة ومقصد التعليم)، وإلا فكلها تنتظم في كليات موحّدة تصبُّ في أمرين؛ صلاح الإنسان وصلاح دنياه، ونجملها في ثلاثة مقاصد تستوعب بالتبع المقاصد الفرعية الأخرى التي ذكرها علماؤنا:
مقصد صحة الاعتقاد: وهو أُمّ المقاصد وأصلها، فالمفسِّر هنا يجتهد في بيان مراد الله تعالى من تحقيق العبودية له وحده، وإثبات النبوّة والرسالة، وتثبيت عقيدة البعث والجزاء، وبيان أن الدين دين الفطرة السليمة، وغيرها من الأمور الاعتقادية التي تكون محصلتها امتلاك الفكر القويم. فوظيفة التفسير الأُولى هي صلاح الاعتقاد مع إيراد الأدلة والبراهين والإعجاز في الردّ على الاعتقادات المنحرفة في عصر كلّ مفسِّر.
مقصد التزكية والأخلاق: وهو مقصد يأتي تبعًا لمقصد التوحيد؛ فبصلاح الاعتقاد يصلح سائر ما يأتي بعده، وهو ما استنبطه الإمام الطاهر ابن عاشور وسماه بالصلاح الفردي قال -رحمه الله-: «الصلاح الفرديُّ يعتمد تهذيبَ النفس وتزكيتها، ورَأسُ الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأنّ الاعتقاد مصدرُ الآداب والتفكير، ثم صلاح السَّرِيرة الخاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصلاة، والباطنة كالتخلُّق بترك الحسد والحقد والكِبر»[13]، والتخلّق بالأخلاق الحميدة. فيكون عمل المفسِّر هو استجلاء مرادِ الله -عز وجل- من الآيات القرآنية تحقيقًا لهذا المقصد. (وفي إشارة موجزة هنا أن هناك مَن جعل من القصص وأخبار الأمم السالفة مقصدًا من مقاصد القرآن، وهو في الأصل -وفي هذا السياق- ليس مقصودًا لذاته وإنما هو يعزّز هذه المقاصد الثلاثة الكبرى وخاصّة ما يتعلّق بالتزكية والعمران).
مقصد التشريع والعمران: القرآن الكريم هو خطابُ تشريعٍ خالد، يقنّن العلاقات الاجتماعية أفقيًّا (أي؛ علاقة الإنسان بأخيه الإنسان في المعاملات والقضاء والعقود وغير ذلك)، وعموديًّا (أي؛ العلاقات المؤسّساتية داخل الدولة وخارجها)، وعلى المفسِّر أن يراعي من جهة بأنّ هذا الخطاب لا يختصّ بفئة محدّدة من الناس أو بزمن مخصوص، وإنما هو «خطاب للحقيقة البشرية، وللطبيعة التي تتمظهر وَفق خصوصيات ثقافية واجتماعية متجاوزة، وتستمر في التمظهر في حالة سيولة مع حركة الواقع»[14]. ومن جهة أخرى يراعي مقصد الصلاح العمراني، أي؛ «حفظ نظام العالم الإسلامي، وضبط تصرُّف الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع، ورَعْيُ المصالح الكليّة الإسلامية، وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لها، ويسمَّى هذا بعلم العُمرَان وعلم الاجتماع»[15].
ونشير في آخر هذه المقاصد أنها غير مقصودة لذاتها، وإنما يراد بها استثمارها في فهم النصّ القرآني وتوجيهه بما يخدم المراد منه، «فغرض المفسِّر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه بأتم بيان يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من كلّ ما يوضح المراد من مقاصد القرآن، أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيلًا وتفريعًا، مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقّع مكابرة من معاند أو جاهل»[16]. فـ«أكثر ما رُوِي في التَّفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المزكّية للأنفس -باستثناء ما رُوي مرفوعًا فلا يقدَّم عليه شيء-، المنوّرة للعقول، فَالْمُفَضِّلُونَ للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات، التي لا قيمة لها سندًا ولا موضوعًا، كما أنّ المفضِّلين لسائر التفاسير لهم صوارف أخرى عنه كما تقدّم. فكانت الحاجة شديدة إلى تفسير تتوجّه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزّلة في وصفه، وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح»[17].
ب- العدّة المعرفية الموظفة لفهم النصّ القرآني:
إنّ الناظر في مقرّرات الدرس التفسيري بالوسط الأكاديمي يجد في أغلبها ذلك الغياب الواضح لكلّ ما يشير إلى علاقة علم التفسير بغيره من العلوم الأخرى، أو التنصيص على التقاطعات المعرفية بينه وبين ما يخدمه من معارف أخرى، وهذا لعمري ضرب من الخلل المنهجي في بناء البرنامج التعليمي للتكوين، والذي يشترط فيه الانسجام بين مواد التكوين ووحداته سواءٌ منها الأساسية أو التكميلية، على المستوى الداخلي للتخصّص أو مع غيره من التخصّصات. فمِن المنهجية التربوية أن يعلم الطالب منذ بدايات اشتغاله بالتفسير «الترابط العضوي والمنهجي بين وحدات العلم الشرعي، فيدرك الأساس المنطقي الذي تم على أساسه تصنيف العلوم؛ لأنه ما لم يحسن الوصل بين العلوم يبقى تعامله معها محكومًا بالتجزيء والانفصال، ولا يستطيع الانتقال من بعضها إلى بعض واستثمار نتائج علم في علم آخر»[18]. وهو في الحقيقة تغييب لوظيفية المعرفة الشرعية، أي: غياب التكامل الوظيفي بين هذه العلوم، وما أحوجنا إلى بيان وتوظيف هذا التجسير في عصرنا هذا الذي بات يعرف انفجارًا معرفيًّا في مناحٍ شتى.
وتكمن أهمية توظيف هذا التكامل في علم التفسير؛ لكون هذا الأخير هو عملية يُتعامل فيها مع النصّ، ولا يعدو أن يكون هذا التعامل إمّا محاولة للفهم أو التنزيل، وسنتحدّث عن وظيفية علم التفسير الاجتماعية في المبحث الأخير من الدراسة، وهي وظيفة تشكِّل العلاقة بين النظر التفسيري والواقع الاجتماعي، أي: محاولة التنزيل الصحيح لهذا النظر على أرض الواقع، وهذا لا يـتأتّى إلا بالفهم الصحيح أولًا؛ لأنّ الفهم سابق عن التنزيل، كما أن الفهم المنحرف يجعل التنزيل منحرفًا أيضًا. وهنا نتساءل حول العدّة المعرفية الموظفة في إنتاج فهم صحيح للنصّ القرآني؟!
لقد أجاد وأفاد علماء التفسير في هذا الباب وتناولوا المسألة تحت مسمّيات عِدّة من قبِيل (ضوابط التفسير)، (استمداد علم التفسير)، (العلوم التي يحتاجها المفسّر)، وغيرها، وفي ملاحظة تقويمية حول كلّ تلك التحديدات نجد:
- أنّ بعضهم أغرق في سرد العلوم التي حدّدها كعلوم ضروريٌّ الإلمامُ بها لكلّ مَن تصدّى لعملية التفسير، فمنهم مَن جعلها -مثالًا لا حصرًا- خمسة عشر علمًا[19]، والأصل في مقام التدريس هو الاقتصار على تدريس المعرفة التي تستثمر في فهم النصّ، فلا يُضاع الوقت في تلقّي معارف لا يحتاجها المفسِّر إلا نادرًا والتي يمكن العودة إليها عندما تقتضي الحاجة بسرعة، لكونها متوفرة وفي المتناول، مثل ما ذكره د. الخالدي من أحداث السيرة وتاريخ العرب والعلم بالمذاهب والفِرَق الفكرية.
- أنّ بعضهم اقتصر في ذلك على العلوم الشرعية فقط[20]، ولم يُشِر البتة إلى كون المفسِّر ينبغي أن يكون مطلعًا على باقي علوم العصر وأحداثه السياسية والفكرية...
فلا شك أنّ النصّ القرآني يحتاج لفهمه وفكّ مغاليقه وإدراك معانيه إلى علوم ومعارف عديدة، فموضوع علم التفسير هو كلام الله، القرآن الكريم الذي هو «مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها، أَودع فيه -سبحانه وتعالى- علم كلّ شيء، وأبان فيه كلَّ هدي وغي، فترى كلَّ ذي فنّ منه يستمد وعليه يعتمد، فالفقيه يستنبط منه الأحكام، ويستخرج حكم الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأخبار ما يذكّر أُولي الأبصار ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أُولو الفكر والاعتبار إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا مَن علم حصرها، هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علّام الغيوب»[21].
فكان لزامًا على مَن أراد الخوض في هذا المضمار أن يتوسّل بتلك المعارف والعلوم، والتي نحصرها حسب أهميتها في الآتي:
- علوم العربية: القرآن الكريم نزل بلغة عربية ولا يمكن فهمه واستيعاب معانيه إلا باللغة التي نزل بها، وهي المفتاح الأول الذي لا يمكن تجاوزه إلى غيره في العملية التفسيرية، ويؤكّد هذا ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى بقوله: «ولا بدّ في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدلّ على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعِين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإنّ عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب»[22]. والناظر في مدوّنات التفسير يلحظ تباين أصحابها في توظيف اللغة العربية ومسائلها بين مكثر ومقلّ، ولا شك أن هذا التفاوت مردّه إلى غياب سياج ضابط لحدود هذا التوظيف اللغوي في فهم النصّ القرآني، فمع أهمية وضرورة توظيف المباحث اللغوية في التفسير إلا أنه ما ينبغي أن تتجاوز حدّ الفهم المقرون بتحقيق المقاصد القرآنية التي سبق الحديث عنها، بعيدًا عن التفسير المغرِق في هذه المباحث وتفريعاتها.
- العلم بأسباب النزول: الإلمام بأسباب النزول مهم جدًّا ومعِين في تفسير القرآن الكريم تفسيرًا صحيحًا، خاصّة عندما يستشكل الأمر على المفسِّر في فهم دلالات بعض الآيات القرآنية، فحينها يرجع إلى الموقف الذي نزلت به أو لأجله فتتجلّى له حقيقة المعنى ويأخذ العِبرة. فتوظيف علم «سبب النزول، طريق قويّ في فهم معاني القرآن»[23].
- العلم بالناسخ والمنسوخ: من أساسات فهم مراد كلام الله تعالى توظيف مباحث علم الناسخ والمنسوخ، فهو من «العلوم التي لا يقوم -التفسير- إلا بها، وكذلك لا يمكن معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة وتفسير تعارُض النصوص إلا بمعرفته؛ ولذلك أفرد له علماء أصول التفسير وعلماء أصول الفقه مصنّفات قديمًا وحديثًا»[24].
- علم أصول الفقه: نلمس التداخل الوظيفي بين علم التفسير وأصول الفقه من جهتين ذكرهما الإمام ابن عاشور في المقدمة الثانية من التحرير والتنوير، الأولى: «أنّ علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللغة، أهمل التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم المخالفة، وقد عدّ الغزالي علم الأصول من جملة العلوم التي تتعلّق بالقرآن وبأحكامه فلا جرَم أن يكون مادة للتفسير. الجهة الثانية: أنّ علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها، فهو آلة للمفسّر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها»[25].
- العلوم المعاصرة: إنّ الدراسة والفهم المتكاملين للنصّ القرآني وتنزيله لا يكتملان إلا بتوظيف المفسِّر للعلوم التي استحدثها عصره في المجال الاجتماعي والإنساني والكوني، وليس في ذلك أيّ نقص لقداسة النصّ القرآني كما يدّعي بعضهم، بل في ذلك تأكيد على أنّ هذا النص غير محصور بزمان أو مكان، وإنما هو عابر لأبعادها، وهو مظنّة لمجموعة من العلوم المستحدثة. وهذا التوظيف سيسعفنا كثيرًا في الجواب على «عدّة أسئلة شغلَت الناس في واقعنا المعاصر، كما أنّ هذا الاهتمامَ بالعلوم الحديثة بُغية تحقيق التكامل المعرفي سيولّدُ لنا نوعًا جديدًا من الاشتغال في الدرس التفسيري بعدما تتمخّض اتجاهاتٌ غير مسبوقة في التفسير تخدم قضايا الأمة الراهنة في كلّ أبعادها»[26]. كما يسعف في البحث عن «العلاقة الناظمة بينها -أي هذه العلوم المعاصرة- وبين مقاصد القرآن وغاياته في صور تشقّ سبلًا جديدة لهداية الناس إلى خالقهم، كما تمكِّن الاستفادة من العلوم الطبيعية من تخطِّي قضية الاستئناس في فهم ما ورد في القرآن حول الظواهر والاكتشافات الحديثة إلى الربط الوثيق بين هذا الشقّ المنبثق عن العلوم الطبيعية وبين مرامي الخطاب القرآني.
ومن جهة أخرى فإنّ الاستفادة من العلوم الطبيعة تمكِّن المفسِّر أيضًا من ردِّ المدّ الجائر الذي يزعم روّادُه أن هناك عداوة بين النصّ القرآني والعلم التجريبي خاصّةً في شتى جوانبه؛ كالاكتشافات العلمية وغيرها، متناسِين أنّ من خصائص القرآن أنه تضمّن مؤشرات منهجية علمية كونية للخليقة والتكوين، حين يتحدّث على سبيل المثال عن التخليق الكوني للإنسان والنفس فيما تعرض له سورة الشمس من متقابلات كونية متفاعلة...، بحيث يقدِّم معطيات علمية دقيقة في أسرار الكون ولطائفه التي تم اكتشافها حديثًا»[27].
ثانيًا: وظيفية علم التفسير على المستوى الاجتماعي:
ويتناول هذا العنصر الحديث عن وظيفية علم التفسير الاجتماعية من خلال؛ بيان أهمية هذه الوظيفة وطرح مقترحات معرفية ومنهجية ينبغي مراعاتها خلال الدرس التفسيري حتى تتحقّق هذه الوظيفية وتترسخ كملَكة لدى طالب علم التفسير.
أ- وظيفية علم التفسير الاجتماعية:
إنّ قراءة متأنية لتاريخ علم التفسير وتطوّره تكشف الدور المهم للعامل الاجتماعي في هذا التطوّر، حيث انطلقت أغلب تفاسير الآيات القرآنية استجابة لحاجات المجتمع وإشكالاته، فبعودتنا إلى عصر النبوّة الذي يُعتبر مهدَ هذا العلم ومنشأه نجد تلك الأسئلة الكثيرة حول آي القرآن الكريم والتي تجاوزت التسعين سؤالًا حول أزيد من ثمانين آية[28]، بعد تتبّعها وإمعان النظر فيها نجد أن المقصد الأساس الذي كان وراء هذه الأسئلة هو الفهم ثم التوظيف، ولعلّ ما يؤكّد استنتاجنا هذا قول عبد الله بن مسعود: كان الرجل منّا إذا تَعَلَّم عشر آيات، لم يجاوزهنّ حتى يعلمَ معانيهنّ والعمل بهنّ[29]، ثم بعد ذلك ظهرت الاتجاهات في التفسير والتي كانت وليدة الإشكالات الثقافية والفكرية التي كانت تشغل مجتمع المفسِّرين، وبالتالي لم تكن وظيفية علم التفسير الاجتماعية مغيّبة عن مناهج علمائنا قديمًا تنظيرًا وتنزيلًا، وإنما أصاب ما أصاب التفسير من ركود وجمود وتغافل عن وظيفته الاجتماعية لِمَا أصبح عليه من تكرار لأقوال المفسِّرين السابقين وإثقال الدرس التفسيري باستطرادات معرفية لا طائل منها، والاقتصار في التفسير على بيان معاني الألفاظ وتوضيح المعاني بمعزل عن ربط ذلك بقضايا المجتمع وإشكالاته.
فصفة التفسير الاجتماعية ضرورة تمليها من جهة؛ خاصية القرآن الكريم «الشمولية والخلود» باعتباره دستورًا إصلاحيًّا لمناحي الحياة في كلّ الأزمنة والأمكنة، وباعتبار أنّ فهمه غير متوقّف على علماء في زمن معيّن دون غيرهم، فـ«من المحال على البشرية أن تفهم كمالات القرآن الكريم في نواحي الوجود كلّها في عصر واحد؛ إذ إنّ باستطاعة كلّ عصر أن يضيف إلى تفسير الآيات المتعلقة بتلك الموضوعات مما يستجدّ أمامه من العلوم والمعارف»[30]. ومن جهة أخرى؛ تنزيل الفهم القرآني على الواقع وملابساته وربطه بقضايا المجتمع في زمن كلّ مفسر، وبالتالي تحقّق هذه الوظيفة مبدأ التوافق بين الفهم القرآني ومتطلبات العصر. فلا يعدّ عمل المفسّر تفسيرًا ما لم يحقّق منه هذه الوظيفة، وإلى ذلك يشير الأستاذ سعيد حوى في قوله: «وأمّا بالنسبة للتفسير، فإذا لم تخدم قضية الإيمان فيه في عصرنا المادي الشهواني، فكأنّ المفسّر لم يفعل شيئًا»[31]، فعمل المفسّر بميزان وظيفية علم التفسير الاجتماعية يتمثّل في النظر في «أوضاع الأمة وعللها وأسقامها، وليرى أحوال واقعها وموقعها بين الأمم، ثم يرى كيف يكون -تفسير- القرآن هاديًا مرشدًا لها في جوانب حياتها المختلفة»[32].
ب- مقترحات معرفية ومنهجية لتجويد الدرس التفسيري تحقيقًا للوظيفية الاجتماعية:
تأتي هذه المقترحات لِما للعلم من علاقة وطيدة بمنهاج تدريسه في تلازمهما وتأثرهما المتبادل، وهي مقترحات تهدف إلى جعل الصفة الاجتماعية حاضرة في الدرس التفسيري، حتى يتبين لطلابه الوظيفة الاجتماعية المتوخّاة من مباحث درس التفسير التي تناولوها بالبحث والدراسة.
ونجمل هذه المقترحات في الآتي:
- إنّ اختيار المعرفة المناسبة للفعل التربوي لأيّ علم غالبًا ما تستهلّ بمقدمات ومداخل لمباحثه التي ستكون محلّ المدارسة، وإن الناظر في مقرّرات الدرس التفسيري بالجامعة المغربية ليجد هذه المقدّمات والمداخل مغرقة بالمفاهيم والتقسيمات والمراحل التي تكون مُخِلَّة بالدرس إذا ما قُورن ذلك بالحيز الزمني المخصّص لوحدة التفسير ضمن الفصول الستة لسلك الإجازة على سبيل المثال، فالأصل أن تكون هذه المداخل والمقدّمات تجمع بين بيان مصطلح التفسير وما يتعلّق به من مصطلحات قريبة -وهي جدّ قليلة- ومقاصده، وبين ربط المعرفة التفسيرية بالواقع الاجتماعي وبيان المقاصد المرجوة منه في إصلاح أحواله وإشكالاته.
- اختيار مادة علمية مرتبطة بقضايا المجتمع واحتياجاته، وللأسف ما يزال بعض مدرسي وحدة التفسير يستحضرون أثناء الدرس أمثلة تطبيقية من قرون خلَت، أمثلة كان لها سياقها الاجتماعي والاقتصادي والفكري الخاصّ، والأَوْلى في ذلك استحضار أمثلة من الواقع المعيش للطالب.
- التركيز على أنشطة البحث والتعلّم الذاتي كتوجيه الطلبة مثلًا إلى: «إنجاز مواضيع وبحوث تتعلّق بدراسة أحوال المجتمع ورصد معطياته، عن طريق التتبّع والملاحظة واستعمال الاستبيانات وما شاكلها من أساليب البحوث الميدانية، ثم ربط النتائج بالدراسة... (التفسيرية)»[33]. وبالتالي رصد الإشكالات المجتمعية التي ينبغي للعملية التفسيرية أن تجد الحلّ القرآني لها.
- دعم الجامعات والجهات المسؤولة عن الدراسات العليا للبحث في ميدان الدراسات القرآنية، فالبحث العلمي قادر على اكتشاف الجديد ومحاكاة الواقع وتكييفه وَفق المبادئ والمعتقدات الإسلامية، فـ«منشط البحث يرتكز على منهج محدّد عمادُه الخبرة والتجربة، ويغدو ذلك المنهج طريقًا واضحًا محددًا لتنظيم النشاط من أجل تحقيق الهدف الإسلامي المعتدل المنشود»[34].
خاتمة:
كانت غاية هذه المقالة البحث في وظيفية علم التفسير على المستويين المعرفي والاجتماعي، وقد التمستُ لتحقيق ذلك استنطاق التراث التفسيري وما تعلّق به من المعرفة قديمًا وحديثًا، والوظيفية في تدريس وتجديد العلوم الشرعية قضية لها قيمتها العلمية والنظرية في حقل تجديد العلوم الشرعية معرفيًّا وتربويًّا، ولها أيضًا ضرورتها في حقل النهوض والإقلاع الحضاري والعلمي.
وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج نعرضها كالآتي:
- وظيفية علم التفسير متوقّفة على معرفة مقاصد القرآن الكريم، ومنه يكون قصد المفسّر من قصد القرآن، أي؛ يكون تفسيره بما يحقّق مراد الله تعالى من خطابه.
- غياب التجاسر والتقاطع المعرفي بين علم التفسير وغيره من العلوم الشرعية والإنسانية في مقرّرات الدرس التفسيري الجامعي.
- إحياء وظيفية علم التفسير الاجتماعية أمر ضروري ومركزي في أيّ محاولة لتجديده معرفيًّا أو تربويًّا.
بعد عرض هذه النتائج يبقى تجويد مناهج العلوم الشرعية بما فيها الدرس التفسيري مطلبًا بعيدًا ينتظر التوافق على رؤية تربوية إصلاحية موحدة، وهذا يتطلّب تظافر جهود الفاعلين التربويين والمتخصّصين في المناهج التربوية والعلوم الشرعية في إطار اجتهاد جماعي قوامه التجديد في إنتاج المعرفة والانفتاح على الحياة العلمية والاجتماعية بمجالاتها المختلفة.
[1] تعدّ فكرة هذه المقالة ورقة علمية شاركتُ بها في مؤتمر دولي بالرشيدية- المغرب يومي 20- 21 جمادى الأولى 1444هـ/ الموافق لـ 14- 15 دجنبر 2022م، وقد أدرجت عليها بعض التعديلات الفنية والمنهجية حتى تتناسب مع سياسة النشر بموقع مركز تفسير.
[2] مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر بيروت، ب ت، (1/ 471).
[3] الإتقان في علوم القرآن، الإمام جلال الدين بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ)، تحقيق: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، ص572.
[4] العلوم الشرعية بين المدارسة والممارسة، أحمد الريسوني، مجلة الواضحة، دار الحديث الحسنية، العدد الأول. تم الاطلاع عليه عبر الرابط: www.edhh.org/wadiha/index.php/oloum-charyaa، بتاريخ 21/ 11/ 2022.
[5] لم أظفر -في ضوء اطّلاعي- على أيّ دراسة عُنيت بالبحث في (مبدأ الوظيفية المعرفية والاجتماعية لعلم التفسير)، اللهم إلا ما جاء به علماء التفسير في مقدمات كتبهم حيث يبدؤون في الغالب بالمبادئ العشرة لعلم التفسير، ومنها ثمرته واستمداده ونسبته إلى العلوم، وفيها يتحدثون عن المقصد منه وعلاقته بباقي العلوم، وسيأتي الحديث والتعقيب عنها في موضعها. وما جاء به سيد قطب في ظلاله بإعماله للوظيفة الاجتماعية في تفسيره بشكل عميق.
[6] البناء النظري للتفسير، خليل محمود اليماني،tafsir.net/research/64، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ص18.
[7]جهود الأمة في مقاصد القرآن، د. أحمد الريسوني، المؤتمر العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه، تم الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدكتور الريسوني يوم 26/ 8/ 2022 رابطه: raissouni.net/1306
[8] مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، د. عبد الكريم حامدي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1429هـ= 2008م، ص47.
[9] مفاتيح الغيب= التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط3/ 1420هـ، (1/ 156).
[10] جواهر القرآن، أبو حامد الغزالي، تحقيق: الدكتور الشيخ محمد رشيد رضا القباني، دار إحياء العلوم، بيروت، ط2/ 1986، ص23.
[11] الوحي المحمدي، محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1/ 2005، ص121.
[12] التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر- تونس، طبعة 1984هـ، (1/ 39).
[13] التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، (1/ 38).
[14] دراسات في تفسير النصّ القرآني، د. حسن جابر، مؤلف جماعي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط1/ 2007، (2/ 228).
[15] التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، (1/ 38).
[16] التحرير والتنوير، (1/ 41).
[17] تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة 1990، (1/ 10).
[18] منهاج تدريس الفقه، د. مصطفى صادقي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1/ 2012، ص309.
[19] ينظر: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، د. صلاح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم- دمشق، ط2/ 2008، ص53- 60.
[20] ينظر على سبيل المثال: التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، (1/ 18- 27).
[21] الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة 1974، (1/ 16).
[22] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، طبعة 1995، (7/ 116).
[23] نقله السيوطي عن ابن دقيق العيد في: لباب النقول في أسباب النزول، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ص3.
[24] الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية، د. عبد الله خضر حمد، دار القلم، بيروت- لبنان ، ط1/ 2017، (1/ 80).
[25] التحرير والتنوير، (1/ 26).
[26] أهمية تحقيق التكامل المعرفي عند المفسِّر في ظلّ المعرفة المعاصرة، يوسف عكراش، موقع: مركز تفسير للدراسات القرآنية، رابط المقال: tafsir.net/article/5443، تم الاطلاع عليه يوم 30/ 8/ 2022.
[27] أهمية تحقيق التكامل المعرفي عند المفسِّر في ظلّ المعرفة المعاصرة، يوسف عكراش.
[28] أخذ هذا الإحصاء من كتاب: سؤالات الصحابة للرسول واستشكالاتهم في التفسير؛ جمعًا ودراسة، تأليف: نورة بنت خالد بن إبراهيم العرف، مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط1/ 2018.
[29] أخرج الطبري في جامع البيان بسند صحيح عن ابن مسعود، تح: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط1/ 2001، (1/ 83).
[30] دراسات في أصول تفسير القرآن، د. محسن عبد الحميد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط2/ 1984م، ص9.
[31] الأساس في التفسير، سعيد حوّى، دار السلام- القاهرة، طبعة 1464هـ، (1/ 23).
[32] تفسير القرآن إشكالية المفهوم والمنهج، د. زياد خليل الدغامين، مجلة: المسلم المعاصر، العدد 81، ص16.
[33] منهاج تدريس الفقه، د. مصطفى صادقي، ص281.
[34] البحث العلمي وربطه بالمستجدات في الدراسات القرآنية العليا واقع وآفاق، د. أحمد عبد الكريم شوكة الكبيسي، موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية، رابط البحث: tafsir.net/research/59، تم الاطلاع عليه بتاريخ: 1/ 9/ 2022.


