أسباب النزول الواردة في الكتب التسعة التي لم يعتبرها ابن عطية في تفسيره
عرض وتحليل
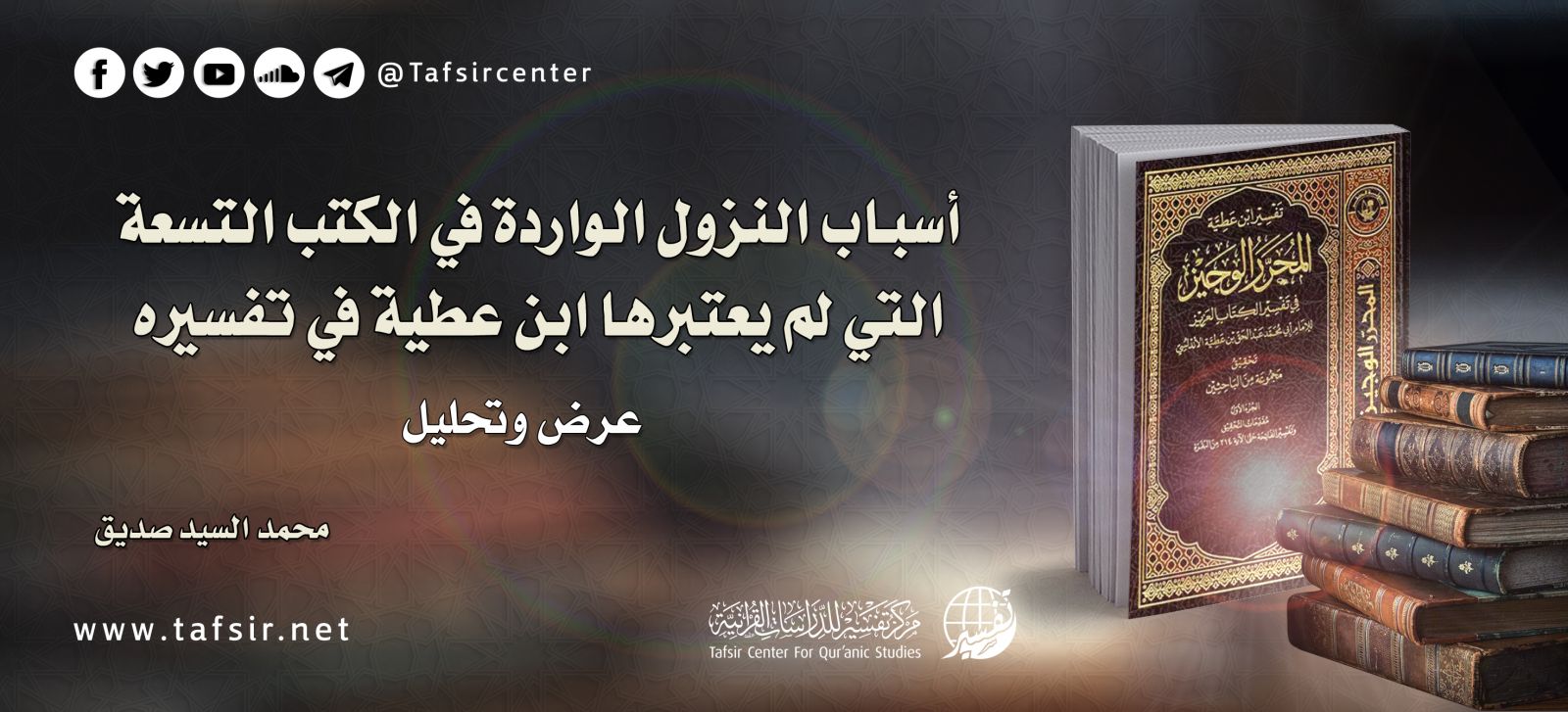
مدخل:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فيُعَدُّ تفسيرُ (المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) للإمام ابن عطية الأندلسي -رحمه الله- من أجلِّ كتب التفسير، وأكثرِها تعرُّضًا للتنقيح والتحرير، ومن أصحِّها نقلًا وبحثًا. يقول أبو حيان -رحمه الله- في كتابه (البحر المحيط) عن ابن عطية -رحمه الله-: «هو أجلُّ مَن صنَّف في علم التفسير، وأفضل من تعرَّض للتنقيح فيه والتحرير»[1]. وقال ابن خلدون -رحمه الله- في مقدمته: «وجاء أبو محمد عبد الحق ابن عطية، فلخَّص تلك التفاسير كلَّها، وتحرَّى ما هو أقرب إلى الصّحة منها، ووضع ذلك في كتاب متداول، حَسن المنحى»[2]. وقال ابن تيمية -رحمه الله-: «وتفسيرُ ابن عطية خيرٌ من تفسير الزمخشري، وأصحّ نقلًا وبحثًا، وأبعد عن البدع»[3]. وشهادة العلماء على مكانة المفسِّر والكتاب أكثر من أن تُحصى في مثل هذا المقام.
ولمّا كان الأمرُ كذلك، أردتُ الكشفَ عن جانب من جوانب التنقيح والتحرير في تفسير ابن عطية، حيث اعتنى ابن عطية -رحمه الله- في تفسيره بالأخبار الواردة في روايات أسباب النزول، فتراه يَقبل منها ويَرفض، ويُرجِّح بينها، ويَسكت عن بعضها، وفي كلّ موطن يُظهر براعةَ التحريرِ والتنقيح للأقوال.
وفي هذه المقالة نسلِّط الضوء على أسباب النزول الواردة في الكتب التسعة، ونقتصر منها على الأسباب التي لم يعتبرها ابن عطية في تفسيره، وذلك بعد تمهيد نعالج فيه بعض الحدود المنهجية الخاصّة باشتغال المقالة.
تمهيد:
تعدّدت مصادر المؤلَّفات التي روتْ أسباب النزول مثل كتب السُّنّة، وكتب التفسير، وكتب أسباب النزول التي أُلِّفت استقلالًا[4]. ومن الكتب المعاصرة التي استوعبتْ قدرًا كبيرًا من أسباب النزول، ولم تكتفِ بجمع الروايات فقط، أو الحكم عليها، بل درستها دراسة وافية، واهتمّت بالجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، ووسّعت نطاق جمع الروايات من كتب السنّة؛ كتاب (المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة؛ دراسة الأسباب رواية ودراية) للدكتور/ خالد بن سليمان المزيني[5]، ويقصد بالكتب التسعة: موطأ مالك، ومسند أحمد، وسنن الدارمي، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه.
وقد جعلتُ حدودَ المقالة هذا الكتابَ، فاستقرأتُه كاملًا، وقارنتُ ما فيه من روايات بتفسير ابن عطية -رحمه الله-، فما سكتَ عنه ابن عطية -رحمه الله- أو أغفلَ ذِكره، أو رجحه سببًا للنزول لم أذكره.
وإنما اكتفيتُ بذِكْر الأسباب التي لم يعتبرها ابن عطية -رحمه الله- في تفسيره وعقَّب عليها، ولم أشترط ذِكْرَه للروايات بنصِّها، واعتبرتُ كلَّ ما ذكره المؤلِّف في الكتاب هو من روايات أسباب النزول، واستفدت من الدراسة التفسيرية التي أوردها المؤلِّف بعد كلّ سبب فيما يخدم موضوع المقالة، ويُنتبه أنّ هدف المقالة ليس تحرير سبب النزول الوارد في الآية كما يهدف الكتاب، وإنما محاولة الكشف عن أسباب عدم اعتبار ابن عطية -رحمه الله- لهذه الروايات، وقد تحصَّل بهذه الشروط (12) سببًا من أصل مائتي (200) موضع.
وقد قسمتُ هذه المواضع تحت خمسة (5) عناصر كلية، تعبّر عن سبب عدم اعتبار ابن عطية -رحمه الله- للرواية، فأذكر الآية، وسبب النزول، وقول ابن عطية -رحمه الله-، ثم تعقيب يفسِّر قول ابن عطية -رحمه الله- ويوضحه ببعض الاستشهادات من أقوال المفسِّرين.
وفيما يلي ذِكْرُ العناصر التي تندرج تحتها أسباب النزول الواردة في الكتب التسعة ولم يعتبرها ابن عطية في تفسيره:
أولًا: مخالفة سبب النزول لسياق الآيات:
يُعَدُّ السياق القرآني من أهمِّ المرجِّحات التي يستعملها المفسِّر في الموازنة بين الأقوال، وقد ردَّ الإمام ابن عطية -رحمه الله- بعض أسباب النزول لمخالفتها لسياق الآيات، ومن ذلك مما أورده الإمام ابن عطية -رحمه الله- في تفسيره:
1- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ [الحجر: 24].
سبب النزول: أخرج أحمدُ والترمذي والنَّسَائِي وابنُ ماجه عن ابن عبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- قال: كانت امرأةٌ حسناءُ تصلِّي خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فكان بعض القوم يَستقدِم في الصف الأول لئلّا يراها، ويَستأخِر بعضُهم حتى يكون في الصّف المؤخّر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله في شأنها: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾[6].
قال ابن عطية -رحمه الله-: «وما تقدَّم الآيةَ من قولِه: ﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾، وما تأخَّر من قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾ يضعِّف هذه التأويلات -يقصد الأقوال التي ذكرها ومنها سبب النزول المذكور-؛ لأنها تُذْهِبُ اتصالَ المعنى، وقد ذكر ذلك محمدُ بن كعب القرظي لعون بن عبد الله»[7].
تعقيب:
نصَّ الإمام ابن عطية -رحمه الله- على تضعيف القول بسبب النزول المذكور؛ لأنه يُذْهِبُ اتصالَ المعنى، يَعني يخالفُ سياقَ الآيات.
والمعنى الذي يدور حوله السياق وذكَرَه ابن عطية -رحمه الله- هو العِبرة والدلالة على قدرة الله تعالى وما يوجب توحيده وعبادته، فما تقدّم الآية من قوله: ﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾، أي: لا يبقى شيء سِوانا، وكلُّ شيء هالكٌ إلا وجهَه، لا ربَّ غيرُه، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾، أي أنّه أخبرَ تعالى بإحاطة عِلمه بمَن تقدَّم من الأمم، وبمن تأخّر في الزمن من لدن أهبط آدم إلى الأرض إلى يوم القيامة... وما تأخر الآية من قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾ أي: أعلم أنه هو الحاشرُ لهم الجامعُ لعرضِ القيامة على تباعدهم في الأزمان والأقطار، وأنّ حكمتَه وعلمه يأتيان بهذا كلّه على أتم غاياته التي قدّرها وأرادها. قال ابن عطية -رحمه الله-: «بهذا سياق معنى الآية، وهو قول جمهور المفسِّرين»[8].
ورجَّح الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- المعنى الذي يتّفق مع سياق الآية، فقال: «وأَوْلَى الأقوال عندي في ذلك بالصّحة قولُ من قال: معنى ذلك: ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدَّم موته، ولقد علمنا المستأخِرين الذين استأخر موتُهم ممن هو حي ومَن هو حادثٌ منكم ممن لم يحدث بعدُ؛ لدلالة ما قبله من الكلام وهو قوله: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾، وما بعده وهو قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾ على أنّ ذلك كذلك؛ إِذْ كان بين هذين الخبرين، ولم يجرِ قبلَ ذلك من الكلام ما يدلّ على خلافه، ولا جاء بعدُ»[9]. ولكنه وجَّه القول بالسبب المذكور فقال: «وجائز أن تكون نزلَت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء والمستأخرين فيه لذلك، ثم يكون الله -عزَّ وجَلّ- عمّ بالمعنى المراد منه جميع الخلق»[10]. وهذا الردّ من الإمامين من جهة المعنى، ولا يظهر من الكلام ردّ الرواية باعتبار الصحة والضعف.
وقد ضعَّف ابن كثير -رحمه الله- الرواية، فقال: «وهذا الحديث فيه نكارة شديدة... إلى أن قال: فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عبَّاسٍ ذِكْر»[11].
وكذلك ضعَّفها ابن عاشور -رحمه الله- وأشار إلى مخالفتها لسياق الآيات، فقال: «وقد تقدّم في طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي أخرجه الترمذي في جامعه من طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن سليمان في سبب نزول هذه الآية وهو خبرٌ واهٍ لا يلاقي انتظام هذه الآيات، ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة»[12]
2- قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾[العنكبوت: 50- 51].
سبب النزول: أخرج الدارمي عن يحيى بن جعدة، قال: أُتِي النبي -صلى الله عليه وسلم- بكتفٍ فيه كتاب، فقال: كفَى بقوم ضلالًا أن يرغبوا عمّا جاء به نبيّهم إلى ما جاء به نبي غير نبيّهم أو كتاب غير كتابهم، فأنزل الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ الآية[13].
قال ابن عطية -رحمه الله-: «الضمير في (قالُوا) لقريش ولبعض اليهود؛ لأنهم كانوا يعلِّمون قريشًا مثل هذه الحجة، يقولون: لِمَ لا يأتيكم بمثل ما جاء به موسى من العصا وغيرها... ثم احتجّ عليهم في طلبهم آية بأمرِ القرآن الذي هو أعظم الآيات ومعجِز للجنّ والإنس، فقال: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ﴾، ثم قرّر ما فيه من (الرحمة والذكرى) للمؤمنين، فقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ﴾ جواب لمن قال: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ﴾». ثم ذكر سبب النزول المذكور حكايةً عن الطبري، ثم قال: «والتأويل الأول أجرى مع نسق الآيات»[14].
تعقيب:
ظاهر كلام المفسِّرين في الآية أنها في غير المؤمنين، لشدّة وضوح سياق الآية في الكفار، ورجَّح الإمام ابن عطية -رحمه الله- المعنى الذي ناسَب السياق، حيث جعل الضمير في (قالوا) في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ لقريش ولبعض اليهود، وأنّ الآية التي تليها هي احتجاج عليهم في طلبهم، وذكَر أنّ هذا المعنى أجرَى مع نسَقِ الآيات.
ومن خلال ما تقدَّم من المثالين يظهر عدمُ اعتبار ابن عطية -رحمه الله- لسبب النزول؛ لأنه خالف سياق الآيات، وأنه قد يعبِّر عن السياق بمصطلحات مشابهة، مثل: اتصال المعنى، أو نسق الآيات. فذهاب اتصال المعنى، أو مخالفة نسق الآيات؛ يعني: مخالفة السياق.
كما يلاحظ عدم تعرُّض ابن عطية -رحمه الله- أثناء ترجيحه بالسياق إلى تضعيف الرواية مثل ما ظهر معنى في المثال الأول من صنيع بعض المفسِّرين، ولعلّه اكتفى بمخالفة الرواية لسياق الآيات، وفي هذا دليل على قوّة المرجِّح، حيث إنه لم يحتَجْ إلى مزاحمته بمرجِّحات أخرى تقويه.
ثانيًا: مخالفة سبب النزول للمكي والمدني من الآيات:
ترتبط مسألة المكي والمدني بمسألة أسباب النزول ارتباطًا وثيقًا، فمن أقوى المرجّحات في اعتبار سبب نزول الآية أن يتفق الحدث الذي في الرواية مع مكية الآية أو مدنيتها، وقد يخالف سببُ النزولِ المكيَّ أو المدنيَّ من الآيات فلا يُعَدُّ سببًا لنزولها وإنما يوجَّه توجيهًا آخر، ويظهر ذلك جليًّا في صنيع الإمام ابن عطية -رحمه الله-، ومن أمثلة ذلك مما أورده الإمام ابن عطية -رحمه الله- في تفسيره:
3- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 52].
سبب النزول: أخرج ابن ماجه عن خبّاب في قوله: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ إلى قوله: ﴿فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي، وعيينة بن حصن الفزاري، فوجدوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع صهيب وبلال وعمّار وخبّاب قاعدًا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلمّا رَأَوْهُم حول النبي -صلى الله عليه وسلم- حَقَرُوهُم، فأَتَوْه فخَلَوْا به، وقالوا: إنّا نريدُ أن تجعلَ لنا منك مجلسًا تَعرِفُ لنا به العربُ فضلَنا؛ فإنّ وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأَعبُد، فإذا نحن جئناك فأقِمْهُم عنك فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: (نعم)، قالوا: فاكتب لنا عليك كتابًا، قال: فدعا بصحيفة، ودعا عليًّا ليكتب، ونحن قعود في ناحية فنزل جبرائيل -عليه السلام- فقال: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾...إلخ[15].
قال ابن عطية -رحمه الله-: «وهذا تأويل بعيد في نزول الآية؛ لأنّ الآية مكية وهؤلاء الأشراف لم يَفِدوا إلا في المدينة، وقد يمكن أن يقع هذا القول منهم، ولكنه إن كان وقع فبعد نزول الآية بمدّة اللهم إلا أن تكون الآية مدنية»[16].
تعقيب:
أورد ابن عطية -رحمه الله- أسبابًا أخرى لنزول الآية غير السبب المذكور، وكان اختياره لِما ورد في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- فقال: «وسبب الآية أن الكفار قال بعضهم للنبي -صلى الله عليه وسلم- نحن لِشَرفِنا وأقدارِنا لا يمكننا أن نختلط بهؤلاء، فلو طردتهم لاتّبعناك وجالسناك...؛ ورَدَ في ذلك حديثٌ عن ابن مسعود»[17].
والحدث المذكور في رواية ابن مسعود مكيّ، ويقوي قول ابن عطية -رحمه الله- في تضعيف سبب النزول الذي جاء عن خبّاب -رضي الله عنه-؛ وذلك لأنّ الآية مكية، والأشراف الذين ذُكروا في الرواية -يقصد الأقرع بن حابس وعيينة- لم يَفِدُوا إلّا في المدينة، وأسلمَا بعد الهجرة.
وقد ضعَّف ابن كثير -رحمه الله- حديث خبّاب، ونقد متنه، فقال: «وهذا حديث غريب، فإنّ هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلمَا بعد الهجرة بدهر»[18].
وبهذا يظهر أنّ استبعاد رواية خبّاب -رضي الله عنه- بسبب أنّ الآية مكية، والحدث المذكور في الرواية حدث مدني، فرُدَّت الرواية من هذا الوجه.
وأشار ابن عطية -رحمه الله- إلى إمكان وقوع القول الذي جاء في الرواية من الأشراف المذكورين، فقال: «ولكنّه إن كان وقع فبعد نزول الآية بمدّة، اللهم إلا أن تكون الآية مدنية» اهـ.
واحتمالُ أن تكون الآية مدنيةً ضعيفٌ ويخالفُ كلامَ المفسِّرين في الآية، ولكن جواز وقوع القول بعد نزول الآية فيُحتمل، ولا يمكن توجيهه على أنه سبب نزول، وإنما يكون من باب تمثُّل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالآية في هذا الموقف.
قال ابن عاشور -رحمه الله- معلّقًا على قول ابن عطية: «ولعلّ ذلك وقع منهما فأجابهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهذه الآية التي نزلَت في نظير اقتراحهما»[19]. وسيأتي بيان وقوع الالتباس في التعبير عن النزول بتمثُّل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالآيات بالتفصيل.
4- قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: 43].
سبب النزول: أخرج الترمذي عن ابن أخي عبد اللَّه بن سلام، قال: «لما أُريد عثمانُ جاء عبد الله بن سلام، فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئتُ في نصرتك، قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عنِّي فإِنَّك خارجٌ خير لي منك داخلٌ، فخرج عبد الله إلى الناس، فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلانٌ فسمّاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الله، ونزلت فيَّ آيات من كتاب الله، نزلت فيَّ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، ونزلت فيَّ: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾، إنّ لله سيفًا مغمودًا عنكم، وإنّ الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيّكم؛ فاللهَ اللهَ في هذا الرجل أن تقتلوه، فواللهِ إنْ قتلتموه لَتَطْرُدُنَّ جيرانَكم الملائكةَ ولَتَسُلُّنَّ سيفَ الله المغمودَ عنكم، فلا يُغمَدُ إلى يوم القيامة، قال: فقالوا: اقتلوا اليهوديَّ واقتلوا عثمان»[20].
قال ابن عطية -رحمه الله-: «وهذان القولان الأخيران -يعني قولي قتادة ومجاهد أنها في عبد الله بن سلام- لا يستقيمان إلا أن تكون الآية مدنية، والجمهور على أنها مكية قاله سعيد بن جبير»[21].
تعقيب:
ذكر الإمام ابن عطية -رحمه الله- القول بنزول الآية في عبد الله بن سلام وتعقَّبه دون أن يذكر نصَّ الحديث، واستبعد هذا القول؛ لأن الجمهور على مكية الآية، وإسلام عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- كان في المدينة، فلا يستقيم سبب النزول مع مكية الآية.
وتعقَّب غير واحد من المفسِّرين القول بأنّ الآية نزلت في عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-:
قال البغوي -رحمه الله-: «قال قتادة: هو عبد الله بن سلام، وأنكر الشعبي هذا، وقال: السورة مكية، وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة، وقال أبو بشر: قلتُ لسعيد بن جبير: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾، أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية؟!»[22].
وقال القرطبي -رحمه الله-: «وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية وابن سلام ما أسلم إلا بالمدينة؟! ذكره الثعلبي»[23].
وقال ابن كثير -رحمه الله-: «قيل: نزلت في عبد الله بن سلام. قاله مجاهد؛ وهذا القول غريب؛ لأن هذه الآية مكية، وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة»[24].
فظاهر كلام المفسِّرين أنّ الآية مكية، وأنّ القول بنزول الآية في عبد الله بن سلام ضعيف. ويمكن توجيه الأقوال التي ذكرت نزول الآية في عبد الله بن سلام أنها ذكرت ذلك من باب المِثال والتفسير وليس من باب النزول.
5- قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: 12].
سبب النزول: أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: «كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النُّقلَةَ إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنّ آثاركم تُكتب فلا تنتقلوا)»[25].
قال ابن عطية -رحمه الله-: «هذه السورة مكية بإجماع إلا أن فِرقة قالت إنّ قوله: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾، نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهم: ديَارَكم تُكتَبْ آثارُكُم، وكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعرُوا المدينةَ، وعلى هذا فالآية مدنية، وليس الأمر كذلك، وإنما نزلت الآية بمكة، ولكنه احتج بها عليهم في المدينة ووافقها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المعنى، فمن هنا قال مَنْ قال أنها نزلت في بني سلمة»[26].
تعقيب:
حكى ابن عطية -رحمه الله- الإجماع على مكيّة سورة يس، وردَّ القول بأنّ الآية نزلتْ في بني سلمة من الأنصار؛ لأنه على هذا فالآية مدنية وليس الأمر كذلك، ثم وجَّه هذا القول بأن الآية نزلت في مكة، واحتج بها عليهم في المدنية ووافقت قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المعنى فمن هنا وقوع الالتباس في القول بالنزول.
وقد ضعَّف ابن كثير -رحمه الله- الحديث، فقال: «وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية، والسورة بكمالها مكية، فالله أعلم»[27].
وأشار ابن عاشور -رحمه الله- إلى توهُّم راوي الحديث أن الآية نزلت في ذلك، وذكر مخالفة سياق الآية ومكيّتها للحديث، فقال: «وتوهّم راوي الحديث أن هذه الآية نزلت في ذلك وسياق الآية يخالفه، ومكيّتها تنافيه»[28].
6- قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: 67].
سبب النزول: أخرج أحمد والنَّسَائِي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم، أَبَلَغَك أن الله -عزَّ وجلَّ- يَحمِلُ الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرَضين على إصبع والشجر على إصبع، والثَّرى على إصبع؟ فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه، فأنزل الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾[29]، وفي لفظ: ثم قرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.
قال ابن عطية -رحمه الله-: «فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- تمثّل بالآية، وقد كانت نزلتْ»[30].
تعقيب:
بيَّن ابن عطية -رحمه الله- أنّ الرواية المذكورة ليست سببًا لنزول الآية، وأن سبب عدم اعتباره للرواية أنّ الآية قد كانت نزلت؛ يعني في مكة، والقصة حدثت في المدينة، ووجَّه ذلك بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تمثَّل بالآية.
وما أشكل في هذه الرواية ما فيها من حدث، وقراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- الآية بعد الحدث، ويشبه ذلك روايات النزول، فيُظَنُّ أنها سببٌ لنزول الآية وتكون قد نزلت ابتداءً قبل القصة.
وكذلك الرواية جاء فيها لفظ (فأنزل الله) وفي لفظ (ثم قرأ)، وهذا التردّد ربما مردّه إلى ما ذكَرْنا.
وقد وصف ابن عاشور التعبير بصيغة فأنزل الله بأنها وهمٌ، فقال: «نزلت قبل ذلك -يعني الآية المذكورة- لأنها مما نزل بمكة، والحَبر من أحبار يهود المدينة... وفي بعض روايات الحديث فنزل قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾، وهو وهمٌ من بعض رواته، وكيف وهذه مكية وقصة الحَبر مدنية»[31].
وخلاصة ما تقدَّم من أمثلة أنّ ابن عطية قد يعارِض أسباب النزول بمكية الآيات أو مدنيتها، وحينها توجَّه توجيهًا آخر، مثل: نزول الآية بمكة ويحتجّ بها عليهم في المدينة ويوافقها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المعنى، أو أن السبب المذكور يكون من باب المثال على ما جاء في الآية، أو أنه تمثّل للنبي -صلى الله عليه وسلم- بالآية، وليس سببًا لنزولها.
ثالثًا: مخالفة سبب النزول لقول جمهور المفسِّرين:
ويقصد به مخالفة سبب النزول لقولٍ نُسِب إلى جمهور المفسِّرين من إمام محقِّق كابن عطية -رحمه الله-، بغضّ النظر عن مستند القول، وأدلّة ترجيحه، فنسبة القول إلى جمهور المفسِّرين -الذين هم أهلُ الفنِّ- في ذاته مرجِّحٌ على غيره، ومن أمثلة ذلك مما أورده الإمام ابن عطية -رحمه الله- في تفسيره:
7- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾[التحريم: 1- 2].
سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والنَّسَائِي عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلًا، فتواصيتُ أنا وحفصة: أنّ أيَّتَنَا دخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- فلتقل: إني أجد منك ريحَ مغافير، أكَلْتَ مغافير، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، قال: «لا بل شربتُ عسلًا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له»، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ -إلى- ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾؛ لعائشة وحفصة: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ﴾، لقوله: (بل شربت عسلًا)[32]. زاد البخاري من رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج: (وقد حلفتُ لا تخبري بذلك أحدًا)[33].
قال ابن عطية -رحمه الله- بعد ذكر الأقوال في نزول الآية: «والقول الأول أن الآية نزلت بسبب مارية أصحّ وأوضح؛ وعليه تفقّه الناس في الآية»[34].
تعقيب:
اختُلف في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيل: نزلت في شأن مارية -رضي الله عنها- وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد حرَّمها ولها قصة، وقيل: إنها بسبب قضية العسل المذكورة في الرواية، والموازنة بين القولين تطول في هذا المقام، ونكتفي بتحليل ما ذكره ابن عطية -رحمه الله- وزيادة بيانه بما يعضِّده من أقوال المفسِّرين.
رجَّح ابن عطية -رحمه الله- القول بأنّ الآية نزلتْ بسبب مارية -رضي الله عنها-، وذكر أنّ هذا القول أصح وأوضح، وعليه تفقّه الناس في الآية.
ويُلاحظ من قوله -رحمه الله- أنه لم يعبِّر بنسبة القول لجمهور المفسِّرين، ولكن عبَّر بقوله «وعليه تفقّه الناس في الآية»، وهذا التعبير وإن لم يكن مطابقًا لمصطلح (جمهور المفسِّرين) إلا أنّ فيه إشارة على أنه قول الأكثر منهم، وقد ذكرتُه استئناسًا.
وقد روى الطبري القول بنزول الآية بسبب تحريم الجارية عن ابن عبَّاسٍ، والحسن، وقتادة، والضحاك، ومسروق، والشعبي، وزيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد، وزاد ابن الجوزي على هؤلاء سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، ومقاتل، ونسب هذا القول إلى الأكثرين[35].
وبهذا يظهر استعمال ابن عطية -رحمه الله- قول الجمهور ضمن المرجّحات التي تقوى بذاتها على ردِّ الأقوال الأخرى وعدم اعتبارها، وقد يستأنس به مع مرجّحات أخرى. وربما يعبَّر عن قول الجمهور بمصطلحات تشابهه في المدلول، مثل قول الأكثر، أو ما ذكره ابن عطية -رحمه الله- من قوله: «وعليه تفقّه الناس».
وينتبه هنا أنّ الخروج على قول الجمهور ليس بالشيء الهيِّن، ولكنه لا يتعذّر خصوصًا مع إمام محرِّر مثل ابن عطية -رحمه الله-.
رابعًا: لزوم مخالفة ظاهر سبب النزول لما هو مستقرّ من أحكام الشرع:
قد يتعارض ظاهر سبب النزول مع ما استقرَّ عليه الشرع من أحكام، وفي هذه الحالة يُضعِّف ابن عطية سبب النزول ويَردُّه لتعذّر الجمع، ومن أمثلة ذلك مما أورده الإمام ابن عطية -رحمه الله- في تفسيره:
8- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 33- 34].
سبب النزول: وأخرج أبو داود والنَّسَائِي عن ابن عبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾... إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، نزلت هذه الآية في المشركين، فمَن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه[36].
قال ابن عطية –رحمه الله-: «ويشبه أن تكون نازلة في بني قريظة حين همّوا بقتل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال عكرمة والحسن: نزلت الآية في المشركين، وفي هذا ضعفٌ؛ لأن توبة المشرك نافعة بعد القدرة عليه وعلى كلّ حال»[37]. ثم ذكرَ من قال إنها نزلت في عكل وعرينة.
تعقيب:
معلوم في الشَّرْع أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا فإنّ دماءهم تحرم، وذكر القرطبي -رحمه الله- الإجماع على ذلك، فقال: «وقد أجمعوا على أنّ أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أنّ دماءهم تحرم»[38]. ومن هذا الوجه ضعَّف ابن عطية -رحمه الله- القول بأنها نزلت في المشركين؛ لأن توبتهم نافعة بعد القدرة عليهم وعلى كلّ حال.
وأشار ابن عطية -رحمه الله- في موضع آخر إلى عدم الخلاف بين أهل العلم أنّ حكم الآية في المحاربين من أهل الإسلام، فقال: «ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتّب في المحاربين من أهل الإسلام، واختلفوا فيمن هو الذي يستحقّ اسم الحرابة...»[39].
واستبعد ابن العربي -رحمه الله- القولَ بأنها نزلت في المشركين، فقال: «ومن قال إنها نزلت في المشركين أقرب إلى الصواب لأنّ عكلًا وعرينة ارتدّوا وقَتَلوا وأفسدوا، ولكن يبعد لأن الكفار لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما يسقط قبلها، وقد قيل للكفار: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾...»[40].اهـ
فعدم اعتبار سبب النزول عند ابن عطية -رحمه الله- لمخالفته لما هو مستقر من أحكام الشرع على هذا القول، وإلا فهناك من قال أنها نزلت في المشركين وردّ على هذا الاعتراض، وليس هنا محلّ تفصيل المسألة[41].
خامسًا: مخالفة سبب النزول لما هو أرجح منه من دلالة الآية على العموم:
من المعلوم من صنيع المفسِّرين أن الأصل إبقاء الآية على عمومها، وقد يأتي سبب النزول ليخرج الآية من العموم إلى كونها في غرض مخصوص، فيُقبل السبب أو يُرَدُّ أو يكون خلاف الأَولى أو يوجَّه بحسَب ما يرجِّح المفسِّر، ومن أمثلة ذلك مما أورده الإمام ابن عطية -رحمه الله- في تفسيره:
9- قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: 80].
سبب النزول: أخرج الترمذي وأحمد عن ابن عبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة ثم أُمر بالهجرة؛ فنزلت عليه: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾[42].
قال ابن عطية -رحمه الله-: «ظاهر هذه الآية والأحسن فيها أن يكون دعاءً في أن يُحسِن الله حالتَه في كلّ ما يَتناولُ من الأمور ويحاولُ من الأسفار والأعمال وينتظرُ من تصريف المقادير في الموت والحياة، فهي على أتمّ عموم، معناه ربّ أصلِحْ لي وِرْدِي في كلّ الأمور وصَدَرِي، وذهب المفسِّرون إلى أنها في غرض مخصوص، ثم اختلفوا في تعيينه»[43]،ثم ساق الأقوال ومنها الرواية التي ذكرناها.
تعقيب:
فسَّر ابن عطية -رحمه الله- الآية على عمومها، دون الحاجة إلى تعيين غرض مخصوص، ووصفها بأنها على أتمّ عموم، أمّا ما ذكره المفسِّرون من تعيين أغراض مخصوصة فهو من باب التفسير، ولم يتناول أحد الرواية المذكورة على أنها من أسباب النزول فليس هناك حدثٌ تنزل الآية بسببه.
لذلك عبَّر المفسرون عن هذه الرواية وغيرها بما يدلّ على أنها قول في التفسير وليست سببًا للنزول:
قال الطبري -رحمه الله- بعد سياق الأقوال: «وأشبه هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معنى ذلك: وأدخلني المدينة مدخل صدق، وأخرجني من مكة مخرج صدق»[44].
وقال البغوي -رحمه الله-: «المراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج، واختلف أهل التفسير فيه: فقال ابن عبَّاسٍ والحسن وقتادة: أدخلني مدخل صدق المدينة، وأخرجني مخرج صدق من مكة، نزلتْ حين أُمِر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بالهجرة»[45]. وهذه النقولات ظاهرة في طبيعة تعامل المفسِّرين مع مثل هذه الروايات وذكرها في صورة أقوال تفسيرية، ولا يُفهم منها السببية.
10- قوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ [الحج: 19].
سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم والنَّسَائِي وابن ماجه عن أبي ذر -رضي الله عنه- أنه كان يُقسِمُ قَسَمًا: إن هذه الآية: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾. نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزةَ وعليٍّ وعبيدةَ بن الحارث، وعتبةَ وشيبةَ ابني ربيعة والوليدِ بن عتبة[46].
قال ابن عطية -رحمه الله- بعد ذكر سبب النزول المذكور: «وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن وعاصم والكلبي: الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم، وهذا قول تعضده الآية؛ وذلك أنه تقدّم قوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾، المعنى: هم مؤمنون ساجدون، ثم قال: ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾، ثم أشار إلى هذين الصنفين بقوله: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾»[47].
تعقيب:
رجَّح ابن عطية -رحمه الله- أنّ الآية في المؤمنين والكفار على العموم، وعلَّل ذلك من خلال سياق الآيات، ولم يجعل رواية أبي ذر -رضي الله عنه- سببًا لنزولها.
وذهب ابن جرير الطبري -رحمه الله- إلى عموم الآية في المؤمنين والكفار، ثم أشكلَ على نفسه برواية أبي ذر -رضي الله عنه- فقال: «فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما رُوي عن أبي ذر في قوله: إنّ ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟ قيل: ذلك إن شاء الله كما رُوي عنه، ولكن الآية قد تنزل بسببٍ من الأسباب، ثم تكون عامة في كلّ ما كان نظير ذلك السبب، وهذه من تلك»[48]. فأدخل ابن جرير -رحمه الله- السبب في عموم الآية.
وفسَّر ابن عاشور -رحمه الله- الآية على عمومها، وما ذكره أبو ذر -رضي الله عنه- في الرواية جعله من باب المثال، قال ابن عاشور -رحمه الله-: «فالمراد من هذه الآية ما يعمّ جميع المؤمنين، وجميع مخالفيهم في الدين. ثم ذكر حديثَ أبي ذر، فقال: والأظهر أنّ أبا ذر عَنى بنزول الآية في هؤلاء؛ أنّ أولئك النفر الستة هم أبرز مثال وأشهر فرد في هذا العموم، فعبَّر بالنزول وهو يريد أنهم ممن يُقْصَد من معنى الآية، ومثل هذا كثير في كلام المتقدّمين»[49].
فجمهور المفسِّرين على عموم الآية في المؤمنين والكفار، وبعض من ذكر العموم منهم كابن جرير وابن عاشور -رحمهما الله- أدخلا الرواية بعد ذكرها في عموم الآية.
11- قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: 4].
سبب النزول: أخرج أحمد والترمذي عن ابن عبَّاسٍ -رضي الله عنه- أنه قيل له: أرأيت قولَ الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾، ما عَنى بذلك؟ قال: قام نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا يصلي، قال: فخَطَرَ خطرةً، فقال المنافقون الذين يصلُّون معه: ألا ترون له قلبين، قال: قلبًا معكم، وقلبًا معهم؟ فأنزل الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾[50].
قال ابن عطية -رحمه الله- بعد ذكر سبب النزول بمعناه: «ويظهر من الآية أنها بجملتها نفيٌ لأشياءَ كانت العرب تعتقدها في ذلك، وإعلام بحقيقة الأمر، فمنها أنّ بعض العرب كانت تقول إنّ الإنسان له قلبان؛ قلب يأمره وقلب ينهاه، وكان تضاد الخواطر يحملها على ذلك... وذكر كلامًا إلى أن قال: وكانت العرب تعتقد الزوجة إذا ظُوهر منها بمنزلة الأم وتراه طلاقًا، وكانت تعتقد الدعيّ المتبنَّى ابنًا، فأعلمَ الله تعالى أنه لا أحد بقلبين»[51].
تعقيب:
أثبت ابن عطية -رحمه الله- الخلافَ في سبب نزول الآية، وذكرَ عدّة أقوال؛ منها رواية ابن عباس -رضي الله عنهما- بمعناها، ثم ذهب إلى أنّ «الآية بجملتها نفيٌ لأشياءَ كانت العرب تعتقدها في ذلك، وإعلام بحقيقة الأمر»، وهذه العبارة يُفهم منها أنه تَرَكَ الآيةَ على عمومها ولم يذكر لها سببًا معيَّنًا، وما ذكره من أشياءَ كانت العرب تعتقدها إنما هو من باب المثال على الأشياء التي نزلت الآية لنفيها.
ومما يؤكِّد تَرْكَ ابنِ عطيةَ -رحمه الله- الآيةَ على عمومها؛ المعنى الذي ذكره وأفاده من سياق الآيات، قال -رحمه الله-: «...ويكون في هذا أيضًا طعنٌ على المنافقين الذين تقدَّم ذِكْرُهم، أي: إنما هو قلب واحد، فإمّا حَلَّه إيمان وإمّا حَلَّه كفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسطة، يؤمن قلب ويكفر الآخر، فنفاها الله تعالى، وبَيَّن أنه قلب واحد»[52]. فتأمّل في هذا المعنى الذي استنبطه من السياق دون الحاجة إلى الروايات المذكورة في سبب نزول الآية.
وأشار ابن عاشور -رحمه الله- إلى دلالة الآية على العموم بعد أن ذكر بعض أكاذيب الجاهلية واعتقادهم في بعض الأشخاص أنّ لهم قلبين، فقال -رحمه الله-: «فوقوع (رجلٍ) وهو نكرة في سياق النفي يقتضي العموم، ووقوع فِعل (جعلَ) في سياق النفي يقتضي العموم؛ لأنّ الفعل في سياق النفي مثلُ النكرة في سياق النفي. ودخول (مِن) على (قلبين) للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجل، فدلَّت هذه العمومات الثلاثة على انتفاء كلّ فرد من أفراد الجَعْلِ لكلّ فرد مما يطلق عليه أنه قلبان، عن كلّ رجل من الناس، فدخلَ في العموم جميلُ بن معمر وغيرُه بحيث لا يُدَّعَى ذلك لأحد أيًّا كان»[53]. فجعل الآية على عمومها، وما ذكره من أكاذيب لأهل الجاهلية داخلٌ تحت هذا العموم.
12- قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ * فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ [فصلت: 22- 24].
سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنَّسَائِي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: اجتمع عند البيت قرشيّان وثقفي، أو ثقفيّان وقرشي، كثيرةٌ شَحْمُ بطونهم، قليلةٌ فِقْهُ قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إنْ جَهَرْنا، ولا يسمع إنْ أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جَهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله -عزَّ وجلَّ-: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ الآية[54]. وفي رواية لأحمد إلى قوله: ﴿فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾[55].
قال ابن عطية -رحمه الله-: «ويشبه أن يكون هذا بعد فتح مكة؛ فالآية مدنية، ويُشبِه أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ الآية متمثلًا بها عند إخبار عبد الله إيّاه، والله أعلم»[56].
تعقيب:
وجَّه ابن عطية -رحمه الله- ما جاء في رواية عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- بأنه يُشبِه أن يكون هذا بعد فتح مكة؛ فالآية مدنية، ويشبه تمثُّل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالآية عند إخبار عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- إيّاه، يعني أنّ قراءة الآية تحقيقًا لمثالٍ من صُوَرِ معنى الآية.
وقد استحسن ابنُ عاشور كلامَ ابن عطية، فقال: «وأحسن ما في كلام ابن عطية طرفه الثاني، وهو أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ الآية متمثِّلًا بها، فإنّ ذلك يؤوِّلُ قولَ ابن مسعود: فأنزل الله تعالى الآية، ويبيِّنُ وجهَ قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- إيّاها عندما أخبره ابن مسعود؛ بأنّه قرأها تحقيقًا لمثال من صُوَرِ معنى الآية، وهو أنّ مثل هذا النفر ممن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم»[57].
ويلاحَظ هنا أمران:
الأمر الأول: أنَّ الإشكال في الرواية بسبب التشابه بين أسباب النزول وبين تمثُّل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالآيات، فكلاهما يتضمّن حدَثًا وقراءةَ النبي -صلى الله عليه وسلم- الآية أو الآيات بعد الحدَث؛ فيتشابهان من هذه الجهة. ويحصل التمايز بين المسألتين بإحاطة المفسِّر بما يَحُفُّ الآية من قرائن، وتدقيقه في روايات أسباب النزول حتى يعتبر الرواية أنها سبب لنزول الآية أو لا.
الأمر الثاني: أنَّ تعليق ابن عطية -رحمه الله- على الرواية لم يتضمن إلا توجيهَها، وتأويلَ قولِ ابنِ مسعود -رضي الله عنه- الواردِ في الرواية، دون الإفصاحِ عن سبب عدم الاعتبار الذي دفعَ ابنَ عطية -رحمه الله- إلى توجيه الرواية وتأويلها.
ويظهر من تفسير ابن عطية -رحمه الله- للآية، ومن استحسان ابن عاشور -رحمه الله- لتوجيه ابن عطية بأنَّ الرواية مثالٌ من صُوَرِ معنى الآية وهو أنّ مثل هذا النفر ممن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم؛ أنّه ربما يكونُ سبب عدم اعتبار الرواية قوّة دلالتها على العموم، مع مناسبة ذلك العموم لسياق الآيات؛ ولذلك لم يخصّص ابن عطية الآية بالسبب، واحتاج إلى تأويلها، والله أعلم.
وختامًا:
فقد تعرَّضنا في هذه المقالة لأسباب النزول الواردة في الكتب التسعة والتي لم يعتبرها ابن عطية في تفسيره، ودرسناها بحسَب مواضعها في الآيات وتبيَّن لنا ما يأتي:
- من أسباب عدم اعتبار ابن عطية -رحمه الله- لأسباب النزول: مخالفةُ سبب النزول لسياق الآيات، ومخالفةُ سبب النزول للمكي والمدني من الآيات، ومخالفةُ سبب النزول لقول جمهور المفسِّرين، ولزومُ مخالفة سبب النزول لما هو مستقِرٌّ من أحكام الشرع، ومخالفةُ سبب النزول لما هو أرجح منه من دلالة الآية على العموم.
- من توجيهات ابن عطية -رحمه الله- لأسباب عدم اعتبار روايات أسباب النزول: نزولُ الآية بمكة ويحتجّ بها عليهم في المدينة ويوافقها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المعنى، أو أن السبب المذكور يكون من باب المثال على ما جاء في الآية، أو أنه تمثّلٌ للنبي -صلى الله عليه وسلم- بالآية.
- إصدارُ الحكم على رواية بأنها سبب للنزول كثيرُ المعطيات، ولا يمكن حصره في صحّة الرواية من ضعفها، أو الاعتماد على الصِّيغة الواردة في الرواية من كونها صريحةً أو غيرَ صريحة، فقد تكون الرواية في البخاري ومسلم، وورَدَ فيها صيغة صريحة، مثل: (فأنزل الله، فنزلت)، ولا يعتبرها المفسِّر سببًا للنزول، ومثال ذلك في الموضع رقم 7 و12 من المقالة.
- تعبيرُ ابن عطية -رحمه الله- عن السياق بمصطلحات مشابهة، مثل: (اتصال المعنى، أو نسق الآيات) في الموضع رقم 1 و2، وعن قول الجمهور بقوله: (وعليه تفقه الناس) على ما ذهبنا إليه في الموضع رقم 7 =يكشفُ لنا التنوُّعَ في التعبير عن المصطلح الواحد، ويلفت النظر إلى أنّ دراسة مصطلحٍ عند مفسِّرٍ ما -خاصة ابن عطية- يلزم منه استقراء صنيع هذا المفسِّر في تفسيره كاملًا، ومعرفة كيف يُعبِّر في تفسيره عن هذا المصطلح؟ وفي هذا ضمان لاستيعاب مادة المصطلح المراد دراسته في التفسير والإلمام به من جميع جوانبه.
- استغناءُ ابن عطية -رحمه الله- عن أسباب النزول وتخصيص الآية بها إذا تبيَّن المعنى المراد من الآية، فكأنه يؤكّد على أنّ الأصل في التفسير هو بيان المعنى المراد، وأنّ أسباب النزول توظَّف لخدمة هذا الغرض، وقوّة السبب وضعفه تكون بحسَب دلالته على المعنى، ومدى اتصاله بسياق الآيات.
إنّ العنايةَ بالجانب التطبيقي ودراسةَ أسباب النزول الواردة في كتب التفسير -خصوصًا الكتب التي تُعْنَى بالتحرير- تكشفُ لنا اعتباراتٍ كثيرةً في الترجيح لا تظهر إلا بعد التطبيق، وتسهم في تصوّر الموضوعات والمسائل بصورة صحيحة، وتجلّي منهجَ أهل الفنّ في التعامل مع أسباب النزول؛ مما يضبط لنا بوصلة التعامل مع المفسِّرين ومع أسباب النزول الواردة في تفاسيرهم وَفق مرادهم.
وصلى اللهُ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله ربّ العالمين.
[1] البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1411هـ، (1/ 10).
[2] مقدمة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن خلدون، دار الجيل، بيروت، ص348.
[3] مجموع فتاوى ابن تيمية، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار التقوى، بلبيس، مصر، (2/ 194).
[4] يُراجع: المؤلّفات المطبوعة في علم أسباب النزول؛ عرض وتعريف، للباحث/ محمد السيد صديق. تقرير منشور على مرصد تفسير تحت هذا الرابط: tafseroqs.app.link/qpcgbB2Jutb
[5] صدر هذا الكتاب عن دار ابن الجوزي/ السعودية، وقد طُبع عدَّة مرات، ونُشرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 1427هـ= 2006م، في مجلدين، ويقع الكتاب في 1202 صفحة. وأصل هذا الكتاب رسالة علمية للدكتوراه، وقد درس فيها المؤلِّف أسباب النزول التي وردتْ في كتب الحديث التسعة، وقد جاء الكتاب في مقدّمة وتمهيد وقسمين وخاتمة: تناول في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهجه في إعداده، وذكر في التمهيد مكانة أسباب النزول وأهميتها، وفوائد معرفة أسباب النزول، ونشأة علم أسباب النزول، ومصادر أسباب النزول، وبواعث الخطأ في أسباب النزول. ثم تناول في القسم الأول من الكتاب قواعد في أسباب النزول وضوابط الترجيح فيها، وفي القسم الثاني: دراسة أسباب النزول دراسة تفسيرية حديثية ورتَّب الدراسة على النحو الآتي: ذِكر الآية أو الآيات النازلة، ذِكر السبب أو الأسباب التي نزلت بشأنها الآيات، دراسة السبب أو الأسباب دراسة تفسيرية حديثية.
[6] أخرجه أحمد في المسند (5/ 5)، رقم (2783)، والترمذي (5/ 197)، رقم (3122)، والنسائي في الكبرى (6/ 374)، رقم (11273).
[7] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (10/ 123).
[8] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (10/ 123).
[9] جامع البيان (14/ 26).
[10] جامع البيان (14/ 26).
[11] تفسير القرآن العظيم (2/ 549، 550).
[12] التحرير والتنوير (14/ 40).
[13] أخرجه الدارمي (1/ 134)، رقم (478).
[14] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (12/ 232 وما بعدها).
[15]أخرجه ابن ماجه (2/ 1382)، رقم (4127).
[16] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (6/ 56- 57).
[17] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (6/ 56- 57).
[18] تفسير القرآن العظيم (2/ 135).
[19] التحرير والتنوير (7/ 246).
[20] أخرجه الترمذي (5/ 299)، رقم (3265).
[21] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (10/ 54).
[22] معالم التنزيل (3/ 25).
[23] الجامع لأحكام القرآن (9/ 336).
[24] الجامع لأحكام القرآن (9/ 336).
[25] أخرجه الترمذي (5/ 278)، رقم (3226).
[26] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (13/ 185).
[27] تفسير القرآن العظيم (3/ 566).
[28] التحرير والتنوير (22/ 356).
[29] أخرجه أحمد (6/ 69)، رقم (3590)، والنسائي (4/ 413)، رقم (7736)، والحديث قد أخرجه البخاري (6/ 2697)، رقم (6978) عن مسدد.
[30] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (14/ 102).
[31] التحرير والتنوير (24/ 63، 64).
[32] أخرجه البخاري (5/ 2016)، رقم (4966)، وأحمد (43/ 41)، رقم (25852)، ومسلم (2/ 1100)، رقم (1474).
[33] أخرجه البخاري (4/ 1865)، رقم (4628).
[34] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (16/ 46 وما بعدها).
[35] زاد المسير (8/ 303).
[36] أخرجه أبو داود، (4/ 536)، رقم (4372)، والنسائي (7/ 116)، رقم (4057).
[37] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 86- 87).
[38] الجامع لأحكام القرآن (6/ 149).
[39] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 86- 87).
[40] أحكام القرآن (2/ 594- 596).
[41] يراجع الخلاف في سبب نزول الآية بشيء من التفصيل في كتاب: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة (1/ 472).
[42] أخرجه الترمذي (5/ 207)، رقم (3139)، وأحمد في المسند (3/ 417)، رقم (1948).
[43] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (10/ 123).
[44] جامع البيان (15/ 149، 150).
[45] معالم التنزيل (3/ 132).
[46] أخرجه البخاري (4/ 1459)، رقم (3751)، ومسلم (4/ 2323)، رقم (3033)، والنسائي في الكبرى (6/ 410)، رقم (11341)، وابن ماجه (2/ 946)، رقم (2835).
[47] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (10/ 123).
[48] جامع البيان (17/ 133).
[49] التحرير والتنوير (17/ 228).
[50] أخرجه أحمد في المسند (4/ 233)، رقم (2410)، والترمذي (5/ 258)، رقم (1399).
[51] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (13/ 46).
[52] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (13/ 46).
[53] التحرير والتنوير (21/ 255).
[54] أخرجه البخاري (4/ 1818)، رقم (4539)، وأحمد (6/ 108)، رقم (3614)، ومسلم (4/ 2141)، رقم (2775).
[55] انظر: رقم (4238).
[56] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (14/ 177).
[57] التحرير والتنوير (24/ 270).


