منهج القرآن في دعوة المؤمنين إلى الأكل من الحلال الطيب
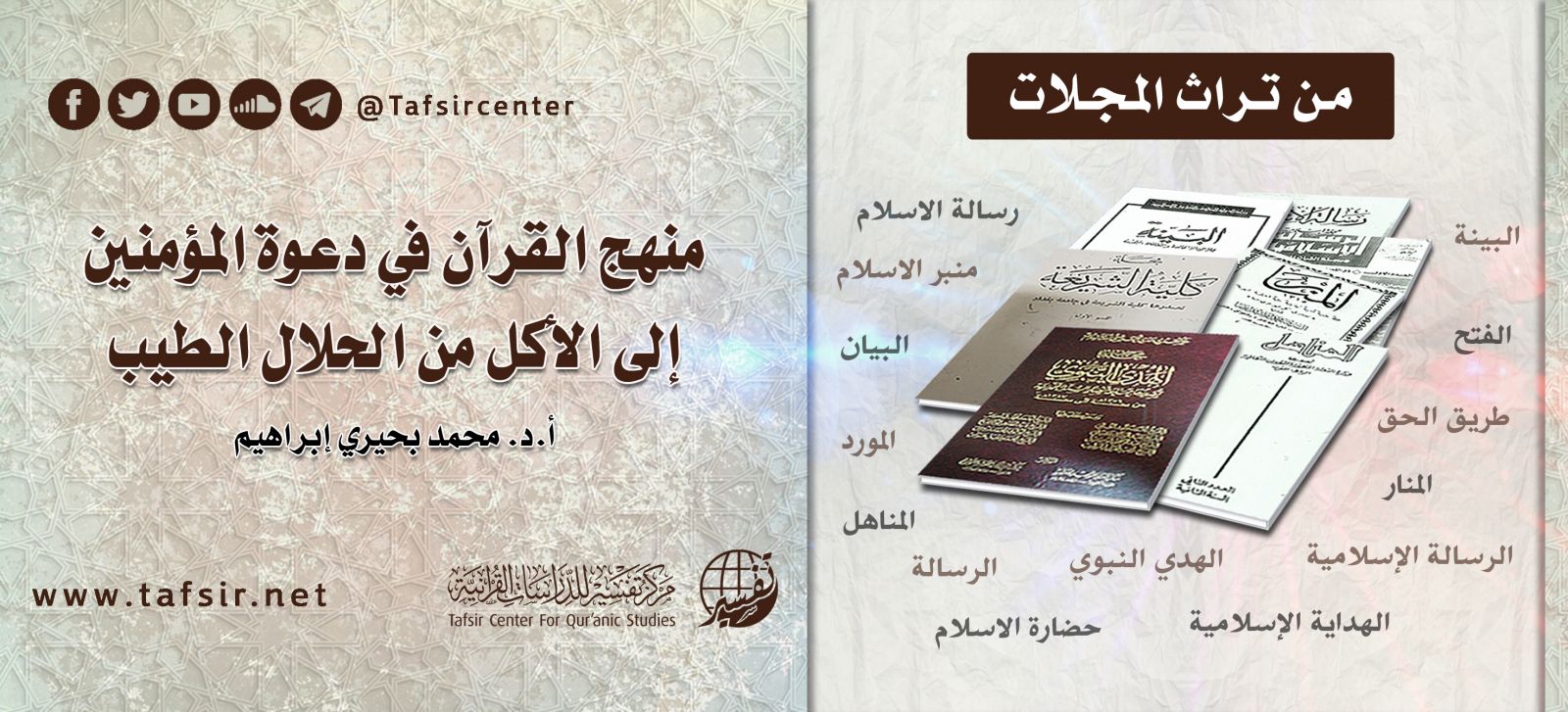
منهج القرآن في دعوة المؤمنين إلى الأكل من الحلال الطيب[1]
الحمد لله، والصلاة والسلام على أفضل رسله ومصطفاه، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن والاه.
وبعد:
فإن مَن يمعن النظر والتدبّر في آيات القرآن الكريم يظهر له بوضوح أن الله سبحانه دعا عباده المؤمنين إلى الكثير من الفضائل الأخلاقية، والتكاليف الشرعية، وأمَرهم أن يقوموا بأدائها أو يتحلّوا بها، ومن ذلك:
• دعوته سبحانه لهم إلى الركوع والسجود، وذِكر الله تعالى وتقواه سبحانه، والإنفاق في سبيله، والصبر، والتوبة، والطاعة، والاستجابة لله ولرسوله إلى غير ذلك من الفضائل والتكاليف.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[الحج: 77].
وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا}[الأحزاب: 41، 42].
وقال عزَّ شأنه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}[التوبة: 119].
وقال وقولُه الحق: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[البقرة: 254].
كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[آل عمران: 200].
وتلك آيات في هذا المقام على سبيل المثال لا الحصر.
• وكما دعا سبحانه عباده المؤمنين وأمَرهم بهذه الأمور؛ دعاهم سبحانه أيضًا وأمَرهم أن يأكلوا مما أحلّه لهم وجعله طيّبًا شهيًّا مستساغًا، وإن اختلف مقتضى الأمر في هذا المجال عنه في الأمور السابقة وجوبًا، أو ندبًا واستحبابًا، ولكن يكفي أن الله تعالى دعا بصريح الأمر إلى استعمال نِعمه الحلال: (أكلًا، أو شربًا، أو غير ذلك).
وجعل الله سبحانه إجابته إلى هذا الأمر طاعة له، واستجابة لدعوته؛ لأن إجابة الكريم في دعوته إجلال له وتعظيم، فضلًا عما يعود على الإنسان نفسه من منافع وفوائد مادية وروحية لا تُعدّ ولا تُحصى.
منهج هذه الدَّعوَة:
وكانت دعوة القرآن للمؤمنين إلى هذا الأمر قائمة على نوعين من الأساليب:
النوع الأول: أسلوب الأمر الصريح بأكل الطيبات من الرزق.
النوع الثاني: أسلوب النهي عن تحريمها، أو إنكار هذا التحريم عندما وقع من بعض الناس.
فمن النوع الأول جاء قوله تعالى:
1- {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}[البقرة: 168، 169].
2- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}[البقرة: 172].
3- {وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ}[المائدة: 88].
4- {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}[النحل: 114].
والواقع أنَّ مَن يتفقد هذه الآيات الكريمة يجد أن القرآن الكريم قد اتخذ في إباحة التمتع بطيبات الحياة -جريًا على مبدأ الاعتدال الذي بنيت عليه سائر أحكام الإسلام- تحفُّظَيْن شدّد في مراعاتهما، هما:
- حُسن النية؛ ويكون بقصد شكر الله على نعمه، لا بقصد التفاخر والخيلاء.
- ثم الوقوف فيها عند حد الاعتدال؛ حتى لا يقع الإنسان في الإسراف.
قال تعالى: {وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}[الأنعام: 141].
وقال عزَّ شأنه: {وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ}[النحل: 114].
وبهذين التحفظَين حارب الإسلام الترف والبذخ والتبذير فيما لا يعود على النفس أو الأمة بخير[2].
بيان هذه الآيات:
في الآية الأولى:
وهي الوحيدة بين زميلاتها في ندائها الناس عامة- نجد دعوةً إلى الأكل من بعض ما في الأرض من أصناف المأكولات، التي من جملتها ما حرَّموه على أنفسهم افتراءً على الله تعالى، الذي أباح لهم من فضله جميع خيراتها، بشرط أن تكون محصَّلة بطريقٍ حلالٍ طيب.
وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «نزلت هذه الآية في قومٍ مِن ثقيف وبني عامر بن صعصعة وخزاعة وبني مدلج، حرَّموا على أنفسهم ما حرّموا»[3]؛ أي: مما جعله الله حلالًا طيبًا ولم ينزل تحريمه عليهم.
فجاء خطاب الله تعالى للناس عامة بأن يأكلوا -من بعض ما في الأرض- المأكولات الطيبة الحلال، ثم حذّرهم سبحانه من اتباع خطوات الشيطان اللعين ومسالكه في هذا المجال؛ فإنه يزين للناس القبيح حسنًا، والمنكر معروفًا، والخبيث طيبًا، ويغويهم بأن يقولوا على الله بلا علم. هذا التزيين الباطل والإغواء المضلّ، والخروج بالأشياء عن حقيقتها إنما يكون منه للإيقاع بالناس في حبائله وشِراكه؛ ولحملهم على تحريم ما أحل الله لهم، فيحرمهم بذلك من كثير من نعم الله وخيراته التي أسبغها عليهم ظاهرةً وباطنة، وهذا الإغراء والتزيين ناشئ في الحقيقة عن عداوته البيّنة لهذا الإنسان الذي اختاره الله تعالى ليكون خليفة له في الأرض.
وفي الآية الثانية:
يوجّه الله تعالى الخطاب للمؤمنين خاصة؛ لأنهم أَولى بالاهتداء، وأحق بالعلم والتوجيه، وأقرب إلى الاستجابة لأمرِ الله سبحانه وأمرِ رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقيل: لكونهم أفضل أنواع الناس[4].
يأمرهم سبحانه بأن يتمتعوا في هذه الحياة بما أحلّه الله لهم من الكسب المشروع، والرزق الطيب، والمتاع النافع؛ ولذلك قال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: إن المراد (طيب الكسب لا طيب الطعام)، ويؤيده حديث: «إنَّ الله طيِّب لا يقبل إلَّا طيّبًا»[5].
وفي مقتضى الأمر في قوله تعالى: {كُلُوا}، يقول الإمام الصاوي في تفسيره: «قيل: الأمر للوجوب بالنسبة لإقامة البنية، وللندب بالنسبة للاستعانة على أمور مندوبة»[6].
والطيبات المذكورة في الآية الكريمة:
- إن أُرِيدَ بها (ما أحلّه الله تعالى منها)، فالأمر بأكلها يقتضي النهي عن سواها، ويوجب قصر الأكل عليها وحدها، وقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- حكمة ذلك في قوله: «يا أيُّها الناس، إنَّ الله طيِّب لا يَقْبَل إلَّا طيّبًا، وإنَّ الله أمَرَ المؤمنين بما أمَرَ به المرسَلِين، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}[المؤمنون: 51]، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}[البقرة: 172]».
- وإن أُرِيدَ بها (أي: الطيبات) ما طاب منها وكان لذيذ الطعم، غزير الفائدة من اللحوم والفواكه وغيرها، فالأمر بأكلها أمرُ إباحة، وليس أمر إيجاب.ـ[7].
ونخلص من هذين الرأيين إلى وجوب الأكل من الحلال بوجهٍ عام، بمقدار ما يقيم البنية ويحفظ على الإنسان صحته وعقله، وهذا يقتضي وجوب الانتهاء عمّا عدَا هذا الحلال. أمّا المستلَذّات من الأطعمة فالأمر بتناولها يكون للإباحة والندب، لا للوجوب؛ لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يحصل على ما تميل إليه نفسه من أطايب الأطعمة والأشربة؛ وذلك لأسباب قد تكون اقتصادية، وقد تكون اجتماعية، وقد تكون صحية، وذلك من حكمة الإسلام ويُسره الواضح.
وهذه الآية تزيد عن سابقتها -ما دام الخطاب للمؤمنين- الأمرَ بشكر الله تعالى على نعمه التي عمّهم بها إن كانوا حقًّا صادقين في دعوى الإيمان، عابدين الله تعالى حق العبادة، منقادين لحكمه، مطيعين لأمره، لا يعبدون الأهواء ولا الشهوات.
وفي مقتضى الأمر بالشكر؛ قال بعض العلماء:
- إنه (للوجوب) إذا كان الشكر بمعنى الاعتقاد، والمعنى: اعتقِدوا أن النعم صادرة لكم من الله، وعلى هذا المعنى يكون إنكاره كفرًا.
- وقد يكون هذا الأمر (للندب) إذا كان الشكر بمعنى المراقبة، والمعنى: راقِبوا في كل لحظة أنّ كل نعمة من الله، وهو بهذا المعنى من مقام الخواص[8].
وفي هذا الأمر العظيم أيضًا: {وَاشْكُرُوا لِلَّهِ} التفات من ضمير التكلُّم إلى ضمير الغَيبة؛ لأنه لو جرى على الأسلوب الأول لقال: (واشكرونا). وفائدته: تربية المهابة والروعة في القلوب إزاء هذا المسلك الخطير[9].
وأمّا الآية الثالثة:
فسوف يأتي الكلام عنها عند الحديث عن آيات النوع الثاني.
وأمّا الآية الرابعة:
فإنها ذُكِرَت في ثنايا نص كريم، يَضرب الله فيه المثَل للمؤمنين بتلك القرية التي كانت آمنةً مطمئنةً يأتيها رزقها الواسع من كل النواحي برًّا وبحرًا، فكفرت بأنعم الله، وجحدت فضله ومننه، بتكذيبها رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل عليها سخطه ونقمته، وأذاقها لباس الجوع والخوف، فظهر عليهم من الهزال وصفرة الوجوه وسوء الحال ما هو كاللباس.
وبعد ضربه سبحانه هذا المثل يقول: {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ}، وقد اختلف المفسرون في المقصود بالخطاب في {فَكُلُوا}:
- فقال بعضهم: إن الخطاب لكفار مكة، والمعنى: وإذا استبان لكم حال مَن كفرَ بأنْعُم الله وكذَّب رسوله وما حلّ بهم بسبب ذلك، فانتهُوا عما أنتم عليه مِن كفرٍ بالنعم، وتكذيبٍ للرسول -عليه السلام- كي لا يحلّ بكم مثل ما حلّ بهم، واعرفوا حق الله تعالى، وأطيعوا رسوله -عليه السلام- في أمره ونهيه، وكلوا مما رزقكم الله حال كونه {حَلالًا طَيِّبًا}، وذروا ما تفترون من تحريم البحائر وغيرها[10].
- وقيل: إن الخطاب للمؤمنين، وهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما-، والمعنى على ذلك: (فكلوا يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله من الغنائم حلالًا طيِّبًا؛ يعني: إن الله أحلّ الغنائم لهذه الأُمّة وطيَّبها لهم، ولم تُحَلّ لأحدٍ قبلهم).
- وقيل: إن المعنى: (وكلوا مما رزقكم الله من الأنعام الطيّبة عمومًا)[11].
ثم ربط ذلك بقضية الإيمان؛ أي: إن كنتم تطيعون الله حقًّا طاعة منشؤها التوحيد، وباعثها الإيمان واليقين بإفراد الله بالعبادة وحده دون سواه، فكلوا مما أحله الله ودَعُوا ما حرّمه.
ثم إنّ عَطْف الأمر بالفاء في {فَكُلُوا} يُشعِر بأن ذلك متسبَّب عن ترك الكفر.
والمعنى: إنكم لمّا آمنتم وتركتم الكفر؛ فكلوا الحلال الطيب، واتركوا الخبائث، وهو الميت والدم، {وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه} التي أنعم بها عليكم، واعرفوا حقها {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}، ولا تعبدون غيره.
وقيل: إنّ الفاء هذه داخلة على الأمر بالشكر، وإنما دخلت على الأمر بالأكل لأنه ذريعة إلى الشكر[12].
وأمام هذين القولين للعلماء في المقصود بالخطاب في {فَكُلُوا} أرَى أن القول بأنه خطابٌ للكفار أَولى بالقبول؛ لأن سياق النص الكريم يقوِّي ذلك ويؤيده، ويبعد أن يكون الخطاب للمؤمنين؛ لأن النهي الآتي بعد هذا الخطاب -وهو قوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ}[النحل: 116]- لا يساعد على هذا القول.
ومن خلال هذه الصورة التي رسمها النص الكريم -وبين ثناياه هذه الآية المباركة- ندرك بوضوح أن التألِّي على أحكام الله تعالى بتحريم الحلال، وتحليل الحرام إنما هو نذير سوء، ومقدمة لنزول مقت الله وغضبه على من يرتكبون هذه الفعلة الجريئة على حق الله تعالى من الإصابة بالخوف بعد الأمن، والجوع بعد الشبع، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
وأمّا النوع الثاني: فقد جاء بأسلوبٍ آخر يختلف في تعبيره عن الأسلوب الأول، متخذًا عدة طرق نبينها فيما يلي:
1- طريق النهي الصريح عن تحريم ما أحله الله تعالى.
وفي هذا السبيل جاء قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[المائدة: 87].
2- أو نفي تحريم ما هو مباح بحكم الأصل، ولم يبين الشرع فيه حكمًا بالتحريم فبقي على إباحته.
ومن هذا النوع جاء قوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ}[المائدة: 103].
3- أو طريق إنكار هذا التحريم على مَن حرّمه، بأسلوب الاستفهام الإنكاري الذي يحمل معاني التوبيخ والتقريع على ارتكاب هذا العمل الأثيم؛ إذ التحليل والتحريم إنما هو من اختصاص المشرِّع الحكيم.
وفي هذا الصدد جاء قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ}[الأعراف: 32]، وقوله تعالى أيضًا: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ}[يونس: 59، 60].
بيان هذه الآيات:
نزلت الآية الأولى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[المائدة: 87]، عندما عزم بعض أفراد من المسلمين في المدينة (دار الهجرة) على التَّزَمُّت بتحريم بعض الطيبات على أنفسهم ظانِّين أن ذلك يرفع منزلتهم عند الله، ويحببهم إلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فقد جاء في سبب نزولها ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنّ رجلًا أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وقال: إذا أكلتُ هذا اللحم انتشرتُ إلى النساء، وإني حرّمتُ هذا اللحم على نفسي، فنزلَت الآية الكريمة».
وقال المفسرون: جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا فذكَّر الناس، ووَصَف القيامة...إلخ، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي فيهم أبو بكر، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، واتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفراش، ولا يأكلوا اللحم ولا الوَدَك[13]، ويترهّبوا، ويجبُّوا المذاكير، فبلغ ذلك رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فجمَعهم، فقال: «ألم أُنبَّأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟» فقالوا: بلى يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير، فقال: «إني لم أُومر بذلك؛ إنّ لأنفسكم عليكم حقًّا، فصوموا وأفطِروا، وقوموا وناموا؛ فإني أقوم وأنام، وأصوم وأُفطِر، وآكل اللحم والدّسَم، ومَن رغب عن سُنّتي فليس منّي»، ثم خرج إلى الناس وخطبهم، فقال: «ما بال أقوام حرّموا النساء والطعام والطِّيب والنوم وشهوات الدنيا، أمَا إني لستُ آمرُكم أن تكونوا قسيسين ولا رهبانًا؛ فإنه ليس في ديني تركُ اللحم والنساء، ولا اتخاذ الصوامع، وإنّ سياحة أمّتي الصوم، ورهبانيتها الجهاد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وحُجُّوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، فإنما هلَك مَن كان قبلكم بالتشديد؛ شدّدُوا على أنفسهم فشدّدَ الله عليهم...، فأنزل الله هذه الآية»[14].
والسر في ذلك: أن الطيبات نِعَم مِن نِعَم الله على الإنسان، والله تعالى يحب من عباده أن يقبلوا نعمه التي تدعو إليها فِطَرُهم، ويحب أن يرى أثرها عليهم، ويكره لهم الجناية على فِطَرهم بمنعها حقها[15].
ومن خلال هذا النص الكريم ندرك أن القرآن العظيم يعتبر هذا المسلك من بعض المسلمين اعتداءً على حدود الله تعالى، حيث يقول: {وَلَا تَعْتَدُوا}؛ أي: ولا تتعدوا حدود ما أحلّ الله لكم إلى ما حرّم عليكم، أو جعل تحريم الطيبات الحلال اعتداءً وظلمًا، فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن تحريمها دخولًا أوليًّا لوروده عقبه[16].
ومن هذا المبحث نخلص إلى أنّ تحريم الحلال وتحليل الحرام، علاوة على اعتباره افتراءً وكذبًا وعدوانًا، هو كذلك كفرٌ وضلال وظُلم، وليس أدلّ على ذلك من قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}[التوبة: 37].
وقال تعالى في مقامٍ آخر: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}[الأنعام: 144].
وبعد أن نهاهم سبحانه عن تحريم ما جعله لهم حلالًا طيبًا مباركًا أمَرهم أن يأكلوا من رزقه الحلال الطيب، مُراعِين تقوى الله الذي آمنوا به إيمانًا عميقًا، وأن تكون هذه التقوى متحققة في كل ما يأتون وما يذرون.
ومن هنا، يجب أن ندرك أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبِر إنما هو في فعل ما ندَب الله عباده إليه، وعمل به رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم- وسَنّه لأمّته، وأقام عليه الأئمة الراشدون والسلف الصالح -رضوان الله عليهم أجمعين-.
وأمّا الآية الثانية: فإنها تفيد تكذيب المشركين فيما دأبوا عليه من تحريم بعض الحيوانات على أنفسهم رغم ما هم عليه من شدة الاحتياج إليها والانتفاع بها، فبيَّن الله تعالى لهم أنّ ذلك الذي يحكمون به من التحريم أمرٌ باطل؛ حيث لم يُكَلَّفُوا به، ولم يأتهم شرع بذلك[17].
معنى الآية: إن الله سبحانه لم يَشرَع شيئًا من هذا الذي حرّمه أهل الجاهلية على أنفسهم (من البَحِيرة، والسائبة، والوَصِيلة، والحام)، ولا هي عنده قُربة، وإنما هم الذين وقعوا في ذلك وجعلوه شرعًا لهم، فحرّموا أكله والانتفاع به، واعتبروه قُربة يتقربون بها إليه دون أن يكون لديهم من الله دليل على ذلك، وإنما يفترون على الله الكذب الصراح، فصاروا بذلك لا يفقهون للحق طريقًا، وإنما أعماهم الهوى والشهوات واتّباع الرؤساء والآباء؛ فضَلُّوا وأضلوا.
وأمّا الآية الثالثة: ففيها يقول الله تعالى لرسوله -صلى الله عليه وسلم-: {قُلْ} لهؤلاء المشركين الذين يحرّمون ما يحرّمون بآرائهم الفاسدة، وابتداعاتهم الضالة المضللة، منكرًا عليهم، وموبخًا لهم: {مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} من النبات، والحيوان، والمعادن.
{وَالطَّيِّبَاتِ}؛ أي: المستلَذّات من المآكل والمشارب من تلقاء نفسه من غير شرع من الله، كلا إنها مخلوقة لمَن آمن بالله وعبَدَه في الحياة الدنيا، وإنْ شاركهم فيها الكفار حسًّا في الدنيا، فهي للمؤمنين خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد منهم؛ لأن الجنة محرّمة على الكافرين[18].
ومن هذا القول نجد دليلًا على أن الأصل في الأشياء هو (الإباحة).
وفي مجال الاستفهام الإنكاري والتوبيخي أيضًا على تحريم الحلال؛ جاءت الآية الرابعة والأخيرة في هذا المقام، وهي قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ}[يونس: 59].
والمعنى -كما يقول كثير من المفسرين-[19]: أخبروني عن الذي أنزله الله لكم من رزق، فحكمتم على بعضٍ بأنه حرام وهو حلال. وعلى بعضٍ آخر بأنه حلال، مع أن الكُلّ حلال، يشير بذلك سبحانه إلى ما حكاه عنهم في سورة الأنعام من قولهم: {هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ}[الأنعام: 138]، وقولهم: {مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ}[الأنعام: 139].
هل أذن الله لكم في ذلك التحريم والتحليل فأنتم تمتثلون أمره تعالى؟ أم على الله تفترون وتكذبون بنسبة الإذن إليه؟
والاستفهام هنا للتقرير والتبكيت؛ وذلك لتحقق العلم بالشق الأخير قطعًا، وهو أنه سبحانه لم يأذن، كأنه قيل: أم لم يأذن لكم، بل تفترون عليه سبحانه. وهذا على اعتبار (أم) متصلة.
وإظهار اسمه الجليل وتقديمه على الفعل دلالة على قبح افترائهم، وتأكيدٌ للتبكيت إثر تأكيد، وجوّز بعض المفسرين أن تكون (أم) منقطعة بمعنى (بل) التي للإضراب الانتقالي؛ حيث أضرب عن التوبيخ والزجر بإنكار الإذن، إلى التوبيخ على الافتراء عليه سبحانه.
ثم ساق سبحانه بعد ذلك كلامًا كريمًا يبين مقدار هول ما سيلقون من جزاء على جعلهم هذا، معبِّرًا عنهم سبحانه بالموصول في موقع الإضمار لقطع احتمال الشق الأول، وبتسجيل عليهم بالشق الثاني وما يستتبعه ويترتب عليه.
ومتى سيقع هذا الجزاء؟ إنه يوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي تُعرَض فيه الأعمال والأقوال، والمجازاة عليها، مثقالًا بمثقال، والمراد تهويل هذا اليوم وتفظيعه بتهويل ما يتعلق به مما يصنع بهم يومئذٍ، وكأنه سبحانه يقول لهم: (أي شيء ظنُّهم بما سيقع يوم القيامة...؟ أيحسبون أنهم لا يُسألون عن افترائهم، أو لا يُجازون عليه؟ أو يُجازون عليه جزاءً يسيرًا ولأجلِ ذلك يفعلون ما يفعلون؟!).
كلا، إنهم لفي أشد العذاب؛ لأن معصيتهم أشد المعاصي: {وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ}[يونس: 60].
والمعنى: أنه سبحانه صاحب فضل عظيم لا يُقَدَّر على جميع الناس؛ بإمهالهم، والإنعام عليهم بنعمة العقل المميِّز بين الحق والباطل والحَسَن والقبيح، وكذلك برحمتهم بإرسال الرسل، وإنزال الكتب عليهم لبيان الحلال والحرام، وإرشادهم إلى ما يهمهم من أمر المعاش والمعاد، إلّا أن الغالب من هؤلاء الناس أنهم لا يصرفون قواهم ولا أفكارهم إلى ما خُلِقَت له، ولا يتّبعون دليلَ العقل فيما يمكن أن يُدرك بالعقل، ولا دليلَ الشرع فيما لا يُدرك إلا بالشرع، ومن أجلِ ذلك وقعوا في مهاوي الرّدَى، وصدَق الحقُّ سبحانه إذ يقول: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا}[الكهف: 17].
إلّا أن المسلم الحق هو من يلتزم بأحكام دينه الحنيف فيما أحلّ وفيما حرّم، فيُحِلّ حلاله، ويُحرِّم حرامه، ويشكر الله سبحانه على ما أحلّ له، ويصبر على ما حرّم عليه، وهذه هي نهاية التقوى التي أمَرَنا بها القرآن الكريم، والله أعلم.
[1] نشرت هذه المقالة بحولية كلية أصول الدين والدعوة، العدد الرابع، عام 1984م. (موقع تفسير).
[2] من توجيهات الإسلام- لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، ص127.
[3] تفسير أبي السعود، (1/ 145).
[4] فتح القدير، (1/ 169).
[5] الحديث رواه الإمام مسلم وأحمد والترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
[6] حاشية الصاوي على الجلالين، (1/ 77).
[7] انظر مجلة الأزهر- عدد 5- رمضان سنة 1398هـ، مقال لفضيلة الشيخ محمد الحديدي الطير.
[8] حاشية الصاوي على الجلالين، (1/ 77).
[9] حاشية الجمل على الجلالين، (1/ 138). تفسير أبي السعود، (1/ 147).
[10] تفسير أبي السعود، (3/ 197).
[11] حاشية الجمل على الجلالين، (2/ 602، 603).
[12] فتح القدير للشوكاني، (3/ 200).
[13] الودَك: الشحم أو الدسَم.
[14] المائدة (88).
[15] من توجيهات الإسلام، لفضيلة الشيخ شلتوت، ص124.
[16] تفسير الكشاف للإمام الزمخشري، (1/ 640).
[17] تفسير الفخر الرازي، (12/ 109)، بتصرف.
[18] تفسير ابن كثير، (3/ 404)، ط. الشعب، بتصرف. وحاشية الصاوي على الجلالين، (2/ 70، 71)، وتفسير أبي السعود، (2/ 164).
[19] انظر: تفسير أبي السعود، (2/ 335، 336)، بتصرف. وحاشية الجمل على الجلالين، (2/ 358).


