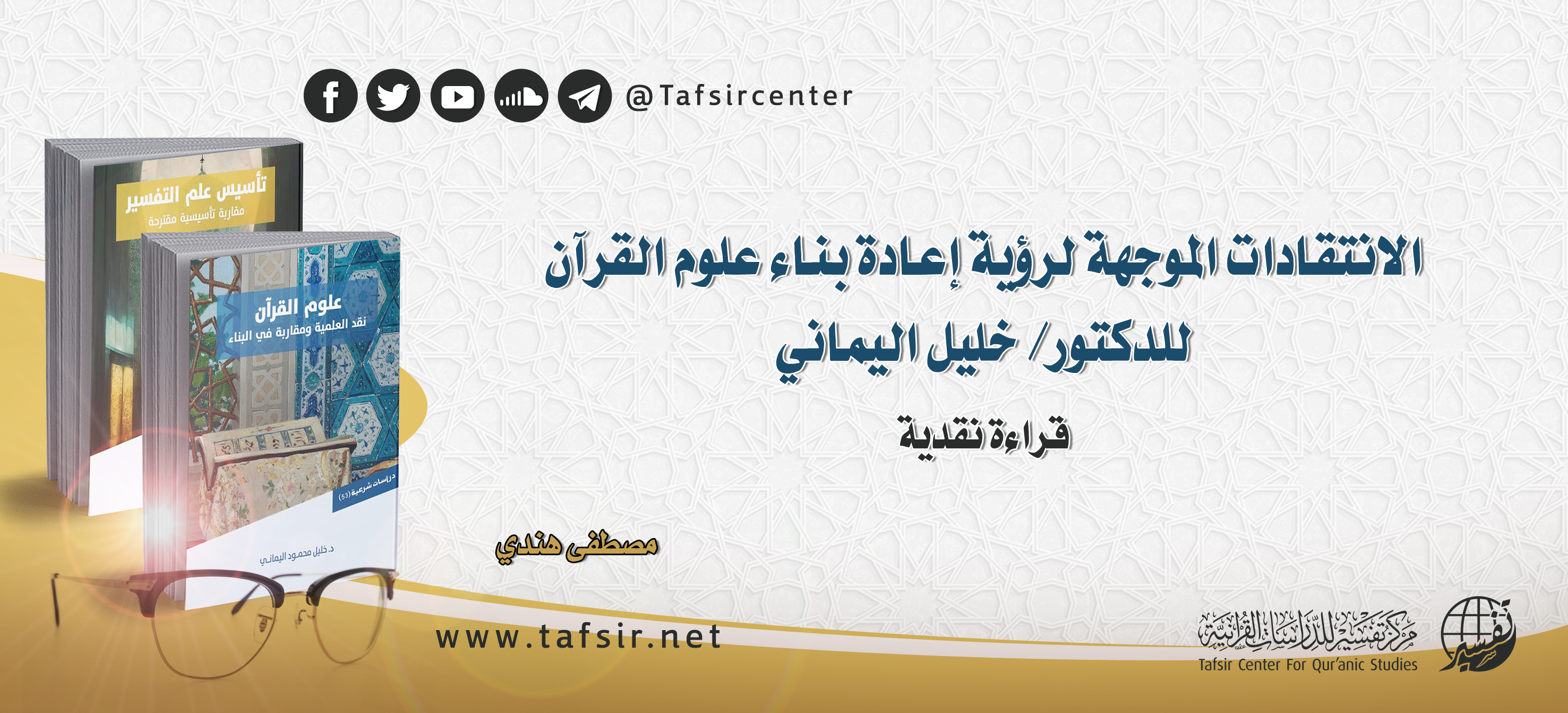الإعجاز الغيبي في القرآن بين الإثبات والنفي (2-3)
الإعجاز الغيبي في القرآن بين الإثبات والنفي (2-3)
الكاتب: محمود عبد الجليل روزن

خلصنا في المقالة الأولى من هذه السلسلة[1] إلى أنَّ الإعجاز الغيبيّ في القرآن الكريم حقيقة لا تُنكَر، ولا ينتصبُ للمماري فيها صراطٌ إلا على ظهر المماحكة اللفظيّة، والمنازعة في الاسم لا في الـمُسمَّى.
وفي هذا المقال الثاني من السلسلة نتوجَّه للإجابة عن السؤال الشائك: هل يدخل الإخبار بالمغيّبات في جملة المتحدَّى به؟
إنَّ منشأ التحدّي بالقرآن أنَّ المكذّبين يشكّكون في الآيات، مع علمهم بأنَّهم لا يقدرون على المجيء بمثلها، فينسبون ذلك إلى قُوى أخرى غير الله تعالى، كأنْ ينسبوها إلى السِّحر الذي يُستعان عليه بالجنِّ، كما في قوله تعالى: {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ}[المائدة: 110]، وكما في قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ}[النمل: 13]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وادَّعى الكفارُ أن القرآن قولُ شاعر، وقولُ كاهن، وأنَّه سحرٌ يؤثَر. ولـمَّا كان الشعرُ صنعتَهم، وكان السِّحرُ والكهانةُ غيرَ خارجَين عن طَوْق تعاطي البشر؛ تحدَّاهم الله -عز وجل- أن يأتوا بمثله، فكأنَّه يقول لهم: إن كان شاعرًا فما يمنعكم -وأنتم الشعراء- أن تقولوا مثله؟ وإن كان كاهنًا أو ساحرًا فما أساطين السحرة والكُهّان منكم ببعيدٍ، فلتستعينوا بمَن شئتم منهم من الجنّ والإنس، ولتستعينوا بمَن شئتم وبمَن استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فلتأتوا بمثله. فإن لم تفعلوا -ولن تفعلوا- فاعلموا أنَّما أُنزل من عند الله -عز وجل-، وأنَّ الجائي به رسولٌ صادقٌ مُصدَّق.
والقرآنُ الكريمُ هو الرسالةُ الخاتمةُ إلى الإنس والجنّ، وعددُ مَن هم مخاطبون به ممن لم يروا الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يشاهدوا سائرَ آياته هم السواد الأعظم من أمَّة دعوته -صلى الله عليه وسلم-، وما معاصروه -صلى الله عليه وسلم- في جملة أمّة دعوته إلا أقلّ القليل، فلم يَبقَ لهؤلاءِ من براهين صدق نبوته إلا القرآن الكريم، وأمورٌ مُتفرّقات مردُّ اعتبار حُجِّيتها والتصديق بإعجازها إلى الإيمان بالقرآن الكريم، فصار القرآن الكريم من هذا الوجه جماع آياته وبراهين نبوته، وإلى ذلك أشار قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من الأنبياء من نبيٍّ إلا قد أُعطي من الآيات ما مثلُه آمَنَ عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيتُ وحيًا أوحى اللهُ إليَّ، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعًا يوم القيامة»[2].
ولا يُفهم من ذلك أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُعطَ غيره من الآيات، ولا أنَّ غيره من الأنبياء لم يُعطَوْا من الوحي ما آمن عليه البشر، وإنما المراد -والله أعلم- ما أشرنا إليه من أنَّ القرآن لا يلزم أن يسمعه المدعوُّ إليه مُشافهةً من النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا أن يكون عصريَّه، بل جُلُّ المخاطبين به ليسوا كذلك؛ لأنهم جاؤوا بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم إن الإيمان به يُهيئ المؤمن للوقوف على سائر آيات النبي -صلى الله عليه وسلم- الأخرى بخلاف القرآن. وأمّا سائر الرسل -صلوات الله عليهم- كانت رسالتهم تنقطع بموتهم، فيُرسِل الله -عز وجل- للناس الأنبياء بالوحي مصدقًا لما بين يديه من الوحي ومبيّنًا وناسخًا، فلم ينقطع الوحي بموت المتقدِّمين. ولما شاء الله تعالى أن تستمرّ شريعة موسى -عليه السلام- وقتًا طويلًا أرسل النبيِّين يحكمون بالتوراة وعقّبهم الربّانيون والأحبار، ثم خلفهم مَن حرَّف وبدَّل حتّى جاء عيسى -عليه السلام- بالإنجيل مصدقًا لما بين يديه من التوراة، فأحلَّ لهم بعض الذي حُرِّمَ عليهم، وردَّهم إلى الأصل الأوّل.
ولما كان تقدير الله تعالى أن تُختم النبوات بمحمد -صلى الله عليه وسلم- تكفَّل بحفظ القرآن من التحريف ليظلَّ هو الرسالة الخاتمة إلى أن يُرفع من الصدور والسطور، فكان هو الآية التي تقوم بها الحُجَّة على المخاطبين به من الإنس والجنّ إلى يوم القيامة؛ ولذا رجا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون أكثر الأنبياء تابعًا.
ولما كان القرآن في ظاهره كلامًا؛ فقد يتبادر إلى ذهن المتشكّك أنه مما لا يُعجِز أن يؤتى بمثله، وهذا واقع في القديم وفي الحديث، قال تعالى حاكيًا عن بعض الكفّار: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}[الأنفال: 31].
فأخضعهم بأنْ طالَبهم أن يأتوا بمثله، فقال تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ}[الطور: 33، 34]، ودعا المخاطبين به من الإنس والجنّ إلى التمالؤ على ذلك، ورخّص لهم في الاستعانة بمن شاؤوا والتظاهر بهم عليه فقال: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا}[الإسراء: 88]، وقال: {وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}[البقرة: 23]، وقال: {وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}[يونس: 38، هود: 13]، فانقطعوا وأُبلِسوا واستبان عجزهم لمن كان عنده مسكة من عقل أو أثارة من علم.
فهؤلاء هم المتحدَّوْن بالقرآن في الحقيقة: عموم المخاطبين به من الإنس والجنِّ، لا العرب فقط أو الإنس فقط، كما ذهب إليه بعضهم[3]. ولا يزال التحدّي قائمًا إلى أن يُرفع القرآن من السطور والصدور؛ إيذانًا بوشك قيام الساعة.
فما المتحدَّى به حقيقة؟ أن يأتوا بكلام يُساميه في النَّظم والبلاغة فقط؟ أم تحدَّاهم أن يأتوا بكلامٍ مثله من كلِّ وجهٍ؟
ظاهر قوله تعالى: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ}[الطور: 34]، وقوله تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا}[الإسراء: 88]، يدلُّ على المماثلة بين القرآن وبين المطلوب الإتيان به من كلّ وجهٍ، سواء في صفاته المصرّح بها، أو في صفاته المستنبطة بالنَّظر والاستقراء. فأمَّا صفاته المصرّح بها فإنها نعوتٌ لم يتركها الله -عز وجل- لتخمينٍ أو حَدْسٍ، وإنما بيَّن في القرآن صفة القرآن، كما بيّن أسماءَه -عز وجل- وصفاتِه، وكما أنَّ أسماء الله تعالى وأوصافه ذاتُ معانٍ ومدلولات صادقة، فكذلك صفات القرآن الكريم ذات معانٍ ومدلولات صادقة، وليست كأسماء البشر، فقد يتسمّى أحدهم (أشرف) أو (أكرم) وليس لهما من الشرف والكرم شروى نقير، وليست كذلك أسماء الله وصفاته، ولا أسماء القرآن وصفاته.
فوصف اللهُ -عز وجل- القرآنَ بأنه حقٌّ مبين، وأنه بيانٌ وتبيانٌ وعربيٌّ وهُدًى وبصائرُ ونورٌ ورُوح ورحمة وفرقانٌ، وعليٌّ ومجيدٌ وعزيزٌ وحكيم وحِكمةٌ وحُكمًا وذكرى وذكرًا وبُشرى وعصمة وشفاء وأنه صدق وتصديق لِما بين يديه من الكتاب ومهيمنٌ عليه... وغير ذلك من الأوصاف ذات المدلولات المعلومة من لغة العرب، والمفسّرة في مواضعها من كتب التفسير بأوضح بيانٍ.
وإنما عجز البشر عن الإتيان بمثله؛ لاستحالة أن يأتوا بكلامٍ متحقق بتلك الأوصاف الجليلة، فكما أنَّهم عاجزون عن إحياء الموتى بردّ الروح إليهم، فإنهم عاجزون عن الإتيان بمثل كلامٍ وَصَفَه الله تعالى بأنَّه روحٌ ونورٌ: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا}[الشورى: 52]، فالفرق بين القرآن وبين كلام سائر المخلوقين؛ كالفرق بين الحيّ الذي لا يموت سبحانه، وبين سائر خلقه الفانين.
ولعلَّ أوّل مَن وضع يده على شيءٍ من هذا المعنى -وإن لم يُحكم عليه قبضته- الإمامُ الخطّابي؛ إذ يقول: «قلتُ في إعجاز القرآن وجهًا آخر ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذُّ من آحادهم، وذلك صنيعُه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنَّك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظَّها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق، وتغشّاها الخوف والفرَق، تقشعر منه الجلود، وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها، فكم من عدوّ للرسول -صلى الله عليه وسلم- من رجال العرب وفتّاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقَتْله فسمعوا آيات من القرآن، فلم يلبثوا حين وقعَت في مسامعهم أن يتحوّلوا عن رأيهم الأول، وأن يركنوا إلى مسالمته، ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاة، وكفرهم إيمانًا»[4].
وما هذه الأمور إلا آثارٌ من مدلولات صفات القرآن، فهو الموصوف بأنه بشيرٌ نذيرٌ موعظةٌ عَلِيٌّ حكيمٌ عزيزٌ مهيمنٌ رحمةٌ هُدًى بصائرُ عصمةٌ شفاءٌ لما في الصدور، ذكرٌ تقشعر منه الجلود، وتلين إليه القلوب والجلود، لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الردّ... وغير ذلك.
فكلامٌ هذه صفتُه لا بّد أن يقع لتاليه ما ذكره الخطّابيّ، وأكَّده غيره، وقد سُئل بندار الفارسي عن موضع الإعجاز من القرآن فقال: «هذه مسألة فيها حَيفٌ على المفتي، وذلك أنه شبيه بقولك: ما موضع الإنسان من الإنسان، فليس للإنسان موضع من الإنسان؛ بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته ودللت على ذاته، كذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه، ومعجزة لمحاوله، وهدى لقائله، وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه فلذلك حارت العقول وتاهت البصائر عنده»[5].
وهذا القاضي عياض يعدُّ من وجوه إعجاز القرآن «الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطره وهى على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورًا كما قال تعالى، ويودون انقطاعه لكراهتهم له... وأمّا المؤمن فلا تزال روعتُه به وهيبتُه إياه مع تلاوته تُوليه انجذابًا وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به. قال الله تعالى: {تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الزمر: 23]، وقال: {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}[الحشر: 21]. ويدلُّ على أنَّ هذا شيءٌ خُصَّ به، أنه يَعتري مَن لا يَفهم معانيه ولا يعلم تفاسيره، كما رُوي عن نصرانيّ أنه مَرّ بقارئٍ فوقف يبكي، فقيل له: مِمَّ بكيت؟ قال: للشجا والنظم. وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده، فمنهم مَن أسلم لها لأول وهلة وآمن به، ومنهم من كفر، فحُكي في الصحيح عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب بالطور، فلمّا بلغ هذه الآية: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ}[الطور: 35- 37] كاد قلبي أن يطير للإسلام. وفي رواية: وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي...»[6].
ثم قال القاضي: «قد عدَّ جماعة من الأئمة ومقلِّدي الأمة في إعجازه وجوهًا كثيرة؛ منها: أنّ قارئه لا يمَلُّه وسامعَه لا يمُجُّه بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة وترديده يوجب له محبة، لا يزال غضًّا طريًّا، وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه يُمَلّ مع الترديد، ويُعادَى إذا أُعيد، وكتابنا يُستلَذُّ به في الخلوات ويؤنس بتلاوته في الأزمات، وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك؛ حتى أحدث أصحابها لها لحونًا وطرقًا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على قراءتها، ولهذا وصف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القرآن بأنه لا يخلَق على كثرة الردّ، ولا تنقضي عِبَرُه ولا تفنى عجائبه، هو الفصل ليس بالهزل، لا يشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، هو الذي لم تنتهِ الجن حين سمعته أن قالوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا}[الجن: 1]»[7].
وقال ابن كثير: «ومَن تدبَّر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، قال الله تعالى: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}[هود: 1]، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكلٌّ مِنْ لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير، ونهى عن كل شر كما قال: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا}[الأنعام: 115]، أي: صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأحكام، فكُلُّه حقٌّ وصدق وعدل وهدًى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر: إنّ أعذبَه أكذبُه، وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معيّن أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع، أو شيء من المشاهدات المتعيّنة التي لا تفيد شيئًا إلا قدرة المتكلم المعبِّر على التعبير عن الشيء الخفيّ أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيها بيتًا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد، وسائرها هذر لا طائل تحته.
وأمّا القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلًا وإجمالًا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إنْ تأمّلْتَ أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حَلا وعَلا، لا يخلق عن كثرة الردّ، ولا يملّ منه العلماء، وإنْ أخَذَ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصُّم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟ وإنْ وَعَدَ أتى بما يفتح القلوب والآذان، ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[السجدة: 17]، وقال: {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[الزخرف: 71]، وقال في الترهيب: {أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا}[الإسراء: 68]، {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ}[الملك: 16، 17]، وقال في الزجر: {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ}[العنكبوت: 40]، وقال في الوعظ: {أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ}[الشعراء: 205- 207]، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة، وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي، اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فأوعها سمعك؛ فإنه خيرٌ ما يأمر به أو شرٌّ ينهى عنه؛ ولهذا قال تعالى: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}[الأعراف: 157] الآية، وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال، وفي وصف الجنة والنار، وما أعدّ الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم؛ بشَّرت به وحذّرت وأنذرت، ودَعَت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهّدت في الدنيا ورغّبت في الأخرى، وثـبّـتت على الطريقة المثلى، وهَدَت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفَت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم»[8].
ويقول الدكتور مصطفى مسلم: «ولا شك أن القول بالصَّرْفة كان نتيجة للتفكير الفلسفي المجرد عن نور الهداية، حيث نظر القائلون بها إلى أن القرآن مؤلَّف من كلمات عربية معروفة باستطاعة البلغاء أن يأتوا بمثلها، فإذا عرفت المفردات أمكن التوصل إلى تركيبها، وإذا عرفت التراكيب أمكن تأليفها، وفاتهم أن المفردات والتراكيب تحتاج إلى الصبغة الإلهية واللمسة الربانية حتى تضفي عليها الإشراق والحياة فيسري فيها الروح فتكون معجزة: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ}[الشورى: 52، 53]. إنّ مثل هؤلاء كمثل الطبيعيين اليوم ينظرون إلى الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان، ويحاولون تحليلها إلى المواد الأولية التي تتكوّن منها. يحاولون بواسطة هذه التحليلات معرفة سر الحياة وإيجاد إنسان أو حيوان أو نبات في المعمل. لقد فات هؤلاء أيضًا أن النفخة الإلهية هي سر الحياة، فلولا هذه النفخة الإلهية لما تكوّنت الحياة في المواد الأولية، ولولا الصبغة الربانية لما كانت الكلمات العربية معجزة»[9].
ثم إذا ذهبنا نُحلّل مضمون الخطاب القرآنيّ اتّضحت لنا صفاتٌ أخرى؛ منها أنَّه متضمّن لقصص الأولين لا تكاد سورة تخلو منه، وقد وصف الله قصصه بأنَّه القصصُ الحقُّ، كما قال تعالى: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[آل عمران: 62]، فهو القصص الحقُّ على الحقيقة، وكلُّ ما عَدَاه يدخله الكذب لا محالة، كما وصفه بأنَّه أحسن القصص كما قال تعالى: {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ}[يوسف: 1- 3]، فكلُّ ما عدَاه نازلٌ عن رتبته في الحسن لا محالة.
وبهذا، يستبين أنَّ مَن رام أن يُعارِض القرآن فعليه -إن كان صادقًا- أن يأتي بمثله في صفاته المصرّح بها، ومنها -وليس كلها- نظمُه وبلاغتُه وبيانُه العربيّ، وأن يأتي بمثله في متضمَّناته ومشتملاته، ومنها الأخبار الغيبية، فإن لم يفعل لم يكن آتيًا بمثله.
وإذن، فحقيقة التحدّي بالإخبار بالغيب أن يأتوا بكلامٍ على غرار القرآن في اشتماله على ذكر الغيب، وعن الأخبار الغيبية التي يثبت صدقها بنحو ثبوت صدق أخبار القرآن ما كان منها عن الماضي وما كان منها إنباءً بالمستقبل، وما كان منها كشفًا للسرائر، وإنباءً في الضمائر، وما كان منها إنباءً بالسنن السائرة الـمُطَّردة التي لا يزيدها مرّ الزمان إلا تأكُّدًا واستقرارًا، فلن تجد لسنّة الله تبديلًا ولا تحويلًا.
وليس للمتحدَّى إلا أن يكون مُتصوِّرًا لما هو مطلوبٌ منه، ولا معنى لحدّ بعضهم التحدِّي بأن يكون من جنس ما برع فيه الـمُتحدَّى، وإن كان التحدّي بذلك أبلغَ.
فإذا أصرَّ بعضهم على أن يكون الـمُتحدَّى به من جنس ما برع فيه المتحدَّوْن فهذا دليلٌ آخر على أنَّ الأمر المتحدَّى به في القرآن الكريم غير محصور في وجهٍ واحدٍ، ذلك أنَّ المتحدَّيْن بالقرآن عموم أمة الدعوة المحمدية من الإنس والجنّ، فناسب أن يجدَ كلٌّ منهم في المتحدَّى به شيئًا مما برع هو فيه، واختّص بحذقه. فتأمل!
ويصحُّ لنا -حينئذ- الاستئناس لكون الإخبار بالغيب داخلًا في شرط التحدّي؛ بأنَّه أدخل الجنَّ في المتحدَّيْن به، وبراعة الجنّ إنما تكمن في ادّعائهم علم الغيب، بما كانوا يسترقون من السمع إلى خبر السماء، فيخطفون الخطفة ويبنون عليها مائة كذبة. وقد بُكِّتوا بدعواهم، فقال تعالى في شأن سليمان: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ}[سبأ: 14]، وهو ما حرص مؤمنو الجنّ على الإقرار به، كما قال تعالى حكايةً عنهم: {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا}[الجن: 10]، ثم أكّدت السورة الكريمة ذلك: {قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا * عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا * لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا}[الجن: 25- 28].
فالتصريحُ بدخولهم في جملة المتحدَّيْن إشارةٌ إلى أنَّ ما ادَّعوه لأنفسهم، وادَّعاه لهم رجال من الإنس، من قدرتهم على علم الغيب؛ ليس بمسعفهم للإتيان بمثله، فليفعلوا إن كانوا صادقين، ولو تظاهروا عليه وتمالؤوا، فليستعينوا بالجنّ في الكشف عن المغيّبات، وليستعينوا بأرباب الصناعات من أمم الإنس المختلفة في تحرير حقائق صناعاتهم، ثم ليدفعوا ذلك إلى الحكماء والفلاسفة والمناطقة ليودعوه شيئًا من حكمتهم وفلسفتهم ومنطقهم، ثم ليدفعوا كلّ ذلك إلى العرب الأقحاح أهل الفصاحة لينظموه هذا النظم المعجز، ثم ليستعينوا على ذلك بالزَّمن وما يصلون إليه من علومٍ ومبتكراتٍ، لعلّهم يستطيعون أن يأتوا بمثله. هذا هو ما يجب أن يُفهم من استفزازهم إلى التعاضد والتمالؤ والتظاهر إنسًا وجنًّا، وهذا هو التحدّي الحقيقيّ، لا ما ذهب إليه بعضُهم من أنَّ التحدّي منوطٌ بالعربِ فقط أن يأتوا بمثل بلاغته، فإنْ عجزوا وهم أرباب الفصاحة؛ فسواهم من الإنس أعجز، وإنْ عجز الإنس وهم الجنس الأشرف والأكمل؛ فالجنّ أعجز. فشتّان ما بين تصوير التحدي على الوجه الأول الذي ذهبنا إليه، وعلى الوجه الثاني الذي يذهب إليه بعض الباحثين.
ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: {فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ * أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ * قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ * أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ * أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ}[الطور: 29- 34]، فنَفَى عنه الكهانة والجنون المقتضي أن يكون له رَئِيٌّ من الجنّ يخبره بالغيب، ونفَى عنه الشِّعر الذي قد يُبرّر هذا النظم الفريد، ونفى عنه الكذب والتقوُّل، ثم تحدَّاهم بأن يأتوا بمثله، فعُلِمَ أنَّ أخباره الغيبية ليست مستقاةً من المصادر التي اقترحوها، كما أنَّه ليست مما يمكن أن ينتجها الكذب والتقوُّل، إذ لو كانت كذلك لكان خطؤها هو الأصل، وصوابها هو الاستثناء الذي يُثبت التقوّل ولا ينفيه، ثم إنَّ نظمه مما يتعالى على الشعر الذي يحذقونه كما يحذقون النَّفَس، فإن كانوا في شكٍّ من ذلك فليجرّبوا أن يأتوا بمثله في نظمه وفي إخباره بالمغيّبات تشاعرًا وتكهُّنًا وتقوُّلًا.
وانظر إلى قيلِ أُنَيسٍ أخي أبي ذر -رضي الله عنهما- في قصة إسلامه: «لقد سمعتُ قول الكهنة، فما هو بقولهم، ولقد وضعتُ قوله على أَقْراءِ الشعر، فما يلتئم على لسان أحدٍ بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق، وإنهم لكاذبون»[10]، فاعتبَر بصدقه وكذبهم، فعُلِم أنَّ القرآن مباينٌ لقول الكهنة والشعراء من جهة أنَّه صِدقٌ وأنَّهم كاذبون.
ولمّا ادّعوا قدرتهم على أن يقولوا مثله وصَفوه بأنّه أساطير الأولين، قال تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}[الأنفال: 31]، فما لمحوا فيه إلا أنَّه أساطير الأولين، فتوجّه فِكرهم في المعارضة نحو مضمونه الذي هو -في زعمهم- أساطير الأولين.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي من شياطين قريش، وكان يؤذي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وينصب له العداوة، وكان قد قَدِمَ الحيرة، تعلَّم بها أحاديث ملوك فارس، وأحاديث رستم وأسفنديار، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس مجلسًا فذكَّر بالله، وحدَّث قومه ما أصاب مَن قبلهم مِن الأمم من نقمةِ الله، خَلَفه في مجلسه إذا قام، ثم يقول: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه، فهلُمُّوا، فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار، ثم يقول: ما محمد أحسن حديثًا منّي. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في النضر ثماني آيات من القرآن، قوله: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ}[القلم: 15]، وكل ما ذكر فيه الأساطير في القرآن»[11].
ويؤكّد أصالة التحدّي بالإخبار بالمغيّبات على الوجه الذي وضحّناه أنَّ ألفًا وأربعمائة سنة ونيِّفًا لم تُسقط التحدّي بل زادته ظهورًا وجلاءً بما استحدثه البشر من علومٍ أثبتَت صدق القرآن، وأنَّه من المستحيل أن يكون قائلُه رجلًا عاش قبل ألف وأربعمائة سنة، فلا بد أنَّه أُنزل بعلم الله، وأنَّ تلك العلوم نفسها لا تمكّن البشر من أن يفْجرُوا الغيبَ فيتنبّؤوا بحقائق كثيرة مفصّلة تقع خلال ألف وأربعمائة سنة قادمة، ولا نِصْف تلك المدة، ولا عُشرها، فما زال التحدّي قائمًا، والعجز حاصلًا، والحصر شاملًا.
قال القاضي عياض في معرض تعليقه على حديث: «ما من الأنبياءِ من نبيٍّ إلا قد أُعطي من الآيات ما مثلُه آمَن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيتُ وحيًا أوحى اللهُ إليَّ، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعًا يوم القيامة»[12]، قال: «وفيه وجه آخر وهو: أنَّ سائر معجزات الأنبياء انقرضت بانقراضهم، ولم يشاهدها إلا ما كان حاضرًا لها، ومعجزة نبينا -صلى الله عليه وسلم- من القرآن وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته بَيِّـنة لكل من يأتي إلى يوم القيامة، إلى ما انطوى عليه من الإخبار عن الغيوب، فلا يمر عصر إلا ويظهر فيه معجزة مما أخبر أنها تكون، تدلُّ على صدقه وصحة نبوته وتُجدِّد الإيمان في قلوب أمّته»[13].
وأمَّا لو قصرنا التحدّي على النَّظم والبلاغة فإنَّ حجّيته لا تحصل لأصحاب تلك العصور بهذه السهولة، إذ إنَّ الوصول لذلك يقتضي سلوك أحد طريقين؛ الأول: أن يثبت لديه إبلاس الأولين، وأنَّهم إذ أُفحموا وهم أرباب البلاغة فالخَلَفُ أولى بذلك. والثاني: أن يحاولوا ذلك فيتبيّن بمعيار صحيحٍ أنَّ ما جاؤوا به نازلٌ عن رتبة نظم القرآن وبلاغته.
فإن وُجد فيهما منازِعٌ في العصور المتأخرة -وخصوصًا من غير العرب- فردُّه إلى جادَّة الصواب ممكنٌ إن كان مُنصِفًا، ولكنه يستلزمُ الكثير من الجهد والوقت. وأمَّا بتوسعة نطاق التحدّي ليشمل المعاني على الوجه الذي وضّحناه فلا يستطيع أن ينازع في ذلك منازعٌ للوهلة الأولى، ولا بتقليب النَّظر ورجعه كرّة بعد كرّة. والله المستعان.
وقد أحسن الإمام ابن عاشور التعبير عن هذا المعنى فقال: «وهذا النوع من الإعجاز [يعني الإعجاز العلمي الراجع إلى الإخبار بالمغيّبات] هو الذي خالف به القرآن أساليب الشعر وأغراضه مخالفة واضحة. هذا والشاطبي قال في (الموافقات): «إن القرآن لا تُحمل معانيه ولا يتأوّل إلا على ما هو متعارَف عند العرب»، ولعلَّ هذا الكلام صدر منه في التفصي من مشكلات في مطاعن الملحدين؛ اقتصادًا في البحث وإبقاءً على نفيس الوقت، وإلا فكيف ينفي إعجاز القرآن لأهل كلِّ العصور، وكيف يقصر إدراك إعجازه بعد عصر العرب على الاستدلال بعجز أهل زمانه إذ عجزوا عن معارضته، وإذ نحن نسلم لهم التفوق في البلاغة والفصاحة، فهذا إعجاز إقناعي بعجز أهل عصر واحد، ولا يفيد أهلَ كلّ عصر إدراكُ طائفة منهم لإعجاز القرآن»[14].
فكأنَّ المكلّفين جميعًا إنسًا وجنًّا على اتّصالِ بقائهم في الدنيا مذ تحدَّاهم إلى أن يبلغوا أجَلَهم الذي أجَّل لهم؛ في العجز كيانٌ واحدٌ، ولو كانت مَلكاتُه جِماعَ ملكاتهم، وقدراتُه مِلاكَ قدراتهم.
وبذا؛ يستبين لك وجه المغالطة في كلام الأستاذ محمود شاكر إذ يقول: «فهذا التحيُّر المظلم الذي غشَّاهم [يعني قريشًا]، وأخذ منهم بالكظم، والذي نعته الوليد فاستجاد النعت؛ كان تحيُّرًا لِما يسمعون مِن نَظْمِه وبيانِه، لا لِما يُدرِكون من دقائق التشريع، وخفيّ الدلالات، وما لا يؤمنون به من الغيب، وما لا يعرفون من أنباء القرون التي خلَت مِن قبل»[15].
فليس الوليدُ وزمرتُه هم كلَّ المتحدَّيْنَ بالقرآن حتى يُلزمنا هذا الكلامُ إخراجَ الإنباء بالغيب من جملة المتحدَّى به. ولو قيل: إنَّ كلام الأستاذ شاكر متوجّه إلى ما وقع به التحدّي لقريش خاصَّةً في أوَّل الأمر فحسب؛ لكان له مساغٌ.
على أنَّ نعت الوليد للقرآن: «والله؛ لقد سمعت من محمد كلامًا آنفًا ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجن، وإنّ أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنَّ له لحلاوة، وإنَّ عليه لطلاوة، [وإن له لَنورًا، وإن له لفرعًا]، وإنه ليعلو وما يُعلى، [وإنه ليحطم ما تحته]»[16]، ليس فيه ما يدلُّ على أنَّه تحيَّر لما سمع من نظمه وبيانه فحسب؛ بل هذه الأوصاف تحتمل الرجوع إلى معانيه كما تحتمل الرجوع إلى نظمه وبيانه، والسبيل الوحيد لقصرها على أحدهما دون الآخر هو التحكُّم الذي لا يعجز عنه أحدٌ.
ضابط الإخبار بالغيب المتحدَّى به:
فإن قيل: ما الضابط للإخبار بالمغيَّبات التي لو صدرت من بشرٍ عُلِم أنَّه جاء بمثل القرآن، وأنَّ القرآن يمكن أن يكون مُختلَقًا؟
فالجواب: يجب ألّا يُنسى ابتداءً أنَّ الإخبار بالغيب ليس هو الوجه الوحيد للإعجاز القرآني، ولا بد أن يأتي هذا الإخبار بالغيب في قالبٍ لُغويٍّ يضاهي القرآن نظمًا وبلاغةً وأسلوبًا وبيانًا. فإن سقط هذا الشرط لا يصحّ الانتقال إلى النَّظَر في فحوى الإخبار المزعوم، كما يرفض مقوّمو سلامة الغذاء الذي حقُّه أن يكون مُعبَّأً النَّظرَ في مفردات سلامته، ومحدّدات جودته التركيبية؛ إن وجدوه بغير عُبوّته.
وهذا الشرط عاصمٌ من الإفك الذي يأتي به بعضهم من خزعبلاتٍ في صورة تنبؤات يخرجونها في لغة غامضة محتملة أشبه بلغة الشفرة يمكن تأويلها على عشرات الأوجه؛ بل على الوجه ونقيضه، ثم يزعمون أنَّها وقعت كما تنبّأ بها المتنبِّئ، ثم يُطيِّرونها كل مطار. وأوضح مثال على ذلك تنبؤات نوستراداموس. فأين هي من تفصيل الأخبار الغيبية الواقعة في القرآن الكريم؟ وأين بيانها من بيانه؟
وأمَّا من حيث هو إخبارٌ بمغيَّب، فيجب أن تجتمع فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون إخبارًا بمغيَّبٍ لا يوصل إليه باستشرافٍ؛ كالتنبؤ بالأرصاد الجوية والكسوف والخسوف وغيرها من الظواهر الطبيعية، وكذا تنبؤات النظريات العلمية المرتفقة على قوانين طبيعية، فتلك -وما جرى مجراها- علوم شهادة وإن ظنَّها بعضهم علومَ غيب.
2- ألَّا يكون مُستقًى من وحيٍ سماويٍّ صحيحٍ، وإلّا لكانوا كَمَن رام معارضة نظم القرآن فعمد إلى بعض ألفاظ الآية، واستبدل بها ألفاظًا ترادفها على نفس وزنها وجرسها. ويمكن القول إنّ ما أخبر به الوحي الصحيح غير المحرّف مما هو صريح الدلالة صار في حكم علوم الشهادة، فإن اتَّكأ عليها المتنبئ لم يكن -في الحقيقة- مخبرًا بغيبٍ.
3- ألّا تعارض في الإمكان عِلمًا ضروريًّا ولا عِلمًا نظريًّا قطعيًّا. ولا يصحُّ هنا أن يقال إنَّ العلم الضروريَّ يفتقر إلى معيار يضبطه، فهذا مُنافٍ لتعريف العلم الضروريّ أو الضرورات العقلية[17].
4- ويلزم منه أن يكون المخبَر به مؤتلِفًا غير مختلف، ولا يناقض بعضه بعضًا؛ إذ العلم القطعيُّ لا يعارض بعضه بعضًا.
5- ألّا يكذِّبه مَرُّ الزمن وتقدُّم العلوم والمكتشفات، فإنْ تحقَّق صدقُ وقوعه بعدُ بما يستجدُّ من معارِفَ وعلومٍ، وبما ينكشف عنه مرُّ الزمن، كان أقطع بالوفاء بالمراد.
6- وكلَّما وقع لهم في قدر القطعة المتحدَّى بها عددٌ صالحٌ من تلك الأخبار يربو على ما تحتمله الصدفةُ -بالقوانين الإحصائية التي يعرفها المتخصصون في علم الإحصاء- كان أقطع بوفائهم بالمراد.
7- وكلَّما توزَّعت أخباره على مجالات الغيب المختلفة كان أقطع بالوفاء بالمراد.
[1] المقالة الأولى: (هل في القرآن إعجاز غيبي؟) على هذا الرابط: tafsir.net/article/5326.
[2] أخرجه البخاري في صحيحه (ح4981، ح7274). ومسلم في صحيحه (ح152).
[3] قال الرماني: «فإن قال قائل: فلم اعتمدتم على الاحتجاج بعجز العرب دون المولَّدِين، وهو عندكم معجز للجميع، مع أنه يوجد للمولّدين من الكلام البليغ شيء كثير؟ قيل: لأن العرب كانت تقيم الأوزان والإعراب بالطباع، وليس في المولدين مَن يقيم الإعراب بالطباع كما يقيم الأوزان، والعرب على البلاغة أقدر لما بيّنّا من فطنتهم لما لا يَفطن له المولَّدون من إقامة الإعراب بالطباع، فإذا عجزوا عن ذلك فالمولدون عنه أعجز». النكت في إعجاز القرآن، للرماني (ص113).
وقال الزركشي، وهو من كلام السبكي وإن لم يصرح به الزركشي: «التحدي إنما وقع للإنس دون الجن؛ لأن الجنَّ ليسوا من أهل اللسان العربي الذي جاء القرآن على أساليبه، وإنما ذكروا في قوله: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ} تعظيمًا لإعجازه؛ لأن الهيئة الاجتماعية لها من القوة ما ليس للأفراد، فإذا فرض اجتماع جميع الإنس والجن وظاهر بعضهم بعضًا وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد أعجز». انظر: فتاوى السبكي (2/ 616- 617)، والبرهان في علوم القرآن (2/ 111).
ويقول الدكتور مساعد الطيار: «ومع تكاثر وجوه الأدلة الدالة على صدقه إلا أنني أوكِّد على أنَّ المقصودين أولًا بهذا التحدي هم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، أمّا مَن عداهم من الأمم إلى قيام الساعة فهم تبع لهم في هذا؛ لأنه إذا عجز العرب الذين هم أرباب الفصاحة والبيان وأصحاب اللغة التي نزل بها القرآن فمن باب أولى أن يعجز غيرهم؛ لأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى درجة العرب في البيان» [شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، للدكتور الطيار، نشرة دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1431هـ، ص282]. وهو قول ناتجٌ عن حصر المتحدَّى به في بلاغة القرآن وأسلوبه ونظمه فقط، وظاهر القرآن بخلافه كما بيَّنَّا، وهو دليل آخر على عدم دقّة هذا الحصر. وفيه تقليلٌ من شأن التحدّي بقصره على قبيلة واحدةٍ في حقبة محدودة من الزمن، وفيه جعل إقامة حجّة القرآن على جُلّ المخاطبين به من الإنس والجنّ في كلِّ عصر ومصر تبعًا لا كفاحًا. علاوة على أنَّ في مذهب السبكيّ والزركشي ومن تبعهما قطعًا بأنَّ الجنّ ليسوا من أهل اللسان العربيّ، وهذا من الرجم بالغيب. ولعلَّ ظاهر الدليل النقليِّ على خلافه إذ ثبت أنَّ وفود الجنّ لقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- غير مرَّة، وأنَّهم سمعوا القرآن وفهموه، ثم ولَّوْا إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان به، وأنهم خاطبوا الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخاطبهم، وسألوه وأجابهم. فهذا ظاهره أنَّهم يتقنون اللسان العربي، والله أعلم بلغتهم ولسانهم وبما كان من هيئة حديثهم مع النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولو قيل إنهم ليسوا من أهل اللسان العربي، ولكنهم يقدرون أن يتعلموه كما يحصل من الإنس إذ يتعلَّم بعضهم أكثر من لغة؛ فما الذي يمنع حذقهم لها بعد تعلُّمها حتى يبزّوا فيها بعض أهلها؟
[4] بيان إعجاز القرآن، للخطابي (ص70).
[5] البرهان في علوم القرآن، للزركشي (2/ 100).
[6] الشفا، للقاضي عياض (1/ 226- 227).
[7] الشفا، للقاضي عياض (1/ 229- 230).
[8] تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ط دار طيبة، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط2، 1420هـ= 1999م (1/ 199- 200).
[9] مباحث في إعجاز القرآن، للدكتور مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط3، 1426هـ= 2005م (ص68).
[10] أخرجه مسلم في صحيحه (ح2473).
[11] جامع البيان، للطبري، ط دار هجر، القاهرة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، 1422هـ= 2001م (17/ 399).
[12] أخرجه البخاري في صحيحه (ح4981، ح7274). ومسلم في صحيحه (ح152).
[13] إكمال المُعْلِم بفوائد مُسْلِم، للقاضي عياض، دار الوفاء، تحقيق: د. يحيى إسماعيل، ط1، 1419هـ= 1998م (1/ 467).
[14] التحرير والتنوير، لابن عاشور (1/ 128).
[15] مداخل إعجاز القرآن، للأستاذ محمود شاكر (ص160).
[16] انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (4/ 492- 493)، والمستدرك على الصحيحين، للحاكم (ح3872)، ودلائل النبوة، لأبي نعيم (ص234 برقم 186).
[17] يُعرِّف ابن سينا الضرورات العقلية بأنها: قضايا ومقدّمات تحدث في الإنسان من جهة قوّته العقلية من غير سبب يُوجب التصديق بها إلّا ذواتها، ومثال ذلك: إدراك أنَّ الكلَّ أعظم من الجزء، فإنَّ هذا الحكم غير مستفاد من حسٍّ ولا استقراء ولا شيء آخر. انظر: النجاة في المنطق والإلهيات، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط1، 1412هـ (1/ 81).
ويقول التفتازاني: «أمّا البديهيات، وتسمّى أوَّليّات؛ فهي قضايا يحكم العقل بها بمجرّد تصوُّر طرفيها؛ كالحكم بأنَّ الواحد نصف الاثنين، والجسم الواحد لا يكون في آن واحدٍ في مكانين». انظر: شرح المقاصد، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1419هـ (1/ 211).
وعرَّفها الساويّ بأنها القضايا التي يُصدّق بها العقل الصريح لذاته ولغريزيته؛ لا لسببٍ من الأسباب الخارجة عنه. انظر: البصائر النصيرية في المنطق، زين الدين عمر بن سهلان الساوي، تعليق: رفيق العجم، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط1، 1997م (ص220).
والمقصود بأنها تحصل من جهة القوة العقلية: أنها هي المقتضى المباشر للغريزة العقلية، بحيث لا يمكن الاستدلال عليها إلا من جهة مطابقتها للغريزة العقلية؛ ولذا فلا تحتاج إلى استدلال، بل هي أساس كلِّ استدلالٍ عقليّ.
وعليه؛ يُمكن أن نُعرّف المبادئ العقلية بأنها «قضايا يُسلِّم بها العقل الـمُدرِك بمجرد تصوُّرها دون افتقارٍ لـمُصدِّقٍ خارجيٍّ لها».
فقولنا: «قضايا»، أي: أحكام تشمل العقليات والحسيّات، وقولنا: «بمجرّد تصوُّرها» يُخرج عقل الطفل قبل أن يقدر على تصوُّر بعض هذه الحقائق، فعدم إدراكه لها لا ينقض حقيقة أنه مفطورٌ عليها، وأنها مغروسة فيه، وكذلك يُخرج عقول المجانين والبُلَداء متناهي البلادة، وقولنا «دون افتقار لمصدّق خارجيٍّ لها» من مجرّب أو خبر، فمجرّد تصوُّرها كافٍ للحكم بصحّتها.
من بحثنا: (المبادئ العقلية الأولية: أهميتها وخطورة الطعن فيها) مخطوط؛ يسَّر الله نشره.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمود عبد الجليل روزن
الأستاذ المساعد بقسم علوم وتقنية الأغذية بجامعة دمنهور - مصر، وحاصل على عالية القراءات، وله عدد من المؤلفات والبحوث العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))