كتاب (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجَّاج
تحقيق نسبته واسمه (1-2)

كتاب (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجَّاج؛ تحقيق نسبته واسمه (1-2)[1]
لم يكن بين يدي الأستاذ إبراهيم الإبياري[2] وهو يحقق هذا الكتاب إلا أصل واحد من مخطوطات دار الكتب المصرية، وهو أصل قديم كتبه أبو الحسن سالم بن الحسن بن إبراهيم الخازمي بمدينة شيراز سنة عشر وستمائة، إلا أنه لم يَسْلَم من عِلَل يعنينا منها ههنا ما ذكره الأستاذ المحقِّق [ص: 1096] من أن عنوانه ونسبته إلى الزجّاج «تحملها صفحة أولى خطُّها يباين خطَّ الكتاب»، وما أشار إليه [ص: 1095] من أن صَدْر مقدمته قد سقط أيضًا، فإنه لو لم يكن فيه إلا هذا لكان مدعاة إلى تقديم الشكّ في اسم الكتاب ونسبته، إلا أن يصحّ من وجه لا يتطرّق إليه ريب؛ إذ الظاهر أنّ مَن أثبتها إمّا أثبتها اجتهادًا من عند نفسه لا نقلًا عن أصلٍ آخر للكتاب سليم، يُؤْذِن بذلك أنه لم يستدرك ما سَقَط من مقدمته أيضًا.
ويزيد الرّيبة في اسم الكتاب خاصّة أنه جاء في وضعه ونظامه على خلاف المعهود عند المتقدمين في كتب الأعاريب، فإنّ جمهور المؤلّفين في هذا الباب جَروا على تناول السور؛ سورة سورة، وآي كلّ سورة، أو ما يريدون الكلام فيه منها، آية آية على ترتيب التلاوة، لم يشذّ عن ذلك -فيما أعلم- إلا ابن هشام (ت: 761) من المتأخرين، وذلك في كتابه المشهور: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)؛ فإنه وضعه -كما يدلّ اسمه- في إعراب القرآن، ولكنه رغب عن طريقة أسلافه وما تُفضي إليه من تطويل، وآثر أن ينظمه في قوانين كلّية وأصول جامعة، فاصطنع لذلك المنهج الذي بسَطه في مقدمته.
وأما هذا الكتاب فجعله صاحبه في تسعين بابًا، تناول في أبواب يسيرة منها أمورًا منها ما هو أدخل في علم القراءات، ومنها ما يتجاذبه هذا العلم وعلم العربية، وأما الكثرة الكاثرة من أبوابه فعقَد كلًّا منها لظاهرة من ظواهر النحو، أو قضية من قضاياه وما جاء من أمثلتها في التنزيل، ونثر خلال ذلك فصولًا تتناول مسائل شتى من دقائق علم العربية وغوامضه.
ويظهر أن الأستاذ الإبياري بدأ بطبع الكتاب وهو واثق بما جاء في صفحة العنوان من أصله المخطوط، ولا سيما نسبته إلى أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجَّاج (ت: 311)، ومن ثمّ ذهب في بعض تعليقاته في أوائل الكتاب [ص: 16 التعليق: 5] إلى أن عبارة: «يا رازي ما لك وكتاب الله!»، التي جاءت عقب كلام المؤلف في بعض الآي «من زيادات قارئ في الحاشية، فالتبسَتْ على الناسخ، فزادها في المتن»، واحتج لذلك بأن الرازي -وقد ذهب ثمَّة إلى أنّ المعنيَّ الإمامُ محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي (ت: 606)- متأخر الوفاة عن الزجّاج، ولكنه ما إن مضى في الكتاب حتى ساوره الشكّ في اسمه ونسبته، فألمع إلى ذلك في التمهيد الذي صدَّر به القسم الأول منه، وذكر فيه أنّ «حول اسم الكتاب وحول اسم المؤلف دراسة سيكون مكانها في آخر الكتاب». حتى إذا أتمّ طبع الكتاب بأقسامه الثلاثة، وألحقَ به الدراسة الموعودة راجعه -فيما يظهر- الاطمئنان إلى اسم الكتاب، وأما نسبته إلى الزجّاج فلم يتردَّد في دفعها، وحقّ له ذلك؛ فإنّ الكتاب حافل بأدلة وشواهد يكفي كلّ منها لإدحاضها، وفيما ذكره الأستاذ من ذلك -فيما سيأتي نقله عنه- مقنع، وإنما النظر فيما انتهى إليه اجتهاده في تحقيق نسبة الكتاب.
افتتَح الأستاذ تحقيقه في هذا الباب بذِکْرِ مقدمات استخرجها من الكتاب نفسه، ونتائج استخلصها منها وبنَى عليها ما ذهب إليه، وقد آثرتُ أن أنقل ههنا ما قال في ذلك [ص 1096- 1099] بتمامه، لأعقب عليه ما ارتَأيْتُ، وهذا نصه:
«والقارئ للكتاب يجد فيه:
1. نقولًا عن أعلامٍ تأخَّرَت وفاتهم عن وفاة الزجّاج، نذكر لك منهم: أبا بكر بن دريد، وكانت وفاته سنة 321هـ، والجرجاني أبا الحسن علي بن عبد العزيز، وكانت وفاته 366هـ، وأبا سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله، وكانت وفاته سنة 368هـ، وأبا على الفارسي الحسن بن أحمد، وكانت وفاته سنة 377هـ، وابن عيسى الرماني، وكانت وفاته سنة 384هـ، وابن جنِّي أبا الفتح عثمان، وكانت وفاته سنة 392هـ.
2. نقولًا عن الزجّاج نفسه تستوي مع النقول المعزوّة إلى غيره.
3. رجالًا كانت وفاتهم متأخّرة عن وفاة الزجّاج، نذكر لك منهم عضد الدولة فناخسرو، وكانت وفاته سنة 372هـ.
4. إشارات إلى كتب يسمّيها مؤلّف الكتاب، وينسبها إلى نفسه، ويحيل عليها، وهي: أ- کتاب الاختلاف. ب- کتاب المختلف. ج- کتاب الخلاف. د- كتاب البيان.
5. إشارات إلى كتب أخرى لم يسمّها المؤلف، فيقول: وقد استقصينا هذه المسألة في غير كتاب من كتُبنا (113، 114)، ويقول: وقد ذكَرْنا في غير موضع من كتُبنا (174).
6. التحامل على المَشارقة، فيقول وهو يذكر أبا على الفارسي: فارسهم (790، 791) وفارس الصناعة (557). ونقرأ وهو ينقل عن الجرجاني: إمّا العجب من جرجانيكم (897). ويعقد بابًا، وهو الباب الحادي والثمانون، [ما] جاء في التنزيل وظاهره يخالف ما في كتاب سيبويه، ويزيد هذه العبارة اللاذعة: وربما يُشكِل على البُزُل الحُذّاق فيغفلون عنه.
7. وقفته وقفة النِّد للمشارقة يناقشهم الرأي، ويعقِّب عليهم، وترى من هذا الكثير في كتابه، فيقول وهو يناقش الكسائي بعد عَرْض رأيٍ له (152): هذا عندنا لا يصح. ويقول وهو يُعَرِّض بالسيرافي في شرحه لكتاب سيبوبه (297): ألا ترى أن شارحكم زعم.
8. وقد تنضمّ إلى هذا عبارةٌ جاءت تعقيبًا على الرازي (16) وهي: يا رازي ما لَكَ وكتاب الله! وقد كنا أثبَتْنا هذه العبارة في الحاشية بعد أن كانت في سياق النصّ ظنًّا بأنها من زيادات قارئ. وإني أعود فأرفع هذه العبارة من الحاشية إلى النصّ لأضمّها إلى أدلّة التحامل. وأحبُّ أن أضيف أن الرازي المعنيّ في هذه العبارة هو أبو يحيى عبد الرحمن بن محمد المحدِّث المفسِّر، وكانت وفاته سنة 291هـ، وليس هو الرازي الآخر محمد بن عمر الذي كانت وفاته سنة 606هـ؛ إِذْ هذا الرأي الذي يناقشه المؤلف في كتابه لم يرد لابن عمر في تفسيره، ولو أن تفسير عبد الرحمن بين أيدينا لملَكْنا الحجة كاملة، ولكنها على هذا لن تعدو الحقيقة.
وفي ضوء هذه الأدلة نستطيع أن نخلص:
1. إلى أن صاحب هذا الكتاب مغربي لا مشرقي؛ لتحامله على المشارقة هذا التحامل الذي مرّ بك شيء منه، والذي يدلُّك على أن ثمة جبهتين.
والغريب أن المشارقة أحسُّوا هذا من مؤلف الكتاب، وحملَت النسخة التي بين أيدينا بعضًا من تعليقات القرّاء، وهم من المشارقة لا شكّ في ذلك، معها مثل هذا النَّيل من المؤلف، ومن هذه العبارات تلك التي جاءت في (ص: 29): يا قارئ كتاب عثمان -يريد ابن جنّي- ولا تفهمه أبدًا -وهو يريد المؤلف لا شك-.
2. إلى أن صاحب الكتاب كان من العلماء المبرزين، وأنه صاحب تواليف عدة، وأن هذه التواليف منها كثرة في علوم القرآن.
3. إلى أن صاحب الكتاب ليس الزجّاج، بل هو رجل آخر، إن لم يكن من مخضرمي القرنين الرابع والخامس الهجريين؛ فلا أقلّ من أن يكون قد بلغ نهاية القرن الرابع».
ثم قال تحت عنوان: (من هو مؤلف الكتاب):
«ولقد عدتُ أستعرض مَن ألّفوا في إعراب القرآن ونحوه في هدي هذا الذي انتهيتُ إليه فإذا أنا أقف عند رجل منهم لا أكاد أجاوزه إلى غيره، هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني. وكان الذي وقفني عنده لا أجاوزه:
1. أن الرجل مغربي لا مشرقي.
2. أنه من أصحاب التواليف الكثيرة، وأن أكثر هذه التواليف في علوم القرآن.
3. أن هذه المؤلَّفات التي ذُكِرَت في الكتاب منسوبة إلى مؤلِّفهِ ذكرت بين مؤلفات مكي.
4. أن مكيًّا هذا من مخضرمي القرنين الرابع والخامس، فلقد كان مولده سنة 355هـ، وكانت وفاته سنة 437هـ.
وبقي بعد هذا أن الرجل له كتابان يتنازعان هذا الغرض الذي يتناوله هذا الكتاب.
وأول الكتابين: شرح مشكل غريب القرآن، ولا يزال مخطوطًا. وحين رجعت إليه تبيّنتُ أنه ليس هو.
أما ثاني الكتابين فهو: (إعراب القرآن)، وما أظنّ إلا أنه هو المقصود، وما أظنه إلا أنه هو الذي بين أيدينا»[3].
وما انتهى إليه الأستاذ المحقق من أن صاحب الكتاب كان من العلماء المبرزين، وأنه صاحب تواليف عدة، وأن هذه التواليف منها كثرة في علوم القرآن -والأدق أن يقال: تُعنَى بالقرآن- وأنه «ليس الزجّاج، بل هو رجل آخر...» حقّ لا ريب فيه. وفيما ذكره في المقدمات الخمس الأُوَل -وهو صحيح في جملته- أبينُ الدليل على ذلك. وأمّا ما ذكره من تحامل المؤلف على المشارقة، وما بناه عليه من أنه مغربي لا مشرقي، ثم ترجيحه -على هدي ما استخلصه من نتائج- أن يكون هذا المؤلف مكي بن أبي طالب القيرواني (ت: 437) فلا يثبت على النظر. ومن الغريب أن يعُدّ الأستاذ المحقق قول المؤلف في أبي علي الفارسي: (فارسهم) و(فارس الصناعة) من قَبِيل التحامل، وإنما هو ثناء محض لم يظفر منه بمثله غير أبي علي، وليس في سياق كلامه ما يوحي أنه قاله على جهة التهكُّم والسخرية.
وأما كلامه في (الرازي)، وفيمَن نبزهما بقوله: «جرجانيكم» و«شارحكم» -وسيأتي تحقيق المعنيين بذلك، وهم من المشارقة- فإنه ينطوي على لمزٍ لهم صريح، وتحامُل عليهم بيِّن. ولكن هل يلزم عن ذلك أن يكون المؤلف مغربيًّا؟! لست أدري كيف عزب عن الأستاذ المحقّق أن هذه النتيجة لا تلزم إلا أن يثبت ببيّنة قاطعة أن التحامُل على المشارقة -وهم أصل هذا العلم ومعدنه- كان سُنّة دَرِبَ عليها علماء المغرب من جهة، وأن علماء المشرق لم يلمز بعضهم بعضًا، ولا تحامَلَ بعضهم على بعض من جهة أخرى! ومن دون ذلك نقض طبائع البشر وهدم التاريخ.
ثم إن ترجيحه نسبة الكتاب إلى مكّي يقوم -من وجه آخر- على التسليم بأنّ اسم هذا الكتاب: (إعراب القرآن)، وبأنّ لمكي كتابًا بهذا الاسم غير كتابه المشهور باسم (مشكل إعراب القرآن)، وكلا الأمرين لا يثبت.
أمّا أولهما: فيرد عليه ما تقدم ذكره في صدر هذه المقالة، والراجح أن مَن أثبت للكتاب اسم (إعراب القرآن) أخطأ في تسميته، [و] أخطأ في نسبته إلى الزجّاج، وسيأتي بسط القول في ذلك، وأمّا ثانيهما: فيدفعه أنّ مَن ترجموا لمكي وعدَّدوا كتبه لا يذكرون له في هذا الباب إلا كتابًا واحدًا هو المشهور باسم (مشكل إعراب القرآن). ومَن سمّاه منهم (إعراب القرآن)، كما فعل ياقوت في معجم الأدباء [19/ 170] والسيوطي في البغية [ص: 397] فالظاهر أنه اختصر اسمه الأصل؛ يؤيد ذلك أن السيوطي لمّا ذكر في الإتقان [1/ 180] مکيًّا فيمن ألَّفوا في إعراب القرآن صرح بأن كتابه في المشكل خاصّة، وتبعه في ذلك صاحب کشف الظنون [1/ 121، 122]، وأما ما ذهب إليه الأستاذ المحقِّق فوَهْم مردّه إلى أنه الْتَبسَ عليه -كما يظهر من كلامه- کتاب (مشكل غريب القرآن) الذي ذكره ياقوت وغيره في كتب مكي بكتاب (مشكل إعراب القرآن)، فظنّ هذا ذاك، وهما كتابان مختلفان موضوعًا وحجمًا، وقد ألَّف مكي أولهما -فيما نقله عنه ابن الجزري في طبقات القرّاء [2/ 310]- في مكة سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. وألّف الآخر في الشام بيت المقدس سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة.
وأما احتجاج الأستاذ المحقق بأن «المؤلفات التي ذُكِرَت في الكتاب منسوبة إلى مؤلِّفه ذُکرت بين مؤلفات مكي» فاحتجاج لا يقوم أيضًا؛ وذلك أنه ذَکَر مما سماه المؤلِّف من كتبه أربعة، وهي: الخلاف، والاختلاف [وأظن هذا تحريفًا لاسم الكتاب الأول]، والمختلف، والبيان. ومواضع الإحالة عليها تدلّ دلالة قاطعة أنها تتناول مسائل من مسائل علم العربية تتعلق بالقرآن. وليس في کُتب مکي ما يحمل اسم (الخلاف) و(المختلف)، وأما ما يحمل منها اسم (الاختلاف) و(البيان) -وهي كثيرة- فتشهد أسماؤها الكاملة أنها عن علم العربية بمعزل. انظر ثَبت كُتب مكي في إنباه الرواة [3/ 315-319]، ومعجم الأدباء [19/ 169-171]، ووفيات الأعيان [5/ 275، 276] (تحقيق الدكتور إحسان عباس) وما ذكره منها الأستاذ المحقق في دراسته، ص: [1100، 1101] ويُؤذن ببطلان هذا الاحتجاج أيضًا أن صاحب الكتاب سمَّی کتابين آخرين من تأليفه فات الأستاذ المحقق ذكرهما؛ أما أولهما فسمّاه [ص: 595] (التتمة)، وأما الآخر فسماه [ص: 640]، و[ص: 684] (الاستدراك)، ثم سماه [ص: 835] (المستدرك)، وليس في كتب مكي ما يحمل هذين الاسمين أصلًا.
وليس هذا كلّ ما هنالك؛ بل إنّ مَن وقف على هذا الكتاب وألمّ بشيء من كلام مكي فيما انتهى إلينا من كتبه -ولا سيما (الكشف عن وجوه القراءات وعللها)، و(مشكل إعراب القرآن)، وهما أقرب ما أَلَّف إلى موضوع هذا الكتاب- لم يخفَ عليه فرق ما بين الرجُلَين والأسلوبين، وأنْ ليس في کلام مکي ما في كلام الآخر من بَأْوٍ وصَلَفٍ وثَلْبٍ لغير واحد من أهل العلم. وأكبر ظني أن صاحب هذا الكتاب كان أشدّ إكبابًا على علم العربية من مكي وربما كان -على تعسفه في بعض مذاهبه- أغوص منه على دقائقه وما استسرّ منه، ثم إن ما ذكره في هذا الكتاب من مسائل الفقه يشهد أنه كان يتفقه لأبي حنيفة وينتصر لمذهبه (انظر أمثلة من ذلك: [ص: 31-36، 80، 332-336]، وأما مكي فكان على المذهب الغالب على المغرب مذهب مالك.
هذا، ولم يخامرني -وأنا أقرأ هذا الكتاب- أدنى ريب في أن مؤلفه مشرقي محض، وأنه -كما يبدو من مذاهبه فيه- من رجال المدرسة البصرية المتأخرة الذين تقيلوا آثار أبي علي الفارسي وصاحبه أبي الفتح بن جني؛ ولهذا ما كانت كتب هذين الإمامين في طليعة المصادر التي عول عليها في تأليفه، وقد نقل عنها فصولًا شتى قد تكون معظم مادة الكتاب، مصرحًا بالنقل في مواضع ومغفلًا الإشارة إلى ذلك البتة في مواضع[4]، وستأتي أمثلة من ذلك فيما يستقبل من هذه المقالة. بيد أنه لم يدع مع ذلك تعقبها والاستدراك عليها في غير ما موضع أيضًا.
وكان قد خطر لي منذ عهد بعيد أنْ ربما كان مؤلف الكتاب أبا الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي علي المعروف بـ(الجامع) أو (جامع العلوم)، وذلك أني رأيت ما يدلّ عليه الكتاب من صفة صاحبه ومنازعه يوافق في الجملة ما كنت قرأته في ترجمة هذا الرجل، ثم لم أُعْنَ بتقصي النظر في ذلك. حتى إذا أخذتُ أعدّ أسباب هذه المقالة -ولم يكن في نيتي أول ما بدأتُ إلا أن أدفع نسبة الكتاب إلى مكي، وأن استكمل تحقيق بعض أبوابه- ألحَّ عليَّ ذلك الخاطر إلحاحًا حملني على معاودة النظر في ترجمة الرجل، وإذا أنا أمام شواهد إن لم ترجح نسبة الكتاب إليه فإنها تسوّغ -على أقل تقدير- عرض المسألة للنظر، وتُغري بمزيد من التتبع والبحث.
وكان أول تلك الشواهد أن صاحب الكتاب قال فيما تبقَّى من مقدمته عقب تعداده أبوابه: فهذه تسعون بابًا أخرجتها من التنزيل بعد فكر وتأمل، وطول الإقامة على درسه، ليتحقق للناظر فيه نول القائل، ثم أنشد:
أحبِب النحوَ من العلم فقد يُدرِك المرءُ به أعلى الشَّرَفِ
إنما النحويُّ في مجلسه كشهاب ثاقب بين السُّدَفِ
يخرج القرآنُ مِن فِيهِ كما تخرج الدُّرة مِن بين الصَّدَفِ
وهذه الأبيات قد نسبها إلى الجامع المذكور مَن ترجموا له، وهم: ياقوت في معجم الأدباء [13/ 164-167]، والقفطي في إنباه الرواة [2/ 247-249]، والصلاح الصفدي في نكت الهميان [ص: 211]، والفيروزآبادي في البلغة [ص: 155]، والسيوطي في البغية [ص: 335]، والخونساري في روضات الجنات [ص: 485]. غير أنّ ياقوتًا -وقد نقل ترجمة الرجل عن كتاب (الوشاح)، لأبي الحسن البيهقي، وعليه عوّل، فيما يظهر، الآخرون- حكى نسبة الأبيات إليه بصيغة التمريض، وقال عقبها: «قال البيهقي: وبعد ذلك تحقّق أنّ هذه الأبيات من إنشاده لا من إنشائه»، وسها عن ذلك الباقون. ومن ثَمَّ قوي في نفسي أنه لا يبعد أن يكون هو مؤلف الكتاب، وأن يكون البيهقي عنى إنشاده الأبيات في مقدمته. وقوّى ذلك عندي بعض التقوية أن أكثر مَن ترجموا للرجل ذكروا أنه سُيِّر سنة خمس وثلاثين وخمسمائة إلى خراسان قول الفرزدق:
وليست خراسان التي كان خالد بها أسد إذ كان سيفًا أميرها
فكتب كلّ فاضل من فضلائها شرحًا له. وهذا البيت -كما يقول القفطي- «قد اختلف النحاة في معناه وإعرابه، فذكره ابن جني في خصائصه، وابن فضال المجاشعي في إكسيره[5]، وتسيير الجامع له إلى خراسان يشعر باهتمامه به، ولعلّه أراد بذلك معاياة علمائها بتفسيره وتوجيه إعرابه». وعلى ما أولاه أصحاب العربية أمثاله من الأبيات الملغزة من عناية، حتى إنّ بعضهم أفردها بالتأليف، فإني لم أصب له ذكرًا إلا في الموضع الذي أشار إليه القفطي من الخصائص [2/ 397] ثم في هذا الكتاب [ص: 705]، وقد احتفل به صاحبه فنقل كلام ابن جني فيه غير مصرح بذلك، إلا أنه قدّم فيه وأخّر، ثم أتبعه قولًا آخر في توجيهه لم يُسَمِّ قائله.
وأما الشاهد الثالث -وقد يكون أقواها دلالة- فهو أنّ صاحب الكتاب ذَكَر فيما سمّاه وأحال عليه من كتُبه كتابي: (الاستدراك، والبيان). وللجامع كتابان يُشبهان أن يكونا المعنيَّين، وهما: (الاستدراك على أبي علي) و(البيان في شواهد القرآن) ورجّح ذلك عندي أنه أحال على (الاستدراك) [ص: 640]، و[ص: 835] وقد سماه في ثاني الموضعين (المستدرك)، في مسألتين استدرك في كلتيها على أبي علي، وأحال [ص: 684] عليه وعلى (البيان) جميعًا في مسألةٍ عرض فيها لقراءة حمزة: {وأنّا اخترناك فاستمع لما يوحَى}[طه: 13] وذهب إلى أنه لا يجوز أن يكون قوله: {وأنّا اخترناك} محمولًا على قوله تعالى في الآية التي قبلها: {أني أنا ربك} بفتح الهمزة؛ لأن حمزة يقرأ في هذه الآية بكسر الهمزة من (إني)، وكان قد تناول المسألة نفسها في موضعين آخرين، [ص: 121و595]، وصرح في الأول منها خاصة أنّ أبا علي حمل قراءة حمزة المذكورة على الوجه الذي دفعه، وأنكر عليه تلك المقالة، وتعجّب منه كيف سها عن قراءة حمزة في الحرف الآخر، فظهر بذلك أنّ إحالته على (الاستدراك) في الموضع الثالث كانت في مسألةٍ استدرك فيها على أبي علي أيضًا.
وقد اتّفَق أن حدّثْتُ بهذا الذي انتهيتُ إليه الأخَ الأستاذ محيي الدين رمضان؛ فوافاني -أحسن الله جزاءه- صورةً لديه عن كتاب (الكشف في نكت المعاني والإعراب وعلل القراءات المروية عن الأئمة السبعة)[6] لجامع العلوم المذكور، وما أن استعرضت الكتاب استعراضًا سريعًا حتى طالعني بأمور تقطع الشك باليقين، وتدلّ دلالة لا تَعْلَق بها شبهة أن مؤلفه هو مؤلف الكتاب الآخر أيضًا، وهذا بيانها:
الأمر الأول: تقارب الكلام على كثير من الآي والمسائلِ المتعلقة بها في الكتابين تقاربًا يتجاوز التشابه العارض، ويحمل على الاعتقاد بأنهما من تأليف رجل واحد، غير أنه قد يبسط في هذا معنى أُجمِل في ذاك، أو يجمع في موضع من أحدهما ما فرّق في مواضع من الآخر تبعًا للمنهج الذي أخذ به في كلّ منها، وهذه أمثلة من ذلك:
1. جاء في (الكشف) اللوح: [3/ 2- 4/ 1] في قوله تعالى: {إن الذين كفروا سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون}[البقرة: 6]: «وقوله: {أأنذرتهم} لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه معنى الخبر، والتقدير: إن الذين كفروا سواء عليهم الإنذار وترك الإنذار؛ لأن الاستفهام يأتي في كلامهم ويراد به الخبر، كما أن الخبر يأتي ويراد به الاستفهام، قال تعالى: {وتلك نعمة تمنُّها عليّ أن عبَّدتَ بني إسرائيل}[الشعراء: 22] والمعنى: أوتلك نعمة؟ فإن قيل: فإنذار النبي -صلى الله عليه وعلى آله- قد نفع كثيرًا من الخلق حتى أسلموا، فكيف قال عزّ من قائل: {إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون}؟ فالجواب: إنّ المراد بهذا قوم مخصوصون لم ينفعهم الإنذار والدعوة، كأبي جهل، والوليد بن المغيرة المخزومي، والعاص بن وائل، وغيرهم من صناديد قريش قُتلوا ببدر، فاللفظ لفظ عام، ويراد به الخاص. وهذا كثير في القرآن».
وقد جاء نحو هذا الكلام مجملًا في الكتاب الآخر [ص: 171، 172].
2. وجاء في (الكشف) [اللوح: 24/ 2] في قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}[البقرة: 173[: «...والتقدير في قوله: {غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} أي: فأكل غير باغ، وإن شئت: فأكل فلا إثم عليه، تقدّره بعد قوله: {غير باغ...} أي: فأكل فلا إثم عليه. فحذف قوله: (فأكل) وقد تقدم نحو ذلك قوله: {اضرب بعصاك الحجر فانفجرت}[البقرة: 60] أي: فضرب فانفجرت، ومثله قوله: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة...}[البقرة: 184] أي: فأفطر فعـدة...، وكذلك قوله: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام}[البقرة: 196] أي: فحَلَقَ ففدية. ومثله في التنزيل كثير»، وقد جاء مثل هذا الكلام في الباب الأول من الكتاب الآخر المعقود «لِما ورد في التنزيل من إضمار الجمل» [ص: 13، 20] (وانظر فيه، ص: 486-489 أيضًا). ومعظم ما جاء في كلا الكتابين مأخوذ من كلام أبي الفتح بن جني، انظر الخصائص: [1/ 289، 2/ 361، 460، 3/ 174].
3. جاء فيه أيضًا [اللوح: 25/ 1-2] في قوله تعالى: {فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}[البقرة: 178]: «قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء} فيها أقاويل:
الأول: فمن عفي عن الاقتصاص منه فاتباع بالمعروف، هو أن يطلب الوليّ الدية بالمعروف، ويؤدي القاتل الدية بإحسان- عن ابن عباس.
والثاني: فمن فضلَ له فضْل، أي: فمن فضل قِبَل أخيه القاتل له شيء- عن السدي.
قال أبو علي: {فمن عفي له} أي: من يُسّر له من أخيه القاتل [شيء]، {فاتباع بالمعروف} أي: ليتبعه ولي المقتول بالمعروف، فيُجمِل في المطالبة، وليؤدّ القاتل إليه الدية بإحسان فلا يمطله. و(الأداء) في تقدير فعل المفعول، أي: فله أن يؤدى إليه، يعني الميسّـر له. ولو قدر تقدير: أن يؤدي القاتل. جاز، والباء حال، ولم يكن من تمام (الأداء)، لتعلق (إلى) به.
قال عثمان: قد يمكن أن يكون تقديره: فمن عفي له من أخيه عن شيء فلما حذف حرف الجر ارتفع {شيء} لوقوعه موقع الفاعل، كما أنك لو قلت: (سير بزيد) [ثم حذفت الباء قلت]: (سير زيد). ويجوز فيه وجه آخر، وهو أن يكون {شيء} مرتفعًا بفعل محذوف يدل عليه قوله: {عفي له} لأن معناه: ترك له شيء من أخيه، أي من حقّ أخيه، ثم حذف المضاف وقدّم الظرف الذي هو صفة للنكرة عليها، فنصب على الحال في الموضعين منها. وقال أبو علي في موضع آخر: أي من جناية أخيه، وتقديره: من جنايته على أخيه.
والعفو: التيسير دون الصفح، كالذي في قوله: (وآخره عفو الله)[7] أي: يسر [له] قبول الصلاة في آخره كقبولها في أوله، ولم يضيق على المصلي...».
وهذه الأقاويل التي ساقها ههنا مجتمعة جاءت متفرقة في مواضع من الكتاب الآخر، ومنها ما تكرّر ذكره فيه. انظر [ص: 22، 48-49، 109] (ومن هذا الموضع استدركت ما جعلته بين حاصرتين في كلام عثمان، وهو مطموس في مصورة الكشف) [556، 557].
4. وجاء في (الكشف) أيضًا [اللوح: 85/ 2] في قراءة أكثر السبعة: {إنَّ هذان لساحران}[طه: 63] بتشديد (إنَّ) والألف في (هذان): «...ولم يقل: (هذين) جريًا على القياس الذي يقتضيه باب التثنية من إقرار الألف في موضع النصب والجر، وترك قلبها ياء، لما كان الألف حرف الإعراب مثلها في (رحى) و(عصا). فكما أن الألف ههنا (عصا) ألف في الأحوال كلما أقرّت ألفًا هنا أيضًا؛ لأن الألف ههنا حرف إعراب كما هو كذلك هناك ومن قال: {إن هذين} جرى على الاستعمال الذي جاء به كلامهم من قلب الألف ياء في النصب والجر. وإنما قلبوها ياء حرصًا على البيان، بخلاف المفرد؛ لأنّ المفرد لا يجب قلبها [فيه] ياء لما يتبع المفرد من التوابع فيوضحه ويبينه. ألا تراك إذا قلت: (ضرب موسى عيسى) وجب أن يكون (موسى) فاعلًا و(عيسى) مفعولًا، فإذا قدمت المفعول وقلت: (ضرب عيسى موسى). لم يجز كما جاز (ضرب عمرًا زيدٌ)؛ لأنه يشتبه الفاعل بالمفعول إذا قلت: (ضرب عيسى موسى)، فتوضحه حين تصفه، أو تؤكده، أو تعطف عليه، فقلت: (ضرب عيسى العاقلَ موسى، أو ضرب عيسى نفسَه موسى، أو ضرب عيسى وزيدًا موسى). وهذا المعنى لا يتأتّى في التثنية، لو قلت: ضرب الزيدان العمران، وكان (الزيدان) مفعولين: لم يجز. فإن وصفتها فقلت: ضرب الزيدان العاقلان العمران، لم يتضح أيضًا كما اتضح في المفرد، فلم يكن إلى ذلك سبيل بتّة إلا بقلب الألف ياء، فقالوا: (ضرب الزيدين العمران)، فلهذا جاءك الاستعمال في التثنية بقلب الألف ياء على خلاف ما يقتضيه القياس...». وقد جاء نحو هذا الكلام في الكتاب الآخر [ص: 933].
5. وجاء في (الكشف) أيضًا [اللوح: 135/ 1] في قوله تعالى: {لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله}[الحديد: ۲۹].
«قالوا: التقدير: ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، و(لا) صلة زائدة، وقيل: ليس بزائدة، بل التقدير: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدر محمد وأصحابه -صلى الله عليه وسلم- على شيء من فضل الله، فالضمير في (يقدرون) ليس لأهل الكتاب، و(أن) مخففة من الثقيلة، ولهذا وصلت بـ(لا)، والمعنى: لئلا يعلم اليهود والنصارى أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والمؤمنين لا يقدرون على ذلك. [وإذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون] فقد علموا أنهم يقدرون عليه. أي: أن آمنتم كما أُمِرتم آتاكم الله -عز وجل- من فضله، فعلم أهل الكتاب ذلك ولم يعلموا خلافه.
وقال أبو سعيد السيرافي: إن لم تجعل (لا) زائدة جاز؛ لأن قوله: {يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورًا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم}، لئلا يعلم أهل الكتاب... أي: يفعل بكم هذه الأشياء ليتبين جهل أهل الكتاب وأنهم لا يعلمون أن ما يؤتيكم الله من فضله لا يقدرون على تغييره وإزالته عنكم. فعلى هذا لا تحتاج إلى زيادة (لا)».
وهذا نحو ما جاء في الكتاب الآخر [ص: 134]، ومنه استدركت ما جعلته بين حاصرتين، وقد سقط من (الكشف) وقوّمتُ منه حرفين آخرين صحّفهما ناسخ (الكشف)، أيضًا.
وفي الكتابين من هذا القبيل أشياء كثيرة تُغني الأمثلة السابقة عن التكثر بذكرها.
ويؤيد ما ذكرتُ -من أن هذه النقول وأشباهها تحمل على الاعتقاد بأن الكتابين من تأليف رجل واحد- ظاهرتان أخريان:
أولاهما: أنّ الكتابين اتفقا في العبارة عن (المبني للمفعول) أو (لما لم يسم فاعله) بـ(المرتب للمفعول)، وما أعرف ذلك في غيرهما. ومما جاء منه في (الكشف)، قوله [اللوح: 42/ 1] في قوله تعالى: {سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقّ}[آل عمران: ۱۸۱]: «...وقرأ حمزة: (سيُكتَب) مرتبًا للمفعول...»، وقوله [44/ 1] في قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}[النساء: 11، 12]: «...وقرئ: (يوصي) و(يوصَى). فمَن قرأ: (يوصي) أي: يوصي الميت، و(يوصَى) بالفتح مرتب للمفعول...» وقوله [99]: {يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال...} [النور: 36، 37]: «فيمن قرأ مرتبًا للفاعل يرتفع (رجال) بفعله، ومن قرأ: (يسبَّح) مرتبًا للمفعول في (رجال) يرتفع بفعل مضمر، ويقف على (الآصال) وكأنه لمّا قال: {يسبح له فيها بالغدو والآصال} قيل: مَن يسبح؟ فقال: (رجال) أي: يسبحه رجال...»، وقوله [110/ 1]، في قوله -عزّ وجل-: {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين}[السجدة: 17]: «فأما مَن قال: {ما أخفي لهم} مرتبًا للمفعول فـ(ما) مبتدأ، و(أُخفي) خبر فيمَن جعله استفهامًا. ومَن جعله خبرًا كان منصوبا بـ(تعلم)». وقوله: [136/ 1] في قوله تعالى: {يوم القيامة يفصل بينكم}[الممتحنة: ۳]: «(يُفصَل بينكم) مرتبًا للمفعول، و(يَفصِل) مرتبًا للفاعل، أي: يفصل الله بينكم. ومَن قال: (يفصل) مرتبًا للمفعول في (بينكم) قائم مقام الفاعل، ولم يرفعه لأنه جرى منصوبًا في كلامهم». وانظر مثل هذا التعبير في الكتاب الآخر [ص: 198، 266، 461، 815] و[ص: 17، 301].
وقد جاء في الموضعين الأخيرين نحو ما جاء في (الكشف) في آيتي (النور) و(الممتحنة). وفي ثانيهما سقط يستدرك مما نقلته عن (الكشف).
والظاهرة الأخرى: عبارات ترددت في الكتابين يبعد أن يكون مثلها من قبيل الاتفاق المحض. ومن ذلك قوله في (الكشف) [اللوح: 93/ 1]: «...ولكنها تخفى إلا على البُزُل الحُذّاق...»، وقد جاء نحو هذه العبارة في عنوان الباب الحادي والثمانين من الكتاب الآخر [ص: 905]، وذلك قوله: «...وربما يشكل على البُزُل الحُذّاق...»، وكذلك قوله في (الكشف) [اللوح: 17/ 1] منكِرًا على أبي عليّ اختلاف قولين له في مسألة واحدة: «...ثم فار فائره فذكر في التذكرة ما منع منه في الحجة»، ونحو هذا ما جاء في الكتاب الآخر، [ص: 587] من قوله: «...فار فائر أحدهم فقال...» وبهذا يتبين أن هذه العبارة التي جاءت فيه [ص: 379]: «...فثار ثائر الزيادي...» صوابها: «ففار فائر الزيادي...»، ومِن ذلك أيضا قوله في (الكشف) [93/ 1] في أُناس نسبوا بعض الحروف المروية عن ابن عامر إلى اللحن: «...وخفيت عليهم الخافية...»، ومثل هذا ما جاء في الكتاب الآخر [ص: 42] من قوله: «...وخفت الخافية عليهم...» ولذلك في الكتابين أشباه غير قليلة.
والأمر الثاني: الكناية في كلا الكتابين عن أبي علي الفارسي بـ(فارسهم) و(الفارس) ولم أُصِب ذلك في غيرهما قط.
أما أُولى الكنايتين فترددَتْ في مواضع شتى من (الكشف) منها قوله [اللوح: 18/ 2]: «...وجَوّز الأمرين فارسهم»، وقوله [61/ 2]: «وأنكر هذا فارسهم وزعم...»، وقوله [74/ 2]: «...فهذه درر أخرجها فارسهم من صدف الكتاب»، وقوله [81/ 2]: «...ولم يتمم فارسهم الكلام هذا الإتمام» وقوله [84/ 1]: «...ولم يتكلم فارسهم في ذا...»، وقوله [92/ 1]: «...وقال الناس ومعهم فارسهم»، وقوله [99/ 2]: «...ثم أخرج فارسهم هذه الآية...»، وقوله [100/ 1]: «...وقدره فارسهم...»، وقوله [103/ 2]: «...ووقع لفارسهم هنا أيضًا سوء التأمل في التلاوة...»، وقوله [107/ 2]: «...لم يجز عند فارسهم...»، وقد جاءت الكناية عنه بذلك في الكتاب الآخر، [ص: 790، 791].
وأما الكناية عنه بـ(الفارس)، فجاءت في (الكشف)، في قوله [اللوح: 74/ 2]: «...والفارس فرق فيها الكلام في مواضع...»، وقوله [100/ 1]: «...فقال الفارس...»، وقوله [107/ 2]: «...فقال الفارس هذا غلط...»، وقوله [142/ 2]: «...عن الفارس في التذكرة».
ولم تأت هذه الكناية في الكتاب الآخر إلا في موضع واحد، وذلك قوله [ص: 871]: «...ذكره الفارس في الحجة».
وقد ذكر فيه بنسبته: (الفارسي) في مواضع كثيرة منها [ص: 42، 121، 266، 531، 593، 748]، وغيرها. ويغلب على ظني أنها كانت في الأصل: (الفارس)، فجعلها الناسخ: (الفارسي).
ويشبه ما تقدم أنّ الكتابين اتفقَا أيضًا في العبارة عن أعلامٍ آخرين بغير المشهور المتعارف. ومن ذلك أن أبا الفتح بن جني لا يذكر فيها إلا باسمه: (عثمان) وأن القارئ الكوفي المشهور: حمزة بن حبيب، أحد السبعة، كثيرًا ما يُذكر فيهما بنسبته: (الزيات) وما أعرف ذلك في غيرهما.
فمما جاء فيه ذكر (عثمان) في (الكشف) قوله [اللوح: 17/ 1]: «...ألا ترى أن عثمان قال...»، وقوله [93/ 1]: «...فإذا نظرت إلى عثمان وقد أخذ في تعداد الشواهد...»، وقوله [93/ 2]: «...لأنهم [يعني القراء] عُنوا بحفظ الألفاظ دون المعاني، والاستكثار من الروايات دون التحقيق كما عُني عثمان...»، وقوله [103/ 2]: «...وفد فرّ منه عثمان ولم يتجاسر على الإلمام بالحجة...»، وقوله [129/ 1]: «...وإنما ذكرنا هذه القراءة وإن كانت شاذة لسوء تأمل عثمان في ظاهر التلاوة... فهذا جولة مع عثمان في المحتسب».
ولهذه الأقوال فيه نظائر كثيرة.
وقد ذُكر بذلك في مواضع شتى من الكتاب الآخر يَسهُل استخراجها من فهرس الأعلام فيه.
وما جاء فيه ذكر حمزة بـ(الزيات) في (الكشف) قوله [اللوح: 79/ 2]: «...والياء قراءة الزيات...»، وقوله [109/ 1]: «...ورفع (رحمة) الزيات...»، وقوله [114/ 2]: «...ويروى أن الزيات قال...»، و«...فتحوا الياء عن آخرهم إلا الزيات...». وقد ذُكر بنسبته هذه في الكتاب الآخر، [ص: 364، 595، 683]. وقرن اسمه بها [ص: 714] في قوله: «روي عن حمزة الزيات...»، ومن الغريب أن محققه لم يذكر (الزيات) في فهرس الأعلام، ولا أدرج هذه المواضع في جملة المواضع التي ذكر فيها (حمزة).
والأمر الثالث: أن صاحب (الكشف)، ينبز بعض أهل العلم بقوله: «شارحكم» أيضًا، ويتحامل عليه وعلى من يدعوه (الرازي)، وينال منهما على نحو ما نيل منها في الكتاب الآخر.
أما الرازي فعرض له في كلامه على قوله تعالى: {كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا}[الأنعام: 71] [اللوح: 55/ 1] -فوصمه بأن لا تمييز له، فقال: «...وقيل: تقديره: كالذي استهوته [الشياطين] له أصحاب يدعونه إلى الهدى حيران، فيجعلون (حيران) حالًا من الهاء المجرورة باللام، وهذا على قول سيبويه ممتنع؛ لأنه لا يجوز (مررت جالسًا بزيد) وأنت تريد: (مررت بزيد جالسًا). ولكن هذا الرازي ليس له تمييز يميز به الصحيح من السقيم، ولو تتبعت كلماته في هذا التصنيف لم تُخرِج منه صحيحًا إلا النزر». ثم غمز قولًا آخر له ودمغه بالخطأ في كلامه على قوله تعالى: {الر كتاب أُحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير * ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير * وأن استغفروا ربكم...}[هود: 1-3] [اللوح:68/ 1] فقال: «...وإجازة الرازي الوقف على لفظة (الله) هنا خطأ محض؛ لأنه يبتدئ بقوله: {وأن استغفروا ربكم} وليس في الكلام ما يتعلق به على زعمه». وأهون مما تقدم أنه وصف قولًا له بالتعسّف، وذلك في كلامه على قوله -عزّ وجل-: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن...}[الأنعام: 82]، [اللوح: 55/ 2] فقال: «...(الذين): مبتدأ، وصلته تنتهي إلى قوله (بظلم). والخبر (أولئك لهم الأمن). ولا يجوز الوقف على قوله: (بظلم) وجوّزه الرازي على أن يكون (الذين) خبر ابتداء مضمر، وهو تعسّف عندي، والصواب ما بدأتك به، إلا أن يقدّر (الذين) على قوله: {فأي الفريقين أحق بالأمن...}[81] فقيل: (الذين آمنوا) أي: هم الذين آمنوا، فحينئذ يقف على (بظلم). والأحسن ألا تحمله على الإضمار لقوله: (أولئك لهم الأمن) فكرر في الثاني لفظ (الأمن). ولو لم يقل: (أولئك لهم الأمن) كان الحمل على الأول أحسن».
وذَكره أيضًا في الكلام على قوله تعالى: {إنّ الساعة آتية أكاد أخفيها لتُجزَى كل نفس بما تسعى}[طه: 15]، [اللوح: 84/ 1] بما لا يخلو من تعريض بغفلته عن المعاني الدقيقة، وذلك قوله: «...يُروى عن الأخفش[8] أنه كان يقف وقفة لطيفة على قوله: (أكاد) ثم يبتدئ ويقرأ: (أخفيها لتجزى كل نفس) ولم يذكر الرازي علّة ذلك. وكأنه إنما وقف تلك الوقفة لأنه أراد أن يبيّن لك أن اللام من قوله: (لتجزى) من صلة (أخفيها) لا من صلة (آتية) وكأنه قدّر: إن الساعة آتية أكاد أظهرها؛ ثم ابتدأ وقال: أخفيها لتجزى...».
وأمّا مَن نبزه بقوله: (شارحكم) فعرض له في موضعين: [اللوح: 81/ 1] و[103/ 2] بما لا كبير قسوة فيه، إلا أن حملته عليه في مواضع أخرى لم تكن بأخفّ وطأة من حملته على الرازي.
ومن ذلك أنه ذكره في كلامه على قوله تعالى: {قل أفغير الله تأمرونّي أعبد أيها الجاهلون}[الزمر: 64]، [اللوح: 120/ 1] فقال: «وقد جاء عن ابن كثير: (أفغير الله تأمروني) بتخفيف النون[9] على أنه حذف إحدى النونين، كقولهم: (فبم تبشرون)[10][الحجر: 54] و{أتحاجوني في الله}[11][الأنعام: ۸۰] وقول عمرو:
[تراه كالثغام يُعَلُّ مسكًا] يسوء الفاليات إذا فليني
أي: فلينني. وأنكر هذه القراءة شارحكم. ومَن أنكر مثل هذا حرم عليه الشروع في كتاب الله -عزّ وجل- والنظر في كتاب[12] الأئمة والعلماء. ومثل هذا إذا أنكر شهد بلادة منكرة وعماه عن الحقّ».
وذكره أيضًا في الكلام على قوله تعالى: {إنكم لفي قول مختلف * يؤفك عنه من أُفك}[الذاريات: ۸-۹]، [اللوح: 130/ 1]، فقال: «قيل: يؤفك عن الحقّ والصواب مَن أفك، فدلّ ذكر (القول المختلف) على ذكر (الحقّ) فجازت الكناية عنه. وتحذلق شارحكم فقام وقعد، فأتى بشيء ظنّ أنه أجود مما قالوه، فزعم أنه يعود إلى (القول المختلف)، وأن المعنى فيه أن (عن) ههنا ليست منزلتها في قوله: (صرفته عن كذا)، وإنما المعنى أنه أُتي من (أُفك) عن جهة القول المختلف، أي: ما وقع به عن هذه الجهة. قال: والمفعول الذي يقتضيه (أفك) [محذوف] أي: أفك عن كذا وعن الحقّ عن جهة القول المختلف فيه. ولم يدرِ أن الفعل لا يتعدى بحرفي جر متفقين، فوقع في هذا الخطأ. والإنسان إذا أراد أن يستنبط معنى يجب له مراعاة اللفظ، وأن يخرج معنى لا يخالفه اللفظ. وهو موصوف بهذه الصفة. وكثيرًا ما يقع له من إطالته وتحسين عبارته في شيء[13] يفسد بأدنى نظر، فيغتر بتلك الطراوة والفصاحة الغِر الجاهل الفَدْم الذي لا يتأتى له النظر في دقائق العربية».
وقد غمز كلا الرجلين وغمز معهما غيرهما من أهل العلم أيضًا في مواضع أخرى سيأتي ذكرها في تحقيق المعنيين بذلك.
وأما الأمر الرابع: فمِن أبينها دلالة. وذلك أن صاحب (الكشف) أحال في بسط كثير من المسائل على كتبٍ مِن كتبه أحيل عليها في الكتاب الآخر بما يدلّ على أنها من كتب صاحبه أيضًا، بل إنّ عبارات الإحالة عليها في كلا الكتابين كثيرًا ما تكون متطابقة أو متقاربة. وجملة ذلك أربعة كتب، وهي: الخلاف، والمختلف، والاستدراك، والبيان. وهذه مواضع الإحالة عليها فيها، ونصّ ما جاء في كلّ منها. أما الخلاف (فجاء في الإحالة عليه في الكشف)[اللوح: 38/ 1]: «...وقد ذكرنا في الخلاف ما هو أتمّ من هذا...»، و[92/ 1]: «...وهذا الكلام قد استقصيناه في الخلاف»، و[138/ 2]: «...وقد استقصينا هذا في الخلاف». وجاء في الكتاب الآخر، [ص: 477]: «...وقد ذكرنا وجه كلٍّ في الخلاف» و[ص: 655]: «...وقد ذكرنا هذه المسألة في الخلاف مستقصى» [كذا، ولعل الصواب: مستقصاة] و[ص: 658]: «...وقد استقصينا هذا في الخلاف»، وجاء فيه [ص: 608]: «...وقد استقصينا الخلاف في هذا...»، وأظنّه خطأ من الناسخ صوابه مثل ما جاء [ص: 658] أيضًا. وأما (المختلف) فأحال عليه في (الكشف)، [اللوح:134/ 2] بقوله: «وقد ذكرنا هذا في المختلف». وجاء في الإحالة عليه في الكتاب الآخر، [ص: 128]: «وقد ذكرنا حِجاج هؤلاء في المختلف»، و[ص: 159]: «...وقد ذكرته في المختلف».
وأما (الاستدراك) فأحال عليه في (الكشف) بهذا الاسم في [اللوح: 81/ 1] بقوله: «...وقد ذكروا [كذا ولعلّ الصواب: ذكرنا] تينك الآيتين في الاستدراك»، وفي [اللوح: 141/ 2] بقوله: «...وقد أشبعت القول فيه في الاستدراك»، وأحال عليه باسم (المستدرك) في [اللوح: 69/ 1] قال: «...وقد ذكرناه في المستدرك». وأحيل عليه في الكتاب الآخر [ص: 640] بقوله: «...وقد بيناه في الاستدراك»، وقرنه [ص: 684] بـ(البيان)، فقال: «...وقد ذكرنا ما في هذا في البيان والاستدراك»، وذكره باسم (المستدرك) [ص: 835] قال: «...وقد ذكرنا في المستدرك أن هذا...»، وأما (البيان)، فجاء في الإحالة عليه في الكشف: [اللوح: 25/ 1]: «...وفيه حديث يطول لا يتسع هذا الموضع له، وقد ذكرته في البيان»،و[42/ 1]: «...والكلام مع أبي عليّ يطول، ذكرته في البيان»، و[68/ 1]: «...وإن أردت البيان فعليك بكتاب البيان»، و[71/ 2]: «...وقد يطول الكلام في هذا، فقد ذكرناه في البيان» و[73/ 1]: «...وقد فسّرنا هذه اللفظة في أول كتاب البيان»، و[126/ 1]: «...ذكرت هذه الآية في البيان بجميع ما يتعلق بها...»، و[126/ 2]: «...وقد تقدّم هذا في البيان»، وذكره [اللوح: 120/ 1] باسمه الكامل، قال: «...[ذكرت] ما في هذا في البيان في شواهد القرآن».
وأحيل عليه في الكتاب الآخر [ص: 679] بقوله: «...وقد نبهتك على الأبيات في البيان». وقد تقدّم أنه أحال عليه [ص: 684] مقرونًا بـ(الاستدراك).
وما أظنني بعدُ غاليًا إذا ما زعمتُ أنّ هذا الدليل وحده كاف للقطع بأن مؤلف (الكشف) هو مؤلف الكتاب الآخر، بَلْه ما تقدمت من أدلة وتضافرها على توكيد هذه الحقيقة.
[1] المقالة الأولى من مقالتين نُشرتا في مجلة (مجمع اللغة العربية بدمشق)، ونُشرت الأولى منهما في الجزء الرابع من المجلد الثامن والأربعين، الصادر في شهر رمضان 1393هـ.
وقد جعل الكاتب عنوانهما: (كتاب «إعراب القرآن» المنسوب إلى الزجّاج؛ تحقيق نسبته واسمه، وتعريف بمؤلفه، واستكمال لتحقيق بعض أبوابه)، وقد اقتصرنا في عنوان المقالتين على موضوعهما؛ حيث ركزت المقالة الأولى على تحقيق نسبة الكتاب لمؤلفه، ومناقشة ما ذهب إليه محققه في النسبة، وتناولت المقالة الثانية تحقيق اسم الكتاب. (موقع تفسير).
[2] الأستاذ إبراهيم الإبياري: هو المؤرخ والمحقق الكبير للتراث العربي والإسلامي، عمل بدار الكتب المصرية، ثم عُيِّن مديرًا لإدارة إحياء التراث، فمراقبًا عامًّا لشؤون مجلس النواب والشيوخ، ثم كان أستاذًا للعربية بمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد، ثم مستشارًا للمؤسسة الثقافية بوزارة الثقافة المصرية، وله العديد من التحقيقات لكتب التراث منفردًا وبالمشاركة، منها كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجَّاج، والذي تدور هذه المقالة عن نسبته للزجَّاج. (موقع تفسير).
[3] أمّا كتاب (شرح مشكل غريب القرآن) فقد طُبِع بتحقيق: د. علي حسين البواب، عن مكتبة المعارف بالرياض، عام 1406هـ- 1985م، كما طبع بتحقيق: هدى الطويل المرعشلي، عن دار النور الإسلامي عام 1408هـ- 1988م.
وأمّا (مشكل إعراب القرآن) فقد طُبع بتحقيق: ياسين محمد السواس، ونشر ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية في دمشق، وأعيد طبعه في دمشق دار المأمون للتراث، كما طبع بتحقيق: حاتم صالح الضامن، ببغداد عام 1973م. (موقع تفسير).
[4] ولم ينفرد المؤلف في هذا، بل إنّ له فيه من المتقدمين نظراء ليسوا بقلّة. وممن رأيتهم يكثرون من سلخ أشياء من كلام أبي علي وصاحبه أبي الفتح خاصّة من غير ما إشارة إلى ذلك: ابن سيده في معجميه: المحكم والمخصص، وابن يعيش في: شرح المفصل، وابن هشام في: مغني اللبيب.
[5] في مطبوعة الإنباه: (...في السيرة) وهو تصحيف صوابه ما أثبت؛ فإنه ليس لابن فضال المذكور كتاب في (السيرة) وله كتابان باسم الإكسير، وهما: (إكسير الذهب في صناعة الأدب) وأغلب الظنّ أنه المعنيّ، و(الإكسير في علم التفسير). انظر ترجمته في الإنباه نفسه [2/ 299-301] ومعجم الأدباء [14/ 90-98].
[6] صور الكتاب عن مخطوط في مكتبة مراد ملا بإستانبول واضطرب ترتيب أوراقه، ولم يكن من العسير ردّ كل منها إلى حاق موضعه، غير أني التزمت الإحالة، فيما يأتي على ألواح المصورة، كما رقمت في وضعها المضطرب.
[7] قطعة من حديث تمامه كما جاء في تفسير القرطبي (2/ 254): «أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله». وأخرجه الترمذي في سننه (1/ 154–155) من تحفة الأحوذي، من حديث ابن عمر، ولفظه: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله».
[8] هو الأخفش الدمشقي، هارون بن موسى أبو عبد الله التغلبي المعروف بـ(أخفش باب الجابية). وكان شيخ القراء بدمشق، وإليه رجعت الإمامة في قراءة ابن ذكوان. توفي سنة 292. انظر ترجمته في طبقات ابن الجزري (2/ 347-348)، وبغية الوعاة، ص: 406.
[9] كذا في الأصل، وهو خطأ، فإنّ تخفيف النون في هذا الحرف قراءة نافع من السبعة، وبذلك قرأ أبو جعفر، واختلف فيه عن ابن ذكوان، وأما ابن كثير فقرأ بالتشديد. انظر التيسير، ص: 190، والنشر (2/ 348)، والبحر المحيط (7/ 439).
[10] يعني في قراءة من خفّف النون وكسرها، وهي قراءة نافع، انظر التيسير، ص: 136، والنشر (۲/ ۲۹۰).
[11] يعني في قراءة مَن خفّف النون أيضًا، وفي قراءة نافع وابن عامر بخلاف عن هشام، وبذلك قرأ أبو جعفر أيضًا. انظر التيسير، ص: 104، والنشر (2/ 250).
[12] كذا في الأصل، بالإفراد. ولا يعدم وجهًا.
[13] كذا في الأصل، وأظن (في) مقحمة. ولا أستبعد أن يكون الصواب (على إطالته) بدل (من إطالته...) أيضًا.


 كتاب (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجَّاج؛ تحقيق نسبته واسمه (2-2)
كتاب (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجَّاج؛ تحقيق نسبته واسمه (2-2)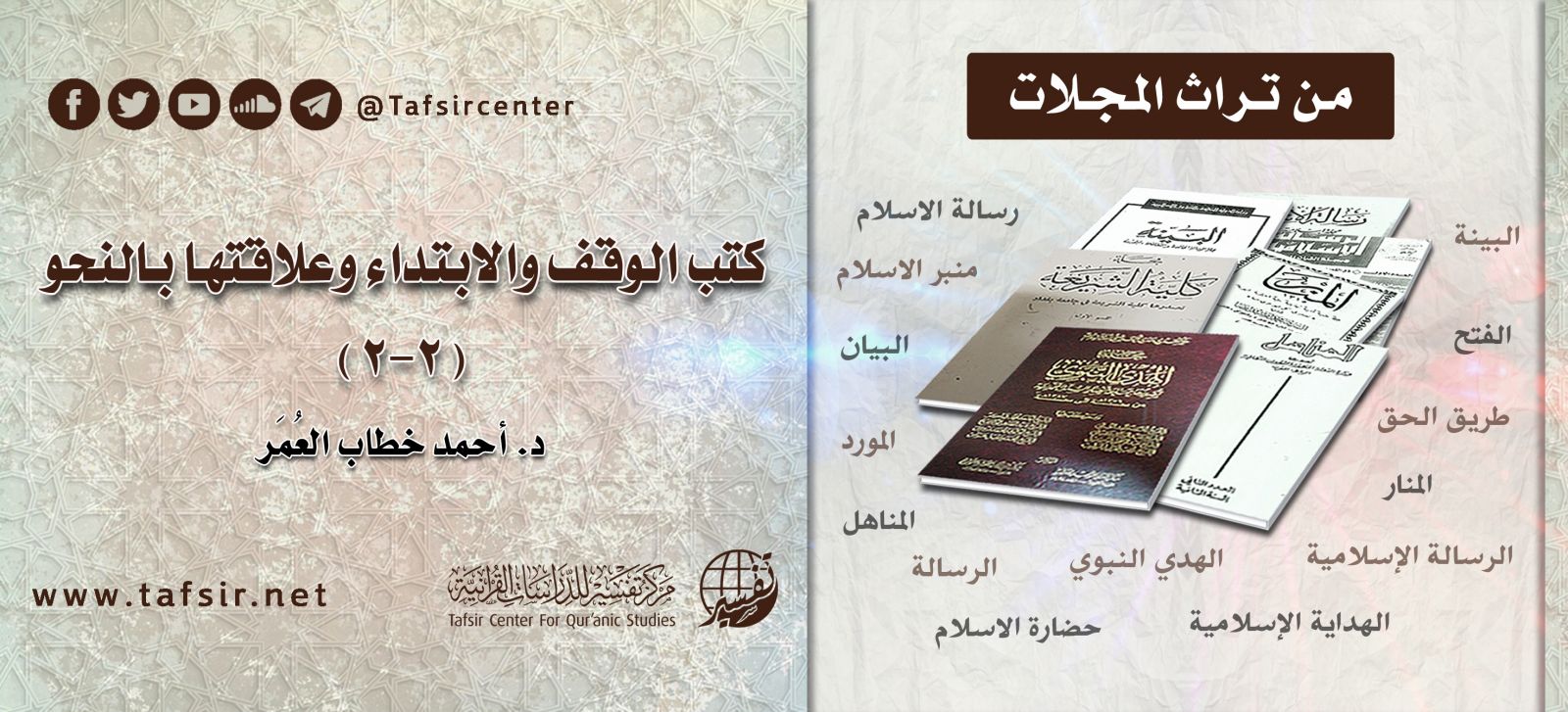 كتب الوقف والابتداء وعلاقتها بالنحو (2-2)
كتب الوقف والابتداء وعلاقتها بالنحو (2-2) طبعة دار الكتب العلمية لتفسير الوسيط للواحدي؛ قراءة نقدية
طبعة دار الكتب العلمية لتفسير الوسيط للواحدي؛ قراءة نقدية الأساليب البلاغية في تيسير الصيام في القرآن
الأساليب البلاغية في تيسير الصيام في القرآن «آيات الرجاء» في كتاب الله
«آيات الرجاء» في كتاب الله