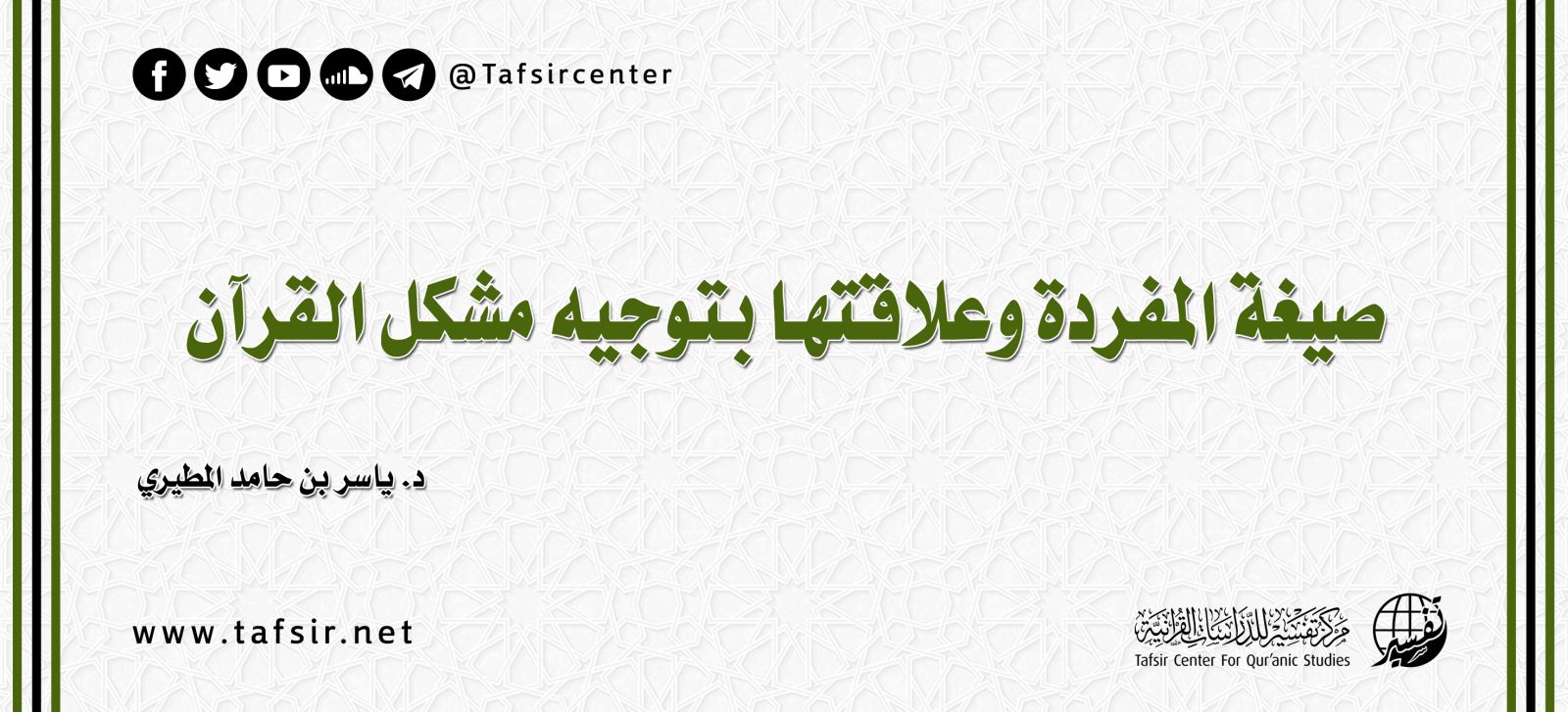مفهوم القراءة عند الحداثيين وعلاقته بالتفسير
مفهوم القراءة عند الحداثيين وعلاقته بالتفسير
الكاتب: فاطمة الزهراء الناصري

مفهوم القراءة عند الحداثيين وعلاقته بالتفسير[1]
إنّ ربط مصطلح (القراءة) بمفهومه الحداثي بالقرآن الكريم على أنه بديلٌ أو قريبٌ من مصطلحات كالتأويل والتفسير والتدبُّر يحتاج إلى كثيرٍ من التحرّز والتدقيق.
المحور الأول: مفهوم القراءة عند الحداثيين:
لقد أصبح من الصعب الإمساك بمفهوم القراءة في الكتابات الحداثية، ذلك أن هذا المصطلح كما يقول عليّ حرب: «بات يشمل أيّ معطى كان، ويتصدّر مفردات الخطاب المتعلقة بالفهم والتشخيص، أو التقييم والتقدير»[2]، وقد احتفى الحداثيون كثيرًا بهذا المصطلح[3] الذي حرَّر فكرهم من جميع القيود المنهجية، ليحلِّق طليقًا في جوّ التخمينات والشطحات وربط كلّ ذلك بالقرآن الكريم؛ لهذا كان مصطلحَا التفسير والتأويل بالنسبة لعبد المجيد الشرفي لا يعبِّران عن الدلالات اللامتناهية للنصّ القرآني، فوجب تجاوزهما إلى مصطلح القراءة، قال: «لئن آثرنا تجاوز مصطلحي التفسير والتأويل إلى استعمال مصطلح القراءة؛ فلأن التعامل مع (النصّ التأسيسي)... يحتمل نظريًّا -بحكم أزليّته- عددًا لا متناهيًا من المعاني، فسمة الإطلاق فيه تجعله يستوعب قراءات»[4]، لكنه لا يحدثنا عن دلالة هذا المصطلح البديل، فما معنى القراءات؟
لقد ذهب الحداثيون مذاهب لا حصر لها في معنى القراءة، فهي عند نصر حامد أبو زيد عملية محكومة بالإخفاء والكشف، قال: «في مقابل النصوص تقف القراءة أيضًا محكومة بجدلية الإخفاء والكشف»[5]، فــ(القراءة) عنده هي عملية كشف عن دلالات وإخفاء لأخرى بحسب الظرف التاريخي، أما عند محمد الطالبي فهي تعني الاجتهاد، قال: «لا بد أن نوفر فضاءً ثقافيًّا... يسمح بتطوير قراءة النصّ، وهو ما اصطلح عليه في لغة الفقهاء بالاجتهاد»[6]، فهل هي محاولة لإزاحة لغة الفقهاء التي يمثلها مصطلح الاجتهاد، والتأسيس للغة الحداثة التي يمثلها مصطلح القراءة؟
وفي ما يلي محاولة لاستقراء[7]دلالات هذه المفردة وخصائصها في الكتابات الحداثية، سواء ما تعلّق منها بالقرآن الكريم أم النقد الأدبي عمومًا، وعلاقة هذه الدلالات بمفهوم التفسير:
1- القراءة جزئيّة:
إنّ «الممارسة النقدية... هي قراءة في معرفة النصّ، وتحديدًا في مستوى من مستوياته المتعددة والمتشكّل منها، وعلى ذلك فإنّ كلّ قراءة نقدية هي بالضرورة معرفة جزئية للنصّ، والناقد الموضوعي حينما يقرأ النصّ بأدوات معرفته يدرك مسبقًا أنه يستكشف مستوى من المستويات المتعددة في النصّ المقروء»[8]، فالقراءة «ليست صدى للنصّ، وليست منتهى الفهم له، فهي تعتبر نفسها احتمالًا من بين احتمالاته المتعددة»[9].
وهذه الخاصية في مفهوم القراءة لا تختلف عنها في مفهوم التفسير؛ فهو أيضًا معالجة لأحد مستويات النصّ القرآني، ولا يمكن لأحد ادّعاء تفسير آية من القرآن الكريم من جميع مستوياتها وإحاطته بكلّ دلالاتها؛ لهذا كان من التفسير ما يتعلّق بالجانب المأثور، ومنه ما يتعلق بالبيان والبلاغة، ومنه ما يتناول الأحكام الفقهية العملية، وهناك الذي يبحث في الآيات الكونية التي تصوّر عظمة الخالق في الآفاق والأنفس، والبعض الآخر يغلب عليه الطابع العقلي أو الذّوقي والتأملي الإشاري، لكن هناك تداخل بين هذه المستويات، والتصنيف غالبًا ما يكون حسب الخاصيّة الغالبة على التفسير، أي: إنّ التناول الجزئي المقتصر على أحد مستويات النصّ -الذي يتميّز به مفهوم القراءة- لا يتنافى مع مفهوم التفسير.
كما أنّ جزئية القراءة تطلق أيضًا بمعنى عدم شمولها للنصّ كاملًا كالتفسير: «الذي يشرح النصّ القرآني كلّه ويلقي الضوء على معنى كلّ آية»[10].
2- القراءة نسبية:
ذلك أنّ القراءة كما يقول إدريس المسماري: «تنبني على تصوُّر مغاير، قوامه تقويض الرؤية التقليدية للدلالة والمعنى، تلك التي ترى في النصّ الديني الحقيقة المطلقة، وتعويضها بتصوّر جديد قائم على تنسيب الحقيقة»[11]؛ ولأن القراءة النقديّة كما يقول أركون هي: «زاوية رؤية الناقد في قراءته، والمحددة بعدة عوامل؛ منها: رؤيته الاجتماعية، ومنظوره الإيديولوجي، وأدوات معرفته النقدية المستخدمة في قراءة النصّ... وليس هناك نقد حتى النقد النظري... كاملًا بذاته مطلق المعايير والأحكام والموازين...»[12].
سبب النسبيّة في القراءة الحداثية إذن هو العوامل الاجتماعية والمنظور الإيديولوجي للناقد، إضافة إلى عدم وجود أدوات ومعايير نقديّة محكمة وكاملة، بل إنّ السبب الأعمق لهذه النسبية هو أنها لا ترى في النصّ الديني رمزَ الحقيقة المطلقة، لكن هذا لا يعني أن هناك من المفسّرين من وسم اجتهاداته في فهم القرآن الكريم بالإطلاقية؛ لأن الاجتهاد البشري النسبي لا يمكن أن يحيط كُليًّا بالمطلق الذي هو كلام الله تعالى، بَيْدَ أنّ التفسير لا يعدم أصولًا وضوابطَ غاية في الإحكام على خلاف ما عليه الحال بالنسبة للقراءة، وعدم إطلاقية التفسير تأتي من طبيعة الكلام المُفَسَّر؛ أي: الربانية، لا من عدم وجود ضوابط وقواعد.
3- القراءة متعدِّدة، وفي كلّ مرة جديدة:
ممارسة فعل القراءة على نصٍّ ما في التصور الحداثي يستلزم تعدُّد دلالات ذلك النصّ، قال محمد أركون متحدثًا عن مشاريعه الفكرية: «كنتُ قد شرعتُ بهذا العمل شخصيًّا تحت عنوان مزدوج: (قراءات في القرآن) مع الإلحاح على فكرة التعدُّدية في كلمة قراءات»[13]، وقال محمد الطالبي: «هنا أسجّل أنّ كلّ قراءة هي فكر يتعامل مع نصّ، فالنصّ واحد والأفكار متعددة، وهكذا لا مفرّ من تعدُّد القراءات بتعدّد الأفكار، وذلك في كلّ ميادين القراءات سواء كانت النصوص دينية أم أدبية أم تاريخية أم فلسفية...»[14]، يعني أنّ تعدُّد الأفكار مبرر كافٍ لتعدُّد القراءات دون تمييز بين النصّ الديني أو الأدبي أو الفلسفي...، فالنصوص أمام القراءة سواء! وقال أيضًا: «بما أنه ليس من حقّ أحد التكلُّم باسم الإسلام، وأنه ليس لدينا كرسيّ رسوليّ، وأنه من حقّ كلّ واحد أن يتحدث من خلال ما يظنّ أنه الحقيقة؛ من هنا تأتي مشروعية تعدُّد القراءات»[15].
والواقع أنّ عدم وجود (كرسي رسولي) في الإسلام هو دليل على عدم مشروعية الذاتيّة في فهم النصوص الدينية، وإنّ الاختلاف الذي يقع في فهم النصّ هو استثناء لا قاعدة كما يريد الحداثيون تصويره؛ إنّ الأصل في فهم نصوص الشريعة هو الاتفاق، والاختلاف جائز لكنه عارض، ولا بد أن تكون وراءه أسباب موضوعية خارجة عن ذاتيّة المفسر أو المجتهد عمومًا، وقد ذكر ابن جُزَي هذه الأسباب الموضوعية لاختلاف المفسرين في مقدمة تفسيره تحت عنوان: (أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجّح بها بين أقوالهم)، قال: «أما أسباب الخلاف فهي اثنا عشر: 1- اختلاف القراءات. 2- اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. 3- اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. 4- اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 5- احتمال العموم والخصوص. 6- احتمال الإطلاق والتقييد. 7- احتمال الحقيقة والمجاز. 8- احتمال الإضمار أو الاستقلال. 9- احتمال الكلمة الزائدة. 10- احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير. 11- احتمال أن يكون الحكم منسوخًا أو محكَمًا. 12- اختلاف الرواية في التفسير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن السلف -رضي الله عنهم-»[16].
وفيما يخص طابع الجِدَة، قال عليّ حرب: «كلّ قراءة في النصّ تشكّل واقعة مضافة، كما أنّ كلّ قراءة في الوقائع تسهم في تجديد النّصوص والمعنى»[17]، فالتعاطي الحداثي مع النصوص -أيًّا كان نوعها- لا بد أن يكون في كلّ مرة جديدًا، وهَمُّ الحداثيين الأكبر في الوقت الراهن هو قراءة جديدة للقرآن، قال عطية عامر: «كلّ قراءة للقرآن يجب أن تكون جديدة... هذا اللون من القراءة هو ما نقصده... ولهذا أطلق على هذا الكتاب اسم (قراءة جديدة للقرآن)، لا (تفسير القرآن) كما هو متعارف عليه بين المفسّرين»[18]؛ لأن القراءة سواء في «الأسماء والأحداث أم في الكلمات والأشياء... أي: بين النصّ والواقع، هي خَلْق وابتكار»[19]؛ لذلك «فكلّ قراءة في النصّ تَقرأ ما لم يُقرأ من بداهات الكلام ومسبقاته، أو من احتمالاته وأبعاده، أو من مآلاته ومفاعيله»[20].
وهذه الخاصية بهذا التعميم راجعة إلى الطابع الذاتي للقراءة، وعدم خضوعها لمعايير وضوابط منهجية، ولتعلقها بنصوص بشريّة، فالتأويلات تختلف باختلاف الذوات، أما تفسير القرآن الكريم فلا يمكن أن يصدر فيه مثل هذا الحكم؛ لأنه يخضع لقواعد منهجية صارمة، لذلك لا يلزم أن يكون التفسير في كلّ مرة جديدًا، وخصوصًا إذا تعلّق الأمر بالآيات المحكمة.
4- القراءة غير حياديّة:
يقول هارولد بلوم في كتابه (خريطة للقراءة الضالة): «لقد جعل مؤوِّلونا المعاصرون من موضوع القراءة ما دعاه نيتشه: نزهة الأشخاص»[21]، فخلفيّة القارئ وحدها تحدّد ما ستسفر عنه قراءته من دلالات؛ لأنّ قراءة الإبداع كما يقول الحبيب شَبيل: «مرآة يتجلى فيها القارئ بصورة من الصور، فالقارئ لا يلج النصّ الذي يقرأ (بفكر محايد)، وإنما يقرؤه بخبراته الثقافية والجمالية وبِرُؤَاه المذهبيّة كذلك»[22]، ثم إنّ الهرمنوطيقا الفلسفية كما يقول زهير بيطار: «تؤمن بأنّ المفسّر أو الفاهم ليس محايدًا في عملية الفهم؛ إِذْ إنّ أُفُقَه المعرفي وذهنيته وقبلياته تتدخّل يقينًا في تفسير النصّ»[23].
5- القراءة تُلْغِي النصّ:
قال عليّ حرب: «قد تكون -أي: القراءة- شرحًا للنصّ أو تفسيرًا له، وقد تتعدى التفسير والشرح لكي تكون تأويلًا وصرفًا لما يحتمله الكلام من المعاني والدلالات، ولكن قد تتعدّى التفسير والتأويل، فتتجاوز المؤلّف ومراده أو المعنى واحتمالاته، لتكون تسريحًا وتفكيكًا[24]للبِنَى والآليات التي تُسهم في تشكيل الخطاب وإنتاج المعنى»[25]، أي: إنّ المتلقي من حقّه أن يتجاوز ما تدلّ عليه بِنَى النصّ ولغته، وآليات التأويل ومناهجه، ومقصود المؤلف ومراده، وله أن يسرح في النصّ مُفكِّكًا ومُركِّبًا ليخرج بدلالات تتجاوز آليات النصّ ولغته ومؤلفه، ويسمى كلّ هذا في عُرْف الحداثة قراءة!
وقال أيضًا -أي: عليّ حرب-: «أمّا القراءة التي تقول ما يريد المؤلف قوله فلا مبرّر لها أصلًا؛ لأنّ الأصل أَوْلَى منها ويُغنِي عنها، إلا إذا كانت القراءة تدَّعِي أساسًا أنها تقول ما لم يُحسِن المؤلف قوله، وفي هذه الحالة تُغْنِي القراءة عن النصّ، وتُصبِح أَوْلَى منه، وهكذا فثمة قراءة تلغي النصّ»[26].
ولأنّ الحداثة لا تعترف بالنصّ النموذج، فهي تعتبر أنّ قراءة الإبداع هي التي «ترفض النموذج، وترى أنّ النصّ يقترح على القارئ معاني متعددة في لحظات متجددة»[27]، ومعلوم أنّ القرآن الكريم هو النصّ النموذجي في المنظور الإسلامي، وأنّ كلّ العلوم الشرعية -وحتى اللغوية- دارت في فَلَكِه وقامت لخدمته منضبطة بضوابطه، بل إنّ النصّ القرآني كان الملهم الأوّل حتى لعلماء الطبيعة المسلمين[28] في عهد ازدهار الحضارة الإسلامية، عندما كان القرآن الكريم النصّ النموذجي للمسلمين، فكانوا بذلك: {خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}[آل عمران: 110].
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا الصّدد هو: هل يمكن الحديث عن القراءة بمختلف هذه المعاني إذا تعلَّق الأمر بغير نصوص الإبداع الإنساني؟ أي: هل يمكن تطبيق القراءة بهذه المفاهيم على النصوص الدينية قرآنًا أو سنة؟ قال الحبيب شبيل بعد أن تحدَّث عن معنى القراءة المبدعة: «يبدو أنّ بسط مشكل إبداع القراءة بالنسبة إلى الثقافة العربية لا يمكن أن يجري إلا على نصوص إنشائية؛ شعرًا أو روايةً أو مسرحًا»[29]، لكن الحداثة لا تميِّز النصوص الدينية عن غيرها من النصوص، والأدهى من هذا وذاك أن القراءة لا بد أن تكون ضالة.
5- القراءة ضالة:
وكأنّ الشقاوة والضلال قد كُتِبا على القراءة في عرف الحداثة من أول يوم وطئت قدمها بطون كتب النقد الأدبي، يقول هارولد بلوم: «فلا يوجد نصوص بإطلاق، بل علاقات بين نصوص، هذه العلاقات تعتمد على فعل نقدي وعلى قراءة ضالة، أو سوء قراءة... علاقة التأثير تشمل -تبعًا لذلك- القراءة مثلما تشمل الكتابة؛ ولهذا فإن القراءة تكون قراءة ضالّة مثلما تكون الكتابة سوء قراءة»[30]، هذا هو مفهوم القراءة في الحقل الأدبي! ليس هناك نصّ ثابت أو أصلي، بل كلّ نصّ هو تجميع لنصوص، وكلّ قراءة هي غير المقصود من النصّ؛ إذ لا بد أن تكون ضالة، والنصوص المقروءة نفسها نشأت عن طريق قراءة ضالة لنصوص سابقة! كيف يمكن إذن تطبيق أو إسقاط مثل هذه المعاني على القرآن الكريم باستعمال مصطلح (القراءة) السيئ السمعة في منشئه الذي هو الدراسات الأدبية؛ لارتباطه حتمًا بالضلال والتلاعب والعبث؟!
ولهذا يتشدَّق الحداثيون بأننا لم نفهم القرآن بعدُ! ذلك أنهم يستصحبون خاصية الضلال في القراءة، قال جمال البنا: «المسلمون فهموا القرآن عبر التفاسير فضلُّوا؛ لأنهم لم يفهموا القرآن كما أُنزل، إذن المسلمون لم يستفيدوا ولم يهدِهم القرآن في هذه الأجيال، كما هدى جيل الرسول أو على الأقل الأجيال الأُولى؛ لأنهم فهموا القرآن عبر التفاسير فضلُّوا»[31]، هكذا يكون المسلمون قد عاشوا -وما يزالون- في الضلال منذ أن بدأ تصنيف التفاسير، ولم ينجُ من هذا إلا الأجيال التي لم تشهد تفاسير القرآن!
فتفاسير القرآن في المنظور الحداثي هي مجرد قراءات ضالّة أو سوء قراءات نقرؤها نحن أيضًا قراءة ضالة وسيئة وهكذا دواليك، فلا معنى ولا دلالة! وإنما تتشكّل النصوص -سواء الأصلية أم المفسرة- من سلسلة من الفهوم الضالة! وقد أمعن عليّ حرب في تأكيد هذا المعنى من معاني القراءة فقال: «القراءة في النصّ سواء بحدِّها الأدنى كالشرح، أم بحدِّها الأقصى كالتفكيك، إنما هي فعل صَرْف وتحويل، يُعاد مع إنتاج المعنى بقدر ما يُعاد ترتيب الكلام نسخًا وتبديلًا، من هنا لا تطابق بين قارئ ومقروء»[32]؛ لأن «الفهم الموضوعي للنص، بمعنى الفهم المطابق للواقع غير ممكن؛ لأنّ العنصر الباطني أو ذهنية المفسر وقَبْلياته شرط لحصول الفهم»[33].
هذه جملة من الدلالات التي يتلون بها مصطلح القراءة[34]، وإن الاختلاف في دلالة هذا المصطلح بهذا الشكل وعدم تحديد مفهومه وإطلاقه بهذا التشويش الغريب، هو إنذار ببروز نزعة عبثية في الحقل المعرفي؛ لأنه إذا نظر إلى مفهوم القراءة من زاوية نفسه، أي: إذا (قُرئ) مصطلح القراءة، فإنه سيعود على نفسه بالإبطال؛ إذ يصير مفهومًا نسبيًّا متعددًا جديدًا في كلّ مرة! ثم إنه غير حيادي ومفكّك بل ضال أيضًا، سيصير بهذا مفهومًا هلاميًّا يستحيل الإمساك بأطرافه، وإذا كان المصطلح بدون مفهوم محدد، فهذا يعني بالتحديد أنه عدمٌ غير موجود! فالقراءة إذن هي العبث بالنصّ! والعدمية الدلالية والفراغ المفهومي في نهاية المطاف.
وهذا المصطلح بهذا المفهوم قد تسرَّب بدايةً إلى حقل النقد الأدبي من الفلسفة الغربية التي تعكس العبث والفراغ والعدمية الذين يفتكون بالبنية الفكرية لهذه الحضارة، رغم ما تتبرَّج به من ألوان التمدن والرقي المادي! وبعد أن انتقل المفهوم من الواقع والفلسفة إلى حقل الأدب ليعبث النقاد بالنصوص الأدبية -كما يعبث جميع الناس في هذه الحياة- شدَّ رحاله إلى ساحة جميع النصوص بما فيها الدينية! وقد آواه الحداثيون المسلمون، واحتضنوه زمنًا طويلًا في النصوص الأدبية، لكنه لم يلبث طويلًا حتى بدأ يتصدّر عناوين كُتبِهم مرتبطًا بالنصّ القرآني؛ ليصبح الواقع الغربي وفلسفته خلفية لقراءة القرآن الكريم!
المحور الثاني: مفهوم القراءة بين نظرية التلقي[35] والقرآن الكريم:
1- علاقة مفهوم القراءة بنظرية التلقي:
لقد أعطت الفلسفة التفكيكية السلطة للمتلقي فكانت القراءة هي علاقة المتلقي بالنصّ، وبالغ نصر حامد في اعتبار المتلقي[36]، مما جعله يقول بتغيّر طبيعة النصّ كُليًّا، الذي يتحول من الطبيعة الإلهية (وحي) إلى الطبيعة البشرية (مجرد نصّ) عندما يتناوله المتلقون، أي: البشر! قال: «القرآن نصّ مقدّس من ناحية منطوقه، ولكنه يصبح مفهومًا بالنسبي والمتغيّر، أي: من جهة الإنسان، ويتحوّل إلى نسب إنساني (يتأنسن)»[37]، وقال أيضًا: «النصّ منذ لحظة نزوله الأُولى -أي: مع قراءة النبيّ له لحظة الوحي- تحوَّل من كونه نصًّا إلهيًّا، وصار فهمًا نصًّا إنسانيًّا»[38]. فالنصّ حسب هذه الأقـوال يفقد قداسته لمجرد نزوله وتناوُل الإنسان له بالفهم! أي: إنه لا قداسة للدلالات؛ لأنها إنسانية، وهذا دون الأخذ بعين الاعتبار أيّ قيد أو شرط؛ كالتمييز بين فهم النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة -رضوان الله عليهم- مثلًا، ثم ألا يمكن فهم النص الإلهي ما لم يتحول ويُقرأ على أنه نصّ إنساني؟! أم أنه لا بد من ذلك؛ لأن موازين النقد التي تدرس بها النصوص واحدة، ولأنها تأسّست أصلًا من أجل النصوص الإنسانية، فما علينا إلا تحويل النصوص غير الإنسانية إلى نصوص إنسانية؛ لندرسها بهذه الآليات، ومن خلال موازين النقد هذه، والتي لا يوجد غيرها ولا يمكن أن يوجد غيرها؟!
وقال محمد أركون في هذا السياق: «لا أستطيع أن أفصل النصّ الذي صُنع لكي يُقرأ عن القارئ الذي يقرؤه»[39]، بل إنّ البعض ذهب إلى أنّ الكاتب والمتلقي كليهما يشتركان في إنتاج دلالات النصّ؛ لأن «النصّ مفتوح، وإنّ القارئ والمتلقي ينتجه في عملية مشاركة، وهذه المشاركة ليست هي الاستهلاك، وإنما هي اندماج القراءة والتأليف في عملية دلالية واحدة، بحيث تكون ممارسة القراءة إسهامًا في التأليف»[40]، لكن الواقع أنّ: «القارئ والمتفهّم هو غير المُلقِي والمتكلّم، بَلْه الموحِي والمرسِل، والنصّ يُنسَب بمنطوقه ودلالة ألفاظه صحة أو خطأ، واستعماله لأداة من أدوات الدلالة أو تلك -لقائله لا لقارئه، وهل يقوم النقد الأدبي وتفضيل شاعر على آخر إلا على حسن أو سوء اختيار لفظ للدلالة على معنى يقصده الشاعر ويعنيه؟! ولو كان الانتساب للقارئ لكان شعر امرئ القيس شاميًّا حين يقرؤه أهل الشام، وحجازيًّا حين يقرؤه الحجازيون... إنّ نظرية موت المؤلف... مكتوبة بحروف إيديولوجيا ترفض الدين منذ البداية... وتفرِّغ الإسلام من محتواه عن طريق تفريغ النصّ من دلالته»[41].
لقد بالغ البعض فأعطى للمتلقِّي سُلطةً من نوع آخر، بحيث لا يقتصر دوره على إعطاء دلالات جديدة للنصّ، وإنما يُملي على صاحب النصّ الألفاظ المستعملة نفسها؛ لأنه كما يقول سعد كموني: «إذا كانت المعاني خاصّة المبدع، فإنّ الألفاظ ألفاظ المتلقِّي، وأن يجد المبدع الألفاظ معه، وبإزاء ناظره إذا ظفر بالمعنى، فهذا يعني أنّ المبدِع لحظة الظفر تلك يكون مسكونًا بالمتلقي... وهذا يعني أنّ للمتلقي سلطة على النصّ تبدأ مع بدايات التفكير عند المبدع»[42]، هكذا يدخل المتلقي بسلطته قبل الإبداع نفسه بإملائه الألفاظ المستعملة على الكاتب!
إنّ هذه النظرية التي تستبعد النصّ والمؤلف معًا غير مستساغة لا منطقًا ولا عقلًا، حتى بالنسبة للنصوص الأدبية[43]، أما تطبيقها على نصّ ديني كالقرآن الكريم فيعني أنه لا يجوز أن يُدرَس على أنه كتاب الله! بل يجب أن ندرسه بِغَضِّ النظر عن صاحبه! يجب أن ننسى القداسة التي يستمدّها من كونه إلهيًّا، والنتيجة هي مساواته بكلّ النصوص، أي أنسنته! ثم إنَّ جعل معنى النصّ هو ما فهمه القارئ -حسب نظرية التلقِّي- يعني أن تفسير الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو ابن عباس أو أيّ رجلٍ على قارعة الطريق، كلّ ذلك سواء!
لذلك تجد أصحاب هذا الاتجاه عندما يحاصَرون بدلالات الآيات التي يقتضيها التفسير بالمنهج العلمي يقولون: هذا فهم الطبري والآخر فهم القرطبي... وهذا تأويلي أنا! وإذا أصبح لكلِّ واحد فهمه صار عندنا مليار وخمسمائة تفسير للقرآن! وهذا يقتضي أنه ليس هناك مفسر كبير وجاهل بالتفسير، كلٌّ له السلطة في فَهم ما يريد بالكيفية التي يريد، بمعنى أن وقت التفسير قد انتهى، وليس هناك في ظلّ نظرية التلقِّي إلا القراءات!
ولقد حارب المفسّرون القُدَامى مثل هذه الفكرة الفوضوية[44] التي تدعو إلى التسيُّب في فهم النصوص، خصوصًا مع الباطنية[45]، حيث أصبح «معنى الصلاة هو موالاة إمامهم، والحج هو زيارته وإدمان خدمته، والمراد بالصوم هو الإمساك عن إفشاء سرّ الإمام دون الإمساك عن الطعام، والزنا عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق، وزعموا أنّ مَن عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها، وتأوَّلوا في ذلك قوله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}[الحجر: 99]، وحملوا اليقين على معرفة التأويل»[46]؛ ولهذا فالحداثة بتبنِّيها لنظرية سلطة القارئ، التي تعبث بالنصوص بعيدًا عن أيّ منهج علمي إنما هي حركة باطنية حديثة![47]
إنّ العلماء المسلمين اهتموا بالمتلقِّي؛ لأن التفسير لا يفترض تغييب ذاتية المفسِّر، بل لقد ذكر السيوطي أنّ الشرط الخامس عشر من شروط المفسِّر هو علم الموهبة[48]، كما أنه ليس في الفكر الإسلامي فئة تحتكر التفسير بالمعنى الإكليروسي، ولكن هناك ضوابط لا يُفسِّر القرآنَ إلا مَن امتلكها والتزمها، وشروط لا يُقدِم على القول في القرآن إلا مَن توفَّرت فيه، وبالتالي فهناك مُفَسِّر ومُفَسَّر له؛ لوجود مَن يمتلك هذه الضوابط ومَن لا يمتلكها، علاوة على الحدود المنطقية التي لا يمكن تجاوزها، بل لا بد من اعتبارها في جميع أنواع النصوص؛ كلغة النصّ[49] ومؤلفه، «لأنّ أيّ نص -كما يقول الدكتور أحمد الريسوني- أو مفردة يختلف تفسيره ودلالته إذا ما عُرِف صاحبه، فصاحب النصّ وسياقه، ثم ألفاظ النصّ وبناؤه هي أمور لا يمكن إسقاطها، وفي حال أُسقطت فإنّ النصّ يسقط»[50].
قد يستند أنصار نظرية التلقي إلى دعوة القرآن إلى تدبر آياته، فنقول: صحيح إنّ القرآن دعا إلى التأمُّل فيه، ولكن بما أنّ القرآن مؤسِّس، فمن الأَولى أن يؤسِّس منهجًا لتدبره، ولا يُعقل أن يُترك الأمر فوضى، خصوصًا في قضية بهذه الأهمية، وهي منهجية الفهم؛ لأنه عندما تتعدّد مناهج التناول تتعدّد الأفهام، وعندما تكون هذه المناهج نفسها منطلقة من أفهام معيّنة فإنّ نتائجها هي فهوم موافقة لمنطلقاتها، وإذا كانت منهجيات تحليل النصوص الحديثة منطلقة من ظروف وملابسات كانت السبب في نشأتها؛ فإنّ تناول القرآن بها سيؤدِّي إلى إسقاط تلك الظروف التاريخية المولِّدة لتلك المنهجيات على القرآن الكريم.
إنّ تدبُّر القرآن ليس فوضى، بل له قواعد وأصول نابعة منه باعتباره مؤسِّسًا، وقد ذكر السيوطي بعضها تحت عنوان: (قواعد مهمّة يحتاج إليها المفسِّر)، منها ما يتعلق بالضمائر وبالتذكير والتأنيث وبالتعريف والتنكير وبالسؤال والجواب، وقد أشار إلى أنّ ابن الأنباري ألَّف في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين، ومن القواعد المتعلقة بالضمير التي فصَّل فيها السيوطي القول على سبيل المثال ما يأتي: 1- «الأصل في الضمير عوده على أقرب مذكور». 2- «الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرًا من التشتيت». 3- «جمع العاقِلات لا يعود عليه الضمير غالبًا إلا بصيغة الجمع». 4- «إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بُدِئ باللفظ ثم بالمعنى»[51]. هذا فقط في الضمائر، ثم تأتي القواعد الأخرى، يعني أن الأمر يتعلق بعملية في غاية الدقّة والإحكام والعِلْمِيَّة.
والقرآن الكريم يدعو إلى طاعة واتّباع الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومـن أهم مظاهر هذا الاتباع والطاعة ما كان في فهم النصّ بالتأكيد، إضافةً إلى أنه -عليه السلام- مُكلَّف ببيان ما أُنزل للناس؛ لذلك كانت السُّنَّة مِنْ ألْزَمِ المصادر في تفسير القرآن بنصّ القرآن نفسه، وكذلك نفهم الأهمية القصوى للغة العربية في تفسير القرآن الكريم من خلال الآيات الكثيرة التي يصف الله فيها القرآن بأنه عربي، وهناك الكثير من قواعد التفسير المستمَدّة من اللغة العربية[52].
وإن كان بعض العلماء المعاصرين مثل الدكتور فريد الأنصاري -رحمه الله تعالى- قد استعمل مصطلح (التلقِّي)، فإنه بهذا لا يحاول أسلمة نظرية التلقي أو التأصيل لها وهي بكلّ هذه الحمولات والدلالات التي تتنافى مع مسلَّمات الفكر الإسلامي، ذلك أن التلقِّي الذي قصده في كتابه: (مجالس القرآن: من التلقي إلى التزكية)[53]، يعني استقبال القرآن الكريم مع التفاعل النفسي والذهني والحضور الروحي للمتلقي، وفي غياب هذا التفاعل والشهود الروحي لا يعتبر الاستقبال تلقيًا، قال -تعالى ذكره- واصفًا الرسول -صلى الله عليه وسلم-: {وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ}[النمل: 6]؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يستقبل القرآن بكلّ جوارحه، وكان يكرِّره وراء المَلَك حتى طمأنه الله تعالى قائلًا: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى}[الأعلى: 6].
لقد برز مفهوم القراءة مع ظهور نظرية التلقي، ذلك أنّ: «النظر في القراءة -كما يقول الحبيب شِبيل- ناشئ عن الأهمية التي حظي بها المتلقي في النقد الحديث، وقد تبلورت في الغرب بفعل منظِّرين... اهتموا بالقارئ وبالعوامل المؤثرة في قراءته، وقد تم هذا الاهتمام بالقارئ بعد التراجع الذي عرفته البنيوية كفاعلية نقدية، مثَّلت في أول عهدها تحولًا عن النقد الكلاسيكي في اعتباره أنّ النقد محاكاة للواقع الموضوعي، وبعد انحسار الاتجاه النفسي الذي سيجعل النصّ المبدع انعكاسًا للا وعي المؤلف»[54]، فهناك إذن علاقة وثيقة بين مفهوم القراءة في الكتابات المعاصرة التي تتحدث عن النقد الأدبي وبين نظرية التلقي من جهة أَولى؛ لأن «القراءة شدَّت إليها اهتمام النقد اليوم، وشدَّدت على دور المتلقي، فاعتبرت قراءته إعادة إنتاج للنصّ الذي يقرؤه، بل إنها جعلت النصّ يفقد شرعية وجوده دون قراءة»[55]، ثم إنّ «الاعتناء بالقراءة والقارئ قد مثَّل في أحد وجوهه نتيجة لتطوّر (التأويلية) في الغرب منذ العقود الأُولى من هذا القرن، وساعد على هذا تراجع البنيوية في العقود الأخيرة»[56]، وهناك علاقة أوثق من جهة ثانية بين نظرية التلقي والحداثة، بل إنّ «التلقي لا يعدو أن يكون أحد أهم انتصارات الحداثة وما بعد الحداثة، وذلك بنقلهما من مجال الاهتمام بالكاتب والنصّ، إلى المتلقي والقارئ»[57].
وقد اختلفت النظريات الأدبية وتضاربت حول المفتاح الذي يمكن به الدخول إلى النصّ؛ لذلك نجد أنّ «العمر المنهجي الحديث ينطوي على ثلاث لحظات: لحظة (المؤلِّف) وتمثلت في نقد القرن التاسع عشر (التاريخي النفسي الاجتماعي...)، ثم لحظة (النَّصّ) التي جسَّدها النقد البنائي في الستينات من هذا القرن، وأخيرًا لحظة (القارئ) أو (المتلقِّي) كما في اتجاهات ما بعد البنيوية، ولا سيما نظرية التلقي في السبعينيات منه، وقيل في اتجاهات ما بعد البنيوية: إنها جاءت لتصحّح الأخطاء التي وقعت فيها البنيوية، وأبرزها الصنَمية النصِّيَّة، وموت المؤلف، وإهمال حركة التاريخ؛ فجاءت هذه الاتجاهات ردَّ فعلٍ حادّ على هذا الانغلاق النصي»[58].
هذا هو السياق التاريخي[59] الذي ظهرت فيه نظرية التلقِّي التي رمَتْنا بمصطلح القراءة، فإذا كان هذا حال النظريات الأدبية في التعامل مع النصوص؛ ما تفتأ إحداها تقف وتستوي على سوقها حتى تهجم صاحبتها بالنقض والهدم في بنيانها، وإذا كنا نستنكر ربط القرآن بكلّ النظريات العلمية المتعلقة بالطبيعة والكون لاحتمال الخطأ فيها، وأن ذلك لا يتم إلا بشروط صارمة[60]، فكيف يكون الحال عندما يتعلق الأمر بنظريات أدبية متضاربة؟!
2- القرآن الكريم ومصطلح القراءة:
إنّ اختلاف مواضيع النصوص يفرض الاختلاف في منهجية فهمها، حتى لو كانت هناك خطوط منهجية كبرى وعامّة يجب التزامها في جميع أنواع النصوص، كاحترام قواعد لغة النصّ، وسياق الكلام، وفهم الجزء في إطار الكلّ وغيرها، فخصوصيات بعض النصوص -وحتى العلوم عمومًا- تفرض بالضرورة التزامات منهجية مضافة؛ لذلك ليس من الاستثناء أن تكون هناك خصوصية منهجية في التعامل مع نصّ الوحي (القرآن الكريم)؛ لأن هذا الأمر مفروض -كما يقول زهير بيطار- «بسبب اختلاف جوهري بين النصوص البشرية والنصوص الربّانية على الأقلّ من جهة المتكلِّم ومقاصده، وجهة المخاطَب في الالتزام المطلوب منه بمقاصد المتكلِّم»[61].
وعدم التفريق بين النصوص البشرية والنصّ الإلهي قد يوقع في مزالق منهجيّة خطيرة؛ بحيث تُجرَى على النصّ الإلهي فكرة فرويد «التي تقول: إنّ في كلّ عمل أو قول يصدر عن الإنسان عنصرًا خفيًّا في نفسه، لا يعلمه هو، ناهيك عن غيره، ويتجلَّى في إنتاجه مضافًا إلى إرادته الواعية؛ لذلك لا يمكن معرفة قصد المؤلف، ومنه فإنّ أيّ نصّ لا يقتضي البحث عن ذلك، بل هو متعذر»[62]. والجواب عن مثل هذه الشبهة التفكيكية التي قد يُعترَض بها للتدليل على عدم إمكانية بلوغ قصد صاحب النصّ، هو: أنّ النصوص بطبيعتها ليست سواء؛ «لأن ما يقال عن عنصر خفيّ في نفسيّة المتكلِّم خلف إرادته الواعية، لا ينسحب بحالٍ من الأحوال على خطاب الوحي الإلهي الصادر عن الله، فكلامه تعالى يعبّر عن إرادته تعبيرًا صادقًا، وفهم الخلفية الثقافية والنفسية للمتكلِّم وظرفيتها لا يسري بذات المضمون على نصوص الوحي... وكمال الذات الإلهية يجعل كلام الله يختلف جذريًّا عن كلام البشر»[63].
فاعتماد أصول لتفسير القرآن الكريم -أو أيّ نصّ- هو مما يقتضيه المنطق والعلم ضرورةً، وتقرُّه كلّ الأوساط الأدبية للاعتبارات الآتية: «أن مما تواضع عليه أهلُ العلم والمعرفة، أنه لغرض الفهم والإحاطة بأسرار أيّ علم ومعرفة دقائقه، لا بد من الرجوع إلى الخبراء المتخصصين فيه...؛ لذلك يجب الرجوع إلى أهل العلم بالقرآن وبلغة العرب، ثم إنّ الرجوع إلى النبي لطلب شرح القرآن تقتضيه طبيعة الأشياء...، ذلك أنّ أيّ كتاب إذا أردنا فهم المراد من عباراته وتيسَّر لنا أن نتصل بمؤلفه ونستشرحه منه، أو نهتدي إلى طريقة أبان عنها صاحب الكتاب بوجهٍ ما؛ فلا شكَّ أنّ ذلك سيجعلنا على ثقة أكبر بصحة استنتاجاتنا...، والكتاب كلما كان راقيًا في مطالبه، عميقًا في مراميه، واسعًا في أغراضه... كانت حاجتنا أشدّ في الاهتداء إلى الطرق الموصلة إلى رحابه... بل إنّ الأمانة العلمية تقتضي أن نفتش عن تلك الطرائق ونأخذ أنفسنا بالصرامة في سلوكها»[64]؛ لهذه الأسباب لا يمكن أن يكون مصطلح القراءة بمفهومه الحداثي بديلًا عن التفسير والتأويل، وليس لأن المسلمين يخافون من أن يكتشف في كتابهم اضطراب أو تتبيّن فيه ثغرات كما يُتَوهّم.
[1] نُشر هذا المقال في ملتقى أهل التفسير بتاريخ: 24/6/1432هـ - 27/5/2011م، وأصله موضوع قدّم في ندوة وطنية نظّمت سنة 2009م بالمغرب، بتنسيق بين: المجلس العلمي المحلي بالمحمدية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، حول موضوع: (القراءات المعاصرة للقرآن الكريم).
[2] (هكذا أقرأ ما بعد التفكيك)، ص9.
[3] وقد تردد على ألسنتهم كثيرًا كمحمد أركون قال مثلًا: «قبل أن أباشر القراءة...»، يقصد قراءة سورة التوبة، (الفكر الإسلامي قراءة علمية)، ص92- 103.
[4] (في قراءة النص الديني)، ص94.
[5] (الخطاب الديني رؤية نقدية)، ص58.
[6] (عيال الله: أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين)، ص68، ومن الحداثيين الذين دعَوا إلى استبدال المصطلحات الحداثية بمصطلحات التراث حسن حنفي الذي يرى أنه لا بد من التخلص من الكثير مما يسميه بـ(الألفاظ التقليدية)، مثل: «(الإجماع) و(الاجتهاد) اللذان أصبحا يعبران عن مذاهب فقهية تاريخية محدودة... أما لفظ (الخبرة بين الذوات) أو (التجربة المشتركة) فهو لفظ معاصر يثير وجدان المعاصرين... وكذلك لفظ (شرعي) ما زال لفظًا دينيًّا وقانونيًّا وتاريخيًّا، ويمكن التعبير عن معناه بلفظ (قبلي)». (التراث والتجديد)، ص123- 124. والأدهى من هذا وذاك أنه لم يقتصر على العبث بهذه المصطلحات الأصولية، بل تعدَّى ذلك إلى اسم الجلالة (الله) نفسه فقال: «الألفاظ العقلية والتقليدية مثل: الأول، والآخر، والظاهر، والباطن... كلّها ألفاظ تقليدية لا يفيد تبديل أحدهما بالآخر، لكن الانتقال من (الله) إلى (الإنسان الكامل) يعبر عن كلّ مضمون الله، فكلّ صفات الله: العلم، والقدرة، والحياة، والسمع... كلّها هي صفات الإنسان الكامل... فالإنسان الكامل أكثر تعبيرًا عن المضمون من لفظ (الله)». المرجع السابق، ص124.
[7] لا ندّعي أنه استقراء كُلِّي، لكنَّ الاستقراء الجزئي أيضًا يفيد العلم، قال الشاطبي: «فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب». (الموافقات في أصول الشريعة)، ج1، ص24.
[8] (حدود القراءة)، لإدريس المسماري، ص11.
[9] (إبداع القراءة)، للحبيب شبيل، ص136، بحث منشور ضمن أعمال ندوة: (النصّ والقراءة في الثقافة العربية الإسلامية)، بتاريخ: 4-5-6 أفريل 1997م، من منشورات مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، طبع ديسمبر 1999م.
[10] (قراءة جديدة للقرآن)، لعطية عامر، ص7.
[11] (إسلام المجددين)، لمحمد حمزة، ص56.
[12] (حدود القراءة)، ص12.
[13] (الفكر الإسلامي نقد واجتهاد)، ص94.
[14] (عيال الله)، ص68.
[15] نفسه، ص71.
[16] (التسهيل لعلوم التنزيل)، ج1، ص15. ومن أول ما أُلِّف في أسباب اختلاف المجتهدين كتاب: (الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم)، لابن السيد البطليوسي، حققه محمد رضوان الداية. ومن أنفس هذه المؤلفات كذلك رسالة ابن تيمية: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، تحقيق عبد الله الأنصاري.
[17] (هكذا أقرأ ما بعد التفكيك)، ص21.
[18] (قراءة جديدة للقرآن)، لعطية عامر، ص6- 7.
[19] (هكذا أقرأ ما بعد التفكيك)، لعليّ حرب، ص16.
[20] نفس المرجع، ص27.
[21] ترجمة: عابد إسماعيل، ص10.
[22] (إبداع القراءة)، للحبيب شبيل، ص137.
[23] (حوارات حول فهم النصّ وقضايا الفكر الديني)، لزهير بيطار، ص23.
[24] «التفكيك قد يكون في أبسط أشكاله مجرد فكّ للحرف لدرك المعنى، وقد يكون اشتغالًا على المعنى بتفكيك بنيته وأصوله، أو تعرية مسبقاته ومحجوباته، أو تبيان خدعه وألاعيبه، أو فضح سلطته وتحكماته؛ للكشف عما يمارسه الكلام من الحجب والخداع، والاعتباط أو الادعاء والتحكم والمصادرة». (هكذا أقرأ ما بعد التفكيك)، لعليّ حرب، ص26.
[25] نفس المرجع، ص25.
[26] (نقد النص)، ص20.
[27] (إبداع القراءة)، للحبيب شبيل، ص136.
[28] فقد ارتبطت أول الجهود العلمية في مجال علم الفلك -مثلًا- عند المسلمين، بالرغبة في تحديد مواقيت الصلاة بدقّة.
[29] المرجع السابق، ص138.
[30] (خريطة للقراءة الضالة) لهارولد بلوم، ترجمة: عابد إسماعيل، ص7-8.
[31] (نحو قراءة جديدة للقرآن في ظلّ التحديات المعاصرة)، حوار أجرته معه صباح البغدادي، ص108، مجلة: (رؤى)، ع23- 24، س2004.
[32] (هكذا أقرأ ما بعد التفكيك)، لعليّ حرب، ص27.
[33] (حوارات حول فهم النص وقضايا الفكر الديني)، لزهير بيطار، ص23.
[34] وقد حاولتُ استقراءها في ساحة الكتابات الحداثية عمومًا، والدراسات النقدية الأدبية خصوصًا؛ لأن هذا المصطلح انتقل أصلًا من هذه الأخيرة إلى النصوص الدينية.
[35] «ظهرت هذه النظرية في الأدب الألماني، وارتبط مفهومها بالصراع الذي واجهته ألمانيا الغربية مع النظام الماركسي؛ ولهذا كانت المعسكرات الماركسية من أشدّ المعارضين لهذه النظرية». (قراءة النصّ وجمالية التلقي)، لمحمود عباس عبد الواحد، ص16، ويرى عبد الله إبراهيم أنه لا يمكن فهم نظرية التلقي «إلا إذا نزلت منزلتها الحقيقية بوصفها نشاطًا فكريًّا متصلًا بنظرية أكثر شمولًا هي نظرية (الاتصال) التي بدأت ملامحها تتبلور منذ منتصف القرن العشرين في ألمانيا». (التلقي والسياقات الثقافية: بحث في تأويل الظاهرة الأدبية)، ص7.
[36] بلغ إعجاب بعض الكُتّاب بنظرية التلقي درجة مناصرتها ولو بشكل صوري من خلال عناوين لا تعبِّر عن مضمون المؤلَّف، كما عند ألفة يوسف في كتاب: (تعدد المعنى في القرآن الكريم: بحث في أسس تعدد المعنى في اللغة من خلال تفاسير القرآن)، فهذا العنوان الذي يوحي بالانغماس في نظرية التلقي إنما كُدِّس تحته ما جاء عن أسباب اختلاف المفسرين، التي أُفردت لها كتب مثل: (اختلاف المفسرين؛ أسبابه وآثاره) لعبد الله الفنيسان، و(أسباب اختلاف المفسرين) لمحمد بن عبد الرحمن بن صالح، كما أن هذه الأسباب تُذكر ضمن مؤلفات أسباب اختلاف العلماء عمومًا، وكذلك ضمن كتب أصول التفسير، فما جدوى إعادة كتابتها تحت مثل هذا العنوان الخادع مع مزجها بأقوال بعض الفلاسفة الغربيين المعاصرين كفتغنشتاين، ومع التعقيد المصطلحي كالحديث عن المعنى (الماصدقي) و(الرمزي) وغيرهما؟!
[37] (الخطاب الديني رؤية نقدية)، ص64.
[38] نفس المرجع، ص64.
[39] (الفكر الإسلامي قراءة علمية)، ص231.
[40] (النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق)، لعدنان بن ذريل، ص18.
[41] (الماركسلامية والقرآن)، لمحمد المعراوي، ص354- 355.
[42] (العقل العربي في القرآن)، لسعد كموني، ص47، فصل بعنوان: (المتلقي منتجًا للنصّ).
[43] قال د. رضوان بن شقرون منتقدًا نظرية موت المؤلف: «النقاد الأدبيون يتناقضون عندما يطلبون في النصّ الأدبي الشروط الآتية: 1- الفكرة. 2- الخيال. 3- العاطفة. 4- الأسلوب. ويقولون في نفس الوقت بموت صاحب النصّ، إذ كيف نجرِّد النصّ عن صاحبه ثم نشترط العاطفة، والأسلوب إنما هو دليل صاحبه؟!» قاله في تعليق على محاضرة: (القراءات الحديثة للقرآن الكريم)، د. مصطفى بن حمزة.
[44] إذا كانت الفوضوية Anarchisme: «مذهبًا اجتماعيًّا اشتق اسمه من لفظة إغريقية بمعنى (لا حكومة)، وهو مذهب يناهض قيام الحكومات، ويدعو إلى إنشاء مؤسسات اجتماعية واقتصادية بمحض اختيار الناس وإرادتهم الحرة». (الحداثة وما بعد الحداثة)، لعبد الوهاب المسيري، وفتحي التريكي، ص358. فكذلك الاتجاه الحداثي يكاد يكون مذهبًا فلسفيًّا يناهض قيام المناهج العلمية للتعامل مع النصوص، ويدعو إلى إطلاق الحبل على الغارب للقرّاء يفعلون بالنصوص ما يشاؤون! تلك فوضى وهذه فوضى.
[45] قال عبد القاهر البغدادي في (الفَرق بين الفِرق): «ظهرت دعوة الباطنية في أيام المأمون من أحمد قَرْمِط، ومن عبد الله بن ميمون القدَّاح، وليست الباطنية من فِرَق ملة الإسلام بل هي من فرق المجوس»، ص22، وقال: «من شرط الداعي إلى بدعتهم أن يكون قويًّا على التلبيس، وعارفًا بوجوه تأويل الظواهر ليردّها إلى الباطن»، ص298.
[46] (الفرق بين الفرق)، لعبد القاهر البغدادي، ص296.
[47] فالمتأمل يجد فعلًا أن التاريخ يُعيد نفسه في مثل هذه الانحرافات الفكرية، فإذا كان هَمُّ الباطنية الأول هو إثارة الشبهات خصوصًا حول المسائل العبادية ذات الكيفيات الخاصة والمقادير المعيّنة التوقيفية: «كقولهم لِمَ صارت صلاة الصبح ركعتين، والظهر أربعًا، والمغرب ثلاثًا؟! ولِمَ صار في كلّ ركعة ركوع واحد وسجدتان؟! لم كان الوضوء على أربعة والتيمم على عضوين؟! ولم وجب الغُسل من المني وهو عند أكثر المسلمين طاهر، ولم يجب الغسل من البول مع نجاسته عند الجميع؟... فإذا سمع الغِرُّ منهم مثل هذه الأسئلة ورجع إليهم في تأويلها، قالوا له: علمها عند إمامنا وعند المأذون له في كشف أسرارنا، فإذا تقرر عند الغِرِّ أن إمامهم أو مأذونه هو العالم بتأويله، واعتقد أن المراد بظواهر القرآن والسنة غير ظاهرها، فأخرجوه بهذه الحيلة عن العمل بأحكام الشريعة». (الفَرق بين الفِرق)، للبغدادي، ص306.
كذلك مفكرو الحداثة المهتمّون بالدرس القرآني، لم يتركوا شُبهة من شُبَه المستشرقين حول القرآن إلا أوردوها، بدءًا من التشكيك في نزاهة عملية تدوين النصّ القرآني أو ما يسميه أركون: «بضرورة إعادة كتابة قصة التشكُّل الأُولى بشكلٍ جديدٍ كليًّا، ونقد القصة الرسمية للتشكُّل التي رسَّخها التراث المنقول نقدًا جذريًّا». (تاريخية الفكر العربي الإسلامي)، ص291. وقد دندن حول هذا الأمر الكثير من المستشرقين، والمبرّر بالنسبة إلى محمد أركون هو أنّ النصّ القرآني قد تعرَّض للتحريف! قال: «إنّ المشرِّعين من البشر -أي: الفقهاء- قد سمحوا لأنفسهم بالتلاعب بالآيات القرآنية من أجل تشكيل علم للتوريث». (من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي)، ص67. إنه يكرّر نفس شُبه المستشرقين واحدة واحدة؛ فالنصّ القرآني كذلك -بالنسبة إليه- يقوم على التناصّ من الكتب السابقة كما بينَّا في مطلب: (الهرمنوطيقا في المرحلة البنيوية)، وهو بذلك يزكي ما ذهب إليه جولدتسيهر من أن: «محمد لم يبشِّر بجديد من الأفكار». (العقيدة والشريعة في الإسلام)، ص5. وكذلك كلّ الشُّبه حول علوم القرآن وتراثه التي سلك المستشرقون طريقها.
[48] انظر: (الإتقان في علوم القرآن)، ج2، ص399.
[49] قال محمد الكتاني: «لم تعد لغة النصّ تمثل أهمية تُذكر في مفهوم التلقي». (الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث)، ج1، ص79.
[50] (في حدود فتح النصّ للتأويل وشروطه)، لأحمد الريسوني، ص88. (المنطلق الجديد)، ع9، س2006.
[51] وهنا لا بد من التمييز بين تدبّر العبادة وتدبّر المتخصصين من أهل العلم، بحيث يكون استدعاء هذه الأصول أكثر إلحاحًا في الحالة الثانية.
[52] انظر: (الإتقان)، ج1، ص397، وما بعدها.
[53] يحمل هذا الكتيِّب مشروعًا إصلاحيًّا، يقوم على إعادة الاعتبار للتفاعل الوجداني مع النصّ القرآني، كأصل للإصلاح يمكن أن يقع في بنيان الأمة الإسلامية؛ لأن القرآن الكريم إنما ينتفع به مَن {كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ}[ق: 37]، فالشهود الروحي عند استقبال القرآن -والذي يُسمَّى في هذه الحالة تلقيًا- هو أصل الإصلاح بالقرآن، ولقد أورد عدة طرق وآليات لإعادة استحضار القرآن الكريم في حياة المسلمين استحضارًا بالروح.
[54] (إبداع القراءة)، للحبيب شبيل، ص136.
[55] نفسه، ص133.
[56] نفس المرجع، ونفس المكان.
[57] (الحداثة والتلقي)، لعمر عبود، ص87. مجلة: (فكر ونقد)، ع53، س2003.
[58] (نظرية التلقي أصول وتطبيقات)، لبشرى موسى صالح، ص32. وهذا الكتاب من أجمل الكتب في هذا الموضوع، أسلوبه سلس ولغته واضحة. إلى جانب كتاب: (التلقي والسياقات الثقافية)، لعبد الله إبراهيم.
[59] حيث تربّع المبدع فترة طويلة على عرش السلطة في النصّ، إلى أن حاول النقاد الشكلانيون والبنيويون إزاحته ليضعوا مكانه النصّ، لكن هذا الأخير لم يلبث طويلًا حتى جاء التفكيكيون ليصبح المتلقي هو أساس العملية النقدية، فصار النصّ بناءً ينتظر القارئ لينفخ فيه الروح، ويسبغ عليه المعنى الذي يريده ويقصده.
[60] لخص فضل حسن عباس الشروط التي لا بد أن يستجمعها التفسير العلمي كالآتي: «1- موافقة اللغة العربية موافقة تامّة. 2- عدم مخالفة صحيح المأثور عن الرسـول أو ما له حكم الموفوع. 3- موافقة سياق الآيات بحيث لا يكون التفسير نافـرًا عن السياق. 4- التحذير من أن يتعرض التفسير العلمي لأخبار وشؤون المعجزات أو اليوم الآخر. 5- أن لا يكون التفسير حسب نظريات وَهْمِيَّة متداعية، بل لا بد أن يكون حسب الحقائق العلمية الثابتة». (التفسير: أساسياته واتجاهاته)، ص624.
[61] (حوارات حول فهم النصّ وقضايا الفكر الديني)، ص32 بتصرف.
[62] نفسه، ص33، بتصرف.
[63] نفسه، ص34.
[64] (دعوى التناقض بين نصوص القرآن الكريم؛ تاريخها ومعالجتها)، حسين شرارة، ص31- 33، بتصرف كبير. وقد برهن من خلال كلامه المذكور أعلاه على ضرورة «الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت في تفسير النصّ القرآني واستنطاقها، والرجوع إلى الصحابة فيما وعَوه وشهدوه من الوحي والتنزيل، لا غنى عنهما في هذا المجال». نفس المرجع ونفس المكان.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

فاطمة الزهراء الناصري
باحثة بمركز الدراسات القرآنية التابع للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، لها عدد من المؤلفات والأبحاث العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))