جماليّة المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثير
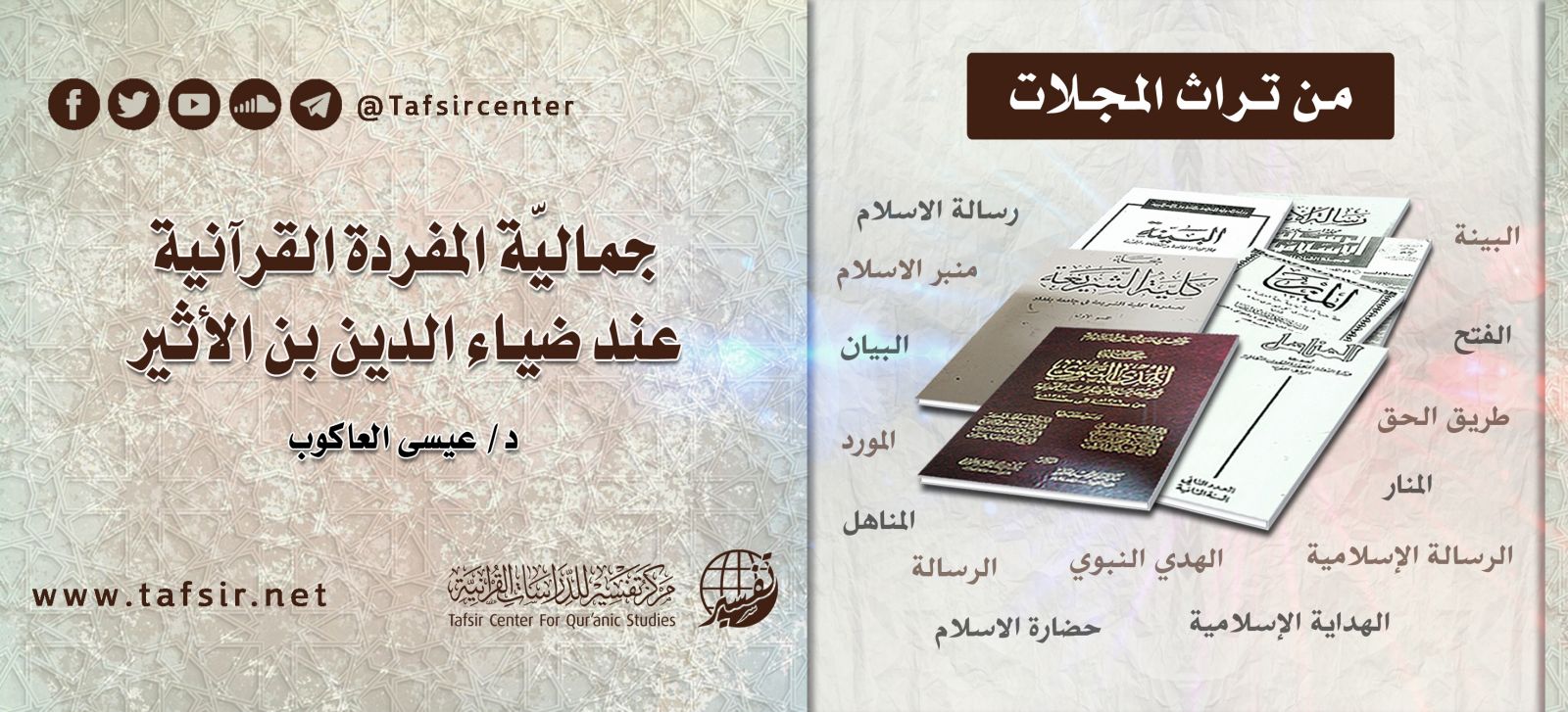
جماليّة المفردة القرآنية عند ضياء الدين بن الأثير[1]
1- شخصية ضياء الدين:
قُيِّض لأبي الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، المشهور بابن الأثير الجزري الموصلي، والملقب بضياء الدين[2]، أن يعيش قريبًا من ثمانين حِجّةً في أواخر القرن السادس والشطر الأول من السابع الهجري. وقد وفَّر له عصره المتأخر نسبيًّا، بالإضافة إلى ما أُوتي من مَلَكاتٍ وآلات، ما جعله واحدًا من الأفذاذ الذين تَرْسُم حياتُهم معالمَ واضحةً في تاريخ أمّتهم. وحسْبُ المرء أن يعود إلى كتابه المشهور (المثل السائر) ليعرف مبلغ الثقافة والاطّلاع والقُدرة على الابتداع التي أُوتيها الرجل. وقد يمكِّنُنا الدرسُ من الإلمام بسِيَر كثير من أعلام الثقافة والأدب وفُرسان البيان والبلاغة ممن ينتسبون إلى هذه الأمّة، لكن سيرة ضياء الدين تظلّ بحقّ نسيجًا وحدها.
ذلك أنك أمَام رجل من أصحاب المزاج العصبي، هؤلاء الذين تحمل أساليبهم سيماء تَميُّز في السلوك والحياة والتعامل مع الآخرين. ولعلّ أبرز ما يميّز شخصية ضياء الدين أنه عَرَفَ قدرَ نفسه كما عرَف أقدار الآخرين. ومن هنا كنت تجد منه هذا الحرص على التميّز والغلبة. ولعَمري، إنّ هذه أُولى مخايل النبوغ والألمعية، وهو مما آنسه ضياء الدين في نفسه فقال عن نفسه:
أطاعَتْه أنواعُ البلاغةِ فاهتدى ** إلى الشّعر من نهجٍ إليه قويم
وتطالعك هذه الشخصية القوية حيث يمَّمْتَ فيما تقرأ من آثار الرجل، لكنها تظهر على أشدّها في حرص ضياء الدين على أن يأتي بالجديد الذي لم يسبقه إليه أحد. وهو كثير الحبور لأنه حُبِيَ درجة الاجتهاد، بينما يعيش جمهور الكاتبين على اجترار نتاجات الآخرين والتحوير فيها والتعليق عليها. وفي ذلك يقول: «وهداني الله لابتداع أشياء لم تكن مِن قَبلي مبتدعة، ومنَحني درجة الاجتهاد التي لا تكون أقوالها تابعة، وإنما هي مُتَّبَعة»[3]. أَنِسَ ضياء الدين هذا في نفسه، وأدرك معه شيئًا آخر هو «المنزلة العلية» لصناعة الكتابة؛ فقد نزلتْ فيه منزلة المحَبّ المُكرَم. وما دام الأمر كذلك فقد سخّر لها أقصى غايات قدراته.
وإذا كان العرب قد ألّفوا قبل عصره فيما ينبغي أن يتوسّل به الكاتب من الأدوات؛ أي: فيما عُرف بـ«أدب الكاتب أو الكُتَّاب»، فإنّ ضياء الدين قد تشدّد أكثر منهم في شأن ملَكات متعاطي صناعة البيان. يقول: «وبالجملة فإنّ صاحب هذه الصناعة يحتاج إلى التشبث بكلّ فنّ من الفنون، حتى إنه يحتاج إلى معرفة ما تقول النادبة بين النساء، والماشطة عند جلوة العروس، وإلى ما يقوله المنادي في السوق على السلعة»[4]. ولا شك في أن الرجل كان يعرف ذلك في نفسه، ومن ثم أخذ يطلبه من الآخرين.
2- ثقافته ومؤلّفاته:
تلقّى ضياءُ الدين ثقافةً ممتازة، وتبيَّنَ العناصرَ الأساسية لثقافة من يريد أن يكون كاتبًا للدولة، وأدركَ أن المَعِين الأول الذي ينبغي أن يستقِيَ منه إنما هو القرآن الكريم والأحاديث النبوية ودواوين فحول الشعراء. فهذه خير ما يرجع إليه من وجدَ في نفسه قابلية للتأدّب بأدب الدرس وأدب النفس. ولقد أفادته مزاولة الكتابة الشيء الكثير مما كان عصيًّا على أقرانه أن ينالوا منه إلا اليسير. فهو يقول: «ولقد مارستُ الكتابة ممارسةً كشفَتْ لي عن أسرارها، وأظفرتني بكنوز جواهرها، إِذْ لم يظفر غيري بأحجارها. فما وجدتُ أَعْوَنَ الأشياء عليها إلا حلّ آيات القرآن الكريم والأخبار النبوية، وحلّ الأبيات الشِّعرية»[5].
كان الذِّكْرُ الحكيمُ الأساسَ الذي شيَّد عليه ضياء الدين طريقته البيانية، وتميّزَ به عن كلّ مَن عالج الكتابة، وجرى منها على عِرق، ولضياء الدين تعامُلٌ خاصّ مع كتاب الله تعالى، وهو يحدّده على هذا النحو: «واعلم أن المتصدِّي لحلّ معاني القرآن يحتاج إلى كثرة الدّرْس؛ فإنه كلّما دِيم على درسه ظهر من معانيه ما لم يظهر من قبل، وهذا شيء جربته وخبرته، فإنّي كنتُ آخذ سورة من السُّور وأتلوها، وكلما مَرَّ بي معنى أُثبته في ورقة مفردة، حتى أنتهِيَ إلى آخرها، ثم آخذ في حلّ تلك المعاني التي أثبتُّها واحدًا بعد واحد، ولا أقنع بذلك حتى أعاود تلاوة تلك السورة، وأفعل مثل ما فعلتُه أولًا، وكلّما صَقَلَتْهَا التلاوةُ مرّة بعد مرّة، ظهر في كلّ مرّة من المعاني ما لم يظهر في المرّة التي قبلها»[6].
أمّا المنهل الثاني الذي نهل منه ضياء الدين فقد كان الشِّعر العربي، وفي أخباره أنه استظهر كثيرًا من أشعار الفحول، الذين شرعوا طريقة النَّظْم للعرب، ومهّدوا السبيل لمَن أتى بعدهم. وابن الأثير يُحْسِن الإفادة من هذه الأشعار. وقد كان حِسُّ الانتقاء عنده قويًّا، ومن هنا قرأ كلَّ أشعار العرب، واختار منها ما آنس فيه تقوية لملَكة البيان. وفي معرض حديثه عن «جوامع الكلم»، التي هي إحدى ثلاث أوتيها النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يؤتَها أحدٌ من قبلِه، يقول: «وقد ورد شيء من ذلك في أقوال الشعراء المفلقين، ولقد تصفَّحْتُ الأشعار قديمها وحديثها، وحفظتُ ما حفظتُ منها، وكنتُ إذا مررتُ بنظري في ديوان من الدواوين ويلوح لي فيه مثل هذه الألفاظ أجد له نشوةً كنشوة الخمر، وطربًا كطرب الألحان، وكثيرٌ من الناظمين والناثرين يمرّ على ذلك ولا يتفطّن له، سوى أنه يستحسنه من غير نظر فيما نظرتُ أنا فيه، ويظنّه كغيره من الألفاظ المستحسنة»[7]. لقد وضع ضياء الدين نصب عينيه أن يكون أميرًا من أمراء البيان العربي، فعكف على دراسة آثار الأئمة السابقين مستفيدًا منهم ما هدتهم إليه عبقريتهم ونبوغهم، ولكنه لم يقف عند الغاية التي جرَوا إليها، بل كان شاغله أن يضيف إلى ما أَتَوا به، ويُثري ديوان البيان العربي بنتائج تجتليها العيون شرقًا وغربًا. والحقُّ أن ضياء الدين كان يعيش تحت وطأة إحساس من أراد أن يكون معلِّمًا لصناعة البيان وراسمًا لخطوطها الأساسية.
ولا غرابة بعد هذا أن نجد بين أسماء مصنّفاته كتابَه المشهور: (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر). فقد هَدَفَ إلى أن يرسُمَ معالم الطريق لمن يريدون أن يسلكوا، وهو كتاب يدرك الباحثون اليوم قيمته الحقيقية ومنزلته بين كتب البلاغة والنقد العربية. أمّا القدماء فقد شهدوا بقيمته، وعرفوا لصاحبه صنيعه الطيب، يقول ابن خلكان عن هذا الكتاب: «وهو في مجلدين جمع فيه فأوعى، ولم يترك شيئًا يتعلق بفنّ الكتابة إلا ذَكَرَه»[8]، ومعروفٌ ما كان من صدى لهذا الكتاب لدى معاصري ضياء الدين والتالين لهم. أمّا كتابه الآخر الذي نحا فيه منحًى تعليميًّا فهو مجموع اختار فيه من شِعْر أبي تمام والبحتري وديك الجن والمتنبي. وعنه يقول ابن خلكان: «وهو في مجلد واحد كبير، وحِفظه مفيد»[9].
ولضياء الدين كتاب آخر اسمه (الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور)، وهو يشير في بدايته إلى أنه أراد أن يتقن صناعة تأليف الكلام فبَدَا له أنه لن يبلغ المراد ما لم يطّلع على علم البيان، الذي هو لهذه الصناعة بمنزلة الميزان، ويذكر أنه أمضى وقتًا مديدًا في التماس أسبابه ووسائله. ويقول: «فلم أترك في تحصيله سبيلًا إلا نهجتُه، ولا غادرت في إدراكه بابًا إلا ولجتُه، حتى اتضح عندي باديه وخافيه، وانكشف لي أقوال الأئمة المشهورين فيه، كأبي الحسن عليّ بن عيسى الرماني، وأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، وأبي عثمان الجاحظ، وقدامة بن جعفر الكاتب، وأبي هلال العسكري، وأبي العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي، وأبي محمد عبد الله بن سنان الخفاجي، وغيرِهم ممن لهم كتاب يُشار إليه، وقول تُعقد الخناصر عليه»[10].
وجملة القول أنّ الدارس يظلّ إزاء ضياء الدين مطمئنًّا إلى عالِم حدّد وِجهتَه ومقصده، وأغذّ السير نحوه بكلّ ما أُوتي من قوة. يدلُّك على ذلك هذا الفيضُ من الأعلام الذين قرأ لهم وناقش آراءهم؛ فأيّد وناصَر أو فنَّد وخالَف. وقد عدَّ له ابنُ خلّكان سبعة مصنفات أثنى عليها جميعًا.
3- ضياء الدين والقرآن الكريم:
لا نجد بليغًا في العربية -سواءٌ أكان ممن دانُوا بالإسلام أم ممن لم يَدِينوا به- لم يطعَم من مائدة القرآن الكريم زادًا من البيان العالي الذي تستطيع أن تتبيَّن سيماءه فيما ترك من نتاج. ولن يحتاج المرء إلّا إلى قليل من النظر ليقف عند آثار القرآن فيما خلَّف كبار الكُتَّاب وعظماء الشُّعَراء. فلقد أسلمَت هذه الأمة مقادتَها لبلاغة القرآن، وكان مقدار الاستجابة لهذا الكتاب المبين وللدِّين الجديد بين قبائل العرب موازيًا لحظوظها من الفصاحة والبلاغة، وعَنَت وجوه الرجال لذي العِزَّة صاحب الكتاب بمقدار نصيب الواحد منهم من اللّسَن والبيان. ولقد أحسن الرافعي -رحمه الله- التعبيرَ عن قيادة القرآن لأمة العرب وتأثيره في فطرتها في قوله: «ومن أين له (أي للقرآن الكريم) إلّا أن يأتي الفطرة التي هي أساس هذه كلّها، فيملكها، ثم يصوغها، ثم يصرفها؛ فإنّ الذي لا يدفع الطبع لا يدفع الرغبة، ومن لم يَقُدْ الأمّة من رغائبها لم يَقُد في زمامه غير نفسِه، وإن كان بعد ذلك من كان، وإن جهد، وإن بالغ»[11].
والحقّ أن ضياء الدين ذو خصوصية وتميّز في هذا الشأن، بل ربما بزَّ السابقين في النهل من معين القرآن، ولا تفارقك آياتُ الذِّكر الحكيم ووجوه بيانه وإعجازه في صفحة من صفحات (مَثله السائر)؛ فقد وقر في صدره أن بيان القرآن فوق كلّ بيان، وأن طريق أيّ ملتمِس لصناعة النَّظْم والنثر ينبغي أن يبدأ بالعكوف على القرآن، وإمعانِ النظر في طرائقه وأساليبه. وضياء الدين كثير الإشارة إلى تلمذته على كتاب الله عزّ وجلّ، وإفادته منه ما جلَّى به وبزَّ الكثيرين. وفي فصل من فصول المثل السائر وسَمه بـ(الطريق إلى تعلّم الكتابة) يقول: «والثالثة أن لا يتصفح (أي طالب البيان) كتابة المتقدِّمين، ولا يطّلِع على شيء منها، بل يصرف همّه إلى حفظِ القرآن الكريم وكثيرٍ من الأخبار النبوية وعدةٍ من دواوين فحول الشعراء ممن غلب على شعره الإجادة في المعاني والألفاظ، ثم يأخذ في الاقتباس من هذه الثلاثة»[12]. بل إنّ أكثر أمثلة البيان والبلاغة إنما أفاده من هذا الكتاب المبين، وعنده أن كتاب الله ضمَّ في جنباته البيان بأسره، ومَن ألمَّ بقدر مناسب منه ظفر بما لا يضاهى من ملكة البيان. يقول في شأن بحثه عن البيان ومصادره: «وكنتُ عثرتُ على ضروب كثيرة منه في غضون القرآن الكريم، ولم أجد أحدًا ممن تقدّمني تعرّض لذِكْر شيء منها، وهي إذا عُدَّت كانت في هذا العلم بمقدار شطره، وإذا نُظر إلى فوائدها وُجِدَت محتويةً عليه بأسره»[13]. وقد أسلفنا الحديث عن طريقته الخاصّة في تدبُّر آي الذِّكر الحكيم وحلّ معانيه. ولنسمع منه الآن هذا التفصيل في مبلغ الفائدة التي يمكن الحصول عليها من قراءة القرآن الكريم وحفظه، يقول:
«وأمّا النوع السادس -وهو حفظ القرآن الكريم- فإنّ صاحب هذه الصناعة ينبغي له أن يكون عارفًا بذلك؛ لأن فيه فوائد كثيرة؛ منها أنه يُضمِّن كلامه بالآيات في أماكنها اللائقة بها ومواضعها المناسبة لها، ولا شبهة فيما يصير للكلام بذلك من الفخامة والجزالة والرونق، ومنها أنه إذا عرَف مواقع البلاغة وأسرار الفصاحة المودعة في تأليف القرآن اتخذه بحرًا يستخرج منه الدرر والجواهر ويودعها مطاوي كلامه، كما فعلتُه أنا فيما أنشأته من المكاتبات، وكفى بالقرآن الكريم وحده آلة وأداة في استعمال أفانين الكلام»[14].
4- آراؤه في جمالية التعبير:
امتلك ضياء الدين ذائقة لغوية ممتازة، تتحسّس في مفردات اللغة وظيفة أخرى غير الوظيفة البيانية، ومعلوم أنّ للبلاغة تعاريفَ كثيرةً، تأتى كثيرٌ منها للعرب من موارد غير عربية، كما يشهد بذلك كتاب البيان والتبيين للجاحظ وطائفة أخرى من الكتب المهتمة بهذا الجانب من الثقافة. وتكاد هذه التعاريف تأتلف على القول بأن البلاغة تكمن في أن يصل المتكلّم إلى مراده بأقلّ قدر ممكن من الأداء اللفظي، حتى لكأنها الإفهام مع اقتصاد ويُسْر في الأداء. وربما كان تعريف جعفر بن يحيى البرمكي مما هو متميّز في هذا الصدد، وهو يقول: «البلاغة أن يكون الاسم يحيط بمعناك، ويجلي عن مغزاك، وتخرجه من الشركة، ولا تستعين عليه بطول الفكرة، ويكون سليمًا من التكلّف، بعيدًا من سوء الصنعة، بريئًا من التعقيد، غنيًّا عن التأمل»[15].
ولقد كان ضياء الدين مدققًا في المصطلحات التي يستخدمها في وصف الخصائص الكلامية، وهو يعيد كثيرًا مما يقال في صفة الكلام البليغ من ألفاظ إلى خَلْقِ الإنسان، يقول: «وقد قيل في صفات خَلْقِ الإنسان ما أذكر ههنا، وهو الصباحة في الوجه، الوضاءة في البشرة، الجمال في الأنف، الحلاوة في العينين، الملاحة في الفم، الظّرف في اللسان، الرشاقة في القدّ، اللباقة في الشمائل، كمال الحسن في الشّعر»[16]. ولعلّ تحديدًا كهذا مما يشي باهتمام العالم الأديب بوظيفة ثانية للغة، وهو يردّ على من يجعل فائدة وضع اللغة في البيان وحده، ويضيف إلى ذلك شيئًا آخر، هو التحسين والتجميل، يقول: «أمّا قولك إنّ فائدة وضع اللغة إنما هو البيان عند إطلاق اللفظ، واللفظ المشترك يخلّ بهذه الفائدة، فهذا غير مسلّم به، بل فائدة وضع اللغة هي البيان والتحسين... وأمّا التحسين فإن الواضع لهذه اللغة العربية، التي هي أحسن اللغات، نظر إلى ما يحتاج إليه أرباب الفصاحة والبلاغة فيما يصوغونه من نظم ونثر، ورأى أن من مهمّات ذلك التجنيس، ولا يقوم به إلا الأسماء المشتركة التي هي كل اسم واحد دلّ على مسمّيَين فصاعدًا، فوضعها من أجل ذلك.
وهذا الموضع يتجاذبه جانبان يترجّح أحدهما على الآخر؛ وبيانه أن التحسين يقضي بوضع الأسماء المشتركة، ووضعها يذهب بفائدة البيان عند إطلاق اللفظ. وعلى هذا فإنْ وضَعها الواضع ذهب بفائدة البيان، وإن لم يضع ذهب بفائدة التحسين، لكنه إنْ وضَع استدرك ما ذهب من فائدة البيان بالقرينة، وإن لم يضع لم يستدرك ما ذهب من فائدة التحسين؛ فترجّح حينئذ جانب الوضع فوضع»[17].
ويحدّد ضياء الدين أداة الحكم الجمالي على ألفاظ اللغة بـ«الذّوق»، فحكومة الذّوق هي التي تُرضَى في مذهب الرجل، وما استحسنه الذّوق السليم هو الحسَن، يقول: «واعلم، أيها الناظر في كتابي، أنّ مدار علم البيان على حاكم الذّوق السليم، الذي هو أنفع من ذوق التعليم. وهذا الكتاب -وإن كان فيما يلقيه إليك أستاذًا، وإذا سألت عما يُنتفع به في فنّه قيل لك هذا- فإن الدُّربة والإدمان أجدى عليك نفعًا، وأهدى بصرًا وسمعًا»[18].
وعند ضياء الدين أنه لا يجوز التقليد إطلاقًا في شأن الحكم على مفردات اللغة بالجمال والقبح، والجمال مادي «فيزيقي» غير عزيز إدراكه على من أُوتي مَلَكة التذوّق السليم. وإذا كان الناس قد درجوا على عادة استحسان ما استحسنه الأجداد واستقباح ما استقبحوه؛ فإنّ ضياء الدين لا يكيل بكيلهم، ولا يحطب بحبلهم، بل ينبغي عنده أن يُتلمَّس الجمال ويُتذوَّق، يقول: «فإنّ استحسان الألفاظ واستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من العرب؛ لأنه شيء ليس للتقليد فيه مجال، وإنما هو شيء له خصائص وهيئات وعلامات، إذا وُجدت عُلم حسنُه من قبحه»[19].
ويعمد ضياء الدين إلى المقايسة ابتغاءَ أن يُقنِع قارئ كتابه بـ«حسية» الجمال اللغوي وإمكان تصيّده. وما دام الناس متباينِين في درجة استيعابهم جمالَ الأشياء تبعًا لأسباب متعدّدة -موروث ومكتسب-، وما داموا جميعًا على حظّ -كبير أو قليل- من إدراك النغمات والطعوم فلا بأس في قياس ضربٍ من جمالٍ يُدْرَك بحاسّة أخرى، يقول: «ومَن له أدنى بصيرة يَعلم أنّ للألفاظ في الأذن نغمةً لذيذة كنغمة أوتار، وصوتًا منكرًا كصوت حمار، وأنّ لها في الفم أيضًا حلاوةً كحلاوة العسل، ومرارةً كمرارة الحنظل، وهي على ذلك تجري مجرى النغمات والطعوم»[20].
والحقّ أن ضياء الدين يذهب في الإدراك الجمالي للألفاظ مذهبًا بعيدًا، ربما لا نعثر عليه عند جمهور السابقين من الناقدين والأدباء، وانفرد بآراء سجّلها له الذين تأخّروا عنه، وكُتب لهم أن يفيدوا منه. ونجدنا مدعوِّين إلى الإقرار بأنّ مِن أجملِ ما سمعنا في شأن إدراك المتلقّي لدلالات التعبير وجمالياته وما يولده الكلام من صور =قولَ هذا العالم الأريب: «اعلم أنّ الألفاظ تجري من السمع مجرى الأشخاص من البصر، فالألفاظ الجزلة تتخيّل في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار، والألفاظ الرقيقة تتخيّل كأشخاص ذوي دماثة ولين وأخلاق ولطافة مزاج؛ ولهذا ترى ألفاظ أبي تمام كأنها رجال قد ركبوا خيولهم، واستلأموا سلاحهم، وتأهبوا للطراد، وترى ألفاظ البحتري كأنها نساء حِسان عليهن غلائل مصبّغات، وقد تحلّين بأصناف الحلي»[21].
ويستحمق ضياء الدين مَن ينكر جمالية المفردة ويذهب إلى أنه لا فضل لمفردة على أخرى، ويردّ عليه بعنف، ويدعوه إلى الاحتكام إلى الحسّ السليم المدرَّب الذي لا يشك في تمييزه وصواب حكمه وقراره، يقول: «وقد رأيتُ جماعة من الجهّال إذا قيل لأحدهم إنّ هذه اللفظة حسنة وهذه قبيحة أنكر ذلك، وقال: كلّ الألفاظ حَسنٌ، والواضع لم يضع إلا حسنًا، ومَن يبلغُ جهله إلى أن لا يفرقَ بين لفظة الغصن ولفظة العُسلوج، وبين لفظة المُدامة ولفظة الاسفَنط، وبين لفظة السيف ولفظة الخَنشَليل، وبين لفظة الأسد ولفظة الغَدوكس، فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب، ولا يجاوب بجواب، بل يترك وشأنه... وما مثاله في هذا المقام إلا كمن يسوي بين صورة زنجية سوداء مظلمة السواد شوهاء الخَلْق ذات عين محمرة وشفة غليظة كأنها كِلوة وشَعْر قَطَط كأنه زبيبة، وبين صورة رومية بيضاء مشربة بحمرة، ذات خد أسيل، وطرف كحيل، ومبسم كأنما نُظم من أقاح، وطرَّة كأنها ليل على صباح، فإذا كان بإنسان من سَقَم النظر أن يسوي بين هذه الصورة وهذه فلا يبعد أن يكون به من سقم الفكر أن يسوي بين هذه الألفاظ وهذه، ولا فرق بين النظر والسمع في هذا المقام، فإن هذا حاسّة وهذا حاسّة، وقياس حاسّة على حاسّة مناسب»[22].
ومِثلُ ضياء الدين ينبغي أن يكون عنده مَثَلٌ أعلى جمالي في البيان، ولقد كان هذا المَثل الأعلى عنده كتابَ الله عزَّ وجلّ. فهو الأسوة الحسنة، والمثال الذي ينبغي أن يُحتذى في فصاحته وسهولته ويُسر لغته. يقول ضياء الدين: «وإذا نظرنا إلى كتاب الله تعالى، الذي هو أفصح الكلام، وجدناه سهلًا سلسًا، وما تضمّنه من الكلمات الغريبة يسير جدًّا.
هذا، وقد أُنزل في زمن العرب العرباء، وألفاظه كلها من أسهل الألفاظ، وأقربها استعمالًا؛ وكفى به قدوة في هذا الباب، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وما أَنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مِثلَ أمّ القرآن، وهي السبع المثاني)، يريد بذلك فاتحة الكتاب»[23].
ولعلّه مسوغ لنا بعد هذا أن نتبيّن جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين، وهو ما إليه صبونا منذ البدء، وما نحن إليه ماضون ملتمسين العون ممن «خلق الإنسان، علَّمه البيان».
5- معايير جمالية المفردة القرآنية:
كان البحث عن أسرار البلاغة الهاجس الشاغل لضياء الدين، وقد أسلفنا أنه أراد أن يستخلص هذه الدقائق والأسرار ويطلع بها على الآخرين معلِّمًا شارحًا. ولمّا كان موقنًا تمامًا بأن بيان القرآن فوق كلّ بيان فقد مضى يبحث عن الدلائل التي جعلت من هذا الكتاب معجِزًا، وقف إزاءه العرب -على ما لهم من فصاحة ولَسَن- حيارى ذاهلين، لا يحيرون جوابًا إلا أن يظنوا بهذا الذي تنزَّل عليه أنه مجنون أو شاعِر أو ما قارَب هذا.
إِذْ «لمّا قُرئ عليهم القرآن رأوا حروفه في كلماته وكلماته في جُمَله، ألحانًا لغوية رائعة، كأنها -لائتلافها وتناسبها- قطعةٌ واحدة، قراءتُها هي توقيعها، فلم يَفُتْهم هذا المعنى، وأنه أمر لا قِبَلَ لهم به، وكان ذلك أبيَنَ في عجزهم»[24].
أخذ ضياء الدين يفتش عن سرّ جمال التعبير، فاهتدى إلى أن ذلك إنما يبدأ بالكلمة المفردة؛ فإنك كثيرًا ما تحسّ بأنّ هذه اللفظة أجمل وآنق من اللفظة الأخرى المرادفة لها في المعنى. ولا شكّ أنه اطّلع على آراء المتقدّمين عليه جميعًا كما بينّا، فأخذ منها ما استساغه، وردَّ ما لم يَرَ فيه حقًّا.
وقد كان ابن سنان جعل من أوصاف المفردة الفصيحة أن تكون متباعدة مخارج الحروف، فردَّ عليه ضياء الدين دعواه، ورأى أن الاستحسان إنما يعود إلى الأحرف بأعيانها، ولا شأن للتباعد في مخارجها، وليس الأمر إلا أن تكون أصوات الحروف جميلة تروق السمع، وكأنه يقول بموسيقيةٍ للتعبير اللغوي. وفي صدد ردِّه على ابن سنان قال ضياء الدين: «على أنه لو أراد النّاظم أو الناثر أن يعتبر مخارج الحروف عند استعمال الألفاظ، وهل هي متباعدة أو متقاربة، لَطال الخطب في ذلك وعسر، ولَمّا كان الشاعر ينظم قصيدًا، ولا الكاتب ينشئ كتابًا إلا في مدة طويلة، تمضي عليها أيامٌ وليالٍ ذواتُ عددٍ كثير. ونحن نرى الأمر بخلاف هذا؛ فإنّ حاسّة السمع هي الحاكمة في هذا المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ يكون متباعدَ المخارج؛ فحسن الألفاظ -إذن- ليس معلومًا من تباعد المخارج، وإنما عُلِمَ قبل العلمِ بتباعدها. وكلّ هذا راجع إلى حاسّة السمع، فإذا استحسنَتْ لفظًا أو استقبحَتْه، وُجِدَ ما تستحسنه متباعدَ المخارج، وما تستقبحه متقارِبَ المخارج. واستحسانها واستقباحها إنما هو مِن قبلِ اعتبار المخارج لا بعده»[25].
والحقُّ أننا لو شئنا أن نضع أساسًا لجودة اللفظ عند ضياء الدين لما وجدنا شيئًا آخر غير أن تكون أصوات حروفه مما «يستلذّه السمع»؛ فما استلذّه السمع من هذه الأصوات التي تصدر عن مخارج الحروف هو الحَسن الجميل، وما استقبحه وأنكره هو القبيح المردود. يقول في هذا الشأن: «لكن لا بد أن نذكر ههنا تفصيلًا لِما أجملناه هناك؛ لأنّا ذكرنا في ذلك الفصل أن الألفاظ داخلة في حيز الأصوات؛ لأنها مركبة من مخارج الحروف، فما استلذّه السمع منها فهو الحسن، وما كرهه ونبَا عنه فهو القبيح. وإذا ثبت ذلك فلا حاجة إلى ما ذُكر من تلك الخصائص والهيئات التي أوردها علماء البيان في كتبهم؛ لأنه إذا كان اللفظ لذيذًا في السمع كان حسنًا، وإذا كان حسنًا دخلت تلك الخصائص والهيئات في ضمن حسنه»[26]. فالمعوَّل عليه إذًا إنما هو جمال الصوت في ذاته، وهو جمال محسوس يُحتكم فيه إلى الأُذن.
والمعروف أنّ النقاد قبل ضياء الدين قد أشاروا إلى طبيعة الصوت الذي يلذّ للأذن، وهو ذلك الذي يأتيها باعتدال وَفق ما رُكِّبَت عليه. فكأنّ للأذن مستوى من الاستيعاب تَجمُل الأصوات حين تفد عليها في هذا المستوى، وتَقبُح حين ترتفع فوقه أو تهبط دونه. وهي نظرية قد يكون لأرسطو أثر في نشوئها؛ وعنده أن من صفات الجميل ألا يكون كبيرًا جدًّا فلا تدركه العينان دفعة واحدة، ولا صغيرًا جدًّا، فتعجز عن الإلمام به، وإنما هو ما تدركه العينان بنظرة واحدة؛ فيحاط بما فيه من انسجام وإيقاع وائتلاف أجزاء. نقول هذا ولسنا على يقين تام من أن نقاد العرب قد أفادوا شيئًا من هذا القبيل من أرسطو. ومما يتّصل بهذا عند ناقدي العرب قول ابن طباطبا: «إنّ كلّ حاسة من حواس البدن إنما تتقبّل ما يتصل بها مما طبعت له إذا كان وروده عليها ورودًا لطيفًا باعتدال لا جور فيه، وبموافقة لا مضادّةَ معها؛ فالعين تألف المرأى الحسن وتقذَى بالمرأى القبيح الكريه، والأنف يقبل المشمّ الطيب ويتأذّى بالمنتن الخبيث، والفم يلتذّ بالمذاق الحلو، ويمجّ البشع المُرّ، والأذن تتشوّف للصوت الخفيض الساكن، وتتأذّى بالجهير الهائل، واليد تنعم بالملمس اللين الناعم وتتأذّى بالخشن المؤذي... وعلةُ كلّ حسنٍ مقبول الاعتدالُ، كما أنّ علةَ كلّ قبيح منفي الاضطرابُ»[27].
على أنّ ثمة رأيًا آخر نحسبُ أنّ أجدادنا تنبّهوا إليه منذ وقت مبكّر، وهو أنّ الصوت في الكلام هو صوتُ النّفْس وجَرْسُها، وأنّ ما صدر من الكلام عن النّفْس مباشرة دون تدخّل من العقل في الاختيار والاصطفاء كان أكثر جمالًا وروعةً ورواءً، وحظي من البلاغة على أوفر نصيب. يُذكر أنه قيل لأعرابي: «ما هذه البلاغة فيكم؟ فقال: شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا»، فما جيَشان الصدر هذا إلا صوت النّفْس الذي يُقْذَف بسرعة على اللسان، فتكون البلاغة. ولم يبتعد مصطفى صادق الرافعي -رحمه الله- عن هذا حين قال: «وليس بخفيّ أنّ مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، وأنّ هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سببٌ في تنويع الصوت، بما يخرجه فيه مدًّا أو غُنّةً أو لينًا أو شدّة، وبما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تُناسِب ما في النفس من أصولها، ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع، أو الإطناب والبسط، بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبُعد المدى ونحوها، مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى»[28].
وبعد أن حدَّد ضياء الدين روح الجمال اللغوي وجوهره مضى إلى القرآن الكريم يتبيّن الشواهد التي تؤيّد مذهبه، ويأخذ في بيان أسباب الجمال التي لا تخرج في النهاية عمّا أسماه بـ«إمتاع الصوت للأُذن». أمّا المعايير الأساسية التي استند إليها فهي:
1- عيار ائتلاف أحرف الكلمة:
يناقض ضياء الدين مسألة أن تكون الكلمة مؤلّفة من أقل الأوزان تركيبًا حتى تكون جميلة، وهو ما قال به ابن سنان، واستقبح على أساسٍ منه بعضَ المفردات، ومن ذلك كلمة «سويداواتها» التي وردت في بيت المتنبي:
إنّ الكرام بلا كرام منهم ** مثل القلوب «بلا سويداواتها»[29]
وينكر أن يكون الطول هو الذي قبَّح هذه المفردة وشأنها، وإنما الأمر أنها هي نفسها قبيحة، وقد كانت جميلة حسنة حين كانت مفردة. وههنا يدلل ضياء الدين على صحة دعواه بألفاظ من القرآن جاءت أطول من هذه الكلمة، ولكنها ظلّت جميلة، يقول ضياء الدين: «وقال (يريد ابن سنان): إنّ لفظة «سويداواتها» طويلة، فلهذا قَبُحَت، وليس الأمر كما ذكره؛ فإنّ قبح هذه اللفظة لم يكن بسبب طولها، وإنما هو لأنها في نفسها قبيحة، وقد كانت وهي مفردة حسنة، فلما جُمعت قبحت، لا بسبب الطول. والدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم ألفاظ طوال، وهي مع ذلك حسنة، كقوله تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 137]؛ فإن هذه اللفظة تسعة أحرف، وكقوله تعالى: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾[النور: 55]؛ فإنّ هذه اللفظة عشرة أحرف، وكلتاهما حسنة رائقة. ولو كان الطول مما يوجب قبحًا لقبحت هاتان اللفظتان، وليس كذلك»[30].
وإذا ما مضينا نتلمّس أسباب استجادة هاتين اللفظتين القرآنيتين، على طولهما، طلع علينا ضياء الدين بتفسير يكاد يكون مجدّدًا فيه، وهو «ائتلاف الحروف مع بعضها»، وهذا أمر لم يشرْ إليه صراحة حين جعل الأساس الأول للجمال «استجادة السمع». يقول في هذا الصدد: «والأصل في هذا الباب ما أذكره، وهو أنّ الأصول من الألفاظ لا تحسن إلا في الثلاثي وفي بعض الرباعي، كقولنا: عذب وعسجد؛ فإنّ هاتين اللفظتين إحداهما ثلاثية والأخرى رباعية، وأمّا الخماسي من الأصول فإنه قبيح، ولا يكاد يوجد منه شيء حسن، كقولنا: جَحْمَرِش، وصَهْصَلِق، وما جرى مجراهما، وكان ينبغي على ما ذكره ابن سنان أن تكون هاتان اللفظتان حسنتين واللفظتان الواردتان في القرآن قبيحتين؛ لأن تلك تسعة أحرف وعشرة، وهاتان خمسة خمسة، ونرى الأمر بالضد مما ذكره. وهذا لا يعتبر فيه طول ولا قصر، وإنما يعتبر نَظْم تأليف الحروف بعضها مع بعض. ولهذا لا يوجد في القرآن من الخماسي الأصول شيء، إلا ما كان من اسم نبي عُرِّب اسمه، ولم يكن في الأصل عربيًّا نحو إبراهيم وإسماعيل»[31].
وكان الرافعي، في أول هذا القرن، قد أيّد مذهب ضياء الدين في شأن جمال هاتين المفردتين، وهو يقول في صدد ذلك: «وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع مما يكون مستثقلًا بطبيعة وضعه أو تركيبه، ولكنها بتلك الطريقة التي أومَأْنا إليها قد خرجت في نظمه مخرجًا سريًّا، فكانت مِن أحضرِ الألفاظ حلاوة وأعذبِها منطقًا، وأخفّها تركيبًا، إذ تراه قد هيّأ لها أسبابًا عجيبة من تَكرار الحروف وتنوّع الحركات، فلم يُجْرِها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها، كقوله: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النور: 55]، فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف، وقد جاءت عذوبتها من تنوّع مخارج الحروف، ومن نظم حركاتها، فإنها بذلك صارت في النطق كأنها أربع كلمات، إِذْ تنطق على أربعة مقاطع، وقوله: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾[البقرة: 137]، فإنها كلمة من تسعة أحرف، وهي ثلاثة مقاطع، وقد تكرّرت فيها الياء والكاف، وتوسط بين الكافين هذا المدُّ الذي هو سرّ الفصاحة في الكلمة كلّها»[32].
2- عيار سهولة النطق:
يذهب ضياء الدين في جمال المفردات إلى أن تكون المفردة مؤلّفة من أحرف يسهل النطق بها، سواءٌ أكانت طويلةً أم قصيرة. ومثّل لثقل المفردة بلفظة «مُسْتَشْزِرَات» الواردة في بيت امرئ القيس. ويرى أنه لو استُبدلت هذه اللفظة بلفظة أخرى هي -مثلًا- «مستنكِرات» أو «مستنفِرات»، مما كان على وزنها، لَما كان في الكلمة المستخدمة أيُّ ثقل أو قبح. ويتصل بسهولة النطق أيضًا أن تكون الكلمة مبنية من حركات خفيفة؛ ليخفّ النطق بها. لكنه لا يبين السبب في ورود كلمات قرآنية توالت فيها حركة الضم الثقيلة دون أن تُستقبح أمثالُ هذه الكلمات. يقول: «ومن أوصاف الكلمة أن تكون مبنية من حركات خفيفة؛ ليخفّ النطق بها، وهذا الوصف يترتب على ما قبله من تأليف الكلمة، ولهذا إذا توالى حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تُستثقل، وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة؛ فإنه إذا توالت منها حركتان في كلمة واحدة استثقلت؛ ومن أجل ذلك استثقلت الضمّة على الواو والكسرة على الياء؛ لأن الضمة من جنس الواو، والكسرة من جنس الياء، فتكون عند ذلك كأنها حركتان خفيفتان... واعلم أنه قد توالت حركة الضم في بعض الألفاظ، ولم يُحدِث فيها كراهةً ولا ثقلًا، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ [القمر: 36]، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ [القمر: 47]، وكقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: 52]؛ فحركة الضمّ في هذه الألفاظ متوالية، وليس بها من ثقلٍ ولا كراهة»[33]. وقد استوقف هذا الرافعيَّ، فأبدأ فيه وأعاد، وصدر عن رأي غاية في الوجاهة، وعدَّ ذلك طريقًا خاصة للقرآن الكريم. يقول: «ومن ذلك لفظة (النُّذُر) جمع نذير، فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معًا، فضلًا عن جَسْأةِ هذا الحرف ونبوِّهِ في اللسان، وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام، فكلّ ذلك مما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه، ولكنه جاء في القرآن على العكس، وانتفى من طبيعته في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾[القمر: 36]، فتأمّلْ هذا التركيب، وأنعِمْ ثم أنعم على ما تأمّله، وتذوَّقْ مواقع الحروف، وأجرِ حركاتها في حس السمع، وتأمّلْ مواضع القلقلة في دال {لَقَدْ}، وفي الطاء من {بَطْشَتَنَا}، وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو {فَتَمَارَوْا} مع الفصل بالمد، كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرَت على اللسان؛ ليكون ثقل الضمة عليه مستخفًّا بعد، ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض في الأطعمة. ثم ردِّدْ نظرك في الراء من {تمَارَوْا} فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء {النُّذُر} حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها، فلا تجفو عليه ولا تغلُظ ولا تنبو فيه، ثم أعجب لهذه الغنَّة التي سبقت الطاء في نون {أَنذَرَهُم} وفي ميمها، وللغنة الأخرى التي سبقت الذال في {النُّذُر}»[34].
3- عيار الجدة وعدم الابتذال:
جعل ضياء الدين من أسباب جمال المفردة أن لا يكون طول الاستعمال قد ابتذلها، فمجّها الذوق، وكرهها السمع. ويلوِّح أن قانون التغيّر يصيب كلّ شيء؛ فما كان جديدًا في زمن يغدو سفسافًا حين تلوكه الألسنة ويغدو ملكًا للناس جميعًا، ومن هنا يجنح البلغاء إلى اصطناع كلّ وسيلة لمباغتة المتلقي بالجديد، وكان المبدأ القائل أنّ «لكلّ جديد روعة»، ينسحب على اللغة نفسها. وقف ضياء الدين حيال هذه المسألة، ورأى أنه لا يسلم شاعر من أن تكون في لغته ألفاظ مبتذلة، لكن الشعراء يتفاوتون في مبلغ الإتيان بهذا المبتذل، لكنه عيب يَخْلُق بالبليغ أن يتجنّبه. وأيّد مذهبه من خلال المقارنة بين استخدام شاعر مفلق والاستخدام القرآني للفظة «آجُرّ»، التي يرى أنها مبتذلة جدًّا، وأنها وردت في شعر النابغة الذبياني، لكن الذِّكر الحكيم حين احتاج إلى مدلولها استعاض عن هذا اللفظ ببديل، في طريقة غاية في السمو والأناقة والروعة. يقول ضياء الدين: «وهذا القسم من الألفاظ المبتذلة لا يكاد يخلو منه شِعْر شاعر، لكن منهم المُقِلّ، ومنهم المكثِر، حتى إن العاربة قد استعملت هذا، إلا أنه في أشعارها أقلّ، فمن ذلك قول النابغة الذبياني في قصيدته التي أولها: مِن آلِ مَيّةَ رائحٌ أو مُغتَدِي:
أو دُمْيَةٍ في مَرمرٍ مرفوعةٍ ** بُنِيَتْ بآجُرٍّ يشادُ بقَرْمَدِ
فلفظة «آجُرّ» مبتذلة جدًّا، وإن شئتَ أن تعلم شيئًا من سِرّ الفصاحة التي تضمنها القرآن، فانظر إلى هذا الموضع، فإنه لمّا جيء فيه بذِكر الآجُرّ لم يُذكر بلفظه ولا بلفظ القَرْمَدِ أيضًا، ولا بلفظ الطوب الذي هو لغة أهل مصر؛ فإن هذه الأسماء مبتذلة، لكن ذُكر في القرآن على وجه آخر، وهو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا﴾ [القصص: 38]، فعبّر عن الآجُرّ بالوقود على الطين»[35]. والحقُّ أنّ مجافاة اللفظة المبتذلة للذّوْق وعدم جماليتها أمر يُرجع فيه إلى الجِبِلَّة البشرية، حيث يأنَفُ الإنسان إلى ما طال وروده على حواسّه في صورة واحدة. ويعمد الذِّكر الحكيم ههنا وفي مواضع كثيرة إلى الكناية، وهي ضربٌ من البيان العالي الذي يذهب بالنفس كلَّ مذهب، ويُحْدِث فيها أقصى قدر من التأثير.
ولقد تبيَّن الرافعي -رحمه الله- في الاستخدام القرآني لهذه الصورة وجوهًا من المعاني والأغراض مما لم يُلِمَّ به ضياءُ الدين، ولا اقترب منه. يقول الرافعي: «ومن الألفاظ لفظة (آجُرّ) وليس فيها من خفّة التركيب إلا الهمزة، وسائرها نافر متقلقل لا يصلح مع هذا المدّ في صوت ولا تركيب على قاعدة نظم القرآن، فلما احتاج إليها لفَظَها ولفَظَ مرادفَها وهو (القَرْمَد)، وكلاهما استعمله فصحاء العرب ولم يعرفوا غيرهما، ثم أخرج معناها بألطف عبارة وأرقِّها وأعذبها، وساقها في بيان مكشوف يفضح الصبح، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا﴾[القصص: 38] فانظر، هل تجد في سر الفصاحة وفي روعة الإعجاز أبرع وأبدع من هذا؟ وأيُّ عربي فصيح يسمع مثل هذا النَّظْم وهذا التركيب ولا يملِّكه حسَّه، ولا يسوِّغه حقيقةَ نفسه، ولا يُجَنُّ به جنونًا، ولا يقول آمنت بالله ربًّا وبمحمد نبيًّا وبالقرآن معجزة؟ وتأمّلْ كيف عبّر عن (الآجُر) بقوله: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ﴾، وانظر موضع هذه القلقلة التي هي في (الدال) من قوله: ﴿فَأَوْقِدْ﴾ وما يتلوها من رقّة (اللام)؛ فإنها في أثناء التلاوة مما لا يطاق أن يُعبَّر عن حُسنه، وكأنما تَنتزع النفسَ انتزاعًا. وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحَسْب، ولكِنْ ما ترمي إليه إعجازٌ آخر؛ فإنها تحقِّرُ شأنَ فرعون، وتصِفُ ضلالَه، وتسفِّهُ رأيَه، إِذْ طمع أن يبلغَ الأسبابَ أسبابَ السماوات فيطّلِعَ إلى إله موسى، وهو لا يجد وسيلةً إلى ذلك المستحيل ولو نصَبَ الأرضَ سُلَّمًا، إلا شيئًا يصنعه هامان من الطين»[36].
4- عيار سهولة الفهم وقرب التناول:
امتاز القرآن الكريم بلغته السهلة الممتنعة التي يدرك عامة الناس -على تفاوت حظوظهم- شيئًا من دلالتها، وحتى صِبيان الكتاتيب يأنسون في أنفسهم قدرًا من الفهم لمدلولات ألفاظ الذِّكر الحكيم، فإنْ عزَّت الدلالة الدقيقة عضَّدتها الدلالة الإيحائية المتأتِّية من رسم ألفاظ القرآن الكريم جزءًا من دلالتها بإيحائها الصوتي وشعاع نورها، الذي يغزو الروح الصافي، فيتلقّاه تلقّي الظامئ باردَ الماء. يقول الرافعي: «وهذه هي طريقة الاستهواء الصوتي في اللغة، وأثرها طبيعي في كلّ نفس، فهي تشبه في القرآن الكريم أن تكون صوتَ إعجازه الذي يخاطب به كلَّ نفس تفهمه، وكلَّ نفس لا تفهمه، ثم لا يجد من النفوس على أيّ حال إلا الإقرارَ والاستجابة، ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربًا من الكلام البليغ الذي يُطمع فيه أو في أكثره، ولَما وُجد فيه أثرٌ يتعدّى أهلَ هذه اللغة العربية إلى أهل اللغات الأخرى، ولكنه انفرد بهذا الوجه للعجز»[37].
أمّا ضياء الدين فقد عدَّ هذه الصفة في القرآن الكريم من مخايل اللغة الجميلة والبيان العالي، وكأنَّ مكمن الجمال ههنا سرعة انجلاء الدلالة لعقل المتلقي وغزوها لقلبه دونما إذنٍ، والحقُّ أنّ لسهولة الفهم هذه أسبابًا كثيرة في كلام المُنشِئ، وقف النقد العربي عندها كثيرًا، وعدّها عنصرًا لا يُستغنى عنه فيما يُسمّى بليغًا من الكلام، وقد تبيَّن ضياء الدين آثارَ ذلك في لغة القرآن الكريم. يقول معلِّقًا على لغة فاتحة الكتاب المبين: «وإذا نظرنا إلى ما اشتملت عليه من الألفاظ وجدناها سهلةً قريبةَ المأخذ، يفهمها كلُّ أحدٍ حتى صبيان المكاتب وعوامّ السّوقة، وإن لم يفهموا ما تحتها من أسرار الفصاحة والبلاغة؛ فإنّ أحسن الكلام ما عرَفَ الخاصّة فضله، وفهم العامة معناه، وهكذا فلتكن الألفاظ المستعملة في سهولة فهمها وقرب متناولها»[38].
5- عيار ملاءمة المقام:
أساس القضية هنا أنّ بعض الألفاظ أحقُّ من مرادفها في أن تقع في جملة من الجمل، وهو أمرٌ مردُّه -فيما يرى ضياء الدين- إلى الفطرة السليمة التي تستجيد لفظًا وتُنكِر مرادفَه مكانَه، على الرغم من أنه يحمل الدلالة نفسَها. ونحسبُ أنّ ذلك مرتبطٌ في بعض نواحيه بجهة من جهات الانسجام الصوتي بين مفردات السياق، وإن كان ضياء الدين لا يُسعفنا ببيانٍ شافٍ لمصدر هذا الإيثار والإنكار، ويعيد ذلك إلى مجرّد الفطرة الناصعة، وما يُحدِثُه السبك من تآلف واقتراب بين الألفاظ. يقول في هذا الشأن: «ومن الذي يؤتيه اللهُ فطرة ناصعة يكاد زيتُها يضيء ولو لم تمسَسْه نار حتى ينظرَ إلى أسرار ما يستعمله من الألفاظ فيضعَها في موضعها. ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد، وكلاهما حسن في الاستعمال، وهما على وزنٍ واحدة وعَدَّةٍ واحدة، إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كلّ موضع تستعمل فيه هذه، بل يفرّق بينهما في مواضع السّبك، وهذا لا يدركه إلا مَن دقَّ فهمُه وجلَّ نظرُه. فمن ذلك قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾[الأحزاب: 4]، وقوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: 35]، فاستعمل (الجَوف) في الأولى و(البَطْن) في الثانية، ولم يستعمل الجوف موضِعَ البطن، ولا البطن موضعَ الجوف واللفظتان سواءٌ في الدلالة، وهما ثلاثيتان في عدد واحد، ووزنهما واحد أيضًا، فانظر إلى سبك الألفاظ كيف يفعل؟»[39]. ويخيّل إليَّ أن الأمر يعود ها هنا إلى الدلالة الإيحائية لكلّ من اللفظتين، ذلك أنّ مادة كلّ منهما تختلف بعض الاختلاف عن مادة اللفظة الأخرى؛ فمادة (الجوف) توحي بالضمور والخلوّ والانحسار والعمق، وخاصّة بما يرسُمه الجيم وبعده الواو الساكن ثم الفاء من دلالة إيحائية، على عكس مادة (البطن) التي توحي بالنتوء والبروز والانكشاف، وهي أنسب للحمل من مادة الجوف؛ فالجنين المكنَّى عنه بقوله تعالى على لسان مريم -عليها السلام-: ﴿مَا فِي بَطْنِي﴾ يناسبه كثيرًا النتوء والبروز والانكشاف، مثلما هي حال (الحامل)، ويناسبه، تبعًا لذلك، لفظ (بطن) دون (جوف).
6- عيار الرفق في التعامل مع الحسّ:
يرى ضياء الدين أنّ أسلوب القرآن الكريم يتعامل مع الحسّ تعاملًا خاصًّا، فهو يرفُق به، ويستعمل كلّ وسيلة يحقّق من خلالها إمتاع هذا الحسّ، فإذا ما حدث أنِ استخدمَ الذِّكرُ الحكيم ألفاظًا متفاوتة في درجة جمالها، فإنه يؤدّيها إلى الحسّ وَفق ترتيب خاص تزداد فيه جمالًا ورواءً. وقد وقف ضياء الدين أمام قول البارئ -جلَّ وعلا-: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ﴾[الأعراف: 133]، فقال: «وإذا نظرنا إلى حكمة أسرار الفصاحة في القرآن الكريم غُصْنَا منه في بحر عميق لا قرارَ له؛ فمن ذلك هذه الآية المشار إليها، فإنها تضمّنت خمسة ألفاظ، هي: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فلما وردَت هذه الألفاظ الخمسة بجملتها قُدِّم فيها لفظةُ الطوفان والجراد، وأُخِّرَت لفظةُ الدم آخِرًا، وجُعلت لفظة القُمَّل والضفادع في الوسط؛ ليطرقَ السمعَ أولًا الحسنُ من الألفاظ الخمسة، وينتهي إليه آخِرًا، ثم إنّ لفظة الدم أحسن من لفظتي الطوفان والجراد، وأخفّ في الاستعمال، ومن أجلِ ذلك جيء بها آخِرًا. ومراعاة مثل هذه الأسرار والدقائق في استعمال الألفاظ ليس من القدرة البشرية»[40].
ولقد وقفَ شيخُ البيان العربي في هذا القرنِ (الرافعيُّ) عند هذه الآية الكريمة، وتبيَّن من أسباب الجمال فيها ما لم يتهيّأ مثلُه لضياء الدين، ذلك أنّ ضياء الدين يَلمح الجمال جملة فيقول إنّ هذه اللفظةَ أجملُ من هذه، ولذلك قُدِّمت هذه وأُخِّرت تلك... إلخ، أمّا الرافعي فيضع يدَنا على تعليل مقنع لجمال ما اعتدَّه ضياء الدين جميلًا. قد تكون طبيعة كلّ من الرجلين وعصره وغير ذلك من أمور مما جعله يذهب إلى ما ذهب إليه.
يقول الرافعي مفصِّلًا مبيِّنًا: «وما يشذّ في القرآن الكريم حرفٌ واحد عن قاعدة نظمه المعجز، حتى إنك لو تدبرت الآيات التي لا تقرأ فيها إلا ما يسرده من الأسماء الجامدة، وهي بالطبع مَظِنَّة أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجاز، فإنك ترى إعجازها أبلغ ما يكون في نَظْمها وجِهات سردها، ومن تقديم اسم على غيره أو تأخيره عنه، لنظم حروفه ومكانه من النطق في الجملة، أو لنكتة أخرى من نكت المعاني التي وردت فيها الآية، بحيث يُوجِد شيئًا فيما ليس فيه شيء. تأمل قولَه تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ﴾، فإنها خمسة أسماء، أخفُّها في اللفظ (الطوفان والجراد والدم)، وأثقلُها (القمَّل والضفادع)؛ فقدَّم (الطوفان) لمكان المدَّين فيها، حتى يأنس اللسان بخفتها، ثم (الجراد) وفيها كذلك مدّ، ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدئًا بأخفِّهما في اللسان وأبعدِهما في الصوت لمكان تلك الغُنَّة فيه، ثم جيء بلفظة (الدم) آخرًا، وهي أخفُّ الخمسة وأقلُّها حروفًا؛ ليسرع اللسان فيها ويستقيم لها ذوق النّظْم ويتم بهذا الإعجاز في التركيب»[41].
إنّ الأساس الذي يَبني عليه ضياء الدين مذهبه في جمالية المفردة القرآنية أنه ليس في كلام الله إلّا ما هو جميل، وإذا ما احتاج الذِّكْر الحكيم أن يستخدم لفظًا وكان ذلك اللفظ مما لا يستحسنه الذَّوْق فإنّ القرآن يتجنب هذا اللفظ ويستخدم مرادفًا له.
ويتصل بهذا أن بعض الألفاظ تكون جميلة في حال الجمع وغير جميلة في حال الإفراد، وقد يحدُث العكس فيُستجاد مفردُ لفظة ويُنكَر جمعها، ويَسري قانون جمالية المفردة القرآنية ههنا بإيثار الجميل واجتناب ما ليس كذلك. واستجابة لهذا المبدأ كنت ترى ألفاظًا لا تستخدم في الذِّكر الحكيم إلا مجموعة، وكذا لا تستخدم بعض الألفاظ إلا مفردة، والمرجع في الاستخدام والاستبعاد هو الذَّوْق السليم ليس غير. يقول ضياء الدين: «ومن هذا النوع ألفاظ يُعْدَل عن استعمالها من غير دليل يقوم على العدول عنها، ولا يُستفتى في ذلك إلّا الذوق السليم، وهذا موضع عجيب لا يُعْلَم كنهُ سرّه، فمن ذلك لفظة (اللب) الذي هو العقل لا لفظة اللب الذي تحت القِشر، فإنها لا تحسن في الاستعمال إلّا مجموعة، وكذلك ورَدَت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وهي مجموعة، ولم ترِد مفردة، كقوله تعالى: ﴿وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾، و﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾، وأشبه ذلك. وهذه اللفظة ثلاثية خفيفة على النطق، ومخارجها بعيدة، وليست بمستثقَلة ولا مكروهة، وقد تستعمل مفردة بشرط أن تكون مضافة أو مضافًا إليها»[42].
وقد استرعى هذا الاهتمام الرافعي، فمضى يتبيّن ويتقصّى، حتى انتهى إلى ما يكاد أن يكون مقنعًا، والحقُّ أنّ الرافعي الذي ألَمّ بالتراث وأفاد كثيرًا من ملاحظات سابقيه وخاصة ضياء الدين، لكن هذا لم يَحُلْ بينه وبين أن يأتي بالعجيب في هذا الشأن. يقول الرافعي في هذا الذي نحن فيه: «ومما لا يسعه طوق الإنسان في نظم الكلام البليغ، ثم مما يدل على أن نظم القرآن مادة فوق الصنعة ومن وراء الفكر، وكأنها صبَّت على الجملة صبًّا؛ أنك ترى بعض الألفاظ لم يأت فيه إلا مجموعًا، ولم يستعمل منه صيغة المفرد، فإذا احتاج إلى هذه الصيغة استعمل مرادفها؛ كلفظة (اللب) فإنها لم ترِد إلّا مجموعة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 21]، وقوله: ﴿وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]، ونحوهما، ولم تجئ فيه مفردة، بل جاء في مكانها (القلب)؛ ذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمع، ولا يفضي إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية، فلما لم يكن ثَمَّ فصل بين الحرفين يتهيأ معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدّة، تحسن اللفظة مهما كانت حركة الإعراب فيها، نصبًا أو رفعًا أو جرًّا، فأسقطها من نظمه بتة، على سعة ما بين أوّله وآخره، ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائعة، وهذا على أن فيه لفظة (الجب)، وهي في وزنها ونطقها، لولا حسن الائتلاف بين الجيم والباء من هذه الشدة في الجيم المضمومة»[43].
أمّا الصورة الثانية، أي: استحسان استخدام بعض الألفاظ مفردة فقط، فقد كان عند ضياء الدين منها أكثر من مثال قرآني. وجُلّها تنصر مذهبه في أن الذِّكْر الحكيم يأنف عن استخدام أيّ لفظ ليس له حظ من الجمال وأسبابه. يقول: «وفي ضدّ ذلك (أي: ما ورد استعماله مجموعًا فقط)، ما ورد استعماله من الألفاظ مفردًا ولم يرِد مجموعًا، كلفظة الأرض، فإنها لم ترِد في القرآن إلّا مفردة، فإذا ذكرت السماء مجموعة جيء بها مفردة معها في كلّ موضع من القرآن، ولمّا أريد أن يؤتى بها مجموعة، قيل: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾، في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 12]. ومما ورد من الألفاظ مفردًا فكان أحسنَ مما يرد مجموعًا لفظةُ (البُقْعة)، قال الله تعالى في قصة موسى -عليه السلام-: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَامُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[القصص: 30]، والأحسنُ استعمالها مفردة لا مجموعة، وإن استعملت مجموعة فالأولى أن تكون مضافة، كقولنا: بقاع الأرض، أو ما جرى مجراها»[44]، ونحسب أنّ استحسانَ لفظةٍ ما مفردة واستهجانها مجموعة يرجع إلى السبب الذي ردّده ضياء الدين كثيرًا؛ أي: مجافاة الرفق في التعامل مع أدوات النطق عند الإنسان مما يثقل كاهلها، وهو أمر يناقض الأساس الأول في تلقّي ما هو جميل، أي: السهولة والدماثة والاعتدال، ذلك أنّ إدراك الجمال ينبغي أن ينتفي معه أيّ إحساس بالإرهاق والتعب؛ ولعلّه لهذا السبب ما جعل أرسطو الجميلَ ما أُدرك بلحظة واحدة. وقد وقف الرافعي عند أول المثالين القرآنيين، فقال: وعكس ذلك لفظة (الأرض)، فإنها لم ترِد فيه إلا مفردة، فإذا ذُكرت السماء مجموعة جيء بها مفردة في كلّ موضع منه، ولما احتاج إلى جمعها أخرجها على هذه الصورة التي ذهبت بسرّ الفصاحة وذهب بها، حتى خرجت من الروعة بحيث يسجد لها كلّ فكر سجدة طويلة، وهي في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 12]، ولم يقل: وسبع أرضين؛ لهذه الجَسْأة التي تدخل اللفظ ويختل بها النَّظْم اختلالًا. وأنت فتأمّلْ -رعاك الله- ذلك الوضعَ البياني، واعتبر مواقع النَّظْم، وانظر هل تتلاحق هذه الأسباب الدقيقة أو تتيسر مادتها الفكرية لأحد من الناس فيما يتعاطاه من الصناعة، أو بتكلفة من القول، وإن استقصى فيه الذرائع وبالغ الأسباب، وأحكم ما قِبَله وما وراءه...»[45].
7- عيار جمالية خاصّة لبعض الصيغ:
استبان ضياء الدين، وقد استقرأ الاستخدام القرآني للمفردات، أنّ الذِّكر الحكيم يصطفي صيغًا صرفية خاصة للمفردات، يلحّ عليها دون غيرها في استخداماته. وحين يردّد المرء النظر في أمثال هذه الصيغ المستخدمة وتُقارن بنظائرها، يدرك بعض الأسرار في إمساك القرآن بها، ونبذِه غيرها. وكأنّ المعجم القرآني لا يأذن بالدخول من مفردات اللغة إلا لِما وافَق الذوق السليم، وخالَط الروح، وداعَب الوجدان. ويلاحظ ضياء الدين -مثلًا- الفعل (وَدَع) لا يحسن إلا حين يستخدم مستقبلًا وأمرًا، ولم يجئ في القرآن الكريم إلا كذلك، بينما جاء في الشِّعر العربي ماضيًا فشأنه إتيانه في هذه الصيغة. يقول ضياء الدين: «ومن هذا النوع لفظة (وَدَع)، وهي فعلٌ ماضٍ ثلاثيٌّ لا ثقل بها على اللسان، ومع ذلك فلا تستعمل على صيغتها الماضية إلا جاءت غير مستحسنة، ولكنها تستعمل مستقبلة، وعلى صيغة الأمر، فتجيء حسنة. أمّا الأمر فكقوله تعالى: ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا﴾[الزخرف: 83]، ولم تأتِ في القرآن الكريم إلا على هذه الصيغة... وأمّا الماضي من هذه اللفظة فلم يُستعمل إلا شاذًّا، ولا حُسنَ له، كقول أبي العتاهية:
أثْرَوا فلم يُدخِلُوا قبورَهم ** شيئًا من الثروة التي جمعوا
وكان ما قدَّموا لأنفسهم ** أعظمَ نفعًا من الذي وَدَعُوا
وهذا غير حسنٍ في الاستعمال، ولا عليه من الطلاوة شيء، وهذه لفظة واحدة لم يتغير من جمالها شيء، سوى أنها نُقلت من الماضي إلى المستقبل لا غير»[46].
8- عيار ملاءمة السياق:
تنبَّه ضياء الدين إلى أن بعض المفردات القرآنية قد جَمُلَتْ كثيرًا لمناسبتها للسياق الصوتي أو التركيب الذي وردت فيه؛ ومن هنا فإن جمالية أمثال هذه الألفاظ ليست في ذاتها، وإنما أحرزتها بموافقتها لجاراتها في الإيقاع، والحق أن ضياء الدين، ههنا، وعَى شيئًا وغابت عنه أشياء، كما يقال في سائر البشر ذوي الإدراك المحدود. ولا يجوز بحال، طبعًا، أن يكون الذوق البشري حجة في جمال الاستخدام القرآني للألفاظ.
والعرب تقول:
ومن يكُ ذا فم مُرٍّ مريض ** يجد مُرًّا به الماءَ الزّلالا
فنرى أنه ينبغي أن يسلَّم بجمالية لا متناهية للاستخدام القرآني، أدرك الناسُ ذلك أم لم يدركوا. والحقُّ أننا نظلم الرجل إن نحن قلنا إنه ناقش، أو حاجّ، أو تطرّق إليه شك في شأنٍ من هذا القبِيل، بل كان مبدؤه الذي لم يتزحزح عنه قيد أنملة أنّ جمال الأداء القرآني فوق كلّ جمال، وأنْ ليس في القرآن الكريم إلا الجميل. لكن يبدو أن بعض المتحذلقين الذين سقم حسهم النقدي رأَوْا مجانبة لفظة ﴿ضِيزَى﴾ الواردة في سورة النجم (في الذِّكر الحكيم) للذوق، وأنها خارجة عما يقتضيه البيان العالي، أَبْرَأُ إلى ربي من قولٍ كهذا، ومما هو أصغر منه! فإذا بضياء الدين يردّ عليهم حذلقتهم وسقم ذوقهم. يقول في ذلك: «وهذه اللفظة التي أنكَرْتَها في القرآن، وهي لفظة ﴿ضِيزَى﴾ فإنها في موضعها لا يسُدّ غيرُها مسدَّها، ألَا ترى أنّ السورة كلَّها، التي هي سورة النجم، مسجوعةٌ على حرف الياء، فقال: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾[النجم: 1- 2]، وكذلك إلى آخر السورة، فلمّا ذكر الأصنام وقسمة الأولاد وما كان يزعمه الكفار، قال: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى * تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ [النجم: 21- 22]، فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعُها عليه، وغيرها لا يسُدُّ مسدَّها في مكانها. وإذا نزلنا معك، أيها المعاند، على ما تريد قلنا: إنّ غير هذه اللفظة أحسن منها، ولكنها في هذا الموضع لا ترِد ملائمةً لأخواتها ولا مناسبة، لأنها تكون خارجةً عن حروف السورة»[47].
وقد وقف الرافعي عند هذه الكلمة وتبيَّن من جمالها مظاهر كثيرة، ومخايل لا يملك من يطّلِعُ عليها إلا أن يخفض جَناح الإقرار والتأييد. قال الرافعي: «وفي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه، وما حُسنت في كلام قط إلا في موقعها منه، وهي كلمة ﴿ضِيزَى﴾ من قوله تعالى: ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ [النجم: 22]، ومع ذلك فإنّ حُسنها في نَظْم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه، ولو أردتَ اللغةَ عليها ما صلح لهذا الموضع غيرُها؛ فإن السورة التي هي منها، وهي سورة النجم، مفصَّلة كلّها على الياء، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل، ثم هي في معرض الإنكار على العرب؛ إذ وردَت في ذكر الأصنام وزعمهم في قِسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بناتٍ لله مع أولادهم البنات، فقال تعالى: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى * تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾[النجم: 21- 22]، فكانت غرابةُ اللفظ أشدَّ الأشياء ملاءمةً لغرابة هذه القِسمة التي أنكرها، وكانت الجملةُ كلُّها كأنها تُصَوِّرُ في هيئة النطق بها الإنكارَ في الأولى والتهكُّمَ في الأخرى، وكان هذا التصوير أبلغَ ما في البلاغة، وخاصةً في اللفظة الغريبة التي تمكّنَت في موضعها من الفصل، ووَصَفَت حالة المتهكِّم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدَّين فيها إلى الأسفل والأعلى.
وجمعت إلى كلّ ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية... وإنْ تعجَبْ فعاجب لنظم هذه الكلمة الغريبة وائتلافه مع ما قبلها؛ إِذْ هي مقطعان: أحدهما مدٌّ ثقيل، والآخر مدّ خفيف، وقد جاءت عقب غُنَّتَين في ﴿إِذًا﴾ و﴿قِسْمَةٌ﴾؛ وإحداهما خفيفة حادة، والأخرى ثقيلة متفشية، فكأنها بذلك ليست إلا مجاورة صوتية لتقطيع موسيقي. وهذا معنًى رابعٌ للثلاثة التي عددناها آنفًا، أمّا خامس هذه المعاني، فهو أن الكلمة التي جمعت المعاني الأربعة على غرابتها، إنما هي أربعة أحرف»[48].
ذلكم، إذن، ما كان من أمر جماليات المفردة القرآنية عند هذا العالم الأديب البليغ، ولعل أقلّ ما يستحق ضياءُ الدين منّا أن نقول في خاتمة المطاف أنه استطاع بحبِّه لكتاب الله وملازمته إيّاه تلاوةً وتأملًا ومعاودة نظر أن يظفر بخبايا وأسرارٍ كثيرة كانت وراء بعض ما نأنس من جمال وطلاوة في المفردات والاستخدامات القرآنية. وإنّ الرجل عرَفَ قدر نفسه، وعرَفَ أقدار الآخرين، وأدرَكَ -على ضياءٍ من النَّصَفة- قيمةَ ما قدَّم، ونفاسةَ ما حصَّل، وروعةَ ما استجاد.
[1] نُشرت هذه المقالة في مجلة «التراث العربي»، العدد (44)، 1 يوليو 1991م. (موقع تفسير).
[2] انظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار، صادر في بيروت، (5/ 389- 397).
[3] المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى الحلبي بمصر، 1358هـ/ 1939م، (1/ 4).
[4] المثل السائر، (1/ 31).
[5] المثل السائر، (1/ 77).
[6] المثل السائر، (1/ 115).
[7] المثل السائر، (1/ 50).
[8] وفيات الأعيان، (5/ 391).
[9] وفيات الأعيان، (5/ 392).
[10] الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور، ابن الأثير، ت. مصطفى جواد، ط. المجمع العلمي، 1375هـ، ص1- 3.
[11] المثل السائر، مقدمة المحقق، ص يد- يه.
[12] المثل السائر، (1/ 76).
[13] المثل السائر، (1/ 4).
[14] المثل السائر، (1/ 30- 31).
[15] كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري، تحقيق: عليّ محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ص48.
[16] المثل السائر، (1/ 181).
[17] المثل السائر، (1/ 20- 21).
[18] المثل السائر، (1/ 5).
[19] المثل السائر، (1/ 151).
[20] المثل السائر، (1/ 150).
[21] المثل السائر، (1/ 178).
[22] المثل السائر، (1/ 149).
[23] المثل السائر، (1/ 157).
[24] إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي في بيروت، ط9، 1393هـ= 1973، ص214.
[25] المثل السائر، (1/ 152- 153).
[26] المثل السائر، (1/ 149).
[27] عيار الشعر، ابن طباطبا، تحقيق وتعليق: د. طه الحاجري ود. محمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 1956م، ص14- 15.
[28] إعجاز القرآن، ص215- 216.
[29] انظر: المثل السائر، (1/ 188).
[30] المثل السائر، (1/ 188).
[31] المثل السائر، (1/ 188- 189).
[32] إعجاز القرآن، ص229.
[33] المثل السائر، (1/ 191- 192).
[34] إعجاز القرآن، ص227- 228.
[35] المثل السائر، (1/ 183- 184).
[36] إعجاز القرآن، ص233- 234.
[37] إعجاز القرآن، ص217.
[38] المثل السائر، (1/ 157- 158).
[39] المثل السائر، (1/ 143).
[40] المثل السائر، (1/ 148).
[41] إعجاز القرآن، ص234- 235.
[42] المثل السائر، (1/ 284- 285).
[43] إعجاز القرآن، ص232.
[44] المثل السائر، (1/ 286- 287).
[45] إعجاز القرآن، ص233.
[46] المثل السائر، (1/ 283).
[47] المثل السائر، (1/ 156- 157).
[48] إعجاز القرآن، ص230- 231.


